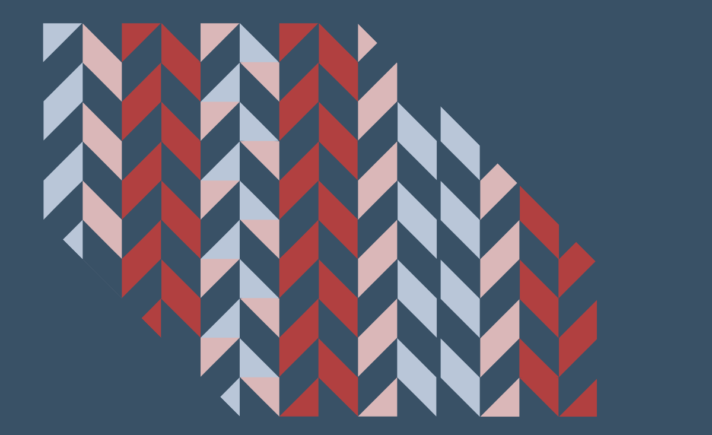مزيجٌ من الوجل والرهبة كان ينتابني عند البدء في كتابة هذا النص، خصوصاً بعد أن قال أحد الأصدقاء الذين أثقُ برأيهم إن الموضوع معقدٌ وصعب. ولكنني لم أتخلَ عن فكرة كتابة النص وعن محاولة قول ما أريدُ قوله من هذا الشأن، كشابٍ عاصرَ سنوات الثورة، غمره التفاؤل في بدايتها، وتألم وأُحبِط لاحقاً بعد أن أدرك أن أحلام جيله قد تم إغراقها بالدماء.
كيف يمكن لثورة، وهي فعل سياسي بامتياز، أن تنتج نشطاء ثوريين بدون سياسية، أو يعادون السياسة، أو يقفون موقف المرتاب من السياسة والسياسيين؟ ربما يرتبط الأمر بما نعرفه عن السياسة وبما يجب أن نرجوه منها، وبما ترتبط به هذه الكلمة «السياسة» من صور وأفكار في مخيلتنا.
سأتحدثُ كشابٍ فاعلٍ في هذا الحراك لا يتنكر لمسؤولياته، محاولاً في الوقت نفسه نقد وتحليل – بقدر ما يمكنني- الظروف الموضوعية والذاتية التي جعلت شباب الثورة لا ينفكون يعبرون عن عدائهم للسياسة.
خلال السنوات الخمسة الأخيرة ظهرت فئة من النشطاء الشباب لا يمكن إغفال دورها في الحراك السوري، وتتراوح أعمارهم ما بين 17 عاماً وحتى 35 عاماً، وربما يعبر ذلك عن الصفة البنيوية في المجتمع السوري، وهي ارتفاع نسبة فئة الشباب، الأمر الذي كان في رأيي أحد الأسباب البعيدة أو العميقة للثورة في سورية، لما ترتب عليه من مشاكل البطالة والفقر في ظروف تراجع مستويات التنمية.
يجب أن ننوه أننا نتناول في محاولة البحث هذه فئة شباب الثورة فقط، لاعتقادنا أنها تشكل كتلة ذات مشترك واحد، هو إيمانها بالثورة السورية مع الأخذ بالاعتبار اختلاف التوجهات السياسية، أي أننا لا نتناول الشباب بوصفهم شباباً فقط، وذلك للاختلاف الجذري بين رؤية هؤلاء ورؤية الشباب المؤيدين للنظام السوري أو المنضوين تحت راية حركات جهادية كتنظيم داعش وجبهة النصرة.
لقد كان هؤلاء الشباب جزءً من مشكلة البلاد، وخلال الثورة كانوا يأملون أن يكونون جزءً من الحل، وجزءً من سوريا الجديدة، دولةً قادرة على استيعاب طموحاتهم الكبيرة، ونظاماً جديداً قادراً على تفريغ شحنات الطاقة التي يمتلكونها. كانوا طاقة عظيمة تحولت فيما بعد إلى ما يشبه مخزن البارود بعد وصول نار الثورة إليه.
منذ بدء الاحتجاجات كان الشباب عماد الحركة المطالبة بالتغيير، وحملت على عاتقها بث روح الثورة في جسد المجتمع السوري كونها شكلت نسبة لا يستهان بها من عدد المتظاهرين، مما جعلهم في لحظات ما قادرين على توجيه الحراك السلمي والقبض على زمامه، لذلك ومنذ البداية خاضت هذه الفئة تجارب تنظيمية واقعية غاية في الأهمية، مثل التنسيقيات والمكاتب الإعلامية ومؤسسات الإغاثة، التي كان من الممكن أن تتبلور إلى هياكل سياسية تمثل تطلعاتهم. لكن معظم هذه التجارب انتهى أخيراً إلى التمزق، نظراً لاستهداف الشباب القائمين عليها بشكل مزدوج، إما من قبل النظام أو من قبل مجموعات مسلحة متطرفة، وكذلك لم تلبِ مؤسسات المعارضة كالمجلس الوطني والائتلاف ما هو مرجو منها بالنسبة لهم، وجاء ذلك في سياق الفشل العام لهذه المؤسسات في تمثيل الثورة السورية بكافة أطيافها.
في الوقت نفسه عجزت الأحزاب الجديدة عن توفير الأرضية الملائمة لهذه الفئة كي تلم شتاتها وتعاود الظهور والنمو، على الرغم من أن هذه الفئة هي التي ستشكل الطبقة السياسية السورية الجديدة عاجلاً أم آجلاً، والأحزابُ الجديدةُ هي الإطار الذي يمكن أن يحتوي الشباب سياسياً، ويجمع خبراتهم المتحصلة من سنوات الثورة.
ترجع محاولة استهداف هذه الفئة إلى البدايات، عبر استهداف التنسيقيات التي كانت في مكان طليعي في قيادة الحراك، فكان نظام الأسد أول من قام باستهداف أولئك الشباب عن طريق الاعتقال والملاحقة والتعذيب، بالإضافة إلى الدفع للعمل المسلح، وأيضاً الإفراج عن قياديين في الحركات السلفية الجهادية الذين جاهروا بعدائهم لأفكار هؤلاء الناشطين الشباب ورؤيتهم السياسية منذ لحظة خروجهم. ولاحقاً انضمت للنظام أطراف إقليمية ترمي لاستهداف ما وصفه سلامة كيلة المفكر الفلسطيني «الطبيعة العميقة للثورة السورية»، والتي ارتبطت بشكل وثيق بشريحة بالشباب أكثر من أي فئة أخرى من المجتمع السوري، في وقتٍ تمتع فيه السياسيون الأكبر سناً والمنتمون لأحزاب سياسية، وهم بمعظمهم معتقلون سابقون لدى النظام، ترفَ النأي بأنفسهم عن الثورة.
حاول عدد من الشباب غير المسيس الدخول إلى عالم السياسة خلال العامين المنصرمين، وذلك عن طريق مجموعات سياسية محلية بشكل خاص، تحرروا فيها من سيطرة السياسيين التقليديين، إلا أنهم فشلوا بشكل مبكر، لسبب رئيسي هو في اعتقادي أن العمل السياسي لم يكن توجهاً أصيلاً لديهم، بقدر ما كان ردة فعل على مشاعر الإحباط الناتجة أصلاً عن تعثر مسار الثورة من جهة، وتعثر المسار التعليمي أو المهني الذي كانوا فيه وذلك بعد حرمان أغلبيتهم من متابعة تعليمهم الجامعي، وهو بالذات ما يرون أن فرصة استدراكه تصبح أبعد مع عدم وضوح أفق الثورة أو منتجاتها، وهي التي يجب أن تكلل بنظرهم بسقوط النظام جزئياً على الأقل.
وقد يقال إن زعمي باطل بخصوص أن فشل المسار التعليمي والمهني كان دافعاً لمحاولات العمل السياسي المتعثرة مؤخراً، وذلك لسبب يبدو وجيهاً وهو أن الشباب قرروا الانخراط في الثورة السورية وكانوا في جامعاتهم يتابعون تعليمهم الجامعي عندما بدأت تتعاظم حركة الاحتجاجات، إذا فرضنا أن ممارسة العمل السياسي من قبلهم هو ردة فعل. وهنا أقول إن مشاعر الإحباط لدى الشباب كانت موجودة أيضاً قبل الثورة، وكان من أسبابها المباشرة غياب تكافؤ الفرص وارتفاع معدلات البطالة، وبحلول عام 2011، كان معدل البطالة قد وصل إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة في سوريا، مما جعل التعليم الجامعي غير ذي نفع لعدد كبير منهم، وهو ذاته الإحباط الذي كان أحد أسباب خروجهم للشارع بغرض التغيير، ويدفعهم الآن إلى محاولات انتظام تكون تعويضاً عن ذاك الشعور بالإحباط.
ينعكس ما أوردناه سابقاً على شكل فشلٍ مبكرٍ لممارسة الشباب السياسة، ويُترجَم عداءً للسياسيين التقليديين الذين لا يلتفتون إلى مشاكل الشباب وانكساراتهم وطموحاتهم، التي تفاقمت جراء استعصاء الحسم في سوريا. ومما تجدر الإشارة إليه أن ظاهرة التحاق الشباب بالعمل السياسي على خلفية الإحباط جراء عدم القدرة على متابعة التعليم الجامعي، منتشرة في عدد كبير من بلدان العالم وفي بلدان أوروبية أيضاً، بسبب عدم قدرة الطلاب في بعضها على متابعة دراساتهم العليا لظروف اقتصادية.
وجدت القوى السياسية التقليدية في الانتفاضة فرصة لتجديد دورها، والاستفادة من حالة الفراغ السياسي، ولم يتسن للثورة ببعدها الشبابي أن تكوّن تعبيراتها السياسية، وهو ما أتى في مصلحة تلك القوى التي شاخت، ببرامجها ورموزها وخطابها، لكنها استفادت من علاقاتها مع بعض دول الإقليم؛ لتطرح نفسها كممثل عن ثورة السوريين، وهو ما تؤكده الحملة التي روّج لها المجلس الوطني في شعار: «المجلس الوطني يمثلني»؛ لاكتساب شرعية شعبية، وقد استجاب كثرٌ لتلك الحملة بدوافع عدة، منها الحاجة إلى مظلة سياسية تعبّر عن الانتفاضة، ولاحقاً اتسعت الفجوة بين الشباب وبين القوى السياسية، بسبب غياب مجموعات الشباب المسيّسين (ناصريون – شيوعيون – إسلاميون معتدلون) التي شكلت قيادة لحراك السلمي في مختلف المناطق في المراحل الأولى، جراء بروز الأجسام السياسية في الخارج بدعم دولي وإقليمي، ثم الذهاب باتجاه العمل العسكري الذي أنهى أي محاولة جدية من قبلهم للاشتغال بميدان السياسة، إضافة إلى صعود التيارات الإسلامية الرافضة لأفكار هؤلاء الشباب، مما جعل الشباب الأقل تسيساً بمواجهة القوى التقليدية دون امتلاكهم أي مقومات سياسية وفكرية للوقوف بوجهها بشكل نديٍّ ومثمر.
تضخم دور القوى التقليدية نتيجة تدفق المال السياسي، أما الشباب فقد قبضوا الريح، وأصبحوا بدون وزن، وبدون أمل، هائمين ضائعين أمام هول التحولات التي ضربت حياتهم دون أن يستطيعوا فهم مجريات الأمور وكيفية مواجهة التحديات مع غياب القدوة الشبابية السياسية التي كان يوفرها الشباب المسيّس الذي توارى عن المشهد. ويتحمل الشباب السوري الثائر بشكل عام بعض المسؤولية عن هذا التواري، بحماسهم المفرط للعمل العسكري، خصوصاً عند الفئات العمرية الأصغر (18 إلى 25 عاماً).
تتجنب القوى السياسية التقليدية الكلام عن «صراع أجيال» بين الشباب والقيادات السياسية التقليدية، وترى الأخيرة أن التوصيف غير مناسب للحالة، وناتج عن اندفاع الشباب وتهورهم في الصدام مع هذه القوى، وتفترض أن الطرفين يجب أن يكملا بعضهما، إلا أن الحقيقة هي أن كلا الطرفين، وبغض النظر عن الفئات العمرية، مختلفان جداً في الطموحات والأهداف، وهناك صراع محموم بين هاتين الفئتين،
ولا يمنع من الاعتقاد بذلك وجود حالات خاصة تكامَلَ فيها الطرفان، كحالة التأييد للمجلس الوطني، فالشاذ هنا يؤكد القاعدة ولا ينفيها.
على العكس من ذلك، نرى أن تفاعل الجماعات الإسلامية المقاتلة (داعش، النصرة، أحرار الشام، وغيرها) مع شريحة الشباب يبدو أكثر براغماتية، فهي تعي تماماً أن السواد الأعظم من هذا الشباب لا يملك أي خبرة سياسية، ولا يستطيع مواجهة جهات إيديولوجية تقول له إنها تحمل الحلول له ولمشكلاته، كما تحاكي رغباته وطموحاته الشبابية، عن طريق منحه المال أو العمل الفاعل ضمن صفوفها بمناصب قيادية إن كان لدى الشاب صفات قيادية بارزة. لذلك نرى تواجداً شبابياً كثيفاً في هذه الجماعات، ومنهم عدد لا يستهان به ممن كانوا قد خرجوا إلى الشارع في العام 2011 مطالبين بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحريات السياسية وتكافؤ الفرص وإصلاح النظام التعليمي.
من جانبٍ آخر، نجد أن هناك سبباً موضوعياً لعدم اشتغال الشباب الفاعل في العمل السياسي، وهو يتلخص بسؤالٍ ما زال بحاجة إلى إجابات عميقة: ما هو الحزب السياسي اليوم؟ وماذا يعني للشباب؟
تتراجع أهمية الحزب السياسي في أوروبا والعالم الغربي لصالح ممارسات سياسية أفقية وأكثر تفاعلاً مع المجتمع المدني الذي تزداد أهميته يوماً بعد آخر، وهناك أسباب أخرى أهمها ثورة وسائل الاتصال الاجتماعي وتوفر خدمة الإنترنت. وبالعودة إلى الحزب السياسي في القرن الماضي في سوريا، نرى أن معظم المنتمين لهذه الأحزاب وخصوصاً من الشباب كانوا يبحثون عن طريق تواصل يستطيعون بلورة ثقافتهم من خلاله، وكانت معظم هذه الأحزاب تعتني بالتنمية الفكرية أو العقائدية لأفرادها الجدد عن طريق الكتب والنشرات والدوريات.
من الواجب النظر اليوم إلى ما يوفره الإنترنت من معلومات وكتب ومعارف وأشخاص، إننا أمام بحر هائل من كل ما سبق، وبإمكان أي شاب الوصول إلى أي شخص أو كتاب أو صحيفة أو معلومة. سيسأل كثيرٌ من الشباب أنفسهم اليوم: لماذا علينا أن ننتسب إلى أحزابٍ إذا كنا قادرين على العمل والتعلم من شبكات الانترنيت؟ لماذا عليَّ أن أخضع لدورات إعداد ثقافي أو عقائدي من أجل الدخول في أحزاب، وبإمكاني أن أثقف نفسي سياسياً عن طريق المعلومات والمعارف المتاحة عن طريق الإنترنت؟
لا شكَّ أن العمل السياسي لا يقتصر على الإعداد، وأن الحزب السياسي ليس مجرد أداة لنقل المعلومات والمعارف. أوافق على ذلك، ولكن حتى التعبير عن موقف عن طريق اعتصام أو مظاهرة صار بالإمكان القيام ببديل عنه من البيت أو حتى من مكان العمل، وصار بالإمكان تجميع الآلاف وحشد الرأي العام عن طريق وسم في توتير، أو تغيير صورة الحساب الشخصي بما يمليه الموقف الذي يريده صاحبه.
أخذت كل هذه العوامل كثيراً من الجانب الوظيفي للحزب، بوصفه معبراً عن آراء تيار سياسي في المجتمع، والأسئلة في هذا الإطار لا يمكننا حيالها سوى الانتظار حتى تتشكل ممارسة سياسية تأخذ بعين الاعتبار هذا المتغير، أي وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكن أن ينطلق حل قضية ابتعاد الشباب عن العمل السياسي من البحث في عوامل ثلاث: إحباط الشباب الناتج عن الأزمة، والمتغير الذي تفرضه وسائل الاتصال الاجتماعي، وغياب القدوة السياسية الشبابية. وباعتبار أن السببين الأول والثاني غير مرتبطين بالشباب بقدر ما يبدو أنهما خارجيان وموضوعيان، فإن السبب الأخير، وهو غياب القدوة الشبابية، ميدانٌ جيدٌ للعمل عليه من قبل الشباب، عبر أدراكهم أنهم سوف يكونون الطبقة السياسية الفاعلة في المستقبل، مما يوجب عليهم إنتاج قيادات شبابية تصبح قدوة بالنسبة للشباب الآخرين الباحثين عن الإنسان المثال، ولا يجب أبداً الاستهانة بتأثير القدوة في سلوك الشباب المندفع.