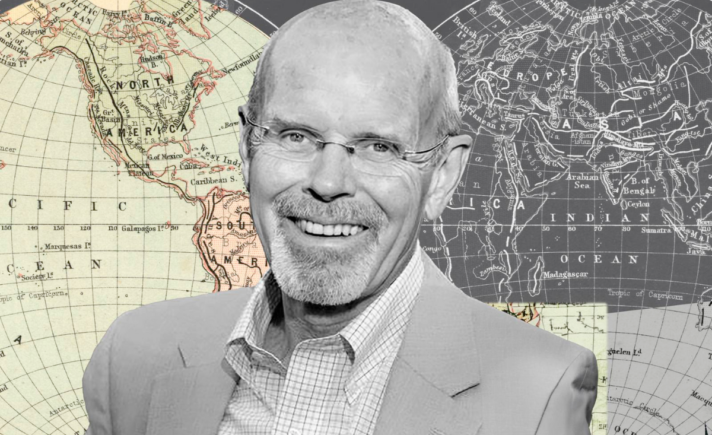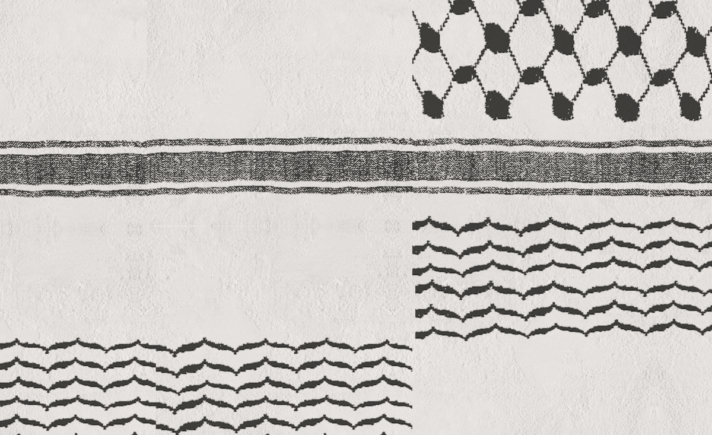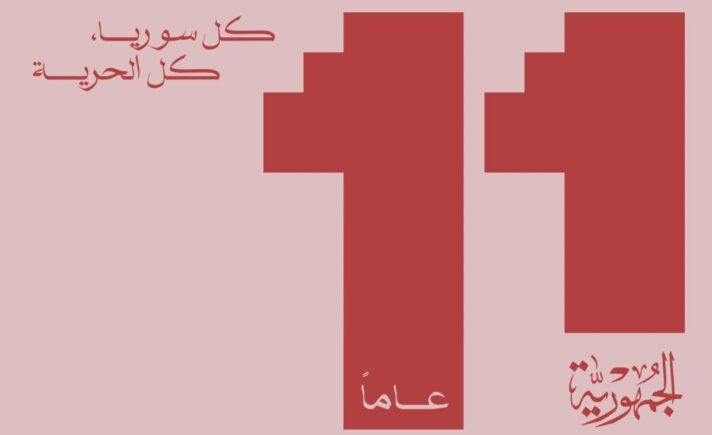بعث العزيز حازم صاغية رسالة إلى مجموعة الجمهورية قبل أسبوعين، ضمنّها ملاحظات نقدية تتعلق باستحضار المجموعة لـ«اليسار»، «بسبب أو بدون سبب» حسب قوله. وإذ أناقشُ الآن بعض النقاط التي استوقفتني في الرسالة هذه، إن من حيث اختلافي الواضح معها أو تساؤلي عن النهايات المنطقية لفحواها، لا بد أن أعترف أولاً أني أشعر بمزيج من التهيب والاعتزاز. التهيب لأني بشكل أو بآخر بصدد الرد على واحد من أهم كتاب المشرق العربي في ربع القرن الأخير وأكثرهم إثارة للجدل، والاعتزاز لأن «الجمهورية» على يفاعة تجربتها وعدم انتظام إنتاجها تماماً، باتت هي أيضاً مثار جدل ونقاش، ومنصةً تتجاوزُ في تغطيتها وتأثيرها والتفاعل معها الإطارَ السوري.
والحال أن العلاقة بين «الجمهورية» والشأن السوري، والذي يجد حازم أننا لا يجب أن «نهدر» الوقت بعيداً عنه، هي أول ما استوقفني في رسالته. فالكاتب المخضرم الذي يأخذ علينا اهتمامنا بمفكرين يساريين من أمثال غرامشي وتشومسكي، لا يقترح علينا بالمقابل الالتفات إلى مفكرين ليبراليين أو محافظين، أو الانفتاح على كتًاب ابتعدوا عن الاصطفاف الإيديولوجي برمته، بل يتمنى علينا التركيز على الموضوع السوري و«ما يتصل به بشكل مباشر لا يقبل التكهن». وهو حتى عندما يسلّم جدلاً بيسارٍ مختلفٍ انبثق عن الماركسية الغربية ومدرسة فرانكفورت، فإنه يعود ليشيح النظر عنه بدعوى عدم ارتباطه بالمجتمع السوري ومشاغله. لذلك وقبل أن نخوض في فهمنا لليسار وأسباب استحضارنا له، يبدو من الضروري أن ندافع أولاً عن فهمنا لطبيعة عمل «الجمهورية»: لسنا ولا نريد أن نكون منصةً تختص بالشأن السوري فقط، وتنتج عنها الشهادات الأولية والتحليلات المحلية، بل أيضاً وبالتوازي نافذةً سوريةً وعربيةً تطلّ على العالم وتشارك في نقاشاته الفكرية والسياسية الكبرى. لا نريد الغرق في «الاستثناء السوري»، ولا قبول أنه من الترف لشعبٍ محطمٍ مثلنا أن ينظر بعيداً، ليتعلم من الهند واسبانيا والأرجنتين وعنها، وأن يفكر عميقاً ويناقش قضايا نظرية وكونية كما يفعل أصحاب الاهتمام في نيويورك ولندن وباريس، وبيروت، دون حاجة إلى التبرير الدائم أو التوطئة المحلية المباشرة. سوريا، على فداحة مأساتها، جزءٌ من هذا العالم، والسعيُ من أجل فهمها وتغييرها لا يمكن أن ينفصل عن السعي لفهم وتغيير العالم، ولذلك، وقبل أي اصطفاف فكري أو سياسي، تبقى «الجمهورية» ملتزمةً بالحفاظ على جانب كوني في هويتها وعملها.
ولأن حازم لا يقارب «الجمهورية» على أرضيةٍ فكريةٍ كونية، بل بالنظر دوماً إلى موقعنا كسوريين معارضين لبشار الأسد، فهو يتجاوز أيضاً في حديثه عن اليسار أي تمييز بين المعرفي والسياسي. وبذلك يصبح الحديث عمّا يمكن أن نتعلمه من كلام غرامشي وتلاميذه الهنود عن الانتفاضات الريفية مساوياً للغزل بجيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني، ويغدو البحث فيما يقوله تشومسكي عن الأخلاق الكونية والنسبوية الثقافية صنواً لتبني ترشيح برني ساندرز في الانتخابات التمهيدية الأمريكية! وبحسب هذا المنطق، ولأن 90 % من اليسار اليوم يقف في صف بشار الأسد، ربما يجب علينا أيضاً ألّا ننخرط في أي نوع من أنواع التحليل الطبقي للمجتمعات، وأن نتجاهل الأثر الهائل للماركسية وتفرعاتها على العلوم السياسية والاجتماعية خلال القرنين الماضيين، وأن نرفض قراءة أريك هوبزباوم في التاريخ، ووالتر بينامين في النقد الثقافي، وبدر شاكر السياب في الشعر العربي!
مقاربةٌ سياسويةٌ كهذه لا تظلم «الجمهورية» فقط، فتضعها في موقع العاشق لمعسكر سياسي لم تنشر الجمهورية بخصوصه إلا النقد والإدانة، بل تبدو وكأنها تتوقع من «الجمهورية» أيضاً عزل نفسها بشكل واضح عن أدوات ونقاشات معرفية لم تعد اليوم حكراً على قدامى الماركسيين، بل يتداولها الليبراليون كما اليساريون، وأنبياء الأصالة كما رواد ما بعد الحداثة. فإما أن حازم يستكثر علينا النقاشات الفكرية كما الشطحات الكوزموبوليتية، وإما أنه يريد بالفعل أن يأخذَ الفكريَ بجريرة السياسي، فيشابه دون أن يقصد الممانعينَ في تجريمهم الطويل لأي اهتمام بالمسألة اليهودية والنتاج المعرفي اليهودي بحجة العداء لإسرائيل، والإسلاميينَ في توجسهم من مجمل العلوم الاجتماعية والإنسانية بوصفها رجساً علمانياً أو وحياً من شياطين الغرب الصليبي!
لكن لبَّ المشكلة في رسالة حازم لا تكمن في مقاربته لـ«الجمهورية» كمنبرٍ سوريٍ حصراً، ولا في تجاهله للفرق بين الاهتمام الفكري والغزل السياسي في مقاربتنا نحن لمسألة اليسار، بل في عزله للثورة السورية عن سياقها الاجتماعي أولاً، واعتباره أن النقاش القِيّمي القابع في الأساس وراء كلمات قد تكون متقادمة وفضفاضة وشديدة الإشكالية في بعض السياقات كـ«اليسار» و«اليمين»، بات هو أيضاً متقادماً وبلا معنى. فمن خلال هاتين الخطوتين سيبدو بالفعل وكأن الثورة السورية و«اليسار» ينتميان إلى كوكبين مختلفين، وأن استحضار اليسار في موقع كـ«الجمهورية» ليس إلا إقحاماً يُنتجه «ولاء متوارث لسلف فكري صالح».
لكن الواقع، بالنسبة لكاتب هذه السطور وزملائه في «الجمهورية»، يكاد يكون العكس تماماً! فحساسيتنا اليسارية تبلورت بشكل أساسي من خلال التفاعل مع وقائع الثورة السورية. ذلك أن حازم عندما يقول محقاً إن موضوعة الاستبداد والحرية هي لبُّ الثورة السورية، يُغفلُ أن الموضوعة هذه ارتبطت منذ اللحظة الأولى، أقلّه على صعيد النقاش السوري-السوري، بسؤال: «حرية من تحديداً؟»، وأن هذا السؤال لم يكن يحيل فقط إلى تناقضات المجتمع السوري الطائفية، بل والطبقية منها أيضاً، وبشكلٍ فاقعٍ وصلَ ذروته مع مقولة «ثورة أبو شحاطة»، وتساؤل كثيرٍ من أبناء الطبقات الوسطى والعليا من مختلف الطوائف فيما إذا كان أبناء الأرياف والأحياء الفقيرة يعرفون معنى الحرية، أو يستحقونها أصلاً! وفي الواقع، إن كان هناك من صدمة أخلاقية شخصية أساسية ارتبطت في ذهن الكاتب بالثورة بالسورية، فهي أن نُخباً مدينية -دمشقية وحلبية بشكل أساسي- دأبت في الماضي على انتقاد النظام وتمني الخلاص منه، كشفت منذ آذار عام 2011 عن ترسانة فكرية حداثوية شديدة النخبوية ناصبَت الثورة العداء بسبب هويتها الطبقية تحديداً، وذهبت بهذا إما إلى موقعٍ فاشيٍ ينادي بسحق «العراعير» المتخلفين وتسوية قُراهم بالأرض، أو إلى موقعٍ محايدٍ لا يستطيعُ تأييدَ ثورةٍ يقودها فلاحون بسطاء.
قد يبدو السياق الاجتماعي للثورة السورية هامشياً بعد خمس سنوات من الصراع، سيما للمعنيين بشكل أساسي بالجانب الإقليمي والدولي للمسألة السورية، لكنه لا يزال يتفاعل بقوة تحت رماد الحرب، ويبقى مرشحاً للعودة بقوة مع توضح شكل الحل السياسي القادم. ومن خلال هذا السياق تحديداً، ومع اصطفافات الثورة خلال عامي 2011 و2012، باتَ واضحاً لكثيرين منّا -ولم نكن منخرطين أو معنيين لا بالأممية الثالثة ولا الرابعة- أن قضية الحرية في سوريا، ليس في جانبها الفردي القائم على عدم التدخل في الحيز الخاص بل في جانبها الجمهوري القائم على امتلاك الشعب للمجال السياسي العام، لا يمكن فصلها أبداً عن قضية المساواة بمعناها السياسي والإنساني الأعمق، وأن النضال من أجل ديمقراطية حقيقية في بلد فقير وطرفي مثل سوريا هو في واقعه دفاعٌ عن الأهلية السياسية والقيمة البشرية لأكثرية الناس من فقراء ومهمشين، وأن الانتصار لهؤلاء، الذين هم قادة الثورة ومادتها وأكثر من ضحى لأجلها، لا يكون إلا بالنضال ضد تراتبيات السلطة والمال والثقافة والجغرافيا التي تعمل بنيوياً، في سوريا كما في كل العالم، للحدِّ من مكانهم ومكانتهم وقدرتهم على الفعل في المجال العام، الآن، وبشكل أشرس وأكثر وضوحاً بعد نهاية الحرب وبداية إعادة الإعمار وعودة الحكم المركزي.
ألا تحمل هذه العِبَر طابعاً يسارياً ما؟ ألا يمكن ترجمتها بشكل سياسي، ودون إقحام اقتباساتٍ من ماركس وتروتسكي، إلى تيار ديمقراطي اجتماعي يلتزم بشكل واضح بالمصالح السياسية والاقتصادية للفئات الأوسع والأكثر تضرراً من الحرب السورية، ويرى النضالَ ضد الاستبداد في معناه الأعمق نضالاً من أجل العدالة الاجتماعية، والنضالَ من أجل العدالة الاجتماعية نضالاً ضد الاستبداد؟ ألا يمكننا البناء على هذه العِبَر معرفياً أيضاً فنضع الثورة مثلاً في إطار كوني مقارن بوصفها ثورة ريفية، بدلاً من التوقف فقط عند تفاصيلها المحلية؟ ألا يمكننا أن نحاول مثلاً فهم بنى السيطرة التي تدفع بفقراء العلويين للموت من أجل الأسد حتى اليوم بدلاً من رد القضية فقط إلى الانهيار المديد لمجتمعاتنا، أو أن نتفاعل مع قضايا التحرر الديني والجندري والجنساني الحاضرة لدنيا اليوم، دون الوقوع في فخ النخبوية؟ لا أرى في هذا ولا ذاك هلوسة يسارية طهرانية، ولا إقحاماً لأفكار غريبة وبعيدة عن الواقع السوري.
هل من الغريب جداً أن يدفعنا اهتمامنا بالمساواة كما بالحرية، وإيماننا بنُبلِ السعي نحو العدالة الاجتماعية، إلى التساؤل عن مصائر ونقاشات هذا التيار السياسي والفكري العريض والمتنوع، الذي لم يؤسس لأنظمة يسارية كما في روسيا وأوروبا الشرقية وبعض بلدان العالم الثالث، ولم يتوقف على مدى ما يقارب القرنين من الزمن عن التأزم والتفكك وإعادة التشكل، كما أنه لم يتوقف أيضاً عن الدفع بمفاهيم المشاركة السياسية إلى مداها الأقصى، والتأسيس لمفاهيم الحقوق الاجتماعية بحدها الأدنى ونقد بنى السلطة واللامساواة على اختلاف أنواعها، والنضال ضد الفاشية والعنصرية والاستعمار. هذا التيار العريض والمتنوع، والذي شمل ديمقراطيين ثوريين ونقابيين واشتراكيين وأناركيين وتروتسكيين وماركسيين غربيين و«تقدميين» أمريكيين حتى الحرب العالمية الثانية، ومن ثم توسعَ بعدها ليشمل في الستينات تيارات واسعة في حركة الحقوق المدنية وحقوق المثليين والنسوية الجذرية، وليقود في السبعينات معارك ضارية ضد الديكتاتورية في هند أنديرا غاندي كما في أميركا اللاتينية.
لا يمكن فهم بعض أبسط معالم الديمقراطية الليبرالية في العالم اليوم، ولا السير خطوة في بحر الأنثربولوجيا وعلم الاجتماع والتاريخ والنقد الأدبي والنظرية السياسية، دون فهم أفكار هذا التيار التي بدأت دوماً هامشية وجنونية. هذا التيار، أقلّه في أعراف التسميات في اللغة الانكليزية، هو أيضاً جزءٌ من «اليسار»، والبحثُ في تاريخ الفكر العربي الحديث يظهر حضوره هنا أيضاً، من يوسف يزبك إلى اسماعيل مظهر، ومن سلامة موسى إلى رئيف خوري.
لا يعني ما تقدَّم أن هذا التيار العريض هو «اليسار الحقيقي» كما سيعتقد البعض أني أقول -لا أؤمن أن هناك يساراً حقيقياً كما لا أؤمن أن هناك إسلاماً حقيقياً- لكنه بلا شك حقيقةٌ واقعةٌ في التاريخ، وأخذه في الحسبان كان سيصعّب على حازم جوهرةَ اليسار بوصفه متنافياً مع الحرية. أما أني أُسبغُ على هذا التيار معنىً نبيلاً (دون أن أتغاضى عن أزماته وتناقضاته)، فهذا صحيحٌ بلا شك، ولكن ما الضير في ذلك تماماً؟ ألا يُفترضُ أن نتموضع سياسياً حسب قناعاتنا القيمية، أي حسب ما نرى فيه سعياً نبيلاً إلى الحياة الجيدة؟ ألا تبدو بعض أفضل نقاشات المجالس البرلمانية في العالم وأشهر نصوص المحاكم الدستورية وكأنها نقاشات فلسفية في معنى الحرية ومعنى المساواة ومعنى التقدم؟ وكيف تتناقض هذه القيم في حين وتتقاطع في أحيان أخرى؟
وفي الواقع، إن إمعنا النظر في مقالاتها، لم يكن حديث «الجمهورية» عن «اليسار» يوماً بغرض «تجويد» الكلمة بحد ذاتها، بل للبحث في مآلات تيار فكري وسياسي ارتبط اسمه بقيمٍ تحملها «الجمهورية»، وباستطاعتنا في كل الأحوال تجاوز الكلمة كلها دون أن نتجاوز حاجتنا إلى النقاش عن القيم ومآلاتها! هل المساواة، برأي حازم، تتنافى دوماً وأبداً مع الحرية؟ وهل الصراع مع استبدادنا المحلي يتطلب القبول بنهائية النظام الليبرالي العالمي وكماله؟ نعم هناك في الليبرالية السياسية ما لا يمكن التفريط به أو التعالي عليه -قد يكون هذا هو الدرس الأساسي والأهم الذي خلص إليه جيل حازم- ولكن لأن الحرية لا تتموضع إلا اجتماعياً، ولأن جوانب جديدة لها تتكشف باستمرارٍ مع الزمن، فإن تعميقها في الواقع لم يأتِ خلال القرنين الماضيين إلا من خلال تفاعل الليبرالية مع نقدها اليساري الديمقراطي. أما القول إنه، وبحجة عدم إنجاز الليبرالية، فإن علينا ألَّا ننصت لأي نقدٍ لها، فهذا لا يُتَرجَم عملياً إلا انعزالاً عن العالم أو تحالفاً مع من يسبغون على الليبرالية هوية حضارية جامدة، أي مع الغرب المحافظ.
أخيراً، يبقى القول إنه إن كان الموقف السياسي للآخرين من الثورة السورية هو المعيار الوحيد الصحيح لتموضع السوريين من مؤيدي الثورة سياسياً وفكرياً وقيمياً، فربما يجب أن نصبح جميعاً من حملة لواء الإسلام السني المحافظ، قبل أن نلتفت إلى تفاصيل فكر جون ماكين السياسي. إذا كان العزيز حازم مستعداً للنظر في الأولى، فله مني وعدٌ أن أنظر في الثانية.