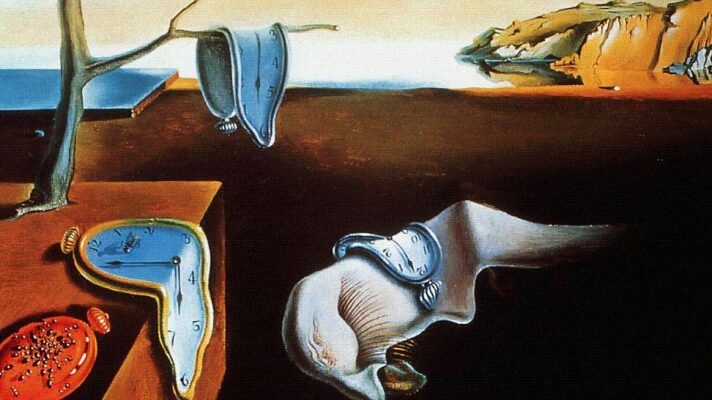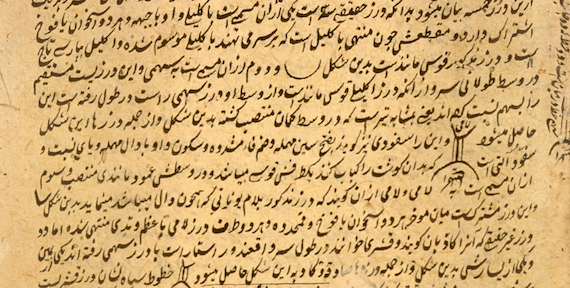تكفي قراءة بسيطة لتاريخ الأحزاب الشيوعية في منطقتنا، كي يُستَدلَ مُباشرةً على تواطؤها وتوافقها المُستبطَن مع بعض الهويات الأهلية في الدول التي نشطت فيها، قومية أو دينية أو مذهبية. حدثَ ذلك سواء بوعي هذه الأحزاب والجماعات الأهلية لتلك العلاقة المُركبة بينهما، أو عبر صمتٍ وقبولٍ متبادل، فشبكة تطابق المصالح والخِطابات والمرامي النسبية التي كانت تجمع هذه الأحزاب الشيوعية مع واحدةٍ من هذه «الجماعات الأهلية» كانت واضحة جداً، ولم يكن يمنع ظهورها ووضوحها إلا تلك النزعة الخِطابية الثقافوية والمدينوية الفوقية التي كانت تتبناها تلك الأحزاب الشيوعية، تكبتُ وتمنعُ عبرها أي تحليلٍ موضوعيٍ وشفاف لتلك العلاقات المركبة بينها وبين تلك الجماعات.
كان واضحاً أن الحزب الشيوعي السوري يجذب الأكراد السوريين أكثر من غيرهم، وأن زعامة خالد بكداش «الكردي» لم تكن مُجرد سيطرة نُخبوية فوقية من قِبل كُرديٍ ما على زعامة الحزب، بل كانت رمزياً تعني مدى هيمنة وحضور الكُرد في الحزب، خصوصاً أيام قوته التنظيمية والسياسية في خمسينات وستينات القرن المُنصرم. وأياً كانت الخِطابات غير القومية، والمُطابقة لخطاب النظام السياسي الحاكم بعد السبعينات (الأسدية)، فإن الحزب الشيوعي السوري كان أقرب، في جملة سياساته وخِطاباته، إلى الكُرد السوريين، مما كان عليه بالنسبة لغيرهم من الجماعات الأهلية السورية.
لم يكن ذلك الشيء يعني بأي شكلٍ أن تلك الخطابات والسياسيات كانت مُطابقة للنزعة القومية الكُردية، والمُعضلات المركزية التي عاناها الكُرد في الكيان السوري مُنذ التأسيس؛ لكن الشيوعي السوري كان أقرب في طروحاته إلى تلك المُشكلات الكُردية من غيره من الأحزاب السياسية «الإيديولوجيّة»، خصوصاً أن النزعة القومية الكُردية لم تكن قد تبلورت في أربعينات وخمسينات القرن المُنصرم، في أوج الاندماج الكُردي في الحزب الشيوعي السوري. بدأ تبلورُ هذه النزعة القومية الكُردية بشكلٍ مُتباين وحتى مُناقضٍ لسياسيات الحزب الشيوعي السوري منذ ستينات القرن، وكان ذلك سبباً جوهرياً لخلخلة الحزب الشيوعي وترهله، لأن الجزء الأكبر من الزخم الشعبي الذي التفّ حول الحركة القومية الكُردية في سوريا، كان على حِساب القواعد الاجتماعية الكُردية التي كانت في الحزب الشيوعي السوري.
كان الحزب الشيوعي يُطالب بالعدالة الاجتماعية وأخوة الشعوب، ولا يفرض هوية قومية ولغوية على أي من الجماعات الأهلية السورية، ويستبطن قراءة مركزية مُعادية للدولة العُظمى، التي كانت قبل سنوات قليلة قد أخرجت الكُرد من مولد الحرب العالمية الأولى دون أي «حُمّص»، وكان الحزب الشيوعي السوري يُصرّح بضرورة الخلاص من الاقطاع الجائر وهيمنة رجال الدين، وكانت أدبياته مُتخمةً بسرديات الشعوب المغبونة ونِضالاتها، يُنادي بتحالف المقموعين مع الاتحاد السوفياتي، ليتحرروا مما يُمارس عليهم. مجموع ذلك كان يُناسب البؤساء من الكُرد السوريين أكثر مما كانت توفره الأحزاب الإيديولوجيّة الأخرى (البعث، القومي السوري، والأحزاب البرجوازية.. إلخ) في ديناميكياتها وخِطاباتها السياسية، التي كانت مواتيةً لجماعات أهلية سورية أخرى. فالشيوعي السوري بمعنىً ما، كان حزب «الجماعات غير الحاضرة في صدر التاريخ» التي تسعى لأن تكون كذلك، فكان بالغ الجاذبية للجماعة الكُردية السورية.
*****
الشيء نفسه كان يجري بالنسبة للأحزاب الشيوعية في باقي الدول الإقليمية، فالحزب الشيوعي العراقي كان حزباً -بهذا المعنى- للشيعة العراقيين، وبدرجة أقلّ للأكراد، بينما كان انتشارهُ ومواءمته للسُنة العراقيين أقلَّ بكثير. كذلك كان الشيوعي اللُبناني مع الشيعة والروم الأرثوذوكس، فهو كان حزبهم أكثر بكثيرٍ مما كان حزب السُنة والموارنة اللُبنانيين. وكذلك الأحزاب الشيوعية التُركية، التي كانت تجذب العلويين والأكراد أكثر مما كانت تجذب الجماعات المركزية في البلاد، الأتراك المُسلمين السُنة الأحناف من سُكان المُدن.
بهذا المعنى أيضاً، فإن الأحزاب الشيوعية في منطقتنا لم تترهل فقط لأن التجربة الشيوعية السوفييتية انهارت، أو لأن أنظمة حُكم يمينية، قومية ودينية ومشيخية محلية، هيمنت على الحياة السياسية العامة، فتحولت معها الأحزاب الشيوعية إما إلى أجهزة سياسية تابعة وشريكة شكلياً لهذه الأنظمة، أو باتت أحزاباً شيوعية/يسارية مقموعة ومُحطمة. تحللت الأحزاب الشيوعية لكُل ذلك، لكن أيضاً لأن قواعد اجتماعية واضحة من هذه الجماعات الأهلية التي كانت توالي الأحزاب الشيوعية، انسحبت منها لصالح تيارات سياسية قومية ودينية يمينية، ومُطابقة بشكل أكثر وضوحاً، في الخطابات والبرامج السياسية، لوعي هذه الجماعات الأهلية لنفسها، بهويتها الأهلية التي باتت أكثر سياسيةً.
*****
لسببين موضوعيين، فإن التيارات السياسية اليمينية الراهنة في منطقتنا، بكل تشكيلاتها الدينية الطائفية والقومية العسكرية والسلطوية الإجرامية كما النِظام السوري، ليست يمينية بالمعنى التقليدي، أي أنها لا تُمثل ولا تسعى ولا تعتبر نفسها مُمثلة وناطقة باسم الجماعة الكُليّة «الأُمة»، بل ناطقةً ومُعبِّرةً عن جماعات أهلية أصغر، ومتباينة مع تلك الجماعة الكُليّة.
لأن «الجماعة الدينية» في منطقتنا غير قائمةٍ على «صفاءٍ مذهبي»؛ فإن التيارات اليمينية الدينية إنما هي تيارات طائفية بذاتها، تُمثل جماعةً أهليةً ما. المنطق نفسه ينطبق على التيارات القومية، التي لا تمثّلُ وعياً يُعبر عن «الأُمة» بما عنته في البُلدان التي تم استيرادها منها، ألمانيا وفرنسا، لأن كياناتنا الحديثة مُركبةٌ للغاية، وفيها مجموعات قومية واعية وموالية لهويتها القومية/الإثنية، أكثر من موالاتها لأي نزعة وطنية/مدنية، لذا فإن هذه التيارات باتت تُمثل أيضاً جماعات أهليةً ما، ضمن هذه الكيانات.
فوق كُل ذلك، الجماعاتُ الأهلية المتباينة والمُتنافرة تقوم راهناً على دعامتين مؤثرتين: من طرفٍ هي كُتل عُصبوية مُسلحة في دولٍ مترهلةٍ للغاية، ومن جهةٍ أخرى باتت مُرتبطة وجدانياً وسياسياً بدولٍ إقليمية مُهيمنة، أكثر مما هي مُرتبطة بكياناتها المحلية، وبالجماعات الأهلية الشريكة لها.
ضمن هذا السياق، إن أي نزعة يسارية في منطقتنا، وإن لم تكن تأخذ صيغة شيوعية أو ثورية انقلابية، بل جوهرياً نزعة يسارية تسعى لتشكيل كُتلة اجتماعية وسياسية من المواطنين المدنيين، الواعين بموقعهم الطبقي وحالهم الاقتصادي، الذين لهم موقفٌ سياسيٌ من السُلطة وكُل أشكال هيمنة «الأقوياء» على «الضُعفاء»، ويعملون على تفكيك خِطابات المُهيمنين وكشف أبعادها، فإن تلك النزعة سترى نفسها في مواجهة «بحرٍ» من الجماعات الأهلية المؤسسة بشكل سياسي وعسكري مُتكامل.
إذاً كيف لتلك النزعة اليسارية أن تقوم بأدوارها، فيما تخلو ساحة عملها المُفترضة من أدوات إنتاج كُل تلك السياسات والبرامج، فمنطقتنا بالمعنى السياسي والثقافي وحتى الاجتماعي الجمعي، خالية من الأفراد والطبقات والأحزاب والمدنيين والنقابات والجمعيات، وحتى من النُخب والعُمال والبيروقراطيين؛ أو أنها تحوي على أقلية قليلة من الذين يحددون هويتهم السياسية والجمعية بتلك المفاهيم والمعايير، أو توجد أشكالٌ مشوهةٌ من ذلك.
عوضاً عن ذلك، منطقتنا مُتخمة بالجماعات الأهلية والعُصب العسكرية والعصبيات المناطقية والنزعات القومجية، ثمة عرب وأكراد وسُنة وشيعة وعلويين وشوام وبيارتة… إلخ، بمعنى أنه ثمة من يحددون هوياتهم السياسية والجمعية بهذه المعايير والهويات الأهلية فحسب.
في ظل هذا، إن هذه النزعة اليسارية في «مواجهة الأهلانية»، يجب أن تجيب على ثلاث أسئلةٍ تتعلق بتموضعها الراهن.
*****
إذا كانت «العدالة» هي جوهر الخطاب والديناميكية والهدف الذي يجب أن يسعى له أي تيارٍ سياسي يساري، فإن هذا المفهوم في «عالمنا» الأهلي لم يعد يعني ما تمركزت وبنت حوله الفلسفة اليسارية نزعتها مُنذ قرن ونصف، وحتى الآن. فـ«العدالة» بمعناها العام بالنسبة لأعضاء هذه الجماعات الأهلية/العصبوية في منطقتنا راهناً، أبعد ما تكون عن مُحددات ومُخيلة هذا المفهوم في سياقه اليساري التقليدي.
الأخذ بـ«ثأر الحُسين»، أو تحقيق الحُلم القومي الكُردي، أو إعادة هيمنة المارونية السياسية، أو اعتبار حُكم العلويين لسوريا والحق التقليدي للأغلبية السُنية بالحُكم… إلخ، جميعها من الأحكام المُبسطة والمُخيلات الجمعية والعبارات القطعية، وهي التي تحتل المكان الأبرز في تعريف وتحديد مفهوم «العدالة». حيث لا تغيب القراءة المفهومية اليسارية التقليدية لمعنى العدالة فحسب، بحيث تستطيع كُل الطبقات والأفراد الحصول على درجة مُناسبة وعادلة من قوة الدولة والاقتصاد العامة وحماية مؤسسات الدولة، لا تغيب هذه المفاهيم فحسب، بل الأغلبية العُظمى من أفراد هذه الجماعات تعتبر هذه المُحددات جُزءاً من «خديعة سياسية» انجرَّ إليها أفرادٌ ما من «أبناء» هذه الجماعة في لحظةٍ تاريخيةٍ ما، ويجب أن يغيروا تماماً من رؤيتهم وقراءتهم لفكرة العدالة بجوهرها، وأن يزيدوا التصاقهم وتماهيهم مع جماعاتهم ورؤيتها لفكرة العدالة.
يجري ذلك في كثيرٍ من المُخيلة الجمعية للكرد السوريين والشيعة العراقيين والروم اللبنانيين والدروز الأردنيين والعلويين الأتراك، وباقي الجماعات الأهلية التي انتمى أفرادها بكثافة للأحزاب الشيوعية واليسارية طوال عقود من القرن المُنصرم.
بناءاً على ذلك، فإن مهمة الأحزاب اليسارية في منطقتنا لا تكمن أولاً في تصعيد «نضال» الطبقات والمؤسسات والأفراد المغبونين في مواجهة نظرائهم، بل أولاً وعيُ أن تلك الطبقات والأفراد والمؤسسات غير موجودةٍ أساساً، وأن السعي لبنائها هو جوهر وأول ما يجب العمل عليه. شيءٌ مما قاله ماركس يوماً، ما معناه أن تدهور وضع وأحوال الطبقة العاملة ليس شرطاً لتكتلها ونضالها، أنما الشرطُ هو أن تعي تلك الطبقة هويتها وموقعها وغُبنها الطبقي. الشيء نفسه يخصُّ المغبونين في منطقتنا، ووعيهم بمكامن وديناميكيات غُبنهم.
*****
المسألة الأخرى تتعلق بـ«الطبقة»، أو بتحديدٍ أكثر مُباشرة، جُملة المصالح المُشتركة بين مجموعة من الأفراد في مُجتمع ما، التي تدفعهم للتكتل والدفاع عن مصالحهم ورؤيتهم المُشتركة. فإذا كانت القراءات والأفكار ترى أن المصالح الاقتصادية جوهر الآلية التي تصنع تلك الطبقة بشكل تقليدي، وأن المالكين هُم أكثر المُمانعين لتبلور تلك الطبقات وانتظامها الذاتي وسعيها للفاعلية والتغيير؛ فإن الطبقتين الأكثر وضوحاً وتبايناً هُما «الأغنياء/الفُقراء»، لأن المُلكية هي جوهر الفرز وصناعة الطبقة، حسب الوعي اليساري التقليدي.
تم استيراد ذلك المفهوم تقليدياً بشكل ميكانيكي إلى منطقتنا من قِبل التيارات اليسارية، دون الأخذ في الاعتبار جُملة الآلية التقليدية المُحافظة لصِناعة «الطبقات» في منطقتنا، كالعائلة والعشيرة والسُلطة الدينية والمؤسسات الدينية… إلخ، وبغض النظر عن أن قُرابة نصف الإنتاج العالمي راهناً بات إنتاجاً غير مادي، إلكترونيات، ثقافة، فنون، خدمات… إلخ، وليس لسُكان منطقتنا مُساهمةٌ فعليةٌ في ذلك الإنتاج غير المادي، وهو مما يُفسد الوعي اليساري التقليدي بفكرة وآلية تشكل «الطبقة». فوق ذلك، إن القيمة العُليا المُنتجة راهناً في منطقتنا هي «الأمن»، وآلية توفير تلك «السلعة» تبدو الأكثر حيويةً وقُدرةً على خلق الطبقات المُفترضة.
الجماعات الأهلية والعُصب العسكرية الأكثر استنفاراً وعصبية وقُدرة على توفير الأمان «البيولوجي» لأفراد الجماعات الأهلية، هي الأكثر حيوية في خلق طبقاتها الخاصة، والتي تتمركز عادة على شكل جماعات، وأشكال شبه مُجردة من الأهلانيات.
سوريا الراهنة مثالٌ حاضرٌ لهذه النمذجة، فالثورة السياسية الاجتماعية التي انطلقت فيها، وكانت مُحملةً في بداياتها بوعيٍ عامٍ بالغُبن الذي يمارسه الأقوياء والمالكون تجاه الضُعفاء والمُهمشين، ما لبثت أن تحولت إلى أشكالٍ مُختلفةٍ من صِراعات الجماعات الأهلية، وبذا تحوَّلَ وعي وآلية انتماء الأفراد ليغدو أكثر بساطة للتوافق مع العُصب العسكرية، التي توفر الأمان والحماية لأبناء هذه الجماعة أو تلك.
رُبما يكون درب اليسار أكثر يُسراً في الجُغرافيات والكيانات الأقل تركيباً، وفي المُجتمعات الأقل تلوناً، لأن النُخب السياسية وقتها ستكون أقلَّ قُدرةً على تطييف أشكال الصراع وتشويه وعي وهوية الطبقات. لكن اليسار في منطقتنا يبدو في حالة حرجة في هذا المقام، حيثُ مُستوى التركيب الكياني والتلون الاجتماعي وصراعات الذواكر حيويٌ جداً، وهذا القدر من التداخل يسمح للنُخب المُهيمنة بإعادة تدوير وتشكيل وتشويه وعي المُنخرطين بهوية وجوهر صِراعهم.
ليس أقل من ذلك، ستجدُ هذه النزعة اليسارية في مواجهة التشكل «الأهلاني» للطبقة نفسها مخلخلةً، لأنها تحيا في مُجتمعات تفتقد للصناعة أو الزراعة المُنظمة بحدها الأدنى، حيث تعمل هذه الأخيرة كمُضاد نوعي لقُدرة الطبقات المُهيمنة على تشويه الوعي الطبقي، كما جرى في جنوب إيطاليا الزراعي وشمالها الصناعي. من جهةٍ أخرى، ستجد نفسها في كيانات غير تاريخية، متداخلة مع قضايا ونزاعات مُتجاوزة لحدودها الكيانية، فـ«النضال» اليساري في كيانٍ تاريخي كالدولة المصرية أو المغربية، يبدو أكثر تماسكاً وأقل حظاً للتشوه من نظيره الذي سيعمل في كيانٍ كسوريا أو لبنان أو العراق. لأن هذه البُلدان الأخيرة أقل تاريخية وأكثر تداخلاً مع جوارها، وتتحول الصراعات فيها إلى أشكال أهلية أكثر حيوية، فإن تشكل الطبقة بالمعنى اليساري التقليدي يبدو أكثر صعوبة.
*****
آخر الأسئلة الكُبرى التي يجب على التيارات اليسارية أن تجيب عليها في ظل هذا الفضاء «الأهلاني» الذي تعيشه مُجتمعات منطقتنا، يتعلق بموقفها ورؤيتها لـ«شكل العالم»، والذي يرتبط بطريقة أو بأخرى بشكل «الذات الكُليّة» و«هوية الكيان». وإذا كان سؤال «العدالة» هو سؤال صورة الشخص عن ذاته، وسؤال الطبقة يتعلق بصورة الآخر/الشريك، فإن سؤال «شكل العالم» يتضمن الرؤية للآخر بمعناه الجمعي والكُلي.
كانت المُعادلة اليسارية التقليدية تُقسم العالم إلى عالم «المُكافحين» من العُمال والفلاحين والثوريين والاشتراكيين، يُقابله عالم الأقوياء المالكين الرأسماليين، وكانت الإيديولوجيا اليسارية تستطيع أن ترسم خطاً «واضحاً» بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب، بين آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية، وبين أميركا وأوروبا الغربية… إلخ. لكن جميع هذه العوالم قد تغيرت، وتغيرت تماماً في منطقتنا. فأي دولة وكيان هو المُهيمن/الغالب بالنسبة للشعب السوري راهناً! أليست إيران التي يُمكن أن يُطابق «شعبها» بحاله وظرفه التاريخي «الشعب» السوري نفسه. الأمر نفسه يتعلق بملايين الأكراد وعلاقتهم مع الكيان والنُخبة القومية التُركية الحاكمة، وكذلك بالنسبة للسُنة العراقيين وأبناء بلدهم من الشيعة العراقيين، وكذلك السُنة اللبنانيين. فالامبريالية والامبرياليون بالمعنى المُكثف الذي كان في الرؤية اليسارية التقليدية، يتمثلون راهناً في كُتلةٍ من القوى الإقليمية والتيارات السياسية الداخلية، المُختلفة بهويتها الأهلية.
ضمن هذا السياق، رُبما يرى أي تيارٍ سياسي يساري نفسه محرجاً في إعادة صياغة موقفه وعلاقته مع القوى والثقافة والخيارات السياسية الكُلية العالمية، أذا ما رغب أن يكون في صف «المُستضعفين» من «شعوب» المنطقة. بهذا المعنى مثلاً يُسترجع السؤال السابق بطريقة أكثر شفافية ومُباشرة: هل فرنسا بمواقفها وخياراتها وإيديولوجيتها الداعمة للربيع العربي بحده الأدنى كما في الحالة السورية، هل هي الإمبريالية والآخر والمُهيمن! بينما إيران هي القوة المُدافعة عن المُستضعفين والمغبونين!!
وليس بأقل من ذلك، على أي تيارٍ سياسي أن يعيد صياغة موقفه من المسألة الكُردية والفلسطينية والإسرائيلية والسُنية والشيعية والمارونية، وألا يثق بنفسه ويعتبر نفسه طُهرانياً وجذرياً في موقفه من جميع قضايا المنطقة بعباراتٍ مُختصرةٍ وكُليةٍ وفوقية، لم تعد تنفع لفهم العالم ومعادلته وتأثيراته على المنطقة، وتركيبها السياسي والهوياتي بالغ التعقيد.
لن يحدث أي شيء من ذلك، ما لم تعترف هذه التيارات اليسارية أن منطقتنا في ذاتها إنما هي «عالمٌ» بنفسه، مُركبٌ ومُعقد، وفيها ما هو مُستضعفٌ وما هو غالب، ما هو امبرياليٌ وقهري، وما هو ثائرٌ وأكثر عدالة. وبهذا المعنى فإن مُشكلة المنطقة ليست مع خارجها بكُل بساطة، إنما مع نفسها أولاً.