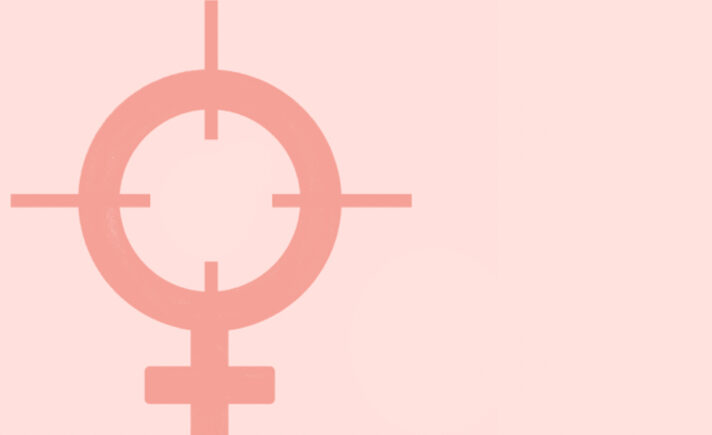لماذا «شهادات نساء»؟ أثارت تسمية الملف تساؤلاتٍ عن خلفيتها لدى عدد من الناشطات النسويات المتابعات للملف، ممن سنحت لي الفرصة بالتحدث إليهن. فالحديث عن تجارب النساء في الحرب وأثرها عليهن دون الرجال، قد يلعب دوراً في تكريس دور المرأة كضحية، وهذا يبعدنا عن كيفية مقاربة «النسوية» لأدوار المرأة، ناهيك عن أن الشهادات ستقتصر ضمن هذا الإطار على من يمتلك ملكة الكتابة، وهي بالتالي لن تتطرق إلى جميع تجارب النساء.
نظَرَت أخرياتٌ إلى التسمية من زاويةٍ نقيضة تماماً، معتبراتٍ أنه بتلسيط الضوء على تجارب النساء لأنهن نساء، يمكن الإشارة إلى التحديات التي يمكن أن تواجهها المرأة فقط لأنها امرأة، فهل يمكن للمرأة التنقل في المناطق التي تخضع لسيطرة المتطرفين بالمقدار نفسه من الحرية المتاحة للرجل؟ وهل يمكن لها ممارسة نشاطها دون المرور بعقبات تواجهها فقط لأنها امرأة ؟ فضلاً عن الحاجة لوجود هذا النوع من السرديات في الأوقات الطبيعية، فكيف إن كان ذلك في ظروفٍ استثنائية تمر بها البلاد.
لا شك أنه قد تمت الإضاءة على بعضٍ من هذه الجوانب في بعض المقالات، وذهب بعضها إلى أبعد من ذلك، من خلال التطرق إلى بعض التغيرات في الأدوار الجندرية التي بدأنا نشهدها بأشكال مختلفة منذ مشاركة المرأة في الحراك الشعبي بعد ثورة آذار، والتي ربما تبدو أكثر وضوحاً في تجارب اللجوء. فمن خلال بعض القصص الشخصية لنساء يعشن في أورفا، تمت الإضاءة على بعض التغييرات في هذه الأدوار، كما في المسؤوليات الجديدة التي بدأت تتحملها النساء، بِدءاً من المساهمة في إعالة الأسرة والدخل الاقتصادي في المنزل، وانتهاءً بالبحث عن فرص التعليم التي تبدو صعبة المنال. وعلى الرغم من أن الحديث عن صعوبات العمل والتعليم التي تواجهها الفتيات، يشبه الحديث عن معاناة جميع اللاجئين ذكوراً وإناثاً، إلا أن هناك حاجةً إلى التحليل والتعمق في هذا التغيير الطارئ، وتحول النساء إلى معيلات أساسيات لأسرهن، وما له من أثر على التغير الديناميكي في مستوى الأسرة انطلاقاً إلى أدوارٍ أكبر. هذا الدور يمكن للجمهورية أن تكون منبراً له، فقد خسرت كثيرٌ من النساء معيلهن من الرجال في الحرب، سواءَ بالذهاب إلى جبهات القتال، أو الاعتقال والاستشهاد، أو بالذهاب في طريق البحر إلى أوروبا أملاً في أن تلحق به عائلته بعد الحصول على أوراق اللجوء.
هذا الواقع من التشتت وظروف الحرب القاسية، وضعَ النساء أمام خيارات قد تبدو للكثيرين سلبيةً، ولكنها قد تحمل في واقع الأمر طابعاً ايجابياً، فخروج النساء إلى العمل وانتقالهن من ربات منازل مُعالات، إلى المصدر الوحيد لدخل العائلة، سيكون له أثرٌ كبيرٌ في تغيير الديناميات على مستوى الأسرة، وربما يقود إلى أبعد من ذلك بتغيير موازين القوى، وإن كنا نتحدث عن المستوى الاقتصادي منها، والذي يمكن أن يقود في كثيرٍ من الحالات ومع استدامته، إلى تغيير في موازين القوى على المستوى الاجتماعي والثقافي وصولاً إلى السياسي، وربما يساهم في وجود النساء في حقول لم تكن لهن يوماً.
تناولَ الملف قضية المعتقلات من خلال مادتين تم نشرهما، كلاهما توصيفٌ لتجربةٍ شخصية في المعتقل، إحداهما بطابع ذاتي توصيفي لما مرت به الكاتبة نفسها، والمادة الأخرى توصيفية لما رأته الكاتبة الأخرى. وبينما تم تناول تجربة الاعتقال من زاويتين مختلفتين، فإن التساؤل هنا حول القيمة المضافة التي تقدمها مناقشة قضايا المعتقلات دون المعتقلين، أليس الإعتقال عابراً للجنس؟ هل يمكن أن يساهم توصيف تجارب الإعتقال للنساء دون الرجال في تعزيز الصورة النمطية للنساء على أنهن الضحايا في النزاعات، أم أن إعلاء الصوت والحديث عن هذه التجارب وكتابتها سيساهم في التعامل معها في المستقبل. بالتأكيد لا يمكن الإجابة على هذا التساؤل بنعم أو لا، فهذا النقاش ليس وليد النزاع السوري، وإنما هو جدلي ويُعاد تكراره اليوم في الحالة السورية بعد أن سبقته تجارب بلدان كثيرة في المنطقة كالعراق، وبلدان أخرى خارج المنطقة كالبوسنة وجنوب إفريقيا، إذ تميزت تجارب بلدانٍ سابقة بمشاركات أكبر للنساء في جلسات الاستماع العلنية التي أدلت فيها النساء بشهادتهن حول ما تعرضن له من تعذيب واعتداء وغيره، بينما قلّت نسبة مشاركة الرجال مقارنةً بالنساء.
تعود صورة النساء بطريقة مختلفة في المادة التي تناولت يوميات النساء السوريات في الثورة، فقد طغت صورة المناضلة على صورة الضحية في هذه المقتطفات التي تروي شهادت نساء عايشن الثورة وكن فاعلات فيها، قُلنَ قصص مشاركتهن وفاعليتهن وكيف تعاملن مع التحديات الاجتماعية في ظل حراكهن السياسي الثوري. يضافُ إلى ذلك مساهمة هذا النوع من الكتابة في كتابة تاريخ مرحلة زمنية معينة لا يغيب الحديث فيها عن التحديات التي واجهتها ناشطة ثورية احترفت التصوير مع بداية الثورة، لتشارك في نقل حقيقة ما يحدث في منطقتها، وبالتأكيد التجربة نفسها مختلفة بين امرأة ورجل، فلا يخفى على أحد أن الخطر كبير على الاثنين، فخطر الاعتقال على سبيل المثال يواجهه النوعان، بينما الضغط الاجتماعي لممارسة عمل بهذه الخطورة في أغلب الحالات ستواجهه المرأة دون الرجل. من الضرورة بمكانٍ سماع صوت النساء وتصويرهن للأحداث في تفاصيل حياتهن اليومية، فلن يتمكن الكاتب من معالجة التحديات القائمة على النوع الإجتماعي، ولا يمكن التعامل مع القيود التي تُفرض على المرأة في الماضي والحاضر والمستقبل، بمعزلٍ عن الحديث عنها على جميع المنابر المتاحة، إذ إن خلق مساحة لهذه السرديات سيتيح المجال أما فهمٍ أعمقَ للعوائق الاجتماعية التي تراكمت عبر التاريخ، لتُشكَّل الواقع الذي وصلت إليه النساء اليوم.
ربما غابت المقاربة العميقة للنسوية في ملف «شهادات نساء»، على الرغم من أن افتتاحية الملف أشارت إلى أن أحد أهدافها هو فتح النقاش حول النسوية، إذ غابت المواد التحليلة عن النوع الإجتماعي والتنظير حول النسوية، وفهم طابع الحركة النسوية السورية والمتغيرات التي طرأت عليها قبل ثورة آذار وبعدها.
على الرغم من تنوع المواد في الملف، إلا أنها بقيت في الطابع العام تروي قصص وتجارب شخصية، وهذا لا يعني أن هذا النوع من الكتابة ليس على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية كما ذكرتُ سابقاً، ولكن الجمهورية كما يراها جميع من تحدثت إليهن، وكثيرٌ من القراء والنشطاء، هي «منبرٌ نوعيٌ نَهَجَ نهجاً مختلفاً عن كثيرٍ من وسائل الإعلام التي ظهرت بعد الثورة، وتعتمدُ في قوامها على التحليل العميق وتقديم المواد النوعية»، وفي هذا الملف تحديداً غاب الطابع التحليلي الذي يشكّل هوية الجمهورية.
عند الحديث عن النسوية والتنظير لها، لا بد من التطرق لأجيال النسوية، فسوريا تشهد اليوم ولادة نسويةٍ جديدة، تنظر إلى الحركة النسوية التي ظهرت في سوريا في السبيعينات والثمانينات واستمرت إلى الآن بعينٍ نقدية. تفضل النسوية الجديدة الابتعاد عن الإيديولوجيات وكسر الاحتكار من قبل أيٍ كان، وتنظرُ إلى أن النضال النسوي لا يعني بالضرورة تقليد الحركات النسوية السابقة، إنما يكمن في التحرر والمساواة، في ابتكار أدوات جديدة يمكن لها أن تتغير حسبَ الظروف والثقافة والبيئة الإجتماعية، وتعتمد في تفكيرها على التغيير الاجتماعي أكثر منه القانوني والدستوري، كما ركز الجيل السابق من الحركة النسوية في سوريا. وبالطبع لا يعني هذا أن الجيل السابق من النسوية السورية بعيد عن رؤى النسوية الجديدة، إلا أن تركيز نضالهن أخذ شكلاً يعتمد على التغيير في القوانين والدستور، أكثر من التركيز على التغيير الاجتماعي. وبالمقابل وضمن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، يبدو غايةً في الأهمية الاستفادة من تجارب الجيل السابق من النسويات في إطار تغيير القوانين ووضع الدستور، وربما يكون هذا من أهم ما يجب التحرك باتجاهه في المرحلة القادمة التي ستُعَادُ فيها صياغة القوانين ودستور البلاد. لقد بقيت النقاط الخلافية بين الجيلين في إطارها الشفهي، ولم تتحول إلى نتاجٍ مكتوب تراكمي، وهذا ما يجعل منبراً كالجمهورية بهويتها التحليلية، منبراً مهماً لطرح هذه النقاط الخلافية بين الجيلين، لإثارة النقاش حولها وخلق أرشيف مكتوب تراكمي يمكن أن يؤسس لفهمٍ أفضل لكل مهتم ومهتمة بهذا الشأن.
ستبقى الكتابة في قضايا النساء قاصرةً إن ارتبط التنظير النسوي والحديث عن شهادات النساء وقصصهن بالكاتبات من النساء، فنحن بأمسِّ الحاجة اليوم إلى كسر الصورة النمطية التقليدية التي تقوم على أن ينظِّرَ للنسوية ناشطاتٌ نسوياتٌ فقط، وماذا عن الناشطين النسويين؟ إن أكثر ما تحتاج إليه قضايا النساء اليوم هو ظهور ناشطين نسويين لمناصرة قضايا المساواة والحقوق، يساهمون في التغيير ضمن مجتمعاتهم، إذ لا يمكن لأي حركة نسوية تحقيق التغيير المنشود، سواء كانَ اجتماعياً أم اقتصادياً أم سياسياً أم قانونياً، إن غاب المناصرون من الرجال عن هذه المطالب.
لقد كان التنوع بين الكتاب والكاتبات في مقالات هذا الملف من نقاط القوة بالتأكيد، وهنا قالت إحدى الناشطات النسويات «لقد كسرت الجمهورية الصورة المعتادة في وسائل الإعلام عند تناول قضايا النساء في أمرين: الأول تنوع جنس من كتبوا، فلم يكونوا جميعهم من النساء، والأمر الآخر أننا اعتدنا رؤية هذه الملفات في مواقع متخصصة بقضايا النساء، وليس في مواقع كالجمهورية».
إن للإعلام بوسائله المتنوعة دوراً أساسياً في دعم المرأة في المعارك التي تخوضها على المستويات المختلفة، وبالمقابل يمكن له أن يلعب دوراً سلبياً في تعزيز صورة الضحية إن غاب الحديث عن فاعليتها، وتركّزَ على توصيف أثر الحرب عليها. ويمكن وصفُ الدور الحالي للإعلام في هذا المجال بأنه دون المستوى المطلوب، فما زالت قضايا النساء غير مطروقةٍ بالشكل اللازم، وربما تعدّ عند كثيرين في آخر سلم الأولويات، فما تمر به البلد من ظروف قاسية هو أولى بالحديث عنه.
يغيبُ عن ملف الجمهورية كما عن كثيرٍ من المنابر الحديثُ عن الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة على صعيد ما يسمى المسار الأول، أي وجودها في مواقع صنع القرار في أي محادثات أو عمليات سلام يمكن أن تحدث، وإذ تعدُّ هذه القضية من أهم القضايا الحالية بالنسبة للناشطات النسويات، ترتفع اليوم كثيرٌ من الأصوات المطالبة بالكوتا بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، وتعتبر أن مشاركة النساء في العملية سيضمن إشراكهن في بناء الدولة في مرحلة ما بعد الحرب، كما وأن غياب المرأة عن هذه المساحات في اتخاذ القرار، وعن أخذ دورها القيادي على جميع الأصعدةـ يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى إقصاءٍ لها، بالرغم من مشاركتها الفاعلة في الثورة، وهو ما سيعيد تكرار تجارب بلدانٍ سابقة شاركت فيها النساء بالثورة، وحُيدنَ في مكانٍ لاحق. وطبعاً لم يغب عن وسائل الإعلام التطرق للمشاركة السياسية على هذا المستوى، وإنما على مستوياتٍ أخرى، كالدور القيادي على مستوى القرية أو البلدة، والتواجد ضمن المجالس المحلية على سبيل المثال لا الحصر، وما هي العوائقُ التي تحول دون وصول المرأة إلى هذه المواقع.
لعبت النساءُ دوراً أساسياً في الحراك الشعبي منذ اللحظات الأولى، وحصل هذا الدور على بعض التغطية الإعلامية، ولكن يغيب الدور الذي تلعبه النساء السوريات اليوم في مواجهة التطرف والمتطرفين، ومعالجة المشاكل التي تواجههن في ظل تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة الأخرى، وربما تعود بعضٌ من أسباب ذلك إلى غياب المصادر التي يمكن أن تُشَارَكَ من خلالها هذه القصص على الإعلام نتيجةً للخطورة القصوى، ولكن لا بد من إيجاد استراتيجيات ووسائل تمكّن من رواية قصص بطولاتهن.
لا يغيب عنا أيضاً أن المرأة تقوم بدور ليس فقط في مواجهة التطرف في ظروف غاية في الخطورة، وإنما في مواجهة ظواهر بدأت بالانتشار، كظاهرةِ تجنيد الأطفال وانتشار الأسلحة وارتفاع نسبة الجريمة، ولا بد للإعلام أن يلعب دوراً في هذا الإطار، فالتغطية الإعلامية لهذه القضايا مع مراعاة سلامة الشاهدات، سيسمحُ بخلق فهم مختلف لهذه الأدوار. ومن زاوية أخرى نعيش اليوم في حالة غائمة من السواد مع ازدياد العنف وغياب أفق الحل السياسي، ويمكن لهذه الإضاءات المساهمةُ في الحفاظ على بعض الأمل بأن دعاة التغيير ما زالوا هنا على الرغم من كل المآسي، وما زالت النساء السوريات قادرات على التغيير والحفاظ على المبادئ الأساسية التي انطلقت من أجلها الثورة.