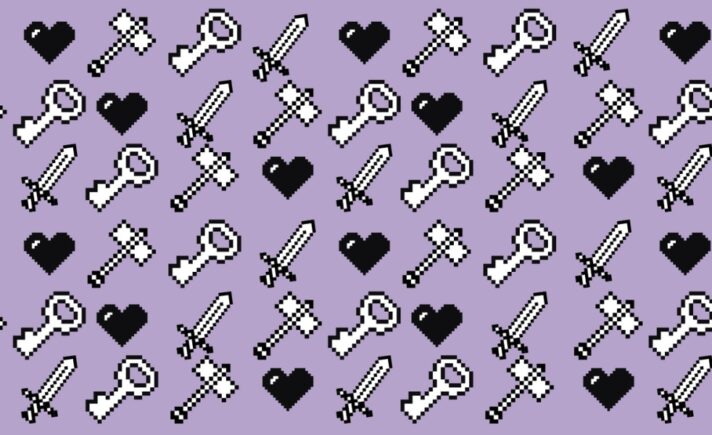عامان وأنا أنام مكبل اليدين والقدمين، يحرسني أحدهم خلف الأبواب، يتلصص النظر بين حينٍ وآخر من ثقبٍ لا يتجاوز قطره بؤبؤَ العين.
أترقبُ ليلَ الثلاثاء المقدس في حلقة التحقيق الأسبوعية، وأياً كانت طريقةُ التحقيق أو أثرُ النتائج على مصيري فإنها لا تهمّني، ما يهمّني بعد تبلدٍ في العقل والجسد، هو الإحساس بكوني بشراً، حيواناً، أو جنّاً، بأيّ شيء يجبرني على مراجعة التفكير بمسألة وجودي على هذه الأرض. كانَ شعورٌ بالراحة الداخلية ينتابني حين أسمع أسئلة المحقق تنهال عليّ، والألمُ الناتج عن جلداتٍ على ظهري تُحركُ الدم في عروقي، يخدرني لاحقاً، ويأخذني إلى نومٍ عميق لطالما حُرِمت منه.
رحلةٌ إلى المجهول
فوهة المسدس الحلزونية، وصديقي حسان الذي كان ينتظر محبوبته في زاوية الحي، آخر مشهدٍ التقطته عيني قبل استسلامي دون مقاومة لأربعة مقنّعين مسلحين. في رحلةٍ للغياب طالت شهراً وضِعتُ بينهم ورأسي بين قدمي، في معاملةٍ فائقة الاحترام. رغم ظلام الليل والعصبة التي لفت عيني، ووسط هذا الخوف والارتباك، إلا أنني أعرف أين ذهبنا في المحطة الأولى والثانية والثالثة حيث المستقر. وكلّ أغنيةٍ ثوريةٍ من تلكَ التي تتغنى بلواء أحفاد الرسول، وحكاياتهم بين بعضهم البعض عن الفدية والرؤوس التي قُطِعت سابقاً، وعن مطاردات «التنظيم» لهم، وعن أنهم مجموعةٌ مستقلة تعمل من أجل المال حيناً، وأنهم خلايا «الأحفاد» حيناً آخر. كلّها محاولاتٌ تكللت بالنجاح في عقولهم على بلاط أميرهم «أبو لقمان»، وباءَت بالفشل عندي وعنده، هو ذكيٌ بقدر ما كانت حاشيته غبية. وأنا أيضاً لا أنسى شوارع مدينتي، أو مقار «دولتهم»، ولست بمستوى غبائهم الذي وصل إلى درجةِ أنهم حدّثوني عن قصصهم حين يطاردهم تنظيم الدولة وسط إطلاقٍ نارٍ متبادل، في وقتٍ كنت أجلس على قبضة اتصال، وأسمع صوتها المنخفض حين يتحدث أحدهم مع الآخر.
ليالي الظلام
لليوم السابع على التوالي، رُبِطت قدماي بأربعة سلاسل حديدية بطول ٣٠ سم مثبتة على الحائط، وأربعةِ أقفالٍ حديدية، ويداي بكلبشات، وثلاث بطانيات، ومصحف، وصندوق لانتخابات مجلس المحافظة مليءٍ بالماء، إضافةً إلى علبةٍ فارغة للتبول فيها.
ممنوعٌ علي كل شيء، وجبة طعامٍ يومية فقط، كانت غالباً علبة حمص ورغيف خبز وبعض التمر. يُسمحُ لي بالذهاب إلى الحمام مرةً واحدة يومياً، وحتى اليوم لا أدري ما الغاية من وجود مصحفٍ ولا أستطيع فتحه، وماءٍ للوضوء وأنا لا استطيع الوقوف، كانت الصلاة دون وضوءٍ وأنا مستلقٍ على جنبي ولا أعرف اتجاه القبلة، هذا عندما حاولت إقناع أحد المنتسبين حديثاً للتنظيم بأنني مسلم وأعرف الصلاة، وسطَ دهشته بأن هناك من يحفظ آياتٍ من القرآن ويعرف الصلاة في سجونهم، وكان دوماً يبرر ذلك بأنني كاذبٌ لأن «الدولة» لا تظلم أحداً، وأن من أفتى باعتقالي يُؤجَرُ مرتين، الأولى عن اجتهاده، والثانية إن أصابَ في فتواه.
المنفردة
دخلتُ كالأعمى، يقبض على يساري «أبو حمزة» السجّان، ارتطمَ وجهي بأحدهم (عرفته لاحقاً). أجلسني وبدأ بعملية ربط الجنازير والكلبشات، ثم قال: «افتح عينيك بعد خروجي».
كانت غرفةً بطول ثمانية أمتار وعرض أربعة، يتوسطها لوحة تحكمٍ الكترونية لمضخة نفط بئر «العكيرشي»، وممرٌ بمسافة متر يحيطها، وأنا مثبتٌ على أحد كابلات التوتر العالي. انتابني شعورٌ بالفرح قليلاً، مكانٌ جديد ومعالم جديدة غير الجدران الأربعة، إضافةً إلى شبّاك في أعلى الغرفة أرى منه نور الشمس، بعد حرمان لسبعة أيام في غرفة بأربعة جدران فقط، ولا شيءَ آخر.
يوميات
أجلسُ أكثر من عشرين ساعةً أراقبُ ما حولي، لا أتكلم، لا أتحرك، لا أفعل شيئاً، ليس هناك شيءٌ أكثر من أن أحاول تحريك فكيّ بين الحين والآخر، أو أسمعَ أزيز الهدوء، أو عويلَ ومناجاة المعتقلين في حلقات التعذيب التي تأتي أصواتها من بعيد. لم أعد أشعر بشيء إطلاقاً، أنتظر اللاشيء. أتقلب يميناً ويساراً بحركة محدودة لا تشمل القدمين في عدة محاولاتٍ بائسةٍ للنوم في ساعات الفجر المتأخرة، لا أكادُ أغفو قليلاً حتى استيقظَ على دغدغة فأرٍ دَخَلَ تحت ثيابي وتجوَّلَ في صدري، ليخرجَ بسرعةٍ من عنقي مروراً على وجهي، كنت أرتعش قرفاً في بداية الأمر، ثم أصبح الأمر مسلياً عندي، حتى أنني كنتُ أحياناً أنتظر قدومه!!
شركاءُ الموت
في زاوية الغرفة سطلٌ أبيض مليء بالبول غامقِ اللون يعود للسجين السابق الذي ارتطم وجهي بوجهه، كان يدعى «عقيل»، وهو ممرضٌ من عناصر تنظيم الدولة اتُهم بالعمالة لصالح تركيا، ولم يسعف عنصراً من التنظيم إلى تركيا إلا وتوفي العنصر. اتُهم بقتلهم عمداً وبيع أعضائهم حسب روايات عناصرهم، كان مريضَ كِلى أو ما شابه، ما يجعله يتبول كثيراً ببولٍ غامق ورائحةٍ كريهة جداً.
في ليلةٍ ظلماء كانت الأخيرة لي وله، تم وضعه بيني وبين شخصٍ عراقي لا أعرف اسمه في سيارة جيب. كان يرتجف بشكلٍ مخيف، لم أكن أعرف مصيره حينها، لكنه كان يعرف أن ساعاتٍ قليلة تفصله عن موته المنتظر، وهذا ما حصلَ فعلاً صبيحة إطلاق سراحي، حيث أُعدِمَ في ساحة المحافظة، بطلقةٍ بالرأس.
العراقي أُطلقَ سراحه معي، كان رجلاً خمسينياً من تنظيم دولة العراق في بغداد، هربَ من هناك بعد أن كُشِف أمره ليلتحق بالتنظيم في سوريا، وكان مصيره الاعتقال لـخمسةٍ وأربعين يوماً بعد دخوله تل أبيض بساعات، وكان بحوزته ثلاثون ألف يورو كدعمٍ من مجموعة عراقيين للتنظيم في سوريا. اتُهِم بانتحال شخصية عنصرٍ في التنظيم، لكن بعد أن تبين لأبي لقمان أن الرجل كان صادقاً، وأنه فعلاً من تنظيم دولة العراق، تم رفضه في سوريا بحجة أن التنظيم لا يحتاج رجالاً هنا، وطُرِدَ إلى تركيا واستولى أبو لقمان على أمواله.

عبد الله العسّاف «أبو عبد الرحمن»، رجلٌ خمسيني، كان محققاً في الهيئة الشرعية بالرقة، وأحد دعاة المدينة. اعتُقل على يد المخابرات الجوية والعسكرية في دمشق عدة مرات بتهمة «السلفية»، خطفه التنظيم من على دراجته النارية أمام مقر الهيئة الشرعية في الملعب البلدي وسط المدينة ثاني أيام عيد الأضحى، دون توجيه أي تهمةٍ له.
دخل إلى الغرفة المجاورة، وهي لوحة تحكمٍ أخرى مفصولة عن غرفتي بواسطة باب خشبي مدعم بقضبان حديدية، لكنها لم تمنع التواصل بيننا في الأيام السبعة الأخيرة لي هناك. كان هادئاً قليلَ الكلام، يقضي معظم وقته في قراءة القرآن والصلاة، والصيام يومين في الأسبوع، كان يأتي من التحقيق، لا يتحدث بأي حرف. في اليوم الثاني يخبرني بأن صِبيةً من التنظيم أهانوه بعد «إفحامهم» بالأحاديث والآيات، أوصاني قبل خروجي بيوم: «إذا جى يوم وطلعت يا حازم، وصّل لأهلي سلامي، ولأبو شيماء (أحد شرعيي التنظيم) عن مكان اعتقالي، عسى أن ينظر الله بوجهي ويفرّج عني»، وإلى يومنا هذا لم يفرّج الله عنه.
التحقيق
كان التحقيق يدور في كل شيء حول القضية الأساسية، لكن المحقق لا يتطرق إلى ما يريد، يتركُ السجين يسترسل في كلامه، حتى يصطاده بكلمةٍ عاثرة لا يعرفها المحقق، ليبحث عن تُهَمٍ جديدة ومعلوماتٍ يجهلها عن السجين، أو عن فريسةٍ أخرى.
كنتُ حذراً جداً، أنتظرُ اللكمةَ على وجهي قبل الإجابة على شيء. عَجِزَ أبو لقمان وحاشيته عن اصطيادِ شيءٍ مني، حتى من حسابي الفيس بوك والسكايب، بعد تأميني للحسابات في وقتٍ سابق، حيث أنها تُغلَق لمجرد تغيير الموقع، ولا يمكن استردادها إلا من الموقع المحدد الذي هو منزلي.
حاولَ الالتفافَ عليَّ وانهال بالأسئلة عن مكان إقامة خالد الحاج صالح، وعن أسباب اتهامِ خالد للتنظيم بخطف شقيقه الأصغر فراس، وعن ممولي حملة «علمنا»، وكنتُ أجيبُ ببلاهةٍ أنني لا أعرف عن من يتحدث، ولا أعرف هؤلاء الأشخاص إطلاقاً. حتى جاءَ يومٌ رأيتُ فيه بعضاً من عناصر التنظيم المنتسبين حديثاً يتوددون إليّ ويحدثونني بلطف، ويقولون إنهم على اطلاعٍ بملفي، وإن التنظيم لا يظلم أحداً، وإنهم مارسوا ضغوطاً على «أبو لقمان» لإخلاء سبيلي بعد عدم إثبات أيّ تهمةٍ عليّ، ولا حتى زلة لسان.
حريةٌ مشروطة
استيقظتُ في الثانية بعد منتصف الليل على أصوات أقفال الأبواب التي فُتِحَت، أبو حمزة السجّان: «أمشي على التحقيق»!
دخلت بهدوء، أجلسوني، وبدأ أبو لقمان قائلاً: «راح نطالعك، بعد ما توقع على هالورقة»، وأمر بإزالة العصبة عن عيني، وبدأتُ اقرأ:
لا أتفوه بحرفٍ واحد عن مكان اعتقالي، ولا عن الجهة التي اعتقلتني.
لا أتصل بذوي أيٍّ من المعتقلين، (قاصدين فيها أبو عبد الرحمن).
لا أستقبلُ في منزلي أيّ أحد، وتحديداً «بني علمان وصبية الجولاني».
وأيّ إخلالٍ بأحد هذه الشروط، سيُباحُ دمي.
لم أشعر بالبرد حينها، لكن «عقيل» جعلني أرتجف مثله بشعورٍ لا إرادي، حتى دخلت بنا السيارة إلى مبنى المحافظة الخلفي، وقادني أحد العناصر إلى البوابة ودفعني قائلاً: «على أهلك ولا تدير وجهك». وقفتُ للحظة، وتابعتُ المسير وأنا أفكُّ عصبتي عن رأسي، أضواءُ المدينة الصفراء وساحةُ المحافظة، شوارعُ خاليةٌ من كل شيء. تابعتُ مسيري إلى بائع التبغ عند «دوّار الساعة» وطلبت منه علبة «وينستون». شهيقٌ من السيجارة التي أحب بعد انقطاعٍ لشهر كانَ يلزمه فنجان قهوةٍ محلَّى تحت عريشة العنب في منزلنا، لكن جلوسي على الرصيف قرب حاوية قمامة أبعدَ رائحةَ القهوة عني، وأبعدَ منزلي سفر مئة عام. لم تعد قدماي قادرتان على حملي تلك المسافة حتى أدركني صاحب التبغ وعرض المساعدة، لأعودَ بعدها إلى صحوتي وأتابع مسيري، وأقيسَ بعد النظر في الطرقات والسماء، بعد أن كان مدى نظري يقتصرُ على مسافة مترين أو أقل.
لم أكن أعلم ما حل بمدينتي وأهلها خلال رحلة الغياب هذه، لكن الرصاصات التي اخترقت جمجمة صديقي «مهند حبايبنا» كانت أول حديث دار بيني وبين أخي الأصغر أحمد حين سألته عن أخينا أيهم. ردّ قائلاً أن أيهم قد خرج الى تركيا، هو وكل اصدقائه، بعد مقتل مهند في قرية الفخيخة غربي الرقة برصاصتين بالرأس. مرّ خبر مقتل مهند مرور الكرام دون أي أثر علي، وكأنه خرج مع أخي وأصحابه إلى تركيا، غائبً هو كغيره من الغائبين بين مهجّر وصامد. لم يكن مقتل مهند آخر حديث، حيث تابع أخي في اليوم التالي قائلاً ان اشتباكات متقطعة اندلعت بين «الدولة» وكتائب الجيش الحر في ريفي ادلب وحلب، مضيفاً أن معارك مشابهة دارت في بلدة تل السمن شمال الرقة بين داعش ولواء «الجهاد في سبيل الله» التابع للجيش الحر انتهت بسقوط عشرات القتلى والجرحى، وانسحاب الأخير الى بلدة صرين في أقصى الشمال الغربي للجزيرة السورية. بهذه الاحاديث يبدأ يومي، وينتهي ليلي بحديثٍ عن مفاوضات بين أهلي وعناصر الدولة على فدية قدرها مئتي الف ليرة سورية قبل قطع عنقي، وكنت دوماً أتساءل ببلاهة إن كانوا قد خطفوا كلباً حتى أكون رخيصاً إلى هذا الحد!! المبلغ كله لايساوي ألف دولار، فيجيب أخي على سخافتي: «يا أخي المفاوضات كانت عبارة عن استفزاز لأعصابنا. كانوا يفاوضون دقيقة، ثم يغيبون اسبوع، وهكذا..».
بعد خروجي بيومين تحدثتُ للجميع عن الجهة التي اعتقلتني وعن مكان الاعتقال، وأرسلتُ سلاماً لعائلة أبي عبد الرحمن لكنني لم أصل إلى أبي شيماء، واستقبلتُ في منزلي كل بني علمان، وذهبتُ بقدمي إلى صبية الجولاني في مقام أويس القرني، بعد رفضهم زيارتي «خوفاً» عليّ.
كنت أعلم أن دمي قد أهُدِرَ سواءَ أخللتُ بالشروط أم لا، أنا الزائرُ الوحيد الذي خرج، وأنا الذي انتظرتُ رصاصةً طائشة من شخص لا أعرفه طيلة أشهر، حتى مغادرتي الأخيرة للمدينة. منذ عامٍ وعشرة أشهرٍ وأنا هنا وهناك، أرى من كان يُفترض أن أموت قبلهم وقد ماتوا قبلي، وخُطِفَت أجسادهم حرقاً دون أيّ أثر.. إلى الأبد!
عامان، وما زلتُ أنام مكبّل اليدين والقدمين دون قيودٍ أو سلاسل حديدية، ما زالت عيون السجّان تراقبني بين الحين والآخر، القلقُ والأرقُ والليل الطويل، الوحدة، وفأرٌ تسلّل بين ضلوعي وهَنِئَ بنومٍ عميقٍ يخنقني. ما زالَ صوت أبي عبد الرحمن يقرأ القرآن ليلاً على مسامعي، وعويلُ «المرتدين» يؤلمني. ما زلتُ أفكر: من هم؟ ومن هناك؟ هل فراس وإبراهيم ومحمد نور وعبد الإله وكل من سُرِقوا.. هناك؟ وهل أهلُ مدينتي هناك؟ هل ذاكَ السجن الكبير بخير؟
أنا لستُ بخير، ولم أغادر زنزانتي منذ غادرتُ مدينتي وتركتُ أهلها.