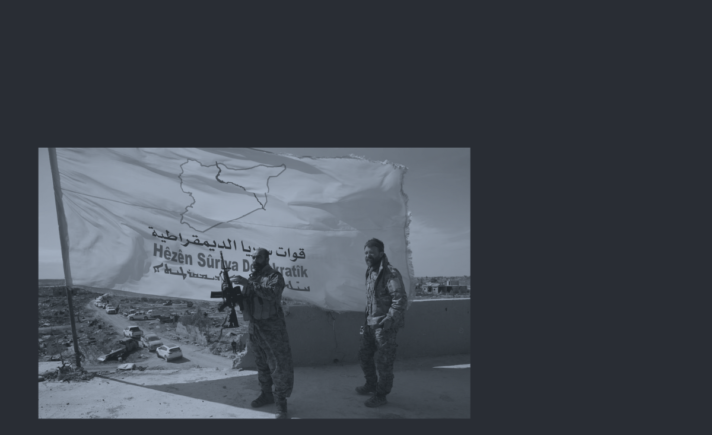«على مدى ما يقرب من ثلاثة قرون، دأب علماء الاجتماع والمثقفون الغربيون البارزون على التأكيد على أفول الدين. وساد اعتقاد بأن التحديث هو المحرك الذي سيتسبب بصورة حتمية في إقصاء الدين عن الحياة…. [ولكن] لا بدّ من إعلان نهاية إيمان علم الاجتماع بنظرية العلمنة، والإقرار بأنها لم تكن إلا محصّلة لأفكار وتوجهات محبَّبة. فبعد نحو ثلاثة قرون من إخفاق نبوءاته، حَريّ بمبدأ العلمنة أن يُلقى في مقبرة النظريات الفاشلة».
بهذه الكلمات بدأ جون فول، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة جورجتاون الأميركية مقاله بعنوان «الإسلام ونهاية العلمانية» في موقع الجزيرة.نت منذ عشر سنوات
من الأكيد أن رؤية جون ستارك تحتاج إلى نقاش أعمق، وقد أوضح فول نفسه جزءاً من فهمه للموضوع حين قال في مقامٍ آخر: «أظن أننا نشهد عالماً يُسقط فكرة أن التحديث يؤدي بالضرورة إلى إقصاء الدين. فقد أدبرت تلك الحقبة التي سادت فيها تلك الفكرة. وبالنظر إلى دور الولايات المتحدة في شؤون العالم، جدير بنا أن نتقبل فكرة نهاية العلمنة كأحد أبعاد عملية التحديث، وليس باعتبار ذلك أيديولوجيا منافسة أو بديلة».
لكن هذا المدخل قد يكون ضرورياً، على سبيل «الحركشة»، للحديث عن موضوعنا هنا فيما يتعلق بأزمة شرائح من النخبة السورية، تنتمي إلى مدارس فكرية وتحمل رؤية للعالم تنضوي في إطار عناوين العلمانية والحداثة والليبرالية.
فمنذ عقود، بدأ الإسلاميون في رفع شعار أصبح مادةً للتندّر فيما بعد، «الإسلام هو الحل». وكما هو معروف، ظهرت المشكلة عندما صار رفع ذلك الشعار ثم الالتفاف حوله هدفاً بحدّ ذاته عند البعض، بل وأصبح عند البعض الآخر بداية الطريق ومُنتهاه. وكان واضحاً من خلال الأدبيات ومن خلال الممارسات أن كثيراً من الإسلاميين يظنّون، ويُوحون للآخرين بالحال وبالمقال، أن كل ما كان مطلوباً هو أن يتمَّ تبنّي الشعار من قبل النظام السياسي/الدولة، لتظهر على أرض الواقع بعد ذلك فوراً حلول سحرية تعالج جميع مشكلاتنا وأزماتنا المستعصية، بل ربما تمتلئ الأرض جَنّاتٍ وتَسيلُ جَنَبَاتها أنهارا.
وفي هذه الأيام، يبدو إلى حد ما أن التاريخ يكرّر نفسه. ففي مقابل واقع العنف والاحتراب في منطقتنا بشكل عام، وفي سوريا تحديداً، والذي يُردُّ بأشكال ودرجات مختلفة إلى الإسلام، يبدو منطق البعض وكأنه يرفع شعاراً جديداً مشابهاً يقول: «العلمانية هي الحل» أو «الليبرالية هي الحل» أو «الحداثة هي الحل». والمنطق هذا يستبطن ضمناً، بتبسيط واختزال، مقدّمة تقول: «ها قد ثبت فشل الإسلام» من قراءة الواقع السوري اليوم، وبالتالي فإن بديلنا، علمانيةً أو ليبراليةً أو حداثة، هو الحل بالضرورة.
يذكّرنا هذا المنطق كثيراً بمقولة «نهاية التاريخ» التي طرحها عالم السياسة الأميركي فرانسيس فوكوياما (1952) في يوم من الأيام، رغم أنه يومها، في ظروف سقوط الاتحاد السوفييتي والمنظومة الشرقية، كان حديث الرجل عن انتصار الليبرالية وقيم الديمقراطية الغربية على الاضطهاد والنظم الشمولية يوظّف بعض الوقائع الملموسة ويستند عليها. غيّر الكاتب رأيه بعد ذلك، بالمناسبة، خاصة فيما يتعلق بكون الليبرالية بنسختها الغربية «المحطّة» الأخيرة في تاريخ البشرية. وكتب أكثر من مرة عن مشكلات المنظومات السياسية والاقتصادية التي انبثقت عن الليبرالية خلال العقدين الماضيين، ولخَّص آراءه في كتاب موسوعي صدر جزءه الثاني هذا العام بعنوان النظام السياسي واهتراء السياسية
أما في حالتنا، حيث تحتفي بعض النخبة السورية بما تراه «هزيمة الإسلام»، وبالتالي انتصار العلمانية والليبرالية والحداثة كنتيجة بَدَهية مقابلة، فإننا أمام حالة ليس لها أي مضمون تستند إليه، ولايمكن القول فقط إنها تفتقد إلى «إنجاز» عملي يُذكر، بل إنها في جزئها الأكبر جزء أساسي من المشكلة في سوريا، ماضياً وحاضراً، وهي أقرب ما تكون لما أسماه منذ عقود المفكر السعودي الراحل عبدالله القصيمي (1907–1996) «ظاهرة صوتية».
تتمثل الإشكالية التي نتحدث عنها هنا في مسارين: يتعلق الأول بالمفارقة بين النظرية من جانب وممارسات حاملها من جانب آخر، ويتعلق الأمر بالغالبية العظمى من النخبة السورية؛ ويتمظهر الثاني في فقر مُدقع من ناحية العطاء الثقافي والطروحات النظرية.
ثمة، بالتأكيد، مثقفون ونشطاء وإعلاميون سوريون يصفون أنفسهم أو يصفهم الآخرون بعناوين الليبرالية أو العلمانية أو الحداثة، ممن يتمثّلون في تفكيرهم وحركتهم، عملياً، قِيماً وأخلاقاً وأساليب حياة تُنسب إلى الأصول النظرية لهذه المدارس الفكرية. ومِن هؤلاء مَن يُعتبر عطاؤه علامة فارقة في مسيرة سوريا الثقافية. الطريف أن هؤلاء هم أقلّ الناس تركيزاً على الشعارات والتصريحات والصخب الإعلامي، وأكثر الناس عملاً على خدمة بلادهم وأهلهم السوريين من خلال ممارساتهم وجهودهم الفكرية. لكن الصخب والضجيج يبدوان من نصيب شريحة أخرى تُصرّ على رفع الشعارات وعلى تأكيد صفتها «الليبرالية» أو «العلمانية» أو «الحداثية» في كل مناسبة، وأحياناً من غير مناسبة، رغم أن طروحات هؤلاء وممارساتهم تبدو أبعد ما تكون عن كلّ ما يمتّ بِصِلَة لقِيَم ومنطلقات تلك العناوين.
وهناك في مجال السياسة من هؤلاء، كما في ساحات النشطاء والإعلاميين، والعسكر بالتأكيد، مَن لم يعد بالإمكان وصف ممارساتهم ومواقفهم بغير كلمة «الفضيحة»، سواء كان هؤلاء أفراداً أو تجمّعوا في هياكل تنظيمية. لاحاجة فيما نعتقد لضرب أمثلة بالاسم من هنا وهناك، فساحة القضية السورية، وثورتها، باتت كتاباً مفتوحاً يعرف السوريون محتوياته، على الأقل في مثل هذه المجالات.
يمكن أن يقول البعض طبعاً إن «هؤلاء» لا يمثلون العلمانية والليبرالية والحداثة. ونحن لا نتمنى هذا فقط، بل ونوافق و«نبصم عليه بالعشرة» (كما يقولون بالعامية)، لكن المشكلة أن هذه المقولة نفسها تُحيلنا إلى أخت لها سَبَق إليها الإسلاميون منذ زمن، فالدفاع الأسهل والأفضل في معرض نقد ممارسات من يوظف الإسلام لمصالحه، أو يتحدث باسمه ناشراً الخراب في الأرض بأساليب مختلفة، يكمن في مقولة أنه «لا يمثل الإسلام»، وكفى الله المؤمنين شر القتال!
المشكلة الأكبر أننا حين ننتقد إسلاميين يتصدّرون المشهد في ساحات السياسة والعسكرة وغيرها، خاصةً في سوريا اليوم، فإننا نتحدث في الأغلب الأعمّ عن حالات طارئة، وعن ظواهر جديدة و«خفيفة»، طَفَت إلى سطح الأحداث بفعل طبيعة الوضع السوري وملابساته السياسية والثقافية المحلية والإقليمية والدولية… أما الحديث عن العلمانيين والليبراليين والحداثيين فمن المفترض فيه أن يكون عن «رموز» فردية وتنظيمية مخضرمة تعمل وتتحرك في ساحات السياسة والثقافة منذ عقود!
الأسوأ من كل هذا واقع شرائح من الشباب السوريين المتحمّسين للعلمانية والليبرالية والحداثة، وأحياناً كردّ فعل على ما يرونه أيضاً «فشل الإسلام». فلِسانُ حال هؤلاء يوحي، كما هو متداول لمن يريد الاستقراء في منابر الإعلام ومواقع الإنترنت، بأن هناك نوعاً من الرومانسية يصبغ تعاملهم وتعاطيَهم مع هذه المدارس الفكرية. بل إن كثيراً من الطروحات التي يتمّ تداولها بشكل أو بآخر تفترض ضمناً أن كل المطلوب الآن «انتظار» الإعلان الرسمي لـ«موت الإسلام»، وهو أمر يرونه قريباً، ثم يتم إعلان تبنّي واحدة من تلك المدارس، أو مجموعها، بديلاً عن الميّت… وما إن يحدث هذا حتى تمتلئ الأرض جنّاتٍ وتَسيلَ جَنَبَاتُها أنهارا…
وإذا كان لهذه الظاهرة من مغزى، فإنه يتمثل في توضيح حقيقة أن المشكلة الأصليّة لإنسان المنطقة العربية بشكل عام، والسوري تحديداً، هي مشكلة طريقته في التفكير، قبل أن تكون مشكلة انتمائه الأيديولوجي المعيّن. أو بمعنى آخر، المشكلة مشكلة منهج عقليٍ معيّن في فهم الحياة وفي إدراك كيفية التعامل معها، من خلال الشعارات والعواطف والأمنيات والنيّات، الطيّبة أحياناً – أو هي مشكلة توظيف الفكرة لتحقيق المصالح الشخصية والوصول إلى مواقع القوة والنفوذ. وبالتالي من الممكن لتلك المشكلة أن توجد، في الحالتين، عند كثير ممن يسمّون أنفسهم إسلاميين، بالقدر نفسه الذي قد توجد فيه عند كثير ممن يسمّون أنفسهم علمانيين أو ليبراليين أو حداثيين، وما إلى ذلك من التصنيفات الشائعة.
ثمة درجة من الغباء الثقافي ومخالفة المنطق في معارضة العلمانية والليبرالية والحداثة بشكل مطلق وأصمّ، ولا سيّما حين يدرك الإنسان طبيعة العلاقة بين التاريخ والحاضر، ويعرف شيئاً عن آليات التفاعل بين مقوّمات الهوية ومقتضيات المُعاصَرة. تماماً كما أن من الغباء الثقافي ومخالفة المنطق معارضة الإسلام بنفس الشكل المطلق الأصمّ. بل إن النظر إلى هذه التصنيفات أصلاً على أنها تصنيفات حَدّية، تعبّر عن منظومات متضاربة كلياً وتجعلها قواقع ثقافية أو جُزُراً فكرية منعزلة لا تمتّ واحدة منها إلى أخرى بِصِلة، هو أمر بات أبعد ما يكون عن فهم آليات التطور الثقافي والسياسي للمجتمعات.
فالواقع الثقافي والسياسي الراهن يفرض تجاوز نظرة التضارب الكامل التي كانت سائدة في وقت من الأوقات، ويتطلّب رؤية الحجم الكبير لما هو «مشترك» أو «متكامل» بين تلك المنظومات الفكرية على عدّة مستويات… وهو تكامل سيراه كل مثقف يمتلك القدرة على تجاوز مرحلة الطفولة الأيديولوجية، التي تنظر إلى العالم من خلال أحادية الانتماء إلى الدوائر الضيّقة المحيطة بالإنسان، وذلك نحو مرحلة أخرى ينفتح فيها العقل والقلب على ذلك العالم ليرى ما فيه من فسحة هائلة للتنوّع والتعددية والاختلاف الإيجابي.
من هنا، فإن رسالة هذا المقال ليست الدفاع عن طرف أو الهجوم على آخر، وهي على وجه التحديد أبعد ما تكون عن الخوض في مداخل الفرز والتصنيف، لأنها على العكس من ذلك دعوة للخروج من الحصار الذي تفرضه على الواقع السوري، والعربي والإسلامي، عقلية الفرز والتصنيف، مهما أُطلق عليها من تسميات.
إضافةً لهذا، يهدف كلامنا للإشارة إلى أن التحديات الكبرى الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها سوريا، ومعها المجتمعات العربية، معقّدة وكثيرة، وهي تتطلب نظرة أكثر واقعيةً وشمولاً إلى الأمور، تتجاوز مجرّد استبدال منظومة فكرية بمنظومة أُخرى، أو استبدال شعار بشعار.
إن هذا الواقع الذي نتحدثُ عنه بحاجة إلى برامج عملية تعمل على معالجة إشكالياته، وهي برامج تنبني في المقام الأول على فهم علمي للتشابك الحاصل تاريخياً وآنياً بين مكوّناته العديدة، بعيداً عن ردود الأفعال، وبعيداً عن محاولات الفرز والتصنيف، وبعيداً عن رفع الرايات والصخب والضجيج تحت الشعارات المكتوبة عليها.
وإذا كانت المنطقة العربية، وسوريا في القلب منها، قد جرّبت حلّ مشكلاتها في الخمسينات والستينات من القرن السابق من خلال شعار «القومية هي الحل»، ثم جرّبت حلّها منذ نهاية السبعينيات تحت شعار «الإسلام هو الحل»، فإن من الغريب أن يعتقد البعض أن مجرد رفع شعار «العلمانية/ الليبرالية/ الحداثة هي الحل» سيكون الآن كافياً لتجاوز واقعنا السوري الصعب، فضلاً عن الواقع العربي المتخَم بالتبعية والوهن والأزمات.
وكما قلنا سابقاً، من هنا تنبع مسؤولية العلمانيين والليبراليين والحداثيين السوريين الحقيقيين في حماية مفاهيمهم من الاختطاف كما تمّ اختطاف مفاهيم أخرى، بحيت تعود لتصبح من المشترك الثقافي الذي يدفع عمليات الإصلاح، بدلاً من أن يكون أداة في يد الخاطفين للهدم والتخريب وزراعة الفوضى الفكرية والعملية.