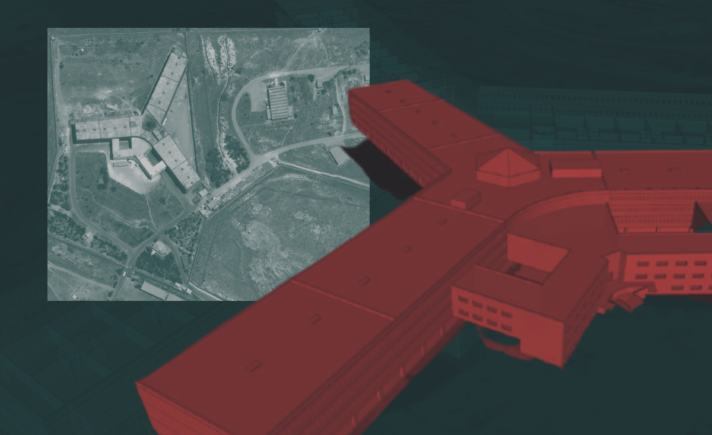1- ما تعريف الجهاد، و متى ينبغي التوقف عنه في الحالة السورية؟
الجهاد له معانٍ متعددة في الشرع، وقد انشغلت كلُّ طائفة من العلماء بمعنى من معانيه بحسب تخصصاتهم. فالفقهاء – مثلاً – اهتموا بالجانب القتالي وأحكامه الواسعة وهو المعنى الذي غلب على مصطلح “الجهاد” لاحقًا، وعلماء التصوف اهتموا بجهاد النفس والهوى ووسائله ودرجاته. ولكن العلماء – في الجملة ¬- يقسمون “الجهاد” إلى ثلاثة أقسام تندرج كلها تحت مسمى “مجاهدة العدو”، وهذا العدو يكون ظاهرًا (القتال، وهو محل اهتمام الفقيه)، ويكون الشيطان والنفس (وهو مجال اهتمام الداعية والواعظ)، وهذه الثلاثة (العدو الظاهر، الشيطان، النفس) يشملها في الإسلام وصف “عدو”، واشتملت عليها آيات كثيرة، وهي داخلة في عموم “فِي سَبِيلِ اللَّهِ”، “وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ” (الحج: 78).
وبعد فَرْض القتال نَقَل الشرع لفظ “الجهاد” من المعنى اللغوي العام (بذل الجهد) إلى المعنى الشرعي وهو – بحسب ما يستفاد من النصوص القرآنية المدنية – : “بذل الوسع بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك”. ولكنّ السؤال عن الحالة السورية تحديدًا، يتجه إلى نوعِ (مجاهدة العدو الظاهر) حصرًا، لأن النظام السوري تحول إلى (عدوّ ظاهر)، وكلُّ مَن يقاومه – بأي وسيلة كان – يقوم بواجب “جهاد الدَّفع” الذي هو من الجهاد المتَّفَق عليه عند العلماء؛ لأن دفعَ ضرر العدوّ عن الدين والنفس والحرمة واجبٌ إجماعًا، “فالعدوّ الصائل (= أي المعتدي) الذي يُفسد الدين والدنيا لا شيء أوجبُ بعد الإيمان من دَفعه، فيُدفَع بحسب الإمكان”، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد تحول النظام السوري بخطاباته وسياساته وممارساته الفعلية إلى عدوّ للشعب (الاحتلال الداخلي بلغة الفكر السياسي الحديث)، وهو ما لم يَعُد خافيًا على أحد إلا مَن عطّل عقله أو حرّكته مصالحه وأهواؤه. وللجهاد أحكامٌ كثيرة، فهو يشغل بابًا كاملاً من أبواب الفقه الإسلامي، وقد تغيرت بعض أحكامه بحسب الوقائع والتطورات السياسية والجغرافية والعسكرية، ولذلك حصلت فيه اجتهادات كثيرة وحديثة، لا يمكن الدخول فيها الآن. ويتم التوقف عن “الجهاد القتالي” في الحالة السورية بإسقاط النظام بكل أشكاله واستقرار سلطة شرعية منتخبة بإرادة شعبية مُعَبِّرة عن أهداف الثورة ومقاصدها الكبرى، ومع بدء مرحلة بناء الدولة، ولكن تستمر أنواع الجهاد الأخرى: بالجهد والفكر واللسان، والمال، سعيًا إلى بناء الدولة بكل السبل اللازمة والضرورية لإعادة إصلاح ما تم تهديمه وتخريبه من إنسان ومؤسسات وعِمران وقيم وعلاقات بين أبناء الوطن الواحد حتى ينهض من كبوته وينصلح أمره، وهذا كله مما يدخل في مفهوم الجهاد الواسع.
2- ما مفهوم الليبرالية في الاسلام؟ وما العلاقة بين الليبراليين والاسلاميين؟
الكلام عن مفهوم الليبرالية وعلاقتها بالخطاب الإسلامي مسألة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة، ولكن النقاش حول الليبرالية بدأ في المجال العربي منذ مطلع الستينيات من القرن العشرين، بعد أن كان النقاش يدور في مطلع القرن العشرين حول قضايا التحديث والعلاقة بالعالم تحت عنوان: (العلمانية، أو العلمانية والإسلام). الليبرالية مفهوم مركّب، له أبعاد فكرية وفلسفية واقتصادية وسياسية، وهي في مجملها تُحيل إلى “الحداثة والتقدم”، وأنتجت جملة من القيم كالحريات والديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية وغير ذلك. والحداثة هنا هي محاربة التقليد (العربي والإسلامي: الفكري والاجتماعي والثقافي والسياسي)، ونَزْعُ القداسة عن الأعراف والنصوص نقطةٌ مهمة في التحديث الاجتماعي والثقافي، ومن ثَمَّ السياسي. أما العلاقة بين الإسلاميين والليبرالية على وجه الخصوص فقد مرت بتطورات عديدة منذ ستينيات القرن الماضي حتى الآن، فقد قَبِل كثير من الإسلاميين (التيار الإسلامي الرئيسي) بجملة من القيم الليبرالية كالحريات (مع بعض الاختلافات في القيود والمرجعية)، وكالديمقراطية والتعددية وحوار الحضارات وغيرها، وردوا بعنفٍ وكثافة على أطروحة “صدام الحضارات”، وخفّت نبرة العداء للغرب لديهم، ولكن بقيت قضايا جوهرية خلافية بين الليبراليين والإسلاميين فيما يخص التحديث ونَزْع القداسة عن النصوص (وإن كان مفهوم القداسة مفهومًا غريبًا على الفكر الإسلامي)، والعلاقة بين الدولة والدين، ومرجعية الشريعة، وشكل الدولة وطبيعتها، وتجاوز الأعراف الإسلامية، والموقف من التراث الإسلامي إلى غير ذلك.
3- يعتقد البعض أن مفهوم “الدولة المدنية” هو نقيض “الدولة الإسلامية” … ما تعريف الدولة المدنية وما إمكانية تطبيق الشريعة فيها؟
تعبير “الدولة المدنية” تعبير أصبح يثير الجدل حديثًا، وهو لم يكن كذلك من قبل، ولكن مع صعود الإسلاميين في بلدان الثورة، دار الجدل حول طبيعة حكمهم وتصوراتهم لمفهوم الدولة وطبيعتها ووظائفها، وقد وقع جدل كبير في مصر حول مفهوم “مدنية الدولة”، فالبعض فسر المدنية هنا بالعلمانية، وبعض آخر رأى أن الدولة الإسلامية هي – بطبيعتها – دولة مدنية، أي أنها ليست دولة رجال دين أو ملالي أو ولاية الفقيه. والدولة المدنية تعني – في حقيقة الأمر – أمرين: أنها مقابل العسكرية من جهة، بمعنى أن الذي يحكم فيها هم مدنيون وليسوا عسكريين. ومن جهة ثانية هي مقابل الكنيسة ورجال الدين، أي أن الذين يحكمون هم بشر ولا يحكمون بسلطة إلهية أو كهنوتية أو دينية. والدولة المدنية معناها هنا أن شرعية الحكم تُبنى على إرادة الشعب، وأن القوانين تصدر بالانتخاب من قِبَل مؤسسات مختصة، وتُتخذ قراراتها وفق المصلحة العامة، مصلحة المجتمع، وبأقصى درجات العدل الممكنة. وأول من تحدث عن “الدولة المدنية” في الإسلام هو الإمام محمد عبده رحمه الله، فقد كان يرى مدنية الدولة في سياق مناقشته لأطروحات فرح أنطون حول العلمانية والدين والدولة، ولم يتحدث محمد عبده عن فكرة “الدولة الإسلامية” فهي مصطلح ظهر بعده بمدة؛ لأن الإصلاحيين الكبار كانوا يطمحون إلى دولة عصرية حديثة يشغل الدين فيها مرجعية إصلاحية خارج إطار “التقليد الفقهي”، ثم التقط الفكرة بعض مفكري الإخوان المسلمين فتحدثوا عن الدولة الإسلامية وأنها دولة مدنية في أثناء صراعهم مع العلمانيين والليبراليين الذين كانوا يتهمونهم بأنهم يسعون إلى إقامة “دولة دينية”، مع أن تقي الدين النبهاني زعيم حزب التحرير وأبا الأعلى المودودي في الهند كانا يستعملان تعبير “الدولة الدينية” ولا يريان حرجًا فيه قبل طروء هذا السجال الإسلامي العلماني. وفي السنوات الأخيرة تحدث عدد من المفكرين والكاتبين المعاصرين (كطارق البشري، ويوسف القرضاوي ومحمد عمارة، وفهمي هويدي وآخرين)، عن مفاهيم مهمة تساهم في بناء الدولة المدنية كمفاهيم المواطنة، والتعددية، والديمقراطية، والشرعية السياسية، وسلطة الشعب، وغير ذلك، بل إن د.سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي الحالي، وأحد قيادات حزب العدالة والتنمية في المغرب كتب دراسة مهمة حول “الإسلام والدولة المدنية” قدم فيها تأصيلاً شرعيًّا من خلال كتب الأصول والفقه، وتحديدًا من خلال مسألة شهيرة عند علماء أصول الفقه وهي مسألة “تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة”. فمن المعروف عند علماء أصول الفقه أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، وليست كلها ناتجةً عن الوحي، بل بعضها بشريّ بحكم طبيعته البشرية، وبعضها بصفته النبوية أي لكونه نبيًّا، فمن التصرفات ذات الطبيعة البشرية: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بصفته رئيسَ دولة، وهذه موضع اجتهاد وليست مُلزمة للأمة أو لمن يَخلُفه، وما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بصفته قاضيًا يحكم بحسب توافر الحجج والأدلة والبينات، وذلك لا يعني أن حكمه قطعي في حقيقة الأمر، وإنما “يَقضي على نحو ما يَسمع” – كما في الحديث، إلى غير ذلك، بل إن عددًا من الأئمة مضَوا أبعد من ذلك إلى أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام فيما سُمي – لاحقًا – “الطب النبوي” هو من الأحاديث ذات الطبيعة البشرية وليس الوحي ومنهم القاضي عياض المالكي وابن خلدون وغيرهما. ومن هنا فإن طبيعة التصرفات النبوية بالإمامة/ رئاسة الدولة توضح كيف أن الإسلام ينزع كل عصمة أو قداسة عن ممارسات الحكام وقراراتهم، كما ينزعها عن الوسائل التي تتوسل بها الدولة لإدارة شؤون الأمة. وهذا كله من أجل توضيح فكرة أن الدولة في الإسلام دولة دنيوية، قراراتها بشرية، واجبها تبني أقصى درجات الموضوعية والواقعية في تسيير شؤون المجتمع، كما أن الحاكم في الإسلام لا يستمد مشروعيته من قوة غيبية، بل هو فرد عادي يستمد ولايته من الأمة التي اختارته وكيلا عنها بمحض إرادتها وهو مسؤول أمامها في الدنيا، فضلا عن مسؤوليته أمام الله يوم القيامة. وفيما يخص “الدولة الإسلامية” فهي مقولة حديثة، تعود إلى عشرينيات القرن الماضي في كتابات بعض الفقهاء (عبد الوهاب خلاف أول من استعمل هذا التعبير)، ثم رفعها الشيخ حسن البنا شعارًا في رسائله الشهيرة وتحولت إلى مطلب رئيس للحركة الإسلامية فيما بعد. أما بخصوص إمكانية “تطبيق الشريعة” في الدولة المدنية، فهو أمر يتوقف على مفهوم تطبيق الشريعة نفسها مما سيأتي في تساؤل لاحق، ولكن الدولة المدنية – بعيدًا عن الخصام الأيديولوجي الذي سيطر على السجال في مصر مؤخرًا – لا تتناقض مع الشريعة؛ لأن الدساتير العربية في ظل الأنظمة الدكتاتورية – بأجمعها – لم تستطع إلغاء بند مرجعية الشريعة فيها، والشريعة تنتعش في أجواء الحرية والإرادة الشعبية أكثر من أجواء الاستبداد. ولكن أؤكد مجددا على ضرورة توضيح مدلول الشريعة هنا بعيدًا عن الخطابات الشعبوية الغامضة التي تستجيب لتوظيف البعض لها في سياق الخصومات السياسية من جهة، وبعيدًا عن بعض الخطابات الموتورة والمتشنجة من ذِكر الشريعة أيضًا، فهما خطابان نقيضان يتغذى أحدهما على الآخر باستمرار.
4- ما معنى الخلافة ؟ وهل هي مفهوم أصيل في الشرع أم أنها حالة طارئة كآلية حكم اتبعها المسلمون؟
الخلافة، والإمامة العظمى، وإمارة المؤمنين: ثلاث كلمات تدل على معنى واحد عند الفقهاء، وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. وقد ذكر علماء الكلام (= العقيدة) الإمامةَ في باب العقائد السمعية (= النصيّة)، وقالوا: هي رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافةً عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، أو هي نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وقد جرّد الفقهاء من خلال النصوص والتاريخ الإسلامي المعاني المقصودة من الخلافة، ولم يحددوا شكلاً محددا للحكم بأنه خلافة أو إمارة أو سلطنة أو غير ذلك، وقد شهد التاريخ الإسلامي أنماطا متعددة في الحكم ابتدأ بالخلافة ثم السلطنة والإمارة وصولاً إلى الدولة الحديثة بعد الاستعمار. ولم يقل أحدٌ من أهل العلم – قديمًا وحديثًا – إن شكلاً محددًا للحكم مطلوبٌ لذاته، أو إن شكل الخلافة مقصود للشارع، فالكل متفق على أن الإسلام، قرآنًا وسنة نبوية، سكت عن تحديد شكل محدد للسلطة أو الحكم، وإنما اكتفى بتقرير بعض القيم والأحكام والمعاني الكلية، وما عدا ذلك مسائل اجتهادية. ولهذا قال الإمام الفقيه الشافعيّ الجوينيّ: “معظم مسائل الإمامة عَرِيَّةٌ عن مسلك القطع، خَلِيَّةٌ عن مدارك اليقين”، أي أنها مسائل متروكة لاجتهادات الفقهاء بعقولهم في ضوء مبادئ الشرع وأصوله وما يحقق المصالح المبتغاة. كما أن مطلب الخلافة تخلى عنه عامة الإسلاميين بعد القول بأطروحة “الدولة الإسلامية”، ولم يصرّ عليه إلا جماعة “حزب التحرير” الذي أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني الفلسطيني.
5- هل مفاهيم مثل الديمقراطية وحرية التعبير متناقضة مع الإسلام؟
الديمقراطية تعني – فيما تعني – حق الشعب في مسائل الحكم والشأن العام، وحرية الاختيار الشعبي للحاكم أو الرئيس في مختلف الولايات العامة والخاصة، وتحديد مدة حكمه، وهي تتضمن جملة آليات أو مفاهيم مثل: الانتخاب، وحكم الأكثرية، والاستفتاء، والمعارضة، وتعدد الأحزاب، والحريات، وغير ذلك. والديمقراطية هي أفضل ما انتهى إليه الفكر السياسي الحديث، وقد اضطرب موقف الإسلاميين منها بادئ الأمر، ولكنهم انتهوا – على العموم – إلى القول بها وأنها لا تتعارض مع الشريعة، وأنها تشبه آلية الشورى الإسلامية التي تعطي للشعب حق المشاركة في الحكم أو القرار، وقد ورد في السنة النبوية أن ممن لا ترتفع صلاتهم شبرًا فوق رؤوسهم: “رجلاً أمّ قومًا وهم له كارهون”، وقد قاس بعض الفقهاء المعاصرين الإمامة العامة على إمامة الصلاة، كما جاء في حديث آخر “أن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم …”، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وهو كناية عن الرضا المتبادل بين الطرفين، وهذا كله يشير إلى اعتبار إرادة الجمهور في اختيار الحاكم أو الإمام، سواء في الصلاة أم الشأن العام. وإذا كان الفقه القديم أعطى هذا الحق في الاختيار لـما أسماه العلماء قديمًا “أهل الحل والعقد”، أي النخبة العالمة أو ذات الشوكة والوجاهة في المجتمع (على خلاف في تحديد المفهوم)، فإن الديمقراطية الحديثة عممت هذا الحق لعامة الشعب، وهذا أَدْعى لإقامة العدل، والموازنة بين منظومة الحقوق والواجبات، فكل واجب يقابله حق وبالعكس، ومن غير العدل أن نرتب واجبات على الشعب من دون إعطائه حقوقًا تقابل هذه الواجبات. وبخصوص اعتبار الأكثرية والأقلية، فقد قدّم بعض الفقهاء المعاصرين أمثال الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ أحمد الريسوني اجتهادات فقهية تأصيلية في موضوع حكم الأكثرية، مفادها أنه أمر شرعي مرعيّ في الفقه، أي له اعتبار، وهو من ضمن المرجّحات التي يمكن الاعتماد عليها. ولكنني أوضح مسألة مهمة هنا لم يتبنه لها مَنْ كَتب في الموضوع، وهي أن اعتبار الأكثرية هنا لا علاقة له بالحق والباطل أو الخطأ والصواب، وإنما هي مسألة مرتبطة بإرادة الناس في اختياراتهم الشخصية والحياتية، وفي تحقيق مصالحهم العامة والخاصة. ولا بد من التذكير هنا بأن مسائل السياسة كلها، أو ما يسميه الفقهاء “السياسة الشرعية” مبنية على مبدأ المصالح والمفاسد، وهي ليست أحكامًا فقهية نهائية أو قطعية، ومن ثم فهي خاضعة للتطور الفكري البشري، والاجتهادات السابقة ليست مُلزمة لنا إذا وجدنا سبلاً أفضل لتحقيق المصالح العامة والمقاصد الشرعية الكلية. ولذلك فَصَل الفقهاء السابقون بين الفقه العام والفقه السياسي أو السياسة الشرعية؛ لأن آلية استنباط وفهم الفقه السياسي تختلف عن آلية فهم واستنباط الفقه العام (فقه العبادات وغيره).
6- هل يَصلح رجل الدين كسياسي؟ ومتى يحق له التدخل في السياسة؟ ومتى لا يحق له؟
أولاً، من المهم عدم استعمال تعبير “رجل الدين” لأنه مصطلح مرتبط بالفكر المسيحي، ويترتب عليه بعض التصورات والمفاهيم المسيحية التي لا تنطبق على “عالم الدين” المسلم، أو على “الفقيه”، و”الداعية”، و”المفكر”. ومن المؤسف أن هذه المصطلحات التي ميّزتُ بينها هنا اختلطت في الأوساط الدينية الإسلامية عامة، وأن الناس لا تميز بين شيخ وشيخ، وأن بعض المشايخ أنفسهم لا يلتزمون بحدود علمهم وأدوارهم، ولكن هذا التمييز واضح عبر التاريخ ولدى العلماء السابقين، فقد كان هناك تمييز بين الفقيه والأصولي، والمحدّث، والواعظ، والمفسر، ومنهم من كان يجمع كل هذا، ومنهم من لا يحسن كل هذا، وكثيرٌ من مشايخ اليوم هم “دعاة/ وعاظ”، وليسوا فقهاء، بل إن آفتنا في سوريا على وجه الخصوص هي قلة الفقه وفَقْر الفكر بين المشتغلين في الوسط الديني عامة، كما أن تكوينهم العلمي لا يؤهلهم للوصول إلى درجة الفقهاء أو المفتين – بتعريف الفقهاء السابقين للفقيه والمفتي -. وبناء على ما سبق فإن عامة المشايخ لا ينبغي لهم أن ينخرطوا في العمل السياسي؛ لأنهم لا يحسنونه، ولأنه يتطلب تأهيلا خاصًّا، وقد نبهنا القرآن الكريم إلى مبدأ عام وهو: “فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”، وأهل الذكر هنا هم أهل الاختصاص في كل فن، وعلم السياسة فن، والعمل السياسي فن آخر، فليس كل من له علم بالسياسة مؤهلاً لممارسة العمل السياسي نفسه، كما أن الخلط بين الدعوة والعمل السياسي أمر شديد الخطورة على الدعوة والسياسة معًا، ومُضرٌّ بكليهما معًا؛ لأن آليات وأخلاقيات العمل الدعوي تختلف كليًّا عن آليات العمل السياسي، واشتغال الدعاة بالسياسة له ضررٌ على مستقبل التدين في سوريا! فالعمل الدعوي ينطلق من مسائل دينية، ومسلّمات شرعية لا يبتغي بها إلا وجه الله، ولا يسأل عليها أجرًا، أما العمل السياسي فمبني على التنافس والتنازع وتزكية النفس، والشهادة لها والمبالغة في ذلك، ومبني على مراعاة رأي الجمهور ورغباته، وعلى المصالح الحزبية والعامة، ويتطلب مؤهلات وتكوينًا خاصًّا في إدراك مسائل الشأن العام وإدارته والعمل الحزبي وعقد التحالفات مع الأحزاب المختلفة، والمعارضة، وكل هذا يجعل الداعية – السياسي طرفًا وخصمًا للأطراف الأخرى لأنه يتنافس معها ويتنازع معها على المناصب والنفوذ، وهذا يُفقده دوره العام الذي يُفترض فيه أنه يخاطب عامة الناس وليس أنصاره فقط، إلى غير ذلك مما لا يحتمل التوسع فيه هنا الآن.
7- هل الدولة الإسلامية جزء أساسي من الإسلام؟ بمعنى هل هي أحكام وحدود يأثم المسلم إن لم يطبقها؟
أم أن الدولة في الإسلام هي صنيعة مجتمع إسلامي ومنضبطة بقيمه ومصالحه؟ سبق أن أشرت إلى أن مقولة “الدولة الإسلامية” مقولة حديثة، ولكنني أضيف هنا أن الإخوان المسلمين (بدءًا من حسن البنا) – وحدهم – مَن جعلوا الدولة ركنًا أو فريضة إسلامية، وهذا مخالف لما عليه الفقهاء والمتكلمون المسلمون من أهل السنة الذين عالجوا قديمًا مسألةَ إقامة السلطة السياسية ومدى الحاجة إليها من خلال مبحث “الإمامة” وما أسمَوه “نَصْب الإمام”. فـ”الإمامة” في الفقه السني الموروث هي من الفروع والفقهيات وليست من الأصول والمعقولات، وقد أوضح ذلك الإمام الجويني فقال: “وليست الإمامة من قواعد العقائد، بل هي ولاية تامة عامة، ومعظم القول في الولاة والولايات العامة والخاصة مظنونةٌ في التأخّي والتحري”، ثم قال تلميذه أبو حامد الغزالي (505 هـ) بوضوح: “اعلم أن النظر في الإمامة أيضًا ليس من المهمات، وليس أيضًا من فن المعقولات بل من الفقهيات، ثم إنها مثارٌ للتعصبات، والمُعرض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصاب، فكيف إذا أخطأ؟!”. وكونها من الفروع يعني أنها من الفقهيات، ولا تدخل في مسائل الإيمان والكفر، وهي من العمليات لا من المعقولات. فوجوبها ناشئ من اعتبارٍ عملي تطبيقيّ، وليس من اعتقاد إيماني، فالإسلام لم يولّد السياسة والدولة من حيث إنهما ضروريتان للإيمان، وإنما من حيث هما نتائج جانبية لنشوء جماعة دينية مع غايات ومصالح ومتطلبات دفاع وتنظيم وإدارة جديدة أيضًا.
8- ما رأيك في الكتائب السلفية أمثال “جبهة النصرة” و”أحرار الشام”؟
الحكم على جماعة أو تنظيم يتطلب توفر معلومات كافية وموثقة عنه وعن أفكاره ورؤيته وممارساته وتكوين أفراده، وهذا ما لا يتوفر لي شخصيًّا، ولذلك من الصعب الحكم عليه. ثم إن المنهج الإسلامي يعلمنا أن الحكم يتناول الأفكار والممارسات لا الأعيان أو الأفراد في أنفسهم، ولذلك يمكننا أن نطلق أحكامًا على السلوك الفلاني أو الفعل الفلاني، فنقول: من فعل كذا فهو كذا، ومن قال كذا فهو كذا، من دون توجيه حكم إلى معيَّنٍ باسمه وشخصه. ولذلك يمكنكم السؤال عن أفعال محددة أو ممارسات بعينها وعندها يمكنني الجواب.
9- ما رأيك ببيان إعلان الدولة الإسلامية الذي نادى به عدد من الكتائب المقاتلة للنظام في مدينة حلب؟
استمعت إلى الإعلان كما استمع غيري، وأرى أنه خطأ فادح في حق الدين والثورة، ففضلاً عن أن الدولة الإسلامية تحتمل كلامًا طويلا في مشروعيتها، وطبيعتها، وشكلها، وآليات عملها، وكيف تقوم؟، ومن يقوم عليها أو من هو المؤهّل لذلك؟ ومن يملك الحق في إقامتها؟ فإن مثل هذا الإعلان هو افتئات على الأمة، وعلى الشرع من قبل مجموعة صغيرة هنا أو هناك أرادت أن تصادر إرادة الشعب. ولذلك لا شرعية لهذا الإعلان، لا شرعية دينية ولا شرعية سياسية، ولا شرعية واقعية. فالأفكار والمشاريع لا تقوم بمجرد الإعلان عنها!. وقد أُثر عن الشيخ حسن البنا رحمه الله مقولة تقول: “أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم”.
10- هل من واجب الدولة الاسلامية تنظيم العلاقة بين العباد ورب العباد أم تنظيم علاقة العباد بين بعضهم وبعض وفق ما يقتضيه الشرع والعرف؟
الإسلام دينٌ يقوم على المسؤولية الفردية، والوازع الديني، والضمير الفردي، وتتحدد المسؤوليات والجزاء والثواب والعقاب فيه بناء على المسؤولية الفردية أصالةً، وعلى المسؤولية الجمعية في مسائل الشأن العام. “كل امرئ بما كسب رهين”، فالكسب الفردي أو العيني عليه مدار عامة أحكام الشريعة، ولكن فرّق الفقهاء بين نوعين من الواجبات: الواجبات العينية والواجبات الكفائية، فالواجب العيني يُخاطَب به الأفراد، والواجب الكفائي تخاطب به الجماعة كلها، فإذا ترك الفرد الواجب العيني يأثم بمفرده، وإذا تركت الجماعة الواجب الكفائي تأثم الجماعة كلها. والواجب الكفائي مثل صيانة المصالح العامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الأمر وليس التغيير)، وإقامة الشعائر (كصلاة العيدين وغيرها)، وسد حاجات المجتمع التي تساهم في تنميته وتطويره وسد حاجات المحتاجين فيه وإعانة المظلومين، إلى غير ذلك. ولا بد من التنبيه هنا إلى مسألة على غاية الأهمية، وهي أن خطاب الله تعالى (في القرآن الكريم) تَوجه إلى الجماعة، وليس إلى الدولة، فالله خاطب المسلمين والمؤمنين والناس أفرادا وجماعةً، فالذي يقوم بحفظ الدين ورعايته وإقامة أحكامه هو الفرد والجماعة، بغض النظر عن الدولة وطبيعتها وعدل النظام فيها وجوره. ولا دخل للدولة إطلاقًا في علاقة المرء بدينه أو بربه؛ إلا من حيث واجباتها ووظائفها التي توجب عليها أن تكفل لمواطنيها حرية أداء الشعائر، وتنظيم مسائل أداء الفرائض من صلاة وحج وغيرهما من حيث التنظيم والإدارة فقط كبناء المساجد وتسهيل إجراءات الحج ونحوها. فالإسلام امتاز عن المسيحية – مثلاً- في أن العلاقة بين الرب والعبد علاقة مباشرة لا وسيط فيها، شخصًا كان (تحت أي مسمى) أو دولةً. “وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان”.
11- هل يجب أن يكون الدين منظِّمًا للحياة أم أن تكون الحياة للدين؟
الإنسان يشغل مركز الخطاب الإلهي، والإنسان هو محور أساسي من محاور القرآن الكريم، وعليه فإن الدين جاء لمصلحة الإنسان ولم يأت الإنسان من أجل الدين. وهذا المعنى يتجلى في مظاهر عديدة، منها أن النبوة مرحلة لاحقة على الخلق أو جَعْل الخليفة، وأن المُكرَه على الكفر يجوز له التلفظ بالكفر لصيانة نفسه، وأن الله سبحانه شرّع أحكامًا تسمى “أحكام الضرورة” يباح فيها بعض المحرمات صيانةً للنفس من الهلاك، كما أن الفقهاء نزّلوا بعض الحاجات منزلة الضرورات فأباحوا لأجلها بعض المحظورات كالقرض الربوي لحاجة السكن في الغرب – على رأي البعض -، وقد شرّع الله أحكامًا خاصة في السفر والمرض للتخفيف عن الإنسان ورعايةً لقدراته ومصالحه، وأن الشريعة كلها جاءت لجلب المصالح للإنسان ودفع المضار عنه، وغير ذلك. وقد عبر الإمام الغزالي تعبيرًا دقيقًا عن هذا المعنى فقال: “مقصودُ الشَّرع من الخَلْق خمسةٌ: أن يحفظ دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم”، بمعنى أن الشرع جاء لتحقيق مقاصد ومصالح الإنسان. وقد قال الإمام الشاطبي: إن هذا مَرعيّ في كل مِلة. والدين هنا في معناه الكلي، وهو ليس مفصولاً عن الإنسان نفسه، فلا وجود للدين بغير الإنسان. فالوظيفة الأساسية للدين أنه جاء لهداية الإنسان.
12- هل الشريعة هي الحدود والأحكام فقط؟ أم هي تلك المنظومة الاجتماعية التي ينادي بها الدين من عدل وأخلاق وحق؟ وهل هناك مراجعات قام بها الكثير من علماء الدين المعاصرون لهذا المفهوم؟
الشريعة كمصطلح قديم، ولكنه كثر وشاع في ثمانينيات القرن الماضي من خلال استعمال الحركات الإسلامية (الإخوان المسلمين خاصة) له في مواجهة الأنظمة القائمة في عالمنا العربي، وهناك فرق بين الشريعة والفقه، فالفقه هو التراث الفقهي الذي كان حصيلة عمل الفقهاء على مدى قرون متطاولة بدءا من القرن الثاني الهجري، أما الشريعة فتُطلق على تلك الأحكام القطعية أو على الوحي نفسه بمعزل عن الاجتهادات البشرية القائمة عليه أو اللاحقة به أو الشارحة له أو المفصّلة لأحكامه، وقد تختلط الشريعة بالفقه في استعمال الحركات الإسلامية أو الخطاب الإسلامي المعاصر، ولكن الشريعة متَضَمَّنة في الفقه نفسه. ونتيجة النقص في العلم أو الغموض في التصور، أو نتيجة تَحَوّل مقولة “تطبيق الشريعة” إلى مقولة شعبية إلى حد ما، تَوهم بعض الناس أن الشريعة هي الحدود فقط، ولكن الشريعة هي منهج حياة للمسلم تبدأ من باب العقائد مرورًا بالعبادات والمعاملات وانتهاء بالأخلاق والآداب وبعض مسائل الفقه السياسي الكلية. ولا تشكل الحدود سوى مسألة جزئية من مكونات الشريعة، وليست هي الشريعة، والكلام عن الحدود ومفهومها ووظائفها وشروط تطبيقها وخلاف العلماء فيها، ودعوة البعض إلى تعليقها، وتأويل آخرين لها، وهل يغني عنها القوانين المعاصرة، تفصيلات كثيرة ليس هنا مجالها ولا وقتها. 14- ما مفهوم تطبيق الشريعة عمليا؟ مقولة (تطبيق الشريعة) مقولة حديثة أيضًا نشأت مع حركة الإخوان المسلمين، وهي مقولة تشتمل على اعتقادٍ بمُسَلَّمتين، الأولى: أن الشريعة انقطعت عن المجتمع ولا بد من إعادتها، والثانية أن الدولة هي التي تحفظ الشريعة لا المجتمع أو الأمة. وهذه المقولة هي جزء من المشروع السياسي الإسلامي الذي طرحته جماعة الإخوان في معارضتها للأنظمة الحاكمة. وفي الواقع الحالي والتاريخي، فإن الحديث عن استمرارية الشريعة أمر سائغ، فلا يوجد حتى الآن إعلان أو تقنين عام لا يعبأ بالتراث الفقهي، وهذه الانقطاعات هنا وهناك، سواء في الممارسة الحكومية أم الممارسة الشعبية أمر طبيعيّ وليس هو المعنيّ حين الحديث عن انقطاع في الشريعة، بل المعنيّ انقطاعها على مستوى التطبيق القانوني على مستوى الدولة، وبشكل كلي قانوني وليس بشكل “انحراف”، وهو الأمر الذي لم يتم التنبه له. ويمكن تأريخ بداية انقطاع “الجانب القانوني” للشريعة بمرحلة الإصلاحات العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي، والتي تمت بعد الاحتكاك بالهيمنة الأوربية العسكرية والاقتصادية؛ الأمر الذي فرض إعادة التفكير بالإسلام في البلدان العثمانية سواء على مستوى النخب الفكرية، أم على مستوى النخب الحاكمة، حيث تعرضت فكرة “تفوق الإسلام الحتمي” إلى زعزعة بفضل صدمة الواقع. وهنا بدأت محاكات الأوربي المهيمن، ولم تكن تلك المحاكاة لتقف عند حدود التفكير ببناء جيش جديد بدل الانكشارية الواهنة، بل تعداه إلى المجالات القانونية والمدنية، بهدف تشكيل دولة حديثة في البلاد العثمانية، وبموازاة ذلك كانت نجاحات محمد علي في مصر الساعي إلى بناء دولة عصرية كذلك. ولكن فيما عدا الجانب القانونيّ للشريعة، لا يمكن بل لا يجوز الكلام عن (انقطاع الشريعة) لأن الذي يحفظ الشريعة هو الأمة وليس الدولة أو النظام أو الحاكم، فقد عرف التاريخ الإسلامي والعلوم الإسلامية استمرارية للتطبيق العملي للإسلام، وهو ما عُرف بالتعبير الحديث باسم “التقليد الحي”، أو بتعبير الفقهاء باسم “العمل”، أو بتعبير المحدّثين باسم “السنة” بمعنى العمل، وبالرغم من اختلاف المعنى بين هذه المصطلحات الثلاثة فإنها تشير في مجموعها إلى معنى مشترك وهو أن الأمة في مجموعها تحتضن الشريعة في ممارساتها العملية وتواظب عليها بالرغم مما قد يطرأ هنا أو هناك من انحرافات ولكنها تبقى جزئية وتبقى انحرافات وليست انقطاعا، فقد دالت دولٌ وبقي التقليد الإسلامي الحي مستمرًّا، وعنه نشأت العلوم واستمر حفظ القرآن، وبقيت الشعائر، وغيرها.
13- دعوتَ سابقًا لتطبيق الشريعة في النفوس قبل تطبيقها على المجتمع. رأى البعض أن هذه العبارة تعني أنه لا يمكن تطبيق الشريعة على الإطلاق. هل تعتقد أنه حتى في مجتمع الصحابة كان الناس يطبقون الشريعة في نفوسهم قبل أن تطبق على المجتمع؟
أولاً عَنيت بالنفس هنا ليس مكنونات النفس، وإنما مبادرة كل فرد بتطبيق ما يَلْزمه من أحكام الشرع، لأنك قد تجد مَن لا يطبق عُشر معشار الشريعة في سلوكه الفردي يخرج في مظاهرة يطالب بتطبيق الشريعة، وهو تاركٌ لما هو في مُكْنته وما لا يحتاج في تطبيقه إلى إذن أحد ولا إلى إعلان!. وهذا يدخل في قوله تعالى: “لمَ تقولون ما لا تفعلون؟! كَبُر مَقْتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون”. ودعوتي التي كانت عبر تعلق على صفحتي الشخصية، جاءت ردًّا على “إعلان الدولة الإسلامية” من قبل جماعة محدودة، والمقصد من وراء تلك المقولة أن الشريعة – في مجملها وعامة أحكامها – يقوم بتطبيقها الأفراد والجماعة المسلمة بدافع التكليف الفردي والجماعي الذي توضحه الفروض العينية والكفائية من جهة، والسنن والآداب من جهة أخرى، فالقرآن -كما سبق – يخاطب الأفراد ويخاطب الأمة لا الحاكم ولا الدولة، ومن ثم لا تتعطل أحكام الشريعة لعدم وجود دولة، أو لوجود نظام لا يلتزم بالإسلام مثلاً. الجزء الوحيد الذي يختص بالدولة هو الجانب القانوني للشريعة كما سبق، وحتى هذا لا يتم تعطيله لغياب السلطة مثلاً، بل هناك بدائل فقهية له، فالشريعة لا تتوقف على وجود حاكم أو غيابه كما أوهم ذلك بعض مفكري الإخوان المسلمين ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي في بعض كتبه. والشريعة لا تؤخذ جملة أو تُترك جملة كما توهم سيد قطب رحمه الله، بل هي – في مجال التطبيق – تؤخذ على قدر الوسع، وبقدر الطاقة، وهي في أحكامها وفلسفتها على مراتب، فهناك الكُمّل وهناك المقصرون، وهناك أهل العلم والفقه وهناك العامة، وينال كلٌّ من الشريعة على قدر علمه وفقهه، وعلى قدر وُسعه، وعلى قدر همته، فطوبى لأصحاب الهمة العَليّة. وفيما يخص الصحابة الكرام، فمن المعروف أن القرآن نزل مُنَجّمًا أي مُفَرَّقًا، وأن الصحابة كانوا يتدرجون في التطبيق بحسب الآيات، فإذا نزلت جملة آيات حفظوها وعملوا بها ثم انتقلوا إلى ما بعدها.
14- الحريات الشخصية في الدولة الإسلامية أو دولة ذات مجتمع يغلب عليه التدين مثل المجتمع السوري هل يجب أن تكون مطلقة أم محدودة بما يقتضيه الشرع والعرف؟
لا يوجد ما يسمى حريات مطلقة وإلا لبطلت القوانين عامة، وفي الوقت نفسه لا ينبغي أن ننشغل كثيرًا بتقييد الحريات الغائبة أصلاً حتى الآن مخافة الفوضى أو مخافة مخالفة الشريعة أو بعض تصوراتنا عنها، مسؤولية العلماء والدعاة أن يُربوا الضمائر وينبهوا إلى الانحرافات، ويرسموا النموذج الأمثل طريقًا وطريقةً، والحرية متروكة للناس “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، والمسلم في تعريف الفقهاء هو “مكلّف”، أي أنه حر بالغ عاقل، والجزاء مرتبط بمدى حريته لا بإكراهه على الطاعة أو المعصية، ولكن بالمقابل يجب أن يكون هناك رعاية لما يسميه الفقهاء وغيرهم “العُرف الصحيح”، وما يسمونه “المجاهرة” بالمعصية، وقد يتوهم البعض أن هذا نوعٌ من النفاق، ولكنه فهم مغلوط، وأصل المسألة يرجع إلى قوله تعالى: “إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا …”، فشيوع الفاحشة وخصوصًا بالنسبة للرموز المحترمة اجتماعيًّا يُجَرّئ على المعصية، لأنه يكسر حاجز الرهبة، ولذلك لم يكن غريبًا أن يأتي الخطاب لنساء النبي مختلفًا بالقول: “يا نساء النبي لستن كأحد من النساء”، أي في المنزلة وفي الخطأ. فيجب أن يكون ثمة حرصٌ على “الحرمات العامة” للإسلام، أو ما يسمونه بلغة اليوم “الذوق العام”، وهي موازنة بين الحق الخاص والحق العام، ولكن ذلك لا يعني بحالٍ تتبع عورات الناس أو حرياتهم الشخصية، أو إكراه غير المسلمين على ما لا يعتقدون حرمته من شرب الخمر وغيره وقد نص الفقهاء على ذلك.
15- يدافع البعض عن حوادث تحطيم بعض القبور المنسوبة إلى بعض الكتائب الإسلامية، بذريعة أن خير القبور الدواثر، ولا يجوز التعلق بالقبور وأصحابها، ويستنكرها آخرون بذريعة انتهاك حرمة الأموات وعدم جدوى إزالة القبر في إلغاء تعلق الناس بالقبور. وقد وُجدت بعض المقاطع المصورة توضح الاعتداء على بعض الحسينيات في إدلب. ما حكم ذلك شرعًا؟
الاعتداء على القبور عامة هو اعتداء على حرمة الأموات، وفاعلُه آثم شرعًا؛ لأن حُرمة الميت كحُرمة الحيّ سواءً بسواءٍ، بأي وجه كان الاعتداء. واذا كان الميت عالمًا جليلا – مثلاً – فالإثم مضاعف: إثم الاعتداء على الميت، وإثم الاعتداء على أهل العلم والصالحين. وبخصوص هذا الفعل – أيًّا كان الفاعل وسواءٌ صحّت نسبته لبعض الكتائب أم لم تصح، وقد حصل مثله في ليبيا بعد الثورة فعلاً – هو جهل بالدين وتعاليمه، فمهمة الدفاع عن الدين من وظيفة أهل العلم وليس غيرهم، وإذا كان هناك منكر حقيقةً فإزالة المنكر لها درجات ثلاثة، ولذلك شروط عند أهل العلم، أولها أن يكون منكرا مُجمَعًا عليه. وأن تكون إزالته بطريق شرعي، وأن يكون مُزيله من أهل الاختصاص والولاية وليس للعامة، وألا يترتب على إزالته منكر أشد منه. وقد سُئل الإمام الفقيه ابن القاسم تلميذ الإمام مالك: “هل كان مالكٌ يُوَسّع أن يصليَ الرجلُ وبين يديه قبر يكون سُترةً له؟ قال: كان مالك لا يرى بأساً بالصلاة في المقابر، وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله. قال: وقال مالك: لا بأس بالصلاة في المقابر. قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة”. وفيما يخص الحسينيات – بغض النظر عن الفاعل الذي لم نتوثق منه حقيقةً – فإن الأصل العام المقرر في الشريعة هو احترام بيوت العبادة عامةً لليهودي والمسيحي والمسلم، وأن كل مكانٍ يُذكر فيه اسم الله له خصوصية، ويدخل في عموم قوله تعالى: “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها” . والله تعالى أعلم.