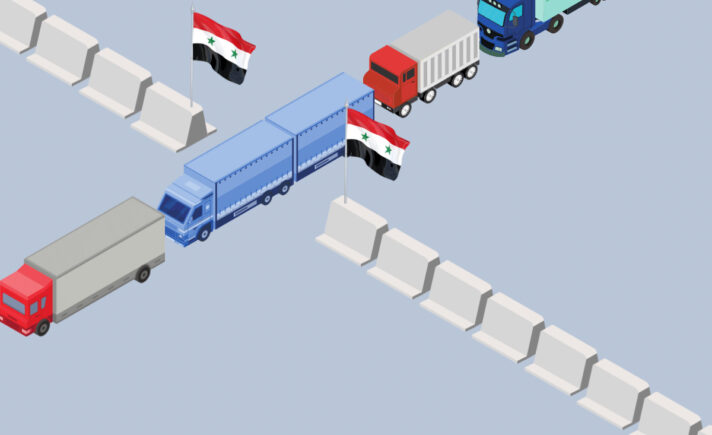قبل حلول نهاية العام 2023، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد المرسوم 38، الذي قضى بحل وزارة شؤون الرئاسة لتحل محلها «الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية». ثمة الكثير ممّا يمكن قوله حول هذا المرسوم، لكن هذه المقالة ستهتم بالمادة 12 منه، التي أحالت جميع العاملين في وزارة شؤون الرئاسة ومكاتب رئاسة الجمهورية وكل مستشاري الرئيس للعمل تحت مظلة الأمانة الجديدة. وبعد صدور المرسوم تمّ تداول أنباء عن اختيار منصور عزام، وزير شؤون الرئاسة السابق، لمنصب الأمانة العامة للرئاسة في عدد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، لكن دون نشر مرسوم تعيينه في وسائل الإعلام الرسمية أو الجريدة الرسمية حتى اللحظة، إلا أنّ أخباراً نشرتها صحيفة الوطن المقربة من النظام قُبيل نهاية العام الماضي تضمّنت الإشارة لعزام باعتباره الأمين العام للرئاسة تؤكد تلك الأنباء.
ورغم استحالة المعرفة الدقيقة بما يجري في أروقة القصر الجمهوري بخصوص هذا المرسوم والدوافع وراءه، ومع أخذ إمكانية أن تكون الخطوة تعبيراً محضاً عن حبّ الأسد للشكليات ورغبته في أن يظهر كمُمارسٍ للسلطة يُنظّم أذرعها التنفيذية، إلا أن ثمة مؤشرات إلى أن الدافع قد يكون السعي للحدّ من نفوذ مكتبٍ أصبح العقل المدبر للاقتصاد السوري في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية؛ المكتب المعروف شعبياً باسم «المكتب السري» أو «المكتب المالي»، والذي تديره نخبة مقربة من بشار الأسد وزوجته أسماء، وتشرف الأخيرة عليه بشكل مباشر. من غير المستبعد أن تكون الإشارة إلى المكاتب التابعة لرئاسة الجمهورية في المادة 12 من المرسوم، وقرار ضمّها إلى صلاحيات الأمانة العامة للرئاسة، محاولةً للحد من نفوذ هذا المكتب بالذات، الذي كشفت الجمهورية.نت قبل عامين للمرة الأولى عن آليات عمله وارتباطه بالقصر الجمهوري، بعد أن كان اسم المكتب السري سبباً لالتباس المعلومات والخلط بينه وبين مكتب آخر، تابع لإدارة الجمارك وكان قد توقَّفَ عن العمل في العام 2009.
ما الذي يفعله المكتب المالي؟
يتحكم المكتب المالي التابع للقصر الجمهوري، أقلّه حتى هذه اللحظة، بكل مفاصل الاقتصاد في البلاد، كما يشرف على قطاعات بعينها بشكل مباشر من خلال أشخاص مقربين أو يعملون في هذا المكتب. وقد كشف تحقيق أعدّه مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية في سوريا، بالاشتراك مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة، عن امتلاك يسار إبراهيم، الذي يعد أحد الشخصيات الأساسية في المكتب المالي، أسهُماً في شركة وفا تيليكوم للاتصالات -إلى جانب شركة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني-. وقد حصلت وفا تيليكوم على ترخيص المُشغّل الثالث في سوريا قبل عامين، بالإضافة إلى حصولها على رخصة التشغيل الحصري لشبكات الجيل الخامس من الاتصالات لعدة سنوات قبل السماح للمشغلين الأقدم بتفعيلها.
كما أشارت تحقيقات صحفية أخرى إلى احتكار شركة إيما تل (المملوكة لأبو علي خضر، أحد أعضاء المكتب المالي) لعمليات توريد أجهزة الهاتف المحمول إلى سوريا ضمنياً، وذلك بعد صدور قرارات بوقف الاستيراد لم تشملها عملياً، وهو ما جعلها المتحكم الرئيسي بسوق تلك الأجهزة في سوريا. هذا عدا عن حصول أشخاص مقربين من يسار إبراهيم وأبو علي خضر على حصص كبيرة في العديد من الشركات الجديدة والأقدم في السوق السورية، ليظهر أشخاص مثل علي نجيب إبراهيم كأحد الأسماء الثابتة في ملكيات الشركات التي تحصل على عقود حكومية أو تحتكر نوعاً من التجارة في البلاد، مثل تجارة ألواح الطاقة الشمسية التي أصبحت من الضروريات في سوريا نتيجة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.
إلى جانب تلك الاحتكارات، قام المكتب المالي طوال سنوات عمله المعروفة لنا بعمليات ابتزاز دورية للتجار والصناعيين من مختلف الفئات، وذلك بهدف الحصول على إتاوات ونسب من أرباحهم كان حسابها دوماً بأثر رجعي لسنوات مضت. وقد كان الاعتقال لدى فرع الخطيب في دمشق (اسمه الرسمي الفرع 251 التابع لإدارة المخابرات العامة المعروفة باسم أمن الدولة) مصيرَ من لم يمتثل لدفع الإتاوات التي يطلبها المكتب المالي.
وفي مستهلّ عمل المكتب المالي، استُهدِفَ رجال أعمال كبار ظهروا خلال سنوات ما بعد الثورة مثل سامر فوز، وآخرون أقدم استمرّوا في العمل بعدها مثل طريف الأخرس. وتقول مصادر متطابقة للجمهورية بأنّ الاثنين قد خسرا القسم الأكبر من أعمالهما لصالح المكتب المالي، وذلك بعد رفضهما دفع مبالغ كبيرة قُدِّرَت بعشرات ملايين الدولارات على الأقل.
وقد تأسَّست المرحلة الأولى من عمل المكتب المالي على إعادة تركيز الثروات الكبيرة بيده، وبالتالي بيد أسماء الأسد. لكنّ ذلك لم يكن كافياً على ما يبدو، إذ توجَّه المكتب المالي في المرحلة الثانية إلى الصناعيين والتجار المتوسطين، الذين يشكلون المحرك الاقتصادي الحقيقي في البلاد منذ التسعينات، ويُشغِّلون النسبة الأكبر من اليد العاملة. وقد دفع هذا الأمر كثيرين منهم إلى الخروج من البلاد أو إغلاق مشاريعهم، نتيجة تضخم الإتاوات التي يدفعونها وعدم قدرة السوق على تعويضهم عنها.
عانى الاقتصاد السوري منذ العام 2019 من أزمات متكررة طالت قطاعات الطاقة والصناعة وغيرها، لكنّ العام الماضي شهد الانهيار الأكبر حسب ما تدلّ عليه الوقائع في ظل عدم وجود أرقام دقيقة. وقد يكون الاستدلال على هذا الانهيار ممكناً عبر مراقبة انهيار العملة المحلية، التي خسرت العام الماضي أكثر من نصف قيمتها، ذلك بعد أن كانت قد تراجعت في الأعوام الثلاثة التي سبقته لمستويات قياسية، لتصل اليوم في بورصة التداول ضمن السوق السوداء إلى أرقام تعدَّت 15 ألف ليرة سورية أمام الدولار الواحد، بعد أن كانت قيمتها نهاية العام 2019 تعادل 900 ليرة سورية أمام الدولار.
قد يكون للعقوبات تأثيرٌ على تسارع هذا الانهيار، لكنّ ذلك لا يفسر كل شيء، إذ تخضع سوريا للعقوبات منذ الثمانينات، وقد أصبح الاقتصاد السوري نتيجة تلك العقود من الخبرة أكثر مرونةً في التعامل مع العقوبات والالتفاف عليها. كما أنّ الاقتصاد السوري كان قد خسر شركاءه الكبار في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011، ما يعني أنّ مسببات الانهيار منذ العام 2019 ليست خسارة أسواق التصدير تلك (ويمكن المحاججة بأنّ التجارة غير الشرعية، التي يأتي تصدير مخدر الكبتاغون على رأسها، قد أكسبت السوق السوري أسواق تصدير جديدة).
الأسوأ لم يحصل بعد
إلى جانب العقوبات التي لا تفسّر كل شيء إذاً، فإنّ المُتغيّر الأساسي في الاقتصاد السوري خلال السنوات السابقة كان تفعيل عمل المكتب المالي، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وفق إرادة أسماء الأسد وتابعيها في هذا المكتب، والأساليب التي اتّبعوها للسيطرة على جميع مفاصل الاقتصاد، والابتزاز الذي مارسوه لتأمين القطع الأجنبي لخزينة النظام الفارغة بوسائل يبدو أنّها أخافت جزئاً كبيراً من الصناعيين والتجار المتوسطين، المسؤولين بمجموعهم عن نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في سوريا. وهذا ما أدّى عملياً إلى انكماش الاقتصاد في البلاد بشكلٍ متسارع، وأدّى بالنتيجة إلى أن تكون ميزانية سوريا لهذا العام، وفق سعر الصرف في السوق السوداء، لا تتجاوز 2.5 مليار دولار، وهي أقل من نصف ميزانية العام السابق، وحوالي 15 بالمئة من ميزانية سوريا في العام 2010، التي بلغت 16.55 مليار دولار.
وضعت سياسات المكتب المالي الاقتصادية مناطق سيطرة النظام السوري، للمرة الأولى منذ العام 2011، على شفا حفرة عدم قدرة النظام على دفع الرواتب للموظفين الحكوميين. وقد تكون النتائج الكارثية لهذه السياسات قد أخافت بشار الأسد، لأنها قد تؤدي إلى عدم قدرة نظامه على تسيير أمور الدولة ولو شكلياً وبالحد الأدنى، ما يعني عملياً تهديداً لاستمرار حكمه، خاصةً في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها داعموه، تحديداً موسكو العالقة في حرب استنزاف منذ أعوام بعد بدء غزوها لأوكرانيا.
قد تكون هذه الأوضاع هي ما دفع رأس النظام لإعادة التفكير والنظر في السياسات الاقتصادية للبلاد، ومن ثم تغيير مراكز القوى المُمسكة بتلك السياسات من خلال مدّ سيطرة الأمانة العامة للرئاسة على جميع المكاتب والمستشارين التابعين لرئيس الجمهورية. فإذا كان هذا هو التفسير، أي إذا كانت مراجعةٌ للسياسات الاقتصادية الكارثية هي التي تقف فعلاً وراء المرسوم، فإنه خطوة جاءت متأخرة كثيراً على الأغلب، ذلك أنّ الثقة التي فقدها المُنتجون المتوسطون والصغار بشأن مدى قدرتهم على الاستمرار في العمل بالطريقة التي كانوا يعملون بها سابقاً، والتي وفّرت فرص عمل ومنتجات محلية رخيصة للسوريين، لا يمكن استعادتها بسهولة.
لطالما اعتمد الاقتصاد السوري على استثمارات رجال الأعمال السوريين، لا على الاستثمارات الخارجية ولا على استثمارات رجال السلطة، وفي ظلّ غياب هؤلاء اليوم يبدو أن تَسارُع الانهيار سيقود البلاد إلى أوضاع مخيفة للغاية بالنسبة لأي سوري، سواء كان مقيماً في البلاد أم راحلاً عنها وله فيها أهلٌ وأحباب.