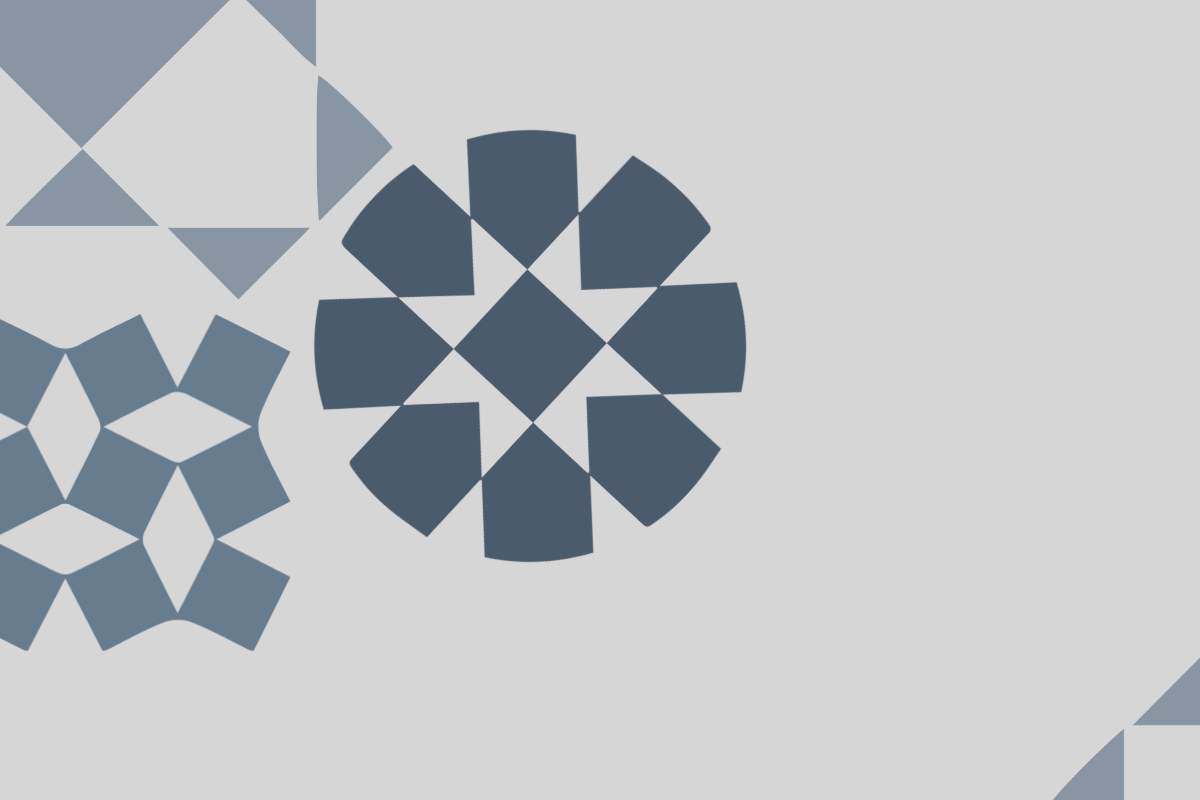ثمة أسئلة مُلحّة يطرحها إخفاق الربيع العربي، وعدم وصوله إلى مآلات سياسية وحقوقية تتناسب وطبيعة تحركه، فالحقوق المدنية والمواطنية، بما يقود إلى عدم التمييز على أساس ديني أو هوياتي أو طائفي أو جندري، شهدت غياباً أو تغييباً قسرياً ترافقَ مع صعود الأصوليات الدينية، ومع رفع درجة التجييش والتعبئة ضد كل من يقف على النقيض من رؤية أصحاب هذه الأصوليات كما هي في أدبياتهم الإسلاموية.
بشكل أساسي، يستند هذا المقال في مقاربته لهذه المسألة على تجربة الربيع العربي في نسخته المصرية.
الدين والإيدولوجيا: الصراع على امتلاك المُقدَّس
لكن هل يمكن القول إن الإسلاميين انخرطوا في عنف رمزي فقط، من خلال الخطاب مثلاً؟ أم أن هناك ممارسات عملية تورَّطوا فيها عبر التحريض والعنف عملياتياً، أو حتى من خلال محاولة شرعنة قوانين تمييزية، بخاصة في مرحلة حكم الإخوان في مصر وفوزهم بأغلبية برلمانية، وتسيُّد حركة النهضة في تونس (فرع إخوان تونس) برئاسة راشد الغنوشي.
علاقة الدين بالسياسة والأحداث الكبرى كالثورات والتغييرات الاجتماعية ليست أمراً جديداً أو مباغتاً، إذ إنّ التاريخ يسجل لنا عدّة مقاربات، منها الموقف التنويري السائد في الأدبيات الفلسفية وصولاً إلى الفيلسوف الألماني هيغل في القرن الثامن عشر، الذي كان عدائياً وراديكالياً يعتبر أن الدين هو سبب الرِّدة التاريخية، وأنه يتعيَّن إجهاضه وعزله من أجل التطور. بعبارة أخرى، القطيعة مع الدين تؤدي (ربما ميكانيكياً) إلى التطور بحسب هذا المنظور. غير أن الاتجاه الآخر الذي تبنّاه فلاسفة آخرون، أبرزهم الفيلسوف الألماني كارل ماركس، هو أن الدين له دور وظيفي، وأنه يعكس مصالح الفئة التي تتولى الحديث باسمه، ويكشف عن درجة التطور الاجتماعي والحضاري والشرط التاريخي. لذا، قد يكون الدين أحد مسوغات القهر والقمع، وغلبة فئة أوليغاركية تملك السلطة والثروة بينما باقي الشعب يرزح تحت سياط العَوَز والتهميش. وهنا انخرط ماركس، خلافاً لسابقيه، في نقد الحقوق والسياسة بدلاً من نقد اللاهوت والسماء، حتى يتمكَّنَ من فضح عمليات النهب والاستلاب الذاتي للإنسان بواسطة أنماط تتخذ أشكالاً مقدسة على نحو خَفيّ ومُتوهَّم.
في فترة عصر الأنوار في أوروبا، بأفكارها وممارساتها القروسطية، كانت الهيمنة الدينية الكنسية في حالتها الإقطاعية نموذجاً لهذا الوضع العنيف والقمعي. لكن المسيحية، مثلاً، والتي كانت وسيلة لتحريض الفئات المهمشة والعبيد، هي نفسها الأداة التي استغلَّها الإقطاعيون بالتحالف مع الكنيسة لمُراكمة النفوذ وحيازة كافة السلطات وحماية امتيازاتهم. في المحصلة، الدين الذي يُشكِّل ضمن عناصر أخرى بنية فوقية (مع الفن والثقافة) يكون مرتهناً للتطور في وسائل الإنتاج، فهو في جوهره ليس الأزمة، إنما الأزمة في درجة التسييس والأدلجة.
يمكن القول إن أزمة الإسلام السياسي، السياسية والإيديولوجية، تخضع في جانب منها للانسداد التاريخي الذي يجعل رؤيتها ماضوية، ومحصورة في إطار شروط لم تعد قائمة. والواقع أن فقدان الإسلاميين إمكانية الانتقال للشرط الديمقراطي بقيَمه المدنية والمواطنية، أو بالأحرى غياب الخيال والأفق السياسي لديهم، إنما يرجع إلى عدم مقدرتهم على تعيين موقع الدين في الدولة الوطنية الحديثة بما أدى لتعميم الخطاب الأخلاقي الديني بمفرداته التبشيرية. فالهوية الدينية، وتحديداً الإسلامية، ظلَّت هي المرجعية المؤبدة للحكم والتي يجري تعميمها في المجال العام.
يقول شريف يونس في كتابه: البحث عن خلاص.. أزمة الدولة والإسلام والحداثة في مصر؛ إن مشكلة هذا النمط تكمن في اختزال تاريخ معقد ومتعدد للقوى في قصة تدور حول بطل رئيسي، فالرواية الوطنية والإسلامية لتاريخ مصر الحديث بحسبه هي «أشبه بملحمة شعبية تحكي سيرة بطل واحد بلا شريك: إما الشعب/الأمة المصرية (وملحقها العربي)، أو الأمة المسلمة». طمحت كلتا الروايتين إلى تحديد هوية المصريين وإلزامهم بالتماهي مع هذا البطل الوحيد، وتخوين أو تكفير أي روايةٍ أخرى، وأكدت كلتاهما أن ديكتاتوريَّتها وحدها هي «الخلاص النهائي والتعويض الشامل عن كل فشل وهزيمة». وهنا كان الخطاب الديني المؤدلج وسيلة لإنتاج مقولات نظرية كفاحية وتبشيرية، بدلاً من أي خطاب عقلاني. ولذلك ظهرت جدالات عديدة عند كتابة الدستور بعد العام 2011، ترى المسيحيين وغير المسلمين بأنهم أهل الذمة في مقابل قِيَم المواطنة، وتُحدِّد المواطنين على أساس قومي أو ديني، فضلاً عن محاولة تعميم مقولات مثل «الولاء والبراء» في ظل سيادة المؤسسات القانونية والدستورية، والترويج لعقوبات بدنية بِدائية وتصنيفها باعتبارها أحكاماً إلهية تحت مقولة «الحكم بما أنزل الله» مثل قطع يد السارق: كل هذه الأمثلة حدثت في أعقاب الربيع العربي، بل حاول الإسلاميون قطع جلسات البرلمان أثناء الآذان في مصر، وطالب بعضهم بعمل «مجلس فقهي» لتحديد مدى صلاحية القوانين من الناحية الدينية على طريقة «الولي الفقيه» في إيران.
وفي تونس أيضاً ما تزال قضايا الهوية، في بلد شهد درجة عَلمَنة غير مسبوقة في محيطه العربي، تَضغطُ على كافة الأطراف وتبعث باستقطاباتٍ حادة، إذ شهدت جدالاً محموماً بشأن إعادة تعيين موقع الدين في دستور «الجمهورية الجديدة». هذا الصراع القديم، والذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي (دستور 1959) بين التيار الحداثي والزيتونيين، عاودَ الظهور مجدداً بين الطرف الأول وتيار إسلامي عريض يتزعمه «النهضة».
يعزو الباحث والأكاديمي المصري الدكتور شريف يونس، في كتابه نفسه، تنامي أفكار ما عرف بـ«الصحوة الإسلامية» في مصر إلى قدرتها على «وراثة أعداد متزايدة من جمهور خدمات الدولة المتراجِعة». ويعني بذلك أن الشرائح الاجتماعية التي فقدت امتيازاتها في مرحلة الانفتاح الاقتصادي تحت حكم الرئيس السابق أنور السادات، وجدت في الإسلام الحركي مَلاذاً وقتذاك: «كان تفسّخُ النظام، إيديولوجياً ومجتمعياً وخدمياً، هو مدخل الحركة الهوياتية الإسلامية في انتشارها الاجتماعي ونشر قيمها».
ولم يكن القبول بالديمقراطية والانخراط في العملية السياسية (الانتخابات مثلاً) سوى قبول بجانب محدود، على المستوى الإجرائي وبشكل ذرائعي دون تبني قيم الحداثة المدنية والسياسية والحقوقية. لذا أخفق الربيع العربي، في ظل هذا التناقض، في العبور الآمن إلى فضاء الحرية والتنوع. ومع مرحلة التمكين، كما يسميها الإسلاميون، كان انقلابهم المرير على كل ما سبق عندما شَرَعوا في تحقيق رؤيتهم المنغلقة والشمولية.
المفكر اللبناني حازم صاغية في كتابه رومنطيقيو المشرق العربي، اعتبر أن الدول في مرحلة ما بعد الكولونيالية في الشرق الأوسط تسببت، من خلال دمجها الغامض بين القومية أو العروبة والإسلام، في ظهور خلل بنيوي نتيجة جمع هذه التناقضات المفخخة. يقول: «وفي خلطٍ ما قد يبدو عصياً على الخلط، أُنشِئ في مصر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام 1960؛ أي إبان الوحدة مع سوريا، للتعريف بالإسلام وإحياء تراثه، وصدر المرسوم رقم (57) الذي ضم المساجد الأهلية إلى وزارة الأوقاف. وفي 1961، سَنَةَ صدور القوانين الاشتراكية، صدر القانون الذي أسفر عن إلحاق الأزهر برئاسة الجمهورية، وتعيين وزير لإدارة شؤونه، بعدما كان قد جُرِّدَ في 1957 من استقلاله المالي بتأميم الأوقاف الخيرية. ثم كان دستور 1964، في ذروة العروبية والاشتراكية، فأُعلن، للمرة الأولى، أنّ الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وتعاظم، بالتالي، التركيز على بناء المساجد، وإنشاء المحطات الإذاعية الدينية، والتوسع في نشر التراث الديني، وصدر القانون رقم 89 عاهداً إلى الحكومة تعيين الأئمة والعاملين في المساجد الأهلية، فضلاً عن كتابة وزارة الأوقاف خطبَ الجمعة وتوزيعها على خطباء المساجد. وغدت برامج التعليم الديني أكثر تسييساً وتبعية للرؤية العامة التي تحملها الناصرية للمسائل المطروحة».
كل ذلك أنتجَ جيوباً يمينية تحتاج فقط إلى الشرط التاريخي المواتي للانقضاض على أي حراك، وطرح نفسها كبدائل سياسية بقيمها الثقافية والمجتمعية. وبدلاً من أن يكون الحراك تغييراً للأمام ونحو التقدم، يُضحي رؤية ماضوية عصبية ومُتشنجة.
الإسلام السياسي وبنية التطور الاجتماعي
لا يمكن فهم الصعود السريع والملفت للتيارات الدينية الراديكالية من خلال استنتاجات سهلة لا تسعى وراء الظاهرة بتشكُّلاتها المعقدة، ولا تحاول معرفة أصولها وقوانين انحسارها وفيضانها، فتُحيله إلى وفرة التمويل، مثلاً، من جهات خيرية أو دول معينة، أو إلى اعتبار أنَّ المجتمع بطبيعته يميل إلى التديُّن، بل إن ثمة ضرورة لتفكيك كل تلك المقولات والمزاعم حتى لو افترضنا صحتها بشكل جزئي.
فهناك جذور اجتماعية وتاريخية وسياسية ساهمت في صعود وتقوية حضور تلك القوى الدينية، وشكلت للتيارات الإسلاموية امتدادات وانحناءات واسعة في المجتمع، الأمر الذي يعود إلى بدايات مشروع النهضة الذي درج عليه مفكرون إسلاميون، في محاولتهم للدمج بين التراث والتجديد، والاستدعاء البراغماتي والمؤقت للتراث، منذ القرن التاسع عشر. ولم ينجح ذلك كله في زلزلة الأرض تحت أقدام أي طبقة اجتماعية وسياسية حاولت أن ترهن التراث لتأويلها الخاص، الأمر الذي ساهم في اتّساع آليات التكفير والإدانة والنبذ لكل من يستهدف تحرير التراث من الإيديولوجيا وقطع الحبل السري بين الدين والسياسة. وبقي العقل الإيديولوجي يتسيَّدُ مسارات الفكر العربي، من خلال مقولاته الجامدة، ويعمد إلى التشويش على أي محاولات أبستمولوجية ومعرفية نقدية جادة، وقد خلَّفَ ذلك تأبيدَ واقعٍ اجتماعي وسياسي رثّ ومُشوَّه، بكل ما يترتب على ذلك من مآلات في التفكير والسلوك.
ووفق المفكر المصري علي مبروك في كتابه الحداثة العربية بين العقل والقوة، فالعربي والمسلم يعيش كل منهما في غربة مزدوجة، «تتجلى في وقوف العربي والمسلم على هامش التاريخ عاجزاً عن الإسهام الفاعل فيه، كما تتجلى في عجزه عن الإمساك بجوهره الأصيل». ويرى أن «الأصل في تلك الغربة يكمن في عجزه عن إنتاج معرفة حقه ومنضبطة بهما»، فالإخفاق والتداعي المستمر للتحديث الديني، من ناحية، وفشل تحرير التراث من الإطارات الإيديولوجية الجامدة، والقراءةُ التمجيدية له، من ناحية أخرى، تسببت بهما محاولات تكييف الواقع، بمفاهيمه ومستجداته، مع التراث، ومصادرة الباراديم القديم، ثم خلق قنوات دعاية شرعية لنصبح بصدد عملية «أسلمة» دؤوبة لكافة عناصر الحياة.
وعلى مدى عقود، وفي مواجهة القوى الأصولية والسلفية التي تعتمد الدين في صراعها السياسي وفي صراعها ضد خصومها الفكريين، رافقت محاولات الإصلاح الديني مُصادرةُ الدولةِ الحديثة الدينَ لحسابها، بل وتوظيفه لخلق شرعية وشعبية تستمد منه نفوذها، كما تبرر به إجراءاتها السياسية وتوجهاتها الاقتصادية، وهو الدور ذاته الذي تتحايل عليه قوى الإسلام السياسي، فتعتمد الدين مرجعية لها، وتستخدم الفتوى والمقولات الدينية لتعزيز موقفها السياسي، وتأكيد نسَبه ومدى قُربه من الشرع. بالتالي، تصبح معارضة أيٍّ منهما خلافاً في الدين ذاته وخروجاً على ثوابته. تصفية هذا الدور للدين من استغلاله النفعي والإيديولوجي، بين الدولة ومؤسساتها الدينية المختلفة، وتحريره من كل صراع على السلطة بينها وبين القوى السياسية والحزبية المعارضة، يمثل العتبة الأولى لتجديد الخطاب الديني وتخليصه من الجمود والعنف والتكفير.
أدبيات جماعة الإخوان المسلمين في مصر لم تكف عن إدانة النظام الناصري، ووصفه بأنه «علماني» يقف على النقيض من الإسلام، حيث مهَّدَ جمال عبد الناصر، برأيهم، الطريقَ للتيارات الإلحادية بتعاونه مع الاتحاد السوفياتي ومخالفته للشريعة بتطبيق «الاشتراكية الإلحادية». وهتف عبد القادر عودة، أحد قيادات الجماعة، أثناء محاكمته في ستينيات القرن الماضي بأن «الإسلام سجين»، معتبراً سجنه وجماعته مُصادرةً للإسلام ذاته، فيما لم يتوانَ الداعية الإسلامي محمد متولي الشعراوي هو الآخر ولم يتردد في الإفصاح عن «سجوده لله» بعد هزيمة 1967، لأن الجيش المصري حارب بسلاح الكفار «يقصد الاتحاد السوفيتي سابقاً»، والانتصار كان سيعني حتماً «فتنة» للناس في دينهم ويدفعهم إلى التمادي مع الأفكار المُعادية للدين في المجتمع، فاعتبر الهزيمة عقاباً سماوياً بسبب الابتعاد عن الله. وهكذا يتَّضح كيف يتقاطع موقف الإسلام الحركي مع موقف أحد الدعاة الإسلاميين، وأكثرهم شعبية، في العداء للنظام السياسي، رغم ما يتصف به الأخير من «اعتدال» و«وسطية»!
بالمقابل، لا يمكن أن نغفل أن الدين كان رافداً مهماً، وأحد الدوائر الثلاث التي اعتمد عليها عبد الناصر في بلورة سياساته تجاه فضاءات التنمية والعدالة، كما جاء في كتابه فلسفة الثورة، إذ استخدمه عبد الناصر باعتباره جزءاً من عملية التعبئة الجماهيرية في مواجهة خصومه المحليين «الإخوان المسلمين»، أو خصومه الإقليميين «السعودية»، ثم محاولاته للتوفيق بين الاشتراكية والإسلام. وقد استدعى عبد الناصر دور الأزهر في إطار ما يخدم رؤيته ويدعم توجهاته، فساندته المؤسسة الدينية الرسمية التي دخلت دائرة الصراع السياسي المحتدم، عام 1954، في ما عرف بـ«أزمة الديمقراطية» بين محمد نجيب وعبد الناصر، وخلالها أصدر شيخ الأزهر فتوى تقول إن «الزعيم الذي يتعاون ضد بلاده ويخذل مواطنيه فإن الشريعة تقرر تجريده من شرف الوطن»، قاصِداً بذلك محمد نجيب. كما أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر في بيان عام 1954 «انحراف» هذه العصابة (تقصد جماعة الإخوان المسلمين) عن منهج القرآن في الدعوة، وجاء في البيان أنه «كان منهم من تآمر على قتل الأبرياء وترويع الآمنين وترصّدَ لاغتيال المجاهدين المخلصين وإعداد العدة لفتنة طائشة لا يعلم مداها في الأمة إلا الله».
فيما عمدَ عبد الناصر إلى هندسة الخطاب الديني بما يتلائم مع مخططاته السياسية والإقليمية، وصولآً إلى مطلع الستينيات عندما أقرَّ قانوناً يضمن هيكلة الأزهر بحيث أضحى تعيين شيخ الأزهر في قبضة رئيس الجمهورية. وساهم المفكرون والكتاب كما الأئمة والخطباء في المساجد في تحقيق مقاربة الدين والسياسة لتلك الفترة، الأمر الذي برز مع كتابات مثل اليمين واليسار في الإسلام للمفكر المصري أحمد عباس صالح، والذي صاغ من خلال طرحه رؤيةً نظريةً للدعوة المحمدية باعتبارها تحمل الأعراض ذاتها للثورات التي قادت إلى الاستقلال والانعتاق من التبعية والظلم الاجتماعي بواسطة الاستعمار وقتذاك. وقد كان الدين، تبعاً لرؤية عباس صالح، مُحرِّضاً على التغيير والانتقال إلى شرط تاريخي تتحقق فيه العدالة وتتراجع فيه حِدّة الفوارق الطبقية، مع الأخذ في الحسبان أن جيوباً يمينية دائماً ما تكون داخل أي حراك أو دعوة تبشيرية، وهو ديالكتيك أي ثورة.
ومع أزمة 1954 أو ما تعرف بأزمة الديمقراطية، فنَّدَ الشيخ السبكي عبر دراسة كافة مقولات سيد قطب في كتابه معالم في الطريق، ومنها تجهيل قطب للمجتمع وتكفيره لهم حكاماً ومحكومين، ووَصفَهُ بأنه «متهوس وشبيه بإبليس ويقود الناس للمهالك ليظفر بأوهامه».
غير أن هذه الاستخدام للدين ظلَّ بمثابة توظيف نفعي وهش، لم يُحقِّق رؤية جديدة ومغايرة للفكر الديني من خلال الاعتماد على العلم والمنهج العقلاني، بما يتوافق مع قيم الحداثة ودولة القانون. هذا ما لاحظه صادق جلال العظم في كتابه النقد الذاتي بعد الهزيمة، ويقصد هزيمة 1967، وسقوط المشروع القومي وتهاوي أفكاره. فهذه الهزيمة تسببت تلقائياً في فقدان الدين عناصره الثورية والتنويرية المفترضة، بل لم تجد الرؤية التقدمية المفترضة والتحديثية للدين الحواضن المجتمعية التي تتبناها تحت وطأة «أسلمة» سريعة منذ النصف الثاني للستينيات. فيما تحوَّلَ الدين في لحظة الإخفاق التاريخي (عسكرياً تلك المرة أمام إسرائيل) إلى رجاء يحمي شقاءهم وهزيمتهم الفادحة. فكانت الجيوب اليمينية للثورة قائمة في قلب تناقضاتها، وكان الخطاب الديني جاهزاً ليحل في هذا الفراغ ويُرتِّق التصدعات والشقوق الموجودة.
فالدينُ ظلًّ مغلقاً على أفكاره القديمة والتقليدية، لم يَمسَّ خطابه التقليدي أي تغيير لا تسعى السلطة إلى تنفيذه، وانحصر كمجرد أداة دفاعية يتم تطويعها لنفي عدة تهم تُروَّج ضد السلطة، التي حَشَدت له كافة الوسائل والدعاية اللازمة لأداء مهمة محدودة وقاصرة، الأمر الذي أدى إلى وقوعه في فخ تبني الأفكار غير العلمية والترويج للخرافات.
برز ذلك في حادثة تجلّي العذراء فوق إحدى كنائس ضاحية الزيتون في القاهرة عام 1968، والتي تبنتها وسائل الإعلام وروّجت لها الصحافة باعتبارها ذات مغزى سياسي، وأصدرت الكنيسة المصرية بياناً يؤكد ذلك. وكل ذلك حدث عوضاً عن كشف عوامل الهزيمة وأسبابها الحقيقية عبر نقد ذاتي وصريح، ثم محاسبة المسؤولين عمّا جرى. ذلك ما اعتبرَه المفكر السوري صادق جلال العظم، في كتابه نقد الفكر الديني، أنه استخدامٌ للدين «عكازاً» من قبل بعض الأنظمة التقدمية العربية، لجهة تهدئة الجماهير وتغطية العجز في هزيمتها أمام إسرائيل.
وفي هذه البيئة تهيأت عوامل وشروط استقبال الصحوة الإسلامية وأفكارها في المجتمع، الأمر الذي شهدته مصر في سبعينيات القرن الماضي في ظل حكم الرئيس السادات، والذي كان على النقيض من سلفه، لكن وجه الشبه بينهما هو الإبقاء على موقع الدين ثابتاً في خطوط النظام الدفاعية، واستخدامه مجرد أداة تبريرية وإيديولوجية لشرعنة توجهات السلطة في صراعها مع القوى المضادة، المحلية والإقليمية، والتي كانت في عهد السادات من الناصريين واليسار. فوجد السادات في الإسلام صيغة جديدة بمقدورها أن تدعم توجهاته نحو الانفتاح الاقتصادي والصلح مع إسرائيل، مثلما تقديم صيغة منه تتوافق مع الاشتراكية في عهد سابق.
كمون السلفية في الواقع المصري
يشير الباحث الفرنسي في شؤون الحركات الإسلامية، ستيفان لاكروا، في بحثه المنشور عبر مركز «كارنيغي»، أن ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، ضد الرئيس السابق حسني مبارك، أخذت الدعوة السلفية إلى حالة إرباك وتردد شديدين؛ فالشيوخ لم يعتقدوا البتة بأن التغيير يمكن أن يولد من رحم السياسة، ولذا نددوا بالحدث، في البداية، بوصفه فتنة، وحثوا أتباعهم على عدم الانخراط في الاحتجاجات، والحال أن الدعوة لم تلتحق بمطالب التغيير إلا قبل أيام قليلة من سقوط مبارك.
وكما حدث مع جماعة الإخوان، التي تعرضت قيادتها إلى انتقادات داخلية بسبب عدم اقتناعها بالثورة في أول أيامها، شهدت الدعوة السلفية انتقادات داخلية مماثلة، وكان من بين الذين وجهوا تلك الانتقادات، كما يشير لاكروا، الدكتور عماد عبد الغفور، وهو طبيبٌ لعب دوراً حاسماً في تأسيس الدعوة السلفية في أواخر سبعينيات القرن الماضي. بعد أيام قليلة من تنحية مبارك، قرَّر عبد الغفور الذي أكد بأنه كان من أوائل الداعمين للثورة، أن في الأفق حقبة ثورية جديدة، ما يُحتِّم على السلفيين أن يكون لديهم حزبهم السياسي الخاص كي يكون لهم دور في عملية الانتقال، وبالتالي، دأب على مقابلة الشيوخ الواحد تلو الآخر، وأقنعهم في نهاية المطاف بالسماح بتشكيل حزب النور السلفي.
ويلفت الباحث الفرنسي إلى أن أكبر المفاجآت في حقبة ما بعد الثورة في مصر، لم تكن الفوز الانتخابي لجماعة الإخوان المسلمين، فهذا ما توقعه كثيرون، وإنما بروز حزب النور السلفي، الذي تأسس في حزيران (يونيو) 2011، كمنافس قوي للإخوان، وكثاني أكبر حزب في البرلمان.
يضيف: «صحيح أن الشيوخ السلفيين الذين يقفون وراء الحزب، ينتمون إلى جماعة دينية تُدعى الدعوة السلفية، لها مواقف دينية شديدة ضد الجماعات غير السلفية على غرار الصوفيين والشيعة أو المسيحيين، كذلك الأحزاب السياسية المنافسة لهم، بما في ذلك الليبراليين والإخوان، إلا أن الحزب طوَّرَ موقفاً غاية في البراغماتية إزاء العمل السياسي، حيث تحالف مع مجموعات وأحزاب لا تشاطره الإيديولوجيا الدينية».
مفهوم السلفية المعاصرة، يؤشر إلى نظام معرفي خاص، قوامه منهج أهل السنة والجماعة وتبني الأصول المتمثلة في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لها، وهو ما يوفر لها العصمة والقداسة. وبالتالي، ليست السلفية هنا بأدبياتها وأفكارها مُنتجَاً بشرياً يمكن تغييره وتعديله، لكنها الإسلام النموذج والمثال في حالته القصوى وتحققه الكامل في صورته السليمة والتامة النقية كما أرادها النبي وأصحابه، وهو كما أشرنا سابقاً، صورة المُتخيَّل الديني التي تؤسس حضورها في الوجدان الديني الشعبي. وهو ما يمكن أن نرصده بسهولة في كتابات محمد نصر الدين الألباني، الذي اعتبرَ «أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة». تمكَّنَ الألباني من بلورة مفهوم السلفية وتصدير نسخته التي ستُصبح معتمدة لدى غالبية الشيوخ السلفيين في العواصم العربية والإسلامية، بعد ما ثارت ضده معركة حول تحديد المفهوم وآلياته من تلامذته، وكان أحد أطرافها، الشيخ البوطي في سوريا، الذي اشتهر بمقولته: «السلفية فترة زمنية مباركة لا يجوز احتكارها من قبل جماعة المسلمين دون غيرهم»، فيما انتصر الألباني وساد مذهبه السلفي نواحي العالم الإسلامي والعربي، والذي ترافق مع صعود المؤسسة الدينية الرسمية ودعم شيوخها وأئمتها كابن باز وابن عثيمين.
يتضح داخل بنية الخطاب السلفي، الذي يقوم على مفهوم «الفرقة الناجية» في حديث الرسول عن الفرق، حضورٌ قويٌ للعنف الرمزي الذي يجعل كل مسلم سلفياً بالضرورة حتى يصح إسلامه، فيما يجسّدُ الخارجون عن «الجماعة» البدعةَ والضلال وخروج عن استقامة المنهج السُنّي السليم، ويشتقون مفهوم الخروج عن الجماعة من حديث نبوي آخر هو «لا تجتمع أمتي على ضلالة».
رغم البراغماتية السياسية والانتهازية لدى جماعة الإخوان، والتي تماثلت مع مواقف السلفيين في انخراطها السياسي، إلا أن الخلاف بينهما اشتعل نتيجة ما اعتبره كل فريق «تفريطاً في الدين». شنَّ السلفيون هجوماً على الإخوان باعتبارهم فرَّطوا في مقتضيات الدين لغرض مكاسب سياسية نفعية وحصد مغانم انتخابية، ومن بين تلك القضايا هي قضية القبول بولاية المسيحي حيث يرفض السلفيون عضوية المسيحي في مجلس النواب أو ترشحه للرئاسة وكذلك ولاية المرأة، فضلاً عن مرونة الموقف الإخواني من إيران. كل ذلك فاقم الخلافات بين السلفيين والإخوان في مرحلة حكم محمد مرسي في مصر.
كذلك فإن ثمة تقارُباً بين السلفيين والإخوان على مستوى الأفكار والتنظيم لا يمكن بحال تجاوزه، حيث زحف الفقه السلفي إلى العقل الإخواني، وذلك مع صعود الفكر القُطبي في نهايات الستينيات، وتراجُع حضور كتب المناهج الصوفية المقررة لدى الجماعة، مثل الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري ورسالة المسترشدين للحارث المحاسبي والأنوار المحمدية للنبهاني، وتمرير بعض الكتب السلفية مثل زاد المعاد ومعارج القبول لابن القيم، وهي المرحلة التي شهدت هجرة العقل الإخواني إلى بلاد الخليج والسعودية تحت وطأة الحكم الناصري، بما شهده من محن شملت حلَّ التنظيم واعتقالات وإعداماً لأبرز مفكريه سيد قطب، وما ترتَّبَ على ذلك من ظهور ما وصفه المفكر الإسلامي حسام تمام «تسلُّف الإخوان»، وانعكاسه على الجماعة حركياً.
في منتصف الثمانينيات، أخرجت الدعوة السلفية نفسها من رحم الجماعة الإسلامية، وبدأت العمل بشكل مستقلّ خارج مداراتها. وبدأت مرحلة الانتشار والتوسع دون قيود، وأسست معهد الفرقان لإعداد الدعاة عام 1986 مقرّهُ الإسكندرية، وهي أول مدرسة سلفية تعمل على تخريج دعاة، وعمل الدعاةُ السلفيون على وضع وضبط المناهج المقررة فيها، وهو ما ألحقته الدولة بوزارة الأوقاف في عام 1994، كمحاولة لتقييد مد نفوذ السلفيين وخشية من توسعّهم، حيث أضحت محطة لكل طلاب العلم الشرعي حتى من خريجي الأزهر، من فقه وتجويد وتوحيد وحديث، وتصدَّرَ الدعاةُ المتخرجون من هذا المعهد لواء الدعوة في كافة أقاليم ومحافظات مصر. كما ظهرت مجلة «صوت الدعوة»، وهي لسان حال الدعوة السلفية، وكانت تُطبع شهرياً لنشر الوعي بالفكر السلفي.
وفي ظل عدم التمييز وخلط التيار السلفي بين المجالين الدعوي الديني والسياسي، الأمر الذي يعود إلى سيولة المشهد السياسي الذي دفعهم لقبوله والدخول في أحشائه والاستجابة لمعطياته بانتقائية وانتهازية وبراغماتية شديدة، وقعت حالة تصدُّع وانشقاق على المستوى الحركي بين القواعد والقيادات من جهة، فضلاً عن حدوث مراجعات عنيفة على أكثر من مستوى وبشكل متباين في درجاته للمرجعية السلفية، ما أدى لظهور تحركات أو بالأحرى انتقالات إلى أقصى اليمين (الانضمام للسلفية الجهادية، مثلاً) أو الانفكاك من الانتماء السلفي. وقد أخفق حزب النور في إنجاز تَصوُّر سياسي شامل يتضمن الرؤية السلفية للدولة الحديثة، وتعيين موقع الشريعة في علاقتها بها، وانحصر انخراطهم السياسي في الأمور الإجرائية وقبولهم الشكلي بالآليات الديمقراطية، مثل الانتخابات والبرلمان.
التناقض البنيوي في الفهم السلفي والأصولي للسياسة تمثَّلَ في إشارة لافتة عرَّج عليها الشيخ السلفي عبد المنعم الشحات أثناء انعقاد البرلمان عام 2011، وهو الذي شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بالاسكندرية، عندما طالب بضرورة تدشين «مجلس فقهي» تُحال إليه القوانين ليفصل في شرعيتها، وهو ما يؤكد على ضرورة المرجعية الدينية والفقهية لما سيصدر من مواقف سياسية أو يترتب عليها من قوانين، وذلك في مقاربة لمبدأ الولي الفقيه بإيران، النموذج السياسي والمعاصر للدولة الإسلامية كما تحققت في طهران منذ عام 1979.
وثمة أمثلة يمكن مُراجعتها بحسب ما تم نقله من الموقع السلفي الرسمي أنا السلفي، والذي جاء فيه على لسان ياسر برهامي تحريم العمل بالقوانين الوضعية فى مؤسسات الدولة والتى تعطل الأخذ بنصوص وكتاب الله فى الحكم وتنظيم شؤون الناس واستبدالها بقوانين وتشريعات بشرية بحسب ما يتبنى من رأى فيقول: «الحكم بغير ما أنزل الله كفر لأن الله تعالى يقول في كتابه (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44)
ومن ذلك أيضاً تحريم العمل في الشرطة باستثناء المطافي، إذ يحرم برهامي العمل في قطاعات الداخلية الأُخرى، وفي ذلك يقول: «إذا كنت تعمل فى المطافي مثلاً، والأعمال التى لا تتعلق بالقوانين الوضعية ولا تمنعك بالقيام بالطاعات واجتناب الظلم والمعاصي، فلا حرج فى ذلك»، وأضاف: «وأما إذا كان لا بد أن تفعل المخالفات الشرعية وأن تنفذ ما تؤمر به مما يخالف شرع الله، قد قال رسول الله: (ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا خازناً)».
ولدينا أيضاً تكفير الأقباط، وهو من أكثر المواقف التي لا تتوانى الدعوة السلفية وأعضاء حزب النور عن التصريح بها ليل نهار؛ فَهُم النصارى والكفار والمشركون، ويستنكرون على المسلم التشبُّه بهم ومشاركتهم أعيادهم ومناسباتهم الدينية، مع تحريم الاحتفال بها أو تهنئتهم فيها.
طُرِح سؤالٌ على موقع أنا السلفي يقول: «هل يجوز للمسيحي الترشح فى مجلس الشعب؟ وإذا كان يجوز فهل يكون على رأس قائمة حزب النور السلفي؟»، وجاءت إجابة برهامي على النحو التالي: «الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمجلس الشعب له سلطة تشريعية ورقابية، ويمكنه عزل رئيس الدولة، ومحاسبة الحكومة، والمقرر أن كل أنواع الولايات لا يحل للكافر أن يتولاها، وهذا ليس غريبًا من القول، فمجلس اللوردات البريطاني، وهو أحد مجالس التشريع، شرط دخوله أن يكون العضو بروتستانتيًا. وعلى أى حال فهذا فى حالة الدولة المسلمة الكاملة».
والمعضلة هي غياب البرنامج السياسي المدني للحزب السلفي، والذي اعتبر كما غيره من جماعات الإسلام السياسي أن المرجعية الدينية تحوي منظومة سياسية ومجتمعية شمولية ولديها الحلول التلقائية. فالمدونة السياسية لحزب النور لم تتضمن أي التزام حقوقي بمبدأ المواطنة، ولم يرد ذكرها مرة واحدة في صفحاته، لا هي ولا الدولة المدنية، فيما يؤكد على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية حاكمة لكافة مناحي الحياة، ولا يكتفي بنص المادة الثانية للدستور الذي يقول: «الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع»، بل تعد مرجعية عليا للدولة في نشاطها السياسي والقانوني والتشريعي والاجتماعي والاقتصادي. ومن ثم، تصبح كل الحقوق والحريات العامة والممارسات السياسية، وفق هذا الإطار الضابط لمفهوم الشريعة، وفق المنظور السلفي، وهو ما يتقاطع مع فتاوى أعلنها الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية على موقع أنا السلفي، والذي يعد المرجعية العلمية والفقهية لحزب النور، تفصح عن مواقفه من الأقباط والعمل في مؤسسات الدولة الحديثة وآليات تداول السلطة والانتخاب وموقفه من القوانين الوضعية، والتي يعتبرها عدواناً على الدين وخروج عن طاعة الله.
خاتمة في ضرورة تحرير الدين من السُلطة
في ظل هذه المواقع التي يتردد بينها الدين، والأدوار التي تبدو متناقضة، يُفترض أن يكون تجديد الفكر الديني من خلال تنحية الدين عن السلطة، أي سلطة، وتحريره منها، أمراً مُلِحَّاً؛ حتى لا يصبح مفهوم التجديد مرتبطاً بمن يملك حصرياً حقَّ الحديث باسم الدين، الأمر الذي يؤدي إلى إحياء الاستخدام السياسي للدين بينما يظل التكفير والعنف على أساسه مشروعاً ورائجاً. وفي الحقيقة، هذا الاستخدام للدين هو ما يجعل العلاقة بين القوى الإسلامية وأئمة الدين وشيوخه، دعاة أو رسميين، تتصدعُ رغم تماهي وجهات النظر في العديد من المواقف وتوافقها في قضايا كثيرة.
راهنية هذه الظاهرة الإسلاموية والحوادث التي تُرافقها تكشف عن واقع أعمق مسكوت عنه، يوفر الشروط الكاملة التي تتأسس عليها هذه الأفكار، ويحافظ على المرجعية التي تستمد منها عملها. من ثم، يجعل هذا من الأفراد المنتمين لهذا الواقع العربي الإسلامي مرشحين للانتقال من كونهم حاضنة اجتماعية لتمرير هذه الأفكار والقبول بها بدرجات متفاوتة، إلى السقوط في أفخاخها والانتماء التنظيمي والفكري لمن يحملها. ثمة عائقٌ يحول دون تحرير الدين من دوره الوظيفي في تبرير العنف وتوفير حماية إيديولوجية له، وهو أن السلطة السياسية في المجتمعات العربية لا زالت تعمُد إلى مصادرة الدين وتطويعه لحسابها، بهدف خلق ما يوفر لها العصمة والقداسة، ويرفع عنها النقد والمُساءلة تجاه إجراءاتها السياسية وقمعها لخصومها. وقد أخفقت كل المحاولات التاريخية في إنهاء تلك العلاقة القسرية بين الدين والسياسة، والتخلص من السلطوية البطريركية.
أدّى هذا الميراث التاريخي من استخدام الدين كإيديولوجيا للحكم، إلى تطييف المجتمعات العربية، وإلى تنامي صراعات عقائدية بين المذاهب الدينية داخل الإسلام ومع الأديان المخالفة للإسلام، واعتبار أصحاب كلّ تيار أن تيارهم يُمثِّلُ الحق الإلهي، بحيث يتشظّى العالم بالنسبة لكل جماعة إلى طرفي نقيض: دار الحرب ودار السلام، أو حزب الله وحزب الشيطان.