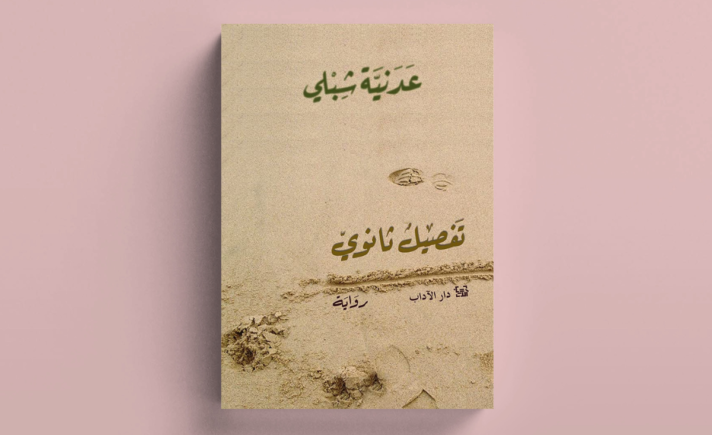تاركاً والدته التي عاشت في رعايته سبع سنوات في مخيم اللاجئين السوريين في لبنان لتنضم إلى إحدى خيام والده المتزوج من ثلاث نساء، هاجر مجدي أبو الروس (29 عاماً) إلى المملكة المتحدة، في تشرين الأول (أكتوبر) 2019.
منذ اليوم الأول، انعزلكل الأسماء في هذا البحث مستعارة بناء على إجراءات السلامة والأمان. مجدي وأسرته عن المجتمع من حوله، بعد أن أخبره المترجم والشخص السوري الذي استقبله لتناول الغداء في منزله ألا يدق الباب على الجيران وألا يزعج أحداً. من يومها وهو يتجنب الاحتكاك مع الجار: «لم أعرف من هم هؤلاء الناس. النصائح التي تلقيتها في البداية جعلتني أتجنّب أي محاولة للحديث، فضلاً عن حاجز اللغة التي لم أعرف منها حرفاً». هناك فئةٌ من المهاجرين يتطوّعون بحكم الأقدمية للعمل كدليلٍ إرشادي لإعادة ضبط الوعي في المهاجرين الجدد، وتعريفهم على نمط المدينة وسلوكياتها العامة، بما يتضمن احترام خصوصية الآخر.
في التاريخ، يقول هابرماس: «تم تبرير تهميش المجتمعات الإقصائية لأصوات وعوالم الطبقات المُهمَّشة بالنزوع لإدراجها تحت مسمى ‘الخصوصية’». وعلى هذا النحو تتحول الخصوصية إلى أداة إقصاء في النطاقات التي تعيش في الظل ولا تصل أصواتها وقضاياها للحياة العامة.
في العام الأول، مع تصاعد التحديات، مرّت الأسرة بلحظاتٍ مشحونة بالقلق والأسئلة. كان اليأس فيها قريباً منهم وهم يشعرون بالعزلة، يتذكر مجدي المخيم كملاذٍ بعيدٍ ممتلئ بالدفء والألفة والذكريات التي عمّرت سبع سنوات من الزمن.
يقول مجدي: «عشت مع عائلتي شهوراً طويلةً أتجنَّب الالتقاء بالجيران أمام البيت، خوفاً من التقاء نظراتنا. إلى أن فوجئنا ذات مساء بجارتنا تطرق الباب وتعرض علينا أن نحتسي معهم القهوة في منزلها».

منذ البداية، لجأ مجدي للبحث عما يفتقده من الدفء داخل مجتمع الجالية. الجالية السورية، التي يشكل حاضرها واقعاً سياسياً معقد ومجتمعاً ناتجاً في أغلبه عن حربٍ أهلية. كيف يجتمع أبناء حرب أهلية في مكان جديد؟ في مكان واحد، حيث يتشاركون، على اختلاف خلفياتهم وسيرهم، عوامل تكافؤ وتشابه كالرغبات والتحديات؟ ما هي هذه الجالية وما هو هذا الحاضر؟
لمحات من تاريخ الحياة السياسية للجالية السورية في بريطانيا
منذ القرن التاسع عشر، تواجدت الجالية السورية في المملكة المتحدة بأعداد صغيرة مقارنةً بالجاليات العربية الأخرى، لكنها من أقدمها. في كتابه مسلمو بريطانيا الأوائل، يذكر فريد هاليداي قصة السوريين القدامى كعرب مَنسيين في بريطانيا، يعيشون بمنأى عن الأضواء، منشغلين بالحياة العملية وشؤونهم الخاصة. هاجرت نسبة كبيرة من السوريين للدراسة في جامعات بريطانية، واستقروا هناك للعمل في مجالات مختلفة كالصحة والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى فئات من المهاجرين الاقتصاديين والتجار البرجوازيين.
وبينما تمركزت غالبية الجالية في لندن، توزَّعت مجموعات صغيرة على بعض المدن الأخرى، خصوصاً مدن الشمال. في تقريرٍ أعدته لصحيفة الغارديان، تُشير الباحثة حمى خليلي إلى تواجد الجالية السورية منذ العهد الفيكتوري في مانشستر، ومع الوقت امتلكت بعض العائلات مصانع نسيج هناك، بعد أن جلبتهم تجارة القطن إلى تلك المناطق الصناعية.
في ستينيات القرن الماضي، وفقاً لنديم شحادة، الباحث في مركز تشاتام هاوس في لندن، بدأت الجالية تضم مهاجرين سياسيين، قدِموا من سوريا إلى بريطانيا نتيجةً للأوضاع السياسية غير المستقرة آنذاك. تلا ذلك دخولُ القوات السورية إلى لبنان عام 1976. وبعد مذبحة حماة في الثمانينيات، تزايدت أعداد السوريين المنفيين داخل الجالية.
على عكس الأفراد والعائلات الأخرى التي احتفظت بصلاتها ورَحلاتها المستمرة إلى سوريا، حُرمت الفئة الجديدة من العودة إلى الوطن خوفاً من الملاحقة والاعتقال، أو تجنباً للالتحاق بالتجنيد الإجباري.
في لندن، وجد القادمون الجدد ملاذاً داخل المجتمع العربي، حيث تُعدُّ المدينة من أهم محاور الثقافة العربية خارج العالم العربي. لكن مع ذلك، افتقدت الجالية السورية طوال الوقت لمجتمعٍ سياسي يعكس الأوضاع الجديدة للاجئين ويصوّر قضايا الهجرة بشكل عام.
بدأ ظهور الأنشطة الفردية في العمل في المؤسسات غير الحكومية مع الإعلان عمّا عُرِف بـ«الجمعية السورية البريطانية» عام 2003، والتي أنشأها فواز الأخرس؛ والد أسماء الأخرس بعد زواجها من بشار الأسد. حتى وقت اندلاع الثورة في 2011، كانت الجالية، المقدّر عدد أفرادها بـ 10.000 سوري-ة، منشغلةً بأمورها الخاصة بعيداً عن الأضواء والسياسة. مع تميُّزها بالحيوية في مواجهة تحديات الهجرة ومشاكل الانخراط، وحصول الكثير من أفرادها على مراكز تعليم عالية ومواقع جيدة في مجال التجارة والبيزنس.

يقول نديم شحادة: «حافظت الأسر على بناء شبكة اجتماعية قوية فيما بينها، وبدا أن الجالية متماسكة خلال تلك العقود»، ولكن أيضاً لم تسمح مناخات الخوف التي زرعها حزب البعث في مواطنيه إظهار أي انقسامات على السطح، فلم تجد أي معارضاتٍ سياسية مكاناً مع وجود ذلك الخوف إلى جانب أذرع المخابرات الطويلة في المنفى.
*****
في منزل الجارة، يجد عليّ، ذو التسع سنوات، سلواناً بالتعرف على أبنائها، مما يلهيه عن فقدانه أبناء عمه، فهو لم يتوقف عن البكاء منذ الوصول إلى المدينة. في الليل يسأل عن الجَدّة، والرفاق الذين اعتاد اللعب معهم طوال اليوم في أرض المخيم. في الصباح لا يذهب إلى المدرسة إلا بعد بكاءٍ لا يتوقف إلا في الفصل. المعلمة تحاول مواساته وملاعبته، تُكثّفُ العملَ معه على تحسين اللغة الإنكليزية، وتدللهُ كثيراً. تفاعل شقيقه محمود مع ظرف الشتات بوتيرة مختلفة، فقد وصل في سنّ أصغر وتعلَّم اللغة بسهولة أكبر، ولم يسأل بنفس القدرعن جدته وأولاد عمه.
في فصله الدراسي في مدرسة نيو مارستون، التقى محمود بتوأم روحه مريم، بنوتة سورية عندها سبع سنين، مثله. وأصبحا ثنائياً لا يفترق في الذهاب والإياب، واللعب والدراسة. الآنسات يأتين من صفوف أخرى ليرونهما ويطلقنَ عليهما «زوج البجع»، كما علِم بقصتهما عائلات الطلاب عبر برنامج المدرسة الذي ينشر القصص والأخبار في مجلة إلكترونية. حين تركت العائلة سوريا، كان علي في الأشهر الأولى. وحين بلغ سن التعليم في لبنان كان متطوعون يعملون معه في حضانة للأطفال.
أثناء تواجدهم في المخيم في لبنان، علم مجدي أن بيته انهدم. البيت الذي بناه في حمص – القُصير، لينفصل عن العائلة ويسكن فيه مع زوجته عبير، كما هو متبعٌ داخل تقاليد العائلة. بعد خروجه من سوريا، بنوا حياةً منزليةً في المخيم؛ بيتاً كاملاً كما يحب تسميته، استضافوا فيه والدة مجدي للعيش معهم. سبع سنوات يحاولون صنع بيتٍ للديمومة، من القماش: «كان في الخيمة كل شيء… كل شيء». وحين تركوها أخيراً إلى بريطانيا لم يأخذوا معهم سوى 15 علبة متّة وشنطة ملابس.
اشتغل مجدي منذ الصغر في مجالات متنوعة من الأعمال والحرف. وفي كل المرات التي اضطرته الظروف إلى أن يبدأ مجدداً، تكون البداية من تحت الصفر. في إنكلترا دفعته ضرورة الحياة والعمل أن يدرس الإنكليزية، في حين لم يكن لديه أدنى معرفة بـ الألفبائية في لغته الأم. ولا حرف واحد بالعربي. كان مجدي أميّاً.
في أحد المعاهد، تندهش معلمته حين تسأله أن يقرأ لها كلمةً بالعربية التي تعرفها قليلاً، ويخبرها أنه لا يقرأ ولا يكتب. كيف يا مجدي لا تقرأ ولا تكتب؟ يخبرها قصته حين كان طفلاً في الثامنة:
«ذهبتُ إلى المدرسة، وأصابت قدمي غرغرينا، صارت تأكل العظم. أخذني أبي إلى المشفى بعد أربعة شهور قضيتها في الصف الأول، أنقذوا قدمي من خلال العمليات الجراحية التي بقيت على إثرها مقيداً خمس أعوام من جبس إلى آخر بين البيت والمستشفى. صار عمري 13 عاماً ولم أنفع في المدرسة. قلت لأبي أنني لم أعد أريد الذهاب إلي المدرسة، فوافق».
تتعاطف المعلمة معه وتكتب له حروف العربية على ورقة إلى جانب الإنجليزية التي تعلّمها، وأصبح بعد عام ونصف من دراستها يراسل أصدقاءه على الواتس بها. يعلِّق الورقة بحروف اللغتين على الجدران وفوق التليفزيون وعلى المرآة، ينظر لها طوال الوقت، ويقول لنفسه: «ما في شيء صعب، سأحاول». يقرأ: ألف، باء، تاء، يخربط، وتصحح له زوجته. «في ليال كثيرة، كنتُ أجلس على هذه الصوفاية، أتذكر بكائي حين كنت أطلب من إخوتي وأصدقائي قراءة رسالة مرسلة لي. ولا أيأس، أتعلم الأبجدية العربية، وأتهجأ الإنجليزية، أركب الكلمات وراء بعضها، وألفظ الجمل الصعبة العصية على التركيب كأنها قطع خراطة عنيدة في الورشة».
لم يجد مجدي مشاكلاً في التواصل مع أبناء الجالية السورية منذ مجيئه. فحالة الانقسام التي انعكست داخل المجتمع اعتباراً من العام 2011، كنوع من التوتر لم تشهده الجالية من قبل، كانت قد صَفَتْ، أو اختفت من السطح. إذ شكلت فترة ما بعد الثورة مرحلةً عابرةً في تاريخ الجالية، وشهدت ظهور الجماهير الغاضبة لأول مرة منذ تلك العقود في صورة تظاهرات احتجاجية مستمرة أمام السفارة السورية في لندن. في بعض شوارع العاصمة، وثّقت الجمعية السورية البريطانية حوادث اعتداءٍ وهجومٍ جسدي ولفظي بين أطراف سورية، كما لاحظت تأثّر الاتصالات الاجتماعية بين العائلات وصعود النبرات الطائفية والتشدد.
بالمقابل، شنّت السلطات السورية في السفارة حينها حملة ترهيب ضد المهاجرين المعارضين وعائلاتهم في سوريا. في تقرير بعنوان «الأذرع الطولى للمخابرات» عام 2011، وثّقت منظمة العفو الدولية زيارات مسؤولين في السفارة منازلَ المحتجّين واستدعاءهم إلى مقرِّ السفارة وتهديدهم بالإعدام في حال عودتهم للوطن. كما وثّقت اعتقال فردٍ من عائلة أحدهم، والسطو على بيت عائلة مهاجر آخر في سوريا. استمرّت هذه الآلية حتى وقت إغلاق السفارة ورحيل السفير.
*****
تعتبر أسرة مجدي مثالاً نموذجياً للحالة السورية التي شكلت مجتمع الهجرة الجديد، فقد هاجرت الأسرة وفقاً لبرنامج إعادة توطين 20.000 لاجئ سوري في بريطانيا، يبدأ من العام 2015 وينتهي عام 2020. والذي أعلن عنه بوريس جونسون بعد تصاعد أزمة اللجوء في أوروبا واتباع إنكلترا والاتحاد الأوروبي سياساتٍ لا إنسانية في التعامل مع المهاجرين السوريين الفارين من الحرب على متن قوارب بالية عبر البحر المتوسط. حيث أصر وزراء الحكومة في عام 2014 على أن عدم إنقاذ اللاجئين الغارقين في البحر المتوسط هو أفضل طريقة لمنع السوريين الآخرين من اتباعهم. وبعد غرق المئات من المهاجرين المتجهين إلى أوروبا، وتشدد سياسات بريطانيا فيما يتعلق بمشكلة اللجوء، جاء البرنامج نتيجةً للتأثُّر بضغط الرأي العام بعد إظهار الفوتوغرافيا جوانب من مأساة اللاجئين السوريين، وأشهرها الصورة المؤثرة للطفل السوري إيلان الكردي. لكن البرنامج لاقى انتقادات من نشطاء سياسيين وأعضاء في البرلمان حينها، فرفضه بعض نواب حزب العمال، وقالت عضو البرلمان عن حزب الخضر كارولين لوكاس: «إن الرقم المُقترح يمثل عدداً ضئيلاً جداً حين النظر إليه موزعاً على النطاق الزمني الطويل، والنظر إليه بالمقارنة مع حجم المأساة السورية. إن 20.000 لاجئ على 5 سنوات رقمٌ صغير بشكل مثير للشفقة».
لكن بحلول عام 2019 أصبح عدد القادمين الجدد يقرب أربعة أضعاف عدد أفراد الجالية، حيث عَبَرَت أعداد كبيرة إلى المملكة المتحدة نازحةً عبر القوارب قدوماً من فرنسا، ليصبح عدد الجالية حينها 47.000 سوري-ة بين مهاجر قديم ولاجئ وطالب لجوء.
فوق أرضٍ جماعية للنجاة، تشكّل سياقٌ جديدٌ للحياة الاجتماعية، غيّر من تركيبة النسيج الاجتماعي من حيث أنماط الحياة والاهتمامات والطبقة والمكانة الاجتماعية التي احتلّت المساحة الكبرى للجالية سابقاً، ومنذ تاريخها.
خلافاً للرفاهية البرجوازية في عهود سابقة، أصبحت نقاط التجمعات تتمثَّل في الحاجة إلى اللّقاء، والمرور بقنوات مشتركة تجمع الآلاف في مراكز التعليم ومعاهد تدريس اللغات وسياقات البحث عن عمل، وذلك بغض النظر عن أمور السياسة أو المعتقد والطائفة والمواقف المتباينة على أرض الواقع داخل الحرب الأهلية. تزامناً مع ذلك، خَفّت النبرة السياسية وتلاشى ظهور الانقسام من السطح، بيدَ أن لمحات لمشاهدَ متوترة تشير إلى أنه ظل مكبوتاً ويعيش متخفّياً في مكانٍ ما. لا يبوح المهاجرون الجدد أو اللاجئون بأمور كثيرة عن الحرب الأهلية، أو للدقة، عن انعكاساتها على الحياة وديناميات التواصل داخل مجتمع اللجوء.
تقول ويندي بيرلمان إن السوري المهاجر يحتاج إلى وقتٍ للحديث بسبب عقودٍ من التلقين المؤسساتي للرهبة وزراعة تماثيل حافظ الأسد في الأماكن العامة وتعزيز الهيمنة بالداخل عبر بث الشعور بالمراقبة وفرض حالة الخوف الدائم.
في جميع المقابلات التي طُرحتُ فيها أسئلةٌ عن التوتر، النزاع، تجلّيات الانقسام أو أثر الحرب الأهلية على الحياة الاجتماعية، كان ثمّة صمتٌ له مغزى ينطِقُ من خلف الأحاديث الطويلة والشيقة عن النجاة والانخراط والتقدم، وكأن الحرب التي أنتجَت الشتات مسألةٌ تتعلق بالوجود على الأرض فقط، أو أنها فكرة تسقط في أعماق المساحة العابرة المخفية التي تُدعى المحيط. كأنّ الشتات مصيرٌ مستقلٌّ عن أية سردية تَشبِكُ الواقع بالرحلة والحكاية؛ سردية قد تكون لشخصٍ فقد أحد أقاربه أو معارفه في المعتقل أو في ساحة الحرب أثناء قتاله ضد جماعةٍ يؤيدها أحد اللاجئين الآخرين في المدينة.
****
بالطبع قد تختلف المواقفُ من الثورة والحكومة والجماعات المتنازعة، كما تختلف وجهات النظر الإيديولوجية من مقابلةٍ لأُخرى، لكن الأشخاص داخل مجتمع اللجوء الجديد لا يختلفون، أو على الأقل لا يَسمحُ الواقع الاجتماعي الحالي بإظهار أيٍّ من هذه الاختلافات. في وِسعي أن أنقل الإحساس الذي لازمني في المقابلات الفردية مع أشخاص متفرقين، يجمع بينهم ذلك النوع من الصمت؛ الفيل القابع في الغرفة، الناطق باختصارات موجزة: إن هناك أشياء لا يمكن أن تُسرد.
كذلك في الأماكن العامة لتجمعات السوريين، حيث ذهبنا إلى موائدَ إفطار جماعية وحلقات نقاش ودردشات في بلاك ليدز كومينتي سيتنر، وتحدثنا بشكلٍ عشوائي مع أفراد من أعمار ومواقع اجتماعية متفاوتة؛ لا وجود لأي انعكاسٍ لأثر الحرب في الحاضر. تحضر الحرب بالنسخة ذاتها البعيدة عن صراع الإيديولوجيات؛ النسخة الملائمة لسياسات الهجرة، إذا جاز التعبير، الصامتة وغير المرئية بالنسبة إلى الفضاء السياسي والعام؛ نسخة تحاول نسيان الحرب التي تشبه ربّما كارثةً طبيعية. فحين تحدث المهندس أحمد السوري في حفلة ببلاك ليدز، بعد كثيرٍ من الابتسامات والتودّد، قال باقتضابٍ كأنما يطرد عن لسانه طعماً مُرّاً، إنه يحمد الله على كل من نجا منها وانضم إلى جالية، والله يكون في عون من ما يزال في سوريا. وكذلك، يتجنَّب الجميع الحكيَ عن الحرب في معظم المناسبات، مُفضّلين الحديث عن الحياة هنا أو الصمت.
في كتابه سياسات الحكي، يتساءل الأنثروبولوجي مايكل جاكسون «عمّا إذا كانت الحياة والرحلة والحكاية مفاهيم متشابكة جداً، ما الذي يحدث في طاقاتنا لحكي القصة عندما تكون أوصال حياتنا ممزقة؟ عندما نضطرُّ إلى مغادرة المكان الذي نسميه وطناً، وتصبح الأماكن العامة التي عشنا وعملنا فيها أماكنَ للرعب والموت؟ عندما نفقد الاتصال مع الأشخاص الذين يعرفون أسماءنا ويتحدثون لغتنا؟ وتتوقف الحياة والرحلة عن سرد المعنى الذي لا يكتمل في المقابل إلا بالسرد؟ حين نصبح فجأةً بلا مكانٍ مستقر نستطيع أن نغامر منه كل يوم، وبلا مكانٍ في النهاية نستعيدُ منه حياتنا من خلال القصص التي نحكيها فيه؟ ما الذي يحدث حينذاك لقصصنا وحياتنا؟».
حسب جاكسون: «تُنتِج الأحداث العنيفة الصمتَ، إذ تعزِل الأشخاص عن الحياة العامة لأنهم غير قادرين على إيجاد السردية المناسبة لذلك الفضاء العام الذي لن يفهم حقيقة ما عاناه هؤلاء الأشخاص».
كما يلاحظ جاكسون: «في حالة الجروح الخفية للحرب وتروما اللجوء، يعجز الأشخاص عن التحكم الواعي في الذكريات الصادمة، ما يساهم به وظيفياً عجزُهم عن إعادة صياغة التجارب المزعجة في شكل سردية، فالذاكرة السردية تضمنُ القدرة على إدماج التجارب الجديدة مع تفاهماتٍ سابقة ومغروسة داخل الفرد والمجتمع، بينما الذاكرة المصدومة شخصيةٌ بالكامل، ولا تسمح بإضاءة إشارات المرور الكائنة على الطريق الرابط بين عقل الفرد والعالم الاجتماعي الذي يعيش فيه».
*****
في أكسفورد يوجد مجتمعٌ سوريٌّ آخر، يتفاعل ويشتبك مع الواقع السياسي على مستوى آخر. داخل جامعة أكسفورد، توجد رابطة اجتماعية للسوريين، تعرف بـ«المجتمع السوري الأكسفوردي». (Oxford Syria Society)، أردنا فهم هذا الوجود السوري داخل الصرح الجامعي، وموقعه من لاجئي البلاد، وما يقدمه لقضية اللجوء بشكل عام، باعتبارهم بشكلٍ ما صوتاً قد يكون مؤثّراً في مؤسسةٍ مهمة داخل الدولة المضيفة، وعما إذا كان هناك أي مساحة للتقاطعات السياسية بين المجتمعين، وما الوسائل التي يستعملونها للوصول إلى هؤلاء الذين يشاركونهم نفس المدينة؟ خاصةً أن وجودهم المؤسساتي يقترح وجوداً أحادياً لنوعٍ من السلطة الاجتماعية، كبقاء إمكانية التواصل الاجتماعي أو الرغبة في إقامة أي روابط على أساس وطني، مكوّمة في طرفٍ واحدٍ داخل سياجٍ يحيط بالحياة الأكاديمية.
في محاولتنا لفهم كل ذلك، أرسلنا طلباً إلى المسؤولين عن الإدارة لعمل لقاءات، ولم نتلقَ رداً حتى كتابة هذه السطور بعد أن أجاب المركز على فيسبوك برسالةٍ يطلب فيها توضيحاتٍ أكثر، ليتوقف التواصل عند هذا الحد بعد ذلك.
لفهم الحياة في أكسفورد، لا بدّ من فهم موقع الجامعة من المدينة التي يتدفّق إليها عشرات الآلاف من الطلاب ودارسي الماجستير كل عام، ما يدفعُ بعالم السكان المحليين في المدينة التي لا تتجاوز مساحتها 45 كيلومتراً، للوراء، لأن يكون عالماً ثانوياً على هامش عالم الجامعة.
واقعون تحت نطاق سؤال الغرباء عمّا إذا كانوا يدرسون في الجامعة، يبدو وجود السكان المحليين كمرحلة متأخرة من التصور الذهني. أما وجود الجامعة فتوقعٌ عفوي في مدينةٍ يبدو أنها لم تُخلَق للسكن. أو كما قال لي صديقٌ يعمل في مؤسسةٍ بديلة: «لا تكاد الأصوات تصل إلى الفضاء العام الذي يشقّه صوت قطار أكسفورد الأكاديمي بلا توقف». أما في فصل الصيف حين يذهب الطلاب في الإجازات الدراسية إلى عائلاتهم، كالطيور العائدة إلى أوطانها الأصلية، يتدفَّق السائحون من أنحاء العالم للفرجة على معالم التاريخ وتراث النخبة في أنحاء أكسفورد العتيقة. وحدهم اللاجئون يبدون داخل المجتمع على هامش الهامش؛ طيورٌ بلا أجنحة ولا وطن يعودون إليه في المواسم. معظم عائلات اللاجئين تعيش في بيوتٍ وفّرها المجلس المحلي وتقع في أنحاء متطرفة، بعيداً عن أماكن تكدُّس الطلاب في منطقة وسط المدينة.
يوجد في أكسفورد أيضاً، منذ القرون الوسطى، مفهوم طبقي يتوارث حتى الآن، يُعرف ب «التاون آند جاون» ويقسّم العالم إلى شطرين؛ شطر المدينة وشطر «الثوب». عالم المدينة محلي، (local)، عادي، مليءٌ بالأشخاص الاعتياديين والسكان المحليين. بينما عالم «الجاون» (الزي الرسمي للجامعة) مميز، ومتفوق، منتقى من النخبة الأذكياء القادمين من أنحاء العالم، ومن هنا تظهر أوضح وأهم الحدود الاجتماعية والطبقية التي تفصل بين قاطني المدينة الصغيرة نفسها.
يعتمد المجتمع السوري في الجامعة اللغة الإنكليزية كلغة رسمية على وسائل التواصل الإجتماعي، وتنزِع لهجته لاتخاذ موقف سياسي واضح حيال الأحداث التي شهدتها سوريا في العقود الأخيرة بإدانة القمع صراحة، ومناشدة قضايا العدل والديمقراطية والسلام.
من ضمن 40 عائلة سورية لاجئة تعيش في مدينة أكسفورد، قابلت الجمهورية ثماني عائلات منها بالإضافة إلى مراكز الرعاية الاجتماعية ومساعدة اللجوء، لم يُذكر أي أثر للروابط الاجتماعية أو التواصل الفعلي والتقاطع على أرض الواقع بين طلاب وأساتذة الجامعة السوريين وتلك العائلات في المدينة.
ربما تشكل مواقع القوى غير المتكافئة، بين السوريين اللاجئين ونظرائهم الأكاديميين انفصالاً واضحاً، حيث معالجة الأخيرين لقضية اللجوء قد تكون بيروقراطية.
يقول فاروسلاف ميميكا: «إن تمثيل الأكاديمية والبيروقراطية تدفع بمشكلة اللجوء لما قد نسميه ‘ادّعاء الخلاص’، ومبادلة التروما بمنح اللاجئ أرضاً للعيش. تلك النظرة التي تشكّل اللاجئ كضحية، وتنظر لنفسها كمُنقذة. والتي تتضمن وتديم علاقات القوى غير المتكافئة بين «هم» موضوع قلقنا، و«نحن» مصدر الحفاظ عليهم. ومع ذلك، نُصرُّ على رؤية اللاجئ بمصطلحاتٍ علمانية، باعتباره نتيجة طبيعية تستحق الشفقة، المساعدة، والحياة الجديدة. نحن في دول اللجوء سنخلّصهم من معاناتهم ونعوّضهم ما فقدوا. إننا نلعب على إظهار المعاناة الظالمة لقضية اللجوء، في حين أن السقوط الإنساني للاجئ الفرد قضية مهمشة، وكأن التروما تطهرت فجأةً متجاوزةً كل الخلل والنواقص الاعتيادية الأخرى. وهكذا فإن تحمّل المعاناة يكون «مقدمةً» ضروريةً للإنقاذ، بالطريقة نفسها التي استحقّ بها يوماً «العملُ الشاق» فترةَ «راحة». ولهجة الخطاب نفسها التي نظرت للسكان الأصليين باعتبارهم أناساً ‘صالحين’».
في شباط (فبراير) الماضي، ذهبتُ بدعوةٍ من صديقٍ يدرس في الجامعة للمشاركة في حدثٍ خيري نظمه المجتمع السوري بالتعاون مع المجتمع التركي، ضمن برنامجٍ لجمع تبرعات حملة إغاثة المنكوبين في البلدين. كان معظم الحاضرين من داخل الجامعة باستثناء بعض المتطوعين في جمعيات خيرية، وكانت اللغة الإنكليزية هي لغة الخطاب والحوارات الجانبية، مثلما هي اللغة الناطقة للجمهور على السوشيال ميديا.
قد تمثل اللغة الإنكليزية جانباً مجسَّداً من هذا الانفصال، إذ أن معظم السوريين اللاجئين ممن قابلناهم في المدينة لا يتحدثون الإنجليزية.
*****
مع مرور الأعوام سيحاول مجدي وزوجته الحفاظ على لغة أبنائهم العربية عبر اصطحابهم إلى المسجد، لعجزهما عن تحمّل تكاليف المراكز العربية لتعليم اللغة بأكسفورد.
في ظل الحياة الفردية القاسية، تطوّع مجدي للعمل في جمعية خيرية كمزارع في حدائق المسنين، باحثاً عن الألفة في الجنائن، والدفء داخل الحياة الاجتماعية للجالية. تعرّف مجدي على الأسر العربية التي يرعى حدائق منازلها، وحصل لاحقاً على رخصة قيادة بعد اجتياز الاختبارات باللغة الإنجليزية، ويعمل الآن، وبحوزته سيارة أنيقة، كموزع لمنتجات الأدوية لدى صيدلية بأكسفورد.
أثناء لقائنا في منزله بـ نيو إيدينجتون، كان علي ومحمود يجلسان على الكنبة المقابلة لنا مستغرقين في اللعب على أجهزة الهاتف، حين سألتهم باللهجة السورية:
-هل تتحدثون العربية؟ يرد عليّ محمود بالجواب التقليدي لأبناء العرب المهاجرين المولودين في الخارج:
- شوي.
- What do you play on your phones؟
- fortnite
- Can I play with you؟
- NO
تغريبة النساء
عام 2012، اضطرت فرح (45 عاماً حينها)، إلى الهروب مع أسرتها الصغيرة من ويلات الحرب إلى الأردن.
في عمّان، كانت أم فرح البالغة من العمر 71 عاماً تعدُّ الليالي أملاً في استقرار أوضاع الحرب بما يسمح لهم بالرجوع إلى الوطن. مرّت أربعة أعوام في الأردن، اختُتِمت بعبور المحيط إلى الاستقرار في بريطانيا. تتذكر فرح الآن كم هو سخيف مرور الأعوام؟ كيف للزمن أن يبرّر نفسه أمام الأم بعد مرور أحد عشر عاماً بلا عودة؟
بمجرد الاستقرار في أكسفورد، شعرت فرح بمدى صعوبة أن تسمي هذا المكان، بكل ما يحمله من غرابة وانعدام ألفة، وطناً. رغم أنها كانت تتقن الإنكليزية إلى حدٍّ ما، وجدت صعوبةً في التواصل مع الآخرين. احتاجت فرح شهوراً قليلة لاستعادة أنفاسها والتعرف على الحياة الجديدة قبل انخراطها في عالم الأعمال التطوعية. في جمعية كونكشن سابورت لمساعدة أسر اللاجئين، أخذت على عاتقها مسؤولية مساعدة الأسر والأفراد التائهين في المدينة، الباحثين بلا لغة عن عمل، والساعين لتعلم اللغة الإنجليزية.
تبدو لدى أسرة فرح قابلية موروثة على الاندماج مع الطبيعة المتغيرة والآخر المختلف. حصلت أمها «سوسو» على الجنسية البريطانية بعد سبع سنوات من إقامتها، لكن جنسيتها السورية أيضاً كانت مكتسبة، بعد أن تركت جنسيتها العراقية وأهلها المسيحيين في بغداد عام 1961 لتنضم مع زوجها، الذي وقعت في حبه، إلى عائلته المسلمة في الشام. وفي بيتهما المكون من غرفتين وصالة لاستقبال الضيوف، كانت سوسو تقطع مشاهدتها لقناة سورية تبث مشاهد من دمشق لتوجه إلينا ابتسامةً أو تتدخل لتأكيد بعض المعلومات التي تقولها فرح: «إيييه تركنا عمّان بعد 4 سنوات، وتركنا كل شيء وجينا».
كيف للذكريات أن تبدأ في أماكن جديدة، هل الانخراط هو إعادة تكوينٍ للذكريات؟ تسكين لذكرياتنا القديمة؟ إسكاتاً لأصوات الطفولة والأصدقاء والأماكن بداخلنا؟ لماذا يرتبط الانخراط دائماً بالانقطاع؟ لماذا يتعلق بترك أجزاء منا في الأماكن التي نتركها خلفنا بلا رجعة؟ تقول فرح إن الأشياء التي نتركها في الأماكن القديمة ونمضي، تحاصرنا في الفراغ الممتد والمحيط بنا في الأماكن الجديدة، حتى ولو أغرقتنا بالأشياء الجميلة، أو أغرتنا بالحلوى، تظل المرارة مقدرة داخل المذاق الحلو للأيام، كأثرٍ دائمٍ للفراغ الذي يفتّش فينا عن البيت، البيت الذي تركناه خلفنا في دمشق.
في الأسابيع التي سبقت الرحيل من دمشق ظهرت أولى أمارات الحرب في محيط البيت. حركة غير مألوفة في الشوارع، غرباء نازحون في الحدائق العامة، أصوات ليست بعيدة للمدافع يتبعها طلقات رشاشات آلية من مكان أقرب. لعدة ليالٍ لم تذق فيها النوم، ظلت فرح، العقل المدبر للأسرة، وأختها، تحرسان الباب خوفاً من اقتحام أحدهم البيت على بنات أختها النائمات في سلام، إلى أن قرروا أخيراً الرحيلَ الصامت تحت جنح الليل إلى الأردن: «خرجنا دون أن نودّع أصدقاءنا أو أحداً من جيراننا، خرجنا كسجناء فارّين».
البنات هنَّ كل ما يُبقي للحياة من معنى في تغريبة النساء. تعيش عليا وليلى (في أواخر العشرينيات) مع أمهما في منزلٍ قريب في الحي نفسه، بعد أن أنهين دراستهن الجامعية في لندن. تزوجت عليا بعد تخرجها من كلية الطب من شاب سوري يعيش بين بريطانيا وهولندا، وتعمل ليلى في إحدى المؤسسات الفنية لتنظيم المعارض.
في سوريا، لم تكن فرح تهتم بالأنشطة الثقافية، حيث عملت في مجال خدمة العملاء لدى إحدى شركات السيارات. لكنها خارج الوطن كرّست جانباً من حياتها للفن، فتطوعت أيضاً للعمل «كمنظمة فعاليات» و«كومينيتي كونيكت» ضمن برنامج «ملتقى»؛ المشروع الذي بدأه لاجئون سوريون في برلين كمساحة ثقافية تتيح للاجئين تمثيل حضارتهم وعرض ثراء مجتمعاتهم وخلفياتهم الثقافية، وذلك في متاحف ومعارض الدول المستضيفة. تقول فرح: «ربما يكتسب هذا المشروع اليوم أهميةً كبيرةً للمساهمة في صوغ التفاهم الثقافي وتقريب نقاط الالتقاء بين الشعوب المضيفة والمجتمعات اللاجئة أو المهاجرة إليها. خصوصاً في ظل تصاعد وتيرة العنصرية وسياق الرفض والكراهية النامي ضد اللاجئين في أوروبا وبعض دول العالم».

في معرض بعنوان «بيوت دمشق القديمة»، اقترحت فرح أفكاراً وقدمت مقتنيات شخصية تتعلق بالتراث السوري في متحف (pitt rivers) التابع لجامعة أكسفورد، والمعروف بكونه واحداً من أهم بيوت الكنوز الأنثروبولوجية في العالم. لوحات رسمها فنانون سوريون مجهولون، انتقتها بعناية لتقدّم معها رسالة افتتاحية للتعريف بالتاريخ المعماري السوري الدمشقي وتراث المدينة. وفي عام 2018، توقّعت فرح حضور 300 شخص إلى قاعة المتحف لمشاهدة مشروعها «الكريسماس لايت فيستيفال»، في حين أغلق المتحف الباب أمام القادمين بعد استقباله 1400 شخصاً. داخل المتحف الزاخر بالمعروضات العربية، أظهرت فرح جانباً من التعايش المسيحي والإسلامي في سوريا. من سياق الحرب الأهلية بالتحديد، عرضت لوحات من أعمال الفنان أكرم السويدان؛ الذي عمل على إعادة تدوير فني لمخلفات الحرب وبقايا القذائف من شوارع سوريا ليدخلها في نسيجه الفني.
تواصلت فرح منصور مع صديقها أكرم المقيم في ريف حلب الشمالي لتحصل على شجرة الكريسماس المزخرفة ببقايا القذائف المعدنية؛ شجرة كرنفالية لرأس السنة، جميلة جداً، على الرغم مما أحدثته يوماً من دمار. بالإضافة إلى قصاصات قرآنية تمثل المسيح كمفهوم لفلسفة النور، مع التمر والماء وفريق الإنشاد السوري الذي أحضرته ليغنوا بلكنة «شامية» محببة، ويرفعوا الآذان لأول مرة في تاريخ المتحف الشهير.

تؤمن فرح أن الفن يمكن أن يُخمِد داخلنا جروح العودة، أن يفتح لنا باباً للحكي، لتدوين سرديةٍ عن أنفسنا وعن الحرب والوطن، وأموراً كثيرة فشلنا فيها و فشَّلتنا، لنخبر العالم بها وبأنفسنا، تذكيرهم أننا ما زلنا هنا رغم الرعب والموت، لم نفقد إنسانيتنا رغم كل ما فقدناه، أن نوضح للعالم أن كل هذا العنف وهذه التجارب لا تقدِر على تدمير الإنسانية داخل شخص واحد.
تبتسم مديرة فرح حين تسمع صوت سيدة في المعرض تقول: «إنها من هنغاريا، وكيف أننا رغم الحرب متشابهون جداً في العادات والتقاليد والثقافة والملبس، وأن معرضها بالفعل نقطة التقاء ثقافية».
العمل الثقافي لأيّة جالية قد يكون بطاقة هويتها التاريخية، مساحةً تُعنى بنزوع المغتربين عبر التاريخ إلى إحساسٍ بالمكان والهوية؛ الالتقاء حول نقطة تربط الشتات بالوطن. هو صوت جماعي لمجموعات قد تختلف سردياتها وطرق رحلاتها في الحياة، لكنه يضمن الخروج من الصمت، صمت الوجوه والأماكن الغريبة، وبالتالي خطوة تاريخية للنجاة في عوالم قد تكون لا مبالية أو إقصائية.