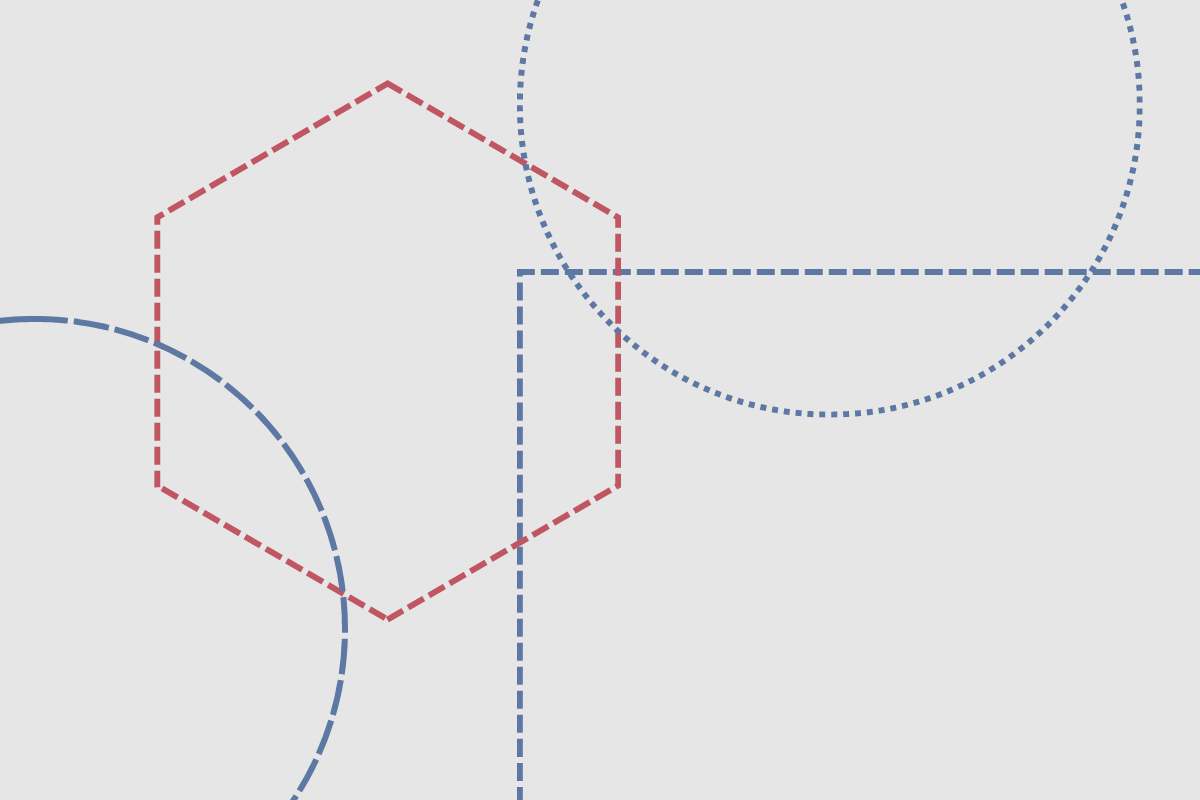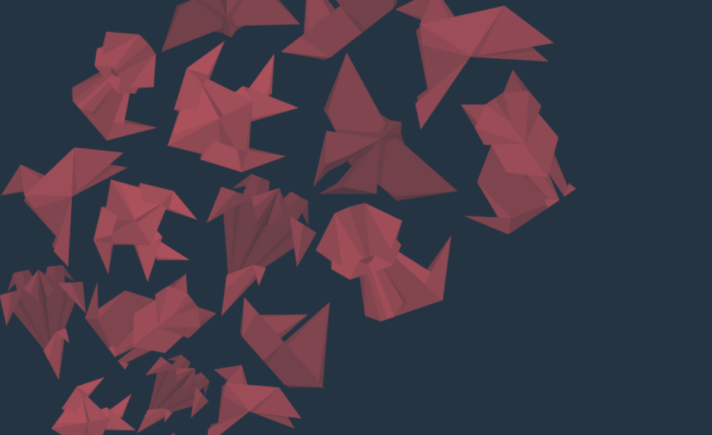«المساحات الآمنة» مصطلحٌ لطالما كُرِّر على مسامعي من خلال تواجدي كفاعلة في المجتمع المدني والحراك النسوي السوري. عوضاً عن التسليم لهذا المصطلح كعبارة جاهزة من بين عبارات ومصطلحات أخرى تدور في أجواء العمل الناشطي والشأن العام، ويتم تكرارها حتى تكاد تبدو مفرغة من معانيها، دَفعتُ نفسي لأفكر بشكل فاعل في معنى الأمان المرجوِّ تحقيقُه فعلاً في مساحات الحوار، بما يخلق توازناً بين وجود حالة مراجعة ونقد صحية تسعى لها هذه الحوارات، وبين المحافظة على حدود الأمان النفسي والذاتي، فلا تطغى حاجةٌ منهما على الأخرى، ولا تُنتِج المعادلة إما أجواءَ جائرة تدميرية تعمل وعملت سابقاً على عزل وإقصاء الكثيرات والكثيرين عن العمل في الشأن العام، أو مظلومية عصية على النقد.
مُنطلَقات الأمان كما فكرتُ بها، ضرورية مهما بدت متوقعة أو بديهية، مثل استطاعتنا التعبير دون الخوف من التعرض للسخرية والإهمال أو الرفض والإساءة، وأن تكون أفكارنا ومقترحاتنا مقبولة ومحط اهتمام للنقاش والتطوير دون تمييز على أساس العمر أو الجنس، دون تحيُّز شخصي وأحكام مسبقة تتلطّى خلف كيفية الاستجابة وتلقي هذه الأفكار، أحكام قد تكون متعلقة بالبيئة الاجتماعية ومكان الإقامة أو القومية أو الدين أو المذهب، وأن نكون قادرين-ات على التعبير عن أنفسنا وطرح كل ما يجول في خاطرنا بشفافية، والأهم أن تكون مساحات للتواصل الفعّال وتمكين بعضنا البعض على تطوير قدراتنا بالتعبير عن أنفسنا وأفكارنا. هذا ما يحفز الجميع على المشاركة بشكل فاعل، ويساهم في فهم أفضل لقضايانا، ويعزز من الأساس بالانتماء ويدعم أماننا النفسي الجمعي وصحتنا النفسية.
على الرغم مما توحي به هذه المعايير أو المتطلبات من بساطة وبدهية كما أسلفنا، لكن في الواقع لا تزال هدفاً بعيد المنال، بعد سنواتٍ طويلة من الاستبداد السياسي وآثاره على الحياة الاجتماعية؛ من الطبيعي أن تُلقي ظروف القمع والتضييق على حرية التعبير وتبادل الأفكار وسيطرة الشك والخوف، ظلالها على الأمان النفسي، وتعزز انعدام ثقة الناس ببعضهم البعض وفي المؤسسات على اختلاف أشكالها، ما ساهم بتعطيل دور المؤسسات الاجتماعية والمدنية في تعزيز مساحات الحوار والنقد من أجل التغيير والبناء، فبقيت الأفكار والرؤى مقيدة بالمسموح والممنوع الذي تفرضه السلطة الحاكمة أو بقية السلطات، حيث كرس القمع السياسي أنماطاً ثقافية مستبدة ذكورية، اتسمت بالهرمية والتمييز وعمَّقت أنماط الاستبداد والانقسامات.
حَمَلت الثورة السورية فرصة للتغيير وقلب موازين القوة، وجدنا كسوريين وسوريات فرصتنا للتجمُّع والتنظيم، واختبرنا أدوات عدة لبناء مؤسسات ومنظمات مدنية وحركات اجتماعية، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الثلاثة عشر للثورة، من خلال عملها على قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ونسوية وقانونية، ضمن سياق النزاع المتغير.
لم يكن العمل سهلاً، وكنا في مواجهة الكثير من التحديات، من جهة كان لا بدَّ من العمل على تجاوز الصعوبات التي يُخلِّفها النزاع وتلبية الخدمات في ظل غياب الدولة ومؤسساتها، وفي الوقت ذاته يجب العمل على التحرر من الرواسب التي خلفها الاستبداد في المجتمع، فكان لا بد من العمل على بناء أنفسنا وذواتنا من جديد، واستعادة الثقة ببعضنا. ومن جهة ثانية، علينا تطوير أدوات للحوار والمراجعة والنقد واختبارها واحتضان المساحة لمواجهة الأخطاء، دون أن ننسى أن على هذه المساحات إنتاج أفكار ورؤى، وفي بعض الأحيان خططاً ومشاريع.
وبالفعل بذلت المجموعات والمنظمات المدنية والنسوية كل جهد لخلق مساحات حوارية أطلقت عليها مسمى «مساحات آمنة»، وبدأت من خلالها فتح حوارات هدفها التعارف والتشبيك، ونقاش المشكلات والتفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول من شأنها دعم الحراك الشعبي، وبناء خطط واستراتيجيات لبناء سورية دولة مدنية ديمقراطية تعيش فيها جميع فئات الشعب السوري بمساواة وعدالة.
لكن عملية خلق التوازن كانت ولا زالت شائكة خاصة مع استمرار النزاع وتعقد سياقاته، وتحمل المجتمع المدني مهام أكبر من طاقته في أغلب المناطق السورية، ووجوب الاستجابة لاحتياجات متعددة ومتجددة في ازدياد مستمر للقضايا الأكثر إلحاحاً، وبقيَت أغلب مساحات المراجعة والنقد مجرد مساحات حوارية لها لون واحد، وغنية بالفوضى، وندر وجود مساحات تعمل بشكل مدروس على دعم أمان أعضائها، على صعيد المجموعة الواحدة أو على صعيد المساحات العامة، فبقيت مساحات المراجعة والنقد موضوعاً للعمل والتفكير، وأولى الأدوات التي يمكن البدء منها باتجاه تعزيز الأمان النفسي الجمعي.
نحو آليات مراجعة ونقد أكثر فاعلية
بُنيت العديد من مساحات المراجعة والنقد في المجتمع المدني، في كثير من الحالات، على مرجعياتٍ من تجارب ونماذج عُمِل بها مسبقاً في دول مختلفة. تعثَّر هذا المسار أحياناً في مفاصل تطلَّبت مواءمة هذه التجارب مع السياق الأكثر محليةً وحاجاته، وشكَّل العمل على تجذيرها فيه تحدياً، كي لا تبقى مقتصرة على البناء الشكلي مع بقاء رواسب عهودٍ من السلطوية الأبوية متغلغلة في تفاصيل التواصل وعلاقات القوة، وليكون خلق التغيير الجذري والعميق في البنية الاجتماعية وأنماط التفكير ممكناً. دون بذل جهود وانتباه فاعل لهذه المعضلة، من السهل أن تنتهي محاولات الحوار بمعظمها إلى إجماع قسري ينبذ المبادرات والمقترحات غير النمطية والمغامرة، ويرسّخ ثنائيات التمييز بين رجال ونساء وبين خبيرات وخبراء مقابل فئات شابة، بين متعلمين-ات ومن فاتتهم-ن هذه الفرصة رغم خبرتهم-ن الكبيرة على الأرض، بين الداخل والخارج، وبين ناشطات ونشطاء ذوي تاريخٍ وأقدمية وبين نظرائهم ونظيراتهن الأحدث خبرة. ،حتى الاختلافات الطبقية الاجتماعية، إن لم تلقى تمثُّلاتها مقاومة فاعلة، ستلقي بظلِّها على هذه المساحات التي ستتحول مع الوقت لمسرحٍ يكرس آليات السلطوية واحتكار المعرفة والقرار بلبوسٍ تحرري.
من المُجدي في هذا السياق، إيلاء الاهتمام لتقنيات بسط السلطة المختلفة وأشكال القمع الأكثر مواربة والأقل مباشرة مما تستخدمه السلطات التقليدية، في الأجواء المدنية والنسوية المنخرطة بالنقاشات العامة والناشطية والمناصرة، ورفع لواء الحقوق التقدمية قد يتّخد القمع من اللغة أداةً له، لفرض الرأي أو لإظهار التفوق بإتقان استخدام اللغة المحلية أو الأجنبية في التعبير، وفي براعة التراكيب وتجيير المصطلحات لصالح الرأي المطروح. يظهر ذلك جلياً بشكلٍ خاص في مساحات المراجعة والنقد ذات الصلة المباشرة مع اللغة اليومية التي تتيح للجميع المشاركة بأفكارهم وخبراتهم، على نحوٍ يفترض أن يكون أبسط مما يظهر أحياناً من نوازع استعراضية.
ومع ذلك تبقى اللغة جزءاً من الإشكالية التي تواجهها المساحات الحوارية، إذ يمكن أن يتم تبسيطها وجعلها ملامسة لحياتنا وواقعنا. فالمشكلة الأكبر في الذهنية الذكورية السُلطوية التي اختارت اللغة الجامدة لادعاء أنها أكثر معرفة، والتي تلغي النقد المبني على الحجة وتُضيِّع إمكانية استخدام الحوار البناء لإحداث تغيير اجتماعي، فأياً كان شكلها ونطاق قوتها، هناك أمر شبه مسلَّم به بما يخص السلطة: إنها لا تقبل النقد ولا تعترف به.
وبالتالي فشلت هذه المساحات في أن تكون مكاناً لطرح كل الأفكار بصفتها أفكاراً صحيحة، يمكن تحليلها ونقدها، وتطويرها والبناء عليها، من خلال النقاش الحر لجميع من يرغب بالمشاركة، كما أنها لم تعمل إلا فيما ندر على تطوير أدوات للنقد والتحليل المنهجي والذي يساهم في خلق وتطوير الوعي الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس النابعة من التجارب الخاصة للمشاركين-ات، والتي تدعم بدورها الأمان النفسي للمتواجدين في بعض المساحات المدنية والنسوية منها، وتكون خطوة باتجاه بناء أمان نفسي جمعي.
جهود تنظيم مساحات غنية بالفوضى
حاولت مساحات مدنية وأخرى نسوية العمل على الحد من الذهنية الأبوية وما ينتج عنها من سلطة، وخلقت العديد من الأدوات التي ساهمت إلى حد ما بمشاركة أفراد متنوعين ومن سياقات وثقافات وتجارب مختلفة، ومع ذلك تظهر إشكالية عدم وجود منهجية واضحة لهذه المساحات، التيبقيت تعتمد على الكلام الشفوي دون تفعيل أدوات تُتيح المتابعة في الحوار والمراجعة والبناء على مخرجاتها، كإحدى أدوات التغيير المجتمعي باتجاه التحرر من السلطوية من خلال تطوير أدوات النقد والتحليل.
ولأن أساس الحوار الهادف هو طرح الأفكار بشكل منطقي وممنهج، فإن اقتصارها على الشفوي وعدم تدوينها وكتابتها جعلها بعيدة عن التحليل بشكل منهجي، أو إمكانية تطوير الأفكار فيها. ومن جهة ثانية الثقافة الشفوية المسيطرة على مساحات المراجعة والنقد لا تخرج عن تكريس منطق الحوار الأحادي، إذ يتحول الحوار إلى خطاب، وتأويلات، وتبريرات. فنرى البعض يتبنى ما يتم طرحه بدون التفكير فيه ونقده ومعالجته، وتفشل المساحات في إنجاز هدفها بتطوير مهارات الحوار ومهارات النقد التي تتناغم فيما بينها عبر استخدام الحجج والبراهين.
وإذا كانت الكتابة والتدوين لهما أهمية بالغة في بناء المساحات وتطوير أدوات الحوار والمراجعة والنقد، فالهدف منها ليس بناء أجندات للحوار وكتابة مخرجات للأرشيف فقط، الأمر ليس بهذه البساطة، لأننا في الأجندة الواحدة نجد عشرات المشكلات المطروحة بدون منهجية واضحة، وبدون تبويب لها حسب الأولويات، وخلال الجلسة نجد سيلاً من الأفكار الجديّة والمهمة تُطرح، وفي كثير من الأحيان لا تتوافر منهجية للمتابعة والعودة لأصحاب وصاحبات الأفكار لتطويرها، وبالتالي خلق مساحات مستدامة للتحليل والتفكير العميق. بالمقابل يتم التركيز على الحلول السريعة والمباشرة كمخرجات للحوار.
وهذا انعكس على الواقع فعلياً، فالمشاكل لا زالت مستمرة، لأنه لم يتم تحليلها وفهم أسبابها بشكل عميق، ولا فهم جذورها وأولويات حلولها وتطوير حلول شاملة ومستدامة لها. مثلاً لا يمكن النقاش حول مواجهة الانتحار دون بناء عشرات النقاشات المعمقة حول أسباب الانتحار، وأين يمكننا التدخل والأهم كيف سوف نتدخل؟ وكيف سنستمر؟ مساحة كهذه لا يكفيها مثلاً عشر جلسات ومخرجات وانتهى الأمر، بل تحتاج أن تستمر سنوات وسنوات لكي تنتج أثراً حقيقياً وتغيراً على الأرض.
فإذا كان الهدف من خلق هذه المساحات أن تكون مُستدامة للنقاش والمراجعة والنقد، فلا بد من بنائها وتمكينها من أدوات تحقق هدفها. وغياب النقد وعدم فهم أهميته لبناء مساحات حوارية، أثَّر سلباً على جودة وفعالية هذه المساحات. فالتعامل السلبي مع النقد، والذي يتضمن استجابات سريعة وغير فعالة مثل الدفاع المبالغ فيه دون التفكير في محتواه، والذي ينتج عنه الاعتراض والغضب وأحياناً التجاهل، وكذلكميل بعض الأفراد لشخصنة النقد (لأخذ النقد على محمل شخصي)، يخلق صراعات داخل هذه المساحات ويكرس حالة عدم الأمان النفسي، بحيث يتراجع اعتماد النقد كأداة للتطور الفردي والجماعي، ليصبح أداةً لتصفية حسابات ضيقة، وهو ما يخلق جواً من الخوف من النقد شبيهاً بالخوف من سلطة الحاكم، وبالتالي يميل الناشطون والناشطات إلى تجنب نقد بعضهم البعض في اللقاءات والاكتفاء بالتمجيد والشكر أو الصمت والانسحاب.
مساحات مراجعة تدعم النقد وتعزز الأمان النفسي
في ظل التحديات الصعبة التي يعاني منها المجتمع المدني السوري والحراك النسوي، يُعتبر بناء مساحات للمراجعة والنقد، وتطوير أدوات التعامل مع الهشاشة تساهم في بناء وتعزيز الأمان النفسي في العمل، أمراً ضرورياً يتطلب منا جميعاً التعاون والعمل على بناء قدراتنا في التعامل مع النقد وعدم شخصنته والتأمل فيه بشكل إيجابي، واختبار أدوات تعزز التفكير النقدي والحوار البناء في بيئة العمل بشكل قصدي، وهذا يتطلب إعادة التفكير بمعنى القيادة، لتكون قيادة تشاركية أساسها العمل مع الآخر، واحترام التخصصات العلمية والمهنية، وتقدير كل الخبرات دون تمييز، فلكل فرد تجربته التي بنى منها خبرته، وآراؤه التي تستحق الإحترام وتتطلب تعزيز التفاعل الإيجابي وممارسة التقدير والثناء على الأفكار الجيدة دون تمييز، لأنه عندما يشعر الأفراد أنهم مُتفهَّمون ومقبولون يصبحون أكثر تفاعلاً ومشاركة في الحوارات وأكثر انفتاحاً في طرح الأفكار.
كما يجب العمل على جعل مساحاتنا محايدة، خالية من الحكم والتمييز والخوف من الانتقام، يستطيع فيها الجميع التعبير عن تجاربهم-ن ومشاعرهم-ن بحرية، وجعلها مساحة لتطوير مهارات الاستماع والتواصل الفعال والتعبير بوضوح، وممارسة مبدأ احترام آراء الآخرين بحيث يشعر الجميع حقاً أن أفكارهم-ن ذات قيمة، وبناء علاقات صحية داعمة تشجع ثقافة العمل الجماعي والشراكات المجتمعية من خلال تبادل المعرفة والخبرات والموارد، لتعميق التأثير الإيجابي لمنظمات المجتمع المدني السوري.
ولتحقيق ذلك لا بد من وضع إطار منهجي للحوارات يساهم في تحقيق أقصى استفادة من المناقشات والمخرجات، حيث يمكننا في ذات الوقت استثمار الجوانب الإيجابية للحوار الشفوي مثلاً في تعزيز التغيير الاجتماعي والحرية عن طريق تحويله لسرديات تتصدى للسلطوية، مع تطوير أدوات النقد والتحليل التي تعزز فهماً أعمق للقضايا، وتساهم في تطوير ثقافة نقدية منهجية تسهم في تقوية قدرة الأفراد على تقديم وتقويم الأفكار بشكل منهجي ومنطقي. من خلال هذا التحول، يمكن للحوار أن يتحول من كونه مجرد خطاب إلى أداة فعّالة لتبادل الأفكار وتطويرها، وتعزيز الفهم المتبادل وبناء الرؤى الجديدة، ومن جهة أخرى، والانتقال من حالة الكلام المحكي إلى تطوير منهجية لمساحات الحوار، تدعم توثيق وتحليل الأفكار والمخرجات بشكل مدروس ومنظم. بحيث تكون هذه المنهجية أداة لمتابعة النقاش وتبادل الأفكار بين المشاركين، وبين مختلف المجموعات ذات الاهتمامات المشتركة.
تُسهِمُ هذه العملية في تطوير الحلول الشاملة والمستدامة للمشكلات، بالإضافة إلى تحديد الأولويات وتوجيه الجهود نحو التحول الإيجابي. بالتالي، تصبح المساحات فعلاً مكاناً للتحليل العميق والتفكير النقدي المستدام، وذلك من خلال توظيف الكتابة والتدوين كأدوات تسهم في تحقيق التغيير على أرض الواقع.
أيضاً، من الضروري أن نتوخى على الدوام خلق مساراتٍ أكثر قرباً للواقع المجتمعي والمحافظة عليها، وأن نشجع المشاركة الفعالة والحوار المتبادل، في سبيل الوصول لمساحاتٍ قابلة بالفعل لاحتواء وجهات النظر المتنوعة، والبناء عليها لخدمة أهداف التجمعات المدنية والنسوية، والخطو باتجاه التغيير المجتمعي والسياسي المطلوب، تكون فيها اللغة وسيلة للتواصل وليس حاجزاً، عبر علاقتها مع اللغة اليومية التي تتيح للجميع المشاركة بأفكاره وخبراته.