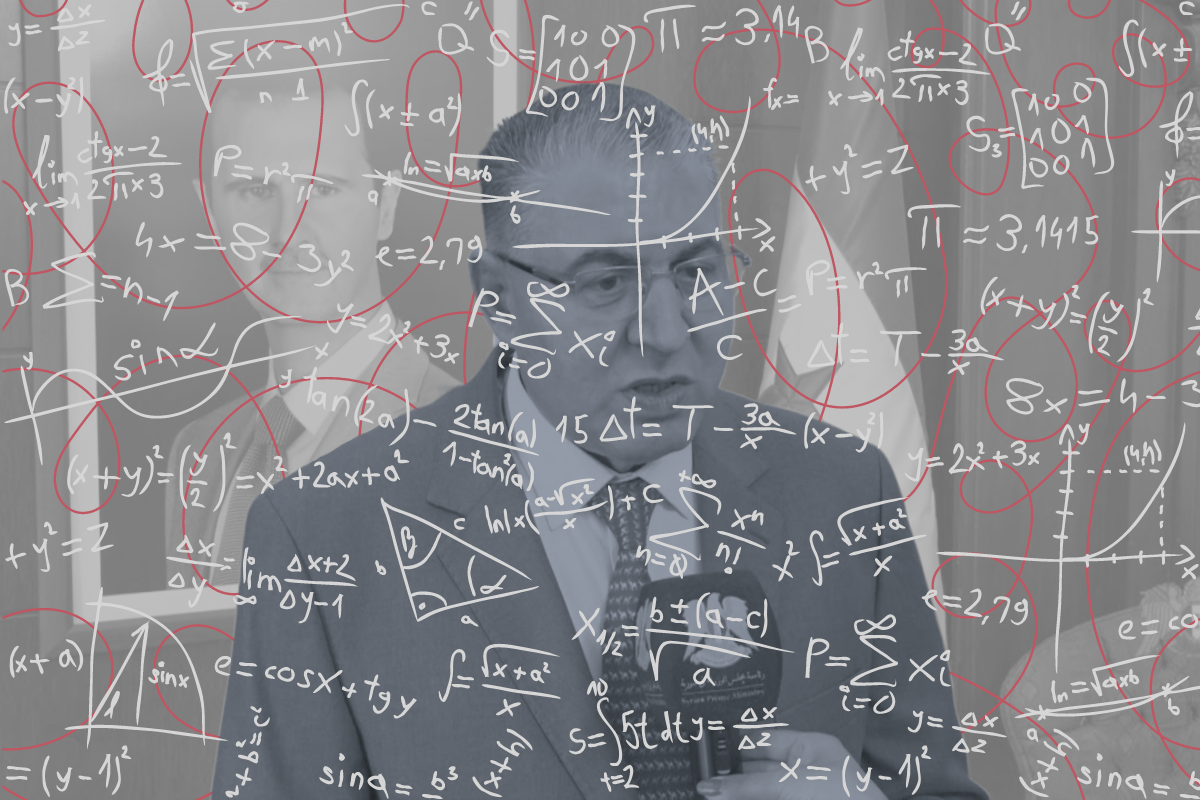عاد رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى تنفيذ الإصلاحات المفضلة لديه، عزل محافظ هنا ومعاقبة مدير ناحية هناك وتبديل وزيرٍ «فاسد» بآخر؛ حيث أصدر منذ أيامٍ قراراً بإقالة وزير التربية والتعليم، دارم الطبّاع، الذي اتخذ من نسف التربية ونقد التعليم عنواناً لمسيرته الوزارية التي امتدت لأربع سنوات، إذ قال في تصريحاته المثيرة للجدل لإذاعة شام إف إم المحلية الشهر الماضي، والتي يبدو أنها كانت المحرّض الأول لحملة المطالبة بإقالته: «يا أخي شو بدك بالبكالوريا؟ أصلاً عنا الهرم مقلوب، فالهرم في كل دول العالم يبدأ من القاعدة وينتهي في البكالوريا، وفي أوروبا ينتهي في الصف العاشر، حيث ينهون مرحلة التعليم العالي فيتعلّمون المِهَن ويدخلون سوق العمل ويُنعشون البلاد، بينما يتوجه قسمٌ منهم فقط نحو التعليم العالي، والقلة القليلة فقط من يتخصصون».
وتابع حديثه المُدينَ للتعليم الأكاديمي معتبراً إياه السبب الأساسي لعدم ارتياد الناس المسرح: «حياة الأكاديمي مو سهلة، بينما اللي بيشتغل بيعيش الحياة، بيطلع مطاعم، بيحضر سينما ومسرح ويطوِّر الحياة الاجتماعية. اليوم الناس نادراً ما تروح مسرح لأنو كلو قاعدلي بدو يقرا، وبدو يساوي جامعات، وبدو يطلع لفوق وبدو يساوي بروفيسور ودكتوراه!».
مَن تابع تصريحات الطبّاع طوال سنواته في الوزارة باستمرار لم يكن ليستغرب من الأخيرة كثيراً، فهي فحوى جُلَّ ظهوره الإعلامي، لكن ماذا لو كانت تنطوي على ما هو أكثر من آراء شخصية؟ على منهجية تجهيل متعمّد تقودها المؤسسات التابعة للسلطة، خصوصاً أنها تتسق تماماً مع التململ الحكومي من استمرار الإنفاق على التعليم، والمتمثل بظاهرتين أساسيتين؛ دعم المؤسسات التعليمية الخاصة، من مدارس وجامعات خاصة يملك معظمها أشخاصٌ مقرّبون من النظام والعائلة الحاكمة، وتقديم التسهيلات لها لتُدرّس ذات الفروع العلمية طويلة المدى التي ينتقدها الوزير، فيما تفتقر للفروع نفسها التي تفتقدها الجامعات الحكومية، رغم أنها «قُدِّمت» كرديفٍ للأخيرة، وليس بديلاً عنها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد خفضاً مستمراً لحصة التعليم، بشقّيه المدرسي والجامعي، من الموازنة العامّة، التي قد تكون تقديرية في أحيان وصورية في أخرى، التي تقرّها الحكومة نهاية كل عام من جهة أخرى؛ إذ هبطت حصة وزارتي التربية والتعليم العالي تدريجياً من 10 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة عام 2020، إلى 6.85 بالمئة عام 2023، بغض النظر عن حجم الموازنة الإجمالي وانخفاضه المستمر أمام الدولار، علماً بأن متوسط حصة التعليم من الموازنة العامة عالمياً هو 14 بالمئة.
لنستحضر تصريحاتٍ أخرى أدلى بها الوزير الطبّاع العام الماضي على شاشة الفضائية السورية، دعا فيها الطلاب إلى التعلّم المهني والابتعاد عن الدراسات الطبية، إذ قال: «أيهما أفضل؟ أن يدرس الطالب الطب ثم اختصاص، ويقضي 12 سنة، ثم يسافر بعدها لألمانيا ويخدم الألمان، أم يدرس معهداً مهنياً لمدة سنتين ويدخل إلى سوق العمل بعمر 20 سنة، ويحصد مليون ليرة (160 دولار حينها) شهرياً».
نظرة على واقع المدارس السورية من خلال تقارير وأخبار وسائل إعلام النظام نفسه، تكشف إنجازات وزارة الطبّاع التي غدَت بفضل القرارات الأخيرة المتعلقة بشروط الاستقالة سجناً إدارياً، لا يغادره مَن قضى فيه أقل من ثلاثة عقود، وذلك رداً على موجة الاستقالات في المؤسسة خلال السنوات الأخيرة في ظل العجز الحكومي عن رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الرسمي. من هذه الإنجازات أيضاً أنَّ توفير الكتب المدرسية مثلاً بات شبه معدوم، وأن الهيئات التدريسية في مختلف مناطق سيطرة النظام تعاني من شحٍّ في الموارد البشرية. وفي الوقت الذي لم يتمكن النظام فيه سوى من تأمين 64 مُدرِّساً فقط من العدد الكلي الذي طلبته مديرية القنيطرة في المسابقة المركزية العام الماضي للتنمية الإدارية، والبالغ 859 مُدرّساً، وفي الوقت الذي أفادت فيه مصادر محلية للجمهورية.نت بأن بعض المراكز الامتحانية في ريف دمشق طلبت من أهالٍ مراقبة القاعات في امتحانات الثانوية العامة الأخيرة لعدم وجود كوادر كافية للمراقبة، لم يجد الطبّاع ما يمنعه من أن يعرض على نظيره الإماراتي استيرادَ من تبقّى من المدرّسين خلال قمة تحويل التعليم في نيويورك.
الجامعات ليست بحالٍ أفضل
إن قرار إقالة الوزير الطبّاع لم يكن سوى إبرة مخدّر ووهم بالإصلاح اعتاده السوريون من بشار الأسد، يقول فيه للموالين بأنه ما زال «الرئيس الطيب المُحاط بالفاسدين» (أو العرصات وفق تعبيرٍ دارج)، إلا أن المشكلة لم تكن يوماً متعلقةً بالطبّاع، أو من سبقه، أو من تلاه. طوال السنوات الماضية، شهدت جامعة دمشق، وما تزال، العديد من الفعاليات. ولكي نكون منصفين، يمتاز بعضها بالطابع العلمي، إلا أن الإعلان عن تلك الفعاليات يقتصر على موقعها الإلكتروني الذي لا يمكن الولوج إليه إلا بضربة حظ، كحال معظم المواقع الحكومية الأخرى، وذلك لضعف البنية التحتية الرقمية، وعجز خوادم الدولة حتى الآن عن تركيب «موزّعات أحمال» تستطيع تنظيم تدفق الطلبات على مواقعها الرسمية. في الغالب، لا يعلم بفعاليات الجامعة إلا من كان مصادفةً في موقع الفعالية يوم حدوثها، بينما تم تخصيص مدرّجي الباسل والصيدلة، أكبر مدرجين في جامعة دمشق، طوال السنوات الخمس الأخيرة لاحتضان ورشات البرمجة اللغوية العصبية، وكُرّست الحملات الإعلانية التي أطلقتها كلية الفنون الجميلة لمعرض «الإمام الخميني في مرآة الفن السوري»، فيما يَشهد المخرج الإيراني جعفر بناهي، القابع تحت وطأة الإقامة الجبرية منذ عام 2010، على علاقة النظام الإيراني «الوطيدة» مع الفن.
أما أبرز العقول الأكاديمية التي استضافتها الجامعة في السنوات الأخيرة لتمنَح الطلاب فرصة الالتقاء بها والاشتباك مع خبراتها وثروتها العلمية بشكلٍ شخصي، فشملت رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، المقرّب من الملك عبدالله بن الحسين والمُقلَّد بوسام الاستقلال الأرفع في المملكة، والذي برز اسمه في وثائق باندورا عام 2021، ولا يكفُّ عن ترويج البروباغندا من خلال تلفزيون روسيا اليوم؛ وكذلك عبد الباري عطوان، الذي غدا من أبرز الأسماء الإعلامية العربية المروّجة لسياسات «حلف المقاومة» من خلال موقع «رأي اليوم» الذي يرأس تحريره، والذي جاء إلى كلية الإعلام ليؤكد أن «القمم العربية خلال السنوات الماضية فشلت فشلاً ذريعاً مع غياب دمشق، واليوم تتوجه الأنظار إلى قمة الرياض التي ستكون مختلفة، حيث ستكون سوريا هي عرّابة هذه القمة» وبأن «روسيا واجهت الغرب كاملاً في أوكرانيا».
لكن هذه بعينها هي التصرفات المتوقعة من جامعةٍ صارت تحت تهديد سحب الاعتراف من قبل أقرب جيرانها، واكتسبت مراتبها المتدنية على مختلف مؤشرات الترتيب العالمية بسبب انعدام الأمان وضعف الكوادر التدريسية وشبه انعدام النتاج البحثي وآلاف الشهادات المزوّرة. ولكن ما هي مبرّرات النظام السوري لهذا التدني دوماً: العقوبات الدولية أحادية الجانب؛ رجل القش الذي نجحت في إلقاء اللوم عليه في كل فشلٍ وتعثّر دون كلل، رغم أن العقوبات لا تفرض نوع الندوات التي تُقام في أروقة الجامعات، ولا المؤتمرات التي تعقدها، ولا ترغمها على الالتزام بمنهجٍ تعليمي لم يُمسّه التطوير منذ سنين.
مناهضة الفكر في مختلف مراحله
يمكن قراءة كل ما سبق من ممارسات في ضوء إيديولوجية «مناهضة الفكر» (Anti-Intellectualism) القائمة على العداء وعدم الثقة بالفكر والمثقفين، والاستهانة بالتعليم والفلسفة ونبذ الفن والأدب والعلوم باعتبارها مساعٍ بشرية غير عملية وذات دوافع سياسية، وحتى مُحتَقَرة في بعض الأحيان. يقدّم مناهضو الفكر أنفسهم كأبطال لعامة الشعب، شعبويّون ضد النخبوية السياسية والأكاديمية، ويميلون إلى رؤية المتعلمين على أنهم طبقة تهيمن على الخطاب السياسي والتعليم العالي، بينما يتم فصلهم عن اهتمامات الناس العاديين. وفي هذا السياق نتذكّر حديث وزير التربية السوري القائل إن الشخص الذي يعطي حياته حقها اليوم في المجتمع، هو غير الأكاديمي الذي يعمل عملاً «عادياً»، وليس الشخص مادةُ التهكّم الذي يرغب في تحصيل الشهادة الجامعية أو الدكتوراه.
لطالما كانت مُناهضة الفكر أداةً بيد الأنظمة الشمولية في الماضي، لقمع المعارضة السياسية واجتثاث بذورها في مختلف القارات والحقب الزمنية، ففي عام 1966 على سبيل المثال، اقتحمت قوات الديكتاتور الأرجنتيني خوان كارلوس أونجانيا المناهض للشيوعية جامعة بوينس آيرس لطرد الأكاديميين الخطرين سياسياً من خمس كليات مختلفة، في أحداثٍ دامية عُرفت لاحقاً باسم «ليلة العصي الطويلة». ولا يمكن إحصاء ليالي ونهارات العصي الطويلة والمزودة بالكهرباء، التي عاشتها جامعة حلب والمدينة الجامعية في دمشق عام 2013، العام الذي شهد توقيفاً شبه تام وممنهج للعملية التعليمية في المدن والمحافظات السورية التي شهدت تواجداً أكبر للمعارضة ورقعة احتجاجاتٍ أوسع.
التاريخ السوري القريب حافلٌ بمثل هذا النهج الذي طال مجمل العاملين في الشأن الثقافي، إذ هناك عشرات المثقفين السوريين المنفيين إلى الخارج، وعشراتٌ قضوا سنوات طويلة في السجون من بين مئات آخرين لم يحالفهم الحظ بالخروج ليحكوا قصصهم، حتى لم يبقَ داخل الجغرافيا السورية سوى النذر اليسير من المثقفين، الذين إما سُمح لهم بالبقاء في الداخل وتمكّنوا من التعايش مع حقيقة حظر أعمالهم أو عدم قدرتهم على العمل أصلاً، أو تعيّنَ عليهم صَبُّ إنتاجاتهم وكتاباتهم في قوالب خيالية ليتمكّنوا من الرقص ضمن حدود الهامش الضيّق المُتاح لهم.
أما القطاع الصحافي والإعلامي فيرسم صورة قاتمة، حيث توقفت الصحف الورقية عن الصدور بشكلٍ نهائي في سوريا عام 2020، إلا أن أكشاك بيعها والمكتبات لم تنعم قبل ذلك بأفضل تشكيلةٍ من خارج الصحف المحلية شبه الرسمية التي تنطق بلسان الدولة، خصوصاً مع قانون «مكافحة الإرهاب» رقم 19 الذي أُقرّ عام 2012، والذي حكم بالأشغال الشاقّة على أي نشاط عملي أو فكري بالقول أو الكتابة، يؤديه أي شخص من خلال توزيع المطبوعات أو استخدام موقعٍ إلكتروني بقصد «الترويج للإرهاب»، وليس خفيّاً على أحد التعريف الفضفاض للإرهاب في قاموس النظام. ولم تنجُ من ذلك الصحُف والمنابر التي غادرت إلى الخارج وتوجهت بنشرها نحو الإنترنت؛ لتبقى حرية الوصول إلى المعلومة، بغض النظر عن دقتها وصدقية مصدرها، شبه معدومة في ظل حجب «أرشيف الإنترنت» برمّته، ومعظم المواقع الإعلامية العربية الكبرى في سوريا على اعتبار أنها «مموّلة من قبل حكوماتٍ وأجهزة استخبارات معادية لسوريا». كما أن السوري الذي لا يملك VPN لن يستطيع الوصول حتى إلى المواقع الإعلامية أو الثقافية السورية المستقلة، مثل هذا الموقع، وعنب بلدي وحكاية ما انحكت ونشرة سيريا ريبورت الاقتصادية وجريدة قاسيون، ولا ننسى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أحصت اعتقال واختفاء 387 عاملاً وعاملةً في قطاع الإعلام منذ العام 2011 وحتى مايو (أيار) 2022.
في كتابه «حرب الحرم الجامعي» (The Campus War)، كتب الفيلسوف الأميركي جون سيرل: «من أبرز سمات حركة مناهضة الفكر عداؤها للجامعة كمؤسسة. المثقفون، بحكم التعريف، هم أناس يأخذون الأفكار على محمل الجد. إذ يعدّ مهماً لهم ما إذا كانت النظرية صحيحة أم خاطئة، بصرف النظر عن وجود تطبيقات عملية لها. بينما في حركة مناهضة الفكر الراديكالية، يتم رفض القيمة الفكرية للمعرفة بحد ذاتها، ولا تُرى المعرفة ذات قيمة إلا عندما تكون أساساً للعمل» أو تحقيق مليون ليرة شهرياً مثلاً بحسب الوزير المُقال.
في نهاية المطاف، لم ينتبه أحد للتبدلات العميقة التي قلبت مفاهيم التعلُّم والثقافة في سوريا، فالجامعة، على اختلاف الكليات، غدت وقتاً مستقطعاً لتحضير وثائق الهجرة دون القلق من شعبة التجنيد، ومكتبات البلاد الكبرى تتساقط واحدةً تلو الأخرى، فبعد مكاتب ميسلون واليقظة والزهراء، أغلقت مكتبة نوبل أبوابها نهائياً، بأرشيفها الذي هُزم أمام «العادات السبع للناس الأكثر فاعلية» المتصدر للواجهات المكتبية في الوقت الراهن، بينما واجهت مكتبة كردية «الكثير من الظروف التي أسهمت في الإغلاق وعدم القدرة على الاستمرار»، رغم تأكيد مؤسِّسها على أن انخفاض المبيعات وعدد القرّاء ليس واحداً منها. أما سوق العمل الذي يدعو السيد الوزير إلى هجر المدرّجات والسباق نحوه، يبقى رافضاً لجميع الوافدين دون أية تفرقة.