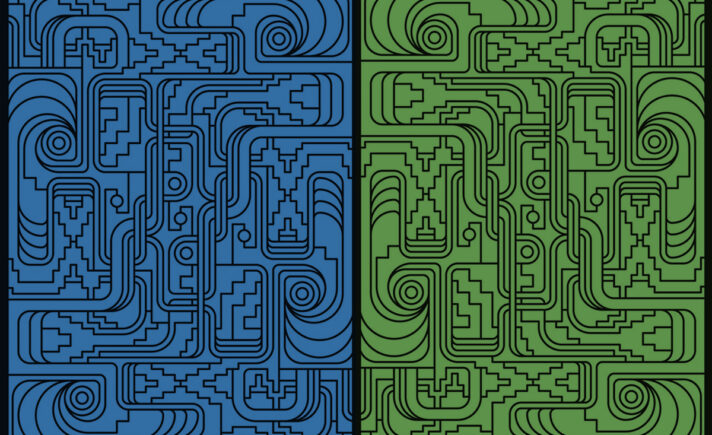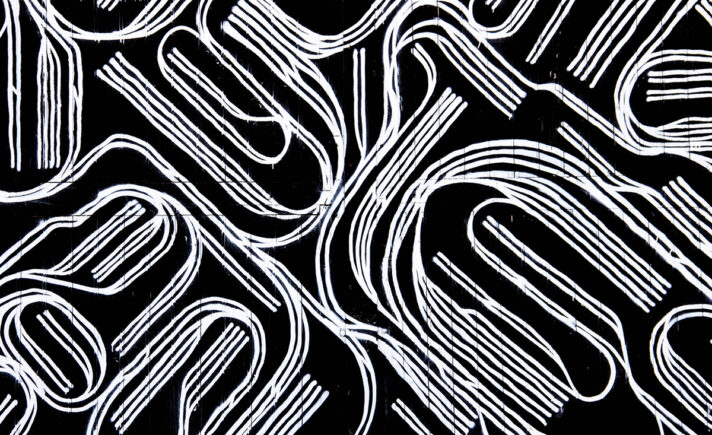يتورّطُ التفكير حول التنوير بالسؤال حول العلاقة مع الاستعمار والهيمنة الغربيَين، سواء كانت هذه العلاقة فعلية أم مُتخيَّلة. فالعصر الحديث باعتباره عصراً غربياً هو عصر التنوير كما هو عصر الاستعمار في آن واحد، وهذا التلازُم بين التنوير والاستعمار وسيطرة أوروبا على العالم لم يقتصر على التلازُم التاريخي، إنما بدا وكأنه تلازمٌ شرطيٌ حيث قَدَّمَ عددٌ من فلاسفة التنوير المُسوِّغات الخاصة بالدعاوى الاستعمارية للغرب وسيطرته على العالم باسم التقدم والتفوق الحضاري وما يلزم عنهما من مهمة خاصة بالغرب تجاه العالم. وبهذا بَدَت سيادة العقل التي بشَّرَ بها التنوير وكأنها تبريرٌ للسيطرة والهيمنة الأوروبية على العالم، باعتبارِ العقلِ نتاجاً أوروبياً حصرياً، فصارت سيادةُ العقل وجهاً آخر للسيادة الغربية، كما أصبحت حقوق الإنسان ذريعة مستمرّة للتدخل الغربي في دول العالم وفرض تصوراته وسياساته عليها.
لم يقف هذا التلازم عند التجربة الاستعمارية فحسب، وهي انقضت على أي حال، بل تَعدَّاها إلى تسويغ الهيمنة الغربية على العالم بعد انتهاء الاستعمار. فسيادةُ العقل والدعوة إلى منظومة من القيم الكونية ظهرت بوصفها شكلاً آخر من المركزية الغربية، وتسويغاً خفيّاً لها، وسعياً لإدامتها على المجتمعات الإنسانية الأخرى التي تمت معاملتها وكأنها بقايا تقاليد مُفوَّتة ومُتعارضة مع كونية الإنسان وقيمه، وبالتالي يجب التخلص منها أو إقصاؤها، على الأقل، من المجال العام وحبسها في حدود التجربة الشخصية للأفراد، فلا يعود لديها ما تقوله حول العالم ونظامه الأخلاقي وما يرتبط به من تصورات حول العدل والحرية والاعتراف. فالدعوة إلى التنوير والعقل تَظهر وكأنها ليست سوى دعوة إلى التَمثُّل بالغرب ومحاكاته بوصفه المسار التاريخي الإجباري لنا، وهو ما يلزمنا ضمناً بالخضوع له بعد أن نتعرّى من «تقاليدنا» التي كانت تمدُّنا بالقيم والقوة والوحدة. تبدو المُطابقة هنا تامّة بين التنوير والغرب، وكأنَّ المجتمعات الأخرى التي لم تعرف التنوير، كما يفهمه الغرب، لم تعرف البتة قيماً عقلانية وأخلاقية كونية وإنسانية. فالغربُ هو الكونية، فيما تصبح المحلية سِمة لمجمل الحضارات والثقافات غير الغربية، التي لا يَنتظر منها أحدٌ أن تقول شيئاً بخصوص الكوني والإنساني الذي بقي مخصوصاً بالغرب.
يمكن من البداية مُساءلة افتراضِ التلازُم بين التنوير والاستعمار، كما تُقدِّمه الفقرات أعلاه، انطلاقاً من العديد من التجارب التاريخية. فمنذ التاريخ المبكِّر للتنوير كانت العلاقة أكثر توتراً ممّا يَفترضه الطرح أعلاه، فقد كان التنوير مصدراً أساسياً لإلهام العبيد الثائرين في هايتي، الذين استلهموا حقوق الإنسان وقدَّموا للعالم نسختهم المحلية من اليعقوبية السوداء المتأثرة باليعقوبية الفرنسية خلال الثورة الفرنسية. بالطبع قامت القوات الفرنسية، دون غيرها، وبشكل كلبي تماماً، بالقضاء على الثورة الهايتية. لكن هذا الاستلهام يُشير إلى الدور الثوري الذي لعبته قيم الثورة الفرنسية في انتفاضة وتَمرُّد المجتمعات المُستعمَرة في مواجهة الاستعمار نفسه، كما في مواجهة طُغاتها الخاصين، حيث كانت قيم الثورة الفرنسية والتنوير ملهمة لمجمل الحركات الثورية منذ القرن التاسع عشر وما تلاه، الأمر الذي تابعَتْهُ لاحقاً حركات التحرُّر الوطني في العالم الثالث، التي استلهمت بدورها قيم التنوير والتراث الثوري الأوروبي بعد الفصل بينها وبين الاستعمار وما تلاه من استخدام ذَرَائعي لهذه القيم في السياسات الغربية.
لاحقاً، وبشكل تدريجي، وانطلاقاً من التاريخ الأوروبي وما رافقه من مُعضلات وتحديات، أصبح للنقد وِجهةٌ أكثر جذرية. فالتنويرُ والعقلُ نَفسُهُما صارا موضوعاً للنقد بوصفهما أدوات سلطة وهيمنة، وبوصفها أدوات أساسية لتشكيل تصوراتنا عن العالم، وهي تصورات مرتبطة بالسلطة والهيمنة. انطلقَ هذا النقد الجذري للتنوير وسيادة العقل من مسارات أوروبية مَحضة، وبالإحالة إلى مُعضلات أوروبية، وقد قامت الدراسات ما بعد الكولونيالية بنقل هذه الخُلاصات إلى العالم الثالث. وقد صار التلازم التاريخي بين التنوير والاستعمار، ولاحقاً المركزية/الهيمنة الغربية، لدى هذه المدرسة تلازماً تأسيسياً يفرضه التنوير نفسه. ووجدت هذه الفكرة الأساسية أرضاً خصبة لها لدى الدعوات الأصولية، ولدى نسخ متعددة من الدعوات الأصلانية (الخاصة بالعودة إلى الهوية الخاصة بالسكان الأصليين بمعزل عن محتوى هذه الهوية)، دون أن يأبهوا كثيراً إلى المصادر الغربية لهذا النقد نفسه.
إضافة إلى ما تمّت الإشارة إليه حول طبيعة هذا التلازم المتوترة، والدور الذي لعبه التنوير في تعزيز الأفكار الثورية والتحررية في العالم الثالث، فإن هناك معضلة أخرى تقف أمام مثل هذه القراءات النقدية، وخاصة في نُسَخها الأكثر جذرية، وهي افتراضُ أن التنوير شيءٌ صَلدٌ موحدٌ يمكن تعيينه وتحديده. ومثلما كان من الممكن مُساءلة افتراض التلازم الضروري بين التنوير والهيمنة الغربية، فإنه يمكن مُساءلة التصور الصَلد للتنوير، فلا يعود التنوير شيئاً واحداً واضحاً ومفهوماً بذاته، بل يُحيل إلى طبقات وأصوات متعددة، إلى تيارات متباينة ونزاعات داخلية.
ففي حين تناولت المقالة السابقة محاولات النظر في التنوير وضد التنوير، فإن هذه الورقة تُحاول النظر في تقاليد التنوير المتباينة والقراءات والرهانات المختلفة التي تُحيل إليها، انطلاقاً من عملين مختلفين يقدمان قراءتين متباينتين لتقاليد التنوير المتنوعة، ودوماً بالإحالة إلى سؤال التلازم بين التنوير والإرث الاستعماري، وبشكل أكثر تجريداً التنوير والهيمنة.
من أجل تنوير مُعتدل
ينطلق دان دينر في تأريخه ومُساجلته حول التنويرDan Diner, Aufklärungen: Wege in die Moderne, Reclam, 2019. من معضلة ذات وجهين: الأول إشكالية العلاقة التي تجمع التنوير بالهيمنة الغربية، والثاني هو مَساعي المجتمعات غير الغربية لتحقيق مُصالحة بين العالم الحديث من جهة وتقاليدها المحلية، وذلك في مواجهة الأصوليات الصاعدة. فسؤال الحداثة مطروحٌ علينا جميعاً: كيف لنا أن نكون حداثيين؟ لكن هذا السؤال لا يستقيم دون وجهه الآخر المرتبط بالعلاقة مع تاريخنا وثقافتنا (والدين الذي يشكل الأساس من هذه الثقافة لدى قدر كبير من المجتمعات غير الغربية)، وما يُرافقهُ من مواجهة مع الأصوليات والنزعات القومية المتصاعدة. كيف يمكن لنا أن نكون حداثيين، دون أن نَخضع للهيمنة الغربية؟ كيف يمكن لنا أن نكون حداثيين ونعيش في الوقت ذاته متصالحين مع تقاليدنا؟ وخاصة إن كان الدين يلعب دوراً جوهرياً في تحديد هذه التقاليد وفي قلب صورتنا للعالم. هذا هو التحدي الذي يسعى دينر إلى التعامل معه وتقديم إجابته عنه، وذلك في معارضة للصورة العامة التي قدمها النقد السابق، التي تَعتبر أن هناك نوعاً من حلف بين التنوير والغرب في مقابل تَعارُض غير قابل للحل بين التنوير والتقاليد الأخرى وبشكل خاص الدينية منها.
ينطلق دينر من فكرة مركزية تقول بعدم وجود طريق واحد إلى الحداثة، بل طُرُق متعددة في التجربة التاريخية الأوروبية للتنوير. حيث يشير إلى تقاليد متباينة شَكَّلت بدورها طرقاً تاريخية مختلفة للحداثة والتنوير في أوروبا. يُميّزُ دينر بين تقليدين مركزيين داخل التنوير، التنوير الراديكالي والتنوير المعتدل، وذلك انطلاقاً من موقفهما من الدين ومكان العقل في نظام العالم وعلاقته بالدين كما يراها كل من هذين التقليدين. فهناك التقليد الاسكتلندي المُعتدل المُتصالح مع الدين، والذي يجد أصوله النظرية في المسيحية نفسها وخاصة نسختها البروتستانتية – الكالفينية. وفي مقابله يقف التنوير الراديكالي في نسخته الفرنسية، الذي يضع العقل في تَعارُض تامّ مع الدين، ساعياً إلى جعل العقل معياراً نهائياً للسلوك الإنساني في مواجهة تامّة مع اللاهوت.
لدى مناقشته للمسألة الأخلاقية، يُبيّنُ دينر اعتماد التنوير الاسكتلندي على الحسّ العام الذي فُهم بوصفه منحة إلهية يملكها كل إنسان (الفطرة)، تُمكِّنُه من التمييز بين الخير والشر، وبهذا يكون الحسّ العام صيغة مُعلمَنَةً عن الضمير المسيحي.

كما تناوَلَ دينر تَصوُّرَ الأخلاق والمنفعة في التنوير الإسكتلندي، الذي نظر إليهما بشكل براغماتي باعتبارهما يقفان على أرضية مشتركة تتمثَّل في الحرية المعطاة للإنسان لتحقيق ذاته. بالنسبة إلى آدم سميث، فإنَّ كُلّاً من العقل والدين يُسهمان في التمييز بين الصح والخطأ، وبالتالي فإن السلوك العقلاني للإنسان لا يعني بالضرورة ابتعاده عن الدين ورفضه، وهذا ما يخالف التصور الفرنسي الراديكالي للتنوير. لهذا نظر سميث إلى الاقتصاد والأخلاق بوصفهما وَجهين للسلوك الإنساني، يؤسسان سوية للأخلاق والأحكام الأخلاقية. وكان سميث في هذا يتابع أحد أساتذته، فرانسيس هِتشسون، الذي اعتبر أن الغاية من الوجود الإنساني وتحقيق الإنسان لذاته تكمن في السعادة التي اعتبرها حالة من الرضا الروحي، وبهذا فإن تحقيق الرغبات الذاتية (المنفعة) تصبح بدورها شكلاً أعلى للأخلاق، وهو ما يُسهم بدوره في التأسيس للحرية. وقد ضَمَّنَ هِتشسون هذه الأفكار في عمله «A System of Moral Philosophy»، الذي هاجم فيه العبودية باعتبارها انتهاكاً للحرية، وهو الكتاب الذي تَحوَّلَ لاحقاً إلى إنجيل حركة مناهضة العبودية في فيلادلفيا. بدوره، تمثَّلَ توماس جيفرسون، مؤلف إعلان الاستقلال الأميركي، التقليد الاسكتلندي للتنوير في فكرته عن «البحث عن السعادة» في إعلان التأسيس، وهو لا يعني مجرد الرخاء الفردي، بل يَتمثَّلُ في الخير العام المُتمثّل في المشاركة في الشأن العام. كما حاجج توماس في أن الملكية الخاصة تنتمي إلى تحقيق الذات وأنّها أحد شروطها، فمن طبيعة الإنسان أن يكون لديه شيءٌ ما. الفكرة الأساسية التي تنتظم حولها هذه التصورات هي أن الأخلاق والاقتصاد يتكاملان ويجدان تأسيسهما في الحرية المعطاة للإنسان لتحقيق سعادته، وهي الغاية التي تسعى الأخلاق والاقتصاد (انطلاقاً من تَصوُّر نفعي) إلى تحقيقها.
مثلت الثورة الأميركية، وأميركا نفسها في مرحلة تالية، التعبير الأمثل عن هذا التقليد التنويري. فهناك اجتمعت العَلمَنة والعَقلَنة والرخاء لتصبح ثقافة جماهيرية. وهنا يجب فهم العَلمَنة والعَقلَنة والرخاء في إطار التقليد الاسكتلندي للتنوير، الذي لا يقدِّم هذه المفاهيم في إطار مُعارَضَةٍ للدين، بل من خلال تصالح وتكامل معه، تتأسس على محورية فكرة الحرية التي يتمتع بها كل إنسان لتحقيق ذاته، وهذه التصورات الثلاثة تصبح شروطَ تحقيق الحرية والسعادة لكل فرد.
في مقابل التقليد المعتدل، يعرض دينر تقليداً راديكالياً يضع العقل في موقعٍ مُعادٍ للدين، ويرى في العقل المعيارَ الحاسم في مواجهة صَرفة مع اللاهوت (يعبر عنه التنوير الفرنسي، ونسخته الأكثر راديكالية هي الموسوعيون والماديون الفرنسيين، لكن أيضاً فولتير وروسو). ﻻ يقتصر هذا التنوير على الدخول في نزاع مع الدين، لكنه، وانطلاقاً من فَرض العقل بوصفه حَكَماً نهائياً، ينتهي بدوره إلى تقديم نسخة وحيدة من الحقيقة (والعقل) علينا قبولها، وهو ما يفتح الباب على المآلات الشمولية للنزعة الثورية لهذا التيار، كما ظهرت في اليعقوبية الفرنسية مبكراً ولاحقاً في الشمولية الشيوعية. وهذا نقدٌ يُذكّر بنقد أشعيا برلين للتنوير، ويستدعي أيضاً نقد حنة آرنت للثورة الروسية.
بحسب دينر، تبدو الشمولية نتاجاً ممكناً للتنوير الراديكالي الذي ﻻ يستطيع أن يُقدم لنا مساعدة في مواجهة الهيمنة الغربية وفي محاولة تجاوز إرثها الاستعماري، وذلك نتيجة عدائه للدين والتجارب الروحية والتاريخية المغايرة للمجتمعات الأخرى، ونتيجة تصوره الأحادي عن العقل بما يجعل منه سلطة (أو حجاباً للسلطة). بالمقابل، يُقدّم التنوير الاسكتلندي خياراً تنويرياً ممتازاً في مواجهة الأصوليات المنبعثة، فهو تنوير مُتصالح مع التجارب الروحية وهو نفسه منغرسٌ في تقليد ديني. إن مكانةُ العقل المتواضعة لدى التنوير الاسكتلندي قياساً بالتنوير الراديكالي، وتركيزه على الحرية وحماية الفردانية (الليبرالية)، تعطيه قوة في مواجهة النزعات الشمولية سواء التنويرية أو ضد-التنويرية. لهذا يبدو التنوير الاسكتلندي، بحسب دينر، خياراً أكثر مُلائمة وقابلية للتحاور مع متطلبات المجتمعات غير الغربية ومَساعيها للتصالح مع الحداثة، ويقدم استجابة تنويرية متصالحة مع التراث الديني، حتى أنها تجد جذورها في التقليد الديني نفسه. وانطلاقاً من هذه المصالحة نفسها، فإن هذا التقليد قَدَّمَ خدمة جليلة لفكرة الحرية وربطها بالوازع الذاتي للإنسان للاختيار وتمييز الصواب من الخطأ، دون أن ينزلق باتجاه تصورات شمولية ونِزاعية انزلقَ إليها التقليد الراديكالي للتنوير، الذي سعى إلى جعل العقل معياراً أوحدَ مضاداً للخبرات الإنسانية المتنوعة، وخاصة الدينية والداخلية التي يتم دمغها باللاعقلانية، وهي مواجهة كانت أكلافها مهولة، وكانت الحرية نفسها أول ضحاياها.
من أجل تنوير راديكالي
من موقع مغاير، ينطلق جوناثان إسرائيل في كتابهJonathan Israel, A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the intellectual origins of modern Democracy, Princeton University Press, 2010. ثورة العقل: التنوير الراديكالي والأصول الثقافية للديمقراطية الحديثة من قسمة شبيهة للتنوير إلى تنوير معتدل وآخر راديكالي، غير أنه يعتمد مروحة أكثر سِعة من المعايير تتضمن الميتافيزيقيا (المادية) والسياسة (النزعة الجمهورية والمساواتية) للتمييز بين التقليدَين. وبهذا يصبح فولتير تنويرياً معتدلاً وروسو له مكانة خاصة عند جوناثان إسرائيل (وقد كانوا لدى دينر أمثلة عن التنوير الراديكالي)، بينما يجد الجمهوريون من كل الخلفيات، وأيضاً جماعات الكويكرز أنفسهم، أنصاراً للتنوير الراديكالي الذي تبقى نواته الصلبة مُمثَّلة بالموسوعيين والماديين الفرنسيين، كما يُمثل التنوير الاسكتلندي النواةَ الصلبة للتنوير المعتدل.
لكن في تباين تامّ مع دينر، يجد إسرائيل ضالَّته في التنوير الراديكالي وليس في التنوير المعتدل. فالتنوير الراديكالي المؤسَّس على ميتافيزيقيا مادية يُعطي السيادة النهائية للعقل كحَكَم على كافة شؤون الحياة؛ مثل السلطة والقانون والتنظيم الاجتماعي وحتى فيما يتعلق بتأسيس الأخلاق، وبهذا يُقدِّمُ التنوير الراديكالي جداراً في مواجهة اللاعقلانية بكل أشكالها، بدءاً من النازية والفاشية وانتهاءً بالأصوليات. كذلك يدافع التنوير الراديكالي عن موقف مساواتي بين البشر دون أي تمييز قائم على العرق أو الثقافة أو الدين، وأيضاً عن التسامح وحرية الرأي غير المُقيَّدة. وهذا الموقف المساواتي الجذري يصل إلى مداه في الدفاع عن فكرة جمهورية كونية، مع إمكانية سلام كوني بوصفها إمكانية حقيقية.
تأسيساً على هاتين المقدمتين، سيادة العقل ومساواة جذرية، يقف التنوير الراديكالي في مواجهة كل الهرميات الاجتماعية تحت أي ذريعة، وخاصة الدينية منها بوصفها مسؤولة عن الظلم والقهر الاجتماعيين، بما يجعل هذه الهرميات الاجتماعية تقف في تَعارُض مع السعي إلى تحقيق السعادة والتقدم الإنسانيين اللذين ﻻ يتحققان إلا عبر حُكم العقل. وهنا يكمن التباين الجذري بين التنوير الراديكالي ونظيره المعتدل، الذي لم يدرك أهمية الثورة الاجتماعية والسعي إلى تحقيق الديمقراطية الجذرية. هكذا يحاجج إسرائيل بشأن الدور الحاسم الذي لعبه التنوير الراديكالي في التحضير للثورات الكبرى، الهولندية والأميركية والفرنسية، التي كانت تأسيسياً للديمقراطية الحديثة التي نعرفها. بل إن اسرائيل يُدلِّلُ على محورية أفكار التنوير الراديكالي لدى المجموعات الجمهورية والمساواتية داخل طيف التيارات الثورية المختلفة، فأفكار التنوير الراديكالي كانت حاضرة خلال الثورة الأميركية لدى جماعات الكويكرز وبنجامين روش وجماعات مناهضة العبودية، الذين تواجَهوا مع آباء الاستقلال المُنحازين لأفكار التنوير المعتدل مثل توماس جيفرسون.
يتابع إسرائيل بشأن مدى انخراط التنوير المعتدل في تبرير التفاوت بين الناس، أو حتى استعبادهم، باسم الملكية الخاصة أو النضج أو الطاعة، مثل جون لوك الذي كان مساهماً في الشركة الملكية الأفريقية وشركة باهاماس، اللتين كانتا تعملان في قطاعات تعتمد على العبيد، مكتفياً بالدفاع عن مساواة روحية بين البشر أمام الله وحسب. يعرض إسرائيل التواشج بين مُحافَظة اجتماعية وميتافيزيقيا مثالية لدى التنوير المعتدل، أسهمت في تبرير السلطات الاجتماعية والنظم الاجتماعية القائمة على التفاوت والسيطرة. هذه الأنظمة الاجتماعية التي أَسَّست شرعيتها بالاعتماد على التقاليد الدينية أو الثقافية أو أية مرجعية أخرى غير العقل، الذي مَثَّلَ بدوره تحدياً لكل أشكال السيطرة والهيمنة. لهذا دعا أنصار التنوير الراديكالي إلى رفض كل أشكال الأنظمة والسلطات الاجتماعية التي ﻻ تعتمد في مرجعيتها الأساسية على العقل.
بهذا ﻻ يعود التنوير الراديكالي مسؤولاً عن الاستعمار وما رافقه من ادّعاءات عنصرية وجدت تبريراتها في التنوير المعتدل، كونه ينطلق من مساواة جذرية تستلزمها ميتافيزيقاه المادية. كذلك ﻻ تعود النزعة الشمولية حصيلة لهذا التقليد، إنما تعود إلى توجهات مثل توجهات روسو الذي استدعى أفكاراً رومانسية من تراث مضاد للتنوير (الإرادة العامة)، بل يصبح التنوير الراديكالي صاحبَ الفضل الحقيقي في نشوء الديمقراطية الحديثة عبر التأسيس لقِيَمها في الحرية الفردية والمساواة.
هنا تنقلب المُحاججة رأساً على عقب، فالتنوير الراديكالي، الذي يُعطي للعقل مكانة تأسيسية حاسمة، يصبح المؤسِّسَ للديمقراطية الحديثة والمساواة بفضل تحديه لكل أشكال السلطات الاجتماعية ومٍساءلة شرعيتها باسم العقل، في مقابل التنوير المعتدل المتصالح مع التقاليد الدينية والسلطات الاجتماعية القائمة عبر قبوله الاستناد إلى مصادر شرعية أخرى غير العقل (مثل الدين أو التقاليد)، ما أسهم في انخراطه في تبرير هذه الأنظمة والدفاع عنها وعمّا قامت به.

خيارات
اختار دينر التنوير المعتدل للدفاع عن ليبرالية معتدلة، تسمح للدين بالحضور في المجال العام (وهو اليهودي المؤمن) بما يعطي إمكانية للمصالحة بين الدين والعقل، ويضمنُ ليبراليةً معتدلةً تحفظ التنوع، بما فيه التنوع الديني في إطار المجال العام والحداثة. بينما انحاز إسرائيل (صاحب الأصول اليهودية والمؤرخ لها) إلى التنوير الراديكالي باعتباره يضمنُ مساواة جذرية بين الناس جميعاً تتجاوز الانقسامات أياً كانت أشكالها، بما فيها الدينية، وتكافحُ النزعاتِ اللّاعقلانية (وفي صلبها الدينية) التي تؤسس لنزاعات وإيديولوجيات استبداد.
قَدَّمَ الإثنان طرقاً متباينة للنظر وتحميل المسؤولية التاريخية في تناولهما التنوير، أيضاً قَدَّمَ الإثنان إجابات مختلفة حول أي تنوير يمكن لنا استدعاؤه لمواجهة أسئلتنا وتحدياتنا الراهنة، فيما اتفقا على الحاجة إلى التنوير في مواجهة الأصولية والاستبداد واللاعقلانية. التباينُ بشأن أي تقليد علينا استدعاؤه يستند إلى التباين حول المهمة التي على التنوير أن يجيب عنها وحدودها؛ هل نريد تنويراً يحفظ للدين مكانه في المجال العام، وبالتالي أن ننخرطُ كمتدينين في العالم الحديث؟ أم تنويراً يُؤمِّنُ لنا مساواة جذرية تفرض إزاحة الدين إلى الشأن الخاص (كونه مرتبط بتموضعات محلية للحضارات)، ومن ثم الاستناد حصرياً إلى العقل كونه المشترك البشري الوحيد؟
التباينُ بين خيارات الإثنين ﻻ يتعلق بمجرد تفضيل هذا التقليد أو ذاك، إنما بالرهان الذي ينطلق منه كل منهما وبالسؤال الذي يسعى كلٌّ منهما للإجابة عنه. فسؤال دينر هو كيف يمكن لنا أن نُوائِمَ بين الحداثة والدين دون أن نخسر أياً منهما؟ كيف لنا أن ننخرطَ في العالم الحديث؟ لكن دون أن نكفّ عن كوننا مؤمنين، ودون أن يكون ثمنُ الحفاظ على إيماننا هو العزلة والقطيعة مع الحداثة بما يهددنا بالأصولية والاستبداد.
بالمقابل، ينطلق إسرائيل من سؤال مغاير؛ كيف لنا أن نؤسس لديمقراطية جذرية تقوم على مساواة تامة بين جميع البشر؟ ديمقراطية ومساواة ﻻ يمكن تحقيقها إﻻ عبر التأكيد على فكرة الإنسان بما هو كذلك، قبل أن يكون معطىً في تقليد أو دين أو مجتمع ما. حرية ومساواة ﻻ يمكن تأسيسهما إﻻ على مُشترَك إنساني كوني يتجاوز أي تقليد، مُشترَك ﻻ يمكن تأسيسه إلا على العقل وحده كمَلَكة إنسانية مشتركة بين الجميع.
هذه الرهانات المتباينة التي انطلق منها كل من دينر وإسرائيل للنظر إلى التنوير والحوار معه تدلُّ بدورها على الطبيعة الشائكة والمتعددة للتنوير والتقاليد المتباينة له، وعلى انفتاحه على قراءات مختلفة وما يرافقها من استدعاءات ورهانات متنوعة ومتباينة.
جميعهم يهود
شتيرنهل وبرلين ودينر وإسرائيل جميعهم يهود، وهذا في جانب منه صدفة في اختيار القراءة، لكنه ليس صدفة محضة بالنظر إلى حجم الاشتغال اليهودي على موضوع التنوير. لكن هذا يعطينا بدوره فرصة للتأمُّل في سياقنا الخاص من زاوية شبيهة، تتعلق بالدور الذي لعبته الأقليات في التأسيس والتمهيد لحركات فكرية وتيارات سياسية محددة، مثل الاشتراكية والقومية والتنوير.
يمكن التعامل مع اليهودية هنا بوصفها العامل المُفسِّرَ خلف الخيارات السياسية والفكرية، غير أن المعضلة التي تواجهنا هي تَنوّع المواقف واختلافها البيّن، وتَوزُّعها على كامل الطيف الممكن نظرياً (يهودياً على الأقل، فاليهودي ﻻ يمكن له أن يكون نازياً معادياً للسامية، لكن بالتأكيد يمكن أن يكون فاشياً) من الرومانسية إلى حمل راية التنوير، وحتى في الحالة الأخيرة تتباين المواقف من الدفاع عن تنوير معتدل إلى الدعوة لتنوير راديكالي.
اعتبارُ اليهودية العامل المُفسِّرَ له تقليدٌ عريقٌ اعتمدته التيارات المعادية للسامية، ويجد أفضل تعبير عنه في نظريات المؤامرة التي تبحث عن اليهودي خلف كل شيء. نظرية المؤامرة لها تراثٌ مسيحيٌ عريق، وهي تَعتبر أن هذه الإجابات المختلفة ليست حقاً مختلفة كما يظهر لنا للوهلة الأولى، فهي ليست إلا قشوراً تُخفي المهمة الحقيقية وراء كل هذا التباين الظاهري. وهذه المهمة هي إضعاف المسيحية. هنا، ﻻ يعود من المهم ما يقوله هذا أو ذلك، بل «هويته» التي تكشف الطبيعةَ الحقيقيةَ خلف ما يقوله. وﻻ يحتاج المرء من أدلّة على ما يكشفه سوى اكتشاف هذه الهوية اليهودية. الهوية نفسها أصبحت الدليل، بغض النظر عمّا قاله أو فعله. ﻻ يمكن وضع جميع المواقف المعروضة هنا، والتي تبناها يهودٌ تاريخياً، في سلة واحدة، وهي مواقف تتوزَّع على تيارات سياسية متباينة ومتعادية. لكن ما يمكن جمعه هنا هو الهوية اليهودية التي يَصدر عنها هؤﻻء جميعاً. هدفُ هؤﻻء اليهود هو إضعاف المسيحية وتحطيمها، وهذه الإجابات ليست سوى وسائل مختلفة لتحقيق هذه الغاية الجهنمية والسرية لهم، والدليل على هذه الغاية هو يهوديتهم. كونها مؤامرة يعني كونها بالطبع سرية فلن نعرف دليلاً حقيقياً عنها، وإلَّا كفَّت عن كونها مؤامرة، لكن هناك قرائن (بتجاهل الأدلة المزورة التي هي حقيقية، ولكن اعتبارها مزورة هو جزء من المؤامرة نفسه، مثل بروتوكولات حكماء صهيون). وبالطبع، كل شيء مع مخيلة جيدة يمكن له أن يكون قرينة. لكن الدليل الأساسي يبقى هو «يهوديتهم».
نحن أيضاً لدينا نسخة إسلامية من هذه النظرية. ألم يكن المسيحيون وراء الدعوات العلمانية والتنويرية والقومية والاشتراكية لإضعاف الإسلام وتفكيك الخلافة الإسلامية وأُمَّة المسلمين؟ أليست القومية العربية دعوة مسيحية ليتساوى المسيحيون عبرها مع المسلمين باسم العروبة، لكن عبر قطع الأخوة بين المسلمين العرب والأتراك؟ كل ما قاله المسيحيون أو فعلوه ليس أمراً مهماً، ليست هذه الأشياء سوى وسائل مختلفة لإضعاف الإسلام، الذي هو الغاية الحقيقة خلف كل هذه التيارات. الدليل، انظروا إلى المسيحيين الذين يقفون وراء كل هذا، إنها المؤامرة على الإسلام.
لكن، وبعيداً عن نظرية المؤامرة، فإن اليهودية هي حقاً عاملٌ مُفسِّر، وليست العامل المُفسِّر. وهذا البعد التفسيري يكمن في الحساسية التي يحملها هؤﻻء لكونهم يهوداً في مجتمعات الأغيار، حساسية تنطرحُ في صيغة: كيف يمكن لنا كأفراد من أصول يهودية أن نتمتع بمساواة وحرية تامَّتين في المجتمعات التي نحيا فيها دون النظر إلى أصولنا اليهودية؟ أو حتى دون التخلي عنها (مثل إسرائيل ودينر)؟ الحساسية اليهودية هي حساسية السؤال المُشترَك، ولكن الإجابات على هذا السؤال تختلف وتتنوع.
اليهودية عامل مُفسِّرٌ بالنظر للسؤال وليس بالنظر إلى الجواب. تحويلها إلى عامل مُفسِّر على مستوى الجواب هو ما يفتح الطريق أمامنا إلى نظرية المؤامرة. ألم يملك المسيحيون المشرقيون حساسية مشابهة وهم يفتحون طريق النهضة العربية، ويؤسسون الخطوات الأولى للتيارات القومية والاشتراكية والليبرالية؟!