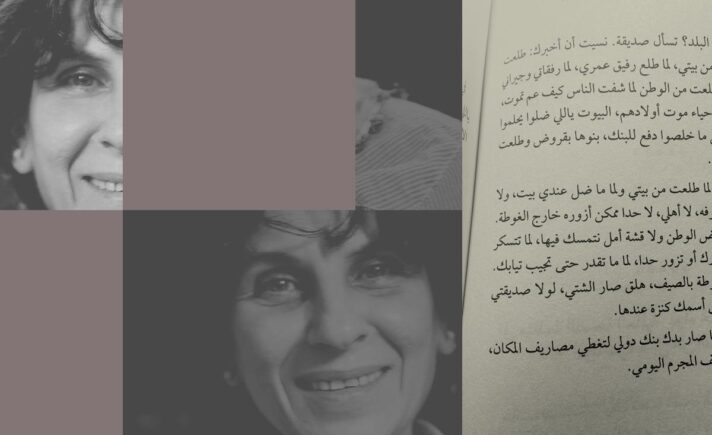طوّرتُ، عندما كنتُ في السابعة من عمري، تقنية خاصة لحماية أفراد أسرتي عندما لا أراهم، وتحديداً أثناء النوم، كنت أنظر إليهم ثم أُسرع إلى سريري لأستلقي وأغمض عينيَّ بقوة، أكرر صورتهم الأخيرة في ذهني مراراً، حتى أستطيع مدَّ خيوط ٍغير مرئية ترتبط بنهايات أصابعي، لتحيط بهم وتُنبِئني في حال اقترب خطرٌ ما.
كانت مخاوفي محددة بمجموعة من الشياطين والجن والأشباح ومصاصي الدماء ووحوش الديجيتال والإسرائيليين واللصوص وأبو عدل، فعلتُ هذه العادة مجدداً في لبنان، لأن الذنب والخوف أذهبا النوم من عيوني؛ كيف استطعتُ أن أتركهم محاصرين مع وحوش حقيقية!
أيقظتني الهزة الأرضية واختلطت عليّ الأمور، اتصلتُ بهم كثيراً، عشتُ جحيماً استمر لساعات بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت عنهم، وقبل أن أدرك حقيقة أن الموت والدمار ينبعُ هذه المرة من باطن الأرض لا من سطحها، سمعتُ صوت أمي الحلوة التي تعيش في أحد أخطر الأماكن في العالم وهي تضحك من نفسها، لأنها خرجت بفستان نومها السكري من البيت، وسارت حافية القدمين بين الناس حتى ساحة المدينة.
رجفات الأرض المتقطّعة هدّدت حياة من أُحب فأيقظتني، وكأن تياراً كهربائياً سَرَا حتى أعماقي، مع أنني لم أَكُن أشعر بأي شيء منذ وقت طويل، تسرّبت الذكريات على الرغم من الكحول، دخان السجائر، السوشال ميديا، يوميات الانهيار الاقتصادي…
****
عندما سرتُ في شوارع بيروت للمرة الأولى، شعرتُ بأنني أعرفها منذ زمن طويل، تحرّكَ جسدي بِخفّة تُبعِد عني مظهر الغريب، كان هذا الإحساس قوياً حتى اعتقدت بأنني أمتلك خارطة داخلية لا تُخطئ، وبأنها هبةُ المدن للوافدين الجدد، كان قَدَرُنا الجديد أن نستمر في العيش معاً بعد كل هذه السنوات الصعبة.
ولكن بعد فترة هنا؛ وعندما حملتني سيارة الأجرة نحو الداون تاون في مرة من المرات، تراءت لي ساحة مدينتنا الصغيرة، انعطفَت السيارةُ وأكملَت مسيرها في حارة ضيقة لمدة ثلاث دقائق بالتحديد، ثم وقفت. قلتُ لنفسي: ها أنا، لقد وصلت، ناولتُ السائق مالاً كنت أحمله بيدي وترجلتُ من السيارة، ثم نظرتُ وبحثتُ في كل مكان، توترتُ جداً وباغتتني دموعي، لُمتُ ذاكرتي الضعيفة، لقد وصلت بعد كل هذا الوقت وكل هذا التعب، خطوات تفصلُني عن مكان يُغنيني عن كل هذا العالم، ولكنني نسيت مكان الباب أو شكله، ولم ينتظرني أبي خارجاً ليُعينني على الحقائب، لا شيء قد يخيفني أكثر من أن ينتظروني وأتأخَّرَ عليهم كعادتي، نظرتُ مرةً ثانية لأتأكد من أنني لم أجلب معي أي شيء هذه المرة، وأنني خرجتُ من سوريا ولم أعُد بعد، أنا في وسط بيروت ونسيت ماذا أنتظر على هذا الرصيف.
خمّنتُ أنها علاقة جديدة مع لبنان ومع مدينة مُدلَّلة كبيروت، لكنني أدركت لاحقاً أنها علاقة قديمة لمّا تنتهي مع سوريا، فتحتُ عيني على طرقاتها ومساكنها وقسوتها ودمارها هنا.
****
في بيروت أماكنٌ للبكاء وأخرى للصراخ دون خوف، محطاتٌ وضعتُ فيها أثقالي جانباً وهززت جسمي بعشوائية وأنا أغمض عيني لأعود طفلاً، فيها من لا يزال يؤمن بأن على أحد أطراف صراعٍ ما أن يفنى كله! وفيها مئات وُرَش العمل عن «اللاعنف» مع بدلٍ للمواصلات، وفيها من يقاتل لأجل حياة يستحقها، ومن هم مثلي يقاتلون الحياة، وفيها سيدة طاعنة في السن وصَمَّاء تنزل ببطء شديد على درج طويل في الأشرفية، وتنظر إلى أعلى الدرج حيث يقف راهب ينظر إليها في المقابل، تشكره بصوت مرتفع لأنه أعطاها خبزاً وعطف عليها، وهو يضحك منها ويقول «أنا ما عطيتا شي».
عَلَّمتني بيروت بتناقضاتها أن للحكاية ألف وجه، ولكن لن يُحبّذ الجميع سماع نسختي عن سوريا، وفي كل مرة أحكيها يتحطم جزءٌ من الوهم العظيم الذي تَراكَبَ في رأسي، لقد رغبتُ بذلك في داخلي، وفي كل لحظة أكون فيها مراقَباً ويُطلب أن أعرّف عن نفسي، أُرتب أحداث حياتي لأحكي عن هناك. لهذا أبدأ من المدرسة الثانوية (2010-2013) ثم الطفولة، فالجامعة (2015-2020)، أتحدثُ ببطء وهدوء في البداية ثم أصبح هستيرياً، وأحتاجُ إلى أسابيعَ حتى أعود إلى اللحظة الحاضرة. علمتُ أن الزمن ينكسر على الحد الفاصل بين هناك وهنا، حتى ساعات إيماننا وكفرنا مختلفة، وبأن الفرق بين كلمات مثل ثورة وحرب، مصالحة أو مسامحة أو سلام، قد تُشتت أمضى العقول عن رؤية كمِّ العنف الهائل الذي نزل بنا والذي ما زال يهددنا.
في الشهر الأول من عام 2022 جئتُ إلى هنا، خرجت لأول مرة في حياتي من سوريا، عشت فيها سبعة وعشرين عاماً متواصلين، تنقلتُ خلالها بين أحضان الجرائم وهربتُ ممّا كنت أعتقد أنه الداخل السوري، والداخل كما فهمته هناك هو سوريا كلّها، مع أن كل بقعة من البلاد تغطس في خراء مختلف، إلا أن هذا الخراء يوحدُنا، لكنني شعرت هنا أن كل جهودنا الذهنية والفعلية للتفرقة بين ما هو لنا وبين ما سُرق منا، بيننا وبين من يحرقنا، باءت بالفشل.
حسناً لقد جئتُ إلى هنا من إحدى المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام.
****
هناك؛ منذ أكثر من سنة ركنتُ جسمي على سرير طفولتي كالجثّة تماماً، كنتُ أنظر إليها وهي واقفة أمامي تُكرر سؤالها: «شو في؟! وقع قلبي. شو صار؟» نصمت كلانا ثم تعيد «الله يأخذني ويريحني»، «إجريي ما عم يحملوني، ما فيني عم وقف. بس إحكي شو في».
حاولتُ أن أبقى صامتاً، لكن نظراتها أثرت بي، وأخرجتْ زوبعة رمال من فمي لتحيطَ بوجهها المتعب.
أمي؛ ماما أنا لم أعرف السعادة أبداً ولكنني كنت أتخيلها قريبة، كبرت وأنا أعتقد بأن عليّ أن اجتهد لآخذ قسمتي من الحياة، ماذا كانت قسمتي؟
لقد كافحتما أنتِ وأبي، ما هي قسمتكما؟
أنا خائف؛ وهذا الخوف لا يفارقني أبداً، معزولٌ عن كل شيء تماماً، فارغٌ من الداخل وأخجل من هذا الفراغ، ومن الحفر العميقة في وجهي، السواد تحت عيني، من يدي الخشنتان، من أسناني ولثتي المتعفنة والتي لا أقدر على معالجتها، لأنني لا أملك أي مال. أخجل من معطفي الذي أرتديه منذ ثمان سنوات، من رائحتي كل صباح بسبب تلك المدفأة اللعينة، التي باتت تحرق كل شيء؛ بلاستيك وأكياس نايلون ودفاتر الجامعة وأصابعنا. أخجل من وقوفي منذ ساعات الصباح الأولى إلى أن تحرق شمس الظهيرة رأسي، ومن الإعياء الذي يصيبني في انتظار المعونات، في ذلك الاصطفاف نعزفُ لحن الجوع بشكل جماعي، هناك اكتشفت أنني مثل كل هؤلاء الناس، أبدو مثلهم، أشبههم تماماً، بائس دون إرادة، ومطيع.
أمي، أحقدُ على الجميع وأكره نفسي، لا مستقبل لديَّ هنا وأهدُس دائماً بالموت، لا أستطيع الهرب من كل هذا، وإن تحقّقت المعجزة وخرجت! فمن سيُخرِج كل هذا اليأس من عقلي؟ من سيُعيد سنوات حياتي التي ضيعتُها؟ ليس لي مكانٌ في العالم، ولا وجود. لم أعد أستطيع الاحتمال، وأقسمُ بأنني أفكر كل يوم في إنهاء هذا العذاب، مشكلتي الوحيدة في الدنيا كلّها هي أنت.
أخبرتُها عن عملي في شركات وهمية لغسيل الأموال، وعن أجريَ الضئيل الذي أقبل به لأعيش، عن غرفتي الصغيرة والمعتمة، عن أصدقائي الذين سافروا وعن حوالاتهم المالية وتلفوناتهم الناصحة، قلتُ الكثير ثم انفجرتُ بكاءً. حاولتْ أمي تهدئتي، جلبتْ لي كأس ماء، وقالتْ كلمات لا أذكرُها، ولكنني أذكر تماماً كيف ارتبكتْ وغاب عنها الكلام.
وعندما لَمحتْ أبي قادماً إلينا، أسرعتْ تجاهه وأخذت تلومه وهي تصرخ، ثم بكَت بحرقة، وبعد شجارهما الذي دام لوقت طويل، ساد الصمت في المنزل كالعادة، ولكنني سمعتُ بكاء أمي من خارج الغرفة. أُقدِّرُ مسافتها الآن وأعتقدُ أنها كانت خلف الباب.
دخل أبي وجلس على طرف السرير، وأخذ يتحدث عن حال الدنيا، كيف تكون تعيساً في أحد الأيام وسعيداً في أيام أخرى، كيف يتكامل هذان الشعوران ليَخلقا التوازن. حكى مجدداً عن محاسن الصبر، وعن الإنسان القوي الذي يهتمُّ بصحته وبعائلته في هذه الأوقات، كنت أسمعه ولكنني لم أقل شيئاً، ولمّا شعر أبي أن صوته وحده يملأ غرفتي الرطبة حلَّ عليه الصمت، ثم قال لي: بابا لا تحزن، اغضب.
****
تزدحم الكوابيس في ذهني؛ وكأن ستارة حالكة اللون غطّت كل شيء أعرفه هناك، سادت العتمة وخنقَت أي نور ممكن، حتى الحياة في تلك الظلمات تبدو وكأنها احتضار.
ومع ذلك أفكر كل يوم بالعودة إلى بيتي، ولكن أن أعيش في سوريا يعني أن أسير على أرضٍ أجهل ما تخبئُه في جوفها؛ مقابر جماعية لمدنيين مثلي؟ غضب سيخلخل جدران منزلي؟ ألغام؟ مخلفات كيميائية تذوب في كأس الماء لينهشني السرطان بعد أن أرتوي. أن أسير بين الأهالي الذين ينتظرون أبناءهم بحرقة ويحملون صورهم، أبناءهم المعتقلين الذين كبروا في سجن غير هذا السجن، هل عاشوا قبل ذلك مثلي؟ أن أسير بهدوء كي لا أوقظ من يفترشون الرصيف، أكانوا أطفالاً أم فقراء ومهجرين وعساكر ضلّوا طريق الطفولة والصبا. أن أقرأ عن أقبية الملح، وعن الموت جوعاً أو احتراقاً أو غرقاً في فتحات مجارير عملاقة، عن انتحار الطلاب من شرفات سكنهم، وعن مسنين يموتون من الوحدة والإهمال، وأن أصمت.
أن أراقب فيَلَة الطاغية تعيثُ خراباً في الأرض، يتقاسمونها وكأنها غنائم حرب، كيف يدعسون على الناس وأرزاقهم ثم يمسحون أقدامهم بأوراق المنظمات الإنسانية، أن أشهد مرحلة بناء الاحتلال لصروح اسمنتية عملاقة وسط العاصمة، كيف ينسفون هوية المكان ويتلاعبون بها، وكيف تتحول عدةٌ من المناطق الأثرية لكراجات سيارات أو لفنادق خاصة للأثرياء.
أن أعود إلى سوريا؛ يعني أن أسير على هذه الأرض خطوة نحو حياةٍ خاصمتُها، وخطوة أخرى نحو الموت، أملي الأخير.
أُخبر صديقي القومي السوري بهواجسي، لكنه يضحك مني، ويخبرني بأنه لم ينسَ كيف شعر بالحرية لأول مرة في الشام، وهناك كان حُبه الأول أيضاً. في مصياف خشن صوته وربّى إحساسه بالذنب وتعلُّقه بأبيه وبالريحان، وذكَّرني لأنني نسيتُ بأن صداقتنا بدأت هناك، وها نحن الآن نديمان صالحان نبكي بلادنا.
يخبرني أن بشار الأسد رجل مهلهل وضعيف، نحفظُ رائحته العفنة ونميُزها، وبأن أمهاتنا قادرات على غسلها أينما كانت بالقليل من الماء مع خل وعصرة ليمون، ثم يُشير إلى عبارة خطها بيده وعلّقها على جدران منزله العتيق «الطغاة كالأرقام القياسية لا بد أن يأتي يوم وتتحطم».
أبتسمُ وأؤكدُ كلامه كي لا أجُرَّهُ معي نحو نافذتي التي تطل على العدم، وأسرحُ بهذه العبارة التي تحوّلت مثل غيرها من المقولات إلى حقائق مرعبة وهواجس مخيفة، والسؤال العبثي الذي يتردد في ذهني عن كم الإجرام الذي سيرتكبونه بعد حتى نعتبرهم أرقاماً قياسية، وفوق جثث من ستتحطم؟ وما الأضاحي التي سنقدمها حتى يتوقف هذا السيل؟
****
بعد الهزة الأرضية الأولى التزمَ والدايَ المنزلَ طوال الوقت، لم يخرجا منه أبداً على الرغم من كل الهزات اللاحقة. خسر أبي دكانه الصغير عام 2016 بصاروخ لم ينفجر، لكنه دمر كل المكان، وخلال الأعوام الماضية تحوّل راتب أمي كمُدرِّسة لمكافئة رمزية، لا تُشفي آلام ظهرها ورقبتها، يَتَّمتهما المسافاتُ بينهما وبين أبنائهما وإخوتهما الذين سافروا بكثافة بين 2013 وأنا عام 2022 إلى خارج البلاد، وللموت والدمار حصة كبيرة ممّا تعلقوا به، وأهم ما خسراه هو إحساسهما بالأمان، أخبرانا بقرارهما الحاسم؛ إذا خسرا بيتهما لن يتبقى لهما أي شيء، فليهوي فوقهما.
كم وددتُ لو استطعت أن أقول لأبي: بابا لا تحزن، اغضب.