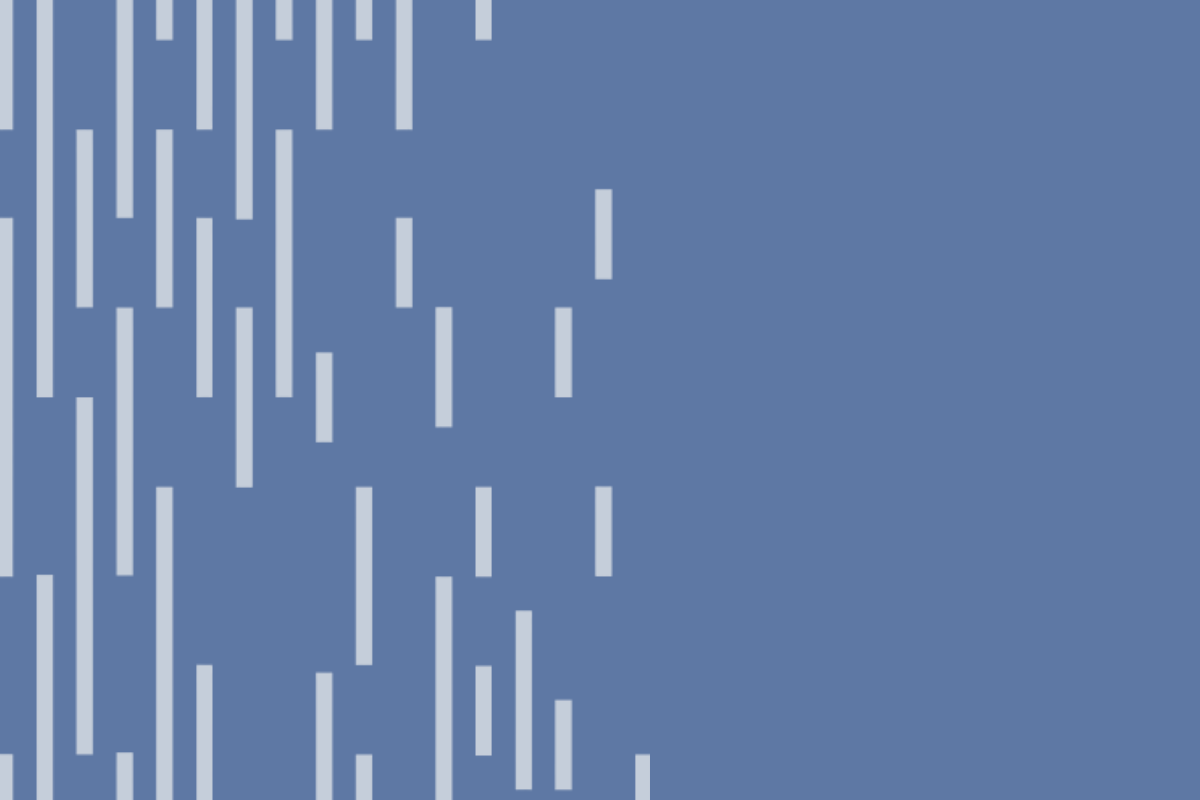عند المقارنة بين غوغل وتشات جي بي تي، لم يخطر في بالي، خلال نقاش مع صديق، سوى المقارنة بين ساعي البريد الذي يُحضِر كامل ما تطلبه من طرود ويُلقيها دفعة واحدة أمام باب منزلك، إلى درجة قد يصبح فيها الخروجُ من البيت متعثراً إن كان ما تريده يتطلّب البحث في الكثير من المواقع؛ وبين أن يكون لديك مساعد أو مساعدة محترفة ومتخصصة، تُنظّم لك ملفاتك وتعطيك الخلاصة، بسرعة وفعالية مقارنة مع ما قد تتطلّبه عملية تنظيم الطرود التي ألقاها ساعي البريد «السيد غوغل» أمام باب منزلك. العملية التي قد تستمر لأشهر، إن كان موضوع البحث متشعباً، دون الوصول إلى النتيجة والخلاصات المطلوبة نفسها، التي يقدمها لك بدقة وإتقان ذلك المساعد «السيد جي بي تي» خلال بضع ثوان فقط لا غير.
والأمر يشمل كل ما يمكن أن يخطر في بالك عند البحث عن شيء معين في الشبكة: من تنظيم عطلاتك الصيفية، الأماكن، المواقيت، الدفعات والحجوزات؛ إلى البحث عن أفضل الخيارات المتاحة أمامك مهنياً ضمن عملك في تخصص ما؛ وصولاً إلى وضع استراتيجية متكاملة لتقديم نفسك في أي سوق مُستهدَف من قبلك للعمل فيه. هذا طبعاً دون أن ننسى إمكانية الدخول في نقاش حتى حول «معضلات الشرق الأوسط المزمنة»!
نعم، ما يزال العمل في بدايات هذا النوع من التكنولوجيا الجديدة مُتعثِّراً في بعض تفاصيله، وهو قد يعطي معلومات خاطئة في بعض الأحيان، ولكن، وبوجود حُسن النية، وبعض الثقة بسرعة تطوير هكذا نوع من البرمجيات (السرعة التي يبدو أنها خاطفة فعلاً)، يمكن افتراض أن الخطأ يمكن أن يُصحَّح، أو يتم تَداركه ويُنسى نهائياً لاحقاً.
الحقيقة أن بعض الأخطاء يمكن تجاوزها، إن كان الباحثُ عن شيء بمساعدة هذا النوع من البرمجيات على دراية مُسبقة بالموضوع الذي يبحث فيه. ولكن هل هذا هو حال كل المتعاملين مع هذه البرمجيات الجديدة؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، هل «الخطأ» فعلاً يمكن أن يَرِدَ نتيجة قصورٍ غير مقصود، أم أن هناك «أخطاء» مُتعمّدة ستُوضَع عن قصد لخدمة أجندة الجهات الممولة لهكذا مشاريع؟
السؤال أعلاه ليس وليد نظرية مؤامرة. من عاش فعلياً في ظل الإعلام العربي، إعلام «طويل العمر» أو «القائد المفدّى»، يدرك تماماً أن «الجنرالات» الحقيقيين، لدى هكذا نوع من الطغاة، لا يقتصرون فقط على أولئك المجرمين وقطاع الطرق من ضباط الأمن والجيش الذين يقومون بقتل ضحاياهم من المدنيين، سواء بالبراميل أو الكيماوي أو تحت التعذيب، بل إن هناك نوعٌ آخر من القتل يُمارَس على مدار الساعة عبر «جحافل» الإعلام الرسمي، والممول (يفترض أن الأخير إعلام «قطاع خاص»)، لخلق ذلك المواطن العربي المُطيع والسعيد والخالي من المعنى، وحتى الحياة، بأي شكل من أشكالهما. وبالتالي يَصحُّ السؤال حول إمكانية تكرار الكارثة العربية نفسها، ولكن على مستوى أوسع وبنتائج أكثر كارثية.
في كل الأحوال، لم ننته بعد، ولا أظننا سننتهي من مشكلة الأخبار الزائفة «fake news»، ولا حتى من تداعياتها تلك التي وصلت في مرحلة من ذراها إلى التأثير في نتائج انتخابات أقوى بلد في العالم. ذلك أن اعتماد الناس على مصدر رئيسي للمعلومات، لن يلبث أن يصبح وحيداً هو الشبكة نفسها، بات بدوره «ثغرة» يمكن النفاذ منها لخدمة أية أجندة يمكن تَخيُّلها.
المشكلة هذه موجودة قبل دخولنا عصر الذكاء الصنعي، الذي نخطو الآن في أول مراحله، وستستمر معه، وإلى ما بعده أيضاً. وبالتالي فإن الخطر قائمٌ، ليس بسبب تكنولوجيا حديثة ومتطورة لن نكون مُهيَئين لها كما يفترض كثيرون، بل بسبب البعض ممّن قد يقررون تمويل تلك التكنولوجيا للسيطرة عليها بُغية الوصول إلى أهداف محددة تخدم مصالحهم بالدرجة الأولى.
في مرحلة معينة، ومع بداية دخول الشبكة كأداة رئيسية في مختلف أوجه حياتنا المعاصرة، كان البحث على الشبكة يقتصر على مجموعة من محركات البحث الرئيسية، كان Yahoo أبرزها وأكثرها انتشاراً خلال التسعينيات من القرن الماضي. في ذلك الوقت، كما في كل وقت للإنصاف (بدءاً من ظهور «صناعة الانتباه» بصفتها صناعة قائمة بذاتها لها مُنتَجُها وسوقها وزبائنها، كما فصّل «تيم فو» في كتابه تجّار الانتباه)، فإن نموذج العمل «business model» كان يعتمد على الدعاية كمصدر رئيسي لدخل تلك المُحرِّكات. لاحقاً، وفي الفترة التي سبقت ظهور Google ببضعة أشهر فقط، كان النقاش قد وصل إلى مرحلة إنشاء محركات بحث متخصصة ومُقادَة بمبدأ الإعلان بالذات «advertising-driven search engine»، بمعنى أنَّ المحرّك هذا يقوم بعرض نتائجه بالاستناد إلى الزبون الذي يدفع ليظهر في قمة القائمة بعد أي عملية بحث.
والأمر لن يقتصر على شركات مُنتِجة لسلع معينة ومتنافسة فيما بينها، بل الخوارزمية كانت مُصمَّمة لتمتد إلى كل ما يمكن للمرء أن يَبحث عنه في الشبكة، حتى لو كان البحث عن جامعة ما، أو مركز متخصص في نوع معين من الأبحاث، فإن النتائج سيتم ترتيبها بحيث تُعطى الأولوية للجهة التي حجزت لتكون في قمة القائمة. تماماً كلوحة الإعلانات، ودون الأخذ بعين الاعتبار لسمعة الجامعة أو مركز الأبحاث وتاريخه، وسواه من معايير تجعل هكذا مؤسسات مرموقة بالاستناد إلى رصيدها الذي بَنَتهُ عبر عمل متواصل دام عقوداً وربما أكثر. المهم في هذه الحالة هو ما تدفعه من أجل أن تصبح «مشهوراً» أكثر، مُعتلياً قمةَ قائمة نتائج البحث.
كان محرك البحث الجديد وقتها، GoTo، هو الذي بدأ بهذه الطريقة في العمل مُبشِّراً بمستقبل البحث على الشبكة، لدرجة أن Yahoo قامت فعلياً بشراء محرك البحث هذا دافعةً مقابله بليون دولار أمريكي! وكان الأمر يمكن أن يستمر فعلاً للوصول إلى تلك النتيجة البعيدة كل البعد عن الحدود الدنيا لأخلاقيات البحث، دون الحديث عن «دمرقطته»، لولا أن الحظ أسعفَ الجميع بظهور محرك بحث قوي وفعّال حقق مصداقية بالاستناد إلى أدائه الفعال وطريقة عمله النزيهة، مقارنة مع المطروح أعلاه، وعلى النقيض منه تماماً وبشكل متعمّد (كما أعلن لاري بيج وسيرجي برين، مؤسسا Google وقتها). وكان هذا بمثابة إنقاذ فعلي لعلميةِ البحث من أن تكون خاضعة تماماً لأهواء المُعلنين، وهذا كان دورَ ساعي بريدنا العجوز «العم غوغل» في شبابه الأول.
أهي صدفة تلك التي أنقذت البحث على الشبكة من أن يتحول إلى لوحة إعلانات لمن يدفع أكثر؟ أم أن الأمر برُمّته وليدُ نقاشات وجدل مُستمرَّين في مجتمعات هي ديمقراطية في الأساس ومفتوحة للتنافس الحر، دون الإخلال بقواعد تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار؟ السؤال ما زال مطروحاً حتى الآن، خصوصاً وأن عقدين فقط من الزمن ما كادا يمران على تلك «المأثرة»، لنجد أنفسنا أمام مُنعطف جديد بالكامل وبكل ما تحوي الكلمة من معنى، وفي مواجهة الأسئلة نفسها، وبإلحاحٍ أكثر بكثير من ذي قبل… العالم كله الآن يتنفّس عبر الشبكة. بينما في بداية الألفية كان هذا مقصوراً على المحظوظين فقط.
المخيف فعلاً أننا، وبمزيد من الذوبان في تلك الشبكة، سنُصبح فيما بعد كائنات افتراضية. هذا بدوره ليس افتراضاً، بمعنى أن كامل تفاصيل حياتنا ستعتمد على تلك الخدمات الموجودة هناك، وأهمها على الإطلاق، في وقتنا الحالي وإلى أجل غير مسمى، هو الذكاء الصنعي. الأمر هنا، ومع الممكنات الهائلة المطروحة أمام الجميع الآن، يصبح في غاية الإغراء لكُثُرٍ كي يحاولوا الدخول والفعل والمساهمة، بكل المعاني التي قد تخطر في البال؛ بدءاً من البحث عن فرص عمل وحياة جديدة بالكامل، وبالاستناد إلى ممكنات ساعد الذكاء الصنعي على تطويرها، إلى درجة قد نتعامل فيها مع أنواع مختلفة من الإبداع التي ما كان يمكن أن تخطر في البال لولا الذكاء الصنعي وما يقدمه من إمكانيات. لكن ذلك قد يصل إلى محاولة معتوهٍ يملك مالاً لا ينضب، وجنونَ عظمة يفوق كل ماله، فرْضَ «رؤيته» على رؤوس العالمين، إلى درجة أننا وبعد بضع سنوات فقط، لو حاولنا البحث عن اسم «جمال الخاشقجي» مثلاً، قد نجد أنه منذ مغادرته قنصلية بلاده من الباب الخلفي، هرباً من خطيبته التركية، ولحاق أخوتها به إلى مطعم قريب، لم يَسمع أحدٌ عنه أي شيء. رواية تملك من الوقاحة ما يوازي وقاحة الجريمة التي ارتُكِبت بحق الرجل. ولكن، قد لا نجد غير تلك الرواية في كامل أرجاء الشبكة، في حال هُزِمت تلك القيم التي دافع عنها «العم غوغل».
الأمر مخيفٌ فعلاً، ولكن، دعونا لا نبالغ هنا، المشكلة كانت قائمة، منذ آلاف السنين، وستبقى قائمة. ولا علاقة لها بتطور تكنولوجي سيتحول بدوره إلى «وحش» سيلتهمنا جميعاً. هذا مجرد خيال علمي، ومن النوع الرخيص حقيقة. المشكلة كانت وستبقى دائماً مشكلةَ بشر، طرق تفكيرهم، وصياغتهم لحياتهم، ورؤيتهم لأنفسهم ولمصالحهم وللعالم حولهم، وطريقة خوضهم لصراعاتهم فيما بينهم.
بل إننا يمكن أن نخطو خطوة إلى أمام ونقول بأن المشكلة ليست موجودة في «التزييف» الذي قد يحصل، أو في الـ (fake news) التي سنجد أنفسنا في مواجهتها بشكل مستمر، وهو أمر قد حصل ويستمر بالحصول دائماً، بقدر ما هي موجودة في تَقبُّل الجموع لهكذا أنواع من التزييف. المشكلة عندنا، قبل الذكاء الصنعي بكثير، وبعده بالتأكيد. ذلك إلى درجة يَصحُّ فيها السؤال، وقبل الحديث عمّا ستؤول إليه «حضارتنا» كبشر على سطح هذا الكوكب السعيد بسبب التطور التكنولوجي «الرهيب»: كم يبلغ عدد المليارات من قاطني هذا الكوكب، وعلى مدار آلاف السنين، الذين ما زالوا موقنين حتى اللحظة بأن هناك شخصاً استطاع شقَّ البحر بعصاته فعلاً؟!