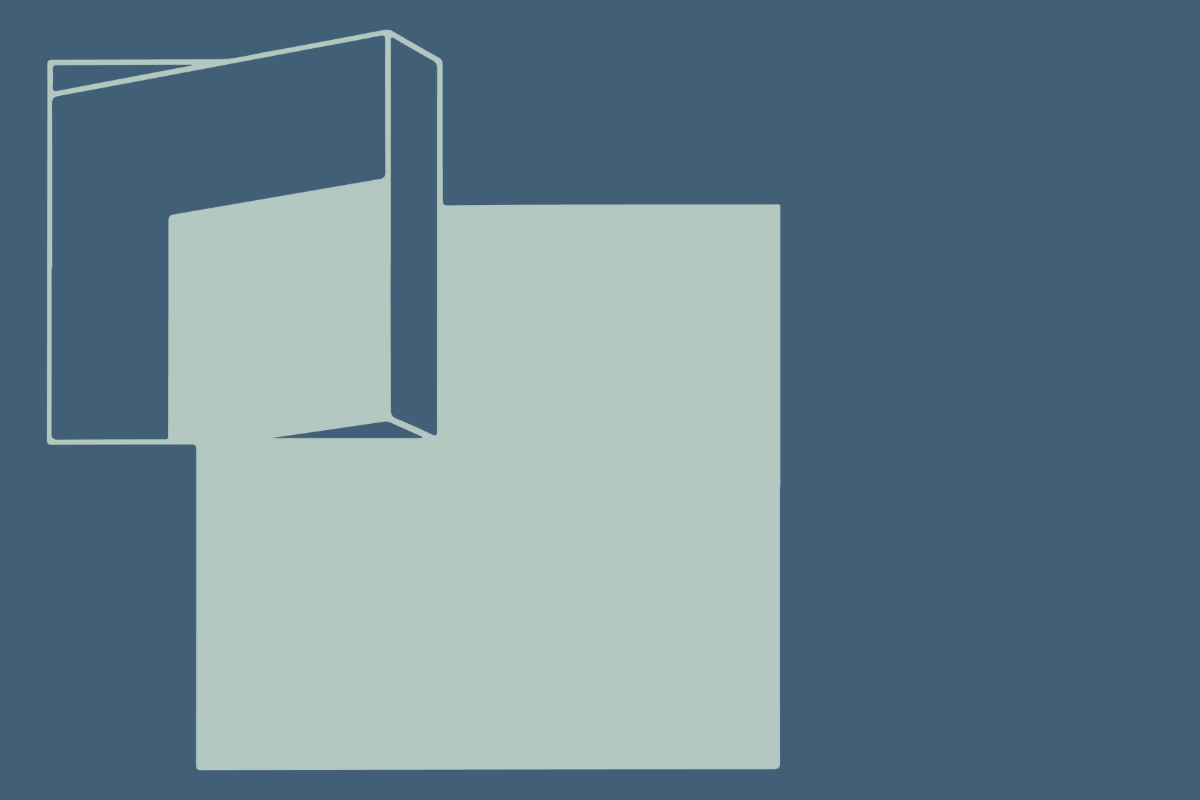تقول إيديولوجيا الإنسان عن نفسه أنه يتميز عن غيره من الأحياء بالتفكير، متوسِّلاً لذلك مَلَكة خاصة اسمها العقل. هناك نقاشٌ ممكن في شأن ما إذا كان العقل ملَكةً أم فعلاً، فعلُ تُعقُّل يُكتسَب عبر تعلُّم اللغة والاجتماع بالغير من الناس والتداول معهم، ويُهدَر دون ذلك، لكن هناك حاجة إلى نقاش فيما إذا كُنا، ككائنات مفكّرة، نريد التفكير، نُقبِل عليه راضين. تميل هذه المناقشة إلى أننا، البشر بعامة، نتجنّب التفكير ما استطعنا، ولا نُقبِل عليه إلا مُضطرين. تميل كذلك إلى أن الاضطرار للتفكير مُحرِّر، ما يدعو إلى أن نختاره بالأحرى.
لكن ما التفكير؟
تقترن الأفعال القريبة من فعل فكّرَ في اللغة العربية، مثل اهتمّ (جذر همم) وتأمّل (ج. أمل) وانتبه (نبه) وأمعن ونظر، بحركة خروجٍ من النفس أو ذهاب النفس إلى موضوع خارجها (أو داخلها). هناك حركة وجهد، صرفٌ للطاقة، وخروجٌ من حالة الراحة أو السكون إلى حال أقل استقراراً، يمكنها أن تكون قلقة ومُربِكة، أو حتى خطرة بخطورة الموضوع. فعلُ التفكير فعلٌ قلق، ليس مستقراً على نحو مطّرد. لا يبدو التفكير تطبيقاً لقواعد مقررة مسبقاً أو فعلاً روتينياً، بل بالعكس، يبدو انتهاكاً للروتين، خروجاً على المقرر من القواعد، وانفلاتاً مما هو مألوف ومستقر. وهذا قد يكون مدخلنا إلى اضطرابات متعددة، أو حتى إلى فقدان العقل. ولقد بات من المعلوم المبتذَل الربط بين العبقرية والجنون أو غرابة الأطوار في أقل تقديرنجد هذا الربط متواتراً في كتاب وليم جيمس: تنويعات التجربة الدينية، الطبعة الأولى، ترجمة إسلام سعد وعلي رضا، مركز نهوض للدراسات والنشر، 2020، ص 65-66، ص 71.. فكأن استخدام ما يُفترض أن يُميِّز الإنسان عن غيره من الأحياء، التفكير، هو ذاته ما قد يؤول إلى فقدان هذا المُميِّز.
ثم إن التفكير فعل مُستغرِق، قد نغرق فيه فنغرق في غيره ممّا يُميت، مثلما وقع لطاليس بحسب أفلاطون. فقد كان الحكيم الإغريقي يسير غارقاً في أفكاره وهو يدرس النجوم، فكان أنْ وقَع في بئر ماء ومات غرقاً. في التفكير لا ننفصل عمّا حولنا من مجتمع، بل ننفصل عن جسدنا ذاته إلى حدٍّ قد يكون مُميتاً مثلما تقول الحكاية عن طاليس. يبدو التفكير نسياناً للجسد، والجسد محلُّ الحياة، إن نسيناه نسِيَنا، وقع في بئر أو ارتمى فيما يُهلك.
ونتأدّى إلى الخلاصة ذاتها إن فكرنا في أن التفكير نفيٌ بمعنى مزدوج: نفيٌ للمُعطَى المباشر، ما تراه العين وتسمعه الأذن ويصلنا عبر حواسنا الأخرى (نفيه بمعنى عدم التوقف عنده وتجاوزه والذهاب إلى ما بعده)، وهو إلى ذلك وعبره نفيٌ للجسد الذي تُشكل الحواس جزءاً منه، نوافذه وموارد مركز التوجيه فيه.
كفعل خروج وانتهاك وانفلات، يبدو التفكير مغامرة غير آمنة، نهرب منها ما تيسّر لنا الهروب، مثلما نهرب من الحرية، وهي الأخرى مغامرة خطرة، وقد تكون قاتلة. قد تظهر صيغة «الموت ولا التفكير» في عنوان هذه المقالة درامية بعض الشيء، لكنها تريد القول إن التفكير همٌّ وقلق، وتجشُّم للمخاطر، وهو ما لا يُعاش به إلا بمشقة بالغة. نتجنبه تجنباً للمشقة. وهذا يصح حتى على اختصاصيي التفكير المفترَضين، المفكِّرين.
«المفكِّر» يفكر في الأشياء على أنحاء تتجه إلى أن تستقر على نسق معين، هو ما يمنح تفكيره هويته. لكن تفكيره يكِّف عن التفكير بقدر ما يستقر على نسق. فإذا لم يستقرّ على نسق، لم يحقق هوية مميزة، وتوافقَ التفكيرُ تالياً مع تآكل ذاتي أو تدمير ذاتي، أي مع ضرب من الموت. وهو إن استقرّ على نسق، جنح هذا إلى التصلُّب في تقليد يتكرر، أي مع صورة أخرى للموت. التفكير هو جوهرياً التفكير بصورة أخرى، وهذا مثلما أن الحرية هي الذهاب مذهباً آخر، أو الخروج على ما أَلِفنا من طرق في الذهابحاولت قول ذلك في مقالتي الحرية، البيت، السجن، المنفى، العالم، المنشور في الجمهورية 2016. مُتاحة على هذا الرابط.. التفكير بالصورة نفسها دوماً هو تقليد، أي موت.
التفكير بصورة أخرى هو ما يأتي بالجديد، أي «يبدع». والاقتران بين التفكير والإبداع هو من المعلوم المبتذَل بدوره. ثم أن الاقتران بين التفكير و«الخلق»، وهو الإبداع نفسه، يُحيل إلى القدرة الخَلْقية عند الإنسان، مشاركته لقُدرة الله. أما التفكير بالصورة نفسها دوماً فلا يأتي بجديد، بل هو يكّف عن أن يكون تفكيراً حياً، يغدو تطبيقاً آلياً لقواعد مُقرَّرة. وعلى المستوى الجمعي، هذا يؤول إلى تجمد ثقافي، تقليد متصلِّب، يبدو أن شيئاً قريباً منه وقع في تاريخنا الاجتماعي الثقافي حتى «الصدمة الغربية» (هشام جعيط) في القرن التاسع عشر.
الأهمية العظيمة للتقليد تتمثل في اقتصاد التفكير، في تأمين مسالك وسُبل نسير فيها دون أن نفكر، بما يساعد على تركيز الجهد على ما ليس منه (من التقليد)، وما يقتضي صرف الطاقة الذهنية عليه. لكن تصلُّب التقليد يمكن أن يكون قامعاً نشطاً للتفكير الجديد، للخلق والإبداع، وللحياة المختلفة. إذ هنا يُمارَس اقتصادٌ كليٌّ للتفكير، فلا يبقى غير دورة التكرار الأبدية.
نبدو أمام مفارقة. نفضل الموت على التفكير لأن هذا همٌّ وقلقٌ وقلةُ راحة، لكن عدم التفكير هو الموت كذلك. في هذه الأزمنة الحديثة على الأقل، يجنح التقليد المتصلِّب إلى أن يصير عائقاً تكيُّفياً، عائقُ بقاء. ومع بقاء اجتناب التفكير خاصية أنثروبولوجية، فإن في الإقبال على التفكير في مجالنا ما قد يكون حلاً لمشكلة تكيُّفية، أخذت تتجلّى بصور صادمة وانتحارية خلال آخر عقدين أو ثلاثة.
وتُفضي مواجهة جروحنا النفسية إلى التقابُل ذاته بين التفكير والموت. إذ قد يصير التفكير ذاته جارحاً، وهذا بخاصة حين نفكر في أشياء مؤلمة تحاصرنا ولا نهتدي إلى سبلٍ لفك حصارها. هنا قد نفكر في أشياء كثيرة كيلا نفكر بالشيء الواحد الذي يجب التفكير فيه، ما يحاصرنا ولا نجد منه مخرجاً. وهنا نبدو حيال حالة أقرب إلى قصوى من «الموت ولا التفكير». من الحالات المُقارِبة؛ الانتهاكات القصوى لكيان المرء مثل التعذيب والاغتصاب والعزل في شروط قاسية، وهي حالات قد توْدي بالمرء إلى الجنون، موت العقل، لأننا لا نستطيع تخللها بالفكر، موضَعَتها والانفصال عنها عبر ذلك.
ليس كل تفكير تفكيراً فيما يؤلم، وربما تفكيراً مؤلماً هو ذاته إلى حد أننا ربما نُفضّل تجنبه. لكن كل التفكير همٌّ وقلق، نفيٌ للمعطى والحاضر والجسم، وذهاب إلى ما وراء (وهو من هذا الباب مدخل محتمل إلى ماورائيات الميتافيزيقا والدين وغيرها). وإذا كان يحدث ألا نتجنّب التفكير مع ذلك، فربما من باب تأليف أنفسنا على الموت، على نفيِنا وما ورائِنا الخاص، تقريب حياتنا من موتنا؟ منذ مونتيني في القرن السادس عشر، صار يُقال إن الفلسفة تَعلُّمٌ للموت أو تَدرُّبٌ على الموت. كتفكيرٍ نافٍ جذرياً (للموضوع)، الفلسفة تُدرُّب على النفي الأخير (للذات).
لكن ألا يبدو التدرُّب على الموت تعريفاً للدين بالأحرى، وربما للإسلام أكثر من غيره، وهو اليوم مفتون بالموت، يمارسه ويدور حوله، وسياسته تتمحور حوله فلا تكاد تتميز في شيء عن حربه؟ على أن الموت ممارَسة وليس نظرية في الإسلام المعاصر، وهذا بقدر ما يبدو الإسلام عموماً، والمعاصر بصورة خاصة، متشكلاً حول إرادة الاعتقاد، وليس إرادة المعرفة، إن استعدنا هذا التمييز من نِتشه. مثل التقليد، الاعتقاد حلٌّ لمشكلة التفكير. نعتقد فنتحرَّر من الحيرة وعذابها، من الشك ومن القلق والهم، ننفي النفي (التفكير) ونحصل على اليقين الذي هو موت آخر. هذا الموت البديل يؤكد قضية الموت-ولا-التفكير، لكن الاعتقاد لذلك بالذات ليس تدرباً على فنائنا عبر عمليات النفي الفكرية. الموت الإسلامي مَعبَر إلى شيء آخر، إلى حياة باقية. وهذا ضرب من ترويض للموت وترويض للنفس له، لا يستطيعه التفكير والفلسفة، ولا يبدو أنهما يريدانه.
تقدمت إشارة إلى أن التفكير قد يكون خطراً. الواقع أنه كذلك بأكثر من صورة واحدة. خطر على من قد يأتون بأفكار جديدة، إقلاق لراحتهم ونسيان لأجسامهم هم، ثم هو إقلاق لراحة التقليد المستقر ومَن يستمدون سلطتهم من رعايته، وبالتالي هو خطر على التقليد والقائمين عليه. تقول حنه آرنت: ليس هناك أفكار خطرة، التفكير بحد ذاته نشاط خطر. الواقع أنه في أطوار مختلفة من التاريخ ظهرت أفكار خطرة، أو بَدَت كذلك في عين المعاصرين. في تاريخنا وفي التاريخ الغربي شهداءُ فكر ومعرفة قتلتهم سلطات سياسية و/ أو دينية بسبب أفكارهم. هذا يعطي لعبارة الموت ولا التفكير دلالةَ النجاةِ من خطر، وفي الحالة القصوى من الموت. فكأننا نموت (بأن لا نفكر) كي لا نموت (لأننا نفكر).
على أن أخطر الأفكار تفقد خطورتها بعد حين، وتكفّ عن كونها ثورية وهدّامة. ما لا يفقِد خطورته هو فعل التفكير، وهذا لأن التفكير هو التفكير المُغاير، المنشق، النافي، التفكير بطريقة أخرى؛ وهو بذلك فعل يُشكِّك في ما هو ماثل ومتماثل، ويعمل على خلخلته وتقويضه. التفكير نشاط شجاع، يتحدى ما هو قائم ويخرج منه، وربما يخرج عليه، مجازفاً بالخطر والموت، وهذا بالضبط لأنه ليس مَيْلنا التلقائي، ليس شيئاً نُقبِل عليه مختارين.
وبينما يدعو ذلك إلى مقاومة تَجنُّب التفكير، وإلى تقريب حياة التأمل من الحياة النشطة، بتعابير آرنت، عبر مغامرة الأفكار الخطرة، فلا يبدو أنه يلغي مَيْلنا، جميع الناس وليس البعض فقط، إلى تجنُّب هم التفكير. حين نتغلب على هذا التجنب نتحرر، نتحرر لأننا نُغالب ميلنا إلى العطالة، الثبات على وضع بعينه وصرف أقل قدر من الطاقة، مما يضمنه التقليد والاعتقاد. هذا إن نجونا من حُرّاسهما.