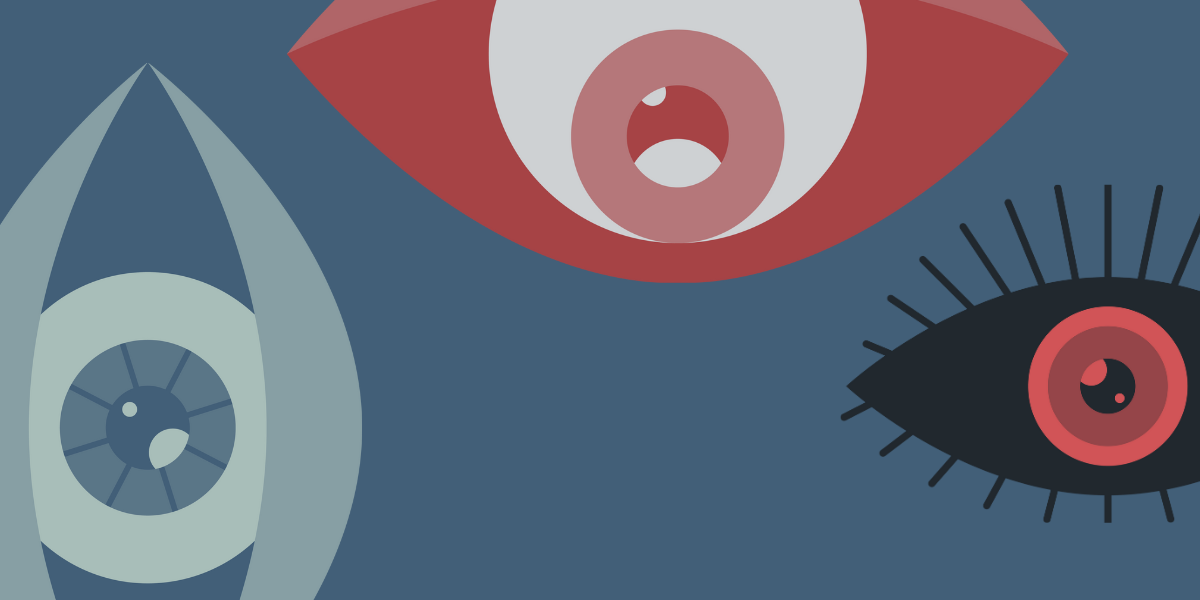لا يصمد للمقارنة مع وفرة الشرور في المجال العربي غير قلّة التفكير في مفهوم الشرّ، أو جموده على صور دينية قديمة، ليست غير مؤهلة لتقديم جديد ذي قيمة في هذا المجال فقط، ولا لضبط مسالك وممارسات مؤذية فردية وجمعية فقط، وإنما هي تبدو متوافقة مع غير قليل من التمييز والإيذاء، بل والقتل، حيال خصوم متنوعين، بمن فيهم شركاءُ في الدين. لقد رأينا بعد الثورات العربية أشكالاً من تدمير البشر والحياة البشرية، لا تبدأ بالتعذيب والاغتصاب، ولا تنتهي بالمجازر وتدمير بيئات الحياة، ودوماً دون محاسبةٍ أو تحقيقِ أدنى حد من العدالة، ما جعلَ بلداننا فراديس للإفلات من العقاب، أي بالفعل للجريمة. ومع ذلك، هناك ضعف مقيم للتفكير في الأبعاد الأخلاقية والنفسية والروحية لهذه التفجّرات الوحشية.
وقد تتمثل مشكلة الحداثة العربية في أنها سَوَّغَت نَفسَها بأشياء كثيرة، ليس منها ظلم أقل وفساد أقل وعنف أقل وتمييز أقل، كي لا نقول عدالة أكثر ونزاهة أكثر وأمان أكبر ومساواة أكثر، فغاب منها الحكم الأخلاقي بالمعنَيين المُمكنيَن للتعبير: القول إن هذا شرٌّ أو خير، ثم البُعد الأخلاقي للحكم السياسي. تبدو الجريمة أو الشرّ الأكبر في عين حداثيينا هي ألّا يكون المرء حديثاً، وهو ما يترك القتل والتعذيب ونَهبَ الموارد العامة والتمييز بين المواطنين أشياءَ غير مُفكَّر فيها في أحسن الأحوال. وبالمقابل، يبدو أكبر الشرور في عين الإسلاميين خلع امرأة لحجابها أو تَحوُّلُ شخص من الإسلام إلى غيره أو إلحاده، وليس المجازر والتغييب والتمييز الديني. هذه مشكلات أَزِفَ أوان طرحها والاستجابة الفاعلة لها. وهي اليوم بعد فشل ثوراتنا، وما شهدته من فورات في الشرّ الدولتي والديني في آن، مما يستوجب الرد مثلما يَستوجبه دفعُ سكين عن الرقبة.
في محاولة للاستجابة لوفرة الشرّ حولنا وقلّة التفكير فيه، تقترح هذه المداخلة تمييزاً بين شَرَّين، صغير وكبير، وبالتالي بين أشرار صغار وكبار. وسيظهر في سياق هذه المداخلة أنه لا علاقة لهذا التمييز بفكرة أهون الشرّين أو الشر الأقل والشر الأكبر الرائجة في مداولات سياسية غربية، وأميركية بخاصة، يمثل الشرُّ الأكبرُ فيها أعداء الأميركيين، أما الشرُّ الأقل فهو ما تضطر إليه الولايات المتحدة (أو إسرائيل) من ممارسات ليست مثالية وهي تواجه الشرَّ الأكبر. ومن الشر الأقل التعذيب، ومنه «الخسائر الجانبية»، ومنه التواطؤ مع أنظمةِ قتلٍ درءاً لما يُفترَض أنها شرور أكبر، «الإرهاب» تحديداً. بعبارة أخرى، الشرّ الأقل هو فعل أخيار أقوياء يحاولون دفع ما يعتبرونه شرّاً أكبر.
ومن أجل مثال توضيحي عن أهون الشرّين، يورد إيال فايسمان خلاصة تقرير لجنة لانداو الإسرائيلية الخاص بحظر التعذيب 1987، وهو يفيد بأن الحظر ليس مطلقاً، بل هو في الواقع يقوم «على منطق الشر الأقل». وعليه فإن «الأذى الناجم عن انتهاكِ تَحرُّزٍ قانوني أثناء التحقيق ينبغي أن يُوازَن مع الأذى الذي قد يطال، عاجلاً أو آجلاً، حياة الآخرين أو شخصهم ».Eyal Weizman: The Least of All Possible Evils, A short History of Humanitarian Violence, Verso, 2017. P 94-95. التعذيب بالتالي شر أهون من وجهة من يمارسون التعذيب (وليس من يُعذَّبون بطبيعة الحال)، و«الأذى الذي قد يطال حياة الآخرين [من يُشرِّعون التعذيب] أو شخصَهم» هو شرّ أكبر. وعملياً انضبطت سياسة الولايات المتحدة في سورية بهذا المفهوم، حيث الشرّ الأكبر هو الإرهاب الإسلامي، ومن الشرّ الأقل الضحايا المدنيون للحرب ضد الإرهاب، ومنه التواطؤ مع جرائم النظام وحلفائه، بما في ذلك اشتراط عدم مقاتلة النظام من قبل أي مجموعات سورية يتعاونون معها.
ومن الشرّ الصغير سكوت يساريين فرنسيين وغيرهم على معسكرات السخرة أو التشغيل القسري في الاتحاد السوفييتي الستاليني في بواكير الحرب الباردة، بذريعة عدم تقديم خدمة لليمين.يُنظَر في هذا الشأن كتاب سيمون دو بوفوار: المثقفون، وبخاصة الجزء الثاني، عن سجالات المثقفين اليساريين الفرنسيين بهذا الخصوص. الكتاب رواية، لكن يبدو أن اثنين من شخصياته الرئيسية، روبير دوبروي وهنري بيرون، يمثلان جان بول سارتر وألبير كامو. ترجمة ماري طوق، مشروع كلمة.
ولا تؤدي نظرية التناقض الرئيسي في تاريخ الشيوعية في القرن العشرين إلى مآلٍ مُختلف، فهو تتوافق مع الإغضاء عن ممارسات إجرامية لمن هم في معسكرنا، مقابل التركيز على العدو الرئيسي: الرأسمالية، الامبريالية، الاستعمار… إلخ.
الشرّ الصغير والشرّ الكبير
في هذا التناول يجري التمييز بين الشرّين الصغير والكبير على أساس من التمييز بين فاعلين صغار، أفراد أو مجموعات قليلة، وبين فاعلين كبار، دول أو تحالفات أو منظمات كبيرة. الشرّ الصغير يمارسه أشرار صغار، مثل اللص الذي يسرق مالاً أو ممتلكات ينتفع بها، ومثل المعتدي الذي يؤذي الغير جسدياً أو نفسياً ويهدد سلامتهم، وصولاً إلى القتل بغرض الانتقام أو الترهيب، ومثل من يكذب ويغش فيُضلّل ويخدع غيره أو يتسبب في فتن وقلاقل في وسطه. يغلب أن يحرك هؤلاء الأشرار الصغار جنيُ مكاسب مادية أو معنوية لأنفسهم، بما يُسوّغ الاعتقاد بأن محرك الشرّ الصغير هو الأنانية.
الشرّ الكبير بالمقابل ينشأ عن أنانية الجماعات، ولا يتكون للجماعة «أنا» كي تصير أنانية دون عقيدة أو رسالة، فكرة كبيرة، خيّرة دوماً. ولم نعرف في التاريخ جماعات أو أمماً ليست خيّرة في عين نفسها، حتى لتَكاد تحصر الإنسانية في ذاتها وتُحيل غيرها إلى اللاإنسانية أو البهيمية. الشرّ الكبير بالتالي هو الشرّ الذي يُقدم نفسه كخير عظيم، تقتضيه مصلحة الأمة أو شَرْعُ الله أو بناء الاشتراكية أو تعميم الحضارة، أو حتى نشر الديمقراطية. هذا شرّ أكبر بما لا يُقاس، ليس فقط لأنه يغلب أن تتكون حول شرع الله وخير الأمة ونقل الحضارة ونشر الديمقراطية وبناء الاشتراكية جماعات كبيرة عازمة، قادرة على الكثير من الأذى، ولا فقط لأن نمط الشخصية الذي يتربى على هذه الأفكار الكبيرة صلب، يأخذ الأفراد فيه أنفسهم بمزيد من الجدية، وإنما كذلك لأن تلك المبادئ والعقائد توفر راحة ضمير كاملة لمرتكبي أكبر الشرور عبر إظهارها كواجب وفعلِ خير.
والواقع أن أعظم الشرور في الأزمنة الحديثة ارتكبها من يخدمون الأمة أو الله أو التاريخ أو الحضارة، وليس لصوصٌ وكذبة ومُنتهِكون صغار أو عصابات منهم. الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش، وإبادة الشعوب الأصلية في الأميركيتين وأستراليا والعبودية الأطلسية، والاستعمار، والإبادة النازية، واحتلال العراق وأفغانستان قبل عقدين، والعدمية الإسلامية المعاصرة، والإبادة الأسدية في سورية، كلها قامت باسم مبادئ سامية، دينية وقومية واجتماعية وحضارية. حين قتل النازيون ملايين اليهود، كانوا يتخلصون من عِرق طفيلي متدنٍ وغادر، خائن لألمانيا، ويدافعون عن عِرق عبقري متفوّق طُعِن في ظهره من قبل اليهود والبلاشفة وغيرهم، ولعلّهم استندوا ضمناً إلى تَصوُّر نيتشوي للخير يطابقه مع القوة؛ وحين ارتكب الصهيونيون المجازر وهجّروا ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني كانوا يدافعون عن حق اليهود في الحياة وحاجتهم إلى دولة تخصهم وجيش يهودي يستطيع الدفاع عنهم؛ وحين يرتكب الحكم الأسدي المجازر ويقتل محكوميه بالسارين والبراميل، فهو إنما يدافع عن سورية ضد «مؤامرة كونية» ويخوض حرباً ضد «الإرهابيين»؛ وحين يرتكب إسلاميون في سورية وغيرها جرائم، فإنهم في عين أنفسهم إنما يدافعون عن شرع الله، وعن الشعب المسلم المظلوم؛ وكان الأميركيون ينقلون الديمقراطية إلى العراق حين كانوا يعذبون ويذلون العراقيين في أبو غريب.
ويبدو الأمر بمثابة قاعدة عامة، قد تُصاغ في صورة أن أكبرَ الشرّ ينشأ عن تصورات لأكبر الخير، تُفرَض بصورة أحادية الجانب على الجميع. ليست أفكار الحضارة والأمة والله والتاريخ شريرة جوهرياً، بل يغلب أن يتوافق ظهورها في التاريخ مع صعود جماعة كبيرة من الناس، خروجها من الغُفْلية وتَمكُّنها من أن تكون شيئاً مذكوراً. هذا كان حال جماعة المسلمين مثلاً، وقد خرج نثار بشري من الغمر وصار قوة عالمية. وعلى أرضية فكرة الطبقة العاملة كحامل للانعتاق البشري ظهرت الشيوعية، فأَلهمت ملايين البشر أفعالاً شُجاعة وأَعطتهم معنى للحياة. وتطورت في أوروبا الغربية أهم الأسس الفكرية والسياسية والمؤسسية للحضارة الحديثة التي يتطلع إليها الجميع في القرنين الأخيرين، وأتاحت لمئات الملايين التعلّم والترقي. على أن نُظُمَ الأفكار هذه نَفسها يمكن أن تؤسس للاستبعاد وضروب مختلفة للشرّ إن حازت السلطة وحدها، ومُنع نقدها والاعتراض عليها، فلا تتوافق فيما يبدو مع حياة طيبة إلا حين تكون ضمن بنى تعددية، أي حيث تكون دستورية ومُقيَّدة وخاضعة للمجادلة الاجتماعية. والقصد أنه ليس هناك عقائد بعينها تستطيع أن تكون عقائد خير في كل حال ودوماً. الخير ليس مسألة عقيدة أو دين أو فلسفة، بل هو مسألة دَسترة للعقائد والأديان والفلسفات، وللسلطات التي تُسوِّغ نفسها بها. لا الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية ولا البوذية… ولا الاشتراكية ولا الليبرالية ولا القومية، هي مذاهب خيرة دوماً وفي كل حال، وليس منها ما هو صالح لكل زمان ومكان. ولا هي مذاهب شريرة في كل حال في واقع الأمر. إنها تَصير شريرة بقدر ما تكون مُطلقة، أو بقدر ما تؤسس لذوات لا تأخذ وتعطي مع غيرها، أي لا تحد نفسها بأنفس أخرى، لا تفكر. وفي هذا إحالة ضمنية إلى نظرية حنة آرنت بأن الشرّ نِتاجُ فشل تَكوُّن الضمير الذي يتولد من التفكير، القدرة على وضع أنفسنا في موقع شخص آخر.
وهذه النقطة، الخاصة بالعلاقة بين شرّانية العقائد والدعوات الفكرية وإطلاقيتها، مهمة في سياقاتنا الفكرية والسياسية والدينية، لأنه يُعتقد على نطاق واسع، أقلّه بسبب غياب النقاش في هذا الشأن، أن الخير هو مسألة وجود عقيدة خيّرة أو مبدأ خيّر أو أشخاص خيّرين، والشرّ هو مسألة غياب أو نقص للمبدأ أو المبدئيين، أو بخاصة تعطيل فعلهم وحرمانهم من السلطة. هذا غير صحيح على ما تثبت تجاربنا وتجارب غيرنا. القومية التي قد تكون تحررية لشعب مُستعمَر أو مقهور، تصير قامعة حين لا يكون كذلك. والليبرالية التي تتوافق مع حريات الأفراد الاجتماعية تصير محامية للأقوياء خارج هذا النطاق. واليهودية التي كانت مضطهدة هي ديانةٌ يُسوّغ أكثر معتنقيها اضطهادَ الشعب الفلسطيني اليوم. وعلى ذلك فَقِس. فُرَص الخير مرهونة في كل حال بضبط تطلّع كل عقيدة وكل سلطة إلى التوسع والانفراد، وضمان حق الجميع في نقدها ومُساءلتها. فُرَص الشرّ هي التي تتوافق مع الإطلاق والدوام، ومع حكم الواحد، شخصاً أو ديناً أو حزباً أو تياراً.
وبعبارات أخرى، هناك نَسقَان من المشكلات يتصلان بعلاقة العقائد بكل من الشرّ والخير. نسق يتصل بمضمون العقائد، وهو يشيخ مع الزمن، ويكف عن كونه مُزكّياً للنفوس إن كان كذلك في الأصل.وهناك جدالٌ مشروعٌ في مدى التزكية أصلاً بخصوص الماركسية، مثلما نعلم بخصوص نقاشات ماركس وباكونين مثلاً، أو بعد الثورة الروسية بين لينين وروزا لوكسمبورغ. وكان شيءٌ مثل ذلك ظهر في التاريخ المبكر للإسلام، وصلتنا أصداؤه عبر القرون رغم الانتصار السياسي للإسلام، وأُدمِجت بعض المُساءلات الباكرة في النص التأسيسي عبر الوحي بالذات. ثم نسق مُغاير من مشكلات يتصل باستئثار العقائد بالسلطة، وبالتالي فرض نفسها على غيرها بالقوة، وقمع الجدل المحتمل بشأن نطاقات صلاحها وعدالتها.
وكمثال قريب ومهم، فإن الإسلامية المعاصرة تعاني من مشكلات الإكراه من خلال الدول أو منظمات منازعة لها، ومن مشكلات في التعاليم (أوضاع النساء، حرية الاعتقاد الديني، أحكام تتصل بالحرب…)، تفاقمت بفعل المعروض القِيَمي المتنوع والواسع الذي اقترن بانخراطنا في العالم الحديث والمعاصر من جهة، ثم بفعل حماية المُعتقَد القويم من النقاش الحرّ من داخله ومن خارجه من جهة أخرى. للتّو شهدنا من يدافع عن السبي والعبودية والجزية ويفرض ذلك بالقوة، ويقول إن هذا أفضل ما في العالم من شرائع وأعدلها وأحكمها. أما من يجادل في ذلك فيفقد حياته. أي أن البرهان العقلي على أن هذه أعدل الشرائع هو قطع رؤوس المتشككين، أو التخلص من عقولهم، لإقناع الرؤوس الباقية بالانحناء تسليماً. فرضُ المعتقد هو شرٌّ بحد ذاته وفي كل حال، يُحوِّله إلى سجن مؤبد، دون أن يعالج أياً من المشكلات التي يُحتمل ظهورها في التعاليم من وجهة نظر وجودنا في التاريخ وفي العالم اليوم. بالمقابل من شأن وجود المعتقد الإسلامي في إطار تعددي مُبرأ من الإكراه أن يُبقي المشكلات الخاصة بالتعاليم في نطاقات خاصة، محدودة الأذى، وقد يَدفع بعضَ المؤمنين إلى العمل على إصلاح هذه المشكلات التي تُوفِّرُ البيئةُ التعددية ذاتُها فُرَصاً لرؤيتها في إطار مقارن. فإذا صحَّ ذلك، كان أوجبَ للمسلمين الغيورين على دينهم أن يكافحوا من أجل ألّا يكون الإسلام في السلطة، كي يعالج مشكلات التعاليم المتولدة عن التاريخ، وربما يُعيدَ بناء نفسه كعقيدة إيمان طوعي أو ديانة ضمير، فيدافع عن نفسه دون حاجة إلى سلطات خارجية. وهذا كما نعلم عكس المسلك الشائع حيث لا يُتصوَّر دفاعٌ عن الإسلام لا يأخذ شكل بناء سلطة إكراه إسلامية، مقرونة دوماً بدفاع عن كمال التعاليم وصلاحيتها العابرة للأزمنة والأمكنة.
ومن أجل مثال آخر، يمكن التفكير في الشيوعية في القرن العشرين. كانت الشيوعيةُ ككتلة دولية في إطار متعدد هو العالم، ثم كأحزاب قوية تنشط بحرية إلى جانب غيرها في بلدان أوروبية، قوةَ عدالة وحقوق ودفاع عن حقوق العمال و«الشعوب المضطهدة» والشرائح الاجتماعية الأدنى، على نطاق عالمي وأوروبي، بينما كانت قوةَ رقابة وقمع وتفتيت اجتماعي ضمن الكتلة وفي متنها السوفييتي الذي موثلت تجربته مع الشيوعية إلى درجة أنها ماتت بموته، أو ظلت على قيد الحياة منها طوائف ماضوية معزولة. ظهرت تناقضات النظرية في التطبيق، وغابت الحرية التي تتيح التفكير في هذه التناقضات والنقاش بشأنها ومعالجتها.
وبالمثل حين انهارت الشيوعية وانفردت الرأسمالية في العقد الأخير من القرن العشرين، أخذت هذه تجمع بين شرور النموذج من استقطاب اجتماعي لمصلحة الرأسماليين ومن تدمير للبيئة، ومن تقويض للديمقراطية من داخلها عبر رشوة وإفساد النخب السياسية، وبين مشكلات التفرّد في العالم. وتأخذ هذه المشكلات اليوم شكل غياب البديل، أي تطبيع الرأسمالية كسلطة غير مُنازَعة، بما يعني عملياً أننا نعيش في سجن حاضر مؤبد، يمكنه أن يكون أخطر من أي سجون مكانية عرفناها، لأنه محسوس أقل، ثم خاصة لأن اللابديل شرط عالمي اليوم. بفضل نقيضها الاشتراكي، كانت الرأسمالية في إطار تعددي في أوروبا الغربية قد ظهرت في صيغة مسؤولة اجتماعياً أكثر، دولة الرفاه والسياسات الاشتراكية الديمقراطية التي أثمرتها.
والقصد من هذه الأمثلة أن الشرّ قرينٌ للواحدية القسرية، وأن ما قد يُخفّف من شرّ تتمخض عنه عقيدة أو نظام اجتماعي هو اندراجهـ/ا في إطار تعددي. التعدد بالتالي ركيزة أساسية للخير، الخير الذي لا يوجد مرة أخرى في صيغة مذهب أو دعوة أو دين أو فكرة محددة أيّاً تكن. وهذا لا يقتضي أن ننكر مفعولاً تهذيبياً للعقائد والمذاهب والأديان مثلما تَقدَّم، لكنه لا يدوم، ولا يستطيع أن يكون شاملاً للجميع. تُهذّب الدعوات الاجتماعية والفكرية البعض في بعض الأنحاء بعض الوقت، فصلاحُها محدود في الزمان والمكان والاستعدادات البشرية. وهي تصير قوة إعاقة بقدر ما تدوم وتنجح في استبعاد من تسميهم الهراطقة والكفار والتحريفيين والمُرتدين.
القصد كذلك أن أكبر الشرور تنشأ عن أفعال أخيار في تصورهم لأنفسهم، ينخرطون في صراعات بينهم، نحن والإسرائيليين مثلاً، أو نحن والإمبريالية الغربية ورسالتُها التحضيرية أو الناشرة للديمقراطية، أو الإسلاميون الأخيار جداً في عين أنفسهم والأميركيون الأخيار جداً كذلك في عين أنفسهم. ومعلوم أن أبطال الجماعات هم مجرمون في عين خصومها، والأمثلة لا تُحصى من التاريخ الإسلامي ومن التاريخ المعاصر، لنا ولغيرنا. وفي كل الحالات، ليس هناك مرتكبو جرائم جمعيون اجتمعوا دون فكرة عن الخير تربط بينهم. أما تَصوُّرُ الأمم والجماعات لذاتها بأنها خيّرة تواجه أشراراً من أمة أو جماعة أخرى فهو في واقع الأمر ميلودراما ركيكة، تتوافق غالباً مع أشد القسوة مع المنشقين الداخليين في أي من الجماعتين أو الأمّتين. وتنشب أعنف الصراعات بين حَمَلَة تصورات للخير ترفض الاعتراف بمحدوديتها ونسبيتها. واحد من هذه الصراعات بين «العالم الحرّ» و«المعسكر الاشتراكي» كاد يودي بالبشرية ككل إلى الفناء، وهو لا يزال في ذاكرتنا.
وهذه الفكرة، فكرة أن أعداءنا أشرارٌ خلافاً لنا نحن الأخيار، هي من موانع تطور الفكر السياسي والأخلاقي لدينا، نحن العرب المعاصرون، وبصيغتين: قوميةٌ عربية وإسلامية. لكن ما يقارب ذلك قائمٌ في كل مكان. وهو غير صحيح في كل حال. فليست أشدُّ صراعات اليوم والأمس صراعاً بين أخيار وأشرار، بل بين أخيار وأخيار، وهي لذلك مأساوية بحسب تعريف أرسطو للمأساة كصراع بين حق وحق. نحن وأعداؤنا أخيارٌ في عين أنفسنا، وأشدُّ شَرِّنا وشَرِّهم نابع من هذه الخيرية. ما يعني أننا وهم أشرارٌ في عينٍ غيرية. هل هذه العين موجودة؟ إنها ممكنة التصور، وهي اليوم حاجة عالمية.
وليس صحيحاً كذلك أن العين الغيرية تقضي بأن «الكل في الهوى سوا»، وإنه ما من خير ولا شرّ، وبالتالي إغراق كل شيء في النسبية، ليشغل الفلسطينيون والإسرائيليون الموقع الأخلاقي نفسه، أو الحكم الأسدي والثائرون عليه. فالعين الغيرية ليست عمياء عن تواريخ مسارات الصراعات، ومن هم الضحايا ومن المعتدون، ومن يدافعون عن امتيازات غير عادلة ومن يعملون على أن تكون لهم حقوق وأن يكونوا مُساوين لغيرهم. على أن العين الغيرية هي في الوقت نفسه إلزامٌ للجميع بمُساءلة النفس، أي بالنظر إلى أنفسنا بعينِ غيرنا، وعرض قضيتنا بأوضح ما يمكن والإقرار بعيوبنا وأخطائنا. العين الغيرية عينٌ بشريةٌ جوّالة، ترى وتشعر وتتعلم، وليست عيناً إلهية متعالية. وهي دعوة إلى الخروج من إطلاقية النفس وضبطها بدستور وإدخال شيء من التعدد فيها. ذلك أن الأقل ميلاً للاعتداء بيننا هم المتعددون، من لا يحملون أنفسهم وما في أنفسهم على مَحمل شديد الجدّ، وهذا نموذج من الشخصية لا يكاد ينتج اجتماعياً لدينا إلا على نطاق ضيق بفعل سلطة الواحديات، أو الاعتقاد بأن الخير محصور فيما نعتقد. يتوسّع ظهورُ نموذجِ المتعدد بالمقابل في فترات التحوّل نحو التعدد، وظهور توازنات اجتماعية وفكرية مرنة.
التفكير في هذا الشأن والنقاش في شأنه راهن جداً بالنظر إلى ما نعيشه من أزمة فكرية وسياسية وأخلاقية بعد إخفاق الثورات العربية، وما ظهر من أشكال من الشرّ الديني ما كانت في الحال ولا في البال.
وإطار النقاش في هذا الشأن اليوم عالمي، بالنظر إلى أوضاع التشابك العالمي، البشري والثقافي والسياسي والحقوقي والتكنولوجي من جهة، ومن جهة أخرى لأن العالم وحده ما يوفر إطاراً تعددياً ومقارناً للشرور والخيرات، ومن وجهة نظر العالم فقط يمكن تصور العين الغيرية. ومثل النظر في أحوال مجتمعاتنا، يُفيد النظر في أحوال العالم بأن الخير والشرّ لا يوجدان في شكل جوهر يمكن امتلاكه من قبل ثقافة أو أمة أو دين أو حضارة، بل هما علاقة بين الناس والجماعات والمجتمعات، متغيرة عبر الزمن. الأديان والأمم والثقافات كلها على تَنبُّه من الشرّ الصغير، تقمعه كلها، لكنها على عمى بنيوي من الشرّ الكبير الذي ينبثق منها، ولا تستطيع بطبيعة الحال الحدَّ منه لأنه هو ما يحدُّ منها، لأنه منبثق من خيرها بالذات. كيف إذن يمكن ضبط الشرّ الكبير؟ هنا أيضاً يلح الإطار العالمي، التفكير في الأمم والجماعات كمكونات لمجتمع عالمي هو الإطار الأعلى للإلزامات القانونية والالتزامات الأخلاقية.
لقد نشأتْ عقائدنا وثقافاتنا بينما البشر قبائل وأعراق وجماعات لغوية وأمم. واليوم نحن بشرية متفاعلة، تتخللها ضروب كثيرة من الشرّ واللامساواة، ولا تصلح عقائد الأمس لمعالجتها، بل هي تستفيد من ضروب اللامساواة والتمييز كي تُديم الشروخ والنزاعات. وإذا صحَّ أننا اليوم في أزمة عالمية، أزمة فقدان اتجاه وغياب بدائل، وأننا مُقبلون على أزمنة مضطربة، فإن من شأن المدخل الأخلاقي للتفكير أن يكون مُساهَمَة في فتح آفاق أكثر عدالة أمامنا.
أعود إلى الشرور الثلاث التي ذكرتُ في مطلع هذه المناقشة، السرقة والانتهاك الجسدي والكذب، للقول إنها من أفعال الأفراد والجماعات، أي من الشرور الصغيرة والكبيرة، التي عُرفت عبر التاريخ، ولم تعرف عقيدة أو جماعة البراءة منها. قد يمكن الحدّ منها بمزيج من جهود إصلاحية مدخلة للتعدد على الأفراد والجماعات وفي نطاق عالمي، ومن إجراءات قمعية تستهدف الفاعلين، بخاصة المنتهكين واللصوص، أما الكذب فيصعب قمعه، وتُوفِّرُ الأطر التعددية سُبُلَ كشفه أكثر من غيرها.
نفرد هذه الشرور الثلاث لأنها تقبل أن تكون كوكبات، تجتمع حول كلٍّ منها شرور مشاكلة أخرى. الانتهاك الجسدي يجتمع حوله التعذيب والاغتصاب وكل ضروب الانتهاكات الجسدية وصولاً إلى القتل، وحين تكون من أفعال الجماعات نتكلم على المجازر والإبادات والتهجير وغيرها؛ والسرقة يجتمع حولها الاستغلال والتسخير والنهب والاختلاس والرشوة و«التعفيش»، ومدارُها المُلكيات، مثلما مدارُ الإيذاء هو الجسد الحي، وحين تكون من أفعال الجماعات نتكلم على الاستعمار والعبودية وغيرها؛ والكذب يجتمع حوله الخداع والتضليل والتزوير، ومدارُه هو الحقيقة، وهي مِرفقٌ اجتماعيٌ أساسي، يتقوّض الاجتماع البشري من دونه لأنه يتعلق بتشخيص سليم للمخاطر بما يساعد على حسن التوجه في العالم، وحين يكون الكذب من أفعال الجماعات فإن الأمر يتعلق بالحملات الدعائية والتضليل المُنظَّم. قد يجازف المرء بإعادة اختراع العجلة بالقول إن المجتمع يتشكل حول سلامة الكيان الجسدي للأفراد، حول سلامة مُلكياتهم وفق تصوّر راهن للمُلكية الشرعية، وحول إتاحة المعلومات الصحيحة للجميع. نكون بأجسادنا، ونملك بما نملك، ونتوجه بما نعرف. ونوجد كمجتمع عبر نفي الأفعال التي تنتهك الجسد أو تعتدي على الملكيات أو تضلل وتنشر الأكاذيب.
تبدو مجتمعاتنا في أزمة وجودية لأن الأجساد مُهدَّدة دوماً، لأن المُلكيات تُسرق وتُنهب وتُعفّش، ولأن الكذب مُمأسس جهازياً. في سورية لدينا جهاز يسمّي الأشياء بغير أسمائها؛ الإعلام، وجهاز يمنع تسمية الأشياء بأسمائها؛ الأمن. وبقدر ما إنهما جهازا الحكم الأساسيان، فإن دلالتهما العيش في عالم كاذب، يفصله سور حماية عن الحقيقة. فضلاً عن ذلك، سورية دولة انتهاك مُنظَّم للأجساد مع سرقة مُنظمة بدورها. فلسطين في وضع معقد آخر، أجساداً ومُلكيات ومعلومات. واليمن، وليبيا، والعراق، ومصر، ولبنان. وخلاصة ذلك البسيطة هي أننا لسنا مجتمعات.
ثم أنه يُسوِّغُ إفرادَ هذه الشرورِ الثلاثة؛ الانتهاك الجسدي والسرقة والكذب، أنه في مواجهتها يمكن الدفع بثالوث قِيَمي يقوم على أساسه مجتمع وسياسة بديلة: الكرامة، العدالة (ومنها العدالة الاجتماعية)، والحقيقة. شعار الكرامة في الثورات العربية يمد جذوره في تصوري في الاحتجاج على نمط مُنتهِك للأجساد لممارسة السلطة في المجال العربي. الكرامة هي ألا نُعذَّب ولا نُغتصَب ولا نُضرَب ونُهان. وهو ما ينبغي أن ينفتح على دعوة إلى حُرمة الجسد، بما في ذلك ضد فرض زي أو مظهر قياسي عليه على يد أي سلطة. وتأخذ العدالة شكل حماية المُلكيات المشروعة للناس، وكذلك ضمان فُرَص حياة أفضل للشرائح الأدنى، المعرضين لكوكبة السرقة أكثر من غيرهم. أما الحقيقة فتتصل بتوفير المعلومات وحرية التعبير والاعتقاد والصحافة، بما يُتيح للمجتمع محاربة التضليل وأشكالَ الخداعِ العامة والخاصة.
الكرامة، العدالة، الحقيقة، هي الأرضيات القِيَمية لعمل الفاعلين العامين من أجل الخروج من أزمتنا الوجودية.
وختاماً، فإن من أغراض هذه المناقشة الدفاعُ عن استقلال الحكم الأخلاقي، استقلاله عن الدين وعن السياسة، وعن الأمة والحضارة، فلا يشتق من أيٍّ منها ولا يتبع لها. إنه مستوى مستقل للنظر في شؤون النفس والعالم، لا يلغي مستويات أخرى، ولا يصح أن تُلغيه.
أما ما يُسوِّغُ الانشغال الأخلاقي ذاته فهو الأهمية الحاسمة لفكرة الحرية. تؤشّر قلة الاهتمام بقضايا الأخلاقيات والقانون على ضعف تَطلُّبِ الحرية، في حين أن قوة هذا التَطلُّب تدعو إلى أن نفكر في القواعد الداخلية المعقولة التي تنظم حياتنا الاجتماعية حين نكون أحراراً. فإن لم ننشغل بذلك، فإن لدى قوى الطغيان في مجتمعاتنا رَدُّها على سؤال الحرية: ليس هناك حرية مطلقة، يقولون، فيفرضون قواعدهم الخارجية القامعة، ويستنتجون من لا إطلاقيةِ الحرية إطلاقيةَ الطغيان.