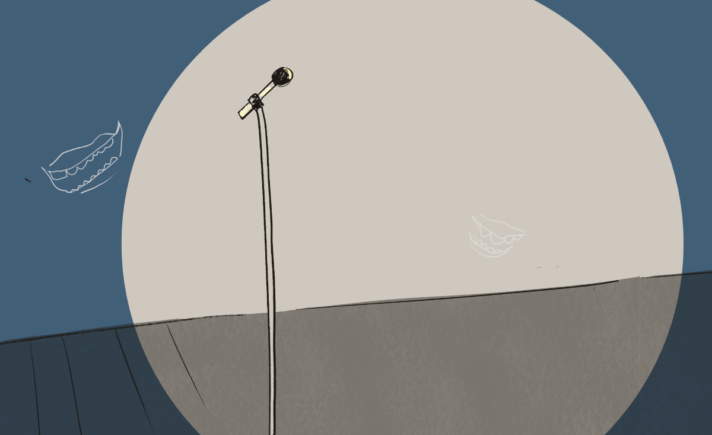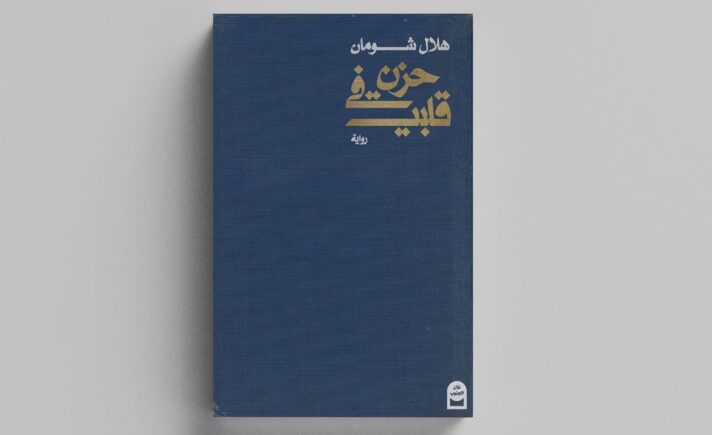منذ 2020 تتضاءلُ القدرة على الكلام إلى حد كبير. ففي لحظة الكارثة تقاومُ اللغةُ أن تصوغَ نفسها بأدوات الأمس. هذا التمنُّع مُتوَقَّع، إذ ما الذي يمكن قوله في لحظة الهَوْل؟
لحظةَ الكارثة، مثَّلَ التعبيرُ الغاضبُ، بكل ما تضمَّنه من شتائم، ذلك القصورَ في التعبير اللغوي، فضلًا عن معانيَ أخرى كُتِب فيها الكثير في الشهور التي فصلت بين 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 و4 آب (أغسطس) 2020. لكنَّ التعبيرَ عن الغضب سرعان ما نضب لصالح انهماك يومي في محاولات استمرار العيش، أو هروب كامل من البلد، أو حالة تامة من النكران.
أحاول التفكير في معنى ما حدث فعلًا في ذلك اليوم، وفي ما وصلنا إليه هذا الأسبوع من خطاب مسعور ضد اللاجئين السوريين وكل من يُشتبَه من مَظهره (!) أن يكون سوريًا. بالطبع، ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء مماثل في لبنان، فمآثرُ الاستهداف اللبناني لغير اللبنانيين وحتى للجماعات اللبنانية التي تعيش على هامش الغلبة الحاكمة، معروفة. هذا في أصل لبنان «المختلف»، حيث يصبح «الاختلاف» هوية فوقية تُشهَرُ في وجه الآخر.
فلندع المشهد القيامي الذي أدى إليه انفجار 4 آب جانبًا للحظة. باعتقادي، إنَّ وطأة الانفجار وقعت بتلك الضخامة في نفوسنا ليس لأنَّها أكدت الاتهامات العامة التي أفضت إلى لحظة 17 تشرين فقط، بل لأنَّها أخرجتنا من فرصة الأمل الممكن إلى حتمية اليأس الكامل. اتهامات 17 تشرين كانت تقول، في ما قالت، إنَّ صلاحية صيغة دولة السلم الأهلي قد انتهت، وإنَّ التسوية بين اللبنانيين ودَولتهم والتي ضمنت نظام عيشهم لم تَعُد سارية، وإنَّ المفوَّضين في مواقع المسؤولية في الدولة والجماعات مسؤولون عما آلت إليه الأمور. حدث انهيار الصيغة بالتقسيط، وعلى مراحل عدة، أُعدِمَ فيه تمامًا أي مجال لانخراط أهلي ونقابي وشعبي لصالح هيمنة طائفية وحزبية وجماعاتية متوحشة ضيقة الأفق (حتى بمفهوم هيمنة سنوات السلم الأهلي الأولى)، فَحَلَّ التوحُّش الكامل في «الإدارة» على إيقاع مفارقة البلد دوره «المميز».
صار لبنان غير ذي صلة في الزمن الجديد، وتُرِكَ الأمر كاملًا لحزب الله الذي أعاد تدوير ما حدث فقدَّمَ لجماعته سرديته «الحصارية» التي تلائم خطاب المظلومية التاريخية والانتصار الحتمي (الحالي والمستقبلي). في مقابل هذه الهيمنة، كان التعامل مع خروج 17 تشرين قاصرًا، فأُعيدَ إنتاج أشكال بائسة من زمن ما بعد 14 آذار 2005، معطوفة على تَمثُّلات تقنية من جوِّ الجمعيات غير الحكومية، وزاد من بؤس هذا التمثُّل التعالي الطبقي وانعدام التنظُّمِ الحزبي والاشتغالِ النظري.
جاء الانفجار ليُقدِّم لنا حقيقة أننا مشروع جثث في أي لحظة، وهو بالفعل حَوَّلَنا إلى جثث محكومة بصدمة ما حدث في ذلك اليوم. قدَّمَ لنا الانفجار حقيقة أنَّ الانهيار يمكن له أن يتخد معنى ماديًا مباشرًا للغاية: قتلٌ جماعي في لحظة واحدة لا يَذُر ولا يُبقي. وبعدما كانت إجابة سؤال «ماذا يمكن أن يفعلوا بنا؟» هي «الحرب الأهلية»، صارت الإجابة أقسى بما لا يُقاس وعصيَّةً على التخيُّل.
انفجار 4 آب عنى، في ما عنى، أنَّ كل شيء يمكن حدوثه، وأنَّ جهنَّم التي بُشِّرنا بها تتسع لخيال أوسع وأسوأ مما ظنَنَّاه، فانتهى الانفجار استعراضَ قوة غير مخطط له جَبَّ ما قبله من فُرَص تغيير، ولو ضئيلة. ولذا، لم تكن الانتخابات النيابية إلا تمرينًا كاذبًا يقدم فُرَصًا غير قائمة -على الإطلاق- للتغيير (حتى في معناه الإصلاحي لا الثوري). كانت الانتخابات فرصة فقط للقوى المُهيمنة للتبصُّر في حجم دورها عند جماعاتها بعد 17 تشرين ليبنوا على الشيء مقتضاه، بالتوازي مع اقتراحٍ لهضم الغضب العام وقلبه باتجاه صِيَغ ما قبل الانهيار: دعوهم يتمثلون داخل هيكل ما تبقى من مؤسسة دستورية. وقد تقافزَ على هذه الفرصة من روَّجَ لانتصارات صغيرة في زمن الانهيار العظيم، وكأنَّنا ندير أزمة نفايات أو إزاء دورة انتخابات في زمن سابق. أَبَّدَت الانتخاباتُ النيابيةُ لحظةَ 17 تشرين وتركتها عالقة في الزمن، وقفزت عن تأبيد الانفجار كحدث مفصلي لتقلبه حدثًا عاديًا يمكن أن تكمل من بعده ليس الحياة فحسب، بل عيش ما قبل 17 تشرين 2019. بترويجها وانخراطها في الانتخابات، فعلت جماعات 17 تشرين عكس المطلوب منها تمامًا، فآثرَت أن تُحصِّل امتيازات بائسة في بلد يسقط بشكل حرّ وتنعدم فيه أدنى أساسيات الحياة.
اليوم، يَتَّسِعُ المشهد المرعب الذي تشارك فيه المحطات التلفزيونية والإعلاميون والنشطاء والسياسيون والفنانون وعامّة الناس (في الشارع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي)، ويفوقُ حدودَ التخيُّل مقارَنةً بأقسى لحظات ما بعد 2005 أو الانفجارات اللاحقة، حين كان العمال السوريون يُخرَجون من الفانات ويضرَبون في الشوارع. وعلى الرغم من أنَّ الحملة الحالية أمنية بامتياز، لكنَّها تبني زخمها من جوٍّ عام قائم بالفعل، وهو جوٌّ لا يختلف كثيرًا عن عموم الأجواء العنصرية في أكثر من بلد فيها خطابات وطنية وانهيارات اقصادية وبطالة وانعدام مجالات سياسية حقيقية.
لا تبدو الحملة معنية بمَنْطَقَة أي شيء، وهذا شأن أي حملة أمنية موجَّهة. أيُّ محاولة لمَنْطَقَة النقاش أو تصويبه أو عَقلَنته ستنتهي بإجابات من نوع «وين عايش إنت؟» أو «شو بدك يعني؟» أو «إي أنا عنصري». هذه حملة مُدارة تتكئ على نبض شعبي جُسَّ مع موقف محافظ حركة أمل قبل أسابيع، تُعوِّل على متغيرات إقليمية ويُقدِّم بعضُ أطرافها أوراق اعتماد داخلية، موفرةً إشغالات متفرقة بمظلة خطاب وطني (ولو بصيغة كاريكاتورية) تستفيد منها كافة الجماعات.
تَستبدلُ الحملةُ كارثةَ الانفجار (التي لم يتحمل مسؤوليتها أحد)، وقبله ومعه وبعده الانهيار الكارثي المستمر (الذي لم يتلقفه أحد بشكل سياسي جذري بعيدًا عن الاعتراضات الصفرية والانتهازية اللحظية)، بكارثة جديدة معروفٌ المسؤولُ عنها، ويمكن للجميع الانخراط والربح فيها: «اللجوء»، والذي لا يُقدَّمُ فقط كمُساهم في الانهيار، أو كمسرِّع له، بل هو مسؤول أول عنه باستنزافه البنى التحتية، وهو الذي يمنع الحل. بعبارة أخرى، هذا هو الاستبدال الحقيقي الذي يختفي وراء خطاب الاستبدال الديموغرافي: استبدال كارثة مستمرة وهائلة بأخرى مُحدَّدة.
وكالعادة، يتنطح فلول 14 آذار لقول ما لا يقوله حزب الله (عن الاستبدال الديموغرافي) وتلك سمة مستمرة عند كل الواقفين قبالة الحزب حيث يلعبون دومًا دوره، بينما يستفيد الحزب من مواقفهم ليبدو في مظهر المتعفّف عن المواقف العنصرية، والمتأفّف دومًا من استدراجه الدائم إلى مثل هذه المهاترات، والمُنشغل في معركته الكبرى حيث يصوغ فيها ما هو أبعد وأعظم من هذا الخطاب «الوطني».
تُفسح الحملة لتَبَارُزٍ أدائي في ثنائية عنصري/لا عنصري، يربحه الخطاب «الوطني» العام مباشرةً بإجابة «عنصري وأفتخر»، فلا يعود الاتهام الأخلاقي ذا معنى، والأهم أن هذا الاتهام لا يحمي اللاجئين أبدًا. وبينما نَشهد هذه المبارزة الأدائية، يُشتَم سوريون، ويضرَبون، ويُرحَّلون إلى مصير كانوا قد هربوا منه.
تطرح الحملة إجابة وحيدة فقط عن سؤال: «ما الذي يعنيه أن تكون لبنانيًا اليوم؟»، والذي يختلف عن السؤال الأعمّ: «ما هو لبنان؟». فإجابةُ السؤال الأخير عالقةٌ في التاريخ، لا يريد أن يقترب منها أحد، ما يشرح الكثير حول لحظة الخطر الطاغية التي يعيشها كل من هو «غير لبناني» بمنطق خطاب الحملة، في الجثة المتفسخة التي اسمها لبنان، حيث تذوي فيها، وعلى هامشها، حيواتٌ بأكملها.