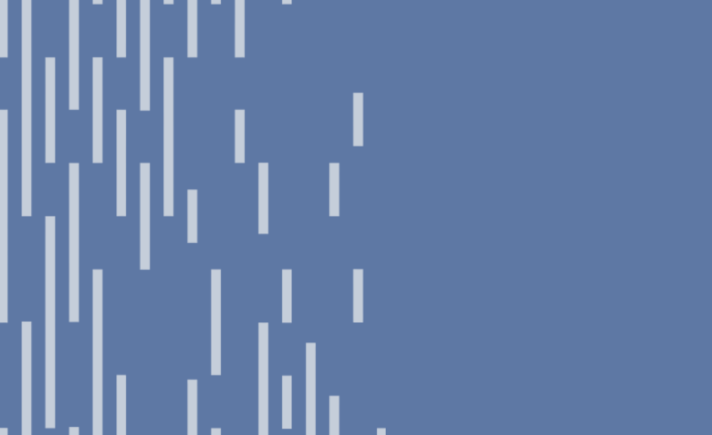عندما سألت تطبيق «تشات جي بي تي» حول ممكنات تحويل النص السينمائي أو التلفزيوني إلى فيديو للمشاهدة دون وساطة من شركات الإنتاج، كانت الإجابة حذرة وعامة واعتمدت تأكيد أن الدور البشري لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال. الواضح أن تَوقُّعَ هكذا نوعية من الأسئلة كان مدرجاً ضمن خوارزمية التطبيق. أقلّه حتى لا يصبح الهلع معمماً حول سلب هكذا تطبيقات محل البشر في مختلف المجالات، كما بات الاعتقاد سائداً منذ فترة ليست بالقصيرة، وبلغ واحدة من ذُراه مع يوفال نوح هراري في كتابه واحد وعشرين درساً للقرن الواحد والعشرين.
واضح أن المشكلة الحقيقية التي لم يستطع التطبيق الإجابة عليها، إلا بعد تفصيل في سؤال لاحق، هي تلك المتعلقة بـ «دمقرطة» عملية الإنتاج كاملة بحيث تقتصر فقط على أولئك المبدعين من مختلف التخصصات، نص، صورة، أداء، صوت وموسيقى، مع استبعاد أي دور وساطة (إدارة أو شركات الإنتاج) لا يمكن أن يفعل أصحابه شيئاً سوى ابتزاز جميع تلك الأطراف المبدعة للبقاء في مركز «مُتّخذ القرار» الأوحد، وعلى حساب عمل أولئك وإبداعهم.
هذه مشكلة لا يمكن أن تكون هناك إجابة واضحة لها في التطبيق نفسه، أو أي تطبيق مشابه أو مطوَّر، لكن الأخبار وبعض التجارب الفعلية لعدد هائل من المستخدمين بدأت تُبشّر بها، إنما في عالم واقعي أثبت أنه أشد شراسة في الدفاع عما يراه البعض «مكاسب» للبشرية لا يمكن الاستغناء عنها، وهي في جزء لا بأس به منها مكاسب لأولئك «المنافحين» عنها بكل ما أوتوا من سلطات راكموها عبر عقود من أجل التحكم المطلق في مجالات عملهم المختلفة. هنا يبرز نموذج هارفي واينستين ليس بصفته متحرشاً فقط، بل وأيضاً بصفته رمزاً لثقافة الهيمنة الذكورية التي فرضها المدراء التنفيذيون في بيئة عمل هرمية ومغلقة بتزمت، وخاضعة تماماً لأهوائهم.
الحديث هنا، وإن ما يزال عن القطاع الإعلامي في صيغته المرئية، إلا أن باقي القطاعات لا تختلف كثيراً في خطوطها العامة على الأقل، وفي «ثقافة» العمل المُعمَّمة، عمّا يحدث داخل هذا القطّاع الأشد إغلاقاً، وبشكل محكم، في مواجهة أي وافدين جدد مسلحين فقط بما يرونه مواهب جديرة بأن تجد فرصتها.
المشكلة مع الذكاء الصنعي للحقيقة ليست في برامجه وتطبيقاته، إنما فيما تطرحه هكذا برامج وتطبيقات من أفق لم تَخُض فيه البشرية من قبل أبداً. بحيث يصبح السؤال معكوساً: ما الذي يمكن أن يفعله البشر في مواجهة حالة جديدة طرحت ممكنات هائلة أمامهم، وهم ما زالوا يخضعون لنفس البنى التقليدية في العمل التي تفرض تراتُبيات بما يخدم فئات محددة، قد تكشف التطورات اللاحقة في الأساليب الجديدة للعمل، بالاستناد إلى الذكاء الصنعي، أنها زائدة عن الحاجة ومُعيقة للعملية برمّتها، وفوق هذا كله تخدم مصالح أخرى على حساب مصالح المنتجين الحقيقيين، والمقصود هو المبدعون في حالتنا هذه؟
بل إن التطورات اللاحقة (كمطالبة بعض أقطاب تكنولوجيا المعلومات بإيقاف تطوير برامج الذكاء الصنعي لستة أشهر تحت ذريعة معرفة أكثر بذلك الأفق الذي نتحرك إليه) تدل بوضوح على أن المسألة لن تقف عند حدود التأمل، وأن هنالك «عروشاً» بدأت تهتز فعلاً! الحقيقة أننا أصبحنا جميعاً أمام تحد جديد قد يؤدي إلى تغيير كامل في منظومة العمل التقليدية في مختلف القطاعات، وبالتالي الاستغناء عن ثقافة الهيمنة وما تستتبعه من تحرش وغيره من السلوكيات.
وحتى لا يُتَّهم كاتب هذه السطور بالمبالغة، أو بالعيش في أحلام يقظة باتت متطرفة بسبب تعامل أولي مع أول تطبيق ذكاء صنعي، أود الإضافة هنا أنَّ من اخترع هذا التطبيق هم بشر أصلاً، أي أن هذه ليست رسالة سماوية هبطت علينا فجأة إثر وحي مُباغت؛ ومن يتحكم برقاب البشر ضمن النسق الحالي لعلاقات السوق وبُنى الإنتاج بمختلف أشكالها، هم بشرٌ أيضاً. وبالتالي الصراع بين بشر وبشر، وهو صراع مصالح وليس صراع بشر في مواجهة ذكاء صنعي.
وبالاستناد إلى أعلاه، فإن المسألة لا تتعلق بمصائرنا كأفراد سنفقد أعمالنا لصالح ذكاء صنعي ينمو دون أن يعلم أحد كيف، ولن يلبث أن يلتهمنا جميعاً، بل إنها تتعلق بتلك المصالح التي ستنهار، وتلك التي ستظهر في مكانها. والسؤال بالتالي: هل سيسمح «أقطاب» العالم القديم لأولئك الذين يريدون بناء عالم جديد يستجيب لمصالحهم بحيث يصبحون هم «أقطابه» الجدد، بالقيام بهذا؟!
نتيجة هذا الصراع ليست محسومة. ودون الدخول في تفاصيل التحديات الجسيمة التي يفرضها وجود الذكاء الصنعي في حياتنا، والمخاطر الحقيقية التي سنتعرض لها، وهو موضوع جدير بنقاش مُفصّل ومنفصل عن هذه السطور، فإن السؤال الذي يطرح نفسه علينا، كـ «شغيلة» هذا العالم، قديمه وحديثه، هو كيف يمكننا الاستفادة من صراع المصالح هذا، الذي طالما كان مفيداً لنا عبر تاريخ طويل. لن ننسى الثورة الفرنسية مثلاً، وهي في أحد وجوهها المتعددة نتاج تحالفات جديدة أنشأتها مصالح جديدة بين قوى جديدة تريد الصعود في مواجهة قوى قديمة، تريد البقاء بأي ثمن. وكانت النتيجة ثورة غيّرت مجرى التاريخ كله.
لم يمض وقت طويل على «ثورة» كانت بالكاد بدأت مُبشّرة بعالم جديد، «ثورة الاتصالات»، وها نحن وبالاستناد إلى نفس المنصات التي أوجدتها هكذا ثورة، ندخل في منعطف ثورة جديدة من الواضح أنها إن أخذت فرصتها كاملة، فلن تبقي ولن تذر.
من ناحيتنا، نحن «الشغيلة»، فأغلب الظن أن الذكاء الصنعي لن يحل محلنا كبشر بقدر ما سيساهم في خلق بيئة مختلفة تتطلب أعمالاً من أنواع مختلفة تُمارس بطريقة لم نعتَد عليها من قبل. لو سمع أحد من «سكان المكاتب»، في نهاية الألفية الثانية حتى النصف الأول من التسعينيات، بالعاملين من منازلهم «Home Workers» وهم موظفون مثله في شركات ويؤدون نفس الخدمات التي يؤديها، وبفعالية أكبر بالتأكيد، لكان قلب الأمر كله إلى مادة للسخرية والتندر، هذا إن فهم شيئاً من السياق الجديد الذي نعيشه الآن فعلياً بعد عقدين فقط. هذا ولم أتطرق بعد لـ «مهنة» جديدة كليا اسمها «المؤثر» أو «Influencer». وبالتالي فأغلب الظن أن صراع المصالح هذا لن يضرنا في شيء إن انتصر فيه الوافد الجديد، إذ هو ككل وافد جديد، بحاجة إلى تغيير جديّ في موازين القوى يعطينا فرصة للصعود وفَرض مطالبنا، بحيث تصبح تلك المطالب أمراً واقعاً لا يمكن الالتفاف حوله فيما بعد. وهذا حصل أكثر من مرة عبر التاريخ.
وبالعودة إلى نقطة البداية، فإنه من الجدير بالتأمّل مجرّدُ طرح إمكانية الاستغناء عن تراتبية تعطي فرصة كبيرة لظهور متنمرين مغتصبين، ليس بالمعنى الجنسي فحسب بل أيضاً بمعنى فرض السطوة على الجميع وتحويل بيئة العمل كلها إلى سجون ضيقة على قياس أرواحهم. هي فكرة جديرة ليس بالتأمل فحسب، بل وبالسعي لتحقيقها. دورنا كـ «شغيلة» هو الدفاع عن قوة عملنا وإبداعنا في السوق بحيث تحصل على كامل حقوقها بمختلف أشكالها، ومن الواضح أن الذكاء الصنعي سيسعى بهذا الاتجاه ليكسبنا إلى طرفه. ومن فعل هذا، عبر التاريخ كله، فهو قد سعى جدياً لينتصر.