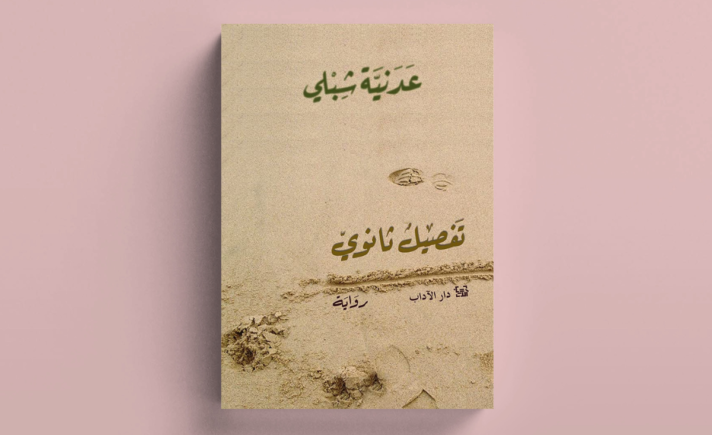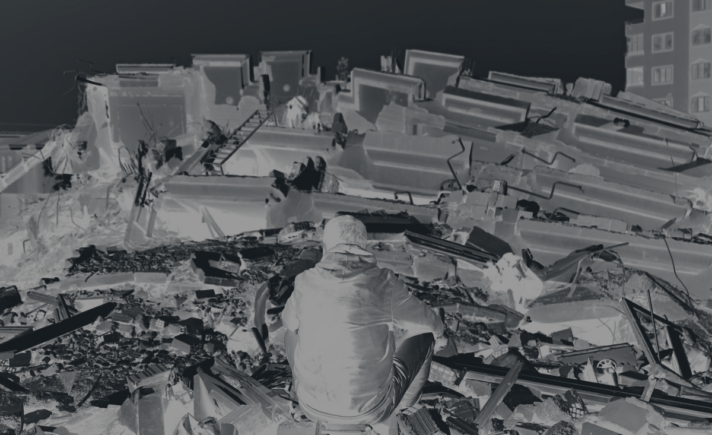توَّلّدَ ما يلي من مناقشة من تجربتي الشخصية ضمن حركة العولمة البديلة، حيث كانت قضايا الديمقراطية في مركز النقاش بقدر كبير. لقد وجد أناركيون من أوروبا وشمال أميركا، وكذلك منظمات سكان أصليين في الجنوب العالمي، أنفسهم في مهب جدالات مماثلة. هل «الديمقراطية» مفهوم غربي متأصّل؟ هل تُحيل إلى شكل من الحِكامة (نمط من التنظيم الذاتي للجماعات)، أو شكل من الحكومة (طريقة محددة في تنظيم جهاز الدولة)؟ هل تتضمن الديمقراطية حكم الأكثرية بالضرورة؟ وهل الديمقراطية التمثيلية ديمقراطية بالفعل؟ وهل الكلمة ملوثة دائماً بجذورها الأثينية: مجتمع مالكي عبيد، عسكري النزعة، يقوم على قمعٍ منظومي للنساء؟ وهل لما نسميه اليوم «الديمقراطية» أي صلة تاريخية بالديمقراطية الأثينية أصلاً؟ وهل يمكن لهؤلاء الذين يحاولون تطوير شكل من الديمقراطية المباشرة القائمة على الإجماع أن يصطلحوا الكلمة لأغراضهم؟ وكيف لنا، إن كان الأمر كذلك، أن نُقنع أكثرية الناس في العالم بأنه لا علاقة للديمقراطية بانتخاب ممثلين؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، وإن قبلنا عوضاً عنه التعريفَ القياسي، وشرعنا نسمي الديمقراطية المباشرة باسم آخر، فكيف يمكننا أن نقول إننا ضد الديمقراطية، وهي الكلمة التي ترتبط بتداعيات إيجابية في العالم كله؟
هذه جدالات حول الكلمات أكثر مما هي حول الممارسات. وبقدر ما يخص الأمر شؤون الممارسة، فهناك في الواقع درجة مفاجئة من التلاقي، بخاصة في الأوساط الأكثر جذرية من الحركة. فسواء تكلم المرء على أعضاء مجموعات زاباتيستا في تشياباس في المكسيك، أو المتاريسيين من العاطلين عن العمل الأرجنتينيين، أو المستقطنين [سكواترز: من يحتلون جماعياً أبنية خالية ويقطنون فيها] الهولنديين، أو الناشطين ضد الإخلاء في مدن جنوب أفريقيا، فالكل موافقون على أهمية البنى الأفقية مقابل العمودية، وعلى الحاجة إلى مبادرات مجموعات صغيرة مستقلة وذاتية التنظيم مقابل تلك التي تتنزل من فوق عبر تسلسل قيادي، وعلى رفض بنى القيادة الدائمة والحاجة إلى صيانة آليات من نوع ما، سواء كانت من النموذج الأميركي الشمالي من «التسهيل» [تصميم وإدارة ملتقيات وورش ناجحة في نطاقات تنظيمية]، أو من نموذج الاجتماعات النسوية والشبابية الزاباتستية، أو أي من التنويعات غير المتناهية من الممكنات التي تضمن سماع صوت من يجدون أنفسهم مهمشين عادة، أو مستبعدين من قبل آليات المشاركة التقليدية. وكمثال فإن بعض النزاعات المريرة بين مساندي التصويت الأكثري والتصويت التوافقي قد حُلّت إلى حد بعيد، أو إن شئنا الدقة صارت تبدو غير مهمة، وقت أخذت حركات اجتماعية متزايدة تقتصر على اعتماد التوافق الكامل ضمن المجموعات الأصغر، وتتبنى أشكال مختلفة من «التوافق المعدّل» ضمن الائتلافات الكبيرة. ثمة جديد ينشأ، والسؤال هو ماذا نسميه. العديد من المبادئ الأساسية للحركة مشتقة من التقليد الأناركي، ومنها التنظيم الذاتي، التجمع الطوعي، العون المتبادل، رفض سلطة الدولة. ومع ذلك ينفر كثيرون ممن يعتنقون هذه الأفكار من تسمية أنفسهم «أناركيين»، وحتى أنهم يرفضون التسمية رفضاً قاطعاً. مثل ذلك بخصوص الديمقراطية. لقد تمثّلت مقاربتي الشخصية في اعتناق العبارتين معاً، الديمقراطية والأناركية، والمجادلة بأن لهما الدلالة ذاتها في الواقع، أو هذا ما يجب أن يكون. على أني أقر بأنه ليس ثمة إجماع في هذا الشأن، ولا حتى وجهة نظر أكثرية.
يبدو لي أن هذه المسائل سياسية وتكتيكية أكثر من أي شيء آخر. لقد عَنَت «الديمقراطية» أشياء مختلفة كثيرة في مسار التاريخ. فحين نُحتت الكلمة أول مرة كانت تحيل إلى نظام يصنع القرار فيه مواطنو جماعة محلية ما عبر التصويت المتساوي في جمعية تضمهم. وخلال معظم التاريخ، أحالت الكلمة إلى اختلال [أو لا نظام] سياسي، إلى شغب، إعدام غير قانوني، وعنف فصائلي (والواقع أن تداعيات الكلمة مماثلة لتداعيات الأناركية اليوم). وحديثاً فقط تطابقت كلمة الديمقراطية مع نظام ينتخبُ فيه مواطنو دولةٍ ما ممثليهم الذين يمارسون سلطة الدولة باسمهم. ومن الواضح أنه ليس ثمة جوهر ديمقراطي يُكتشف هنا. فلعل المشترك الوحيد تقريباً بين هذه الدَوالّ هو إقرار من نوعٍ ما بأن المسائل السياسية التي هي عادة شغل نخبة ضيقة هي هنا مفتوحة للجميع، وبأن هذا جيد جداً أو هو سيء جداً. لقد كانت الكلمة مشحونة على الدوام، بحيث أن كتابة تاريخ الديمقراطية بأسلوب فاتر أو متجرد يبدو تناقضاً في الألفاظ. ويتجنب الكلمة معظم الباحثين الذي يريدون الحفاظ على مظهر متجرد. أما أولئك الذين يقومون بتعميمات عن الديمقراطية فلهم حتماً تحيزاتهم الخاصة.
أنا منهم، هؤلاء المتحيزين. ولذلك أشعر أنه من العدل إظهار تحيّزاتي للقرّاء منذ البداية. يبدو لي أن هناك سبباً وجيهاً لكون كلمة الديمقراطية، رغم دوام إساءة استخدامها من قبل الطغاة والغوغائيين، تحتفظ بجاذبية شعبية عنيدة. فما زالت الكلمة تُطابق فكرة إدارة الناس العاديين الجماعية لشؤونهم. وكان لها هذا التضمين في القرن التاسع عشر، ولهذا فقد أخذ سياسيو القرن التاسع عشر ممن اجتنبوا الكلمة في البداية بتبنيها، وبالإحالة إلى أنفسهم كـ«ديمقراطيين»، وأن يُلفِّقوا تاريخاً يمكّنهم أن يمثلوا أنفسهم فيه كوَرَثَة لتقليد يعود إلى أثينا القديمة. وعلى أي حال سأفترض أن تاريخ «الديمقراطية» يجب أن يُعامَل كتاريخ لكلمة «ديمقراطية» ليس إلا؛ أفعل ذلك دون سبب خاص، أو بالأحرى دون سبب بحثي خاص بالنظر إلى أن هذه المسائل ليست بحثية، بل هي مسائل أخلاقية وسياسية فقط. فإذا كانت الديمقراطية ببساطة شأن الجماعات المحلية بينما هي تدير أمورها عبر عملية نقاش عام مفتوحة وقائمة على مساواة نسبية، فليس هناك سبب لأن لا تكون الأشكال المساواتية من صنع القرار عند الجماعات الريفية في أفريقيا أو البرازيل مستحقة بالقدر نفسه لاسم النظم الدستورية التي تحكم معظم الدول الأمم اليوم، بل ولعلها في حالات كثيرة أجدر بهذا الاسم.
وعلى هذا الضوء، سأدلي بسلسلة من الحجج المتصلة، وقد تكون أفضلُ طريقة لمواصلة النقاش هي تقرير هذه الحجج في الحال:
- كل من يكتب في الموضوع تقريباً يعتبر «الديمقراطية» مفهوماً «غربياً»، بدأ تاريخه في أثينا القديمة، وأن ما أخذ سياسيو القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بإحيائه في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية هو هذا الشيء نفسه. وهكذا يُنظر إلى الديمقراطية كشيء يجد موطنه الطبيعي في أوروبا الغربية، وفي المستعمرات الاستيطانية الأوروبية الناطقة بالانكليزية والفرنسية. لكن هذا الافتراض غير مبرر بحال. ومفهوم «الحضارة الغربية» هو مفهوم مختل بوجه خاص، فإذا كان يُحيل إلى أي شيء على الإطلاق، فربما إلى تراث فكري. وفي عمومه، هذا التراث معادٍ لأي شيء على صلة بالديمقراطية، مثله في ذلك مثل تراثات الهند والصين وأميركا الوسطى.
- على أن الممارسات الديمقراطية، أي عمليات صنع القرار على قاعدة من المساواة، توجد في كل مكان، وليست مقصورة على أية «حضارة» مُعطاة أو ثقافة أو تقليد. وهي تَنْزَعُ لأن تنبثق حيثما شقت الحياة البشرية دربها خارج بنى القَسر النظامية.
- يَنزَعُ المثال الديمقراطي لأن يَظهر في شروط تاريخية معينة حين يُسائل المثقفون والسياسيون تراثهم الخاص، بينما هم يلتمسون سبلهم بين الدول والحركات الشعبية والممارسات الشعبية، فيعرضون أمثلة على ممارسات ديمقراطية من الماضي أو الحاضر بغرض إظهار أن تراثهم الخاص يتضمن لباً من لباب الديمقراطية، وهذا دوماً في سياق حوار مع تراثات أخرى. أسمي هذه اللحظات بـ«إعادة تأسيس الديمقراطية». ومن منظور تراث فكري بعينه، هذه اللحظات لحظات تعافٍ أيضاً، تعرض فيها المثل والمؤسسات التي هي في الغالب نتاج أشكال مذهلة التعقيد من التفاعل بين تواريخ وتراثات مختلفة أشد الاختلاف، ممثلة لأشكال ناشئة من منطق ذلك التراث الفكري نفسه. في مسار القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بصورة خاصة وُجِدت هذه اللحظات في كل مكان، وليس في أوروبا وحدها.
- ولا يعني قيام المثال الديمقراطي على تراثات مُخترَعة، جزئياً على الأقل، أنه غير أصيل أو غير شرعي، وعلى الأقل لا تعني أنه أقل أصالة وأقل شرعية من أي مثال آخر. وفي كل الحالات، يتمثل التناقض في أن هذا المثال يقوم دوماً على حلم مزاوجة مستحيلة بين الإجراءات والممارسات الديمقراطية وبين الآليات القسرية للدولة. ومحصلة هذه المزاوجة ليست «ديمقراطيات» بأي معنى حقيقي للكلمة، بل جمهوريات بقليل جداً من العناصر الديمقراطية.
- ما نمر به اليوم ليس أزمة في الديمقراطية بل هو أزمة في الدولة. في السنوات الماضية أُعيد إحياء الاهتمام على نطاق واسع جداً بالممارسات والإجراءات الديمقراطية بين الحركات الاجتماعية العالمية، بيد أن ذلك جرى بالكامل تقريباً خارج الأطر الدولتية. مستقبل الديمقراطية يقع بالضبط في هذه المساحة.
دعوني أتناول هذه النقاط بالترتيب الذي عرضتها فيه، وسأبدأ بالفكرة الغريبة التي تقول إن الديمقراطية هي «مفهوم غربي».
القسم 1: في اختلال فكرة «التراث الغربي»
أَبدأُ بهدفٍ سهل نسبياً: مقالة صموئيل هنتنغتون الشهيرة: صدام الحضارات. هنتنغتون أستاذٌ للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، مثقفُ حرب باردة كلاسيكي، وحبيب لمراكز التفكير اليمينية. وقد نشر عام 1993 مقالة تجادل بأنه بعد نهاية الحرب الباردة ستتركز النزاعات الدولية حول الصدامات بين التقاليد الثقافية القديمة. تميّزت دعوى هنتنغتون بأنها تروّج لضربٍ معيّن من التواضع الثقافي. فاستناداً إلى أرنولد توينبي، رجا هنتنغتون الغربيين بأن يفهموا بأن حضارتهم هي واحدة بين حضارات غيرها، وأن لا يفترضوا الكونية في قيمها. وهو جادلَ على الخصوص بأن الديمقراطية فكرة غربية، وأن على الغرب أن يكف عن بذل الجهود لفرضها على بقية العالم.
وبحسبه، يبدو ظاهرياً أن الكثير من الثقافة الغربية قد تَخلَّلَ بالفعل بقية العالم. لكن على مستوى أعمق، تختلف المفاهيم الغربية اختلافاً أساسياً عن تلك السائدة في حضارات أخرى. فلا يكاد يكون ثمة صدى للأفكار الغربية عن الفردانية والليبرالية والدستورية وحقوق الإنسان والمساواة والحرية وحكم القانون والديمقراطية والسوق الحرة وفصل الكنيسة عن الدولة، في الثقافات الإسلامية والكونفوشية واليابانية والهندوسية والبوذية والأرثوذكسية. وقد أنتجت المحاولات الغربية لنشر تلك الأفكار ردود فعل ضد «إمبريالية حقوق الإنسان» وإعادة تأكيد للقيم الأصلية، على ما يُرى من دعم للأصولية الدينية من قبل الجيل الأصغر في الثقافات غير الغربية. بل إن فكرة «حضارة كونية» بالذات فكرة غربيّة بحسب هنتنغتون، وهي في تَعارُض مع خصوصية معظم المجتمعات الآسيوية التي تشدد بالأحرى على ما يميز شعباً عن آخر (1993، 120).
قائمة المفاهيم الغربيّة هذه مدهشة من زوايا عديدة. فإذا أُخذت حرفياً، فإنها ستعني أن «الغرب» لم يأخذ شكلاً يمكن التعرف عليه إلا في القرن التاسع عشر أو حتى القرن العشرين، بالنظر إلى أن أغلبية كاسحة من «الغربيين» كانت سترفض معظم تلك المبادئ قبل ذلك، هذا إن كانوا قادرين على تصوّرها أصلاً. يمكن للمرء، إن شاء، أن يُعيي نفسه في البحث في الألفيتين أو الثلاث ألفيات الأخيرة في مواقع مختلفة من أوروبا للعثور على مقدمات معقولة لمعظم تلك المفاهيم. يحاول ذلك كثيرون. وتُؤمّن أثينا القرن الخامس قبل الميلاد مصدراً نافعاً في هذا الشأن، هذا إن كان المرء مستعداً لأن يتجاهل، أو على الأقل أن يمر مرور الكرام على كل حدث بين ذلك الوقت وعام 1215، بل ربما بينه وبين عام 1776. وتقريباً، هذه هي مقاربة معظم الكتب المدرسية التقليدية. هنتنغتون أرهفُ من ذلك بقليل. فهو يعامل اليونان وروما بوصفها «حضارة كلاسيكية» مستقلة، انقسمت بعد ذلك إلى مسيحية شرقية (اليونان) ومسيحية غربية (لاتينية)، وفيما بعد عالم الإسلام بالطبع. وحين بدأت الحضارة الغربيّة كانت مُطابِقة للمسيحية اللاتينية. على أن هذه الحضارة فقدت خصوصيتها الدينية بعد اضطرابات الإصلاح الديني والإصلاح المضاد وتحولت إلى شيء أرحب، علمانيٍ جوهرياً. على أن النتيجة التي يتأدّى إليها هنتنغتون تبقى مماثلة لما في الكتب المدرسية التقليدية، وهذا لأنه هو الآخر يصر على أن التقليد الغربي كان طوال الوقت وريثاً لأفكار حضارة اليونان الكلاسيكية، أكثر من المسيحية الأرثوذكسية ومن الإسلام.
والحال أن هناك ألف طريقة لمهاجمة موقف هنتنغتون. فقائمته من «المفاهيم الغربية» تتميز بالاعتباطية، وهناك العديد من المفاهيم التي طفت على السطح في أوروبا الغربية عبر السنين، وكثير منها مقبولة على نطاق واسع. فلماذا تُنتقى هذه القائمة دون غيرها؟ ما هو معيار الانتقاء؟ واضح أن هدف هنتنغتون المباشر هو إظهار أن كثيراً من الأفكار واسعة القبول في أوروبا الغربيّة وأميركا الشمالية يُنظر إليها بارتياب في مناطقَ أخرى من العالم. ولكن ألا يمكن للمرء، حتى على هذه الأرضية، تأليف قائمة مغايرة تماماً، فلنقل أن «الثقافة الغربية» قائمة على العلم، الصناعة، العقلانية البيروقراطية، القومية، النظريات العنصرية ودافعٍ لا يُحد للتوسع الجغرافي، وقد يمضي المرء إلى حد القول إن «الرايخ الثالث [الحكم النازي]» هو ذروة الثقافة الغربية؟ (والواقع أنه يُحتمل لبعض النقاد الراديكاليين للغرب أن يُقدِموا هذه الحجة بالضبط). لكن هنتنغتون أصر بعناد على هذه القائمة الاعتباطية بالذات بالرغم من النقد (مثلاً، 1996).
يبدو لي أن الطريقة الوحيدة لفهم سبب وضع هنتنغتون لتلك القائمة هي تُفحُّص استخدامه لكلمتي «ثقافة» و«حضارة». فإذا ما قرأ المرء نصّه بعناية، فسيجد أن عبارتي «الثقافة الغربيّة» و«الحضارة الغربيّة» قد عُوْملتا كمترادفتين. لكل حضارة ثقافتها الخاصة بحسبه. ومن جهتها، تبدو الثقافة مكونة أساساً من «أفكار» و«مفاهيم» و«قيم». وفيما يخص المثال الغربي يبدو أن هذه الأفكار كانت مشدودة يوماً إلى ضرب محدد من المسيحية، إلا أنها تحظى اليوم بتوزع جغرافي أو قومي أساساً، بعد أن مدت جذورها في أوروبا الغربيّة ومستعمراتها الاستيطانية الناطقة بالإنكليزية والفرنسية.
بل هو زاد الأمر سوءاً. ففي توضيح لاحق عنوانه: ما يجعل الغرب غربياً (1996)، يزعم هنتنغتون أن «التعددية» هي واحدة من صفات الغرب الفريدة. يقول: «إن المجتمعات الغربية شديدة التعدد تاريخياً. فما هو مميز للغرب على ما لاحظ كارل دوتش ’هو نهوض ودوام مجموعات مستقلة متنوعة، غير قائمة على روابط الدم والزواج‘. وبدءاً من القرن السادس والسابع شملت هذه المجموعات الأديرة والرهبانيات وأصناف الحرف، وانتشرت بعد ذلك في عدة مناطق في أوروبا لتشمل تشكيلة من الروابط والجمعيات» (1996: 234).
ويمضي هنتنغتون إلى بيان أن التنوع الغربي شمل كذلك تعددية طبقية (أرستقراطيات قوية)، تعددية اجتماعية (أجسام تمثيلية)، تنوعاً لغوياً، وغير ذلك. ويقول إن كل ذلك مهّدَ للتعقيد الفريد للمجتمع المدني الغربي. والحال أنه من الميسور إظهار كم أن كل ذلك مثير للسخرية. يمكن للمرء مثلاً أن يُذكّر القارئ بأن الصين والهند تمتعتا طوال معظم تاريخيهما بتعددية دينية أكبر بكثير مما في أوروبا الغربية،
لا يعدو جدال هنتنغتون أن يكون استشراقاً نمطياً عتيق الطراز بطرق متعددة،: يجري تمثيل الحضارة الأوربية بأنها ديناميكية على نحو متأصل، أما «الشرق» فهو، ضمناً على الأقل، راكد، لا-زمني، واحديُّ التكوين.
على أن ما أود لفت الانتباه إليه هنا هو اختلالُ أفكار هنتنغتون عن «الحضارة» و«الثقافة» ليس إلا. يمكن استخدام كلمة «الحضارة» لتعني شيئين مختلفين تماماً. فهي قد تُحيل إلى مجتمع يعيش الناس فيه في المدن، وهذا على نحو ما قد يُحيل عالم آثار إلى وادي الهندوس. أو قد تعني الكلمة الرهافة، التمام، الإنجاز الثقافي. ولكلمة الثقافة المعنى المزدوج نفسه. فهي تستخدم بالمعنى الأنثروبولوجي لتُحيل إلى بنى الشعور، والكودات الرمزية التي يمتصها المَنسوبون إلى ثقافة ما في سياق ترعرعهم، والتي تشكل كل أوجه حياتهم اليومية: كيف يتكلمون، يأكلون، يتزوجون، يومئون، يعزفون الموسيقى وغير ذلك. ومن باب استخدام مصطلحية بورديو، يمكن للمرء أن يسمي الثقافة هابيتوس(ب). وبالمقابل، يمكن استخدام الكلمة للإحالة إلى ما يسمى «الثقافة العليا»، أي أفضل وأعمق ما تنتجه بعض النخب الفنية والأدبية والفلسفية. إصرار هنتنغتون على تعريف الغرب فقط بمفاهيمه الأرفع، المرموقة أكثر من غيرها، مثل الحرية وحقوق الإنسان، يوحي بأنه إنما يُحيل إلى المعنى الأخير لكلمة ثقافة. ذلك أنه إذا كان للثقافة أن تُعرَّف بالمعنى الأنثروبولوجي، فلن يكون الورثة المباشرون لليونان القديمة الإنكليزيُ والفرنسيُ الحديثان، بل اليونانيون الحديثون. هذا بينما تقرر منظومة هنتنغتون أن اليونان الحديثة فارقت الغرب منذ 1500 عام، أي منذ اعتنق اليونانيون الشكل الخطأ من المسيحية [الأرثوذكسية].

والأمر باختصار أنه إن كان لفكرة «الحضارة» بالدلالة التي يستخدمها هنتنغتون أن تعني شيئاً، فلا بد من تصورها كتراثات(ج) لأناس يقرؤون بعضهم بعضاً من حيث الأساس. من الممكن القول إن نابليون ودزرائيلي(د) وريثان لأفلاطون وتوسيديدز أكثر من راعٍ يوناني معاصر للأوّليْن لسبب وحيد: يرجّح للرجلين كليهما أن يكونا قد قرآ أفلاطون وتوسيديدز [خلافاً للراعي اليوناني]. ذلك أن الثقافة الغربية ليست مجموعة مرسَلة من الأفكار، بل هي مجموعة من الأفكار التي يجري تعليمها في كتب مدرسية وتناقش في قاعات الدرس وفي المقاهي والصالونات الأدبية. ولو لم يكن الأمر كذلك، لتعذّر تخيل أن نصل إلى حضارة تبدأ باليونان القديمة، وتمر بروما القديمة، وتحتفظ بنصف حياة في عالم العصر الوسيط الكاثوليكي، لتحييها النهضة الإيطالية، ومن ثم تمر من هناك وتستقر في البلدان المتاخمة للمحيط الأطلسي الشمالي. ولامتنعَ كذلك شرح كيف أنه طوال معظم تاريخها وُجِدت تلك «المفاهيم الغربية» مثل حقوق الإنسان والديمقراطية بالقوة(هـ) فقط. يمكن القول إن هذا تراث أدبي وفلسفي، جَمْعةٌ من أفكار جرى تَصوُّرها بداية في اليونان القديمة، وانتقلت بعد ذلك في كتب ومحاضرات ودروس عبر ألفيات من السنين، وانجرفت نحو الغرب إلى أن تحول وجودها من القوة إلى الفعل وتحقق كُمونها الليبرالي والديمقراطي في بضعة بلدان متاخمة للأطلسي قبل قرن أو قرنين. ومنذ أن تكرّست في مؤسسات ديمقراطية جديدة، أخذت هذه الأفكار تتسرب إلى الحس الاجتماعي والسياسي الشائع للمواطنين العاديين. وأخيراً، رأى أنصار هذه الأفكار أن لها مكانة عالمية وحاولوا فرضها على بقية العالم. لكنها هنا بلغت حدها، إذ ليس في وسعها التوسع إلى مناطق تعمّها تراثات نصية قوية منافسة، تقوم على الدراسات القرآنية أو على تعاليم بوذا، أي تراثات تغرس مفاهيم وقيم أخرى.
يتصف هذا الموقف بأنه، على الأقل، متسق فكرياً. يمكن أن يطلق المرء عليه اسم نظرية الكتب الكبرى في الحضارة. وبصورة ما، هي نظرية مقنعة. إذا يمكن لقائل أن يقول إنه ليس لكون المرء غربياً علاقة بالهابيتوس. فلا صلة للصفة الغربية بتجسد عميق الأفهام للعالم يمتصها المرء في طفولته، أفهام تجعل بعض الناس انكليزاً من الطبقة العليا، وبعضهم صبيانُ مَزارع من بافاريا، وغيرهم أولاداً إيطاليين من بروكلين. الغرب، بالأحرى، هو التراث الأدبي الفلسفي الذي تجري تنشئتهم كلهم عليه، في سني المراهقة أساساً، وإن صارت بعض عناصر هذا التراث جزءاً من الحس الشائع للجميع تدريجياً. المشكلة أنه إذا طبق هنتنغتون هذا النموذج بصورة متسقة فإنه سيدمر نظريته. ذلك أنه إذا كانت الثقافة ما يتجسد بعمق من أفكار، فلماذا لا يمكن لامرأة من الطبقة العليا في البيرو أو صبي مزرعة من بنغلادش أن يأخذوا المناهج نفسها ليصيروا غربيين مثل أي غربيين؟ بيد أن هذا هو بالضبط ما يحاول هنتنغتون إنكاره.
وبفعل ذلك، يجد نفسه مضطراً للنَوَسان بين معنيين لكلمة «الحضارة» ومعنيين لكلمة «الثقافة». في الغالب يُعرِّف الغرب بمثله العليا. لكن في بعض الأحيان يُعرِّفه ببنيته المؤسسية المزامنة، مثلاً بتلك الأصناف الحرفية والرهبانيات القروسطية التي لا يبدو أنها تلقت الإلهام من قراءة أفلاطون وأرسطو، بل ظهرت «على كيفها» هي. أحياناً تُعامَل الفردانية الغربية كمفهوم مجرد، مقموع غالباً، فكرة محفوظة في الكتب القديمة، لكنها تُطل برأسها بين وقت وآخر في وثائق مثل الماغنا كارتا. وفي أحيان أخرى تعامَل بوصفها فهماً تجسد بعمق في عموم الناس؛ فهمٌ يتعذر استيعابه ممن نشأوا في تراثات ثقافية أخرى.
ومثلما قلتُ أعلاه فقد اخترت هنتنغتون لأنه هدف سهل. نقاشه في «صدام الحضارات» مهلهل غالباً،
ملاحظة معترضة: في شأن زلاقة العين الغربية
ما أقترحهُ هو أن فكرة الغرب بحد ذاتها مؤسسة على تضبيب مستديم للحد بين التراثات النصية وأشكال الممارسة اليومية. وها هنا مثال خاص قوي: في عشرينيات القرن العشرين، كتب فيلسوف فرنسي اسمه لوسيان ليفي- برول سلسلة من الكتب تقترح أن العديد من المجتمعات التي درسها أنثروبولوجيون تعرضُ «عقلية ما قبل منطقية» (1926، إلخ). وقد جادل بأن البدائيين يستخدمون مبادئ مختلفة عن تلك المنطقية التجريبية التي يستخدمها الغربيون الحديثون. لا لزوم لشرح النقاش ككل، فقد هوجم كل ما قاله ليفي برول فوراً تقريباً، وكل نظريته تُعتبر اليوم بلا أساس. ما لم يُشِر إليه عموم ناقديه هو أن ليفي برول يقارن بين التفاح والبرتقال [أي بين أشياء لا وجه معقولاً للمقارنة بينها]. فما قام به هو تجميع العبارات الطقسية الأشد إلغازاً لأناس من أفريقيا وغينيا الجديدة وأماكن أخرى، أو ردود فعلهم على أوضاع غير عادية، وهي عبارات وردود فعل كوّمها من المشاهدة مبشرون أو موظفون استعماريون أوروبيون، ثم حاولوا استقراء منطقها. وما قام به ليفي- برول بعد ذلك هو مقارنة هذه المادة لا مع مادة مماثلة جُمعت من فرنسا أو بلدان غربية أخرى، بل مع تصور مؤمثل كلياً لكيفَ يفكر الغربيون في أمثلِ الأحوال، وهذا بناء على نصوص فلسفية وعلمية (مدعمة دون شك بملاحظات عن طريقة تصرف فلاسفة وأكاديميين آخرين بينما هم يتناقشون ويتجادلون حول تلك النصوص). نتائج ذلك جليةُ السخف، فكلنا نعلم أن الناس العاديين لا يطبقون في الواقع القياس الأرسطي والمنهج التجريبي في شؤونهم اليومية، بيد أن من سحرِ أسلوبِ الكتابةِ هذا ألا يجد أحدٌ نفسه مدفوعاً إلى مواجهته.
وهذا لأنه أسلوب شائع جداً في الواقع. كيف يعمل هذا السحر؟ عموماً عبر دفع القارئ إلى التماهي بكائن بشري محدد دون خصائص محددة يعمل على حل لغز. يرى المرء ذلك في التراث الفلسفي الغربي، البادئ بأعمال أرسطو بخاصة، وهو تراث يعطي الانطباع بأن الكون إنما جرى خلقه البارحة، بما يوحي بأنه ما من ضرورة لمعرفة مسبقة، وهذا بخاصة إن جرت مقارنة هذا التراث البادئ من أرسطو بأعمال مماثلة في تراثات فلسفية أخرى (وهي قلّما تنطلق من مفكرين منزوعين من سياقاتهم). أكثر من ذلك، تنزع هذه الأعمال لعرض راوٍ مزوّد بالحس الشائع يقف في مواجهة ممارسات مُغرِبة. هذا مثلاً ما يجعل القارئ الألماني يقرأ كتاب تاسيتس: جرمانيا، ويتماهي تلقائياً مع منظور الراوي الإيطالي، وليس مع أسلافه الجرمان،
وأكثر من أي شيء آخر، «الفرد الغربي» عند ليفي برول ومعظم الأنثروبولوجيين المعاصرين هو بالضبط ذلك المراقب العقلاني الذي بلا ملامح، عين غير متجسدة، نُقِّيَتْ من أي محتوى فردي أو اجتماعي. وهذا هو الفرد الذي يفترض بنا أن نتظاهر أننا هو حين نكتب بعض أصناف النثر. إنه بلا علاقة تذكر بأي كائن بشري وُجد يوماً، نما وترعرع، أَحب وكره، وكانت له التزامات اجتماعية. إنه تجريد محض. والإقرار بهذه المشكلة يتسبب بمشكلة رهيبة للأنثروبولوجيين: فإذا لم يكن «الفرد الغربي موجوداً»، فبم تُجدي مقارنته بالغير بالضبط؟
يبدو لي على كل حال أنها تخلق مشكلة أسوأ لكل من يرجو أن يرى في هذا «الفرد الغربي» حاملاً لـ«الديمقراطية» كذلك. فإذا كانت الديمقراطية هي حكم الجماعة الذاتي، فإن الفرد الغربي هو ممثلٌ جرت تنقيته من أي روابط جمعية. وبينما قد يمكن أن نتصور هذا المراقب العقلاني الذي بلا ملامح بطلاً من أبطال أشكال معينة من اقتصاديات السوق، فإن جعله (وهو ذَكَرٌ ما لم ينص على العكس) ديمقراطياً لا يبدو ممكناً إلا إذا عرّفنا الديمقراطية ذاتها كنوع من السُوق يدخلها الفاعلون وبحوزتهم ما لا يزيد على جَمْعة من مصالح اقتصادية. وهذه بالطبع هي المقاربة التي تروج لها نظرية الخيار العقلاني [وهي تَفَكرٌ في المجتمع مكونٌ من أفراد يقررون وفق حسابات عقلانية تحددها تفضيلاتهم…]، ويمكنك القول إنها مُضمَرة بصورة ما سلفاً في المقاربة السائدة لصنع القرار الديمقراطي منذ أيام روسو، وهي ترى أن «المداولة» [الديمقراطية] هي مجرد موازنة للمصالح، وليست عملية يتكون عبرها الأفراد أنفسهم ويتشكلون (مانين، 1994).
إعادة تشكيل نظام العالم
من حق القارئ أن يتساءل هنا: إن كان «الغرب» مقولة بلا معنى، فبأي طريقة إذن نتكلم على هذه الشؤون؟ يبدو لي أننا في حاجة إلى جَمعة جديدة كلياً من المقولات. وفي حين أن هذا المقام لا يناسب تطوير هذه المقولات، فقد اقترحتُ في مقام آخر (غريبر 2004) أن هناك سلسلة كاملة من المصطلحات، تبدأ بالغرب لكنها تشمل كذلك مصطلح «الحداثة»، تحلّ عملياً محل التفكير. فإذا نظر المرء إلى تركز التمديُن، أو التراثات الأدبية- الفلسفية، صعبٌ عليه أن يتجنب الانطباع القاضي بأن أوراسيا كانت منقسمة خلال معظم التاريخ إلى ثلاثة مراكز رئيسية: منظومة شرقية وهي متمركزة حول الصين، ومنظومة جنوب شرق آسيوية متمركز حول الهند الحالية، ومنظومة غربية متمركزة حول ما يُعرف اليوم بـ«الشرق الأوسط»، وهي تمتد بقدر أكبر أحياناً وأصغر أحياناً في المجال المتوسطي.
وعليه فإنه يُستحسن التفكير بما اعتدنا على تسميته «صعود الغرب» كظهور لما سمّاه ميشيل رولف ترويلوت (2003)، مستعيناً بلغة أنظمة العالم: «المنظومة الشمال أطلسية» التي حلت بالتدريج محل شبه الهامش المتوسطي، وبرزت كاقتصاد عالمي مستقل، منافسة، ثم ببطء وبصورة مؤلمة، مدمجة الاقتصاد العالمي القديم الذي كان متمركزاً حتى ذلك الوقت حول المجتمعات الكوزموبوليتية حول المحيط الهندي. ولد هذا النظام الشمال أطلسي عبر كارثة يتعذر تخيلها: تدمير حضارات بأكملها، عبودية جمعية، ومقتل ما لا يقل عن مئة مليون إنسان. كما أنتج أشكالَه الخاصة من الكوزموبوليتية، عبر عمليات صهر لا تنتهي لتراثات أفريقية وأميركية أصلية وأوروبية. إن معظم تاريخ البروليتاريا الشمال أطلسية البحرية يجري بناؤه اليوم بالكاد، وهو تاريخ تمردات وقراصنة وثورات وانشقاقات وجماعات تجريبية وكل ضرب من ضروب الأفكار الشعبية المتناقضة، المستبعدة من التقارير التقليدية [عن تلك الحقبة]، التي ضاع أكثرها نهائياً، لكن التي يبدو أنها لعبت دوراً أساسياً في كثير من الأفكار الراديكالية التي سيحال إليها فيما بعد بكلمة «الديمقراطية». هذا استباقٌ للأمور من طرفي. أما الآن فأريد فقط أن أشدد على أن تاريخ «الحضارة» لا يتطور عبر عملية انبساط داخلي هردرية أو هيغلية(و)، بل إننا نتعامل بالأحرى مع مجتمعات متشابكة كلياً.
القسم 2: الديمقراطية لم تُخترع
بدأتُ هذه المقالة باقتراح أنه يمكن كتابة تاريخ الديمقراطية بطريقتين مختلفتين؛ فإما أن يكتب المرء تاريخ كلمة «ديمقراطية»، فيبدأ من أثينا القديمة، أو يكتب تاريخ ذلك الضرب من إجراءات صنع القرار المساواتية، الضرب الذي أخذت تُسميه أثينا بـ«الديمقراطي».
نميل عادة إلى أن نُماهي بين الاثنين لأن المعرفة السائدة تقرر أن الديمقراطية، ومثلها في ذلك العلم والفلسفة، اختُرعت في اليونان القديمة. ظاهر أن هذا التقرير غريب. فالجماعات المساواتية وُجدت طوال التاريخ البشري، وكثير منها كانت أكثر مساواتية من أثينا القرن الخامس قبل الميلاد، وكان لكل منها إجراءٌ من نوعٍ ما للتوصل إلى قرارات في المسائل ذات الأهمية المشتركة. ويغلب أن يتضمن ذلك الإجراء احتشاد الجميع في المناقشات التي يحوز كل فرد من الجماعة فيها، نظرياً على الأقل، فرصة كلام مساوية لغيره. مع ذلك، يفترض [في الغرب] أن هذه الإجراءات ليست «ديمقراطية» بكل معنى الكلمة.
والسبب الرئيس لما يبدو من أن لهذا الحجاج معنىً وجيهاً يدرَك حدسياً هو أن الأمور قلّما تصل في الجماعات المحلية الأخرى [غير الغربية] إلى التصويت. فلطالما اعتمدت هذه الجماعات على إيجاد توافق من نوع ما. وهذا أمر مهم بحد ذاته. فإذا قبلنا فكرة عرض الأيدي التي ترفع، أو انتحاء مؤيدي اقتراح ما جانباً من الساحة ورافضيها جانباً آخر، فليست هذه بالأفكار المعقدة جداً بحيث لا بد من عبقري قديم كي «يخترعـ»ها؛ فلماذا إذن قلّما جرى استخدامها؟ ولماذا تفضل الجماعات المحلية بدلاً من ذلك المهمة الأصعب، مهمة التوصل إلى قرارات توافقية؟
الشرح الذي أقترحهُ هو التالي: إن معرفة ما يريد القيام به من أمرٍ أكثريةُ أعضاء جماعة من جماعات المعشر [أي حيث يعرف الناس بعضهم] أسهل من معرفة كيفية تغيير فكر أولئك الذي لا يريدون القيام بذلك الأمر. صنع القرار التوافقي هو سمة مجتمعات لا توجد فيها طريقة لإجبار الأقلية على الموافقة على قرار الأكثرية، وهذا إما لأنه ليس هناك دولة تحتكر قوة إكراه، أو لأن الدولة غير معنية بعمليات صنع القرار المحلية، أو هي تميل إلى أن لا تتدخل فيها. فإن لم يكن ثمة طريقة لإجبار من لا يستسيغون قرار الأكثرية، فإن آخر ما يمكن أن يُراد هو إجراء تصويت: مسابقة عامة يخرج منها طرف ما خاسراً. إذ سيكون التصويت في هذه الحالة هو الوسيلة المرجّحة لضمان ضرب من الإذلال أو إثارة السخط أو تهييج الكراهيات التي تؤدي في النهاية إلى دمار الجماعات. ومثلما يمكن أن يخبرك أي ناشط تدرَّب على تسهيل إدارة مجموعة فعل مباشر(ز) معاصرة، فإن عملية التوافق ليست مثل النقاش البرلماني، وإيجاد التوافق لا يشبه بحال التصويت. ما نحن بصدده هنا بالأحرى هو عملية تسوية وتركيب يراد منها اتخاذ قرارات لا يجدها أيٌ كان جديرة باعتراض حاد إلى درجة ألا يوافقوا عليها. ويعني ذلك تمازج مستويين اعتدنا على التمييز بينهما، أعني صنع القرار ثم فرضه. ليس الأمر أن على الجميع أن يوافقوا على قرار معين. فمعظم أشكال التوافق تتضمن تنويعة من أشكال متدرجة من عدم الاتفاق. الأمر بالأحرى هو ضمان ألا ينصرف أناسٌ من الاجتماع وهم يشعرون أنه جرى تجاهل وجهات نظرهم كلياً، وهو ما يجعل حتى أولئك الذين يعتقدون أن المجموعة اتخذت قراراً سيئاً مستعدين لمنحه قبولاً سلبياً.
الديمقراطية الأكثرية يمكن أن تنشأ فقط حين يتلاقى عاملان:
1- شعور بأنه يجب أن يكون للناس قولٌ متساوٍ في صنع قرارات المجموعة،
و
2- جهاز إكراه قادر على فرض تلك القرارات.
كان نادراً خلال معظم التاريخ الإنساني توفر هذين العاملين معاً. فحيثما وُجدت مجتمعات مساواتية، فقد اعتبرت أنه من الخطأ فرض إكراه منظومي. وحيث وُجدت آلية إكراه لم يخطر مجرد خاطر على بال أولئك الذين يمارسون الإكراه أنهم إنما يفرضون إرادة شعبية من أي نوع.
ويتصل بذلك أن اليونان القديمة كانت واحدة من الأكثر تنافسية مما عَرفَ التاريخُ من مجتمعات. كانت مجتمعاً يَنزَعُ لأن يجعل كل شيء مسابقة عامة، من الرياضة إلى الفلسفة إلى المسرح التراجيدي إلى كل شيء آخر. لذلك لم يكن مفاجئاً تماماً أنهم جعلوا من صنع القرار السياسي مسابقة عامة كذلك. بل أن الأهم من ذلك هو حقيقة أن القرارات كانت تُتخذ من قبل الشعب المسلح. في كتاب السياسة يلاحظ أرسطو أن دستور المدينة-الدولة اليونانية يتحدد بالسلاح الرئيس في عسكرها. فإن كان سلاح الفرسان هو الرئيس فالحكم للأرستقراطية لأن الأحصنة غالية الثمن؛ وإن كان المشاة المدرعون، فالحكم للأوليغاركية لأنه لا يسع الجميع تحمل كلفة الدروع والتدريب؛ أما إذا كان السلاح هو قوات بحرية ومشاة خفيفة، فمن المتوقع أن الحكم ديمقراطي بالنظر إلى أنه يمكن لأي كان أن يُجذِّف أو يستخدم المقلاع. وبكلمات أخرى، إذا كان المرء مسلحاً فينبغي أن يؤخذ رأيه بعين الاعتبار. ونرى هذا المنطق فاعلاً بأوضح صورة في كتاب كزينوفرون أناباسيس، الذي يروي قصة جيش من المرتزقة اليونانيين وجدوا أنفسهم فجأة ضائعين وبلا قيادة في وسط بلاد فارس. فكان أن انتخبوا ضباطاً جدداً، وقاموا بتصويت جماعي لتقرير ما يفعلونه بعد ذلك. في حالة كهذه، وحتى لو كانت نتيجة التصويت 60 مقابل 40، فيمكن لأي كان أن يرى توازن القوى القائم، وما يمكن أن يحدث إذا بلغت الأمور درجة تبادل الضربات. لقد كان كل صوت فعل إخضاع بالمعنى الحقيقي للكلمة.
وبكلمات أخرى من جديد، هنا أيضاً تنحل (أو يمكن أن تنحل) في بعضها صناعة القرار مع أدوات فرضه، وإن بطريقة مغايرة.
ولقد أمكن للفيالق الرومانية أن تكون ديمقراطية على هذا النحو ذاته [أي عبر حمل السلاح]. وإنما لذلك لم يُسمَح لها قط بأن تدخل إلى روما. وحين أحيا ميكافيلي فكرة الجمهورية الديمقراطية في فجر «الحداثة»، رجع مباشرة إلى فكرة الشعب المسلح.

وقد يشرح ذلك مصطلح «الديمقراطية» نفسه الذي يبدو أنه صيغ كقدح من قبل خصومها النخبويين. فهو يعني حرفياً «قوة» أو حتى «عنف» الشعب. قراطوس وليس أركوس [نظام]. النخبويون الذين صاغوا المصطلح اعتبروا الديمقراطية دوماً شيئاً غير بعيد عن الشغب وحكم الرعاع، وبالطبع كان حلهم لهذه المشكلة هو الإخضاع الدائم للشعب على يد طرف آخر. والمفارقة الساخرة أنه حيثما استطاعوا قمع الديمقراطية بوصفها شغباً ورُعاعية، وهو ما حدث غالباً، كانت النتيجة هي أن إرادة الشعب العامة عُرفت فقط من خلال الشغب، وهي الممارسة التي تمت مأسستها في روما الإمبراطورية مثلاً، وفي إنكلترا القرن الثامن عشر.
هناك سؤال يحتمل تقصياً تاريخياً، يتصل بدرجة تشجيع الدولة الفعلي لهذه الظواهر. لست أُحيل هنا إلى الشغبَ بالمعنى الحرفي للكلمة بالطبع، بل إلى ما يمكن تسميته «المرايا القبيحة»، أعني مؤسسات تروّج لها النخبة وتدعمها، وهي من جانبها تعزز فكرة أنه لا يمكن لعملية صنع القرار شعبياً إلا أن تكون عنيفة، فوضوية، و«حكم رعاع» عشوائياً. أنا أشتبه بأن هذه المرايا شائعة في الأنظمة التسلطية. تأمَّل مثلاً في حقيقة أن الحدث العام المُعرِّف للديمقراطية الأثينية هو الأغورا [الساحة العامة، يلتقي الناس فيها ويتداولون في شؤونهم ويتخذون القرارات العامة]، أما الحدث المُعرّف في روما فهو السيرك، حيث يتجمع العوام لمشاهدة سباق أو منافسات بين مجالدين أو إعدامات جماعية. جرت هذه الألعاب تحت رعاية مباشرة من الدولة، أو في الغالب، رعاية أعضاء محددين من النخبة (Veyne 1976; Kyle 1998; Lomar and Cornell 2003).
ما يَفتن في مسابقات المجالدين بخاصة، هو أنها تتضمن ضرباً من صنع القرار الشعبي: الهتاف الشعبي هو من يقرر القضاء على حيوات أو الإبقاء عليها. لكن بينما كانت إجراءات الأغورا الأثينية مصممة لتعظيم كرامة الديموس وتروّي مداولاته، وهذا برغم ما هو مضمر فيها من عنصر إكراه، قد يصل أحياناً إلى صنع قرارات بسفك الدم، كان السيرك الروماني عكس ذلك تماماً تقريباً. فقد تميز بجو من الإعدامات الدورية غير القانونية برعاية الدولة. وتكاد كل صفة تنسب عادة إلى «العوام» من قبل الكتّاب اللاحقين المعادين للديمقراطية، مثل النزوية المتقلبة، القسوة الفاجرة، الفصائلية (كان مناصرو فرق العربات المتنافسة يتقاتلون عادة في الشوارع)، عبادة الأبطال، جنون الأهواء، كل هذه الصفات كانت موضع تشجيع وليس فقط موضع تسامح في المدرجات الرومانية. يبدو الأمر كما لو أن النخبة التسلطية كانت تحاول أن تزوِّد العموم بدفق متواصل من صور كابوسية للفوضى التي سيتمخض عنها استيلاء العوام على السلطة.
ليس المقصود من التركيز على الأصول العسكرية للديمقراطية المباشرة أن التجمعات الشعبية في المدن القروسطية، أو في التجمعات في بلدات نيوإنغلاند مثلاً كانت خلواً من إجراءات مرتبة ومحترمة وفق الأصول. وهذا بالرغم من أن المرء يشتبه بأن وجود الإجراءات والأصول نشأ جزئياً عن حقيقة أنه كان ثمة خط معين من السعي وراء التوافق يجري اتباعه في الممارسة الفعلية هنا أيضاً. ومع ذلك يبدو أن هذه التجمعات فعلت القليل لتجريد أعضاء النخب السياسية من فكرة أن الحكم الشعبي سيشبه أكثر السيركات وممارسات الشغب في روما وبيزنطة. يُسلِّم مؤلفو الأوراق الفدرالية(ح)، مثلهم في ذلك مثل كل متعلمي زمانهم، بأن ما يسمونه «الديمقراطية» (ويعنون بها الديمقراطية المباشرة أو «الديمقراطية النقية» مثلما يسمونها أحياناً)، غير مستقرة بطبيعتها، شكل مضطرب من الحكومة، هذا دون قول شيء عن أنها تُعرّض للخطر حقوق الأقليات (الأقلية المحددة التي في بالهم هنا هي الأغنياء). فقط حين أمكن لمصطلح «الديمقراطية» أن يتحول كلياً ليستوعب مبادئ التمثيل (ولهذه الكلمة تاريخ مثير للفضول، بالنظر إلى أنها تَحيل في الأصل إلى ممثلي الشعب أمام المَلِك، أي إلى سفراء داخليين في واقع الأمر، على ما كان كورنيليوس كاستوريادس يحب أن يذكر (1991; Godbout 2005)، مقابل أولئك الذي يمارسون السلطة بأنفسهم)، أقول فقط عندئذٍ أمكن أن يُعاد تأهيله عند المنظرين السياسيين من ذوي المولد الامتيازي، وأن يأخذ معناه الجاري اليوم. سأنتقل في المقطع اللاحق، وإن بصورة وجيزة، إلى بيان كيفية حدوث ذلك.
القسم 3: بخصوص ظهور «المثال الديمقراطي»
الأمر اللافت هو كم من الوقت استغرق حدوث ذلك. في القرون الثلاثة الأولى من عمر النظام الشمال أطلسي، استمرت الديمقراطية تعني «الرعاع». وكان هذا صحيحاً حتى في «عصر الثورات»(ط). ففي جميع الحالات تقريباً، رفض مؤسسو ما نعتبرها الآن دساتير ديمقراطية في إنكلترا وفرنسا والولايات المتحدة أي إيحاء بأنهم إنما كانوا يقيمون «ديمقراطية». ومثلما لاحظ فرانسيس دوبوي- ديري (1999، 2004): كان مؤسسو الأنظمة الانتخابية الحديثة في الولايات المتحدة وفرنسا مضادين للديمقراطية علانية. ويمكن شرح النزعة المضادة للديمقراطية هذه جزئياً بمعرفتهم الواسعة للنصوص الأدبية والفلسفية والتاريخية اليونانية الرومانية القديمة. كان شائعاً للشخصيات السياسية الأميركية والفرنسية أن يروا أنفسهم ورثة مباشرين للحضارات الكلاسيكية، وأن يعتقدوا أنه طوال التاريخ، من أثينا وروما إلى بوسطن وباريس، تَواجهت القوى السياسية نفسها في صراعات أبدية. وقد وقف أولئك المؤسسون إلى جانب القوى الجمهورية ضد القوى الأرستقراطية والديمقراطية، وكانت روما الجمهورية هي النموذج السياسي لكل من الأميركيين والفرنسيين، فيما كانت الديمقراطية الأثينية محتقرة كنموذج مضاد (دوبوي- ديري 2004: 120).
في العالم الناطق بالإنكليزية مثلاً كان معظم المتعلمين في القرن الثامن عشر على إلفة بالديمقراطية الأثينية عبر ترجمة توماس هوبس لتوسيديدس أساساً. وما كان مفاجئاً بالتالي الاستنتاج بأن الديمقراطية [في تصورهم] غير مستقرة، مضطربة، ميالة إلى الفصائلية والغوغائية، وتتميز بنزعة قوية نحو الاستبداد.
وهكذا، كان معظم السياسيين معادين لأي شيء يشبه الديمقراطية، وهذا بالضبط لأنهم رأوا أنفسهم ورثة لما يسمى اليوم «التراث الغربي». كان مثال الجمهورية الرومانية مكرّساً في الدستور الأميركي الذي كان واضعوه يحاولون بوعي محاكاة «الدستور المختلط» لروما، الدستور الذي يوازن بين العناصر الملكية والأرستقراطية والديمقراطية. في الدفاع عن الدستور (1797) جادل جون آدامز مثلاً بأن مجتمعات مساواتية حقاً غير موجودة، وبأنه كان لكل مجتمع بشري معروف قائد أعلى وأرستقراطية (سواء كانت أرستقراطية ثروة أم أرستقراطية فضيلة طبيعية) وشعب، وأن دستور روما كان الأكمل في إقامة توازن بين هذه القوى. وكان يُراد للدستور الأميركي أن يُدخِل هذا التوازن عبر إقامة رئاسة قوية، ومجلس شيوخ يمثل الأغنياء، وكونغرس يمثل الشعب، وإن تكن قوة الأخيرين على توفير تحكّم شعبي بتوزيع أموال الضرائب قد حُدّت بقدر كبير. يكمن المثال الجمهوري في صلب المؤسسات «الديمقراطية»، وإلى اليوم يحب مفكرون أميركيون محافظون أن يشيروا إلى أن «أميركا ليست ديمقراطية، إنها جمهورية».
وقد لاحظ جون ماركوف من جهة أخرى أن «أولئك الذين كانوا يسمون أنفسهم ديمقراطيين في أواخر القرن الثامن عشر كانوا في الغالب مرتابين بالبرلمانات، ومُعادين صراحة للأحزاب السياسية المتنافسة، ناقدين للتصويت السري، غير مهتمين بتصويت النساء أو حتى معارضين له، وأحياناً متسامحين مع العبودية» (1999: 661). وهذا غير مفاجئ من أولئك الذين يَودون إحياء تجربة أثينا القديمة.
في ذلك الوقت كان ديمقراطيون صرحاء من هذا النوع، أشخاص مثل توم باين مثلاً، كانوا يُعتبرون أقلية ضئيلة من مُهيجي الرعاع حتى من قبل النُظُم الثورية. أخذت الأمور تتغير فقط في القرن اللاحق. في الولايات المتحدة، حيث توسّع حق الانتخاب في العقود الأولى من القرن التاسع عشر، وازداد اضطرار السياسيين إلى التِماس أصوات مزارعين صغار وعمال مدنيين، أخذ بعضهم يتبنى الكلمة. وقد تَصدَّر هؤلاء أندرو جاكسون الذي أخذ يصف نفسه كديمقراطي في عشرينيات القرن التاسع عشر. وخلال عشرين عاماً أخذ جميع السياسيين، بمن فيهم الأشد محافظة، وليس الشعبيون منهم فقط، بفعل الشيء نفسه. وفي فرنسا أخذ الاشتراكيون يدعون إلى «الديمقراطية» في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وبنتائج مماثلة. فخلال عشر سنوات أو خمس عشرة سنة، أخذت الكلمة تُستخدم حتى من قبل الجمهوريين المعتدلين والمحافظين ممن اضطروا لمنافستهم على أصوات الجمهور (دوبوي- جيري 1999، 2004). وشهدت الفترة نفسها إعادة تقييم درامية لأثينا التي أخذت منذ عشرينيات القرن التاسع عشر تمثل تجسيداً للمُثَل النبيلة للمشاركة العامة، وليس كابوساً من كوابيس سيكولوجيا الحشد العنيف (ساكسون هاوس 1993). على أن هذا التحول لم يحدث وقتها لأن أياً كان اعتنقَ الأسلوب الأثيني من الديمقراطية المباشرة، ولو على المستوى المحلي. بل يُخيّل للمرء في الواقع أن هذه الواقعة بالذات [يبدو أن غريبر يعني نبذ الديمقراطية المباشرة] هي ما جعلت إعادة تأهيل أثينا القديمة شيئاً ممكناً. لقد أخذ معظم السياسيين يُحِلون كلمة «ديمقراطية» محل «جمهورية» دون أي تغيير في المعنى. وإني لأرتابُ بأن إعادة تقييم أثينا إيجاباً أوثق صلة بالافتتان الشعبي بأحداث اليونان في ذلك الوقت أكثر من أي شيء آخر، وبخاصة حرب الاستقلال عن العثمانيين بين 1821 و 1829. كان يتعذّر ألا ترى تلك الأحداث تكراراً للصدام بين الإمبراطورية الفارسية والدولة المدينة اليونانية على نحوِ ما رواه هيرودوت في نص مؤسس للتقابُل بين أوروبا المُحبِّة للحرية والشرق المستبد، وبطبيعة الحال يقود تغيير الإطار المرجعي من توسيديدز إلى هيرودوت إلى صورة أفضل لأثينا.
حين بدأ روائي مثل فكتور هوغو وشاعر مثل والت ويتمان التغني بالديمقراطية كمثال جميل، على ما أخذا يفعلان في ذلك الوقت، لم يكونا يُحيلان إلى ألعاب النخب بالكلمات، بل إلى عاطفة شعبية عريضة دفعت مزارعين صغاراً وعمالاً مدينيين لأن يستحسنوا الكلمة، حتى حين كانت النخبة السياسية لا تزال تستخدمها ككلمة سيئة. وبكلمات أخرى، لم ينشأ «المثال الديمقراطي» من التراث الأدبي الفلسفي الغربي. لقد فُرض عليه بالأحرى. والواقع أن فكرة أن الديمقراطية هي مثال «غربي» ظهرت بعد ذلك بوقت طويل. فخلال معظم القرن التاسع عشر، عرّفَ الأوربيون أنفسهم ضد «الشرق» أو «المشرق»، وهم فعلوا ذلك كأوروبيين لا كغربيين.
أما «الحضارة الغربية» التي يتكلم عليها هنتنغتون فقد ولدت متأخرة حتى عن ذلك. لقد استخدمت هذه الفكرة أول مرة في الجامعات الأميركية بعد الحرب العالمية الأولى (Federici 1995: 67) وقت كان المثقفون الألمان عالقين سلفاً في جدال بشأن ما إذا كانوا جزءاً من الغرب أم لا. وخلال القرن العشرين ثبت أن مفهوم «الحضارة الغربية» مصمم على نحو مناسب جداً للزمن الذي شهد تحلل الإمبراطوريات الاستعمارية، وهذا لأنه نجح في كبتَلَة المتروبولات الاستعمارية السابقة مع أغنى وأقوى مستعمراتها الاستيطانية السابقة، هذا بينما يلح المفهوم على تفوق أخلاقي وفكري مشترك لهما، وعلى التخلي عن فكرة أن عليهما بالضرورة مسؤولية «تحضير» أي كان. يبدو التوتر الغريب والظاهر في عبارات مثل «العلم الغربي، الحريات الغربية، السلع الاستهلاكية الغربية» ناشئاً مباشرة من التباسات اللحظة التاريخية الراهنة. فهل تعكس هذه العبارات حقائق كونية يتعين على جميع البشر معرفتها؟ أم تُراها نتاجات تراث واحد من تُراثات عديدة؟ الصياغات الناتجة مفعمة فيما أرى بالتناقضات حتى ليصعب فهم كيف ظهرت إلا لسد حاجة تاريخية محددة جداً.
فإذا تفحصت هذه العبارات عن كثب، فسيظهر لك بوضوح أن هذه الأشياء «الغربية» نتاج تشابكات لا نهاية لها. «العلم الغربي» تلفيقة من اكتشافات جرت في قارات عديدة، وهو اليوم نتاج لا غربيين بقدر كبير. «سلع الاستهلاك الغربية» استُخلصت من مواد أُخذت من كل أنحاء العالم، وكثير منها تحاكي نتاجات آسيوية، وكلها اليوم تُنتَج في الصين. فهل يمكن قول الشيء نفسه عن «الحريات الغربية»؟
الأرجح أن القارئ يُخمّن جوابي.
القسم 4: تعافٍ
يتمثل واحدٌ من مواضيع الجدال الرئيسة في النقاشات عن أصول الرأسمالية في ما إذا كانت الرأسمالية، أو الرأسمالية الصناعية، قد ظهرت بداية في المجتمعات الأوروبية، أو أنها تُفهم فقط في سياق نظام عالمي أوسع، يربط أوروبا بممتلكاتها ما وراء البحار وما فيها من أسواق ومصادر عمل. أرى أنه يمكن إثارة نقاش في هذا الشأن لأن كثيراً من أشكال الرأسمالية بدأت باكراً جداً، وقد يمكن القول بخصوص بعضها أنها كانت موجودة، في أشكال جنينية على الأقل، منذ الفجر الباكر للتوسع الأوروبي. هذا مما لا يمكن قوله بخصوص الديمقراطية. فحتى لو شاء المرء أن يتبع العرف الجاري اليوم ويعرف أشكال الحكومة الجمهورية بتلك الكلمة، فقد ظهرت الديمقراطية فقط داخل مراكز امبراطورية مثل إنكلترا وفرنسا، وفي مستعمرات مثل الولايات المتحدة، وذلك بعد ظهور نظام شمال الأطلسي بثلاثة قرون تقريباً.
قدَّمَ كل من جيوفاني أريغي وافتخار أحمد ومن-ون سنيه (1997) ما أراه أهم الردود على هنتنغتون: تحليل نُظُمي-عالمي للتوسع الأوروبي، بخاصة في آسيا خلال بضع القرون السابقة. ويتمثل أحد العناصر المثيرة في تحليلهم في بيان أنه وقت شرعت القوى الأوروبية تفكر في نفسها كـ«ديمقراطية»، أي في ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر، أخذت تلك القوى نفسها تتبع سياسة دولية داعمة للنخب الرجعية ضد أولئك الساعين وراء أي شيء يشبه، ولو من بعيد، الإصلاحات الديمقراطية في المتروبولات. كانت بريطانيا بالتحديد وقحة جداً في هذا الشأن، سواءً في دعمها للإمبراطورية العثمانية ضد تمرد الحاكم المصري محمد علي بعد معاهدة بالطا ليماني عام 1838، أو في دعمها لقوات كينغ الإمبريالية ضد تمرد التايبينغ بعد معاهدة نانجينغ عام 1842. في الحالين وَجدت بريطانيا ذريعة للهجوم العسكري على إحدى قوى النظام القديم الآسيوية الكبرى، وإلحاق الهزيمة بها وفرض معاهدة تجارية مجحفة عليها، ومن ثم تتحول إلى منع هذا النظام نفسه من السقوط على يد متمردين سياسيين أقرب بوضوح إلى ما يفترض أنها القيم «الغربية» من النظام المَحمي نفسه: في الحالة الأولى تمردٌ يهدف إلى تحويل مصر إلى شيء أشبه بدولة-أمة حديثة، وفي الثانية حركة مسيحية مساواتية تدعو إلى الأخوة الجامعة. وبعد التمرد الكبير في الهند عام 1857، أخذت بريطانيا باستخدام الاستراتيجية نفسها في مستعمراتها الخاصة، فمنعت بوعي سقوط «ملاك الأراضي الأثرياء والحكام الصغار لـ’الدول الأصلية‘ في إمبراطوريتها الهندية» (1997: 34). وقد جرى تدعيم كل ذلك على المستوى الفكري في الوقت نفسه بتطوير النظريات الاستشراقية التي ترى أن تلك النظم التسلطية محتومة في آسيا، وأن حركات الدمقرطة ليست طبيعية هناك، بل هي غير موجودة.
يقول المؤلفون الثلاثة: «والخلاصة أن ادعاء هنتنغتون أن الحضارة الغربية هي حامل ميراث الليبرالية، الدستورية، حقوق الإنسان، المساواة، الحرية، حكم القانون، الديمقراطية، الأسواق الحرة ومثل عليا جذابة أخرى، مُثُلٌ يقال لنا إنها تخللت الحضارات الأخرى سطحياً فحسب، هذا الادعاء باطل في نظر كل من ألِفوا السجل الغربي في آسيا في عصر ما يسمى الدولة- الأمة. من الصعب أن تجد مثالاً واحداً من قائمة المثل هذه لم يَجر إنكاره جزئياً أو كلياً من قبل القوى الغربية القائدة للعصر في تعاملاتها مع شعوب أخضعتها لحكمها الاستعماري المباشر، أو مع حكومات أرادت أن تفرض عليها ضرباً من الولاية [فلا تتصرف تلك الحكومات بصورة مستقلة في المجال الدولي]. بالمقابل، يتعذر أن تجد مثالاً واحداً من تلك المُثل لم تتمسك به حركات التحرر الوطني في صراعها مع القوى الغربية. على أن الشعوب والحكومات غير الغربية التي تمسكت بتلك المثل عملت على مراكبتها مع مثل مشتقة من حضاراتها هي في المجالات التي ليس فيها ما تتعلمه من الغرب» (أريغي، أحمد وسنيه 1997: 25).
والحال أني أعتقد أنه يمكن المضي أبعد من ذلك بكثير. حتى في وقت مبكر وإلى اليوم، يبدو أن معارضة التوسع الأوروبي في معظم العالم تحققت باسم «القيم الغربية» التي لم يكن الأوروبيون المعنيّون يملكون منها شيئاً. يلفت إنغسنغ هو انتباهنا مثلاً إلى أول صياغة معروفة لفكرة الجهاد ضد الأوروبيين في المحيط الهندي: كتاب اسمه هدية إلى المجاهدين فيما يخص البرتغاليين من شؤون، كُتب عام 1574 من قبل قاض عربي اسمه زين الدين الماليباري، موجهٌ إلى السلطان المسلم لدولة دِكا في بيجابور. يوضح المؤلف في الكتاب أن من الشرعي شن حرب ضد البرتغاليين لأنهم يدمرون مجتمعاً تعددياً متسامحاً، تَدبَّرَ فيه المسلمون والهندوس والمسيحيون واليهود العيش معاً (2004: 222-24).
في المسكونة التجارية المسلمة في المحيط الهندي، كانت بعض قيم هنتنغتون، وبينها فكرة معينة عن الحرية، فكرة معينة عن المساواة، أفكار مفصلة جداً عن حرية التجارة وحكم القانون، كانت تعتبر مهمة منذ زمن طويل. ويحتمل لقيم أخرى مثل التسامح الديني أنها صارت قيماً بفعل دخول الأوروبيين على المسرح، وإن من باب التضاد معهم. غرضي الفعلي هو أنه لا يمكن للمرء أن ينسب أياً من تلك القيم لتراث أخلاقي أو فكري أو ثقافي محدد. إنها تبزغ بالضبط من هذا الضرب من تفاعل التراثات.
ثم أني أريدُ أن أقترح قضية أخرى. نحن نتعامل هنا مع عمل قاضٍ مسلم، يكتب كتاباً موجّهاً إلى ملك في جنوب الهند. قيم التسامح والقبول المتبادل التي يرجو الدفاع عنها (هذه في الواقع كلماتنا نحن، أما هو فيتكلم على «اللطف»)، يحتمل أنها نشأت ضمن فضاء بين-ثقافي معقد، خارج سلطة أي دولة شاملة، وأنها تتبلور كقيم ضد أولئك الذين يرجون تدمير هذا الفضاء. ومن أجل أن يدافع عن هذه القيم، ويعطي الشرعية لدفاعه، كان على الماليباري أن يتعامل مع دول وأن يؤطر دفاعه بلغة تراث أدبي فلسفي واحد: تراث الإسلام السني في هذه الحالة. كان ثمّة فعلُ إعادة إدماج، فعل محتوم ما إن يجري الدخول في عالم سلطة الدولة والمرجعية النصّية. وحين يكتب مؤلفون لاحقون عن هذه الأفكار، ينزعون إلى تصوير الأمر كما لو أن المثل توّلدت عن تراثهم، لا ضمن فضاءات بينية.
وكذا يفعل المؤرخون. ولعله يكاد يكون محتوماً عليهم أن يفعلوا ذلك، بالنظر إلى طبيعة مصادر مادتهم. فهم أساساً دارسو تُراثات نصّية، والمعلومات عن فضاءات بينية هي مما يصعب في الغالب أن يصادفه المرء. وإلى ذلك يكتب المؤرخون ضمن التراث الأدبي ذاته لمصادرهم، هذا أقله حين نتعاطى مع «التراث الغربي». وهذا ما يجعل من الصعب جداً إعادة بناء المصادر الحقيقية للمُثل الديمقراطية، خاصة وأن الحماس الشعبي لأفكار الحرية والسيادة الشعبية يجبر السياسيين على تبني هذه اللغة. تذكَّر هنا ما قلته قبل عن «زلاقة العين الغربية». لقد مال التراث [الغربي] لوقت طويل إلى وصف المجتمعات الغريبة كأنها ألغاز لا يفك مَغاليقها غير مراقبين عقلانيين. وبفعل ذلك، كان وصف المجتمعات الغريبة في ذلك الوقت يُستخدم لتسجيل نقاط سياسية، سواءً مقابلة المجتمعات الأوروبية مع الحرية النسبية لسكان أميركا الأصليين، أو مع النظام النسبي في الصين. لكن المجتمعات الغربية لا تميل إلى الاعتراف بدرجة تشابكها هي نفسها مع تلك المجتمعات الأخرى، أو درجة تأثر مؤسساتهم بها. ومثلما يَعرف أي دارس للأنثروبولوجيا الباكرة، فإنه حتى المؤلفين الذي كانوا جزئياً من السكان الأصليين لأميركا أو جزئياً من الصينيين، أو مَن لم يحطوا الرحال في أوروبا يوماً، يميلون إلى الكتابة بهذه الطريقة في الواقع. فبوصفهم رجالَ ونساءَ فِعل، فإنهم يشقون سُبُلَهم بين العوالم بالمفاوضة بينها. لكن حين يأتي وقت الكتابة عن تجاربهم، فإنها تصبح تجريدات بلا ملامح. وحين يأتي وقت كتابة تواريخ مؤسسية، فإن إحالاتهم تعود دون استثناء تقريباً إلى العالم الكلاسيكي.
«سجال التأثير»
في عام 1977 قُيّضَ لمؤرخ الكونفدرالية الإيروكوا (ينحدر هو نفسه من الأميركيين الأصليين، كما أنه عضو في الحركة الأميركية الهندية) أن يَكتبَ مقالة توحي بأن عناصر معينة من الدستور الأميركي، منها بخاصة ما يتصل ببنيته الفدرالية، تلقت الإلهام جزئياً من رابطة الأمم الستة (ي). وأسهب في بيان حجته في ثمانينيات القرن، مع دخول مؤرخ آخر، ديفيد جوهانسن، يقترح أن ما نسميه اليوم الروح الديمقراطية الأميركية تلقت الإلهام من مثال الأميركيين الأصليين.
كان بعض ما حشَداه من دلائل مقنعاً جداً. ففكرة تشكيل نوع من فدرالية مستعمرات كانت قد اقتُرحت بالفعل من قبل سفير من أونوداغا اسمه كاناساتيغو، وكان الرجل قد نال منه الإنهاك باضطراره للتفاوض مع مستعمرات منفصلة أثناء المفاوضات من أجل معاهدة لانكاستر عام 1744. والصورة التي استخدمها لتِبيان قوة الاتحاد، وهي حزمة من ستة أسهم، لا تزال تظهر على الختم الاتحادي للولايات المتحدة (لكن الأسهم زيدت لاحقاً إلى ثلاثة عشر). بنجامين فرانكلين، وكان حاضراً وقت حادثة الأسهم، أخذ الفكرة وروّج لها عبر دار نشر كان يملكها خلال العقد اللاحق، وقد أثمرت جهوده عام 1754 عبر مؤتمر ألباني في نيويورك الذي حضره ممثلو الأمم الستة، حيث وُضعت ما ستسمى خطة ألباني للاتحاد. رُفضت الخطة في النهاية من قبل السلطات البريطانية وبرلمانات المستعمرات، بيد أنها كانت خطوة أولى مهمة جداً.

ولعل ما هو أهم من ذلك هو أن أنصار ما سيسمى لاحقاً «نظرية التأثير» رأوا أن قيم المساواتية والحريات الشخصية التي ميزت العديد من مجتمعات وودلاندز الشرقية ألهمت المساواة والحرية التي روّج لهما المستعمرون المتمردون [على السلطة البريطانية]. حين أطلق وطنيو بوسطن ثورتهم مُرتَدين زي الموهوك بينما هم يَرمون الشاي البريطاني في البحر، كانوا يقدمون بياناً واعياً بخصوص مثال الحرية الفردية الذي يتبنونه.
كانت فكرة أن لِمؤسسات اتحاد الإيروكوا بعض التأثير على دستور الولايات المتحدة تُعتبر غير جديرة بالاهتمام كلياً حين اقتُرحت على نحو عارض في القرن التاسع عشر. وحين اقتُرحت مرة أخرى في ثمانينيات القرن العشرين أطلقت دوامة سياسية. فبينما أيد الأميركيون الأصليون الفكرة بقوة، وأصدر الكونغرس مشروع قانون يعترف بها، فقد انقضَّ عليها المعلقون اليمينيون على تنوع أصنافهم، واعتبروها أسوأ ضرب من ضروب الصوابية السياسية. على أن الفكرة قوبلت بمعارضة مباشرة ضارية من قبل كل من المؤرخين المحترفين الذين يُعتبرون حججاً في الشأن الدستوري، كما من قبل الأنثروبولوجيين المختصين بالإيروكوا.
وآلَ النقاش بالكامل تقريباً إلى التساؤل عمّا إذا كان يمكن إثبات علاقة مباشرة بين مؤسسات الإيروكوا وتفكير واضعي الدستور الأميركي. لقد لاحظ باين (1999) على سبيل المثال أن بعض مستعمري نيوإنغلاند كان يناقشون مخططات فدرالية قبل أن يعرفوا بوجود رابطة الأمم الستة. وعموماً جادل المجادلون بأن ما قام به أنصار «نظرية التأثير» هو في الجوهر عملية تزوير عبر انتقاء أي مقطع وارد في كتابات السياسيين الاستعماريين يُثني على مؤسسات الإيروكوا، هذا بينما يغفلون مئات النصوص التي يندد فيها أولئك السياسيون أنفسهم بالإيروكوا وبالهنود عموماً بوصفهم همجاً قتلة جهلة. قالوا إن خصومهم يتركون لدى القارئ الانطباع بوجود برهان نصي واضح على تأثير من الإيروكوا على الدستور الأميركي، وهذا غير صحيح بكل بساطة. بل يبدو أنه حتى الهنود الذين حضروا الاجتماعات من أجل الدستور كانوا هناك للتعبير عن تظلماتهم، وليس من أجل تقديم النصح. وحيث ناقش سياسيو المستعمرات [البريطانية التي صارت الولايات المتحدة] أصول أفكارهم، فقد كان يعودون دوماً إلى أمثلة كلاسيكية وإنجيلية وأوروبية: سفر القضاة، رابطة الآخيين، الكونفدرالية السويسرية، المقاطعات المتحدة في هولندا. وبدورهم أجاب مناصرو نظرية التأثير بأن هذا الضرب الخطي من التفكير تبسيطي، فلا أحد يزعم أن رابطة الأمم الستة كانت المثال الوحيد أو حتى الأول للفدرالية الأميركية، بل هي عنصر بين عدة عناصر تمازجت في الدستور، وبالنظر إلى أن رابطة الأمم الستة كانت المثال الوحيد على نظام فدرالي عامل يعرفه المستعمرون مباشرة، فإن الإصرار على نفي أي تأثير هو أمر عجيب ببساطة. وبالفعل تبدو بعض الاعتراضات التي أثارها أنثروبولوجيون غريبة جداً، ومنها مثلاً اعتراض إليزابيث توكر (1998)، ومفاده أن رابطة الأمم الستة كانت تعتمد قاعدة التوافق وتحتفظ بموقع مهم للنساء، فيما اعتمد الدستور الأميركي قاعدة الأكثرية وأعطى حق التصويت للرجال فقط، فلا يمكن بالتالي أن يلهم أي منهما الآخر. أو خذ ملاحظة دين سنو (1994: 54) أن هذه الادعاءات «تشوش وتحط من شأن السمات المرهفة والمرموقة لحكومة الإيروكوا». حيال مثل هذه الاعتراضات يستنتج المرء أنه ربما كانت فاين دلوريا، الناشطة الأميركية الأصلية، محقة حين اقترحت أن معظم هذا الجدال هو جهد من قبل باحثين لحماية ما يعتبرونه مجالهم الخاص، أي ضرب من حماية حقوق الملكية الفكرية (جوهانس 1998: 82).
رد الفعل التملّكي هذا أوضح في بعض الدوائر. «هذه الأسطورة ليست سخيفة فقط، وإنما هي مدمرة أيضاً»، بحسب أحد المشاركين في مجلة نيورببليك، «فمن الواضح أن الحضارة الغربية التي بدأت باليونان قد وفّرت نماذجَ للحكم أقرب بكثير إلى قلوب الآباء المؤسسين من هذا النموذج. لم يكن ثمّة ما يُجنى من النظر في العالم الجديد بحثاً عن إلهام» (نيومان 1998: 18). قد يكون هذا صحيحاً إن كان المرء يتكلم على التصورات المباشرة للعديد من «الآباء المؤسسين» للولايات المتحدة، لكن إن كنا نحاول أن نفهم تأثير الإيروكوا على الديمقراطية الأميركية، فالأمر مختلف تماماً. فكما رأينا، تماهى واضعو الدستور بالفعل مع التراث الكلاسيكي، لكنهم كانوا معادين للديمقراطية بسبب هذا التماهي بالذات. لقد كانوا يُعرّفون الديمقراطية بحرية غير مقيدة وبالمساواة، وبقدر ما كانوا على معرفة بالعادات الهندية فقد كان مرجّحاً أن يعترضوا عليها لهذه الأسباب بالذات [أي بالضبط بسبب ما يُميزها من حريات غير مقيدة ومن مساواة].
فإذا أعدنا تفحُّصَ المقاطع موضوع الجدال، فهذا هو بالضبط ما نجده. نذكر أن جون آدامز قد جادل في كتابه دفاع عن الدستور بأن المجتمعات المساواتية غير موجودة، وأن السلطة السياسية في المجتمعات البشرية كلها مقسمة بين المبادئ الملكية والأرستقراطية والديمقراطية. وقد رأى أن الهنود يشبهون قدامى الجرمان من حيث إن «الفرع الديمقراطي تحديداً قوي التصميم، وأن مقر السيادة الفعلية هو الشعب»، وهذا الترتيب يعمل جيداً حين نكون حيال سكان مبعثرين فوق أرض واسعة دون تركز حقيقي للثروة، لكن الترتيب نفسه يُفضي إلى الاضطراب والنزاع وعدم الاستقرار حين يكون السكان مستقرين ويديرون موارد مهمة، وهي الحال التي وجدها القوط حين فتحوا الإمبراطورية الرومانية. (Adams: 296; see Levy 1999: 598; Payne 1999: 618)
ملاحظات آدامز نمطية من أمثاله. لقد مال ماديسون وحتى جيفرسون إلى وصف الهنود مثلما فعل جون لوك، باعتبارهم نماذج للحرية الفردية غير المقيدة بأي شكل من الدولة أو الإكراه المنظم، وما جعل هذا الوضع ممكناً هو أن المجتمعات الهندية لم تتسم بتقسيم مهم للمُلكية. وقد اعتبر رجال النخبة هؤلاء أن مؤسسات السكان الأصليين غير ملائمة لمجتمعٍ كمجتمعهم هم.
ومع ذلك فإن الأمم لا تقوم على الأفعال الحكيمة للمشرّعين، خلافاً لنظرية التنوير. ولا هي الديمقراطية اختراع من اختراعات النصوص، وهذا رغم أننا مضطرون إلى الاعتماد على النصوص لتخمين تاريخها. والواقع أن الرجال الذين كتبوا الدستور لم يكونوا مجرد مُلّاك أرض أثرياء، لقد كان لبعضهم خبرة كبيرة في مصاحبة زمرة من أمثالهم من المَلّاكين الأثرياء، وهذا على الأقل إلى أن أخذوا يشاركون في المؤتمرات الاستعمارية. بالمقابل، تجنح الممارسات الديمقراطية إلى أن تجري في مواقع خارج مَطال هؤلاء الرجال، فإذا ما شرع المرء بالبحث عن معاصريهم ممن لهم خبرة عملية في هذه الشؤون، فالنتائج مفاجئة أحياناً. في موقع ما من مقالته أين ومتى اختُرعت الديمقراطية، وعلى نحو عابر تماماً، يلحظ جون ماركوف، أحد كبار المؤرخين المعاصرين للديمقراطية الأوروبية، أنه «يرجَّح لفكرة أن القيادة تُشتق من رضا المَقودين، وليست منحة من سلطة أعلى، أن تتصل بتجربة طواقم سفن القراصنة في بواكير العالم الأطلسي. لم يكن طواقم القراصنة ينتخبون قباطنتهم فقط، وإنما كانوا على دراية بالسلطة المضادة الموازنة (في صورة مسؤولي التموين ومجلس السفينة)، وبالعلاقات التعاقدية الفردية والجمعية (في صورة بنود مكتوبة تحدد الحصص من الغنائم ومعدلات التعويض في حالة الإصابة على ظهر السفينة» (Markoff 1999: 673n62).
ويبدو في الواقع أن المنظمة النمطية لسُفن قراصنة القرن الثامن عشر، على نحو ما فصلها مؤرخون مثل ماركوس ريديكر (2004: 60—82)، كانت ديمقراطية بصورة مرموقة. إذ لم يكن القباطنة منتخبين فقط، وإنما كانوا يقومون بأعمالهم مثل قادة الحرب عند الأميركيين الأصليين: لهم سلطة مطلقة أثناء المطاردات والمعارك، وما عدا ذلك يعامَلون مثل أفراد الطاقم العاديين. والسفن التي مُنح قباطنتها سلطة عامة أكبر كانت تصر على حق الطاقم على عزلهم في أي وقت، إن بسبب الجبن أو القسوة أو أي سبب آخر. وفي كل الأحوال، كانت السلطة النهائية بيد جمعية عامة كانت تحكم غالباً حتى بشأن أصغر القضايا، ويبدو أن ذلك كان يسير وفق أكثرية الأيدي المرفوعة.
وقد لا يبدو كل ذلك مفاجئاً إن أخذ المرء بالاعتبار أصول القراصنة. فقد كانوا عموماً متمردين: بحارة أُجبروا في الأصل على الخدمة في مرافئ المدن الأطلسية، وقد تمردوا على قباطنتهم المستبدين و«أعلنوا الحرب على العالم كله». وقد صاروا غالباً عصابات قطاع طرق كلاسيكيين، يعيثون انتقاماً من القباطنة الذين يسيئون معاملة طواقمهم، ويطلقون سراح من لا يجدون ضدهم شكاوى، أو حتى يكافئونهم. كان تكوين طواقمهم بالغ التنوع بشرياً. لقد كان «طاقم بلاك سام بيلامي مكوناً في العام 1717 من جمهرة مختلطة من كل البلدان، بمن فيهم بريطانيون، فرنسيون، هولنديون، إسبان، سويديون، أميركيون أصليون، أميركيون أفارقة، ودزينتين من الأفارقة الذين جرى تحريرهم من سفينة عبيد» (Rediker 2004: 53).
وبكلمات أخرى، نحن بصدد تشكيلة من البشر يُرجّح أن يتوفر فيها على الأقل بعض المعرفة المباشرة بمروحة واسعة من مؤسسات الديمقراطية المباشرة، تتراوح بين «التنغات»(ك) السويدية إلى اجتماعات القرى الأفريقية إلى مجالس الأميركيين الأصليين مثل تلك التي تطورت عنها رابطة الأمم الستة ذاتها، وقد وجدوا أنفسهم على حين غرة مضطرين لارتجال صيغة ما للحكم الذاتي في غياب كامل لأي دولة. كان هذا فضاء تجريب بين ثقافيّ كاملاً مُكمّلاً. والواقع، من الأرجح أنه لم تتوفر أرضية مواتية أكثر من هذه لتطور مؤسسات ديمقراطية في أي مكان في العالم الأطلسي في ذلك الوقت.
أتكلم في هذا الشأن لسببين اثنين. أولهما واضح: ليس لدينا دليل على أن الممارسات الديمقراطية مثلما تطورت في سفن القراصنة في بواكير القرن الثامن عشر قد أثرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تطور الدساتير الديمقراطية بعدها بستين أو سبعين عاماً. ولا يبدو أننا نستطيع إيجاد دليل على ذلك. وفي حين انتشرت الكتابات عن القراصنة ومغامراتهم على نطاق واسع، وكانت جذابة شعبياً كحالها اليوم (ويُفترض أنها كانت أكثر دقة على الأرجح في ذلك الوقت من نسخها الهوليودية المعاصرة)، كان هذا الانتشار هو تقريباً آخر تأثير يمكن لجنتلمان فرنسي أو إنجليزي أو مستعمر أن يُقرَّ به. وهذا ليس للقول إن ممارسات القراصنة كان يُرجَّح لها أن تؤثر على المؤسسات الديمقراطية، إذ لكنا عرفنا لو حدث ذلك. كل ما في الأمر أنه يمتنع تصور أن تكون الأمور مختلفة عن سفن القراصنة حين يتعلق الأمر بهؤلاء الذين يُحال إليهم عادة بـ«الهمج الأميركيين».
ويتمثّل السبب الثاني في أن المجتمعات الحدودية في الأميركيّتين كانت أشبه بسفن القراصنة مما قد يُترك لنا أن نتخيل. لعلها لم تكن كثيفة السكان مثل سفن القراصنة، أي في حاجة مباشرة إلى تعاون مستمر، لكنها كانت مثلها فضاءات للارتجال بين الثقافي، خارج نطاق سلطة الدول بقدر كبير. لقد وثّق كولن كالواي (1997; cf. Axtell 1985) كم كانت متشابكة مجتمعات المستوطنين والأصليين، حيث يتبنى المستوطنون محاصيل الأصليين وألبستهم وعقاقيرهم وأعرافهم وأساليبهم في الحرب، يتاجرون معهم ويغلب أن يعيشوا جنباً إلى جنب، أحياناً يتزاوجون، وأكثر من أي شيء آخر كانوا يثيرون أشد المخاوف بين قادة الجماعات الاستعمارية والوحدات العسكرية، مخاوف من أن تابعيهم الحدوديين كانوا يمتصون مواقف الهنود فيما يخص المساواة والحرية الفردية. وفي الوقت نفسه، وبينما كان أمثال كوتون ماذر، المُبشّر البيوريتاني في نيوإنغلاند، يندد بالقراصنة بوصفهم بلاءً على الجنس البشري عقاباً على كفره، كان كذلك يشكو من أن صَحبهُ من المستعمرين أخذوا يقلدون الهنود في أساليب تربية الأطفال (فيتخلون عن العقاب الجسدي مثلاً) وينسَون أكثر وأكثر مبادئ الانضباط السليم و«الشدة»، في سَوْس عائلاتهم، لمصلحة ما يميز الهنود من «تساهل أحمق»، إن في العلاقة بين السادة والخدم، أو الرجال والنساء، أو الصغار والكبار (Calloway 1997: 192).
كان هذا صحيحاً بخاصة في الجماعات المكونة من عبيد وخدم آبقين، ممن «صاروا هنوداً»، خارج سيطرة الحكومات الاستعمارية كلياً (Sakolsky & Koehnline 1993)، أو في جيوب جزيرية يعيش فيها مَن سمّاهم لاينباو وريديكر (1991) «البروليتاريا الأطلسية»، ذلك الخليط المتنافر من عبيد معتقين، بَحّارة، عاهرات سفن، خوارج، مرتدين، متمردين، خليط تطور في مدن مرافئ العالم شمال الأطلسي قبل ظهور العنصرية الحديثة، ويبدو أنه انبثق منه بدايةً قدرٌ كبيرٌ من الدافع الديمقراطي في الثورة الأميركية وغيرها. إلا أن الأمر يبدو صحيحاً كذلك بخصوص المستوطنين العاديين كذلك. والمفارقة أن هذه كانت الحجّة الفعلية لكتاب بروس جاهونس مؤسسون منسيون (1982)، الكتاب الذي أطلق «سجال التأثير»، وهي حجةٌ آل الأمر بها إلى الضياع في كل ذلك الصخب والعنف(ل) حول الدستور. ما تقوله هذه الحجة هو أن الفرنسيين والإنكليز الذي استوطنوا المستعمرات أخذوا يفكرون في أنفسهم كـ«أميركيين»، كنوع جديد من الناس المحبين للحرية، بالضبط حين أخذوا يفكرون في أنفسهم كأشباه للهنود أكثر. ولم يتلق هذا الحس إلهامه الأول من ضرب من رَمنَسة عن بُعد قد يصادفها المرء في نصوص لجيفرسون أو آدم سميث، بل عن تجربة العيش في مجتمعات حدودية كانت في الجوهر «مزائج» على ما وصفها كالواي. لقد وجد المستعمرون الذين قَدِموا إلى أميركا أنفسهم في وضع فريد في الواقع: هربوا من التراتبية والامتثالية في أوروبا، ووجدوا أنفسهم في مواجهة سكان أصليين، مخلصين لمبادئ المساواة والفردانية التي كانوا حتى ذلك الوقت يتخيلونها تخيلاً، هذا قبل أن يمضوا إلى استئصال الأصليين، حتى وهم يتبنون معظم أعرافهم وعاداتهم ومواقفهم.
وقد أضيف إلى ما سبق أن الأمم الخمسة [كذا في الأصل: أفترضُ أن المقصود الأمم الستة] كانت هي الأخرى مزائج في ذلك الوقت. فقد كانت في الأصل جمعاً لمجموعات توافقت على تعاقد فيما بينها لخلق طريقة للتوسط في النزاعات وصنع السلام، وصارت أثناء حقبة التوسع في القرن السابع عشر خليطاً استثنائياً من الناس، بينهم نسبة عالية من أسرى حرب تبنتهم أسر من الإيروكوا بديلاً عن أبنائها الذين ماتوا. لقد شكا المُبشّرون في تلك الأيام من أنه من الصعب دعوة السينيكا بلغتهم لأن أكثرية منهم لم تكن طليقة بتلك اللغة (Quain 1937).
وحتي في القرن الثامن عشر حيث كان كاناساتوغا أحدَ زعماء أوندونداغا، كان المفاوضُ الرئيسُ الآخر مع المستعمرين، سواتاني، فرنسياً، أو على الأقل ولد لأبوين فرنسيين في ما هي اليوم كندا (كان يسمى شيكالليمي). والقصد أن الحدود كانت ممحوّة من كل جوانبها. إننا حيالَ تتابع مُتدرج لفضاءات ارتجال ديمقراطي، من الجماعات البيوريتانية في نيوإنغلاند ومجالسها المدينية إلى الجماعات الحدودية، إلى الإيروكوا أنفسهم.
التقاليد [التراثات] كأفعال إعادة تأسيس لا تنتهي
دعوني أحاول تجميع بعض القِطَع ممّا سبق معاً.
لقد جادلتُ طوال هذه المقالة بأن الممارسة الديمقراطية، سواءً فُهمت كإجراءات صنع قرار مساواتية، أو كحكم قائم على المناقشة العامة، تميل إلى الظهور في أوضاع تتدبر فيها الجماعات من هذا النوع أو ذاك أمورها خارج نطاق سلطة الدولة. غياب سلطة الدولة يعني غياب آلية الإكراه المنظومية لفرض القرارات، ويميل هذا الوضع إلى أن يتمخض عن عملية توافق من نوع ما، أو في حالة تشكيلات عسكرية أساساً مثل المشاة المدرّعة الإغريقية أو سفن القراصنة، عن تصويت بالأكثرية (وهذا بالنظر إلى أن النتائج في مثل هذه الحالات واضحة بسهولة، ما لم تنزلق الأمور إلى تنافس للقوى). يميل الابتكار الديمقراطي وظهور ما قد تسمى القيم الديمقراطية إلى الانبثاق مما أسميه حيزات الارتجال الثقافي، وعادة خارج سلطة الدولة كذلك، حيث تضطر تشكيلات متنوعة من الناس، من تقاليد وخبرات مختلفة، لأن تجد طريقة ما للتعامل فيما بينها. إن جماعات الحدود، في مثل مدغشقر، إيسلندا القروسطية، سفن القراصنة، الجماعات المتاجرة في المحيط الهندي، كونفدراليات الأميركيين الأصليين على تخوم التوسع الأوروبيين، كلها أمثلة على ذلك.
ولا شأن لأي منها بتراثات أدبية فلسفية كبيرة من تلك التي تُرى كركائز عظيمة للحضارة. والواقع أن هذه التراثات، خلا استثناءات قليلة، معادية للإجراءات الديمقراطية صراحة، كما للناس الذين يستخدمونها.
على أنه في لحظة معينة أخذت الأمور بالتغيّر بدءاً من دول القلب في النظام الأطلسي، وبخاصة إنكلترا وفرنسا، وللبلدين أكبر المستعمرات في أميركا الشمالية. كان مما آذن بتغير النظام الأطلسي دمار هائل غير مسبوق سمح بظهور فضاءات ارتجال جديدة لا حصر لها لـ«البروليتاريا الأطلسية» الناشئة. وتحت ضغط الحركات الاجتماعية، أخذت الدول تُدخل إصلاحات، كما أخذ من يعملون على التراثات الأدبية بالشعب وراء سوابق لهذه الإصلاحات. كانت النتيجة خلق نُظم تمثيلية على شاكلة روما الجمهورية، نُظم أعيد تسميتها كـ«ديمقراطيات» تحت الضغط الشعبي، وأعيدت أصولها إلى أثينا.
والحال أني أقترحُ أن عملية التعافي وإعادة التأسيس الديمقراطي هذه موافقة لعملية أوسع واسمةٍ لجميع التقاليد الحضارية، إلا أنها تميزت في ذلك الوقت باحتدادٍ حاسم. فبقدر ما توسعت الدول الأوربية وأخذ النظام الأطلسي يَشمل العالم، بدا أن كل أنواع المؤثرات العالمية تلتحم في العواصم الأوروبية، وأنه أعيد امتصاصها ضمن التراث الذي صار يُعرف في النهاية بالتراث «الغربي». وعلى سبيل المثال، يكاد يستحيل إعادة بناء النِسابة [الجنيالوجيا] الفعلية للعناصر المؤتلفة في الدولة الحديثة، أقله لأن عملية التعافي تميل لأن تزيل العناصر الوافدة الأغرب من التقارير المكتوبة، وإلا فهي تدمجها في ثيمة الاختراع والاكتشاف المعتادة. والمؤرخون الذين ينزعون إلى الاعتماد حصرياً على النصوص يهنئون أنفسهم على معايير تدليل صارمة، فينتهون بذلك إلى ما انتهوا إليه بخصوص نظرية تأثير الإيروكوا [على الدستور الأميركي] من الشعور بأن مسؤوليتهم المهنية توجب التصرف كما لو الأفكار الجديدة تنبثق من التراثات النصية. دعوني هنا أقدم مثالين:
أولهما يتصل بالفيتشية الأفريقية وفكرة العقد الاجتماعي. معلوم أن النظام الأطلسي أخذ يتشكل في غرب أفريقيا حتى قبل أن يبحر كولومبوس إلى أميركا. لقد وصف وليم بيتز في سلسلة مدهشة من المقالات (1985، 1987، 1988) الحياة في الجيوب الساحلية الناشئة حيث تعايش بنادقة وهولنديون وبرتغاليون وكل صنوف التجار والمغامرين الأوروبيين مع التجار والمغامرين الأفارقة، متكلمين عشرات اللغات المختلفة، وكانوا مزيجاً من مسلمين وكاثوليك وبروتستانت وتنويعة من ديانات الأسلاف. وضمن هذه الجيوب كانت التجارة تنضبط قياسياً بمواضيع أخذ الأوربيون يحيلون إليها باسم «الفيتشات»، ويجتهد بيتز لتفصيل نظريات التجار الأوروبيين في القيمة وفي المادة التي انبثقت من فكرة الفيتش هذه. ولعل الأطرَف هو المنظور الأفريقي في هذا الشأن. فبقدر ما يمكن إعادة بناء هذا المنظور، فإنه يبدو مماثلاً بقدر مدهش لنظريات العقد الاجتماعي من الصنف الذي طوره أناس مثل توماس هوبز في أوروبا في تلك الفترة نفسها (MacGaffey 1994; Graeber 2005).
وفي الجوهر، خلقت الفيتش سلسلة من أطراف متناقضة أرادت الدخول في علاقات اقتصادية جارية مع بعضها، علاقات ترافقت في شأن حقوق الملكية وقواعد التبادل، على أن تصيب قوة تلك المواضيع من ينتهكون القواعد بالدمار. وبكلمات أخرى، فإن العلاقات الاجتماعية هنا، تماماً مثلما هي عند هوبس، تقوم عندما تُقرر مجموعة من الناس أن تنشئ سلطة سيدة تهددهم بالعنف إن هم لم يحترموا حقوق الملكية والتزاماتهم التعاقدية. وفي وقت لاحق بلغ الأمر بالنصوص الأفريقية أن أثنت على الفيتش بوصفه يمنع حرب الجميع ضد الجميع. ومن سوء الحظ أنه من المستحيل تماماً أن نجد دليلاً على أن هوبس كان على دراية بأي من ذلك، إلا أنه عاش في مدينة ميناء، ومن الوارد جداً أنه التقى بتجار على إلفة بهذه الأعراف، إلا أن أعماله السياسية تخلو من أي إحالات إلى القارة الأفريقية.
ويخص المثال الثاني الصين والدولة- الأمة الأوروبية. فأثناء الطور الباكر من الزمن الحديث، أخذت النخب الأوروبية بالتدريج تتصور مثالاً لحكومات تحكم شعباً متجانساً، يتكلم اللغة نفسها، وينضبط بنظام موحّد من الإدارة والقانون، وفي النهاية يقع تسيير هذا الحكم بأيدي نخبة جدارة [مريتوكراسي] يقوم تأهيلها أساساً على دراسة كلاسيكيات الأدب باللغة التي تتكلمها الأمة المعنية. الشيء الغريب هو أنه ما من سابقة مشابهة وُجدت في أي مكان في تاريخ أوروبا السابق، رغم أنه مطابق تقريباً للنظام السياسي الذي اعتقد الأوروبيون أنه نافذ في الصين الإمبراطورية،
من ملاحظة لايبنتز الشهيرة التي تقول إن الصينيين هم من ينبغي أن يرسلوا مبشرين إلى أوروبا وليس العكس، إلى عمل مونتسكيو وفولتير، نرى تَعاقُباً من الفلاسفة السياسيين الذي يُطرون المؤسسات الصينية، وإلى جانبه افتتان شعبي بالفن الصيني والحدائق الصينية والأزياء والفلسفة الأخلاقية (Lovejoy 1955)، وهذا بالضبط وقت بلغ الحكم المطلق أشده، ولن يخبو هذا الافتتان إلا في القرن التاسع عشر وقت صارت الصين غرضاً للتوسع الإمبريالي الأوروبي. ظاهرٌ أن ذلك كله لا يبرهن على أن الدولة- الأمة إلهام صيني. لكن بالنظر إلى طبيعة التراث الأدبي الذي نحن بصدده، هذا أكثر ما يسعنا توقعه من برهان لو كان الأمر صحيحاً بالفعل.
فهل تكون الدولة-الأمة الحديثة نموذج إدارة صيني في الواقع، جرى تبنيه للتحكم في الدوافع الديمقراطية المستلهمة من تأثير مجتمعات الأميركيين الأصليين وضغوط البروليتاريا الأطلسية التي آلت إلى تسويغ نفسها بنظرية العقد الاجتماعي المستلهمة من أفريقيا؟ ربما لا. فمن شأن ذلك أن يكون مبالغة دون شك. إلا أني لا أعتقد أنها مصادفة أن مُثل الحكم الديمقراطية ظهرت في فترة كانت الدول الأطلسية فيها في وسط إمبراطوريات واسعة وفي غمار ترافد لا متناهٍ من المعرفة والمؤثرات، ولا أراها طورت النظرية التي انبثقت منها تلك المثل بالاستناد الحصري إلى الحضارة «الغربية»، مع ما هو معلوم من أن الأوروبيين وقت لم يكونوا في مركز إمبراطوريات عالمية لم يطوروا شيئاً كهذا.
وأرى أخيراً أنه من الأهمية بمكان التشديد على أن عملية التعافي ليست مقصورة بحال على أوروبا وحدها. من المدهش في واقع الأمر أن الجميع أخذوا يلعبون اللعبة نفسها بسرعة. ومثلما يوحي مثال الماليباري، فمن المحتمل أن درجةً ما من التعافي بدأت قبل أوروبا. وصحيح بالطبع أن حركات ما وراء البحار شرعت في استخدام كلمة «ديمقراطية» بعد ذلك بكثير، لكن حتى في العالم الأطلسي، دخلت الكلمة الاستخدام العام حول منتصف القرن التاسع عشر. وإنما حول منتصف ذلك القرن نفسه كذلك، وبتواقُت دقيق مع استحضار القوى الأوربية لفكرة الديمقراطية من أجل تراثها الخاص، كانت بريطانيا تقود بوعي سياسة قمع أي شيء يحتمل أن يحوز طاقة للتطور إلى حركة شعبية ديمقراطية وراء البحار. وآل أمر الاستجابة الغالبة في العالم المستعمَر إلى الشروع في لعب اللعبة نفسها. فقد أخذ خصوم الحكم الاستعماري يجوبون تراثاتهم الأدبية الفلسفية بحثاً عن نظائر لأثينا القديمة، وإلى جانب ذلك يتفحصون أشكال صنع القرار الجماعي التقليدية في مناطقهم النائية. ومثلما وثَّقَ ستيف مولنبرغر وفيل باين (1993; Baechler 1985) مثلاً، فإنه إذا عرّفها المرء بصنع القرار عبر المناقشة العامة، فإن الديمقراطية ظاهرة شائعة، ويمكن إيجاد أمثلة عليها حتى في الدول والإمبراطوريات، ولو لأن حكام الدول والإمبراطوريات لا يكادون يبالون بما يجري في هذه المناطق والنطاقات. وعلى سبيل المثال، كان المؤرخون الإغريق الذين كتبوا عن الهند شهوداً على العديد من الكيانات السياسية التي اعتبروها جديرة بصفة الديمقراطية. وبين عامي 1911 و1918 أخذ عدد من المؤرخين الهنود (K.P. Jayaswal, D.R. Bhandarkar, R.C. Majumdar) يتفحّصون مصادر أخرى،
لقد بالغ أولئك المؤرخون الباكرون في قضيتهم. وبعد الاستقلال جاء رد الفعل المحتوم على مبالغاتهم. فقد أخذ المؤرخون يشيرون إلى أن تلك «الجمهوريات القبلية» كانت ديمقراطيات محدودة جداً في أحسن الأحوال، وأن أكثرية ساحقة من السكان، من النساء والعبيد والغرباء، كانت بلا حقوق مطلقاً. كان هذا صحيحاً بخصوص أثينا كذلك بالطبع، وهو ما أشار إليه المؤرخون بإسهاب. لكن يبدو لي أن مسألة الأصالة ثانوية الأهمية في أحسن الأحوال. فهذه التراثات هي تلفيقات عموماً. وبقدرٍ ما، يمكن تعريف التراثات بأنها هي هيَ عملية تلفيقها المستمرة. والقصد أن ما لدينا هو في كل الحالات نخب سياسية أو مشاريع نخب سياسية، تُماهي التراثَ بالديمقراطية بغرض الإعلاء من أشكال حكمها الجمهورية. ثم إن الأمر يتعدى أنَّ الديمقراطية لم تكن اختراعاً «غربياً» خاصاً، إلى أن عملية التعافي وإعادة التأسيس لم تكن غربية كذلك. صحيح أن النخب الهندية شرعت تلعب اللعبة متأخرة ستين عاماً عن نظيراتها في إنكلترا وفرنسا، لكن هذه ليست بالفترة الطويلة من وجهة النظر التاريخية. وبدلاً من اعتبار ما يزعمه الهندي أو المالاغاشي أو التسواني أو المنحدر من المايا من كونه جزءاً من تراث ديمقراطي أصلي محاكاةً فرديةً للغرب، يبدو لي أننا ننظر إلى أوجه مختلفة من العملية الجارية على الكوكب نفسها، أعني تبلور ممارسات ديمقراطية طويلة الأمد في تشكيل النظام العالمي، حيث تتطاير الأفكار في كل الاتجاهات، وحيث يجري تبنٍ تدريجي وعلى مضض من قبل النخب لبعض هذه الأفكار.
يبدو إغواء إرجاع الديمقراطية إلى بعض «الأصول» الخاصة مما لا يقاوم. وينغمس فيه حتى باحثون جديون. دعوني أعودُ إلى هارفرد لتقديم مثال أخير، يبدو لي مثيراً للسخرية: مجموعة من المقالات عنوانها الاختراق: أصول الحضارة (M. Lamberg-Karlovsky 20008) جمعها معاً آثاريو [أركيولوجيو] رموزٍ أميركيون بارزون.
وبالمقابل، فإن الدول التي ظهرت في الشرق الأوسط في الألفية الثالثة قبل الميلاد تمثل اختراقاً نحو نموذج بديل، أكثر تعددية، بدأ بأن صار ينظر إلى الآلهة وكهنتهم في استقلال عن الدولة. ويتألف معظم المجلد الناتج عن هذا العمل من تأملات بما يعنيه هذا الاختراق. يجادل سي سي لامبرغ-كارلوفسكي بأن مفتاح التحول يتمثل في أول ظهور لأفكار الحرية والمساواة في بلاد الرافدين القديمة، وفي المبادئ الملكية التي تميزت بعقد اجتماعي بين الحكام والدول- المدن المفردة ورعاياها، وهو ما يسميه الاختراق، وما يوافق معظم المشاركين في الكتاب على وجوب النظر إليه كـ«علامة على الطريق المؤدي إلى الديمقراطية الغربية» (ص 122). وسرعان ما صار موضوع النقاش هو من يستحق الثناء أو ما هو الجدير بالثناء. يرى ماسون هامون أنها «الأصول الهندوأوروبية لمفهوم المجتمع الديمقراطي»، ويقول إن أفكار الديمقراطية «لم تصل إلى الإغريق من الاتصال بالشرق الأدنى وبلاد الرافدين حيث كانت المساواة والعدالة هدية من الحاكم، بل هي نَبعت من مفهوم التنظيم الاجتماعي الهندوأوروبي حيث لا تدين السيادة للزعيم بل لمجلس من كبار السن وحملة السلاح من الذكور» (ص 59). ومن جانبه، يرى غوردون ويلي أن محفزات الديمقراطية نشأت من السوق الحرة التي يعتقد أنها كانت أكثر تطورا في بلاد الرافدين من الصين، وكانت غائبة بقدر كبير في ممالك المايا حيث كان الحكام يحكمون بالحق الإلهي «ودون دليل على وجود قوة موازنة ضمن الدولة تضع حدودا لسلطتهم» (ص 29).
تبدو هذه النقاشات أحياناً محاكاة كوميدية لذلك الضرب الذي أنتقِده عند المؤرخين، وبخاصة نهج البرهنة الذي يفترض أنه ما لم يكن ثمة دليلٌ مباشر على شيء ما، فيمكن معاملته كما لو أنه غير موجود. ويبدو هذا المَسلك غير ملائم حين نكون بصدد الأزمنة القديمة الباكرة، حيث يتعلق الأمر بمجالات لا يسع علم الآثار واللسانيات فتح ما يتجاوز كوى صغيرة جداً فيها. فعلى سبيل المثال، لا تكفي حقيقة أن «السلت البدائيين والجرمان» تلاقوا في مجالس جماعية، بحد ذاتها، لإثبات أن لهذه المجالس أصولاً هندوأوروبية، هذا إلّا إذا كان في وسع المرء أن يثبت أن مجتمعات بلا دولة وتتكلم لغة ليست هندوأوروبية في ذلك الوقت لا تتكلم هذه اللغة غير الهندوأوروبية. والواقع أن هذا يبدو بُرهاناً دائرياً، ما دام المؤلفون يعنون بـ«البدائيين» من هم «بلا دولة»، أو من هم «مساواتيون نسبياً»، وهذه المجتمعات بالتعريف تقريباً لا يمكن أن تُحكم أوتوقراطياً، أياً تكن اللغة التي يتكلمها الناس. وبالمثل، حين توصف المايا الكلاسيكية بافتقارها إلى «مؤسسات موازنة»، لا يبدو أنه خطرَ ببال أيٍّ من المؤلفين أن يتساءل عن كيف كانت روما القديمة أو إنكلترا القروسطية ستبدو إن كانت كل عُمدتهم في إعادة بناء تاريخها هي مبان مهدمة وبيانات رسمية منقوشة على الحجر (غوردون ويلي يصف حتى الأزتك المتعطشين للدماء بأنهم أقل سلطوية بسبب أسواقهم المتطورة).
الواقع أنه إذا كان حِجاجهم صحيحاً، فإن ما يقوم به هؤلاء المؤلفون هو البحث عن أصول الديمقراطية بالضبط حيث لا يُحتمل أن توجد: في تصريحات الدولة التي تقمع عادة أشكال الحكم الذاتي المحلية والمداولة الجمعية، وفي التراثات الأدبية الفلسفية التي تسوغ للدول فعل ذلك (وهذا يساعد على الأقل في شرح لماذا تظهر المجالس السيدة في بدايات التاريخ المكتوب لتختفي بسرعة بعد ذلك). مصير المايا غنيٌّ بالفائدة هنا. لقد انهارت حضارة المايا الكلاسيكية في وقت ما من أواخر الألفية الأولى. ويتجادل الآثاريون في أسباب ذلك، ولعلهم سيتجادلون دوماً، إلا أن معظم النظريات تفترض أن لانتفاضة شعبية بعضَ الدور في ذلك على الأقل. وحين وصل الإسبان بعد 600 عام، كانت مجتمعات المايا غير مركزية بالكامل، مع تنويعة غير متناهية من الدول- المدن الصغيرة، وبقادة منتخبين لبعضها. الفتح الإسباني استغرق وقتاً أطول هنا مما في البيرو أو المكسيك، وأثبتت جماعات المايا نزعتها المتمردة إلى درجة أنه خلال الخمسمائة عام الأخيرة لم يكن ثمة موقع دون تمرد مسلح من قبل البعض فيه. وأكثر ما يثير السخرية أن الموجة الحالية من حركة العدالة العالمية انطلقت أساساً بفضل الـ(EZLN)، الجيش الزاباتستي للتحرر الوطني، وهو مكون بقدر كبير من متمردين في تشياباس يتكلمون لغة المايا، ينحدر معظمهم من فلاحين عاودوا التوطن في جماعات جديدة في غابة لاكاندون المطرية. قاموا بتمردهم عام 1994 باسم الديمقراطية صراحة، وكانوا يعنون بهذه الكلمة شيئاً أقرب إلى الديمقراطية المباشرة اليونانية من الأشكال الجمهورية للحكم التي استولت على الكلمة. طوَّر الزاباتستيون نظاماً مفصلاً تترابط فيه المجالس المحلية التي تعمل وفق قاعدة التوافق، والتي تكملها تجمعات نسوية وشبابية توزان الرجحان التقليدي للذكور البالغين، تترابط ضمن مجالس يقبل مندوبوها الانعقاد عند اللزوم. وهم يزعمون أنها متجذرة في الطريقة التي حكمت الجماعات المتكلمة للغة المايا نفسها وفقاَ لها طوال ألوف السنين، لكن في صيغة أكثر جذرية. نحن نعلم أن معظم جماعات نجود المايا حكموا أنفسهم، منذ توفرت سجلات عن ذلك، بنظام توافق من نوعٍ ما، أي على الأقل في الخمسمئة سنة الأخيرة. وبينما لا يُحتمَل وجود شيء كهذا في الأرياف أيام عز حضارة المايا الكلاسيكية قبل نحو ألف عام، فإنه يبدو غير مرجح بالأحرى [كذا في الأصل. لعل هناك خطأ في تركيب الجملة، وقد يكون الصحيح القول: وبينما يحتمل وجود…].
الأكيد أن المتمردين الحديثين واضحون كفاية في تقديم تصوراتهم عن المايا الكلاسيكية. ومثلما قال زاباتستيٌ يتكلم لغةَ تشول لصديقٍ لي مؤخراً، بينما هو يشير إلى خرائب بالنيك: «لقد استطعنا التخلص من أولئك الأشخاص. ولا أعتقد أن الحكومة المكسيكية يمكن أن تكون تحدياً أكبر بالمقارنة معهم».
القسم 5: أزمة الدولة
ها نحن أخيراً حيث بدأنا، مع صعود الحركات العولمية المطالِبة بأشكال جديدة من الديمقراطية. إن النقطة الرئيسية في هذه المقالة هي إظهار أنه ما من شيء غير مألوف بخصوص الزاباتستيين. إنهم يتكلمون تنويعات من لغة المايا (تزلتال، توجالوبال، تشوي، تزوتزي، مام) وينحدرون من جماعات سمحت تقليدياً بدرجة من الحكم الذاتي (وهذا ما أهّلهم لأن يكونوا احتياطيات عمل أصَلانية في مزارع نباتية وحيوانية كبيرة واقعة في أماكن أخرى)، وهم شكلوا جماعات جديدة متعددة إثنياً في الأراضي المفتوحة حديثاً في لاكاندون (Collier 1999; Ross 2000; Rus, Hernandez & Mattiace 2003). وبكلمات أخرى، إنهم مثال كلاسيكي لما أسميه الارتجال الديمقراطي حيث يجد مزيج بشري مختلط يحوز كثيرون ضمنه بعض أوليات أساليب إدارة الجماعات الذاتية على الأقل، ويجدون أنفسهم في جماعات جديدة خارج الإشراف المباشر للدولة. ثم أنه ما من شيء جديد جداً في حقيقة أن الزاباتستا على نقطة تقاطع تأثيرات عولمية: يمتصون أفكاراً من كل مكان، ولمثالهم أثرٌ بالغٌ على الحركات الاجتماعية في طول الكوكب وعرضه. وعلى سبيل المثال، تمخض الملتقى الزاباتستي الأول عام 1996 عن تشكيل شبكة دولية (الفعل الشعبي العالمي، أو PGA) تقوم على مبادئ الاستقلالية والأفقية والديمقراطية المباشرة، وهي تضم مجموعات متباينة، مثل حركة العمال الزراعيين الذي لا يملكون أرضاً من البرازيل، جمعية مزارعي ولاية كارانتاكا، وهي مجموعة فعل مباشر اشتراكية غاندية من الهند، اتحاد عمال البريد الكنديين، وعدد كبير من التجمعات الأناركية في أوروبا والأميركيتين، علاوة على منظمات سكان أصليين من كل قارة. لقد كانت شبكة الفعل الشعبي العالمي مثلاً هي من أطلقت نداء الاعتراض على اجتماع منظمة التجارية العالمية في سياتل في تشرين الثاني (نوفمبر) 1999. أكثر من ذلك، كان لمبادئ الزاباتستية ورفض النزعة الطليعية والتأكيد على إنشاء بدائل قابلة للحياة ضمن الجماعات كنهج للتغلب على منطق الرأسمال العولمي، كان لها تأثير ضخم على المنخرطين في الحركات الاجتماعية، بمن فيهم من ليس لديهم في بعض الحالات غير معرفة غامضة بالزاباتستيين أنفسهم، ولم يسمعوا قط بشبكة الفعل الشعبي العالمي. لا ريب في أنَّ نمو الإنترنت والتواصل العولمي قد سمح بأن تمضي هذه العملية أسرع من ذي قبل، سمح كذلك بتحالفات رسمية صريحة، غير أن هذا لا يعني أننا حيال ظاهرة غير مسبوقة كلياً.
ويمكن للمرء قياس أهمية هذه النقطة عبر النظر فيما حدث حين لا تكون في البال على الدوام. دعوني أعودُ هنا إلى مؤلف يقارب موقفه موقفي في واقع الأمر. في كتاب بعنوان الكوزموبوليتية [العالمية، أو العالم كوحدة سياسية] صدر عام 2002 يقدم مُنظِّرُ الأدب وولتر منغولو خلاصة جميلة عن كيف أن كوزموبوليتية كانط أو خطاب الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان قد تطورت في سياق من الفتح والإمبريالية، وهو يستحضر دعوات الزباتستيين للديمقراطية ليعارض دعوى لسالفوي جيجك تفيد بأن على اليساريين أن يخففوا من نقدهم للمركزية الأوروبية من أجل اعتناق الديمقراطية، بوصف الديمقراطية «ميراث أوروبا الحقيقي من أيام الإغريق القدماء إلى اليوم» (1998: 1009).

كتب منغولو: «يستخدم الزاباتستيون كلمة الديمقراطية، رغم أن لها معنى مختلفاً في استخدامهم عمّا عند الحكومة المكسيكية. لا تجري مَفهَمة الديمقراطية عند الزاباتستيين بلغة الفلسفة السياسية الأوروبية، بل بلغة تنظيم المايا الاجتماعي، اللغة المبنية على التبادلية والقيم الجمعية (وليس الفردية)، قيمة الحكمة وليس الأبستمولوجيا، وما إلى ذلك… لا خيار أمام الزاباتستيين غير استخدام كلمة فرضتها الهيمنة السياسية، واستخدام الكلمة لا يعني بعد ذلك الرضوخَ لتأويل أُحادي المنطق لها. ما إن يجري فرز الديمقراطية هكذا من قبل الزاباتستيين فإنها تصير قوة مُوصلة، تتصالح فيها المفاهيم الليبرالية للديمقراطية ومفاهيم السكان الأصليين للتبادلية والتنظيم الاجتماعي المحلي من أجل الخير العام» (Mignolo 2002: 180).
هذه فكرة لطيفة، ومنغولو يُسميها «التفكير الحدودي». وهو يقترحها كنموذج لكيفية الإتيان بكوزموبوليتية نقدية، معافاة، ضد تنويعاتها المركزية الأوروبية ممثلة بكانط وجيجك. لكن يبدو لي أن منغولو انتهى إلى نسخة أكثر تواضعاً من الخطاب الجوهراني ذاته الذي يحاول النجاة منه.
فقوله إن «لا خيار أمام الزاباتستيين غير استخدام كلمة الديمقراطية» غير صحيح ببساطة. بالطبع لديهم الخيار. وقد قامت مجموعات قاعدتها من السكان الأصليين بخيارات مغايرة تماماً. فكمثال واحد، فضلت حركة إيمارا من بوليفيا رفض كلمة «ديمقراطية» بالكامل، وسوغت ذلك بأن الكلمة في التجربة التاريخية لشعبها استُخدمت فقط لوصف نظم فُرضت عليهم بالعنف.
والواقع أن عبارة «الكلمة التي فرضتها الهيمنة السياسية» هي في هذه الحالة ذاتها تسوية غير متوازنة. ولو لم تكن كذلك، لما حصلنا على كلمة إغريقية صيغت بداية لوصف شكل من الحكم الذاتي المحلي، ثم طبقت على الجمهوريات التمثيلية. هذا هو بالضبط التناقض الذي يضع الزاباتستيون أيديهم عليه، ويبدو مستحيلاً التخلص منه في الواقع. يُبدي منظرون ليبراليون أحياناً الرغبة في إزاحة الديمقراطية الأثينية جانباً، إعلانها غير ذات شأن والتخلص منها كلياً (e.g., Sartori 1987: 279)، لكن لأسباب إيديولوجية يتعذّر أن تكون هذه الحركة مقبولة. إذ ما من طريقة لولا أثينا للزعم بأن لـ«التراث الغربي» أي صلة ذاتية بالديمقراطية. ولَكُنا لولاها تُركنا نتعقب أصول مُثُلنا السياسية عَوْداً إلى تأملات أفلاطون التوتاليتارية، أو ربما نقر بعدم وجود شيء اسمه «الغرب» في الحقيقة. والحال أن المنظرين الليبراليين حصروا أنفسهم في الزاوية. وليس الزاباتستيون وحدهم من وضعوا يدهم على هذا التناقض، لكن بفعلهم ذلك وجدوا هذه المرة صدى قوياً، وهذا يعود جزئياً إلى أزمة عميقة في الدولة في هذه الآونة.
الزواج المستحيل
في الجوهر، لا أعتقد أن التناقض لغويٌ فحسب. إنه يعكس شيئاً أعمق. في القرنين الأخيرين كان الديمقراطيون يحاولون تطعيم مُثُل الحكم الذاتي الشعبي على جهاز الدولة القمعي. هذا المشروع غير عملي بكل بساطة في المآل الأخير. فالدولة بطبيعتها لا يمكن أن تتدمقرط حقاً، ذلك أنها أساساً طريقة في تنظيم العنف. كان الفدراليون الأميركيون واقعيين تماماً حين رأوا أن الديمقراطية لا تتوافق مع مجتمع يقوم على اللامساواة في الثروة، لأن حماية الثروة توجب وجود جهاز إكراه لكبح جماح «العامة» الذين يُفترض بالديمقراطية أن تُمكِّنهم. كانت أثينا فريدة في بابها لأنها عملياً كانت في وضع انتقالي: كان ثمة بالفعل أوجه لا مساواة في الثروة، بل وربما طبقة حاكمة، لكن لم يكن ثمة جهاز إكراه رسمي تقريباً. ولذلك ليس هناك إجماع بين الباحثين على أنها كانت دولة أصلاً.
وإنما بالضبط حين يفكر المرء بمشكلات احتكار الدولة الحديثة لقوة الإكراه ينحل مظهر الديمقراطية في خليط عشوائي من التناقضات. صحيح، على سبيل المثال، أن الدولة الحديثة قد نحّت جانباً الخطاب الأقدم عن العامة كـ«بهيمة ضخمة» قاتلة، إلا أن هذا النعت نفسه يطلّ برأسه، وبالشكل نفسه الذي ظهر فيه في القرن السادس عشر، ما إن يقترح أحدٌ ما دمقرطةَ بعض أوجه جهاز الإكراه. فعلي سبيل المثال، يشير مناصرو حركة «هيئة محلفين كاملة الاطلاع» في الولايات المتحدة إلى أن الدستور الأميركي يسمح بالفعل للمحلفين أن يقرروا بشأن مسائل القانون، وليس بشأن الأدلة وحدها، لكن يندد بهم في الإعلام حين يفعلون ذلك ويوصمون بأنهم يودون العودة إلى أيام الإعدامات غير القانونية و«حكم الرعاع». ليس من باب المصادفة أن الولايات المتحدة، البلد الذي لا يزال يغبط نفسه على روحه الديمقراطية، هي كذلك البلد الذي يتصدر العالم في أسطرة جهاز البوليس لديه، بل في تأليهه.
كان فرانسيس دوبوي-ديري (2002) قد نحت عبارة «رهاب الأغورا السياسي» [رهاب الساحة العامة] في وصف الارتياب المستمر في التراث الغربي بالمداولات العامة وصنع القرارات العامة، ارتياب يلحظ في أعمال كونستانت، سييس، ماديسون مثلما يلحظ عند أفلاطون وأرسطو. وأضيف من جهتي أن إنجازات الدولة الليبرالية المثيرة للإعجاب وعناصرها الأكثر ديمقراطية، مثل كفالة حرية الكلام والاجتماع، مشروطة هي ذاتها برهاب الأغوار السياسي هذا. فقط حين يكون واضحاً وضوحاً قطعياً أن الكلام والاجتماع العامين ليسا وسيطين لصنع القرار السياسي، وإنما هما في أحسن الأحوال محاولة لنقد صناع القرار السياسيين أو التأثير عليهم أو تقديم اقتراحات لهم، فقط في هذه الحالات تُعامل هذه الحريات كمُقدّسة. والخطير هو أن رهاب الساحة العامة هذا لا يقتصر على السياسيين والصحفيين المحترفين، وإنما هو يشمل العموم بقدر كبير. وليست أسباب ذلك مستعصية على البحث. ففي حين تفتقر الديمقراطيات الليبرالية إلى ما يشبه الأغورا الأثينية من قريب أو بعيد، فهي بالتأكيد لا تفتقر إلى ما يشبه سيركات روما. ويبدو أن ظاهرة المرآة القبيحة حيث تشجع النخب الحاكمة أشكالاً من المشاركة الشعبية بغرض تذكير الشعب بأنه غير مهيأ للحكم قد بلغت درجة غير مسبوقة من الكمال في العديد من الدول الحديثة. خذ مثلاً النظرة إلى الطبيعة الإنسانية التي يكونها المرء ويعممها استناداً إلى تجربة سوْق السيارة إلى العمل عبر الطرق السريعة بالمقارنة مع النظرة التي قد نُكوِّنها انطلاقاً من تجربة النقل العام. مع ذلك فإن علاقة الحب التي تجمع الأميركيين، أو الألمان، بالسيارة كانت نتاج قرارات واعية من قبل النخب السياسة ومدراء الشركات بدءاً من ثلاثينيات القرن العشرين. ويمكن للمرء أن يكتب تاريخا مماثلاً للتلفزيون، لنزعة الاستهلاك، أو مثلما رصد بولانيي قبل زمن طويل لـ«السوق».
لقد كان الحقوقيون على بينة من أن الطبيعة الإكراهية للدولة تتكفل بأن تقوم الدساتير الديمقراطية على تناقض أساسي. كان فالتر بنيامين قد أجملَ الأمر بأناقة حين لفت إلى أن أي نظام قانوني يزعم احتكار استخدام العنف لا بد أن يقوم على قوة ليست قوته هو، ما يعني حتماً قيامه على أفعال لم تكن قانونية وفقاً لأي نظام قانوني كان قائماً قبلها(م). وعليه فإن شرعية نظام قانوني ما تقوم بالضرورة على أفعال عنف إجرامية. إن الثورتين الفرنسية والأميركية مذنبتان بالخيانة في عين القانون الذي شبّتا ضده. وبالطبع كان الملوك المقدسون من أفريقيا إلى نيبال قد تدبروا أمر حل هذه المعضلة المنطقية بوضع أنفسهم خارج النظام، مثلهم في ذلك مثل الله. لكن مثلما يذكرنا منظرون سياسيون مثل أغامبن ونغري، ليس ثمة طريقة مماثلة ليمارس «الشعب» السيادة بالطريقة نفسها. فالحل اليميني الذي يقرر أن النظم الدستورية تتأسس على يد قادة مُلهمين، تتجسد فيهم الإرادة الشعبية، إن في صورة آباء مؤسسين أو فهارِرة [جمع: فوهرر، قائد بالألمانية]؛ والحل اليساري الذي يقول إن النظم الدستورية تحوز شرعيتها من الثورات الشعبية العنيفة، يقودان معاً إلى تناقضات سياسية لا تنتهي. كان السوسيولوجي مايكل مان قد ألمح (1999) إلى أن معظم مذابح القرن العشرين قد ارتُكبت على يدي إحدى نسختي هذا التناقض. لقد أفضى مطلب إقامة جهاز إكراه موحد في كل قطعة أرض من الكوكب، مع المثابرة في الوقت نفسه على الادعاء بأن شرعية هذا الجهاز مشتقة من «الشعب»، إلى حاجة مستمرة إلى تقرير من بالضبط يفترض أن يكون «الشعب».
على تنوعها خلال الثمانين عاماً الماضية، من جمهورية فايمار إلى النازيين إلى شيوعيي جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، استخدم القضاة الصيغة نفسها في المحاكم الألمانية المتنوعة: In Namen des Volkes، باسم الشعب. ومن جهتها تفضل المحاكم الأميركية صيغة: «قضية الشعب ضد س» (Mann 1999: 19).
وبعبارة أخرى، يتوجب استحضار «الشعب» كسلطة تقف وراء توزيع العنف، وهذا بالرغم من أنه يرجح لأي اقتراح بوجوب دمقرطة هذه الدعاوى أن يثير رعب كل المعنيين به. يقترح مان أن الجهود العملية لتسوية هذا التناقض: استخدامُ جهاز العنف لتعريف وتشكيل «الشعب» بحيث يشعر من يديرون الجهاز بأنه مصدر سلطتهم، هذه الجهود مسؤولةٌ عن مقتل ستين مليون إنسان في القرن العشرين وحده.

وإنما في هذا السياق أَقترحُ أن الحل الأناركي، القاضي بأنه ما من حسم لهذا التناقض، ليس بالأمر غير المعقول. لقد كانت عبارة الدولة الديمقراطية متناقضة على الدوام. وما فعلته العولمة هو أنها كشفت تعفن دعامات الدولة الديمقراطية وخلقت الحاجة إلى بنى صنع قرار على مستوى كوكبي، حيث ستكون أي محاولة للاستمرار في مزاعم السيادة الشعبية [على نطاقات محلية]، دع عنك المشاركة الشعبية، سخيفة بكل جلاء. الحل النيوليبرالي هو بالطبع في إعلان السوق كشكل وحيد للمداولة العامة يحتاجه الناس، مع قَصْر الدولة بصورة شبه حصرية على وظيفتها الإكراهية. وفي هذا السياق يحوز أكملَ المعنى ردُّ الزاباتستيين المتمثل في التخلي عن تصور الثورة كمسألة استيلاء على جهاز الدولة الإكراهي، واقتراحهم بالمقابل إعادة إقامة الديمقراطية في جماعات محلية مستقلة وذاتية التنظيم. وهذا هو السبب، بادئ ذي بدء، وراء إثارة تمرّد غامض في جنوب المكسيك كلَّ هذه الضجة في الدوائر الراديكالية. في الوقت الراهن تعود الديمقراطية إلى الفضاءات التي نشأت فيها: فضاءات الما-بين. أما إذا كان من شأنها أن تبتلع العالم كله، فالأمر لا يعتمد على ما قد نبني من نظريات حول ذلك، بل على ما إذا كنا نؤمن بإخلاص بأن الكائنات البشرية العادية ستكون قادرة في مجالسها التداولية على أن تدير شؤونها الخاصة مثلما تديرها لها النخب التي تدعم قراراتها بقوة السلاح، أو على الأقل أن يكون لها الحق في المحاولة.
في مواجهة هذه الأسئلة، وقف المثقفون المحترفون كلهم تقريباً إلى جانب النخب خلال معظم التاريخ البشري. وانطباعي أنه إذا حقت المحقوقة، فإن أغلبية ساحقة منهم لا تزال تغويها المرايا القبيحة المختلفة، ولا تؤمن إيماناً حقيقياً بإمكانيات ديمقراطية شعبية. لكن ربما يمكن لهذا أيضاً أن يتغير.
هوامش المترجم
(أ) أقترحُ إدخال كلمة يُكَبْتِل من المحكية السورية كفعل رباعي يندمج فيه جذرا كتل وكبل كترجمة لفعل Lump together، وهذا لأن الكلمة ممكنة، سهلة الدخول في نسيج العربية، وتَفي جيداً بالمعنى المراد.
(ب) بيير بورديو عالم اجتماع فرنسي مرموق، ماركسي فيبري، رحل عام 2002. والهابيتوس من مفاهيمه الأساسية، وقد يمكن أداءه بالعربية بكلمة التطبّع، ما نكتسبه من استعدادات من تجاربنا وحياتنا الاجتماعية ويشكل مواقفنا وسلوكنا.
(ج) تراث هي الترجمة المعتمدة هنا لكلمة ترادشن الإنكليزية التي يشيع أن تُترجم كتقليد. وسبب تفضيل كلمة تراث أنه في معظم مواقع ورودها في المقالة تُحيل إلى كتب وأفكار ونصوص، وليس إلى مؤسسات وأعراف وعوائد.
(د) نابليون معروف. ودزرائيلي هو أول رئيس وزراء يهودي لبريطانيا، عام 1868 ثم بين 1874 و1880. له رواية اسمها تانكرد أو الصليبية الجديدة، ويجمع فكره بين اليهودية والإمبريالية البريطانية.
(هـ) تميز ميتافيزيقا أرسطو بين وجودٍ إمكانيٍ أدّاه المترجمون العرب القدامى بعبارة الوجود بالقوة، ووجود بالفعل هو الوجود المُحقَّق.
(و) التاريخ عند هيغل (1770-1831) هو انبساطٌ للفكرة المطلقة التي هي صيغة معلمنة لله، تَحقُّقٌ للممكنات المطوية في هذه الفكرة، وإن عبر عمليات نفي وصراع. ويبدو أن غريبر يرى أن هردر (1744-1803) ليس بعيداً عن هذا التصور للتاريخ.
(ز) الفعل المباشر هو أنشطة عنفية أو غير عنفية لمجموعات يسارية تحررية، صغيرة عموماً، بغرض التأثير المباشر وتحقيق أهداف محددة، سياسية أو اقتصادية أو حقوقية.
(ح) سلسلة من 85 مقالة كتبها في ثمانينيات القرن الثامن عشر ثلاثة من رجال الاستقلال الأميركي، ألكسندر هاملتون وجيمس ماديسون وجون جاي لإقناع ناخبي نيويورك بتبني الدستور. وهي بمثابة دفاع عن نظام الحكم الأميركي وتطبيق لمبادئه السياسية.
(ط) عنوان كتاب للمؤرخ الماركسي البريطاني إريك هوبسباوم، ينظر في الحقبة بين الثورة الفرنسية 1989 وثورات 1848 الأوروبية. عبارة عصر الثورات تستخدم أحياناً لتغطي الفترة بين الثورة الأميركية وثورات 1848، ويطبعها تهاوي الحكم المطلق والانتقال إلى الحكم الدستوري.
(ي) تَجمُّعٌ عسكري وسياسي بين ستة من أمم أميركا الأصلية (الهنود الحمر): كايوغا، كانينكيهاكا أو الموهوك، أونيدا، أونوداغا، سينيكا، وتوسكارورا، جمع بينها ميثاق للسلم.
(ك) مجلس أو تَجمُّع للعموم باللغات الاسكندنافية.
(ل) تضمين من قبل الكاتب لعنوان رواية مشهورة لوليم فوكنر، مستمد هو ذاته من مسرحية ماكبث لشكسبير. الرواية والمسرحية مُترجمتان إلى العربية.
(م) يميز فالتر بنيامين بين العنف المؤسِّس للقانون والعنف الحافظ للقانون. الأول هو عنف الثورة أو التأسيس الجديد. والثاني هو عنف النظام القانوني القائم حمايةً لدوامه. عنف الثورات غير شرعي دوماً من وجهة نظر العنف الحافظ للقانون.