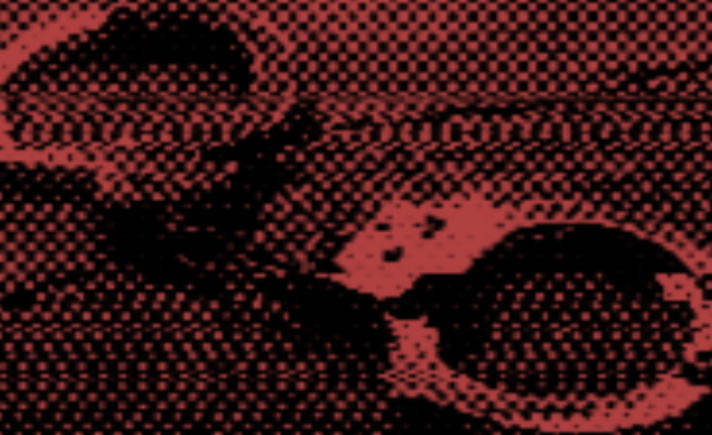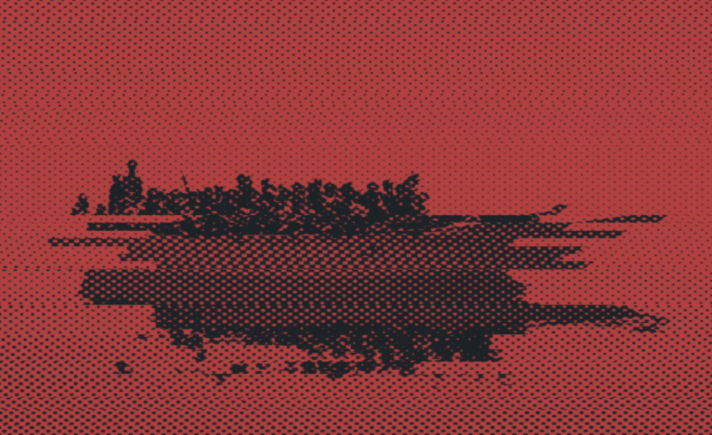الفهرسالفصل الأول: السلطة |
يتناول الفصل الثالث تفاصيل أكثر عن فترة اندلاع الثورة السورية الأولى. جذوة الثورة بدأت من تعطش جارف للتغيير، ألهم اندلاع مظاهرات كبرى على طول الشرق الأوسط المحكوم من دكتاتوريات منذ عقود. ففي كانون الأول 2010، أحرق مواطن تونسي نفسه، فأشعلت الحادثة شرارة المظاهرات في ريف تونس. وما كان من قوات الأمن التونسية إلا أن قمعت المتظاهرين، لكن غضب الشعب تنامى أكثر فأكثر، ما أدى إلى انتشار أوسع للمظاهرات التي انتهت بهرب الرئيس زين العابدين بن علي، المكروه من شعبه، في منتصف كانون الثاني 2011. ثم نزل المصريون إلى الشوارع، وظلوا طيلة ثمانية عشر يوماً يقاومون وحشية قوات الأمن، مما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة حسني مبارك، الرئيس الذي حكم مصر لثلاثة عقود.
وفي الوقت الذي كان هذا «الربيع العربي» ينتشر بين الدول العربية، وصولاً إلى اليمن والبحرين وليبيا، كان العديد من المراقبين يعتقدون أن «مملكة الصمت» ستكون بمعزل عن هذا المدّ. لكن كثيراً من السوريين تأثروا بما شاهدوه من قوة إرادة الشعوب، وبدؤوا يعربون عن معارضتهم السياسية بطرائق مختلفة. من هذه الطرائق تلك المظاهرة العفوية التي خرجت في الحريقة، إحدى الأسواق الدمشقية العريقة، وقيام آخرين بوقفات احتجاجية عند سفارات مصر وليبيا للتعبير عن تضامنهم مع شعوب تلك الدول. إضافة إلى ذلك، ظهرت دعوات عبر الإنترنت تحث الناس على الخروج في مظاهرات تغطي كل المدن السورية يوم 15 آذار، وقد شهدت بعض المناطق مظاهرات صغيرة تمكنت الأجهزة الأمنية من فضّها سريعاً.
وفي مدينة درعا الحدودية مع الأردن، قامت قوات الأمن باعتقال أطفال بعد كتابتهم عبارات ضد النظام على جدران إحدى المدارس، فلجأ أهالي الأطفال إلى رئيس الأمن السياسي ذي السمعة السيئة، لكنه أهانهم بعبارات استفزت جميع سكان المنطقة، مما أدى إلى مظاهرات كبيرة في اليوم التالي قتل فيها الأمن اثنين من المتظاهرين السلميين. بعدها، سار الأمر على نحو تصعيدي: تخرج جنازة، فتتحول إلى مظاهرة كبيرة، يسقط فيها ضحايا جدد، فتخرج جنازاتهم وتتحول هي أيضاً إلى مظاهرات أكبر من التي سبقتها. الجنازات تؤدي للمظاهرات، والمظاهرات تؤدي لجنازات أكثر. كان المتظاهرون يوثّقون كل هذه الأحداث عبر هواتفهم، يصوّرون فيديوهات ثم ينشرونها عبر الإنترنت، فتتناقلها المحطات الفضائية الإخبارية. وهكذا انضمت سوريا إلى «الربيع» والعالم كله كان يشهد.
بعد أسبوع واحد من بدء المظاهرات في درعا، تظاهر عشرات الآلاف في شتى أنحاء البلاد. قام النظام بمبادرات صغيرة لتهدئة الناس، كما استمرّ بفضّ التجمعات بالقوة، مما زاد من حنق الشعب وإصراره. وهنا انطلقت العبارة الشهيرة التي وصفت تماماً حال السوريين في تلك اللحظات التاريخية التي انتفضوا فيها: سقط حاجز الخوف.
أبو ثائر، مهندس (درعا)
كان إجبار زين العابدين بن علي على التنحي في تونس كالحلم. أتذكر أنني عندما تلقّيت الخبر دمعت عيناي فرحاً، مثل الكثير من السوريين. لم يصدّق الناس ما حصل… يا إلهي! مستحيل! هل حدث هذا فعلاً!؟ بدا الأمر كأنه معجزة إلهية. تساءلنا: هل يمكن تكرار الأمر في دولة أخرى؟
لكن الأثر النفسي لثورة تونس لم يكن بحجم أثر الثورة المصرية واتساعه. كان عمر الثورة المصريّة ثمانية عشر يوماً فقط، لكن الكثير من الشباب وصلوا ليلهم بنهارهم مترقّبين الأحداث والأخبار الجارية هناك… مصر… مصر… مصر… أينما ذهبت يتحدّثون عنها طوال اليوم. وحين تنحّى حسني مبارك أخيراً، بدأ الناس يتكلّمون عن الحدث، وكلّما ذكرت مصر يقولون: «الحمد والشكر لله»، أو يلعنون مبارك، ويقولون: «لقي جزاءه أخيراً، ونجح المصريون بالوصول إلى الديمقراطية». لم يتطرّق أحد لبشّار، لكن الناس في قلوبهم كانوا يريدون ويطمحون إلى ثورتهم هم. تحدّثوا عن مصر ظاهرياً، لكن الأمر برمّته كان يحرّكهم داخلياً ويحفّز أفكارهم.
آدم، منسق إعلامي (اللاذقية)
خرج التونسيّون في مظاهرات كبيرة وكان لسان حال السّوريين: «همممم، لطيف!». بعدها خرج المصريّون، فصاروا يهتفون معهم «ارحل!». ثم تنحى الرئيس المصري، ووقتها فكّرنا: «يا للهول، كل السلطة لنا نحن الشعب!». بعدها انضمّت ليبيا إلى الموجة، ما دفع السوريين إلى التفكير ملياً لأن القذافي كان سيطلق الجيش على الشعب. كسوريين، كنّا نعرف ما سيحدث، كاللّيبيين وأكثر. ثم ناشد اللّيبيّون دول العالم للمساعدة، ورحنا نقول: «تماماً، هؤلاء نحن». ووقتها تدخّل المجتمع الدولي وقال: «سنحمي اللّيبيين».
وصلت رسالة إلى السوريين أنّه إن ساءت الأمور إلى أقصى حدّ فسيحدث دعم ما. طبعاً كنّا نعلم أنّنا سنقدّم تضحيات، وأنّنا سنخسر أرواحاً كثيرة، لكن لم يخطر في بالنا قطّ أنّ العالم سيسمح للجيش بقتلنا. كنا نعلم جميعاً أنه حين تطأ قدم القوّات الدوليّة أرض سوريا سيُهزَم الجيش السوري في دقيقة؛ سينقلبون على الأسد، وسيُحَلّ الأمر.
بشر، طالب (دمشق)
شارك أخي في الوقفة الاحتجاجية مقابل السّفارة المصريّة في دمشق تضامناً مع الثورة المصريّة. وحين نظّم الناس وقفة احتجاجيّة خارج السّفارة اللّيبيّة قرّرتُ الانضمام إليهم.
عند وصولي، كانت المسيرة منطلقة. أذكر تلك الفتاة التي كانت تحمل شمعة ذائبة على يدها بينما كانت تهتف ضد القذافي. ملأ رجال الأمن المكان، وأخذوا يصوّرون وجوه الجميع. خفتُ حينها قليلاً، لكنّ سعادتي غلبتْ خوفي. بعدها اتصلت بأخي في السعودية، وأخبرته أنّني شاركت في المسيرة وهتفت: «حرّيّة… حرّيّة…». شعرت بحاجة لإخباره عن ذلك. قلت له: «عليك أن تجرّب الشعور». شعور لا يمكن وصفه، كأنّك تطلق كلّ الطّاقة الكامنة داخلك، وكلّ الأشياء التي كتمتها لسنين. تشعر كأنّك لست على الأرض، وأنّ روحك تطير في مكان ما. قمت بتسجيل المظاهرة عبر جهاز استماع أغاني كان في جيبي. كانت مخاطرة، لكنّني أخفيتُه جيداً. ما زلت أحتفظ بالتسجيلات إلى اليوم، وأسمعها من وقت لآخر. أعيد سماعها مراراً وتكراراً، وفي كلّ مرّة أعيش الشعور ذاته الذي عشته أوّل مرّة حين خبّأت الجهاز في جيبي.
ريما، كاتبة (السويداء)
أهان رجل شرطة بلا سبب شخصاً في سوق الحريقة، وهو أحد الأسواق العريقة في دمشق القديمة. خلال دقائق تجمّع الناس، وتظاهروا ضد النظام، وهتفوا: «الشعب السوري ما بينذلّ». هكذا قال لي أحد الأصدقاء في العمل، وكان متحمّسة جداً. لم أصدّق ما حدث! لأوّل في حياتنا نسمع أو نرى مثل ذلك الأمر. حمّلت الفيديوهات التي وثّقت الحادثة ونُشِرَتْ على اليوتيوب في أقلّ من ساعة. تابعتُهم وبكيتُ من الفرح. الثورة السورية بدأت أخيراً!
وليد، شاعر (ريف دمشق)
بدأنا بالحديث عن وضع سوريا، وأجمعنا أنّ مصر جاهزة للانتفاضة وأننا في سوريا بحاجة إلى ما لا يقلّ عن خمس سنوات من التحرّك والنّشاط السياسي قبل الوصول إلى ما وصلت إليه مصر. اتفقنا أن علينا العمل نحو هذا الهدف.
تعالت دعوات الثورة في 15 آذار، فخرجنا. بتلك البساطة بدأت الثورة. أخذت المظاهرات تتقدّم… هل كان علينا القول: «انتظروا، نحن بحاجة خمس سنوات قبل التظاهر؟». بالطبع لا، أبداً بتاتاً ومستحيل. لقد بدأت الثورة وانتهى الأمر، لذا علينا المضيّ معها.
شفيق، خرّيج جامعي (داريا)
أعمل في مجال الكمبيوتر، وكنت متصلاً بالإنترنت على مدار الساعة. بدا الحدث في مصر وتونس بالغ السهولة، لذا اعتقدنا أن الطريق أمامنا ممهّد، وأن الحرّية والكرامة قادمتان لا محالة.
تأسست أول صفحة فيسبوك باسم «الثورة السورية ضد بشار الأسد»، كانت توثق الأحداث يومياً، حدث كذا وكذا، وفعل فلان كذا وكذا. بعدها حدّدوا تاريخ الثورة: 15 آذار.
انتظرت يوم 15 آذار كمن ينتظر موعداً غرامياً. كنت بحاجة لأن أرى هذا اليوم، فقد بلغ عدد المعجبين بصفحة الفيسبوك نحو عشرين ألفاً. تخيّلت أن يخرج منهم ألف على الأقل.
قابلت شاباً كان من أوائل الناشطين في بلدتي، سأسميه هنا نزار. قال لي إنّه يجب أن يكون لي دور في المظاهرة، ليس الخروج فيها وحسب. قلت له: يمكنني أن أساهم في الإعلام، لذا اشترى لي كاميرا، وقمنا بشراء قميص، وثقبنا جيبه بشكل دائرة، وضعنا الكاميرا في الجيب، وارتديتُ سترةً فوقه. قال لي أن أدير الكاميرا حين الوصول إلى المظاهرة، وأن أخلع السترة حين تُتاح الفرصة للتسجيل.
وصلنا إلى سوق الحميدية في دمشق. هتف أوّل رجل، قيل لاحقاً أنّه عنصر مخابرات يريد توريط الناس وتشجيعهم على الهتاف، وبالتالي كشفهم وتسهيل اعتقالهم. بعدها صرخت تلك الفتاة التي قيل إن والدها من معتقلي عام 1982: «الله.. سوريّة.. حرّيّة وبس!».
لم يشاركها أحد. للأمانة كنت خائفاً، وكان الجميع ينظر وحسب. لكنّ السوريين تأثّروا وشعروا بالخزي أمام تلك الفتاة. قلت لنفسي: «هل يعقل أن تكون هي أشجع مني!». شاركتها وهتفت: «الله.. سوريّة.. حرّيّة وبس». أخذ صوتي يعلو ويعلو بالهتاف، ونسيت أمر الكاميرا.
بعدها بقليل، وصلت سيارات الأمن، فخفت وانسحبت. تراجعت إلى الخلف وراقبت فقط. وصلتْ قوّات الأمن بالعصيّ وبدؤوا بضرب المتظاهرين، ثم ظهر مدنيّون فجأة وشاركوهم أيضاً.
حزنت في تلك اللحظة، كرهت العالم والحياة، وشعرت بالأسى لأولئك الشباب الذين كانوا يهتفون لمصلحة الوطن بأسره وقُوبِلوا بالضرب. شعرت بالأسى على حالنا.. لِمَ ليست لدينا أيّة خطط؟ لِمَ لم نكن منظّمين؟ لمَ ولمَ ولمَ؟ أردت أن أشرب الماء وأمضي، أردتُ أن أبتعد عن المكان قدر المستطاع.
ركبت سيّارة أجرة، وقلت له أن يبتعد. لم أسجّل شيئاً على كاميرتي، وعُدتُ غاضباً إلى المنزل. كيف ضُرِبَ أولئك الشباب؟ وماذا لو كنت مكانَهم وتلقّيتُ ذلك الضرب؟ تخيّلت نفسي مكانَهم والجميع حولي يشاهدون من دون أيّة حركة.
جلست، وفكّرت لساعات «هذه ثورة، وذلك ما يحدث في الثورات. من الممكن أن أُضرب أو أموت. كلّ ذلك في سبيل هدف واحد، فإمّا تحقيقه أو الموت». ضغطت على نفسي أكثر: «ما مشكلتك؟ كلّ ما حدث طبيعي! ماذا كنت تتوقع من نظام فاسد كهذا!؟».
أحمد، ناشط (درعا)
يقول بعضهم إنّ الثورة بدأت بدعوات التظاهر في 15 آذار 2011، لكن المتظاهرين في ذلك اليوم أنهوا مسيرتهم وعادوا إلى منازلهم. أما ما حدث في درعا يوم 18 آذار فمختلف تماماً. كان الضابط المعيّن رئيساً للأمن السياسي في درعا قبل عامين من الأحداث هو عاطف نجيب، ابن خالة بشّار الأسد. فرض الرجل سلطته على كلّ شيء، من الحدود إلى الجمارك وغيرها من الخدمات الأمنيّة ومؤسّسات الدّولة وحتّى شرطة المرور. كان عاطف يعاني من جنون العظمة. أحد قراراته كانت منع الناس من بيع الأراضي أو العقارات دون تصريح أمنيّ. بعدها صار يمنح موافقات أمنيّة لعناصره لكي يشتروا الأراضي بأسعار زهيدة.
كان النّاس غاضبين من الأساس، قبل أن ينفجروا بعد حادثة الأطفال. وصل المعلمون والطلبة إلى المدرسة في أحد الصباحات ليُفاجَؤوا بعبارات كُتبت على جدران المدرسة، لا أحد يعلم مَن كتبها إلى يومنا هذا: «إجاك الدور يا دكتور». اتّصل مدير المدرسة واستدعى الأمن السياسي، فجاء العناصر واعتقلوا عدة أشخاص دون تحقّق. كانوا بحاجة لاتهام أيّ أحد ليكتبوا التقرير ويثبتوا أنّهم أدّوا مهمّتهم. لذا جمعوا الأطفال المكتوبة أسماؤهم على الحائط، حتى وإن كانوا كتبوها منذ سنين، وكان معظمهم لم يتجاوز الستة عشر عاماً. عذّبوا الأطفال حتى قالوا لهم ما أرادوا سماعه، كما طلبوا منهم الاعتراف على أسماء زملائهم ليقوموا باعتقالهم أيضاً.
لجأت عوائل الأطفال إلى رئيس فرع حزب البعث في المنطقة، وطلبوا مساعدته للإفراج عن الأطفال، لكن دون جدوى. بقي الأطفال معتقلين. شكّل الأهالي وفداً للذهاب والتحدّث مع عاطف نجيب، لكنّه رفض إطلاق سراح أطفالهم وقال لهم: «انسوا أطفالكم وارجعوا إلى زوجاتكم وأنجبوا أطفالاً آخرين، وإذا كنتم لا تعلمون كيف فأحضروهنّ لي وسنعلّمكم كيف».
انتشرت تلك الإهانة وسمع بها كلّ سكان درعا. كان ذلك يوم الخميس 17 آذار. لكن لنعُدْ الآن إلى 15 آذار: خطّط أشخاص ينتمون إلى بعض الأحزاب اليساريّة لوقفة أمام مجلس مدينة درعا، كان أبي منهم. وبعد وصولهم تفاجؤوا أنّ عناصر الأمن سبقوهم وانتشروا في المكان بانتظارهم. فانسحبوا دون أن يرفعوا لافتة أو يهتفوا بهتاف، مع ذلك اعتقل رجال الأمن بعضهم، بما في ذلك أبي.
أهانوهم وهدّدوهم بألّا يفكّروا مجرّد تفكير في التظاهر مجدّداً، وبعدها أطلقوا سراحهم. في مساء ذلك اليوم، قرّرت المجموعة ذاتها الانطلاق في مسيرة من المسجد في صباح اليوم التالي بعد صلاة الجمعة. لماذا من المسجد؟ ببساطة لأنّه المكان الوحيد الذي تسمح قوّات الأمن بالتجمّع فيه. لكن عناصر الأمن كانوا منتشرين في أكبر مسجدين في درعا، فقرّرت مجموعة أبي التوجّه إلى مسجد صغير يدعى الحمزة وعباس. لم يجدوا هناك أيّ عنصر أمن، لكنّهم وجدوا أهالي الأطفال المعتقلين في انتظارهم.
بعد انتهاء الإمام من خطبته، هتف أحدهم «الله أكبر»، وهتف البقيّة وراءه، فانطلق الجميع في مسيرة نحو الجامع العمري الذي يقع في مركز البلدة. هذا ما حصل… انضمّت عوائل الأطفال بسبب غضبها ممّا جرى لأطفالها. وصلوا إلى الجامع العمريّ، وحينها انضمّ إليهم المصلّون. توقّعنا التعاطف، لكن لم نكن نتصوّر أن ينضمّ الجميع خلال دقائق. ما إن شاهد الناس الجموع حتّى فهموا ما يجري، وانضموا إلى المسيرة وشاركوا في الهتاف. جاؤوا من كلّ مكان، من البيوت والشوارع ومن المساجد الأخرى. خرجت الأمور عن السيطرة في تلك اللّحظات، وتحوّل الموضوع إلى قضيّة عامّة. لم يمضِ وقت طويل حتّى بدأت المروحيات تنقل عناصر الأمن إلى الملعب البلديّ، بعد أن سبقتهم باصات مملوءة بالعساكر إلى هناك. تجمّعت المظاهرة على حافّة وادٍ يفصلها عن الحيّ الذي تقع فيه مؤسّسات الدولة. تجمعّت قوّات الأمن على الجهة المقابلة، وجاءت الشرطة والمحافظ والضابط الذي قام باعتقال الأطفال أيضاً. هدّدوا المتظاهرين باعتقالهم وقتلهم في حال لم يتراجعوا. لكن ذلك زاد غضبَ الناس، فواصلوا التظاهر، بل قاموا برمي الحجارة أيضاً. بعدها قامت قوّات الأمن بإطلاق النار، وقُتِل متظاهران اثنان، وأصيب ثالث ثم تُوفِّي لاحقاً متأثراً بإصابته.
كان من الممكن أن يعود أهالي درعا إلى بيوتهم في تلك الليلة ويفكّروا بحلول بديلة، لولا أنّ النظام تورّط في القتل. خرج الناس في اليوم التالي لتشييع شهداء المظاهرة، وأخذوا يهتفون ضدّ النظام. استمرّت المظاهرات، وقتلت قوّات الأمن أعداداً أكبر. أدركنا في تلك المرحلة أنّه لا عودة عن المظاهرات، وأنّ الأمر تحوّل من فكرة سياسيّة إلى حراك شعبي.
منتصر، صحفي (درعا)
كان أخي في مسجد الحمزة والعباس. خُطِّط لكلّ شيء بسرّيّة تامة، ولم نكن متأكّدين أنّ المظاهرة ستتمّ فعلاً إلى أن انطلقت.
حين اقتربتِ المظاهرة منّي، كنت أنتظر في الجامع العمريّ. كان الشعور غريباً. كنت سعيداً جداً إلى حدّ البكاء؛ لم نشهد شيئاً مثل هذا من قبل. حتى تلك اللحظة، لم نكن نعرف سوى المسيرات المؤيّدة للنظام.
قُتِل أوّلُ شهيدين، ورُتِّب تشييعهما في اليوم التالي. لم نتوقّع أن يحضر أحد بسبب الذّعر الذي حدث من جرّاء مقتلهما في اليوم السابق، لكنّ المفاجأة كانت حضور 150 ألف شخص من القرى المجاورة أيضاً.
كان الجميع يعرف إجرام النظام، لكن كنا نخشى الخروج ضده. ثم أتتنا فرصة سانحة! هل لو أضعناها لن نتمكّن بعدها من الخروج ضده أبداً؟ كنا نعرف أننا لو تراجعنا أو استسلمنا فسيقبض النظام على جميع الذين خرجوا في اليوم الأوّل، وقد يموتون في المُعتَقل. لذا لا خيار لنا سوى إكمال ما بدأناه، فقد اخترنا طريقاً لا رجعة فيه.
أبو ثائر، مهندس (درعا)
خرجتْ أوّل مظاهرة يوم الجمعة، تبعتْها عدّة جنازات ومظاهرات. بدأ الناس يوم الثلاثاء مساءً اعتصاماً في الجامع العمريّ، وفي حوالي الثالثة صباحاً اجتاحت قوّات الأمن الجامع من الجهات كلّها. قتلوا العشرات، وجرحوا أعداداً أكبر. أحرقوا المصاحف، وكتبوا على الجدران عبارات من قبيل «لا تركع إلا للأسد».
سمع النّاس في القرى المجاورة عن مجزرة الجامع العمريّ، فبدؤوا يتوافدون على درعا. دخلوا المدينة يهتفون «سلميّة.. سلميّة.. سلميّة». فما كان من قوّات الأمن إلّا أن فتحت عليهم النيران. تخيّل! من هذه القرية مات عشرة، ومن تلك مات خمسة، ومن الأخرى ثلاثة، ومن أخرى اثنان… وهكذا دواليك.
أرسل النظام شهيداً لكلّ قرية، وهكذا انفجرت الثورة في المحافظة كلّها. تخرج الجنازات فتتحوّل إلى مظاهرات. لو ألّفت كتاباً حول هذا لأسميته: كيف تصنع ثورة في أسبوع بدون معلّم.
حسين، كاتب مسرحي (حلب)
كنا نوجّه النصائح على فيسبوك خلال الثورة المصرية، ونشارك الأغاني الثّوريّة. شعرنا أنّنا نعيش معهم في ميدان التحرير. بعدها خرجت مظاهرة في درعا، ووصل خبرها إلى حلب. كتبتُ منشوراً على الفيسبوك يعبّر عن دعمي لما يحصل، لكنّني لم أضغط على زر النشر لمشاركته. كانت أصابعي على لوحة التحكّم، لكنّني كنت خائفاً جداً. قلتُ لنفسي إنّ من العار أن أكتب وأدعم الثورة في مصر، وأن يمنعني الخوف من القيام بأيّ شيء للثورة في بلدي! بعدها تجرّأت وضغط على زر النشر، وذهبت للنوم متأكّداً من أنّ عناصر النظام ستعتقلني صباحاً.
أبو طارق، مهندس (ريف حماه)
اتّصلت بأصدقائي في درعا للاستفسار عمّا يجري هناك. كلنا تأثّر بما حدث. لكن ما الوضع؟ ماذا علينا أن نفعل؟ كنت في القرية مع أصدقائي حين قرّرنا، في إحدى الليالي التي كنا نسهر فيها ونلعب الورق والشطرنج، أن نخرج في مظاهرة يوم الجمعة 25 آذار. كان علينا الخروج في مظاهرة من أكبر مسجد في حماه. كان النظام يشعر أنّ شيئاً ما يحدث، لذا أرسل عناصره لتهدئة الوضع. جاء السكرتير السابق لشعبة حزب البعث، والذي يشغل منصبه منذ أحداث حماه عام 1982. دعاه الإمام لإلقاء كلمة للمصلّين، فقال: «لم يحصل شيء في درعا وكل ما سمعتموه مجرد كذب».
حبس الشعب غضبه لسنين وسنين، وكان لا بدّ من لحظة انفجار. فبدأ الحاضرون بالصراخ على سكرتير الحزب وشتمه٬ «اخرس! لا ننتظر من فاسد أن يُملي علينا ما نفعله»، وقام الجميع ثم خرجوا من المسجد. مشينا ما يقارب ثلاثمئة متر فقط، قبل أن تقتحم قوات الأمن الجموع وتضربنا.
في الجمعة التي تبعتْها، بدأت قوّات الأمن تهاجم الناس داخل المسجد حتى قبل أن يخرجوا، ولم يعطونا فرصة للوصول إلى الشارع. مع ذلك، كانت هذه المظاهرة أكبر من التي سبقتها. كلّ حماه كانت تقول «علينا الخروج».
أحد أقاربي لم يكن داعماً للمظاهرات، إذ رأى أنّ الوقت غير مناسب، وأنّ الأمر بحاجة إلى تحضير، وأنّنا غير منظّمين. ردّي عليه كان أنّ النّظام لن يسمح لنا بالتنظيم أبداً، فهو لم يسمح لنا قطّ بإنشاء حزب أو جريدة أو حتى تنظيم اجتماع. كان عليّ الحصول على موافقة أمنية لمجرّد دعوة 15 شخصاً إلى منزلي والاستماع إلى قصص يرويها أحدنا. لا يريد النظام أيّ تغيير ما دام متحكّماً بكل شيء. كان الاقتصاد كلّه في قبضته، بالإضافة إلى خمسمئة ألف ضابط. في لحظة ما، كان علينا المواجهة.
كريم، طبيب (حمص)
خرجتْ أوّل مظاهرة في حمص يوم الجمعة 18 آذار. انتهت الصلاة، وخرج الناس من المسجد يهتفون. كان عناصر الأمن في انتظارهم عند البوّابة، فقبضوا عليهم وأخذوهم في باصات، وسرعان ما انفضّت المظاهرة.
الجمعة التي تلتها، في 25 آذار، كنت رفقة أصدقائي نشرب القهوة حين سمعنا ضجّة غريبة «هوووو». لم يكن لدينا علم بأيّ شيء، فاقتربنا قليلاً ورأينا الناس. أخذت الضجّة تتعالى وأعداد الناس تزداد. سار الناس من حمص القديمة إلى وسط المدينة.
لم نصدّق ما رأيناه.. هل هذا حقيقي؟ انضمّ آخرون إلى المسيرة، فكبرت أكثر وأكثر، حتى أصبحت مظاهرة ضخمة. انضممتُ أيضاً إلى الحشود. رغم وجود عناصر الأمن، لكنّهم وقفوا عاجزين أمام الجموع غير قادرين على فعل شيء.
هتف المتظاهرون لثلاث ساعات تقريباً، إلى أن وصلت باصات محمّلة بمؤيّدين للنّظام – معظمهم من الطائفة العلويّة – نزلوا وأخذوا يرمون الحجارة على المتظاهرين. بعدها بقليل، بدأت المجموعتان تتراشقان بالحجارة. تدخّل عناصر الأمن وأطلقوا الغاز المسيل للدموع واعتقلوا كثيرين.
تسلّق أحد المتظاهرين جدار نادي الضبّاط العسكري وأنزل صورة لحافظ الأسد بعدها ظل يركلها حتى مزّقها نصفين. بُثّ ذلك المشهد وانتشر ولم يكن أحد يصدّق عينيه.
كانت أيّام الجمعة تشهد ازدياد حجم المظاهرات أسبوعاً بعد أسبوع. لو ذهبت إلى حمص أثناء الأسبوع لوجدت الحياة طبيعية جداً: المحلّات مفتوحة، والناس يمارسون أعمالهم كالمعتاد. لكن عناصر الأمن كانوا يفتّشون البيوت ويبحثون عن كل من ظهر في الفيديوهات التي لديهم.
كان عناصر الأمن يملؤون الساحة الرئيسية في مركز المدينة، ويقيمون حواجز لمنع الناس من التجمّع فيها. بدأ النّاس يخرجون في أحيائهم، حتى الذين لا يصلّون كانوا يذهبون إلى المساجد فقط للتظاهر. الجميع كانوا متعطّشين لفعل شيء ما. كنا على يقين أنّنا سنسقط الرئيس عبر تلك المظاهرات السلميّة وحدها.
زياد، طبيب (حمص)
دخل رجل إلى مسجد في حمص وهو يرتدي سلسلة في رقبته، وكان يظهر جزؤها العلوي بينما يختبئ الباقي داخل قميصه. اصطفّ معنا وصلّى، وحين ركع تدلّت قلادته وظهر صليب. سأله أحدهم إن كان يرتدي السلسلة بالغلط أو دخل المسجد بالغلط. فردّ الشابّ المسيحي: «بل دخلت إلى هنا لأنّني أرغب في التظاهر معكم».
ميريام، طالبة سابقاً (حلب)
في أحد أيام الجمعة، ذهب أخي إلى المسجد الذي ستخرج منه مظاهرة، وحين انتهت الصلاة قال لنفسه: «لماذا عليّ أن انتظر كلّ مرة غيري ليبدأ بالهتاف؟ لِمَ لا أكون أنا من يهتف أوّلاً هذه المرة؟». وقف وأخذ يهتف «الله أكبر… الله أكبر…» فيما كان الجميع ينظرون باستغراب. تبيّن أنّهم غيّروا مكان انطلاق المظاهرة.
هادي، مالك محل (ريف اللاذقية)
بدأت الثورة في قريتي في اللاذقية عبر الغرافيتي. كان الناس يخرجون ليلاً ويكتبون على الجدران بسرّيّة تامّة. أطلقنا عليهم اسم «خفافيش الليل»، فقد كنا نستيقظ صباحاً لنرى الجدران مزيّنة بشعارات مثل «الشعب يريد إسقاط النظام».
كنت أملك محلّ دهانات، لذا جاءني عناصر الأمن وطلبوا منّي تسجيل معلومات كلّ زبائني ومن يشتري منّي الدهان. كان عليّ تسجيل اسم الزّبون واسم أبيه وأمّه، بالإضافة إلى رقم هوّيته. خاف الناس ولم يعد أحد يشتري مني. بعدها بفترة، اضطررت لإغلاق المحلّ. لكنّ رسّامي الغرافيتي وجدوا محلاً آخر واستمرّوا في نشاطهم.
بعد ذلك بقليل، كانت الكهرباء تنقطع من الساعة السابعة مساءً فلا تجد ضوءاً واحداً. لكن الهتافات بدأت تنتشر: يصرخ أحد أصحاب القلوب الجريئة من شباكه في وسط العتمة: «الله أكبر»، فيشاركه جميع مَن سمع. كانت الأصواتُ تأتي من الجهات جميعها، وحين يصل عناصر الأمن يسكت الجميع حتى يغادروا، ثم تبدأ الهتافات من جديد.
محمود، ممثل (حمص)
في البداية كان الناس يخافون التحدّث عبر الهاتف، لذا كانوا يتناقلون الأخبار عبر شيفرات. كنت أدرس في دمشق، وحين كنت أتّصل بأمّي في حمص أسألها: «مرحباً ماما، ما الأخبار؟». فترد مثلاً: «الحمد لله، اليوم كان الجوّ غائماً وممطراً». «غائم» تعني حضور عناصر الأمن، و«ممطر» تعني أنّهم أطلقوا الرّصاص، أمّا «عاصف» فتشير إلى قصف. كنا نتبادل تلك الأحاديث الجوّية ونحن في عزّ الصيف! لذا كنت أنهي الحديث: «نعم يا أمي، علينا تحمُّل الطّقس».
كنت أخاف من التّظاهر، ولم أشارك إلّا مرّة واحدة مع حبيبتي لأنّها أرادت المشاركة. ذلك اليوم شككتُ في الجميع وظننتُهم عناصر مخابرات يرغبون باعتقالي، سواء في التاكسي أو في المظاهرة. اعتُقِلَ شخص أعرفه بتلك الطريقة. أخذوه للتحقيق، لكنه لم يعترف بمشاركته في المظاهرات حتى عرضوا عليه فيديو وقالوا له: «إذا كنت لم تشارك، فمن هذا الذي يظهر هنا؟». تحوّل لون الشاب إلى الأصفر، فقد كان يظهر في وسط المظاهرة محمولاً على ظهر أحدهم. كان الشخص الذي يحمله هو المحقّق ذاته.
حسين، كاتب مسرحي (حلب)
كبرت المظاهرات على مهل. بعض أحياء حلب شهدت مظاهرات أسبوعياً. عملت جنباً إلى جنب مع المتظاهرين الشباب، وعقدنا اجتماعات أسبوعيّة وسرّيّة في منازلنا. كنت يوماً أتحدّث عبر الهاتف حول خروجي في مظاهرة، فسمعتني ابنتي ذات الستة عشر ربيعاً حينها.
قالت لي: «أريد الذهاب معك في المظاهرة».
قلت لها: «هل أبدو كشخص قد يخرج في مظاهرة؟».
أصرت قائلة: «سمعتك تقول لأحدهم أنّ العرس سيكون في الثانية بعد الظهر، فمن يتزوّج في تلك الساعة؟! أنت تقصد الذهاب لمظاهرة، وأنا سأذهب معك».
تجادلنا لمدة ساعة، وفي النهاية سمحتُ لها بمرافقتي. وحين تجهّزنا للخروج، تبعتْنا زوجتي السابقة إلى الباب. قالت: «إذا كنتما ذاهبين للمظاهرة فسأرافقكما أيضاً، لن أبقى وحيدة في المنزل».
بعد ذلك اليوم أدمنت الاثنتان على المظاهرات. اكتشفنا لاحقاً أن ابنتنا تفوّت مدرستها لحضور اجتماعات الناشطين. لذا اضطرّت أمها إلى مرافقتها يومياً للمدرسة وانتظارها في الخارج حتى تنتهي وتعودا معاً إلى المنزل.
ياسر، خرّيج جامعي (حلب)
أوّل مظاهرة خرجتُ فيها كنت ضمن مجموعة، لكن حين وصلنا إلى المظاهرة أضعتُ أصدقائي بسبب كثرة الناس. رأيت الكثير من الشبّيحة. أحدهم كان يحمل خيزرانة، وكان يتظاهر أنّه يتعكز عليها رغم أنه لم يكن يعرج. شبّيح آخر كان يحمل أداة حادة لكنه كان يتظاهر أنّه يقوم بإصلاح سيارة. تظاهر جميعهم أنهم يقومون بشيء ما بالأدوات التي بأيدهم، لكن الحقيقة كانت أنّها أدوات لضرب المتظاهرين. بعد قليل كان الجميع يشك بالجميع.
كان من المفترض أن تبدأ المظاهرة في الساعة 8:30، لكن لم يبدأ شيء حتى 8:35. بعدها مرّ رجل كبير على الشابّ المسؤول عن بدء الهتاف، وسأله: «لماذا تقف هنا؟ قل شيئاً أو انصرف».
عندها فكّر الشاب في نفسه: «عليّ قتل نفسي إذا كان هذا العجوز أشجع مني». لذا خرج وهتف، وبعدها تبعه الجميع. تخيّل أنّ بين يديك رزمة أوراق نثرتَها فطارتْ وتبعثرتْ في كلِّ مكان. هكذا بدت تلك المظاهرة.
جمال، طبيب (حماه)
كان من المستحيل خروج أعداد كبيرة من الناس للتظاهر في دمشق. خوف الناس في العاصمة كان شديداً. لذا كنا ننظّم مظاهرات خاطفة نسمّيها «مظاهرة طيّارة»، حيث نهتف لمدّة خمس دقائق أو أكثر، ثم نتفرّق ونهرب. كما ابتكر الناس طرائق مختلفة للتعبير عن معارضتهم للنّظام، كأن يتّفق مجموعة على مكان وزمان معيّنين، ثمّ يظهروا جميعاً مرتدين اللّون ذاته. على سبيل المثال، كان الجميع يذهبون إلى مقهًى معيّن مرتدين اللّون الأسود. لن يستطيع أحد محاسبتهم، وكانت تلك طريقة لمعرفة حجم المعارضة في المدينة. تدريجياً، فهم عناصر الأمن ما يحدث، فأصبحوا يلاحقون كل من يرتدي اللّون الموحّد.
لو سمعنا كلام أهالينا لما خرجنا أبداً. فقد عاش جيلُهم مأساة حماه. كانت خالتي حاملاً في تلك الفترة، وكان على والديّ أخذها للمستشفى، وكان عليهم التوقّف على بعض الحواجز ورؤية الجثث مصفوفة على حافّة الطريق. ما زال أبي يحمل ذلك المشهد في خاطره إلى اليوم، ولم يتخلّص من خوفه منذ تلك اللحظة. هو حتى لا يتحمل مشاهدة البرامج السياسية، وكان كل مرة يرى شيئاً سياسياً يطلب منا إطفاء التلفزيون. كان خائفاً إلى ذلك الحدّ. حتى جيلنا يخاف، لكن ليس كخوفهم أبداً. الآن أقول لوالديّ: «لماذا صمتم كل تلك السنين؟».
نقول ذلك لجيلهم كاملاً.
ريما، كاتبة (السويداء)
كنت في مظاهرة وكان البعض يهتف فشاركتهم. همست: «حرية»، بعدها صرت أسمع صوتي وأنا أردد: «حرية… حرية… حرية». هنا بدأت أهتف بصوت عال: «حرية!». اختلط صوتي بالأصوات الأخرى، ارتجفتُ وبكيتُ حين سمعته. شعرت أنني أطير! قلت لنفسي: «هذه أول مرة تسمعين بها صوتك». كانت أول مرة أشعر بأنني روح لا تخاف من الموت أو الاعتقال أو أي شيء. أردت أن أشعر بهذه الحرية للأبد، وعاهدت نفسي ألا أسمح لأحد قط بسرقة صوتي مرة أخرى.
ومنذ ذلك اليوم كنت أشارك في جميع المظاهرات.
أمل، طالبة سابقاً (حلب)
كان الطلّاب في باحة الجامعة في انتظار محاضراتهم حين صرخ أحدهم «الله أكبر!»، وشاركه الجميع وهتفوا: «حرّيّة!». تجمّدتُ، شعرتُ بالقشعريرة. شدّتْني صديقتي من حقيبتي لتمنعني من التظاهر، لكنّني واصلت السير نحو المتظاهرين. شعرتُ كأنّني أفقد السيطرة على نفسي وجسمي وأنّ قدميّ تتحرّكان وحدهما. حاولتْ صديقتي إرجاعي مرّة أخرى، وسحبتْني وفشلتْ مجدداً. انقطع حبلُ حقيبتي، لكنّني أخيراً أصبحت في وسط الحشد.
سناء، مصممة غرافيك (دمشق)
كنت خائفة جداًفي طريقي إلى المظاهرة. كان الوقت ليلاً، وكنا ملثّمين لنخفي هويّتنا عن عناصر الأمن. مشينا في الحارات الضيّقة التي تؤدي إلى الساحة. حين وصلنا، كانت الساحة مضاءة، وكان البعض يعزف الموسيقى على آلات مثل الطبل والناي. لا أعلم مَن أمسك بيدي اليمنى أو اليسرى، قبل أن نبدأ نغنّي ونرقص ونقفز. كانت حفلة لإسقاط النظام.
لم يهمّني أيّ شيء وقتها. كنت سعيدة جداً. تلك اللّحظات لن أنساها ما حييت؛ اللّحظات التي وقفتُ فيها مع ناس لا أعرفهم، أرقص وأهتف لإسقاط بشار الأسد. اتفقت مع زوجي على التناوب على الخروج في المظاهرات. ففي اليوم الذي يذهب فيه، أبقى أنا في المنزل، والعكس صحيح. ذلك كان أفضل في حال حدث شيء ما. عاد مرّة من إحدى المظاهرات وكان متأثّراً للغاية. بكى وقال لي: «مَن لم يعش هذه اللحظة لم يعش حياته أبداً». كنت أعلم منذ أوّل مظاهرة أنه على حقّ.
شادي، محاسب (ريف حماه)
كانت أوّل مظاهرة أجمل من يوم عرسي. حين سمعتني زوجتي أقول ذلك خاصمتني لشهر.
وضاح، خرّيج جامعي (اللاذقية)
أنا وأخي الأصغر كبرنا في الخليج، ثم عدنا إلى سوريا للدراسة. كي أكون صريحاً، كنا نكره السوريين بعض الشيء. شعرنا أنهم لا يمانعون التعرُّض للعنف أو الإذلال. أحياناً كنت أتمنى لو لم أكن سورياً. كنت أنتظر أن أتخرّج من الجامعة لأغادرها على الفور.
استيقظتُ صباح 21 من آذار في بيتنا في المعضّمية على صوت يهتف: «حرّية… حرّية…». اعتقدت أنني ما زلت نائماً، وتمنّت لو يستمر هذا الحلم. لكن الأصوات كانت تأتي من الخارج، واكتشفتُ أنّ ذلك واقع! فتحتُ باب غرفتي، وصرخت: «مظاهرة!». بعدها طرقتُ على باب شريكي في السكن وأنا ما زلت أصرخ: «مظاهرة! مظاهرة!». بعدها انتبهتُ أنّني بلباس النوم وحافي القدمين. ارتديتُ ملابسي، وخرجتُ مسرعاً.
رافقني أخي. طلبتُ منه العودة إلى المنزل لأنّني شعرت بشيء من المسؤوليّة تجاهه، وخفت عليه من التعرّض للأذى هناك. لكنه بالطبع لم يُطعْني. هذه ثورة، ولا أحد سيُطَاع بعد اليوم.
بدأتُ بالهتاف بصوت عالٍ: «كرامة…». لا نعلم ماذا نريد بعد الكرامة، لكنّنا كنا متأكّدين أنّنا بحاجة إلى أشياء كثيرة غير الطعام. كبرت المظاهرة حتى أصبحنا ما يقارب الثلاثين شخصاً، بعدها تجمّع حولنا رجال يرتدون معاطف سوداء ويتحدّثون عبر الهواتف المحمولة. تمكّنت أنا وأخي من الفرار عبر الحارات الفرعيّة، لكن البقيّة اعتُقِلوا. كلهم.
كنت أنا وأخي مميّزين بسبب شعرنا الطويل. كانت الناس تسأل أين اختفى ذوا الشعر الطويل؟ لكنّ سكان المعضمية ساعدونا وتستّروا علينا ولم يشِ أحد بمكان سكننا.
كنّا نأمل أن تخرج مظاهرة أخرى في 25 آذار. ذهب صديقي إلى مسجد في دوما، وذهبتُ أنا إلى مسجد في المعضمية. اتفقنا على شيفرة: إذا أرسل علامة زائد (+) فهذا يعني أن هناك مظاهرة لديه، أمّا علامة ناقص (–) فتعني أنّ المصلين انتهوا وعادوا إلى منازلهم.
جلست في المسجد أستمع إلى خطبة الإمام، التي بدت بلا نهاية، وكنت أنتظر علامة زائد. ثم وصلتني فعلاً! سمعتُ الناس في الشارع يهتفون: «بالروح بالدم نفديكِ يا درعا». ركضنا خارجاً ونحن نقفز على الدرج من الحماس حتى وصلنا إلى الشارع، وإذ فوجئنا بما يقارب 2,000 متظاهر.
بكيتُ حينها، ولمتُ نفسي على شعوري بالعار من كوني سورياً، وكيف كنت أنعت هؤلاء بالجبناء. كنت أعتذر لهم في نفسي: «أنا آسف.. آسف جداً منكم.. أنتم إخوتي.. أنتم ناسي.. أنتم عظماء».
أنس، طبيب (الغوطة)
خرجنا في مظاهرات «الجمعة العظيمة» بالتزامن مع عيد الفصح، احتراماً وتضامناً مع إخوتنا المسيحيين. أردنا تشجيع السوريين المسيحيين لمشاركتنا والانضمام إلينا.
كان الحشد كبيراً جداً، والمظاهرة ضخمة، وتجاوز عددنا 100 ألف متظاهر. جاء الناس من جميع مناطق ريف دمشق، دوما وحرستا وزملكا وكفر بطنا.. شعرت وكأنّنا عبرنا جسراً وقد اهتزّ من وقع أقدامنا الكثيرة.
وصلنا إلى جوبر، وكان عناصر النظام بانتظارنا هناك. أطلقوا علينا الغاز المسيل للدموع فتراجعنا. بعدها جاءت الباصات المحمّلة بالشرطة والشبّيحة. جاؤوا من كلّ الاتجاهات، وهاجموا الناس بكل الأدوات التي بحوزتهم. بحكم عملي كطبيب، حاولت مساعدة الجرحى. كان بعضهم يختنق من الغاز المسيل للدموع، وكنا نصبّ على وجوههم الكولا حتى تقلّل من تأثير الغاز، فتصبح وجوههم دبقة ولامعة.
هتفنا: «حرّيّة.. حرّيّة.. حرّيّة!»… وفجأة صرخ أحدهم: «الشعب يريد إسقاط النظام». هنا سكت الجميع لأنّها كانت المرّة الأولى التي نسمع فيها تلك الجملة بالصوت العالي. صمتْنا لعشر أو خمس عشرة دقيقة، وخفنا أن يكون هذا الشخص من المخابرات.
بدا كأن الجميع يفكّرون: هذا الشخص تجرّأ على قول ما نريد قوله منذ سنين، هل صحيح ما سمعناه؟ هل فعلاً قيلت هذه الجملة بعد سنين من الصمت؟ هل علينا أن نهتف بها معه أو نبقى صامتين؟ تأمّل بعضنا بعضاً، وكانت وجوهنا تحدّق في حدود المسموح. هل نقولها أم لا؟
شيرين، أُم (حلب)
اعتدنا كثيراً على الظلم. كان جزءاً من حياتنا اليومية، كالماء والهواء والشمس. لم نعد حتى نشعر بوجوده. كأنه الهواء، تشعر به لكن لا تراه ولا حتى تسأل أين هو. الجميع كان معارضاً لأوضاع البلد، لكن أحداً لم يخرج للتظاهر. كان عليك التأقلم مع الظلم حتى تتعفّن فيه بصمت.
في ثانية واحدة انقلبت الموازين. بصرخة واحدة وصوت واحد أصبحت تتحدّى الموت وتقف في وجهه دون خوف. وكأنك حطّمت خردة قديمة ورميتها أرضاً.
شجعتُ أبناء أختي على الخروج معي في المظاهرات. شعرتُ أنّ عليهم أن يعيشوا تلك التجربة ليذوقوا طعم الحياة. حتى لو فشلت الثورة، فهم لن ينسوا هذه الأيّام مدى الحياة. سنخبر أطفالنا أنّنا اتخذنا موقفاً، وخرجنا، وتكلّمنا، بل صرخنا أيضاً.
بنتان وولد هم أبناء أختي الذين رافقوني في المظاهرات. كانت أصواتهم منخفضة وخجلة في البداية، لكنّها علت في كلّ مرة عدنا فيها إلى الهتاف. ارتفعت الأصوات حتى سُمع صداها بين الأبنية، وخرج سكّانها ليروا ما يحصل. لا توجد كلمات تصف المشهد.
لا يمكن لأحد تخيّل صعوبة الخروج في مظاهرة. أيّة شجاعة تجعلك تقف وجهاً لوجه مع من يحمل سلاحاً موجّهاً إليك، وهو على وشك قتلك! نحن – الشعب – كنّا متأكّدين من أنّ النظام سيقتلنا، ولكن لم يذهب الخوف لمجرد معرفتنا بحتمية الموت. شدّة الظلم هي ما دفع الشباب والشابّات للخروج والهتاف والتكبير. بعدها أصبح ما يقارب 200 شخص مستعدين لقول «الشعب يريد إسقاط النظام».
يعلو صوتك وتخالجك مشاعر جياشة، ترتجف، ويرتفع جسمك، وتجد نفسك تفعل كلّ ما تخيّلته لسنين. فجأة تنزل دموعك… دموع الفرح! أنت أخيراً كسرت الحاجز، أخيراً لم تعد خائفاً، أخيراً أنت حرّ! تنهمر دموعك، ويتغيّر صوتك، فيصبح خليطاً من الحزن والسعادة والخوف والشجاعة؛ خليطاً من الأصوات الصادحة الهدّارة.
كنت أعتقد أنّ سوريا ملك للأسد، وأنّها مجرّد مكان أعيش فيه. اليوم فقط، وبعد قيام الثورة، صرت أشعر بانتمائي لها بوصفها وطني. كغيري من الأكراد، كنت أشعر بالظلم، بأن هناك شريحة محظية مدعومة من النظام. لكن بعد الثورة اكتشفنا أنّ الجميع بلا استثناء يعاني من ظلم النّظام، وأنّنا فقط كنا متفرّقين ولم نكن على قلب واحد، وذلك ما جعلنا لعبة في يد النظام.
عبد الرحمن، مهندس (حماه)
ربّتني أمي وحدها لأنّها كانت مطلّقة. لم تكن تملك سوى شهادة الثانوية، وكنّا فقراء. لذا كانت دراستي أملي الوحيد بمستقبل أفضل.
لطالما حلمت أن أصبح مهندساً. حصلت على بعثة لدراسة الهندسة في الجزائر. باعت أمي عِقداً كانت قد اشترته لها جدّتي لتوفّر لي ثمن تذكرة الطائرة. كنت مراهقاً مشاغباً، كالجميع في سنّي، لكن حين وجدت نفسي وحيداً في الجزائر، أصبحتُ طالباً مجتهداً. تعلّمت الفرنسية، وحصلتُ على المرتبة الأولى في قسمي، كما وقعتُ في حبّ فتاة جزائرية.
حين بدأ الربيع العربي، كنت أنهي دراسة الماجستير. اقترب حلمنا بالحرّيّة، لكنني كنت خائفاً حتى من تسجيل إعجاب بصفحة الثورة السورية على فيسبوك. أنشأتُ حساباً آخر تحت اسم «رجل سوري» لأتمكّن من التعبير والتفاعل بحرّيّة.
كان معي في الجزائر شابّ سوري آخر. شعرتُ أنّني أوقّع على ورقة موتي حين شاركته آرائي السياسية، لأنّ والديه كانا في الشرطة وعائلته موالية للأسد. لاحقاً، قُتل أحد أصدقائه في إحدى المظاهرات، وحين أريته فيديو احادثة قلت له: «انظر إلى الشرطة، قد يكون أحد أقاربك مشاركاً في هذه الجريمة». هنا نظر إليّ وتعابير الصدمة بادية على وجهه.
حجزت تذكرة عودة، وذهبت إلى سوريا فور انتهاء امتحاناتي. حين وصلت، ركبت تاكسي من مطار دمشق إلى محطّة الباصات. كنت في غاية الحماس للحديث عن الثورة مع أيّ أحد. كدت أنسى وأفتح الحديث مع السائق، لولا أن شعاع الشمس ضرب ذراعه فجأة ونبّهني إلى وشمه الكبير: «يا علي، يا بشار». بما أن علي شخصية مقدّسة، فلا بد أن بشّار أيضاً شخصية مقدّسة لديه، بل إله. أغلقت فمي تماماً.
وصلت إلى حماه في الساعة 6:30 صباحاً، وخرجتُ في المظاهرة في اليوم نفسه. شعرتُ كأنّني في الجنّة وأنا أصرخ لأول مرة «الموت ولا المذلة». غمرتني السعادة، وبدا كل شيء حولي سعيداً، حتى حجارة الشارع. توافد النّاس من الجهات كلّها، وتحرّكت الشوارع من تحت أقدامنا. سرنا نحو ساحة العاصي في مركز المدينة. نثرتْ علينا النساء السكاكر والرز من الشّرفات، وصدح صوتُ المكبّرات بأغنية يا حيف: «وانت ابن بلادي… تقتل بولادي… وظهرك للعادي… وعليّ هاجم بالسيف… يا حيف».
تنفّستُ الحرية كأيّ شخص حرّ. كنت أفكّر كم أنا سعيد لأنّني أعيش هذه اللّحظات، ولأنّني أنتمي إلى هذا المكان.
مرسيل، ناشطة (حلب)
كنت في السابق تلك الفتاة المسيحية التي تؤكد أنّ كل شيء في سوريا بخير لأنّ النظام فيها علماني ويرعى حقوق الأقلّيّات. انضممتُ عام 2005 إلى إحدى مجموعات الإنترنت، وبدأت أشارك في المنتديات. اعتُقِل بعض المشاركين في المنتدى بسبب كتاباتهم. شكّل ذلك عندي أوّل موقف تجاه حقيقة النّظام.
كانت أوّل تدوينة لي عن الثورة في 15 آذار. قلت حينها إنّنا نستحقّ الحرّيّة، وكتبتُ ذلك باسمي الحقيقي. فمنذ بداية نشاطي على الإنترنت وأنا لا أكتب تحت اسم مستعار. كان ذلك مخاطرة كبيرة بحياتي، لكنني أردتُ أن يعلم السوريّون جميعاً أنّني امرأة، وأنّني مسيحيّة، وأنّني أؤمن بأنّ على هذا النظام الرحيل. كذلك أردت القول أنّني لا أرى المسلمين خطراً علينا نحن المسيحيين، وأنّني أثق بهم لنمضي ونتحرّك معاً نحو هدف واحد.
انضممتُ إلى الناس، وخرجتُ إلى الشارع في نيسان. كنت أعيش حياة منقسمة: أخرج للتظاهر في السّرّ دون أن يعلم أحد، لأنّ عائلتي مؤيّدة للنظام. ردّد بعض أصدقائي ما كانوا يسمعونه من إعلام النّظام حول وجود عصابات مسلّحة تخرّب البلد، فبدأت بأخذ بعضهم معي للتظاهر. وكما تقول إحدى عبارات السيد المسيح الشهيرة: «تعال وانظر». اعتقدتُ أنّ النظرة المسبقة ستتغيّر لو جاء المظاهرات وحضرها أشخاص أكثر.
كانت المظاهرات رائعة، وكان يشارك فيها أبطال حقيقيون، هم أنفسهم لا يدركون مدى بطولتهم. أناس رائعون مستعدّون لخوض مخاطر كبيرة لمجرّد توزيع مناشير أو إسعاف أحدهم للمستشفى. قمتُ بأفعال متهوّرة لإنقاذ أشخاص لا أعرفهم؛ أفعال كادت تؤدّي إلى مقتلي. كنا واحداً، وعلى قلب واحد، نهتف للهدف نسفه.
كانت أمي تبكي في تلك الفترة من قلقها علي، كنت أريدها أن تتقبّل حقيقة أنّني قد أموت يوماً ما. كنت أرفض الشعور بالتميّز عن الباقين، فقد كان أهلي يفكّرون بإرسالي إلى أوروبا لحين انتهاء الثورة. فضّلتُ أن أُضرَب في الشارع مع الذين يُضرَبون وأن أُعتَقَل مع الذين يُعتَقَلون.
كنت أُستدعَى للتحقيق من الأمن أسبوعياً. أذهب للتحقيق في الصباح، وأخرج في المظاهرة مساءً. أصبح وجودي في المنزل خطراً، لذا صرت أنام في بيوت أصدقائي.
لم أعد أرى أمّي كثيراً. ذهبتُ للبيت يوماً في المساء، وكانت تستعد للذهاب إلى عرس، وفي طريق العودة أوقف أحد الحواجز السيّارة التي كانت تركبها، وحدث إطلاق نار. أُصِيبَتْ أمّي وتُوفّيت على الفور. هناك في المستشفى، أدركتُ أنّني لم أعد شخصاً طبيعياً. كانت أختي تبكي وأنا صامتة. لم أتمكّن من الحزن أو البكاء بشكل طبيعي. حتى أصدقائي المقرّبون جداً لم يأتوا إلى المستشفى خوفاً من أن يعتقلهم الأمن. الغريب أنّهم كانوا مؤيّدين للنّظام! كلّما اشتدّ خوفك اشتدّ ولاؤك.
كنت متأكّدة أنّ نشطاء الثورة حين يعلمون أنّ والدتي قتلها النظام سيعتبرونها شهيدة ويأتون لتقديم التعازي في الكنيسة. لم أرغب أن يحدث أيّ خلاف مع المصلّين، لذا اجتمعت مع النّشطاء وطلبت منهم أن يرتدي الجميع قمصاناً بيضاء، وأن يحملوا وروداً حمراء دون شعارات أو هتافات. أردنا أن نرسل رسالة سلمية يفهمها المسيحيّون، وفي الوقت نفسه أن نعكس سلميّة الثّورة نفسها.
طلبت منهم أن يثقوا بما أقول. فلو جاؤوا إلى الكنيسة وهتفوا بشعارات ثورية، سيخاف المصلّون في الداخل، وسيأتي الأمن ويضرب المتظاهرين، وسيتم تبرير ذلك بسهولة.
في النهاية، نفّذ النشطاء ما طلبت، وحضر العزاء ما يقارب 500 شخص. جاؤوا إلى الكنيسة بهدوء وسلام. كان هناك عناصر أمن بالطبع، لكنهم لم يتمكّنوا من فعل أيّ شيء لهم، لأنهم ببساطة مجرّد معزّين داخل كنيسة يحملون وروداً حمراء.
احترمتُ جداً رغبة الناشطين بأن يهتفوا بملء حناجرهم ضدّ بشّار الأسد، لكنهم لاحظوا انبهار الحاضرين بهم. كان المشهد رائعاً. قال لي أحد رجال الكنيسة: «ما نظّمتِه اليوم بشكل سلميّ مهمّ للغاية، بارك الله بكِ».
لم أدرك حينها مدى قوة تلك الرسالة في تلك الأوضاع. لقد امتلكتُ الشجاعة الكافية لأجعل من موت أمّي رسالة ثورية.