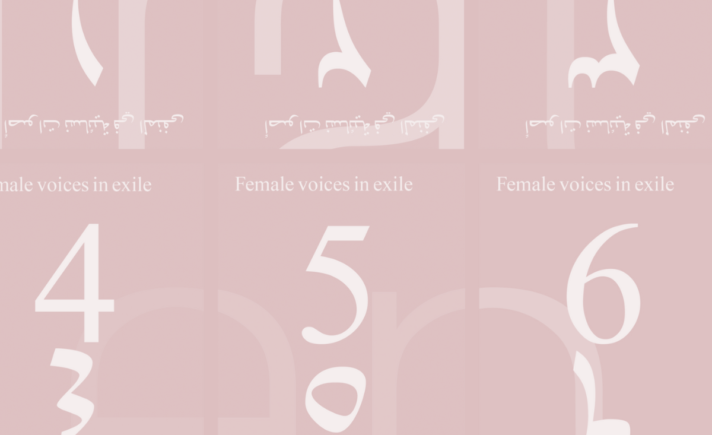ليس للكتابة بعد الثورة – المجزرة – الحرب أن تكون مثل الكتابة قبلها. فمن شأن ذلك أن يعني وضع الحدث المَهوْل بين قوسين، ضربٌ من فاصل مزعج يعود الكتّاب بعده إلى ما كانوا فيه أو عليه؛ أو أسوأ: وضع الكتابة ذاتها بين قوسين، خارج الحدث وخارج التاريخ. والأرجح أن هذا المسلك يصدر عن رفض أخذ علمٍ بذاتية الحدث وطاقته على المساءلة والتغيير. لا يتحتّم أن يأخذ رفضُ أخذ العلم هذا شكلَ إنكار الواقع، بل ربما نفيَ معنى الحدث، إنكار معقوليته، وصمه بالزيف، رفض أنه كان ثورة في أي وقت. في أحسن الأحوال يجري نفي تاريخية الحدث ومفصليّته استناداً إلى كلفته العالية وانقلاب وُعوده الباكرة على نفسها، وفي أسوئها هو إيثارٌ للسكون أو انحيازٌ إلى ما هو ميت من عيش وفكر سابق للثورة والحرب والموت العميم.
كما لا يتحتّم أن تكون الكتابة بعد اثني عشرية الهول كتابةً عن الثورة – الحرب – المجزرة حصراً، لكن لا بدّ لها أن تكون كتابة مسكونة، آهلة بالناس وقصصهم وسيرهم ومِحنهم وموتهم، وليست محصورة في مجرّدات لا تاريخية، تحوم من علٍ فوق رؤوس الأحياء. هذا لأنه لم يسبق أن كان تاريخ سورية آهلاً بالناس أكثر مما كان في الأعوام الاثني عشر الأخيرة، ولم تكن سورية متعددة الأصوات يوماً مثلما ظهرت بعد ربيع 2011، بل إلى اليوم رغم كل شيء. ليس في الكتابة المسكونة ما يمنع من التجريد والتفكير المفهومي والنظرية، بل لعل فرص النظر المجرّد والمفهومية في التجدد أكبر وأوسع عبر الكتابة العامرة بالبشر منها عبر كتابة خالية منهم، تحاكي في بُنيتها السياسة الخالية من الناس التي تمرّد عليها السوريون. التجريد الذي يُبنى على وفرة الملموس هو معرفةٌ تعي نفسها، فتصير ذاتاً، غير التجريد المستند إلى تجريد آخر، يستمد شرعيته من أب أو أصل ما.
الكتابة بعد المجزرة مدعوّة لأن تنظر في كامل طيف التجارب التي خبرناها خلال نحو اثني عشر عاماً، وهي تجارب قصوى، مُعمِّمة، تراجيدية، ليس في تاريخنا المعاصر ما يشابهها أو يقاربها. هذا ما يجعل الكتابة ثورية. الكتابة الثورية ليست الكتابة المتحمِّسة للثورة (التي أكلت نفسها وفشلت، وخسرنا المعركة على كل حال)، بل التي تشتبك مع ما جرى بكل ما فيه، تنظر في التفاصيل، وتعمل على إنتاج المعاني والمفاهيم من طيف التجارب الواسع، وتناضل من أجل حرية المخيلة.
الثورة السورية نفسها لم تكن طرفاً محدداً في صراع اجتماعي سياسي، بل كانت طيفاً واسعاً، متعدداً وبالغ التنوع، شيئاً يشبه سورية ذاتها. ومعلوم أن من المحسوبين عليها من ارتكبوا جرائم شنيعة، وأن بيئاتها تحملت الغرم الأعظم خلال ما ينوف على اثنتي عشر سنة من الصراع، وأنه ينتمي إلى طيفها حصراً أنبل أبطال الشعب السوري ومن تتمثل فيهم سورية حرة وعادلة. ثم إن الثورة- الطيف انتهت إلى أن تكون طيفاً، شبحاً هائماً بلا جسد، بعد أن كانت أكثر تجسداً وأقل طيفية في بداياتها. الجسد مات وتحلل، وإن لم يدفن (هناك متعيّشون يحرسون الجثة المتحللة). أما الطيف فلا يتحلل ولا يزول، ينتاب الذاكرات والمخيّلات طوال الوقت، وهو لا يكف عن التجلي حتى في الكتابة التي تنكر الحدث.
وإنما لذلك لا يمكن للكتابة بعد الثورة- المجزرة أن تكون مثل الكتابة قبلها. هناك شبحٌ لا يغيب، يطلب العودة، يبحث عن جسد، ولا يرتضي بأقل من كتابة مسكونة، جسدٌ من كلمات، بعد أن تعذّر أن تكون السياسة مسكونة بأجساد من لحم ودم وأمل، تجتمع وتتكلّم وتعترض. الكتابة المسكونة تحوز هنا معنى يضاف إلى الكتابة العامرة بالناس، معنى الكتابة المهجوسة بأرواح هائمة، بأطياف شبحية تظهر وتختفي، وهذا مثلما نتكلم على بيت مسكون أو مغارة مسكونة. الكتابة المسكونة مجنونة بصورة ما، متمردة، غير عاقلة، منفلتة من الرقابة، خارجة على القانون.
مسالك
يبدو اليوم أننا على مفترق مسالك كتابية.
ثمة مسلك أول تقدّم التلميح إليه، يتفرع من داخل ما يُفترض أنه الطريق الثوري الحقيقي، أعني التثبّت على لحظة الثورة، وهي لحظة انقضت سورياً في وقت ما، إن لم يكن في عام 2013 وظهور داعش واكتمال انهيار الإطار الوطني للصراع، ففي لحظة إعادة احتلال حلب أواخر 2016، وقت عاود الطيران الروسي وقاسم سليماني وأتباعه السيطرة على حلب الشرقية وتهجير سكانها. في مسار الصراع السوري خلال 12 عاماً ثمة أقنمة للثورة لم نعرف كيف نطوي صفحتها حتى بعد أن خسرنا وتشردنا. وبتصاعد انفصل الخطاب الثوري عما يجري في الواقع، مستمراً بهتاف يَلعن روح حافظ ويطلب رحيل بشار، حتى بعد أن رحل الهاتفون إلى بلدان قريبة وبعيدة. وراء ذلك دوافع نبيلة: الوفاء للشهداء والضحايا، أو إكراه نفسي: التجمد عند لحظة الرضة، الفقد أو التهجير أو التعذيب أو الاغتصاب…، مما هو مألوف في سيكولوجيا التروما. تحولت الثورة عند كثيرين منا من نِصاب العمل على تغيير الواقع (وقد فشل) إلى نصاب الهوية، تعريفٌ لأفراد ومجموعات في حالة إنكار لواقع لا يطاق. وكمقوّم للذات وتعريف لها يستمر خطاب «الثورة مستمرة» لأنه الآن مبدأ استمرار ومعنى للقائلين به، يخسرون معناهم من دونه. لكن بذلك يصير الكاتب تنويعة ثوروية لـ«المثقف الأهلي السوري» على ما وصفه حسام جزماتي، «عرضحالجي» الجماعة الأهلية، «السنية» غالباً في هذا المقام، يهتدي بِهداها ويغوي إن غوت. الثورويّة أو عبادة الثورة هي هنا عبادة للذات، لا شيء أكثر من نرجسية الجماعة الجريحة. ولا تعوض أي فاعلية سياسية عما يعرضه مؤقنَمو الثورة السوريين من تحجر ثقافي يظهر في شكل «نصوص أصالوية تعتمد على المعاينة الشخصية الموضعية والانطباعية والتزيين اللغوي» بحسب جزماتي. وهو ما يغري بالقول إن الخصلة الأكثر ثورية للثائرين هي القدرة على إعلان نهاية ثورتهم، إعلان نهاية «حالة الطوارئ» النفسية والسياسية التي مثلتها الثورة، والتحول نحو سبل مغايرة من أجل الاستمرار في الكفاح.
ويقود مسلك ثان إلى كتابة من لا مكان أو لا موقع، هي بطبيعة الحال بلا بشر كذلك، بلا حساسية مميزة وذاكرة مختلفة ومخيلة مغايرة. وإغراء اللاموقعية أقوى في شرط «خارج المكان»، الذي هو «المنفى». ويغلب أن تأخذ شكل الاندراج في نقاشات البلدان التي ننتشر فيها اليوم، مع افتراض كونية ناجزة لما يُثار هنا من قضايا ولمن يثيرونها وكيفيات إثارتها. فهي بذلك عودة إلى أفكار كانت رائجة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، إن في صورة ماركسية أو تنويرية، حين كان يفترض أن «الكونية» توجد في شكل «علم» أو فكر تقدمي أو نظرية في التاريخ، أو «عقلانية»، لا في شكل تفاعلي متعدد الأصوات ومفتوح للغائبين أو مكتومي الصوت.
ويتفرع من «المْصَلّبة» (تقاطع أربع شوارع، تعبير شائع في حلب) الكتابية مسلك ثالث، ارتدادي يقود عوداً إلى إيديولوجية غثة كانت مزدهرة قبل الثورة السورية، وتعود بأشكال مواربة إلى الازدهار بعد الموجة الإسلامية اللاحقة للثورات. أعني الثقافوية التي كانت تشخّص مشكلتنا في رأس معطوب، وليس في «الكرسي» (أدونيس) أو «صندوق رأس» (جورج طرابيشي) مضروب، بسبب محتواه الديني، فلا تحل المشكل بـ«صندوق الاقتراع». في المثالين يغيب النظر في الجسم وبنيته ومعيشته وعلاقاته وتجاربه، فتحكم الثقافوية على نفسها بأن تكون مذهباً اختزالياً مثلما كانت الاقتصادوية حتى سبعينيات القرن العشرين وبعده، ولكن مع وظيفة تبريرية سياسياً، ودون أي حس جدلي معرفياً. الكاتبان لا يحيلان إلى أحد ولا يقتبسان من أحد، ولا يقدمان أمثلة ويناقشانها.
وللاموقعية نسخة إسلامية، تصادر على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فلا يعنيها أي زمان أو مكان، فلا تعيش في زماننا هذا في أي مكان محدد بغير عنف بلا حدود. تبدو الإسلامية المعاصرة لا أرضية، «منفية» ولا موقعية في كل مكان، ضرب من رومنسية جهادية مترحّلة وجوّابة آفاق على نحو أسس لظاهرة المجاهدين الجوالين الذي لا عمل لهم غير الجهاد، وقد كانوا كارثة نكراء حيثما حلوا.
وبالمثل للثقافوية نسخة إسلامية، شعارها الصريح أو الضمني هو «الإسلام هو الحل»، وتأويله أن ترؤس الإسلاميين هو الحل، فلا يهم بعد ذلك حال الجسم الاجتماعي الذي يراد ترؤسه، اللهم إلا أن يكون مطيعاً مطواعاً. وفيّة للاتاريخيتها المتأصلة، تعتقد الثقافوية الإسلامية أن ما بعد داعش (وقد كان هذا الوحش البهيم جزءاً من الحدث الكبير ومن أسئلته التي ستبقى مفتوحة لزمن طويل) يمكن أن يكون استمراراً بسيطاً لما قبله، وأنه يمكن المضي إلى ما لا نهاية في مونولوج مديح النفس النرجسي ومظلومية الشكوى من العالم.
الكتابة المسكونة والإنسانيات والديمقراطية
هناك مسلك رابع، بديل: الكتابة المسكونة ذاتها، المفتوحة على التجارب الحية، والمتمرّسة بالمناهج التي تطورت لتمثيل دخول الناس إلى التاريخ وسكناهم في سياسة بلدانهم. أعني مناهج الإنسانيات، من الفلسفة والتاريخ والعلوم الاجتماعية. الإنسانيات هي الثقافة الديمقراطية، من حيث إن ميلادها وتطوّرها قرين السياسة المسكونة، العامرة بالبشر. وبقدر ما إن السياسة المسكونة هي الديمقراطية، فإن الكتابة المسكونة وجهٌ أساسيٌّ لثقافة الديمقراطية. الكتابة غير المسكونة لا يمكن أن تكون ديمقراطية بالمقابل. ورغم ما يبدو من إخراج الناس في سورية، وغيرها من البلدان العربية التي مرت بتجربة الثورات، من التاريخ الذي ناضلوا للدخول فيه، فإن هذا المسعى لا يمكن أن ينجح ويستقر. ورغم كل شيء فهو لم ينجح في سورية التي تعرض مجتمعها لتحطيم مهول، لكن التي لم يعرف سكانها دخولاً في السياسة والتاريخ منذ نشوئها قبل قرن ونيف أكثر مما خلال اثني عشرية الهول، وإلى اليوم. وإنما لذلك يتعين تمثيل ذاك الدخول بالأدوات الأنسب التي تتكلم عليه في شروطهم الاجتماعية التاريخية والعالمية، بأجسادهم ونفوسهم، بكونهم حملة ذاكرات ومخيلات متشكلة تاريخياً ومتغيرة تاريخياً، بمواقعهم في إنتاج الحياة وإنتاج الخيرات وإنتاج السياسة وإنتاج المعنى، بمشاعرهم وانفعالاتهم، ببُناهم الأنثروبولوجية وسبل تعاملهم مع المفاجئ وغير المسبوق. من شأن التقدم في ذلك أن يكون امتلاكاً رمزياً للبلد الذي فقدنا ملكيته إلى حين.
هذا بديل من تحت، مفتوح على الملاحظة والتجربة والبحث المنظم كثيراً أو قليلاً، فضلاً عن استنفار الذاكرة والمخيلة، وليس بديلاً من فوق في صورة إيديولوجية ناجزة أو أبوة أخرى. وهو بديل متواضع، يوظف التجريب والأخطاء والتعلم، لكنه مثمر على مدى أطول. وهو بعد ذلك يحول فكرة الثقافة الديمقراطية باتجاه اجتماعي تحرري لتكون وعياً بالصراع من أجل الحرية والحقوق والمواطنة من قبل البشر العيانيين، بعيداً عن اشتراط ثقافي، بل إيديولوجي، على الديمقراطية هو في الواقع اشتراطٌ على حريات عموم الناس وحقوقهم (عينة مثلى على ذلك، كتاب جورج طرابيشي «ثقافة الديمقراطية»، وهو مثال للكتابة غير المسكونة: لا يرد فيها مثالٌ واحدٌ يحيل إلى تجارب وخبرات مناضلين من أجل الديمقراطية في سورية أو غيرها).
والواقع أن هذا البرنامج ليس ثورياً إلا بالمقارنة مع خواء الثقافوية بصورتَيها، ومع اللاموقعية بصورتَيها كذلك، وكذلك مع الثورانية أو أقنمة الثورة.
في غير هذا الإطار، برنامج الكتابة المسكونة – الإنسانيات هذا، أو «الثقافة الديمقراطية»، هو بالكاد «برنامج ديمقراطي»، منفتح على تمثيل الناس المختلفين لأنفسهم، بمن فيهم قريبون من مسوغي الفاشيَتين: فاشية ربطة العنق وفاشية اللحية الكثة. نقد الثقافوية واللاموقعية والثورانية هو المدخل الأنسب للإنسانيات، وحدث الثورة- الحرب- المجزرة هو مرجعيتها الأغنى.
عُسر كتابي
ثمة مشكلة عملية يتعين الوقوف عندها عند الكلام عن الإنسانيات و«الثقافة الديمقراطية». كلاجئين خارج بلدنا، نحن نعيش في المؤقت، وفي الزمان أكثر من المكان وأوضاعه وعلاقاته. وهذا مدخلٌ إلى عسر كتابي، يبدو الكتّاب القدماء نسبياً، ومنهم كاتب هذه السطور، معرضين لمعاناته أكثر من غيرهم، أعني أن نتكلم على عالم لم يعد موجوداً، على سورية قديمة وسوريين قدامى دون شبه بسورية والسوريين اليوم. كانت تجاربنا المباشرة ترفد كتابتنا حين كنا في البلد، فتُبث فيها حساً بالواقع، وليس الحال كذلك اليوم. نتابع تفاصيل الشأن السوري بقدر المستطاع، إلا أن المتابعة لا تُغني عن المعايشة المباشرة. وفي هذا ما يؤرق من يتطلع إلى أن تتزامن تجاربه الحية وأدواته التحليلية في ما يكتب.
لكن عدا أن الأمر يتعلق بعدة سوريات، منها سورية الخارجة، نحو 30 بالمئة من السوريين متناثرين في نحو 127 بلداً في العقد الأخير، وعدا أنه ليس ثمة موقع واحد يتيح إحاطة وافية مبدئياً بسورية التي هي اليوم عنوان لشتات، فإن هذه صعوبة عملية، من صنف ما يواجه المشتغلين بالإنسانيات من ملاءمة ما يقدمون من تحليلات ونظريات لإطار الإحالة الواقعي الخاص بهم، وليست مسلكاً كتابياً عقيماً أو ارتدادياً مثل الثقافوية (وهي من النقائض التامة للثقافة الديمقراطية) واللاموقعية والثورانية أو عبادة الثورة. لسنا أول لاجئين خارج بلدهم يعملون في حقول الفكر والفن والثقافة، يستمرون في الصراع التحرري بطرق أخرى، مع كل ما قد يَسِم ذلك من أوجه قصور ونقص.
الطيف وطائر الصدى
التضحية الهائلة خلال السنوات المُنقضية مؤهلة لأن تؤسس لتحول فكري وثقافي، يأخذ علماً بها ويتلبّث عندها ويفكر فيها كمنعطف لشيء مختلف، شيء لا يقع بالقطع في الماضي، وإن كنا لا نستطيع أن نَعرِف اليوم خط السير نحو مستقبل مختلف. نَعرِف أن لدينا نقطة انطلاق مرجعية رئيسية، مركز نتوجه منه ولا نبقى حتماً فيه: اثنا عشرية الهول، الثورة – المجزرة – الحرب.
ولا يبدو على كل حال أن هناك جدال في أساسية هذا المنطلق. التقابل الكتابي الرئيس، اليوم، لا يقوم بين من ينطلقون من هذا الأساس وبين من لا يرونه غير فاصل مزعج أو غير معقول، فالجميع ينطلقون منه بصور مختلفة. التقابل الكتابي يقوم بالأحرى بين من لا يكفّون عن إدانته وتحقيره ونفي المعنى عنه مثل أدونيس (وهو مستمر في اجترار تفكير قروسطي يشتق التاريخ المتحول من الماهيات الثابتة، وينتحل جذرية شكلية مثابرة على لوم الضحايا وإعفاء القتلة)، وبين من لا يكفّون عن الإحالة إلى هذا الحدث والنظر في ثناياه وطياته، ومساءلة أنفسهم ومجتمعهم وزمنهم وعالمهم بينما يفعلون ذلك. في المسلك الأخير من الطاقة على تجاوز أقنمة الثورة أكثر بكثير مما في الأول الذي يجعل من الحدث أقنوماً مضاداً، كُفراً آخر، فينكرون عليه المعنى كلياً مثلما ينكر الجهاديون المعنى على العالم (وعلى الثورة كذلك، بالمناسبة).
والقصد في المحصلة أن تماثل الكتابة بعد المجزرة بالكتابة قبلها ممتنع أو غير ممكن قبل أن يكون غير مرغوب.
وعلى أرضية امتناع التماثل، تريد هذه الفقرة الختامية أن تُقرِّب بين الشبح- طيف الثورة الهائم الذي يسكن الذاكرات والمخيلات وبين صيغة مُحوَّرة لأسطورة طائر الصدى العربية القديمة. تقول الأسطورة إنه يخرج من جسد القتيل طائر اسمه الصدى، لا يكف عن الصراخ طالباً الثأر، ولا يتوقف صراخه حتى يشرب من دم القاتل. وهناك من يقول إن هذه الطائر هو البوم، وهو ما يعطي وجاهة، إن صح، لرمزية الشؤم والخراب التي يحملها هذا الطائر في ثقافتنا. على أنه يمكن تأويل الأسطورة باتجاه أن يكون الصدى سعياً وراء صوت، وروحاً تبحث عن جسد. يدعو الطائر الذي لا يكف عن مراودة ذكريات الأحياء ومخيّلاتهم لأن نكون صوته، لأن نترجم صراخه وننقله إلى كلمات مكتوبة. وما يشجع على تحوير القصة بهذه الصورة الحرة هو أنه ليس ثمة ثأر ممكن لمن قُتلوا، وللثورة المقتولة. أقله لأن القتلة ليسوا طرفاً واحداً. لقد توزع دم الثائرين السوريين والثورة السورية بين القبائل (والأديان والدول). وفي هذا ما يجعل الثأر ممتنعاً، لكنه لا يلغي حلم الثورة والتغيير الجذري.
المسكونون بالصدى، بالطيف الهائم، يترجمونه كتابة إلى معان تحيا. وهذا إلى حين تترجم المعاني إلى واقع مغاير، ويعثر الطيف الهائم على جسد حي فتيٍّ من جديد، إلى حين ثورة جديدة. ويبقى لغير المسكونين أن يبقوا على السكون على ما كان وما مات.