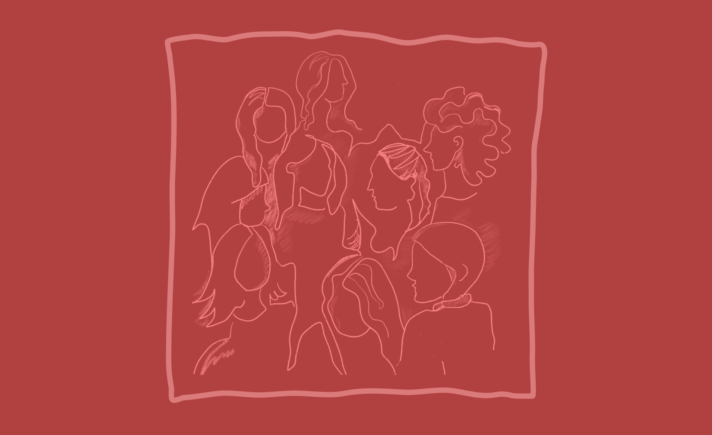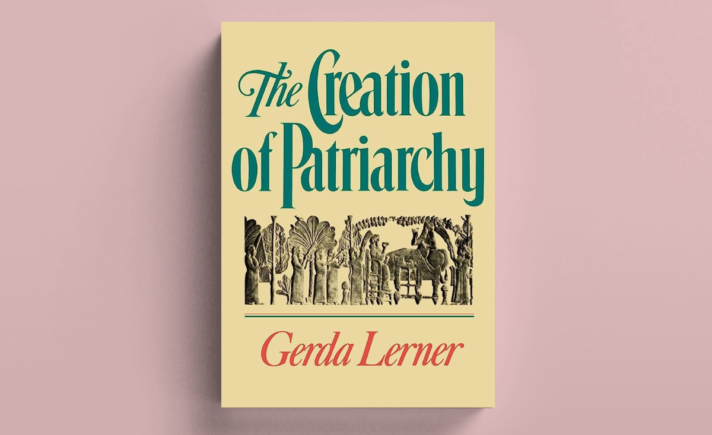عندما تمّت دعوتي للكتابة في هذا الملف، فكّرت بمقالٍ عن السرد الذاتي، والسرد النسوي، وأهميته في تفكيك وتحليل الخطابات الذكورية، وإعادة فهم ذواتنا من وجهة نظر نسوية، وحاجتنا إلى زيادة الاهتمام به في الصحافة العربية البديلة. أردتُ أن أناقش من خلاله الأسباب التي تجعلنا كنساء خائفات ومترددات في الكتابة عن قصصنا، خاصة تلك المرتبطة بالبوح ذاتي، أو التي تتناول مواضيع حساسة كالتحرش، الاغتصاب، التمييز الجندري، العدالة الجنسانية، الهويات الجنسية، الإسكات أو التكميم، التضامن النسوي، والحريات الشخصية وغيرها من القضايا.
عندما بدأت بالكتابة، وجدت نفسي أغوص في فكرة «تحقيق العدالة من عدمه»، كأحد أهم الأسباب التي تجعلنا نتردد ونسأل أنفسنا عن الجدوى من المكاشفة العلنية؛ إذا لم يكن الخروج إلى العلن قادراً على تحقيق العدالة لقضيتنا، فلماذا نُكاشف؟ وأعود للتفكير بسؤالٍ آخر عن التضامن وأدواته التي تتبناها النسويات/ين، وهل ما تقدمه مجتمعات التضامن من دعم، كافٍ للوقوف في وجه الانتهاكات؟
قرّرت في النهاية أن أكتب عن تجربة شخصية، ومواجهة قاسية خضتها مع الخطاب الذكوري، والأثر العميق الذي ترَكَته في ذاتي رغم اعتقادي سابقاً أني محصنة، وقادرة على مقاومة أشكال مختلفة من الانتهاكات.
وقبل أن أغرقكم-ن في تفاصيل قصتي، (التي أعتبر سردها اليوم حقاً وردَّ اعتبارٍ لمكانتي المهنية، دون أن تتطلع إلى تحقيق العدالة القانونية بسبب مرور سنوات عليها)، أريد أن أقول إن سردياتنا لا تسقط بالتقادم، وأنه لا يوجد توقيت مثالي لخروجنا إلى العلن، وإنما يكفي أن تشعر الواحدة منا بأنها جاهزة ومستعدة، وأنها اليوم، تريد أن يسمع العالم ما تريد قوله، دون أن يتم إسكاتها وتكميمها، أو إعادة وضعها في قوقعة الضحية المهزومة والضعيفة، لأن معنى خروجنا إلى العلن هو عكس هذا كله. هو شِفاء، ومحاولة للوقوف على قدمين ثابتتين.
توضيح لا بد منه
عندما بدأت ثورات الربيع العربي، كنت أبلغ من العمر 28 عاماً، امرأة مستقلة مادياً واجتماعياً، لديّ صراعاتي وتجاربي فيما يتعلق بحرياتي الشخصية وعلاقاتي مع العائلة والمجتمع وعاداته وتقاليده، والتي جعلتني أمرُّ بعواصفَ من مجابهاتٍ لم تكن سهلةً ابداً. أؤمن بحرية النساء وأدافع عنها رغم عدم امتلاكي أيّة معرفة نسوية نظرية حينها.
في الحقيقة، لم يكن مصطلح «النسوية» موجوداً ضمن نشاطاتي السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، على الرغم من أني أنتمي لوسطٍ ثقافي ليبرالي داعم لقضايا النساء وحقوقهن، وسطٌ نشَط بشكل جيد في مدينة حلب وبعدها في دمشق. لا أنفي هنا وجود النسوية السورية قبل ثورات الربيع العربي طبعاً، لكني أريد القول إن النسوية لم تكن حاضرة في نقاشاتنا، بينما اخترق اليوم مصطلح النسوية المجتمعات السورية باختلافها، وباتت الكثيرات والكثيرون يتبنونه في الخطاب والسلوك، كما أنه مصطلحٌ يُشكل حالةً جدلية، ويخلق مواجهات مستمرة مع سلطات الأمر الواقع على اختلافاتها السياسية والإيديولوجية.
خلال السبع سنوات الأخيرة، بدأتُ الاهتمام بالنسوية ونظرياتها وفلسفاتها وأدواتها وتجاربها، وبَنيتُ معرفةً عن الأنظمة الأبوية والذكورية وخطاباتها، وعن الأدوار الجندرية وتوزيعها، بالإضافة إلى العدالة الجنسية والجندرية. أعدتُ النظر في الكثير من المواقف التي اختبرتها من منظورٍ نسوي هذه المرّة، لأفهم ذاتي والطريقة التي تشكّّلْتُ بها سياسياً واجتماعياً وثقافياً. ذهبتُ بعيداً إلى تجارب في الطفولة والمراهقة والشباب، إلى سيرتي وتاريخي، نضالاتي من أجل حريتي الشخصية، وجود الرجال والنساء بحياتي، وشكله، منذ كنت طفلة إلى اليوم، ورحتُ أفكّك وأحلل كل تجاربي. بدأتُ أفهم السلطة والقوة والامتيازات والإقصاء والتهميش في توزيع الأدوار الجندرية، وأن علاقتنا مع أجسادنا تعرضت حتى للترويض والتبعية. أدركت أيضاً أن النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني مبنيٌّ من وجهة نظرٍ ذكورية وسلطوية أبوية، وأن لهذه الأنظمة أدواتها وخطاباتها ومؤسساتها ورجالها، وأنها ترفض تغيير هذا الواقع، وتعمل جاهدة على ألّا يتم المساس بكل مكاسبها وامتيازاتها المُسلَّم بها منذ قرون.
كيف ساعدتني النسوية على الوقوف مجدداً
في نهاية عام 2014، تعرضْتُ لتجربة إقصاءٍ وتكميمٍ مهني، جعلتني أنطوي بعيداً عن الشأن العام، بعد أن تم فصلي من المؤسسة الإعلامية التي كنت أعمل بها كمراسلة ومقدمة برامج بطريقة تعسفية وغير قانونية، وعندما تحدثتُ للعلن عن هذا الفصل التعسفي الذي طالني مع زملاء آخرين، أصدرت المؤسسة بياناً يحتوي على تُّهمٍ خُصّص لها ثلاثة عشر سطراً من معلوماتٍ مضللة وكاذبة، استُهدفَتْ بها مهنيتي وكفاءتي والتزامي بالعمل. على الرغم من أن المؤسسة لم يسبق لها أن وجهت لي أي انتقادِ مهني من قبل، ولم ترفض أي عملٍ صحفي قدمته، وكانت تقوم بنشر جميع موادي عبر قنواتها.
استمرّت المضايقات وتلفيق التهم وتشويه السمعة من قبل المؤسسة، وبعض الموظفين الذين يريدون تثبيت مواقعهم وولائهم على ظهر هذه القضية، دون قدرتي على تحقيق أي نوعٍ من العدالة أو ردّ الاعتبار، إذ كانت المواجهة أكبر وأقوى مني، حيث كنت أنا، وعددٌ قليلٌ من المتضامنات والمتضامنين، في مواجهة مؤسسة إعلامية ضخمة تمتلك تلفزيون وراديو ومواقع تواصل اجتماعي يتابعها الملايين، بالإضافة الى تعقيدات وجودنا كسوريات/ين في تركيا حيث لا نملك أيّة حقوقٍ أو حمايةٍ قانونية، وبسبب عدم قدرتي المادية على خوض معركة قانونية، وهو أمرٌ تدركه المؤسسة تماماً.
استطاعت المؤسسة تغيير سياق قضيتي، وتشويه الحقيقة، والتلاعب بمصيري وسمعتي المهنية، وتثبيت سرديتها مقابل سرديتي، وأجبرتني على التراجع والانسحاب، وأفقدتني الثقة بنفسي وقدرتي على الإنجاز، ودفعتني إلى الضياع في سؤال البحث عن معنى جديد، دخلت من خلاله في دواماتٍ من الغضب والقلق والإحساس بالفشل.
عشت بعد هذه التجربة حالة قاسية جداً، اختبرت فيها مشاعر عميقة من عدم الثقة بالنفس والنظر إلى نفسي على أني إنسانة فاشلة وغير قادرة على الإنجاز، دون أن أربط هذه المشاعر بقضيتي مع المؤسسة وما نتج عنها، خاصةً البيان وخطابه وأثره على ذاتي ونظرتي تجاهها. بقيَتْ هذه المشاعر تزداد عمقاً وتؤثر على كل حياتي، خاصة أنها ترافقت مع فترة خروجي من تركيا لاجئة الى فرنسا، ومواجهة واقع جديد فَرَضَ عليَّ التعامل مع صراعات جديدة حول الاندماج والمجتمع والجدوى والخسارة والعجز والبدايات الجديدة، وكل ما حملناه معنا نحن السوريات/ين الخاسرات/ين في معركة الحلم بواقع جديد، التي بدأناها مع الثورة السورية.
استمر هذا التكسير لذاتي ينهشني من الداخل، ويجعلني هشّة لفترة طويلة من الزمن، لم أجرؤ خلالها على التقدُّم للحصول على وظائف أعرف جيداً أنني أستطيع القيام بها، مقتنعة تماماً أني لا أصلح إلا لأعمالٍ لا تحتاج مهارات أبداً، ولم أستطع تحديد شغف جديد، ولم أعد أجرؤ على التعريف عن نفسي حتى بصيغة صحفية سابقة. ففي تلك الفترة كنتُ في حالة «عمى نسوي» إن صح التعبير، ولم أكن أرى الأشياء في بُعدها الذكوري والأبوي، ولم تكن مفاهيم الإسكات والتكميم والإقصاء في الخطابات الذكورية وتداخلها مع مفهومَي السلطة والقوة قد تبلورت بشكل واضح في ثقافتي ومعرفتي.
كانت نجاتي من هذا كله قد بدأت تدريجياً عبر اهتمامي بالنسوية ونضالاتها، والغوص في مفاهيمها ومحاولة فهم ما قالته عن الخطابات الذكورية، وأدواتها المتغلغلة في المجتمعات والمؤسسات، وكل تفاصيل حياتنا وما يرتبط بها، سواء كنا نساءً أو رجالاً أو غيرهم. منذ فترة وأنا أحاول إعادة التفكير بكل شيء وتفكيكه وتحليله من منظورٍ نسوي، وكان لا بد لي من إعادة قراءة هذه التجربة، وإعادة قراءة البيان والمصطلحات المستخدمة فيه، كي أستطيع فهم ما الذي جرى، وكيف يمكن استخدام مراكز القوة والسيطرة بخطابٍ وأدوات ذكورية، ليتمّ من خلالها الإسكات والتكميم والإقصاء وإيقاع الظلم على الآخرين دون الخوف من الحساب، بالإضافة إلى فهم عجزي عن تحقيق العدالة لقضيتي رغم امتلاكي كل ما يثبت الظلم الواقع علَيّ.
كما استطعت فهم الظلم الذي وقع على زملائي الأخرين في الحادثة نفسها، لأني اليوم أدرك أيضاً، أكثر من أي وقت مضى، أن أدوات القمع والإسكات والتمييز وانتهاك الحقوق، في الثقافة الذكورية وأماكن قوتها وسلطتها، لا توجه طاقاتها فقط ضد النساء، بل يتضرر منها الجميع بغض النظر عن هوياتهم الجنسية والجنسانية.
مجتمعات التضامن
عندما قررتُ الخروج إلى العلن وفضح سلوك المؤسسة التعسفي وقتها، لم أكن حقيقةً متأكدة من أنني سأتلقّى كل التضامن الذي حصلت عليه، لقد استمديت قوتي من المتضامنات/ين في كل مرة حاولَتْ فيها المؤسسة والموالون لها تشويه سمعتي الشخصية والمهنية، هذا الشعور في الحقيقة أهمّ ما جعلني متماسكة في ذاك الوقت.
لكن بعد مرور هذا الوقت، وعندما بدأت إعادة التفكير في هذا الموضوع، بدا التضامنُ الذي حصلت عليه لدعم قضيتي قوياً بالمعنى النفسي والإنساني، إلا أنه كان هشاً بأدواته وقدرته على مساعدتي لتحقيق العدالة لقضيتي. لا أعني بذلك أن التضامن يجب أن يكون مشروطاً بتحقيق العدالة، لأنني أدرك اليوم أن التضامن النسوي بشكلٍ خاص له معانيه المختلفة عن أشكال التضامن الأخرى، وأنه ليس لدعم امرأة قررت أن تقول ما تريد فقط، بل يذهب لأبعد من ذلك بكثير. وأن حالة الاحتفاء التي تعبر عنها النساء والنسويات/ين في تضامنهن، تجسد فكرة أن كل امرأة تكشف أي انتهاك أو تمييز على أساس الجندر، فهي تكشف تقاطع قصتها مع الآلاف وربما الملايين، من الأخريات اللواتي خضن نفس التجربة ولم يجرؤن على الخروج للعلن، أو أخريات ممن لم يمتلكنَ الأدوات والمعرفة النسوية اللازمة حتى يستطعنَ إدراك شكل الظلم الواقع عليهن. فعندما نبوح بسردياتنا ونعلن عن الظلم الواقع علينا، مهما كانت دوافعه وأدواته، فنحن نبحث عن «رد الاعتبار لذواتنا» ونبحث عن تضامن يحتفي بجرأتنا ويبني عليها قضية قد تمس الكثيرات/ين غيرنا.
إن واقع التضامن النسوي السوري والعربي اليوم يسعى إلى امتلاك أدواته ويطورها ويبني عليها، إلا أنه يحتاج لذراع قانونية تجعل من التضامن قوة قادرة على تحقيق العدالة، أو على تهيئة الطريق لها على الأقل، خاصة في ظل قوانين ذكورية منحازة وغير منصفة. فلو أُتيحت لي الفرصة في ذلك الوقت لخوض معركة قانونية، وقُدّم لي الدعم القانوني اللازم، كان لقصتي أن تنتهي نهاية مختلفة تماماً.
في النهاية، أؤمن اليوم أكثر من أي وقت مضى أن مفهوم العدالة الجندرية سيبقى الهاجس الأكبر الذي يجب أن نسعى اليه كنسويات، إلا أننا أحياناً نحتاج لأن نُثَّبت سرديتنا في الفضاء العام، وندافع عنها بوجه أي منتهك يمتلك القوة والقدرة على تقويضها أو تغييرها أو التلاعب بها بهدف دفعنا للتراجع والاستسلام لدور «ضحية» لا حول لها ولا قوة. كما أؤمن إن إعادة قراءة واقعنا والتجارب التي اختبرناها ونختبرها من منظور نسوي، تجعلنا قادرات/ين على تفكيك وتحليل الخطابات الذكورية والأبوية، والذهاب إلى العمق الذي استُعملت فيه أدواتها وامتيازاتها في كل تفاصيل حياتنا، حتى ساهمت في تشكيل ذواتنا وهوياتنا والطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا بغض النظر عن جنسنا وجنسانيتنا.