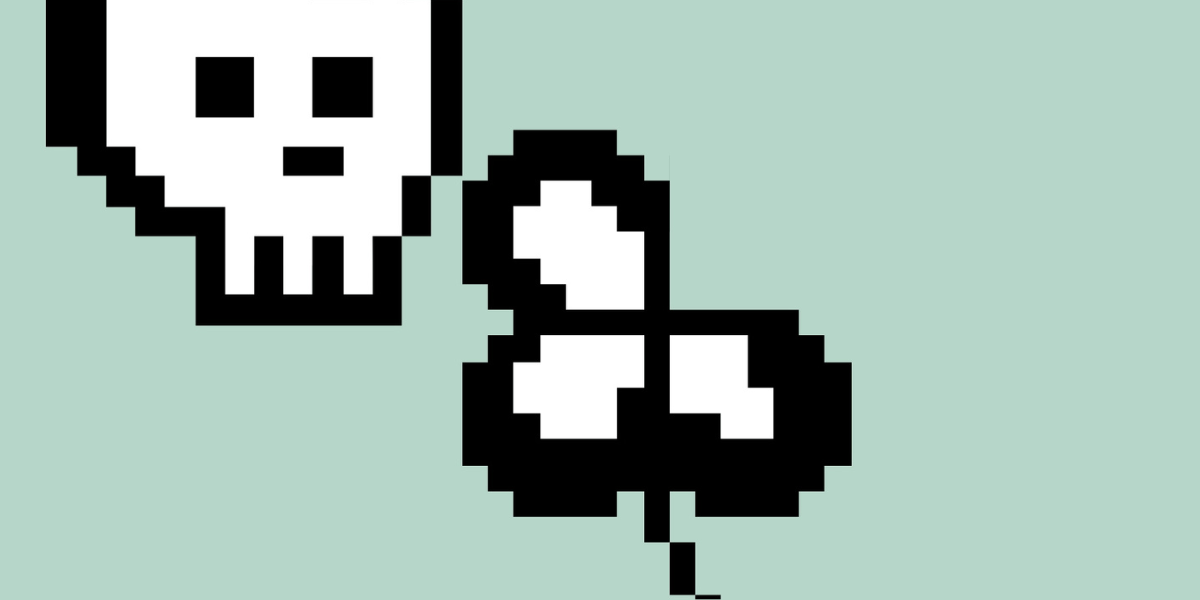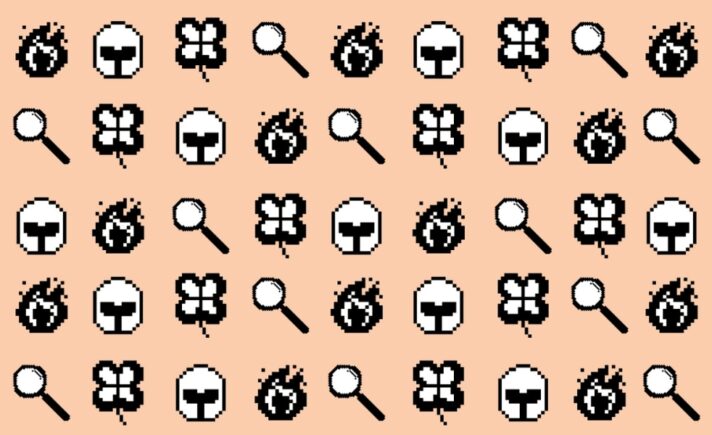إلى سارة حجازي ومحمد أبو الغيط وعلاء عبد الفتاح، أصحاب القلوب العامرة بالحب رغم الألم الطافح
لم أكن أتوقع أن أتلقى ضربة بهذا العنف على كتفي لأنني أَسدُّ الشارع عن غير قصد. السيدة البيضاء التي عبرت لم تلفت انتباهي بلطف إلى أنني أَسدُّ الرصيف الضيق. كنت سأعتذر وأفسح الطريق وأُغير مكان وقوفي لو فَعَلتْ. لكنها لكمتني بقوة على كتفي مُتابِعةً طريقها وهي تدمدم أنني أَسدُّ الطريق وأنني أحمق. اللكمة المفاجئة أخفت الابتسامة التي كانت على وجهي. لا أعرف المدة التي قضيتها عاقداً جفني بعد الحادثة مغموراً بمشاعر الضيق. كان الحدث صغيراً، ولكنني لم أستطع تجاهله وإكمال حديثي. الإحساس المفاجئ بالخطر والاستنفار عزلني عن العالم مؤقتاً، فأحدُنا لا يتلقى لكمة كهذه كل يوم يمكن لها أن تفتح باب الذاكرة على لكمات وصفعات ومشاعر قهر وانسحاق نائمة في الجينات. لم تهدأ الأفكار المتزاحمة في رأسي إلا بعد أن وضعت صديقتي يدها على كتفي وذكرتني بالسياق المحدود لما جرى. هذا الحدث التافه والعابر ليس مهماً. المهم هو المشاعر المتناقضة التي استثارتها كل من اليد اللّاكمة واليد المهدئة للروع. ما سأحاول التفكير فيه وتأمله في هذا المقال هو مشاعرنا المعقدة، ومن ضمنها الحبّ وأثر حضوره وغيابه على حيواتنا وأَمزجتنا في هذا العالم العاصف.
تتمحور حول ثيمة الحب معظم الأعمال الفنية والأدبية الإنسانية. يَمثُل كقيمة عليا ومطلقة في خلفية كل فعل وحركة وسكنة للإنسان. نبحث عنه على الدوام ونقتاد بطيفه في كل تفاصيل حياتنا. لا نستطيع العيش بدونه. نتقفّى أثره في العيون والكلمات. يكاد يكون كل شيء. وحين يغيب وتحل محله الإساءة والإهمال والوحدة، ترى وحوشاً تضرب بقسوة وتحطم ذواتها ومحيطها. يستعصي الحب كأُحجية غير قابلة للحل. يستثير الدمع حين يحضر ويكشف الخدوش الغائرة. ننكشف عليه فنصبح في غاية الهشاشة والضعف، لكننا نستلّ ومضة من بريقه لنصمد ونشتدّ في أكثر المعارك ضراوة ودموية. ننهار في حضرته، ونشفّ أمام الرقّة الغامرة لوردة مُندّاة أو طفل نائم بهناء، ونصبح به أشداء وخارقين للطبيعة في لحظات البأس. للحبّ صور وتجليات كثيرة، وربما كان الحديث عنه أسهل لو لم يكن عالقاً في معادل بصري مُسِخَ فيه ليصبح مُقتصراً على علاقة أحادية مُغايرة تنتهي بقبلة على السفح الغارب في الفيلم الهوليوودي. في الحديث عن الحب، لا أقصد الحب الرومانسي العالق في المخيال كعلاقة بين رجل وامرأة في الغالب، بل أتحدث عن كل تفاعل عاطفي حميمي عميق مع الأشخاص والأشياء؛ التفاعل الذي يُتاح فيه للمشاعر أن تتحرك وتسري وتهزّ الكيان، في مقابل التبلُّد الذي نضطر إلى اللجوء إليه كوسيلة دفاعية.
قد يدوخ من يحاول فهم شيء كالحب، ففيه الكثير من التناقضات والتشابك، هو من أكثر المشاعر تعقيداً في الذات البشرية، ولا نعرف كيف يُستثار ويخبو ويستبد ويتسرب من بين الشقوق. يقول العلم إن مشاعر الحب مقترنة بهرمون الأوكسيتوسين الذي يدغدغ الجوف حين يتدفق في الدم. ولكن لا يُمكن فهم الحب دون العبور بالجنسانية والهوية واللجوء إلى المجاز والتجريد.
نحاول فهم الحب بسبب جماله وفظاعته العَصيّان على الوصف. من يعيشون الحب يتألقون ويشعّون، ولكنهم يُقرّون ضمنياً بالألم الذي عَرَّضوا أنفسهم له: القطة التي نعيش معها ستموت. الشركاء والأولاد سيسافرون و يتغيرون. الحصول على بهجة الحب وألقه وشغفه يعني قبول الأشواك العالقة في ثوبه. يقدم لنا الحب ما تقدمه الحياة: بهاءُ القبلة على الجبين، وفظاعةُ الطعنة في الخاصرة.
تخفيف هيبة الفزّاعة
يصعب على من يرغب بتعريف الحب عدم ربطه بالأمان والألفة. يتجسد حب الأم لطفلها، القادم إلى هذا العالم بلا حوْل، بالحماية من الأذى وتوفير الأمان الجسدي والنفسي والعاطفي. من يفتقد لهذا الأمان المؤسِّس في سنينه الأولى سيقضي بقية حياته محاولاً إيجاده لدى الآخرين، وسيُعاني حين يحاول إيجاد هذا الأمان في ذاته. يحصل الطفلـ/ة على هذا الحب عن طريق التواصل الفيزيائي والكلامي بالمقام الأول. ومع غياب الحصانة التي يخلقها حبّ كهذا، يتضاعف التأثّر السلبي بالصدمات وتحديات الحياة؛ حتى لدغة البعوضة تصبح أكثر ألماً. القرد الرضيع، الذي وضع له هاري هارلو أُمّين افتراضيتين، واحدة تقدم الحليب والأخرى تقدم الحضن الدافئ، كان يلجأ إلى الأم التي تقدم الحضن الدافئ حين يفزع من الدمية المخيفة. لجأ القرد إلى الدمية الوثيرة هرباً من الوحش، مُتجاهلاً الدمية القاسية التي تمتلك الرضّاعة. الثواني المعدودة التي قضاها في حضن الدمية العطوفة أمدّته بالأمان الكافي للتقليل من هيبة الوحش والنظر إليه كلُعبة مسلّية.
في ظروف قاسية كالتي يفرضها العيش في بلاد يحكمها الفزع والرعب والفاقة، تنكسر قدرة الأفراد على توليد الحب والطمأنينة. تتعاقب الأجيال على الواقع الموحش بمصائر مهددة تحول بينها وبين توفير الحصانة لذاتها وللآخرين. تصبح المجتمعات المشغولة بالنجاة أكثر استعداداً للعنف والقسوة، وأكثر عطشاً للغيبيات التي توفّر اليقين وتُمأسس القسوة وتُشرعنها أحياناً. يشيع في هذه المجتمعات وجود نماذج وأنماط سلوكية متّسقة مع الحطام، منها مثلاً نموذج الأب الصارم الكَتوم، والباطش غالباً، والأم المقموعة التي تقدم الطبق بدلاً عن كلمة أحبك، والأطفال الجاهزين إلى تكرار هذا النموذج في حين يشبون ويكبرون. بيد أن تحولاً جذرياً يحدث اليوم لدى آباء وأمهات مشتتين، يعون هذه الأنماط ويحاولون كسرها عبر محاولة التعلم والخلاص والحرص على توفير ما يُمكن من الحب والحرية لأبنائهم وبناتهم. هذه الثورة هي ثورة في الحب، يتم فيها السعي لفهم ظروف الجيل الأكبر والصفح عنه، ثم الصفح عن الذات والعمل على عدم توريث جراحها.
نشعر بالأمان حين نعيش الحب، ولكننا نحتاج إلى الشعور بالأمان لفتح أبواب القلب على هذا الحب الذي سيُشعرنا بالأمان. إزاء هذه المعادلة الفكد أب، ينبض قلب المحبّـ/ة بجنون على الناصية في انتظار المحبوب وكأنه على وشك الانسحاق والتبخّر. تأتي رهبة الحب من كونه يضع المُقبلين عليه في المجهول، جرّاء تعريض ذواتهم وذواتهنّ إلى عيون تمتلك سلطة الإحياء والإماتة المعنوية.
مكرٍ مفرٍّ كجلمود صخر
بيد أن رهبة الحب الطبيعية، بسبب كونه مرآة تظهر فيها كسور الذات، تتحول إلى رُهاب حين تتسلط على البشر قيم وأعراف تدعو إلى الصلابة والطهرانية والاستقامة، وتُدين الرغبات وتحاول تأطير ميولهم وهوياتهم. تحت سلطة هذه القِيَم، تصبح الفضيلة هي البوصلة، ويُطلَب من البشر سحق أنفسهم وإدانتها على الدوام. تأمر الفضيلة الرجال بالاشتداد وتحرمهم من حقهم في الضعف والتعبير عن العواطف، وتفوّضهم كحرّاس لها. تسحق النساء وتسلب حريتهنّ وتدعوهنّ إلى التعفف وحماية شرفهنّ المعرض للانتهاك في أية لحظة. وتطلب ببساطة ممن لا يقع ضمن ثنائية الرجل والمرأة الموت والهلاك والقفز في الهوتة.
في ظل هذه السلطة المؤسسة للقسوة والتوحّش، يعيش البشر في صراع أبدي مع ذواتهم يحاولون فيه التسامي عن الأهواء ولجمها، مؤمنين بدونية هذه الأهواء. يعيشون خصاماً أبدياً مع أنفسهم غير القادرة على الامتثال الكامل، وتنزلق مرة تلو الأخرى في دناسة الهوى. يصبح الحب المكبوت، بتعبيراته الجنسية والعاطفية والفيزيائية، عاراً ومَثاراً للإدانة الاجتماعية حين يظهر. بيد أن كبت هذه الرغبات والعواطف لا ينفع، وحين يفشل البشر في الاعتراف بها وقبولها يعيشون غالباً وسط دوامة من الذنب والعار والغضب في حياتين منفصلتين؛ يُصدّرون في أُولاها صورة طاهرة عن أنفسهم كأفراد ومجتمعات، ويقضون في ثانيها أَوطارهم في العتمة التي يَتشرعن فيها ما لا يمكن قبوله في ضوء الفضيلة.
هكذا، تعيش الذوات المقموعة/القامعة في الإطار الضيق الذي ترسمه الفضيلة، وتَحار في كيفية تبرير انزلاقها خارجه. تعيش على الدوام في عذاب مستمر وحارق يفيض بها فتوزِّعه على الآخرين. تخلق هذه الذوات فضاءاً تعيش فيه الفتاة، على سبيل المثال، رعباً مزلزلاً إذا نبض قلبها بالحب، ويتجذر هذا الرعب مُقترناً بالعار والغضب على الذات والفزع من الموت قتلاً إذ تُرجم هذا الحب إلى قُبلة أو جنس. يرسم «الطاهرون» طريقاً صارماً وضيقاً لحياة البشر، يحددون فيه ما يجوز وما لا يجوز دون هوادة، مستعدين للرجم والسلخ والتحطيم المادي والمعنوي لمن يخرج عن مألوفهم. يُمأسسون لفهم الحب «ومن ضمنه حب الإنسان الصحي لذاته وقبولها وعطفه عليها» كبوابة للانزلاق إلى الشرور والخطايا، فامتلاكُ القلب يعني امتلاك الجسد. بهذا، يلوب المُقدمون على الحب، الذي تتحرر فيه الأجساد والقلوب والعقول من سطوة الفضيلة، في دوامة الذنب والاحتراس، ويُؤمِنُ الخارجون منه باستحقاقهم للعقاب والتقريع والانسحاق أمام السلطة ورواسبها الكامنة في النفس.
لا يقتصر التحرر من الفضاء الذي تخلقه الفضيلة على الخروج الفيزيائي منه ومغادرته. فحتى بعد مغادرة أفراد مجتمع الميم للبلاد التي قمعتهم، يخوضون ويَخُضنَ معارك طويلة تحتاج إلى الكثير من الصبر والحب لترميم ما هشّمته الفضيلة الباطشة في الإنسان وفي صورته عن ذاته. كانت سارة حجازي مثالاً لما يُمكن أن يعيشه من يقرر تحدي هذه المنظومة برمّتها. إضافة للتعذيب الجسدي الذي تعرضت من قبل سجانيها، اختبرت سارة ألماً طافحاً في منفاها البعيد آلاف الأميال التي ظهر فيه العالم كمكان موحش وقاس صعب الاحتمال. ولكن الحب الذي كانت سارة أيقونة له حَصَّنها من إعادة تدوير القسوة كما هو حال سجانيها، فقالت للعالم الذي حطّمها إنها تسامحه.
فتح النافذة للشبح
تلقاء هذه الحياة البسيطة والمعقدة، يُفترض بنا أن نعيشها ببساطة، أن نشعر ونتفاعل مع ما يمرّ عبر حواسنا؛ أن نحسّ ببرودة الماء الدافق على الكف، بحرارة الشمس على الأجفان المُطبقة، بسكون ليل الربيع، وبقُبلة دافئة في يوم عاصف.
بيد أن هذا الحضور الكامل، المُغلّف بالهناءة والحب والرضا، قد يمتنع ويصبح صعباً على كائنات مشغولة بالنجاة جادت عليها الحياة بالصدمات والخدوش وليّ الأذرع. التعرُّض للمخاطر والتجارب القاسية يُجبرنا على التحفّز لتأمين الذات من تكرار التهديد المُحتمل، فنخاف من تذكّر الماضي ونحاول التحصن من غموض المستقبل.
في ضوء هذا التحفز، ينفصل الإنسان عن واقعه الآنيّ. يعيش بأعصاب مشدودة وينشغل لا شعورياً بما لا يقع في مرمى نظرهـ/ا أو بين يديهـ/ا. تتناقض حالة الاستنفار هذه مع الحالة التي يتطلبها عبور الحب، وهي الاستسلام المُطمئن وعيش اللحظة دون مبالاة بما يقع خارجها.
الاستسلام للحب يعني وضع كافة الدروع جانباً وتعريض الذات. من يمتلك الشجاعة الكافية لعيش الحب يتحرر ضمنياً من سطوة أشباح الماضي والمستقبل. يقول في ذاته، بلهجة ثائرة وقاطعة: فليكُن ما يكون. بهذا، يصبح الضعف وتعريض الذات جسراً إلى التعافي والتحرر.
ولكن من لا يستطيع امتلاك هذه الشجاعة، بسبب عدم امتلاك الأدوات الكافية للافتكاك في الألم أو بسبب فظاعة ما مرّ أو يمرّ به، يعيش في إطار ما يُتيح لنفسه الشعور به. تمر الأحاسيس عبر فلاتر التحصّن وقد لا يصل منها سوى الفُتات. كلام الناجين من الأهوال عن تبلّد أحاسيسهم قد يكون مألوفاً في سياقاتنا. يصبح للحياة والموت تعريفات أخرى في هذا الصدد: من يتحرر ويتيح لنفسه الإحساس بالحب يتحدث عن سَرَيان الحياة في عروقه، ومن يضطر للاستمرار بالاحتراس يشير إلى كونه يعيش على هامش الحياة في واقع موازٍ.
بذلك، يصبح الخوف عدواً للحب؛ خوف الجريح الراغب بالتحصّن، الذي يدفعه إلى قطع الطريق على تكرار مشاعر الألم، وينتهي به إلى قطع الطريق على المشاعر كلها، بحلوها ومرّها، مُعبِّداً الطريق إلى العيش بترقّب على حافة الواقع. العبور من هامش الحياة إلى متنها يتطلب الكثير من الانتباه والصبر والعطف، وقد يحتاج من يترنّح على المركب المهتزّ في هذه الرحلة إلى اليد الساندة، التي تحصنه/ا من السقوط.
الحب شأن شخصي للغاية، ولكن تَأثُّره بالسياسة والاجتماع، وتأثير حضوره وغيابه عليهما، يجعل منه شأناً عاماً يصلح التفكير فيه لدى مقاربة أوضاعنا والتفكير في أحوالنا. قد نخلص لدى تأمله إلى نتائج بسيطة، وهي أننا نحتاج الحب لنعيش، وأخرى أكثر تعقيداً، لها علاقة بالديناميات التي تحكم علاقة البشر المفتقدين للأمان في سياقات الاستبداد والكولونيالية. التفكير بالحب كشأن عام يفتح الباب إلى مراجعة الماضي ومُعاينة الحاضر بمناظير جديدة، تطل على المجتمعات والبلاد، بالقدر ذاته التي تطل فيه على القلوب والأجساد والأعصاب.