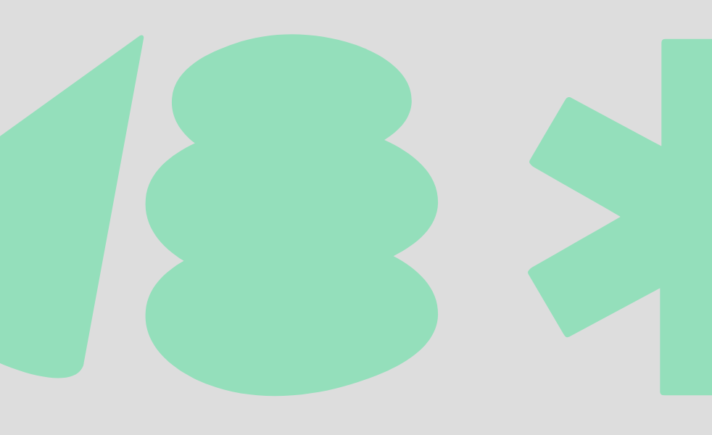نور شنتوت، فنانة وباحثة سورية مقيمة في النمسا، هي ضيفة هذا الجزء من سلسلة زيارة في الاستديو، متحدثةً من مشغلها الفني في فيينا، المدينة التي احتوت بهدوئها الفنانة التي جاءت إليها شابةً بضجيج داخلي حفلت به سيرتها من التجارب والخبرات التي اشتبكت معها في مدنٍ مثل دمشق وبيروت، ومنحتها فرصة لتأمل هذه التجارب من نقطة بعيدة. تتحدث نور عن هذه النقطة من بين أمور أخرى، تتضمن اهتمامها بمشروع التطريز الفلسطيني، والأرشفة المضادة، والعلاقة مع إرث عائلي يتفاوت أثره بين الامتيازات وبعض الأعباء أيضاً:
نبدأ من سؤال المكان وهو محور هذه السلسلة من اللقاءات. تنقلتِ بين أربع مدن، دمشق وبيروت وباريس وفيينا. لنحاول العودة ورسم خط زمني بين هذه المدن وما عنته في كل مرحلة، كعناوين عريضة، من مراحل عملك.
كنت لا أزال صغيرة بالسن في فترة سوريا. خرجت منها وأنا ابنة 21 عاماً. كان لدي وقتها استديو عمل مشترك مع صديقة لي. والدها أعطانا مساحة العمل هذه. لا أعرف إن كان ما أعمل عليه حينها يعتبر تجريبياً للغاية، كنتُ في طور التعلّم وأنا أَدرس اختصاص النحت. أي في مرحلة لا تشبه شغلي الحالي على الإطلاق. ولكن ما أذكره وأذكر أثره الأبلغ عليَّ حينها هو النقاشات التي كانت تدور بيننا، أذكر المكتبة التي كانت لدينا في الاستديو. كنا نمضي الوقت بالحديث، ونرسم بعضنا، كانت إحدانا تلعب دور الموديل العاري لترسمه الأخرى. لم يكن لدينا هذا الخيار، الموديل العاري، في الكلية. كان ذلك مهماً لنا، وهي أصبحت رسّامة فيما بعد.
على أيامِك لم يكن هناك وجود لموديلٍ عارٍ في كلية الفنون الجميلة في دمشق، رغم أنها كانت مادة أساسية في فترة تأسيس الكلية بين عقدي الستينات والسبعينات…
حاولنا، أنا وزملائي، كتبنا رسالة وحاولنا تضمين بند الموديل العاري في قسم النحت. كنا مهتمين ومهتمات بدراسة التشريح. لا يهمني هذا الموضوع في عملي الحالي، ولكن حينها كنا نتعلم تقنيات مختلفة وكنا نريد أن نعمل منحوتاتِ للعارضين والعارضات. كانت نتيجة طلبنا أن أتوا لنا بتماثيل من محافظة السويداء. سافرت هذه التماثيل من أجلنا من السويداء، حيث وجِدت من قبل كلّية فنونٍ جميلة فيها تماثيل غير موجودة لدينا في كلية الفنون في دمشق. وهي تماثيل تشريح في النهاية.
فيما بعد، حين بدأت الثورة في سوريا، كان من الصعب عليَّ التواجد في الاستديو والعمل فيه، حاولت، ولكن حدثاً أكبر كان يجري في الشارع. قَلَّتْ زياراتي للاستديو وتَغيَّرَ كل شيء في حياتي. تركتُ سوريا بعدها. بالنسبة إليّ، حين أنظر إلى تلك المرحلة كان ما تعلمته من تفاعلاتي مع من هم حولي مؤثراً فيّ أكثر مما درسته دراسة نظرية. نتعلم في الكلية بطريقة كلاسيكية، نتعلم كيف نبني منحوتة ونتعلم تقنيات، ولكنني تعلمت من الناس أكثر مما تعلمته من الأساتذة، كان هناك مجتمع مميز في الجامعة. جاء قرار السفر إلى باريس على نحوٍ مفاجئ. في صيف عام 2011 سافرت إلى باريس أنا وصديقتي نفسها، التي تشاركتُ معها مساحة العمل في دمشق. ودرسنا في صفوف دورات فنية وكان التركيز حينها على الرسم أكثر. بعد ذلك سافر أهلي إلى بيروت والتحقتُ بهم بعد أن مررت بتحدياتٍ إجرائية صعبة في باريس. على المستوى الذهني أيضاً كان الأمر صعباً، أن يترك المرء خلفه حدثاً كبيراً بحجم ثورة، ومن ثم يحاول التأقلم في مكان جديد، لا التأقلم بمعنى الاندماج طبعاً. قررتُ أن أعود إلى بيروت وأتابع الدراسة هناك. عدت لتجربة مشاركة مرسم ولكن هذه المرة مع أبي. لم أحب أن أعمل في أوقات عمله نفسها في المرسم، فكنتُ أختار العمل ليلاً بعد انتهائه، بمرافقة صوت المولدة الكهربائية. في هذه المرحلة أيضاً، مرحلة بيروت، طورتُ اهتماماً خاصاً بالفلسفة، مع اتصال بيروت بالأجواء الفكرية والفنية الأوروبية والعالمية. حملتْ مرحلة الدراسة تحدياً، في جامعة خاصة يتقن روداها الفرنسية بطلاقة، ولكن تَعمَّقَ اهتمامي بالجانب النظري للفنون. لم أوظف هذا الاهتمام مباشرة وأطبقه في عملي. كانا شأنين يسيران في مسارين مختلفين، على عكس عملي في الوقت الحالي.
تجربة دراسية مختلفة عن مرحلة جامعة دمشق التي سبقتها، ولكن كانت مفيدة ربما على مستوى تأسيسي؟
نعم. الميزة الأبرز في فترة الدراسة في جامعة دمشق هي تعلم الأساسيات، ولكن عند تعلم تاريخ الفنون كنا نتعلم أكثر عن تاريخ الرجال البيض من الفنانين الحداثيين، بيكاسو ومونيه وغيرهما. هكذا يبدأ تاريخ الفن من هذا المنظور. لا ندرس بشكل كاف عن النساء في الفن وبالكاد تُذكر أسماؤهن. كانت لدينا في المنزل مكتبة فنية وأدركت منذ وقت مبكر أن ما يتعلمه المرء لا يقتصر على المناهج التدريسية، خصوصاً مع منع الكثير من الكتب في سوريا وأننا كنا نبدأ مرحلة الدراسة الجامعية في سنٍ مبكر.
جاءت تجربة بيروت في مرحلة أنضج عمرياً، ولكن كان يجب أن تنتهي أيضاً.
لم تكن مرحلة بيروت سهلة، لقاءاتي وتفاعلاتي مع من هم حولي كانت مميزة أيضاً وتوطدت صلتي بالمسرح والسينما أكثر فيها. انتشار النَفَس العنصري في بيروت بعد الثورة السورية كان تحدياً إضافياً، لديَّ امتيازات ربما كان يمكن أن تحميني إلى حد معين ولكن المكان كان صعباً رغم ذلك، وكان هناك شعور أنها محطة مؤقتة. بالصدفة التقيت بالجامعة بسيدة كانت تعمل في إحدى الجامعات في باريس. صدفةٌ بحتة أدت إلى ذهابي مرة أخرى إلى باريس في إطار برنامج تبادل طلابي حيث درست النحت أيضاً. كانت بالنسبة لي تجربة جديدة، من حيث وجودي في وسطٍ منشغلٍ بما هو سياسي بقدر انشغاله بالفن، رغم تحدياتٍ جديدة برزت في هذا المكان مع الطلاب وهي مشاكل من نوع آخر مثل الموقف من القضية الفلسطينية. أذكر أننا كنا نحضر الأفلام السينمائية وطورت شغفاً بالممارسات الفنية التي تحكمها الموضوعات. حتى الآن أحمل في عملي تركيزاً على ما هو جمالي رغم بعده النظري الواضح. أرغب في أن يشعر الناس بمشاعر مختلفة عندما يتواجدون في مكان العرض. بدأ ذلك في مرحلة باريس تحديداً، وعندما تَعمّقَ اهتمامي بالفلسفة وبدروس الفلسفة التي كنا ندرسها في الجامعة، ولكنني كنت أرغب بتعلم ما يتجاوز محتوى المناهج الجامعية، ما يتجاوز الفلسفة وتاريخ الفن، كنت أرغب بدراسة الذاكرة والجنسانية، لذلك تقدمتُ بطلب لإتمام دراستي في فيينا في تخصص النحت أيضاً لأحاول بعدها توزيع اهتمامي بين النحت وبين الدروس النظرية. درست الفن النسوي وكانت مشرفتي في الدراسة قيّمة فنية وباحثة من يوغوسلافيا سابقاً، وقدمت لنا تجربة تدريسية ملفتة عن موضوع الذاكرة بشكل خاص وعلاقتها بيوغوسلافيا السابقة.

كانت لديك مساحة عمل خاصة حينها؟
كان عندي مرسم في الجامعة هو عبارة عن بناء في قلب غابة تُقام فيه الكثير من الدورات التدريبية، وكان يشبه بيتاً فيه حمام ومطبخ للطلبة. كنت أقضي معظم وقتي هناك حتى في الفترة الصيفية. كانت المساحة المخصصة لي صغيرة لأن المكان هو مساحة مشتركة، ولكن كان هناك حديقة ملحقة بالمكان تعلمتُ فيها العمل على الحديد والخشب والعديد من المواد المختلفة. تغير أسلوب عملي مرة أخرى بعد تخرجي وتحقق إمكانية عملي في مكاني الخاص حيث أعمل بمشاركة فنانٍ آخر، غير موجود هنا معظم الوقت، ولدي مساحة خاصة بي في المرسم. هناك تغيير يطرأ على عملك عندما تمتلكين مساحة خاصة بك.
كيف؟
صرت فكّر أكبر. تَغيَّرَ حجمُ القطع وحجم المشاريع التي أعمل عليها. ازداد عدد الشركاء ممّن أعمل معهم على مشاريعي، وطال الوقت الذي أَستغرقه للعمل على هذه المشاريع. تحول المرسم إلى مكان للاجتماعات واللقاءات أيضاً، وأحياناً ما تتخذ هذه الاجتماعات طابعاً شخصياً، إذ يشبه المرسم منزلاً مع انتشار بطاقات الملاحظات والكتب والقطع القماشية التي تشكل مادة لعملي، ومع تواجدي فيه لفتراتٍ طويلة.
يبدو ملفتاً هذا الارتباط بين وجود مساحة خاصة رحبة والتقدم في العمل على مشاريع فيزيائية. في مراحل سابقة، ومع عدم وجود مساحة العمل المستقلة على الأرض، كنت تنشطين في مساحات ذهنية أكثر.
أذكر عندما كنت أعمل في مرسمٍ مشترك مع والدي، ورغم وجود غرفة خاصة لي، كنت أشعر بعدم امتلاكي لمكاني هناك رغم إمكانية عملي بحرية وحتى لو تواجدت في أوقات مختلفة. لم يكن مكاناً للتجريب، التجريب جزء من العمل عندما يكون المرء وحده، بإمكانك تكريس وقت وجهود على أمرٍ يمكن ألا يُعرض وألا يراه أحد أبداً.
مع ذلك أشعر بالحاجة الآن للعودة إلى هناك في زيارات. إلى بيروت وسوريا والبقاء على تواصل مع ما يجري هناك من متغيرات. يزداد نشاطي في الكتابة في هذه الزيارات وهي ملهمة إلى حد كبير. أركز في عملي على التأريخ والتأريخ المضاد والأرشفة المضادة، لذلك من الضروري أن أشهد التغيرات. عندما أعود إلى هنا تتاح لي فرصة التفكّر في ذلك كله وبهدوء.
حركة السكون والضجيج المتناوبة هذه تبدو أمراً ذا تأثير في عملك.
هي مهمة للغاية. الفترات التي كنت كنت أتنقل فيها بين لبنان وفرنسا كانت صعبة، فيها الكثير من الضجيج، لا على مستوى رمزي، بل حرفياً، ضجيج. أتيت بعد ذلك إلى فيينا وهي مكان هادئ، وأنا محمّلة بذلك الضجيج بداخلي. وقد أخرجت الكثير منه حتى الآن.

تحدثت عن الأرشفة المضادة التي تشغل حيزاً كبيراً من اهتمامك الآن، بشكل خاص من خلال عملك على التطريز الفلسطيني في دول الشتات وفي سوريا على وجه الخصوص. متى بدأت تطورين هذا الاهتمام؟
في فرنسا عرفت تماماً أين سأوجه تركيزي. عرفت أنني أريد العمل على أعمال تركيبية ذات صلة بالمكان، متأثرة في ذلك بالمسرح وبالمُشاهِدية أو المتفرجية (Spectatorship)، كيف يتحرك الناس في المكان الفني وما هي أسئلتهم. تطور هذا الاهتمام في باريس تحديداً مع النقاشات المرافقة للحصص التعليمية، ومن ثم في فيينا مرة أخرى مع تجربتي مع أستاذ جامعي معني بفن العمارة من منظور فلسفي. من هنا بدأ اهتمامي يتركز على الأرشفة والتأريخ، متأثرة بما قدمته المدرسة ما بعد البنيوية بهذا الصدد ممّا اطلعتُ عليه أثناء إقامتي في باريس، منشغلة بأسئلة متعلقة بمن يكتب التاريخ ومن يكتب حتى النصوص الموجودة في المتاحف؛ من يكتب النص المرافق لمنحوتة مسروقة من العراق في متحف اللوفر؟ لم أكن حينها أنوي العمل على موضوعات خاصة بسوريا وبالأجزاء الأقرب من هويتي. ربما لأنني كنت مُتعبة حينها من وطأة حجم الحدث الذي شهدته. مرت عدة سنوات قبل أن أتمكن من تفكيك حدث على هذا المستوى والتعامل معه، استفدت فيها على وجه الخصوص من قراءة ما قدمته كاتبات مثل سارة أحمد ونسويات أخريات، ملونات على وجه الخصوص. كنتُ مدركة قبل ذلك أن ما هو شخصي هو سياسي أيضاً، ولكن هذه القراءات ساعدتني أكثر على تركيز معارفي النظرية في ما أعمل عليه من مشاريع.
الثوب كمساحة تفكير وعمل سياسية
بدأ اهتمامي بالتطريز في عام 2015، عبر قصة شخصية. كل فرد من أفراد عائلتي كان الآن يحمل أوراقاً رسمية مختلفة تخصّ مكان إقامته أو إقامتها، لم يكن لقاؤنا ببعضنا سهلاً. أرسلت لي جدتي ثوباً مطرزاً من أثوابها، وأذكر انزعاجها عندما قصّرته والدتي. حرصت جدتي دوماً على ارتداء الثوب، بالنسبة لها هو فعل سياسي، وكان أفراد من عائلتها المنتشرين في عدة دول يرسلون لها أٌثواباً من أماكن إقامتهم بين فترة وأخرى. جدتي فلسطينية ممن توجهوا نحو الأردن بعد عام 1948 حيث تزوجت جدي ورحلوا بعدها إلى سوريا. كان من الصعب عليها الالتقاء بأفراد عائلتها مع تغير وضعهم الإجرائي في بلدان إقامتهم، للأسوأ غالباً. فكرت بالأهمية الرمزية التي يحملها الثوب الفلسطيني، وكيف يحكي عن الحدود بطريقة أعمق من الكلام المباشر. قررتُ أن أبدأ العمل على موضوع الثوب. لم أكن أعرف الكثير عنه حينها، هل التطريز يدوي أم آلي على سبيل المثال، قبل أن أتعمق أكثر بالموضوع ويصبح موضوع بحثي الأساسي في الدكتوراة، ولكن كنت أعلم أن التطريز وهذا التراث تحولَ إلى فعلٍ ثوري، لمواجهة محاولات اقتلاعه. لم أكن أعرف أن لكل قرية في فلسطين أسلوب تطريز خاص، وأن هناك مدارس مختلفة للتطريز. قررتُ أن أحاول تعلم التطريز بنفسي، وقررت ألا أقتصر في بحثي على جدتي وحدها فسعيت للقاء أخريات ممّن يعملن على تطريز الأثواب. لاحظ جدي اهتمامي بالموضوع وأعلمني أن جمعية عائدون الأهلية التي أسسها – وهو رجل سياسي كان سابقاً عضواً في الجبهة الديمقراطية – قد أقامت ورشات تطريز تدريبية للنساء بعد الثورة ومع احتياج الكثيرات منهن لعمل. لم أكُن على علم بذلك وعرض علي جدي أن يصلني بسيداتٍ يعملن في التطريز. يحدث معي ذلك غالباً في المشاريع التي أعمل عليها. لا أَدخُلُها بأفكار محددة حول المكان والتوجه، تلعب الصدف أحياناً دوراً في توجيه مسار العمل، ونادراً ما تكون لدي أفكار ناجزة حول كل تفصيلٍ في المشروع.
البحث عن الثوب الجديد
زرت أماكن شغل النساء وكنّ كريماتٍ للغاية في حديثهن معي. شعرت حينها بأهمية تركيز الاهتمام على عمل النساء في فترة ما بعد الحرب. هناك الكثير من الحركات والتيارات النسوية تنشط في فترات ما بعد الحروب وإِثرَ الهزات التي يختبرها المجتمع. ربما لم يكن البعد النسوي ظاهراً في فترة الثورة السورية أو ربما تبلور وسيظهر بشكل أوضح لاحقاً. لم تكن معظم أولئك النساء يعملن من قبل. ما الذي يعنيه ذلك؟ قال لي بعض من قابلتهم إن عمل النساء في التطريز «ليس عملاً أصلاً» فهو عمل تمارسه نساء. مع اهتمامي بهذا الموضوع بنيتُ متحفاً متخيلاً من أثواب جدتي. تضمن لافتاتٍ عُرِضت إلى جانب الأثواب تضمنت اقتباسات من مقابلاتي مع النساء. لم يكن في المعرض ما هو متخيل ولكن هذا الانطباع تولَّدَ عند الزائرين. هذه الانطباعات هي ما كنتُ مهتمة به، وهو عائدٌ لانشغالي بعلاقة المُشاهِد مع العمل، عندما يدخل المرء إلى متحفٍ لا يشك في ما يُعرض فيه من معلومات وأغلب الناس ترى في المتاحف مكاناً للتعلم. عملت على تطريز معظم الأثواب بنفسي، يستغرق العمل على كل ثوب قرابة ثلاثة أشهر، وكنت أعمل في الوقت نفسه على ورقة بحثية عن التطريز في سوريا وكيف تأثر بعد تدمير مخيم اليرموك الذي كان مركز التطريز الفلسطيني في سوريا. تعلمت التطريز وتعلمت عنه. كان مهماً بالنسبة لي أن أُطرز بيدي، كان مهماً أن أبني هذه العلاقة مع المادة ومع زمن العمل عليها وحتى مع من أتحدث إليهن من النساء المنشغلات بالتطريز في المقابلات. ما الذي يعنيه أن نعمل في عهد الرأسمالية المتأخرة عملاً يستغرق ثلاثة أشهر بمعدل ثماني ساعات عمل يومياً لإنجاز قطعة واحدة؟ فتح هذا المشروع باباً لمشروع آخر بعده عن التطريز في مخيم شاتيلا وكيف تأثّرَ بهجرة النساء السوريات للمخيم، وخضتُ رحلة البحث عن الثوب الجديد وهو عنوان المشروع الذي عرض في أماكن عدة وهو موضوع رسالة الدكتوراة التي أعمل عليها.

تعملين على نصوص مكتوبة أيضاً إلى جانب عملك البحثي والفني، وتحرصين على إبقاء هذه الصلة مع ما هو مكتوب.
أذكر أنني كنت أكتب كثيراً في إحدى مراحل إقامتي في فيينا، أثناء عملي في مساحة عمل مشترك مع فنانات أخريات، كنت حينها أكتب أكثر ممّا أعمل على مشاريع فنية حتى. كانت مرحلة تشبه مكان العمل هذا. أحب الكتابة حتى لو لم يكن النشر هو الهدف، أشعر بمساحة حرية في الكتابة غير الأكاديمية، وربما أكتب مرة في السنة وأود أن أكتب أكثر. يحمل عملي هذه العلاقة بين النص والعمل، وهناك الكثير ممّا هو مكتوب في الأعمال. في بعض المعارض تحضر نصوص تشرح للزائر ما يراه، ولكنني أرى الكتابة كطبقة ثانية في عملي، تدفعك لطرح أسئلة أخرى ربما. أود تجربة الكتابة الخيالية أيضاً، ككتابة عمل روائي، ولكن ذلك سيتطلب وقتاً طويلاً حتى يتم إنجازه. أحب أن أكتب مستلهمة من تجارب شخصية عِشتُها ومن شخصيات مرت في حياتي، عن شخصيات نسوية وكويرية وكيف تعيش في هذه الفضاءات المختلفة وعن علاقاتها بالمجتمع والناس.
شغلك معنيٌ بما هو سياسي بشكل واضح.
الفن بمعظمه سياسي، حتى لو كان عملاً تجريدياً. حتى لو عرضت لوحة فارغة، أنت تعرضين أمام مشاهد، تقدمين موقفاً، تقولين شيئاً ما. أفتخر أن عملي سياسي وكان ذلك قراراً اتخذته، خلال مدة زمنية طويلة. أُسأل على الدوام ما إذا كنت أَعتبرُ نفسي «أكتيفست». تعرفين، كأنها صارت مسبّة أو شي بيضحك. ولكنني كشخص عاش في سوريا، نصف فلسطينية، لم يعد الأمر خياراً بالنسبة لي، أن أكون منخرطة بالسياسة أو لا. منذ فترة مراهقتي كانت لدي رغبة بالتحرر والثورة، تأثرتُ بشخصية جدي. أما عن وضوح ذلك في عملي، أذكر أنني في أيام بيروت قرأتُ كتاباً، ربما هو مبالغ في تقديره إلى حدٍ ما، كتاب المتفرّج المتحرر لجاك رانسيير، ومن ثم ظهر أثرُ هذه القراءة في عملي بما يخص العلاقة بين المشاهد والعمل، العلاقة السياسية على وجه الخصوص. ما بين توجهٍ ملتزم اجتماعياً وملتزم سياسياً في الفن أرى نفسي أقرب إلى الثاني. أرغب في تقديم ما يطرح أسئلة حول اللحظة الراهنة سياسياً والآراء المحيطة بها. في أحد مشاريعي جمعتُ ملابس عُمّال وعرضت معها نسخاً من لافتات موجودة في متحف الخزانة الإمبراطورية في فيينا، في إطار مشروع قصيدة من المستقبل، وبعد ذلك بدأتُ العمل على موضوع التطريز الفلسطيني ذي التوجه السياسي الواضح أيضاً.

كتبتِ في مقالة نُشرت في موقع جيم عن كرسي الأب وسطوته الرمزية، مستعيدة تأملات سارة أحمد في طاولة الطعام وما تمثله من سلطة عائلية. إلى أي حد كان ظل هذا الكرسي عبئاً وقد وجدت نفسك في الحياة، ابنةً لفنانٍ معروف، هو التشكيلي حمّود شنتوت، بما يعنيه ذلك من أحمالٍ وتوقعات مسبقة بقدر ما يحمله من امتيازات.
كثيرون ممن اشتغلوا بالفن في سوريا، هم من عائلات برز منها فنانون آخرون. ليس الأمر كما هي الحال عليه هنا مثلاً، أبواب المتاحف مفتوحة أمام الزوار مع وفرة في المعارض والمتاحف والكتب الفنية المتخصصة. في البداية لم أكن أعرف حتى أي توجه سأتخذ في دراستي. كنت أكثر ميلاً لدراسة العمارة وكنت مهتمة بالرياضيات ولكن لم أكن قد قررت تماماً ما الذي سأفعله. بحكم نشأتي في أسرة فنية كنت أزور معارض وأقرأ مما تحتويه مكتبتنا من كتب فنية. لم يكن قرار دراسة الفنون في دمشق سهلاً في مكان يعرف فيه الجميع والدي، وهناك توقعات عالية بما يخصني. منذ البداية كنت أعي ذلك وتولَّدَ لدي شعور برفض التشابه في عملي مع عمل أي شخص آخر. والدتي فنانة أيضاً، كنت أزورها وأزور والدي في مرسميهما وكنت أحاول الخروج من حالة التأثر بهما. دفعني ذلك إلى محاولة التعلم أكثر لاتخاذ مسار مختلف. لم يكن ذلك سهلاً، ولم يكن الطريق معبداً بالورود كما يمكن أن يبدو الأمر. أحد نتائج هذه الجهود أنني لست فنانة غاليريهات، وعملي الفني مبني على البحث أكثر. ربما كوني عرفت عالم الفن عن قرب استطعت اختيار مسارات مختلفة تماماً عمّا كان موجوداً حولي، رغم أن ذلك قد استغرق وقتاً طويلاً.
الصراع مع السلطة ورموزها موجود في عملي على الدوام، وفي علاقاتي مع عائلتي ومع محيطي. في المقال الذي ذكرتِهِ نفسه أوردتُ شكوكي وعدم قناعتي بنموذج العائلة النواة – الأولية والعائلة الممتدة، خضت تجربة الحياة مع عائلة ممتدة كفتاة مولودة في عقد التسعينات، ربما لذلك تلعب جدتي دوراً مؤثراً في عملي. تتحدث الكاتبة النسوية بيل هوكس وهي ممن تأثرتُ بشغلهنّ، أن العائلات الممتدة وبما تحمله من احتمالاتٍ للتعقيدات والمشاكل، تدفع المرء عادة إلى التطلع نحو شخصياتٍ في الأسرة تتجاوز أسرته الأولية. أذكر أنني كنت متأثرة بجدي، الفلسطيني الماركسي في البداية وبعد قراءاتي النسوية وجهت اهتمامي نحو جدتي أكثر وبحثت لديها عمّا يمكن أن أتعلمه وكان أن تعلمت التطريز منها، كانت هذه إحدى طرقي في كسر الهيمنة والمركزية الأبوية في العائلة.