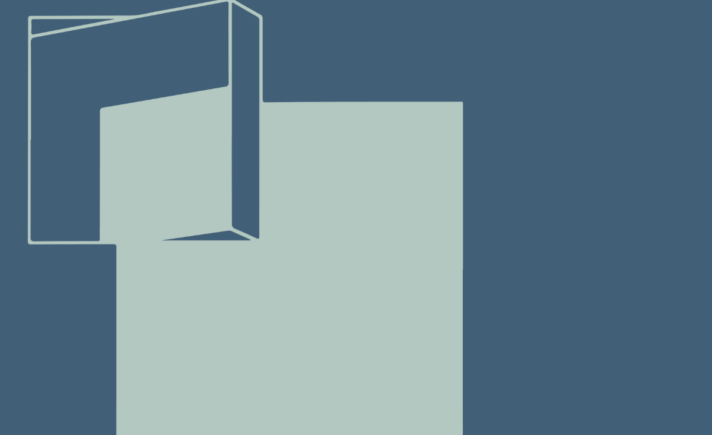من شأن مقاربة الأوضاع الراهنة في سورية والمجال العربي من زاوية شدة الانفعالات السلبية التي تثيرها هذه الأوضاع أن يضيء جوانب من عمليات التفكير والمعرفة المُعبَّر عنها بلغتنا وفي جِهتنا من العالم. هذه المقاربة غائبة دون وجه حق، ومعها يغيب التفكير في الانفعالات ذاتها، إن من حيث وصفها وتصنيفها، أو من حيث ارتباط حدة اختلافاتها وشدّتها باختلاف شروط الحياة المتاحة، أو من جهة مُرافِقاتها الجسمية والسلوكية، فضلاً عن العلاقات المحتملة بين تَبدُّل الانفعالات وتَغيُّر الأفكار. لقد اعتدنا على عدم الربط بين انفعالاتنا من غضب وحزن وقنوط ويأس وغمّ وهياج وغيرها (وفرح ورضا واستبشار وغيرها كذلك) وبين ما نتبنى أو ندعو إليه أو نطوره من أفكار، ويغلب في الواقع أن نعيد أفكارنا إلى أنساب فكرية معروفة، في شكل مذهب أو تيار فكري أو معتقد ديني، أو إلى رؤوسنا مفصولةً عن حياة اجتماعية، نَسيجُها في كل حال انفعالات مستمرة نعيش فيها أكثر مما نعيش في الأفكار، وقلّما تسير العلاقة بينهما في توافق وانسجام.
ولعل سؤال الانفعالات لا يُثار إلا حين تثور الانفعالات نفسها، أي حين تتواتر أحوال التوتر والسخط والحزن والجزع والكره واللوعة والحسرة. أما حين تستقر انفعالاتنا على نسق لا يكاد يتغير فإنها تمر تحت عتبة التفكير، فلا تُوعى. وكذلك الحال حين تكون الانفعالات إيجابية، مدارها الرضا والسرور. والملاحظة الأكيدة أننا أشد انفعالاً بعد الثورات العربية، بعد أن لم تكن انفعالاتنا هادئة قبله، وأن هذا واقع كتل بشرية بالملايين وعشرات الملايين وليس أفراداً ومجموعات هنا وهناك. قبل ما يزيد بقليل على عقد واحد ارتفعت توقعاتنا السياسية والحياتية، واتخذ كثيرون منا قرارات حاسمة ما كان يمكن أن يشعروا بوجوب اتخاذ مثلها في ظروف أخرى، وآل الأمر بقدر واسع إلى حبوط التوقعات الإيجابية، وإلى ما لا يُحصى من انقلابات حياتية ومآسٍ شخصية، في إطار مآسٍ جمعية هائلة.
ثورة الانفعالات هي أحد أوجه الثورات في مجالنا، بل لعلّ الثورة هي قبل كل شيء ثورة انفعالات، على ما يدل الاشتقاق العربي. لغوياً، الثورة انفعال شديد، احتداد واشتداد في المشاعر، وبخاصة الغضب. ثم أن ما يثير هو ما يحرك أو يحفز، فنتكلم على ما يثير الأعصاب أو التفكير أو النِزاع، أو على ما يثير جنسياً. أياً يكن الأمر، فإنه يمكن للتفكير في ثورة الانفعالات أن يكون مدخلَنا إلى ثورة في التفكير والتعبير، وربما الأفعال.
انفعالات وأفكار
نتعرض للتمييز، نُحرَم من حق لنا، نُستغَل، نُضرب، نُشتم، نُهان، نُخدع، نُؤذى بصور مختلفة، فننفعل بذلك حتماً، سواء عبَّرنا علانية عن الأمر أم لا. الانفعال ليس من السهل تعريف الانفعالات، وتمييزها عن المشاعر والعواطف والأهواء. في استخدامها هنا أركز على كونها الاستجابة الأولى لما يحدث لنا أو حولنا، أي على صلتها بتجاربنا المباشرة، وعلى أنها أقرب للجسم من التعابير الأخرى. المشاعر أقرب إلى المحتوى النفسي للانفعالات، لكنها أَدْومُ أو أطولُ أمداً. أما العواطف فهي أحوال للنفس ذات صفة علائقية واجتماعية. ولعل الأهواء هي ما تتعذر السيطرة عليه بالعقل والإرادة من منازع نفسية. وأجد مربكاً أن يترجم الأستاذ ربيع وهبة كلمة emotion بانفعال دون أن يسوغ للقارئ اختياره هذا بدل الترجمة الأشيع: عاطفة، وهذا في ترجمته لكتاب أولي ريس وليندا وودهد: A Sociology of Religious Emotion، فصار عنوان الكتاب في العربية: سوسيولوجيا الانفعال الديني. هذه التعابير متقاربة والحدود بينها ليست واضحة على ما يشهد المؤلفان في الصفحة 35 من كتابهما، لكن مردود النظر في هذا الحقل المربك رهنٌ بإعطاء دلالات واضحة لهذه التعابير، والاتّساق في التزام هذه الدلالات. الكتاب الصادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2018. مزامنٌ في كل حال للأفعال التي تستثيره، وهو الوقْع الأول في نفوسنا لما يستجد من واقع حولنا. وهذه منذ الآن نقطة مهمة للنظر في أحوالنا الثقافية والفكرية. فأياً تكن عقائدنا ونظم الفكر التي نعتنق، فإنها تتأثر بقدر كبير بنظام الانفعالات الذي تعمل ضمنه، أعني بما يثير غضبنا أو غيظنا أو خوفنا أو كراهيتنا أو ألمنا أو قنوطنا، وما هو متحدد بأوضاع عامة متواترة أو مديدة، ستتطرق إليها هذه المناقشة.
يتشكل المجتمع حول تصريف الانفعالات السلبية، سواء بمعالجة أسبابها، أو بإتاحة التعبير العلني عنها، أو بمساندة من تعرضوا لأشد المثيرات الانفعالية على نحو يساعدهم في تخفيف وقْعها. ومن ذلك طقوس الحِداد مثلاً، وضروب المواساة الأخرى عند خسارة أو مرض. ومنها مسالك وتعبيرات التضامن عند وقوع اعتداء أو أذى. فإذا عجز المجتمع عن القيام بذلك، سواء بتجاوز شدة الإيذاء قدرته على التحمل والتصريف، أو بمنع الناس من التعبير عن انفعالاتهم وعدم معالجة بواعثها، أو بخوف الناس من بعضهم وعدم ثقتهم ببعضهم، وكلها من «طبائع» الاجتماع السوري المعاصر، فإن المجتمع ذاته قد يتمزق وينهار. يمكن لذلك أن يأخذ شكلَ تَجزُّئِه إلى مجموعات أو مجتمعات صغيرة منكفئة على نفسها، تتبادل الانفعالات داخلياً لكن لا تتفاعل مع غيرها، أو شكلَ الاندراج في روابط وتجمعات أو مجتمعات أخرى. وكِلا الشكلين مُختبران سوريّاً، وإن غلب الثاني في أوساط الشتات.
ثم أن الانفعالات السلبية هي ما تدفع الناس إلى النظر في واقع حياتهم، وربما تحفزهم إلى العمل على تغييره، بدءاً من الحلم بذلك وصولاً إلى الثورة. لا أحد بالمقابل يثور من الفرح أو الرضا، فهنا نريد الدوام فقط. وبِلُغة الانفعالات، الواقع السيء الذي قد نعمل على تغييره هو الواقع الذي يثير فينا مشاعر الاستياء أو الغضب أو الاشمئزاز أو الذلّ إلخ. قد يعمل أهل الفكر والسياسة، أو لا يعملون، على ربط توليدي لهذه الانفعالات بهياكل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو جيوسياسية… هي ما يتعين أن تتغير كمضمون فعلي لتغيير «الواقع السيئ». لكن حياة أفكارنا على المدى الأطول مُستمدة في كل حال من قدرتها على التمفصل مع عوالمنا الانفعالية، وما قد تثيره فينا من أحلام وأفعال.
وموتُها في فشل التمفصل. تتآكل الأفكار أو التوجهات الفكرية المسبقة للأفراد والجماعات بفعل تركز النفوس حول الانفعالات المباشرة أو انشغالها بمداواة آثارها السامة. قناعاتُنا العليا تتأثر حين تتمكن منا مرة بعد مرة مشاعر السخط والأسى والذعر والحقد والإحباط، كأنما تكتئب هي ذاتها باكتئابنا وتتشاءم بتشاؤمنا، بل لعلّها تكفّ عن الوجود، فلا تبقى لها مساحة في النفس أصلاً. الانفعالات أقوى من الأفكار، والانفعالات القوية تطرد الأفكار الرفيعة من النفوس، حتى ليمكن القول إنه ليس للمنفعلين أفكار. وهذا مثلما ليس للجائعين من أفكار (غير الطعام)، وليس لمن يجري تعذيبهم من أفكار (غير توقف التعذيب).
وتَفوُّقُ الانفعالات على الأفكار مضمونٌ بقدر ما تكون عنيفة ومتكررة ومديدة. اعتداء عارض لا يترك أثراً مثل تمييز مديد، وتعذيب أو اغتصاب ليس مثل شتيمة جارحة، وإساءات شخصية ليست مثل قوة منظمة تسيء معاملة الواقعين تحت سطوتها طوال سنين أو عقود، وانفعالات المقهورين ممن اقتلعوا من مواطنهم، يعيشون غرباء في خيام بائسة، مهددين بالجوع والمرض، ليست مثل مصاعب اللاجئين في أوروبا على مشقة حقيقية لهذه في أحيان كثيرة.
فإن لم تتشكل نُظُم تفكيرنا بصورة تستجيب لانفعالاتنا القوية، فإنها تخرج من التداول بالتدريج. لا توفر القومية العربية، مثلاً، لغة ومواقف للاعتراض على انفعالات السوريين، وقبلهم العراقيين أيام صدام، المتصلة بدولة تعذيبٍ ترفع راية القومية. ولا توفر الليبرالية عتاداً فكرياً يستجيب لانفعالات الفلسطينيين باحتلالٍ استيطاني عنصري بالغ العدوانية. ولا تستجيب الإسلامية بصورة إيجابية لمشاعر الذل التي تَسبَّبَ بها إسلاميون، ما آل بالبعض إلى الخروج من الإسلام ذاته. وأخذت الشيوعية بالتداعي حين تراكم فشلها في التفاعل المرن مع انفعالات متصلة بسلبِ الحريات العامة وتوحش الدولة، فضلاً عن الفشل الاقتصادي.
والحال أن التعارض أو اللاتناسب بين تيارات الفكر المتاحة وبين الأحوال الانفعالية المتواترة يمكن أن يكون أساساً لنظرية في التغيُّر الفكري. إذ يبدو أنه حين لا تتناسب الأفكار السائدة في وسط ما مع ما تثيره الأوضاع القائمة من انفعالات، فإنها تأخذ بالتدهور والتلاشي. اللاتناسب يعني أن تيارات الفكر لا تتوفر على لغة وعلى مواقف وعلى ذاكرة تَرُدُّ بها ردّاً فعالاً على ما يتواتر أن يصطخب في النفوس من انفعالات قوية. وهذا يضيء حقيقة أن الأزمات الكبرى، من حروب وثورات وحروب أهلية، تتمخض في الغالب عن تغيرات فكرية كبرى. ذلك أن الأزمات الكبرى هي زلازل نفسية كبرى كذلك، أو ثورات انفعالية كبرى، تطلب استجابات فكرية فعالة، وتطيح بقوة بما لا يوفر الاستجابة من أفكار ومذاهب، ومن باب أولى بما يبدو أنه متسبب بالأزمات وثورات الانفعال. لقد أخذ مفهوم التقدم يفقد شرعيته الفكرية بعد الحرب العالمية الثانية بأثرِ ما شهدته من جرائم مهولة تشكك في وجود «العقل في التاريخ» (هيغل)، وكذلك بأثرِ استخدام التقدم التقني في الإبادة والتدمير، ثم أكثر بعد ثمانينات القرن العشرين بأثر الأزمة البيئية التي توصف أحياناً بأنها إبادة بيئية، إيكوسايد.
ثقافة ورثاثة
لأغراض هذه المناقشة، يمكن تعريف الثقافة بأنها المسالك والقواعد والعادات والأفكار التي تساعد على التحكم بالانفعالات السلبية من غضب وخوف وكره وكيد ومشاعر عدائية، جملة الأنشطة الفكرية والرمزية والأدائية التي تعمل على تحويل الانفعالات المباشرة إلى أفكار ومعانٍ وصور وغيرها، تشكل عبر تَجدُّدها مستوىً للحياة الاجتماعية يفصلنا عن تلك الانفعالات المباشرة. وتكون اللاثقافة، بالتالي، هي سيطرة هذه الانفعالات الخام واستعصاؤها على التحكم بفعل وفرة عوامل إنتاجها، ومن ثم تَمكُّنُها من منع الثقافة من التشكل كمستوىً اجتماعي مستقل. وليس بعيداً عن ذلك أن الثقافة بالمعنى المعياري للكلمة، أي كمجال للتهذيب والإبداع والرهافة وحسن التفاعل وترقي أساليب الكلام والسلوك والتحكم بالنفس، أي كتحضر ورقي، هي نتاج انتشار هذه الروحية وتعممها بين جمهور متسع.
التدهور الاجتماعي الثقافي الذي خبرناه سورياً وعربياً خلال جيلين يعود بقدر كبير إلى أن اجتماعنا المعاصر مُولّدٌ لانفعالات قوية عنيفة، لا تتحكم بها إنتاجية اجتماعية مهمة من المؤسسات والتقاليد والأنشطة والمعايير، الثقافة، التي تُحيِّدها. وهذا أحد أوجه ضعف تحكم عام، هو قبل كل شيء ضعف تحكم بالدولة التي، بالعكس، تتحكم بطرق خشنة بالمجتمع، وتحول دون ظهور مؤسسات وتقاليد ومعايير وقواعد تضبط أفعالها.
بوصفها الوجه الظاهر لما أسماه نوربرت إلياس في سياقات أوروبية «العملية التحضيرية»Norbert Elias: The Civilizing Process, Vol.1 The History of Manners; Vol. 2 Power and Civility. Pantheon Books, New York, 1982.، سجلت الثقافة تراجعاً كبيراً في سورية في الحقبة الأسدية التي تغطي نصف تاريخ البلد. ترسخت وتبنيَنت، بالمقابل، عملية ترثيثيّة شاملة، في السياسة والدولة والثقافة والاجتماع والدين. ويبدو أن شيئاً مثل ذلك يجري في مصر، على ما يُستدل من كتاب محمد نعيم: تاريخ العصامية والجربعة، تأملات نقدية في الاجتماع السياسي الحديث.مركز المحروسة، القاهرة، 2021.
وليس مرد الترثيث السوري تدهور النظام التعليمي وصمود الأمية على نسبة تقارب ربع السكان، ولا حتى القيود على حرية التعبير والكتابة والنشر والاجتماع، ولا فشل تنموي مديد، إلا بقدر ما أن تدهور التعليم وصمود الأمية والقيود على التعبير والفشل التنموي والفساد، أوجهٌ لنوعية أولويات الدولة المخصخصة وتمركزها حول التأبيد في الحكم وتوريثه. التمركز حول البقاء أسَّس لنظرة مرتابة وعدائية حيال المحكومين، عكست نفسها في تعامل خشن مع قطاعات واسعة من السكان، وفي انخفاض عتبة لجوء الدولة إلى العنف ونشره في الحياة اليومية، مصحوباً بأوجه من الإذلال والتمييز الظاهر والوقح. لدينا هنا نموذج للدولة المؤذية، السامّة بالفعل، التي تحكم يدوياً،عملتُ على بلورة فكرة الحكم اليدوي في أوجه المجزرة السبع، التي تناولت مجزرة التضامن. المقالة متاحة هنا. فتضرب وتُعذّب وتهين، لا تكف عن إثارة انفعالات عدائية في نفوس محكوميها. وفي تكرار انفعالات خام، دون آليّات معاوضة اجتماعية أو حقوقية أو سياسية تُهدّئها وتخفف من سميتها، ما يحول دون التهذيب والترقي، أي التحضر. وهذا خلال أكثر من نصف قرن وفي مجتمع لا تتجاوز نسبة من هم فوق الستين من أفراده 4%. المحصلة، انتشار النفس المنفعلة، الحانقة والعدائية و«المكيودة»، وغيابٌ واسع لما يمكن تسميتها بالنفس المتفاعلة.
نركز على الدولة لأنها قوة تَحكُّم عامة وسيدة، إن انفلتت من التحكّم كانت قوة توحش وتدمير، وإن انضبطت بقواعد وأصول معلومة كانت أفضل معين لملايين البشر على التحكّم بحياتهم بقدر من الرشاد. ونتكلم على دولة مؤذية لأنها الفاعل العام شبه الحصري هو المؤذي العام، أي لأن الأناني والعنيف هو العام والحاكم. وكذلك كي نقول إن نظام الانفعالات لدينا متشكل في بنية متحددة سياسياً بقدر كبير.
للانفعالات تاريخٌ هو من وجهٍ تاريخُ المثيرات الانفعالية من حيث النوعية والقوة والدوام، ومن وجهٍ آخر تاريخُ الهياكل الاجتماعية والسياسي والثقافية التي تستوعب الانفعالات أو لا تستوعبها. بما هو كائن حي، الإنسان ينفعل بما حوله، ولا يكون ذلك مشكلة إلا إذا لم نكن غير كائنات منفعلة، لا نتمكن لسبب ما من تجاوز انفعالاتنا الأولى إلى انفعالات ثانية، أفكار وقواعد وعوائد وقوانين ومؤسسات تُمكَّننا من تحسين تحكمنا بأنفسنا والعالم من حولنا. الكائنات الحية تنفعل، لكن ربما ينفرد الإنسان بالتعبير والتفكير، ثم بالقواعد والمؤسسات التي تجعله كائناً تاريخياً كذلك. حين لا نكون إلا منفعلين فإننا نكون أقرب إلى الحياة وإلى الجسم، وأبعد عن الفكر و«العقل». اللغة ذاتها تفقد قدرتها على البيان حين نكون منفعلين أشدَّ الانفعال.
الانفعال والكليشيه
تُعيد الانفعالات السلبية غير المُتحكَّم بها هيكلة اعتقاداتنا بصورةٍ تُحوِّرُ المحتوى الفكري وتُوزّعُ عناصره في بنية جديدة مغايرة، وإن مع الحفاظ على الاسم والعنوان والهوية. هنا يلعب القول المأثور المكرور والكليشيه والعبارة الاعتقادية والشعار المحفوظ دور حجب عملية تحوير الانفعالِ للمُعتقَد، أو توفير نقاط ارتكاز في حياةٍ شديدة الارتجاج، لا تكف عن تهشيشنا وتشتيتنا وإضعافنا. لا يقتصر الأمر على أن المكرور لا يتعارض مع الانفعال المتجدد حتماً، بل هو قد يسير معه كجهد للاستمرارية والثبات، أو كتعويض محتمل عن تقلّب العالم حولنا. والمكرور بعدُ يوفر لغة لجمعَنة الانفعالات التي سيجري الكلام عليها لاحقاً، ضربٌ من «سُنّة» تتكون حولها «جماعة».
ويجمع بين الاثنين، التعبير المباشر عن الانفعال والكليشيه أو العبارة الاعتقادية، تدنّي المحتوى العقلاني. مرة لأن التعبير عن الانفعالات هو أقرب إلى صرخات غضب أو تألم أو لوعة… ومرة لأن ما يُحتمل من محتوى عقلاني أصلي قد نضب وذوى مع التقادم وكثرة الاستخدام. يجمع بينهما كذلك الصفة غير الحوارية لهما. في الانفعال نحن لا نحاور، ينتهي الحوار إن كنا في موقف حواري أصلاً. والعبارة الاعتقادية خاصة بالمعتقدين تعريفاً، وليست حوارية. التفاهم ممكن بين الأفكار، وليس بين الانفعالات، وبقدر ما تثور الانفعالات مثلما هو الحال بعد الثورة السورية تسود حالة من اللّاتفاهم الشامل، تعكس انحسار دور الأفكار في تشكيل النفوس.
ما يضمحل مع استنفاد الانفعال والكليشيه لسُبُل تفاعلنا مع العالم من حولنا هو مساحة التمثيل الحية، مساحة ترجمة التجارب إلى أفكار، والمفاجآت إلى محرضات لتفكير مغاير. يمكن أن تتشكل مجموعات حول الأفكار لأنها تتحاور. بالمقابل، الانفعالات لا تتحاور. لا نتشكل حتى كذوات بقدر ما نبقى منفعلين.
قد لا يكف إسلامي عن استحضار محفوظات من أحاديث نبوية وآيات من القرآن، ولكن الإسلامية الأكثر أصولية وحرفية، السلفية والجهادية منها بخاصة، هي الإسلامية الأشد انفعالاً واشتباكاً مع العالم اليوم. نحن هنا حيال مفارقة مثيرة: فالمحتوى الانفعالي للسلفية الجهادية عصري أو راهن جداً، أكثر من أي مذهب إسلامي آخر، هذا بينما محتواها الفكري هو الأقدم. السلفيون معاصرون انفعالياً وغير معاصرين فكرياً. وفي عمومها، الإسلامية مُزامِنةٌ لعالم اليوم في انفعالاتها، ولا يمكنها إلا أن تكون كذلك، بينما هي ماضوية في أفكارها بدرجات متفاوتة، كبيرة عموماً. ويبدو أن العمليتين تغذيان بعضهما: مزيد من الانفعال الراهن يسير مع مزيد من التمسك بالأصول القديمة. الانفعال السلبي يشكل المحتوى الفكري ويوجهه توجيهاً نافياً للعالم، عدمياً، في عملية تُخفي أنها تركيبٌ جديد. هذا بالتمام والكمال نقيض النظرية الرائجة التي تشرح الإسلاميين بإسلام مماثل لذاته عابر للأزمنة، فتضعُ بين قوسين الحاضر وبنيته، وتفكر في الدين كتعاليم حصراً. في واقع الأمر، الإسلام ذاته (والكلام هنا يجري على الإسلام السنّي حصراً) يُنتَج ويعاد إنتاجه كركيزة فكرية لنفي العالم، النفي الذي يتغذى من منابع انفعالية راهنة.
ولعل الجسر الذي يربط بين العالم الفكري للإسلامية وبين انفعالات سلبية مديدة هو نظريات المؤامرة، وهي ركنٌ ركين من نظرة الإسلاميين إلى العالم. نظريات المؤامرة هي في الآن نفسه كليشيه أو آلية شرح مكرورة لا تشرح شيئاً، ثم إشارة إلى المنابع الانفعالية التي تتشكل الإسلامية بالتفاعل معها.
لكن التركيب، إسلامياً، بين انفعال راهن وتفكير قديم يبدو أنه انفجر في داعش على نحو يمتنع التئامُهُ من جديد. وهذا ما ستحاول الفقرة التالية مناقشته.
النفس المنفعلة أو البافلوفية
ماذا يحدث لنفوسنا حين تتواتر المثيرات الانفعالية السلبية، ولا يحدث تصريف صحي للانفعالات المُثارة؟ مثلَ الأذيات الجسمية، تترك الأذيات النفسية المتكررة جروحاً تتندّب مع الوقت، فتضيق المساحة النفسية التي يمكن أن تُعالج فيها أذيات جديدة. نثور ونغضب ونحزن ونُحبط على نحو متكرر، يتجاوز قدرتنا على تحويل انفعالاتنا إلى أفكار ومعان، كان من شأنها أن توسع مساحتنا الداخلية. عبر التكرار، يصير الانفعال «مَلَكة» دائمة في نفوسنا، وهذا هو أصلاً معنى الكلام على نفوس منفعلة. فإذا اصطلحنا على تسمية تلك المساحة الداخلية بالروح، فإن تواتر الجراح والندوب النفسية يتركنا بأرواح متندّبة، قاسية، صخرية. وإنما بأثر هذه القسوة نواجه المُثير الانفعالي بالانفعال المباشر، أي بما يقارب ردّ الفعل الفيزيائي المباشر أو الاستجابة الانعكاسية البافلوفية. إنتاج النفوس المنفعلة هو نفسه الإنتاج الاجتماعي للبافلوفية. واليسار البافلوفي الذي تكلّم عليه فاروق مردم بيك في مقالة بالفرنسية بعنوان سورية: الثورة اليتيمة، نشرت في مجلة بوليتيس، في مطلع آذار 2012. يجب القول إن النفس البافلوفية شأن علائقي، لا ينشأ فقط بسبب حدة الانفعالات وشدتها وتواترها، وما يتسبب به ذلك من تصلب نفوسنا، وإنما كذلك أيضاً تصلب أنظمة تفكيرنا، وتراجع قدرتها على استيعاب الانفعالات وتوليد الأفكار والمعاني التي تحيدها أو تتحكم بها. التصلبان يعززان بعضهما على نحو ربما تجسده الإسلامية اليوم أكثر من غيرها. هو من أوجهِ بافلوفيةٍ متسعة النطاق، من أوجهها الأخرى إسلامية بافلوفية، وقومية عربية (وكردية) بافلوفية وغيرها. ومقابل اتّساع الإنتاج الاجتماعي للنفس المنفعلة تضيق فرص ظهور النفس المتفاعلة، الاجتماعية أو الصانعة لمجتمع عبر شبكة تفاعلاتها مع آخرين. وعلى هذا النحو يُنتِجُ «الواقع السيء» شروط دوامه.
ولنعد، كمثال، إلى الإسلامي الذي لا يكف كما تَقدَّم عن تعريف نفسه بدلالة إسلام متماثل مع ذاته على مرّ الأزمنة. في واقع الأمر، هو يستعير من المجمل الإسلامي في عملية غير موعاة ما يستجيب لأوضاع انفعالية محددة اجتماعياً وتاريخياً، أوضاع تُنازِعُ في القوةِ المحتوى الاعتقادي، فتتبادل معه إعادة الهيكلة. وهذا لأن الإسلام فكرة كبيرة، بل ضخمة، لا تتغلب عليها الانفعالات بسهولة. فهو يتكلم على الكون كله والعالم المشهود و«الغيب» من جهة، ومن جهة ثانية له تاريخ مديد وعَرَف تنوعَ أشكالٍ وتَمرَّسَ بأوضاع شديدة التباين خلال عشرات الأجيال ومئات السنين من جهة ثانية، وأخيراً لتمفصله مع جوانب من النفس البشرية أوسع من تلك التي تتمفصل معها معارفنا وإيديولوجياتنا الدنيوية. ولذلك فهو يصمد بقوة أكبر في مواجهة الانفعالات القوية، لكن ليس دون إعادة هيكلة مستمرة، أي توزع مختلف لمكوناته ومعانيه وقواه وإحالاته. يمكن فهم ظهور الإسلام السياسي، ثم السلفية الجهادية المعولمة، كأشكال من إعادة الهيكلة أو التشكل، ريفورميشن، «الإصلاح الديني». لكن إعادات الهيكلة الإسلامية كانت محركاتُها انفعالية، المبادر فيها هو الواقع المتغير وليس التعاليم الدينية غير المتغيرة،ناقشتُ أمثلة على إعادة تشكيل الإسلام على نحو يدر شرعية أعظمية على جماعات سلفية مثل القاعدة وجيش الإسلام في: الإسلام، الإسلاميون والعنف، في كتابي: الامبرياليون المقهورون: في المسألة الإسلامية وظهور طوائف الإسلاميين، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 2019. وفي: صورة وعلمان وراية، ضمن كتاب الثورة المستحيلة، عرضتُ أمثلة على تحوير كسول لشعارات مكتوبة على الجدران في دوما مثل الأسد أو لا أحد! إلى: الأسلام أو لا أحد! جنود الأسد مروا من هنا! إلى جنود الأسلام مروا من هنا! حتى أن الهمزة ظلّت فوق الألف. المغزى هو إعادة تصور الإسلام ليكون الحاكم المطلق مثل بشار الأسد، استجابة لضغوط واقع متحدٍ ومُتسارع التغيرات. ولا رؤى إصلاحية عامة تتيح لدين الإسلام امتلاك نفسه والتحكم بواقعه.
وليست الأفكار غير الدينية ممتنعة على إعادة الهيكلة، أي على الإصلاح والتشكل المغاير، لكن لأنها ذات تكوين عقلاني- نفعي مبدئياً، فإن ظهور تراجع نفعها أو تدهور قدرتها على تعقل ما يجري يدفع إلى التخلي عنها دون أزمات ضمير كبيرة خلافاً للمعتقد الديني. هل بقيت علاقتنا بالماركسية، مثلاً، بعد تجارب التعذيب مثلما كانت قبلها؟ ولا بحال من الأحوال إذا احتكمنا إلى أدب السجون السوري الذي كتبه معتقلون شيوعيون سابقون. حين لا تُهجر الماركسية كلياً، فإنها تصير جزءاً من تكوين فكري مغاير. تجربة السجن، وهي تجربة تتزاحم فيها انفعالات الخوف والغضب واليأس، تدفع السياسي- الحقوقي إلى الصدارة في تفكير المعتقلين السابقين، فلا تبقى الماركسية المحور التفضيلي لوعينا الذاتي.ثم إننا لا نكف عن هيكلة أفكارنا على المستوى الفردي. لقد فعلتُ ذلك طوال الوقت بصدد قضايا متعددة، ولقد كان الدافع وراء ذلك انفعالياً في الغالب، يتصل بتجارب جديدة اختبرت في سياق ما بعد الثورة السورية. على أن إعادات الهيكلة هذه لا تستبعد إدخال عناصر جديدة لم تكن موجودة في الهيكل الأقدم، ولا يتحتم أن تكون انفعالية المنشأ. تفكيرنا يتطور عبر عمليات من هذا النوع تربط تاريخنا الشخصي بالتاريخ العام.
ويعرض الليبراليون في بيئاتنا تشاؤماً صلباً، يحدث أن يكون مقاتلاً، وهو متصل على الأرجح بأن وجدان الفرد الفرداني الذي هو الليبرالي يُصدَم بما يعاين من أوضاع سياسية واجتماعية وفكرية وأخلاقية محبِطة. يصير التشاؤم آلية حماية نفسية من التقلّب بين انفعالات عنيفة.
والقصد المجمل من هذه الأمثلة هو أن نظام الانفعالات مبدأٌ للتاريخية، يفسر كيف تأخذ الإسلامية أو الماركسية أو الليبرالية أو غيرها أشكالاً متغايرة عبر الزمن وعبر المجتمعات المختلفة، وكيف تفقد صلاحيتها حين لا تستطيع التمفصل مع نظام الانفعالات القائم مثلما تقدم، إن من حيث القدرة على شرحه أو اقتراحِ سُبُلٍ للرد عليه. اجتماعنا السياسي المعاصر محرقة للأفكار لأنها قلّما تستطيع الرد على ثورة الانفعالات المستمرة، أي تغيير «الواقع السيء». لقد صعدت الأفكار الديمقراطية في ثمانينات القرن العشرين وما بعد بفعل أفضليتها في شرح أقوى منابع السوء، المنبع الدولتي، لكن من الواضح أنها أقل أهلية في مواجهة واقع أكثر تعقيداً كالذي نعيشه بعد الثورة السورية (هناك فاعلان آخران على الأقل، إلى جانب المؤذي العام: إسلاميون متنوعون، وقوى أجنبية محتلة). وفي حين أن الدين أقوى تَحمُّلاً للتغيّرات الانفعالية من الأفكار غير الدينية، فإن لهذه المرونة حدوداً فيما يبدو. تشهد على ذلك عمليات خروج من الدين تتكاثر في السنوات الأخيرة، بارتباط أكيد مع الأشكال الحدية وغير العاقلة من إعادات التشكل الدينية.
عقائدنا المختلفة أشبه بنا وبزمننا في كل حال منها بأصولها. في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته كان يُقال إن ماركسية المتأخرين متأخرة بدورها، وهذا وقت كان يفترض أن الماركسية هي خُلاصة التقدم الفكري التاريخي. تأخُّرُ الماركسية تَمثَّلَ في تلك الأيام باختزالها إلى سلة إجابات جاهزة أو غير نوعية على أسئلة نوعية يطرحها واقع مجتمعات مستقلة منذ نحو جيل، وتواجه مشكلات وطنية واجتماعية متنوعة، تُعاش انفعالياً كبؤس وتشاؤم وشعور بالعار وبحث عن خلاص ودعوة إلى الثورة. فكرة تعريب الماركسية، وكانت رائجة وقتها، عنت تقريبَ الماركسية من وعيِ واقعٍ كان يُفكَّر فيه تلك الأيام كواقع عربي. عبدالله العروي وياسين الحافظ اللذين تكلما على التأخر العربي كانا معنيين بتعريب الماركسية، أي إعادة هيكلتها أو تشكيلها في صورة أوفى بحاجات النضال العربي بحسب لغة تلك الأيام. هذه الدعوة إلى التعريب تعكس قوة الماركسية وقتها، ولو كانت ضعيفة لجرى التخلي عنها دون إشكال. بعد سنوات، بين أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، سيَشيع هذا التخلي بالتناسب مع تفاقم الضعف السياسي والرمزي والمعرفي للماركسية إثر تفكك الاتحاد السوفييتي وانفضاض معسكره. اليوم نفكر في هذا الشؤون بصورة مختلفة. ليس ما يلزم تعريب أفكار أو «تبيئة مفاهيم» على ما سيقول محمد عابد الجابري بعد العروي والحافظ بسنوات، بل هو مساحة التفكير النقدي الذي يضيء عوالمنا الانفعالية (وتقاليدنا ومعتقداتنا الموروثة). لكن هذا نقاش آخر.
جَمعَنَةُ الانفعالات
ما قد يبقى من ثقافة في شروط اجتماعية سياسية ضاغطة ومديدة كشروطنا هو شيء مقطوع الفاعلية على البنية الاجتماعية، لا يتشكل كمستوى اجتماعي أو بنية اجتماعية فرعية، بل ينزع إلى أن يكون مقطوع الفاعلية على سلوك المنتجين الثقافيين أنفسهم. والإنتاج الثقافي، الفكري والفني، في مثل هذه الشروط مهدد بأن ينقلب هو نفسه إلى تعبير شفاف كثيراً أو قليلاً عن الانفعالات السلبية، الفردية أو الجماعية. فيكون بذلك انعكاساً للبنية الاجتماعية ومثيراتها الانفعالية، وليس قوة تحويل لها.
والانقطاع البنيوي لتأثير الثقافة كفاعلية تهذيبية واعية على المجتمع يُسوغ القول إن غيرَ قليل من نقد المثقفين هو في غير محله. بل إنه يبدو أن التكرار المنفعل لهذا النقد هو ذاته أقرب على مؤشر على ما تورثه الانفعالات الحادة من هياج وقلة تمييز. ما يمكن أن يؤخذ على مثقفين بحق هو تواطؤ بعضهم مع شروط سياسية تلغيهم، أو تردهم إلى زينة نافلة. لكن، حتى لو لم يتواطأ أحد من المثقفين، فإن سياسيات الثقافة في بلد مثل سورية (فضلاً عن اقتصادياتها) تضمن ألّا يكون ثمة تأثير إلا للتزيينيّ والداجن من أنشطتها (مسلسلات التلفزيون وما في حكمها من سينما دعائية وغناء). لا يتعلق الأمر بحال بانعزال ذاتي وأبراج عاجية مختارة، بل بعزل بنيوي صلب ومديد.
إلى جانب المثقفين والانقطاع البنيوي، غابت الأحزاب السياسية التي يمكن تعطي الانفعالات وجهة عامة معقولة، والأصح أنها غُيَّبت، عبر عقود من الاستنزاف والتضييق. ما بقي لدينا من أحزاب تحولت من أحزابِ أفكارٍ إلى أحزابِ انفعالات، مجموعات متوترة تتأثر بما يجري حولها ولا تؤثر، أو هي صارت بلا أفكار ولا انفعالات، فلا تؤثر ولا تتأثر.
إلى ذلك، الانفعالُ شفاهيّ، وهو الضد التكويني للكتابة التي تتطلب الجلوس والعودة إلى الذات واستجماع الأفكار. لكن يمكنه أن يكون الضد المُغذّي، المحرض على التفكير. فليست المسألة في هذه المناقشة الدعوة إلى ضبط الانفعالات أو التحرر منها، مما هو مُمتنع بل وغير مرغوب. المسألة هي أنَّ تَخلُّلَ الانفعال للكتابة يسوقها إلى خدمة الشفاهة وإلى الجَمعَنة المنفعلة كما سنقول للتو. فإذا اتسعت مساحة حضور انفعالاتنا الغاضبة والناقمة والكارهة في الكتابة، توافق ذلك مع تقدم الشفاهة وعلاقاتها القائمة على العِشرة والعشيرة والاتصال المباشر، وضمر بالمقابل المجرد و«الخيالي» والمدروس. الهويات المنشطة في أطر اجتماعية سياسية عنيفة ومنفعلة تقوم على الشفاهة لا الكتابة. فإذا كتب التاريخ الثقافي للحقبة الأسدية يوماً، فلعله يلحظ صعود الشفاهة وعلاقاتها وأطرها الاجتماعية، وانحدار الكتابة كأحد أوجه الانحدار الاجتماعي الثقافي عموماً، أي الترثيث.
فإذا كانت الثورة السورية صراع انفعالات ومشاعر أكثر مما هي صراع أفكار وبرامج، فهذا غير منقطع الصلة بغياب فاعلين عامين وفضاءات عامة، كان يمكن أن تُيسِّرَ تحويل الانفعالات إلى أفكار ونقاش، فتوسع المساحة الداخلية للمجتمع. بالعكس، في مثل أحوالنا المتمادية طوال عقود، تتجه الانفعالات إلى أن تتجمعنَ فئوياً. فالمنفعلون الغاضبون يبثون انفعالهم الحاد في أوساطهم الخاصة وبيئاتهم وأهل ثقتهم. ويمكن التفكير في الروابط الأهلية كأُطُر لانفعالات مُجمعنة، أطر ثقة ضيقة يجري التعبير فيها عن الغضب والكراهية والحزن والنقمة ومَنازِع الانتقام. ولطالما كانت العائلة وحدة انفعالية على الدوام، تدور فيها على نحو تفضيلي وربما حصري انفعالات أعضائها. وهي تحملت في الحقبة الأسدية أعباء رهيبة، أفضت في بعض الحالات إلى تمزق حتى هذه الوحدة الصغيرة.
ويمكن التفكير في جمعنة الانفعالات فئوياً وأهلياً بوصفها أحد أوجه سياسة الانفعالات، سياستنا كمنفعلين، غاضبين كارهين محبطين…، لا يتاح لهم تصريفٌ عامٌ وآمنٌ لانفعالاتهم السلبية. يتقوقعون في نطاقات ضيقة، تبدأ بالعائلة وقد تنتهي بها. والعنف الثأري المنتقم أساسي في سياسة المنفعلين، إلى جانب الجمعنة. سياسة المنفعلين هي ذاتها سياسة منفعلة، تجنح نحو منطق رد الفعل المباشر، وتميل إلى مواجهة التمييز بالتمييز والعنف بالعنف والقسوة بالقسوة، مما رأيناه عياناً بياناً مع تآكل الوعود الباكرة للثورة بتحول سياسي وطني عام.
كما يمكن التفكير في أن جمعنة الانفعالات هي بمثابة تخزين للغضب والكراهية في قواقع أهلية ضيقة لا تتوافق حتماً مع «الطوائف»، على الأقل في الأوساط السنّية حيث تفشل جهود صنع طائفة سنية رغم وفرة الطائفيين السنيين. في هذه الأوساط أخذت جمعنة الانفعالات أشكالاً محلية وعشائرية، وأممية، وليس شكلاً سنّياً جامعاً. لكن يبدو أن هناك تناسباً طردياً بين تخزين الغضب وبين العنف، وأن المجموعات الأكثر تخزيناً للغضب هي الأشد تقوقعاً، والمرشحة لأن تركن إلى العنف عند تغير الظروف.
والواقع أن هناك نسقاً فرعياً للانفعالات في الإطار السوري يتصل بمخاوف الجماعات الأهلية المنفعلة من بعضها وعدم ثقتها ببعضها، مما يتغذى من نمط ممارسة السلطة في البلد، وهو ذاته تمييزي وطائفي، ولكن كذلك من نموذج الإسلامية السائد سورياً وعربياً، وهو نموذج سيادي يريد الدولة، وليس سياسياً يريد أن يُوجَد على قدم المساواة إلى جانب تيارات سياسية وفكرية أخرى. هناك تطييف متقدم للمجتمع السوري، يعززه ضعف الفاعلين العامين، من أحزاب سياسية ومثقفين ديمقراطيين ومنظمات مدنية، ممن يمكن أن يعبروا عن الانفعالات العامة بلغة اجتماعية وسياسية عقلانية.
والعلاقة بين نَسقَي الانفعال، المتصل بالدولة المؤذية وحكمها اليدوي، والمتصل بالمخارف الأهلية، لا تحكمها محصلة صفرية. فالنسقان يعملان معاً، وما يتصل بالحكم الأسدي من انفعالات خوف ونقمة ومهانة، وما يتصل بالجماعات الأهلية المطيفة من خوف وعدم ثقة، سارا طوال عقود معاً، والمزيد من الأولى اقترنت بالمزيد من الثانية. ولعل في ذلك ما يدل على أن المنبع الأول هو المهيمن، وهو ما يضمن تفعيل المنبع الثاني ودوام تجدده.
نحن وأوروبا
بالمقارنة مع مجتمعات أوروبية، بات بعضنا على إلفة بها بفعل تجربة اللجوء، حضور الانفعال المباشر في الكتابة وفي الحياة الاجتماعية محدود. النفوس ليست شاشات تنعكس عليها خشونة الحياة مباشرة، ولا يُعتدى على الناس بصور تُبقي انفعالاتهم متأججة وحبيسة صدورهم كأفراد أو حبيسة صدور جمعية. المجتمع يُصرّفُ الانفعالات عبر فضاءات عامة متسعة وعبر الأنشطة الاحتجاجية والنظام التمثيلي وحرية التعبير محدودة القيود. الاجتماع السياسي هنا غير جارح، والدولة ليست مؤذياً عاماً، وليست هي الأنانية مُعممةً.
والواقع أن الأمر يتعلق باختلافات نوعية وليس بفوارق كمية في الانفعالات بيننا وبين أوروبا. نظام الانفعالات هنا محدد اقتصادياً أساساً، يتصل بفرص العمل والدخل والأمن الاجتماعي. أكثر ما يثير القلق في أوروبا يحيل إلى ذلك، لا إلى تجارب مع الدولة. المؤذي العام هنا هو الرأسمالية، وبخاصة في صيغة الليبرالية الجديدة في العقود الثلاثة الأخيرة، حيث تجنح الدول إلى أن تُشابِه الشركات الكبرى. الأذى هنا لا يأخذ شكلاً جارحاً أو رضياً أو مُلوعاً مثلما لدينا، بل شكلَ قلق شعور بعدم الأمان وتوجس من المستقبل. دالُّ الأمن هنا اجتماعي- اقتصادي، بينما هو في بلادنا سياسي.
بيدَ أنه هنا أيضاً ثمة نسقٌ نامٍ من الانفعالات في أوروبا، يتصل بالهجرة والمهاجرين من بلدان متعثرة أو منهارة مثل بلدنا، وهو يظهر في مشاعر سلبية تجاه الهجرة، يحدث أن تنفجر عنفاً لا يزال فردياً بين حين وآخر. هذه الانفعالات تتجمعنُ في منظمات اليمين الشعبوي التي سجلت مؤخراً صعوداً مقلقاً في السويد وصعدت إلى الحكم في إيطاليا. ويربط الشكل الراهن من العولمة، وقد كمن خلف الأزمة الاقتصادية الحادة في 2008 و2009، بين نسقي الانفعال الاقتصادي الاجتماعي والقومي الثقافي، ما يُرجِّحُ أن يكون لصعود اليمين الشعبوي ما بعده. لا تزال الدولة قوة تَحكُّم عام عاقلة نسبياً، لكن الأمور تنزلق ببطء منذ نحو عقد ونصف، ولا تواجه من قبل الحكومات بغير منهج إدارة الأزمات، ومع ضعف قوى بديلة مسلحة برؤى وأفكار قوية.
تبدو الانفعالات هي القوية والمسيطرة في كل مكان من العالم قياساً إلى الأفكار. وهذا عائد جزئياً إلى ضعف، إن لم يكن موت، الأفكار التغييرية الكبيرة، التي كانت تساعد مئات الملايين من الناس على التحكم بانفعالاتهم أو توجيهها في اتجاهات تاريخية تغييرية. من يحملون أفكار كبيرة هم تيارات اليمين، وليس اليسار والخضر وما بقي من الاشتراكيين الديمقراطيين. ويبدو أن اليمين يكسب بالضبط بفعل احتياج نسبة متزايدة من السكان إلى ثقل الدين أو الثقافة أو العرق في مواجهة ما يُعاش كفوضى في الاجتماع والمعلومات والسياسة. ومستودعُ ما هو ثقيلٌ في عالم اليوم هو الماضي وحده.
خارج دوائر اليمين، عالم اليوم هو عالم «الأفكار الصغيرة»،تنظر مقالتي: أناس وأفكار وأزمنة، في الجمهورية، 14 تموز 2020. التي لا تستطيع مقاومة الانفعالات أو امتصاصها مثل الأفكار الكبيرة والضخمة، بل هي ذاتها أقرب إلى تعبيرات لحظية عن الانفعالات. نموذج الفرد المنتشر عالمياً اليوم هو فرد يعبر أولاً بأول عما يشعر ويحس، تسهل له من ذلك تكنولوجيات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي المتكاثرة. المُعبِّر اليوم هو الفرد المتابع، وقد كان قبل جيلين هو المنظمة الاجتماعية أو السياسية، أو ربما الشعب أو الأمة. في أزمنة أسبق كان المعبر هو نواب الله والنبي من الملأ الديني. كان الأفراد بقدرٍ ما نتاجَ عقائدهم الكبيرة، ما يؤمنون به من أفكار وأديان، وكان لهذه مفعولٌ تهذيبيٌ عليهم. نحن اليوم نبث أفكاراً طوال الوقت، وهي لا تهذبنا لأننا لا نلبث أن ننساها، وقلما نهذبها بفعل السرعة ونزعة وسواسية إلى ألا نفوِّت شيئاً. يقول بيونغ شول هان، وهو فيلسوف ألماني نشط، أن جهاز الهاتف المحمول هو ضرب من مسبحة مثل تلك التي كان يحملها المؤمنون المسيحيون (والمسلمون) وأن اللايك هو كلمة آمين.ينظر هذا الحوار معه. متاح في هذا الرابط. الملل الذي هو «ذروة الاسترخاء النفسي»، بحسب هان،Byung-Chull Han: The Burnout Society. Translated by Eric Butler, Sranford University Press, 2015; p13. مات عبر إدمان المتابعة. ومكمن الخطر أن الفرد المتابع، المعزول، المنفعل والضعيف، هو الذي قد يسعى وراء جسم ضخم يندرج فيه، أو يتبع زعيماً فاشياً. يبدو أن ذلك يحدث سلفاً، وكانت حنة آرنت قد قالت شيئاً مثله بخصوص التوتاليتارية في زمانها.Hannah Arendt: The Origins of Totalitarianism, Penguin Books, 2017; p423-427.
خلاصات
تُبنى على مجمل ما تَقدَّم خلاصةٌ نظرية تفيد أن الوجود الاجتماعي يحدد الوعي الاجتماعي وفق عبارة ماركس، لكن بتوسط نظام الانفعالات، استجابات الرضا والسخط، التي تثيرها منبهات الوجود في مجتمع في زمن بعينه. وجود الماركسية الاجتماعي ليس استثناء عن ذلك، كذلك وجود الإسلام الاجتماعي، أو وجود الليبرالية الاجتماعي. نُظُم تفكيرنا تتشكل اجتماعياً في كل حال بنوعية وجودنا، بمستويات الرضا والتنغيص المتاحة لنا فيه. وهذه المستويات لا تتحدد اليوم بـ«شروط الحياة المادية» ومستويات العَوَز والحاجة فيها فقط، وإنما بارتباط مع ذلك بأمن أجسادنا وتكاملها وكرامتها. نقترب من الجسد أكثر حين نتكلم على الانفعالات، سواء كان مدارها حاجاتنا المادية أم أمننا وسلامتنا.
وتقضي خلاصة أخرى، برنامجية، بوجوب دراسة بنية وتاريخ الانفعالات في مجتمعاتنا بصور أكثر تفصيلاً، وبالانكباب على مواردِ ملاحظةٍ أوسعَ نطاقاً من الثقافة العليا، ثقافة الفكر والكتابة، وأقل تعرضاً للرقابة بالتالي. اليوم، يمكن لمواقع التواصل الاجتماعي أن تكون المجال الأمثل لمثل هذه الدراسة، لاتساع نطاق الاشتراك فيها، ولاقترانها بثورة الانفعالات التي مثلتها الثورات العربية، ولكونها أوثقَ صلة بالنفس وأحوالها ومشاعرها وتعبيراتها، ولأنها تعرض طوال الوقت ثنائية الشفاهي والمكتوب، كما ثنائية الثقافة الشعبية والعالية.
وبالنظر إلى أن الانفعالات تتوسط بين التاريخ الاجتماعي والسياسي وتاريخ الأفكار، فإن النظر فيها ميدانٌ خصب للبحث والتفكير. فإذا جاز صوغ ما تريده هذه المناقشة في توصية، فقد تكون: فتش عن تبدلات المشاعر والانفعالات وراء تحولات العقائد والعناوين الفكرية! وعن تغيرات الأفكار في تغير بنى الانفعال والشعور!