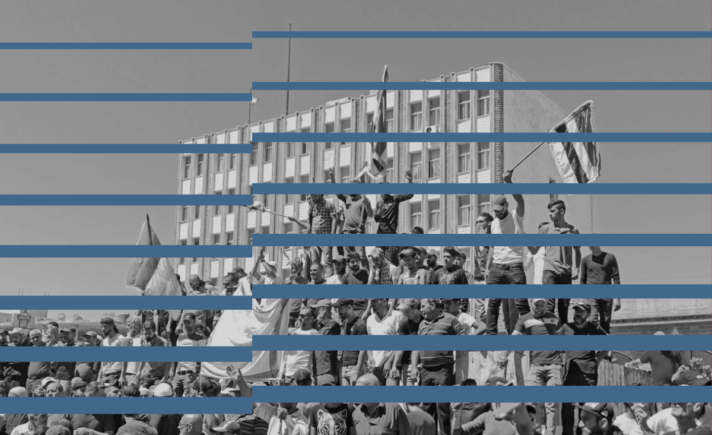وأنا على مشارفِ الأربعين من عُمري اتخذت قراراً بعدم الإنجاب. هنا في المنفى، بعمرٍ مليءٍ بالخسارات، أراقب الأطفال يمرّون مع أهلهم كالسحاب في شهر آب، يخفّفون حرّ الحياة ولظى الفقد.
من بيروت إلى برلين احتضنتُ حقيبةً صغيرةً كانت جنى ثمانية وثلاثين عاماً، فيها بعض ذكريات عائلةٍ مبعثرةٍ في أصقاع الأرض. عشر سنواتٍ لم أرَ فيها أمي وابتسامتها المضيئة كقنديل. كبرتْ ابنة أخي نور وصار عمرها ثمانية عشر ربيعاً، وقد تركتها طفلةً صغيرةً أحملها معي في مشاوير شوارع دمشق ومقاهيها. أنجب أخي فراس قمرين شاهدتُ صورهم من البعيد. ثم أنجب أخي الأكبر مرةً أخرى ولداً أسماه على اسم ثورةٍ أعطتنا يقيناً بأن هذا العالم ليس عادلاً وأخذت منّا كل ما نملك.. أسماه «ثائر» كي لا تذهب خساراتنا هباءً.
ماذا تبقى لنا في هذا الشتات؟
أسمع في ألمانيا قصصاً عن كيف حمل الأهل أولادهم من براثن القصف عابرين بهم البحار، وكيف كبروا في رحلات التيه من سوريا إلى تركيا، خائضين معهم لجة البحر، راكضين بهم في غابات أوروبا. كأنّ قدراً بمخلوقاتٍ أسطورية يطاردهم، وصاروا مقاتلين شرسين في معارك التشرد والبرد والعوز والقلة والوحدة تارةً، والفقد تارةً أخرى. يدرّبون أنفسهم يوماً بعد يوم ليكونوا قساة، يحاربون أشباح الماضي الذي يطاردهم والمستقبل الذي يقف كسيافٍ خارج عتبة البيوت. وبعد كلِّ ذلك، أدركتُ أن «العائلة» هو ما يستحقّ الدفاع عنه، وأن الإنجاب يخفّف وطأة الاغتراب الوجودي والفكري الذي نعيشه. أدركتُ أن الأطفال يَهبون تجربتنا معنىً بأفكارهم ومخيلاتهم وقصصهم وأسئلتهم. عندما جاءت ابنة أخي نور إلى الحياة وحملتها بين يديَّ، تأملت عينيها الواسعتين وذاب شيءٌ ما في قلبي. تعلّمت منها الرِّقة. وكثيراً ما سألتُ نفسي: متى يتحوّل الأهلُ إلى قُساة؟ كيف تستحيل رقةٌ تبثّها ابتسامةُ طفلٍ في قلوبنا إلى عنفٍ مفرطٍ وقسوةٍ غَير مفهومة؟ كيف يمكننا إيقاف عجلة الألم التي تدور دون توقف؟
لا أعلم متى بدأت تكبر بذرة هذا القرار. ربما يعود ذلك إلى طفولتي، فقد كان والدي رجلاً ذا كاريزما، حادّ الذكاء ومحبّب الشخصيّة، لكنه كان قاسياً.. كحال جلّ الآباء في سوريا. ولطالما بُرِّرت قَسوةُ الآباء تحت حجةِ حماية الأولاد، ثم بدأتُ أفهم أنَّ تلك القسوة كانت عُنفاً متوارثاً. لم يكن جميع الآباء عنيفين، فمنهم من منح عائلته الحب و الانفتاح ولم يمارسوا «حق» القوة-العنف-القسوة. ذلك أن «القوة» هي نواةٌ لجميع أنواع السلطات، وخصوصاً الدكتاتورية، وهي ترسم العلاقة المجتمعية بين الأب والأم والأولاد من جهة، والعلاقة مع السلطات من جهةٍ أخرى. في اللحظة التي يتزوج فيها الرجل يكتسب حقه في القوة. تصبح لديه عائلة يكون فيها الآمر الناهي على الزوجة والأولاد وصولاً إلى الأحفاد. يستقي هذه القوة من القانون في بعض الدول، ومن العادات والتقاليد ومن الدين في دول أخرى. وتقترن مسألة الإنجاب بالنسبة للرجل والمجتمع بـ«الفحولة»، فالمعنى المجتمعي العميق للفحولة ليس إلا قدرة الرجل على ممارسة سلطته على أولاده؛ فالرجل الذي لا ينجب لا سلطة له يمارسها على أحد. كما ترتبط الفحولة أيضاً بالأولاد «الذكور»، فمن خلالهم يعزز الأب قوته. والأب الذي ينجب «إناثاً» فقط لا يعتبر قوياً من الناحية المجتمعية. ثم تبدأ العائلة بإعداد الإناث زوجاتٍ للذكور الأقوياء، وعند هذه النقطة يبدأ الخلل في حقوق النساء والرجال في المجتمعات، وتبدأ جميع الممارسات العنيفة بحق المرأة.
يعرّف ماكس فيبر القوة على أنها قدرة أحد الفاعلين على فرضِ إرادته في علاقةٍ محددةٍ بموجب المصالح والمعايير الاجتماعية. وبصرف النظر ما إذا كان هناك مقاومة ناشئة، يساعدنا هذا التعريف في فهم علاقة الأبوّة التي تفرض الإرادة في العلاقات العائلية (الأمومة، الأولاد)، والتي تجعل منهُ مصدراً للسلطة وممارساً لها، وهي ترسم المعنى الفلسفي العميق لتلك المفاهيم.
وقبل الحديث عن الأبوة سأحاول الحديث عن معنى الأمومة، فماذا يعني أن تكون المرأة أماً؟
تبدو الأمومة مقترنةً بفعل الحياة. سأستند إلى ما قاله فرويد في تحديده للإثنية التي تهيمن على حياة الإنسان في كتابه الأنا والهو، وهي: «الحياة وغرائزها»، و«الموت وغرائزه». يصف فرويد هذه الإثنية قائلاً: «إلى جانب غريزةِ حفظ الجوهر الحي، لا بد أن تُوجدَ غريزةٌ عكسية أخرى تسعى إلى حل تلك الوحدات وإعادتها إلى حالتها الأولى غير العضوية». تبدو غريزة حفظ الجوهر الحي إحدى تجليات الأمومة، وهي لا تتوقف عند ذلك، لكنها تحمل أيضاً جزءاً من صراعنا نحن الأولاد وعلاقتنا بالأمهات وعلاقة الأمهات بالأبناء.
تذكر إيمان مرسال في كتاب كيف تلتئم: عن الأمومة وأشباحها قصيدتين للشاعرة سنية صالح ربما تلقيان الضوء على العلاقة المعقدة بين الأم وأولادها. تطلق صالح على الأولى «رُعب الفطام». أي ذلك الخوف من انفصال الولد عن الأم وما يخلق داخل الأم من مشاعر متناقضة حول انفصال الأولاد عنها.
أغرقي رأسك فيَّ
اخترقيني
حتى تكاد عظامنا تغيب داخل بعضها البعض.
ولنكن متجاورتين
متشابكتين كثنائية القلب.
المسيني كما يلمس الإلهُ الطين
فأنتفض بشراً
وفي القصيدة الثانية تبدو مخاوف الأمومة أكبر ليس بعلاقتها مع أولادها فقط، إنما مع المحيط كامرأة بالدرجة الأولى وكأم بالدرجة الثانية. حيث تحدد الملامح «الذكورية الأبوية» التي تصيغ هذا العالم (التاريخ، والمحاربون العظماء، والجلادون). جميع هؤلاء بالنسبة لصالح هم ذكور تخاف على ابنتها منهم. وإذا ما عدنا إلى فرويد، يبدو الرجال في هذه القصيدة هم الوحدة الثانية التي تهيمن على حياة الكائن الحي؛ أي وحدة الموت وغرائزها. قد يبدو هذا التوصيف مبالغاً فيه، لكن يتّخذ في قصيدة صالح دلالةً واضحةً ومباشرة تحيل إلى حديث فرويد.
أيتها اللؤلؤة
نمتْ في جوفي عصوراً
استمعتْ إلى ضجيج الأحشاء
وهدير الدماء
ريثما ينتهي التاريخ حزنه
ريثما ينتهي المحاربون العظماء حروبهم
والجلادون جلد ضحاياهم
ريثما يأتي عصر من نور
فيخرج واحدنا من جوف الآخر
كانت أمي امرأةً جميلةً قادرةً على أن تجعل من مر الحياة أمراً حلواً. وكساحرةٍ هونت علينا قسوة الحياة وجعلت منها مغامرة. يكفي أن نراقب الأمهات عندما يصنعن من فوضانا صباحاتٍ جميلة، يهذبن طباعنا ويرسمن لنا طريقاً من الدعوات والأمنيات قادرةً على أن تحفظنا من كل سوء. لطالما شعرت أن ثمة قدسية تحيط بأمي؛ شيءٌ ما يشبه صور الأيقونات. لكنني أدركت أنها لم تكن ملاكاً. درّست أمي أجيالاً خمسة وعشرين سنة، وكان عليها أن تعمل وتربي أربعة أولاد، ثم حُرمت من رؤيتهم. أستطيع الآن تذكر دموعها وقنوطها من قسوة عالمٍ لم يكن منصفاً بحقها؛ لا كامرأة ولا كأم. لم تكن أمي مقدسةً كما اعتاد المجتمع أن يصوّر الأم، فالقدسية تحرم المرء من أن يشعر ويتألم. وهذا ما يُطلب من المرأة التي تُعَدُّ فقط لتكون أماً مقدسة.
وقد تبدو الامومة متأرجحةً بين موقعها المقدس ورغبة الأمهات بتحقيق ذواتهن وأحلامهن. يبدو ذلك جلياً في تجربة الأمهات في المنفى، فمع وجود بعض القوانين المنصفة للمرأة، سمح لهن التحرر من سلطة الأب والعائلة لطلب الطلاق، الذي يعتبر بمثابة الكفر في بلادنا. فالمرأة المطلقة عانت نبذ المجتمع والعائلة. وتعتبر كلمة «مطلقة» وصمة عارٍ تلاحقها لسنين طويلة. ويمثل الطلاق سلاحاً يبتزُّ به الرجلُ المرأةَ في الغالب، وهو وسيلة للاخضاع والتحكم. وفي حال حدوث الطلاق يتحول الأطفال إلى ساحة للابتزاز شديد القسوة، تمتد لسنوات طويلة قد يذهب فيها الأب والأم إلى المحاكم، وتقع فيها الأم نهباً للتلاعب، وتُنهك في معارك طويلة لا تجد نهاية لها.
وفي خضم ذلك تسعى الأمهات لتربية أولادهن بعيداً عن تلك العلاقة الهرمية من جهة، ولتحقيق أحلامهن من جهة أخرى. لكن حتى في دول المنفى لا يبدو ذلك سهلاً. فقوانين العمل لا تبدو منصفة للأمهات، ولا حتى نظرة المجتمع التي تبقى تلاحق الأم كما لو أنها لعنة. قد يبدو ذلك في بعض الأحيان كما لو أنه نواة لثورة تحاول فيها الأمهات تعليم أولادهن ألاّ يكونوا آباءً يمارسون سلطتهم التي تفضي غريزة إفناء الكائن الحي بالحروب والصراعات، كما يصفها فرويد؛ أو عظماء وجلادين ومحاربين، كما تصفهم سينة صالح
إنهنّ مجبوراتٌ على الكدح لضمان حياة كريمة، ويحاربن بشكلٍ يومي في سبيل تأمين حياة كريمة، ويلعبن جميع الأدوار كأم وأب وجد وجدة وعائلة حنونة وحامية ورحيمة على الأولاد، ليحققن ذواتهنّ ويكنّ مستقلاتٍ قادراتٍ على خلق التوازن في البيت المحاط بكل أنواع الاغتراب.
الأب المقدس
يَصف لنا الإنجيل الثالوثَ المقدس بـ «الآب» و«الابن» و«الروح القدس». توضح هذه العلاقة تجليات الهرمية في العائلة، فالمسيح يذهب إلى صليبه تنفيذاً لمشيئة «الأب». تحمل القصة في دلالتها عنفاً شديداً في علاقة الأب والابن، فيطلب الأب من الابن الذهابَ إلى صليبه تنفيذاً للمشيئة الأبوية التي تقتضي الإذعان. ولعلنا نلمح شيئاً من ضعف الابن وبحثه عن أبوةٍ ضائعةٍ ورغبةٍ بالرحمة والرأفة، فعندما يُثقب جسده ويُصلب على الخشبة وهو مليءٌ بجروحه وآلامه وقبل موته يهتف قانطاً: «أبي، لماذا تخليت عني»!
كما تصف لنا قصة النبي إبراهيم أيضاً في الكتب المقدسة شكلاً مشابهاً للعلاقة الأبوية المقدسة التي تفترض الطاعة. وفي القصة أنّ النبي إبراهيم يرى في حلمه أنه يقتل ابنه إسماعيل، فيقصُّ إبراهيم رؤياه على ولده، ويخبره أنه ماضٍ في تنفيذها. وتخبرنا القصة أن إبراهيم يمتثل لطاعة أبيه، فيأخذ إبراهيم ولده إسماعيل إلى الجبل لذبحه، ثم يفتدي الله الولد بالأضحية. إن هذا الموقف ليس فقط امتحان مشيئةٍ إلهية، ولكنه امتحان الرضوخ في علاقة «الأب» و «الابن». فإسماعيل لم يكن لديه خيارٌ حتى في رغبة إبراهيم في قتله.
نلاحظ غياباً لموقع الأم في تلك القصص؛ (الأم، الزوجة)، فموقع السلطة يتحدد مع الأب والزوج في القرارات المصيرية، والإذعان يرتبط بالأولاد والزوجة لذلك الموقع. فقدسية الأب هنا تختلف عن قدسية الأم، ذلك أن الرجل في تلك العلاقة الهرمية هو الذي يحدد معايير علاقته مع الأولاد والزوجة.
ينتج عن سلطة الأب صراعٌ بينه وبين والابن، ونلاحظ أنه لا توجد تلك الإشارة لعلاقة الصراع بين الابنة والأب، ذلك أن الابنة تنشأ مجردةً من القوة التي تتيح لها التنازع والصراع مع الاب. ولعلنا شاهدنا الكثير من الفتيات يدخلن في صراعاتٍ وتمردٍ على الأب في عمرٍ معين بعد إحساسهنّ بالسلطة المطلقة التي يمارسها الأب على أولاده.
ويفسر فرويد مشاعر الأبناء بحسب جنسهم بعقدة أوديب (عقدة الكترا). ولعل تفسير فرويد لا يأخذ بعين الاعتبار أن علاقة الأب بالابن يحددها الإطار الاجتماعي والسياسي والديني في المجتمع.
لكن مَن هو الأب؟ ما هو المعنى الحقيقي للأبوة؟ يتساءل محامي الدفاع في رواية الإخوة كارامازوف في فصل (الزاني بالفكرة). وفي محاولة الإجابة عن ذلك يستشهد بما قاله بولس الرسول: «لا تغيضوا أبناءكم». لا تجعلوا منهم أعداءً لكم. وإذا ما كان هنالك سببٌ لقتل الأب؛ سواء واقعياً أم معنوياً، فلا يعود ذلك لتنافسٍ بيولوجي كما ذكر فرويد، وإنما بسبب القسوة والأنانية والجشع الذي من الممكن أن يكون عليه الأب أثناء تربية أبنائه. لقد كان الأب كارامازوف مثالاً حقيقياً لما هو عليه الأب في مجتمعاتنا؛ قاسياً جشعاً حقوداً ومليئاً بالرغبات غير المشبعة. ذلك ما يدفع «سمردياكوف»؛ الابن غير الشرعي له بقتله. ولم يكن سمردياكوف وحده من يشتهي قتل والده، لكن جميع أبناء المجتمع قد تمنّوا ذلك؛ تمنوا قتل أبائهم الذين يهيمنون على كل قرارٍ من قرارات حياتهم كقادةٍ خالدين.
يمثلُ قرار الإنجاب محنةً، جسدها المخرج الأمريكي دارين أرنوفسكي في فيلمه نوح (إنتاج سنة 2014 ومن بطولة راسل كرو)، فمعضلة نوح كما طرحها الفيلم هي التضحية بنسله مقابل فناء البشرية بعد انتشار الخطيئة (العنف بكل أشكاله ضد الحيوانات والنساء والأطفال). يمنع نوح أولاده حام ويافث من الزواج، فيما إيلا، زوجة سام عاقر. وبصعوده إلى السفينة مع الحيوانات، يتأكد أنه قد أنجز مهمته، فبعد انحسار المياه سيطلق نوح الحيوانات، ثم ستموت عائلته تباعاً وسيكونون آخر أهل الأرض.
يواجه نوح قراراً صعباً، فهو في حالةٍ من التغريب الواقعي عن موطنه (الأرض) والتغريب الوجودي، حيث سيرتكب جريمة قتل البشرية جميعاً، فمسألة الإنجاب هي المفتاح الذي يستطيع نوح أن يديره في قفل الدائرة غير المنتهية من العنف المتوارث. يتخلى نوح عن سلطته كأب، ويقتل ذلك الميل الأصيل في داخله تنفيذاً لفكرةٍ سامية. يواجه رغبته الذاتية في استمرار نسله أمام قتل ذلك العالم المتوحش الذي أصبح فيه الرجال يستعبدون النساء والأطفال.
لكن رغبة نوح تُواجه برغبة زوجته والهة، فينتقل الفيلم إلى صراع من نوع آخر، فنوح يجسّد رغبة الموت، فيما والهة تجسّد رغبة الحياة (حفظ جوهر الكائن الحي عن طريق الإنجاب). وبمعجزةٍ تمنح والهة لزوجة سام (إيلا) قدرةً على الإنجاب. وفي لجة الطوفان حيث البشرية تغرق بآثامها، يكتشف نوح أن زوجة سام قد حملت.
يشعر نوح بالضياع الكامل، ثم يقرر أن ينتظر مولود إيلا، فإذا كان ذكراً سيدعه يعيش، وإذا كان بنتاً سيقوم بقتلها تنفيذاً لمهمته. يظهر نوح في تلك اللحظات قاسياً عنيفاً من ناحية، وعاجزاً متردداً شكاكاً من ناحيةٍ أخرى. تلد إيلا فتاةً، فتهرب بها إلى سطح الفلك فيلحق بها نوح حاملا سكينه. وفيما يهم نوح بقتلها واضعاً سكينه على عنق الفتاة الصغيرة، تغني إيلا أغنيةً كان نوح يغنيها لها عندما كانت صغيرة. وقبل أن يصل نصلُ السكين إلى عنق الفتاة تسيل دموعه ثم يرسم قبلةً على جبهة الفتاة ويتركها لأمها.
قد لا ينقذ قراري بعدم الإنجاب البشرية، وربما هو اعترافٌ ضمني بتنازلي عن تلك السلطة الممنوحة لي بحكم المجتمع والدين والعائلة، وربما تلح الرغبة مع مرور الوقت لأعدل عن هذا القرار، لكنني أسأل نفسي إن كان بإمكاننا أن نكون آباء لا بفعل شيء بيولوجي، ولا بفعل سلطةٍ يمنحنا إياها المجتمع والدين والعائلة، وإنما بسلوكنا الذي يجعل منا آباءً؛ شيءٌ نكتسبه بفعل الممارسة، وأن يكون الحب هو المفتاح الذي يحيد عجلة العنف والقسوة عن طريقها، وأن يكون لنا القدرة على الرأفة بأنفسنا وزوجاتنا وأولادنا حتى نستطيع أن نمر بسلام في رحلة الحياة القاسية.