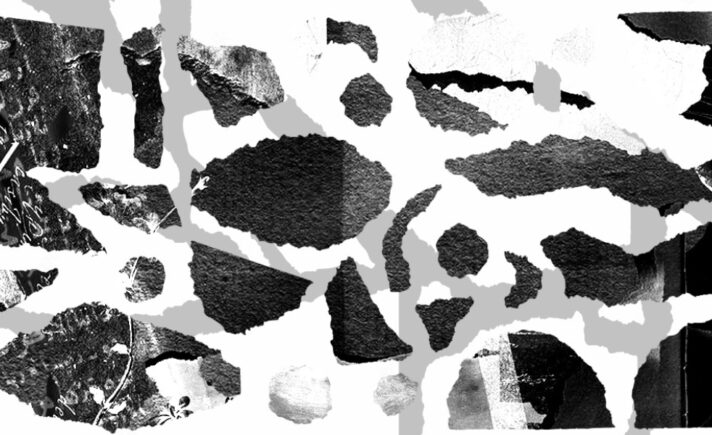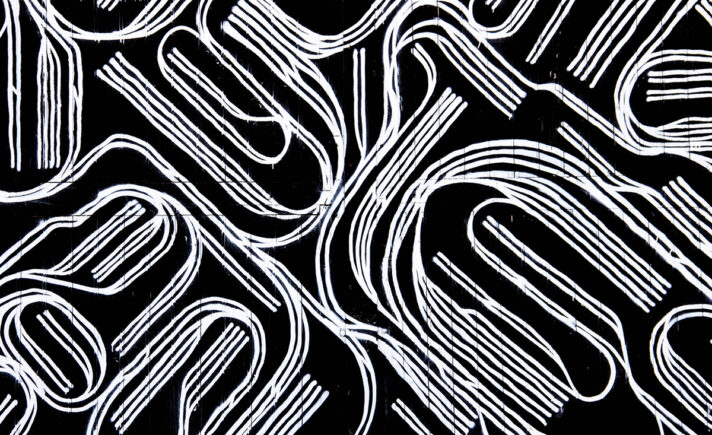تسعى هذه المقالة لفحص حدود المنطق الكامن خلف سؤال الإصلاح الديني فى سياقنا العربي ومدى صلاحيته، بالإحالة إلى ملاحظة تتعلق بطبيعة الإيمان الإبراهيمي استناداً إلى تجربة أيوب بوصفها تكثيفاً لهذا الإيمان.
يتناول القسم الأول من المقالة سؤال الإيمان الابراهيمي كما تعرضه تجربة أيوب. فيما يتناول القسم الثاني سؤال الإصلاح الديني في السياق العربي، محاولاً فحص المنطق الثاوي خلفه. في القسم الثالث من المقالة تتم مقابلة السؤالين (سؤال الإيمان وسؤال الإصلاح) ببعضهما في محاولة تبيين اختلاف موضوعات السؤالين وإشكالياتهما.
أيوب، الإيمان وعدل الله الملغّز
تكشف شخصية أيوب طبيعة الإيمان الإبراهيمي بشكل مكثف، الإيمان الإبراهيمي بوصفه:
أولاً: تسليماً تاماً لإرادة الله الفائقة.
ثانياً: طبيعة العدل الإلهي الملغّزة، والناشئة عن الطبيعة الفائقة والمفارقة لله، مما يجعل مساءلتها غير مفيدة. فالعقل الإنساني غير قادر على التكهن بالطبيعة الحقة للعدل الإلهي، وربما تؤدي هذه المساءلة نفسها إلى شبهات تضعف إيماننا وتكون سبباً لخداعنا وضلالنا، مع نُبل القصد المتمثل بالفهم والوصول إلى الحقيقة. والأسوأ أن هذه المساءلة نفسها قد تشير إلى خطيئة قاتلة وهي التكبر.
ثالثاً: النظر إلى الحياة الدنيا بوصفها مكان اختبار (رغم أن أيوب لم يعرف فكرة الجنة وجهنم، ما يجعل منه نفسه نموذجاً أشد قوةً وعمقاً مما تفترضه السياقات المسيحية والإسلامية، وحتى اليهودية المتأخرة، التي تحيل إلى الحياة الآخرة كمكافأة).
ما يعنينا هنا هو تقديم ملاحظة عن «الإيمان الإبراهيمي» استناداً إلى فهم الشبكة التي تنظم الأشياء الثلاثة المكونة لنظام العالم، وهي: الله والطبيعة والإنسان. وهذا يعني فهم تصورهم عن هذا النظام (من منظور الفاعل/الشخص الأول)، كيف يعاينون النظام الذي تنضبط فيه هذه الأركان الثلاثة ويدركونه. إن فهم تجربة الإنسان في العالم، طبيعة المنطق الذي يحكم سلوكه والمعايير والأهداف التي تضبط أفعاله، لا ينفصل عن فهم نظام الأشياء الذي يحدد مكان المرء في العالم (بالتحديد في مقابل القطبين الآخرين: الله والطبيعة). يقدم أيوب تجربة نموذجية لمعاينة موقع الإنسان في هذه الشبكة، سواء من جهة موقعه من الله والطبيعة، وموقع الأخيرة بدورها من الله، لكن أيضاً من جهة طبيعة هذه العلاقات والحدود التي تؤطرها.
تظهر الطبيعة (أو العالم الدنيوي) باعتبارها مكان اختبار للإنسان أمام عيني الله، هي مكان إقامة مؤقت لأهداف قد لا ندركها تماماً وتتجاوز حدود المكان وزمن الإقامة ذاتهما. بالمقابل، يتعالى الله عن القطبين الآخرين: الإنسان والطبيعة. إن الطبيعة الفائقة لله تتجاوز إدراكنا البشري المحدود، وهذا يصدق بالتالي أيضاً بخصوص أهدافه وخطته، بما يجعل من علاقتنا به تقوم على مرتكز الإيمان أولاً وليس العقل. وهذا ليس رفضاً أحمقاً ومتعسفاً للعقل، كما قد يبدو، إنما تأسيساً على إدراك الطبيعة الفائقة، وحقيقة أن العقل ما أن يسعى إلى القبض بالكلية على طبيعة الله فإنه ينتهي إلى مآزق لا تتوقف، مآزق تجعل من «الله» متناقض ومقيد ونسبي بما ينفي عنه الألوهية نفسها. إن التركيز على الإيمان هو نتيجة إدراكٍ واعٍ للمأزق الناشئ عن السعي للإحاطة بالمطلق واستحالة مثل هذه الإحاطة. لكن هذا التأسيس على الإيمان يجعلنا، بالمقابل، نواجه موقفاً محدداً في تأطير خبرتنا مع الطبيعة والله، وهو إدراكنا لطبيعتها الغامضة ومن ثم عجزنا عن استخلاص نتائج قائمة على افتراضات سببية منظمة وواضحة. هناك دوماً مساحة للغموض الذي ليس لنا معه إلا الإيمان. إن أمسك العقل العالم فلن يكون هناك مكان لله، أو لن يكون هناك سوى إله محتجب لا نميزه عن القانون نفسه. وقد أدرك الأشاعرة –خاصة الغزالي- هذا الأمر بشكل مبكر وواضح، وقد كان هذا الموضوع مادة أساسية في تقاليد لاهوتية عدّة، كما كان حاضراً بوضوح على قائمة مارتن لوثر في مجادلاته حول الإيمان والعلاقة بين اللاهوت والفلسفة.
لننظر إلى تجربة الإيمان كما تتجلى في حالة أيوب:
أيوب رجل صالح في عيني الرب، لم يخطئ أو يفعل ما لا يرضي الله، ولكن ولهذا السبب يجب عليه أن يمر بأشد الاختبارات قسوة، أشد ما يمكن أن يتعرض له إنسان على الأرض، اختبار خسر أيوب فيه ماله وأبناءه وعانى اعتلال جسده. لم يخطئ أيوب حتى تكون معاناته ثمناً لهذا الخطأ. على العكس تماماً، معاناة أيوب مرتبطة بكون أيوب صالحاً ومؤمناً قوياً بما يكفي لأن يتعرض معه لأشد الاختبارات وأقساها. قسوة الاختبار وشدته لا تتناسب مع الخطيئة، بل مع قوة الإيمان. حدثنا قتيبة حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة (سنن الترمذي 2398). من هنا يمكن البدء في النظر إلى ما يميز الاعتقاد الإبراهيمي في تصوره للعلاقة المؤمن بالله، ومن ثم الدور الذي تشغله الحياة الدنيا في هذه العلاقة. فالحياة الدنيا عموماً ليست جزءاً أصيلاً يحكم العلاقة التي تجمعنا بالله. إيماننا بالله لا يقوم على وعد بالسعادة في هذه الحياة، وعليه فإن حال الدنيا (السعادة أو النجاح) ليس مؤشراً لصحة أو صلابة اعتقادنا وإيماننا بالله. على العكس، ما تقوم عليه هذه العلاقة هو حضور المحنة، الابتلاء والتجربة الذَين يكشفان قوة وصلابة إيماننا بالله. الإيمان -بحسب ما يعرفه الرسول بولس- هو يقين ورجاء بما لا يمكن رؤيته أو التحقق منه، وهو يتصلب ويقوى عبر الاختبار والمحنة. صور الشهداء ومعاناة القديسين وتجارب المتصوفة (والمجاهدين كذلك) تحيل جميعها إلى هذه الابتلاءات التي لا تُنتظر معها جائزة أو مكافأة دنيوية. ما يعطينا القدرة على مواجهة هذه الابتلاءات والصمود أمامها هو إيماننا ويقيننا بالله، مدركين أن هذه الابتلاءات ليست إلا اختبار إيماننا ويقيننا.
لا يستدعي هذا الشكل من العلاقة بين الإنسان والله في التصور الإبراهيمي السعادة أو النجاح في الحياة الدنيا لتقييمه، وبالتالي التحقق من طبيعة فهمنا لعمل الله وخطته، التي هي غامضة وتتجاوز إدراكنا تماماً. وكما في حالة أيوب، فإن خطة الله بقيت غامضة وملتبسة دون إجابات واضحة سواء لأيوب نفسه أو لمن يقرأ السفر، وبالطبع لمن وقع عليهم البلاء برفقته (لنفكر بأبنائه الذين قضوا حتفهم كنتيجة للمحنة ولن يعودوا، بحسب رواية العهد القديم). بالمقابل، وانطلاقاً من إدراكنا للطبيعة الغامضة والملغّزة لعمل الله -وهي كذلك فقط لأن عقولنا ليست قادرة على فهم مراد الله والإحاطة به كليةً- فإن أساس هذه العلاقة يقوم على الإيمان واليقين، وهما يتجليان حقاً في الابتلاء. إيماننا بالله لا يتسق ويستقيم إلا في إطار الحضور الدائم والمحايث للابتلاء في حياتنا، فنحن في كل لحظة معرضون للتجربة، ورحمة الله وحدها هي التي تقينا. فغياب الابتلاء (أو التجربة) لا تعني عدم وجودها، فهي الممكن الأصيل الوحيد الذي نعيشه. في سياق شبيه، لم يعد المسيح أتباعه بالسعادة، بل بصلبان عليهم أن يحملوها ويسيروا وراءه في الطريق. هنا لا تلعب السعادة دوراً يذكر، ليست إشكالاً للتفكر فيه. وبمعنى آخر إن الطبيعة (أو الحياة الدنيا) هي فقط مكان اختبار، وليست موضع حكم، ليست محلاً يمكن اعتماده لأن نحكم فيه على خِطَّة الله أو على إيماننا فيه وطبيعته.
يقدم أيوب تجربة إيمان مؤسسة كلّياً على التسليم والمحنة، تسليم لإرادة الله وعدله الفائقين (والمُلغّزين لهذا السبب أيضاً) وتسليم بالمحنة في العالم بوصفها كشفاً لحقيقة الإيمان وقوته.
الإصلاح الديني
منذ عصر النهضة وسؤال الإصلاح الديني يُطرح بشكل مستمر كحاجة ملحة وماسّة للتقدم والنهضة العربية. لكن، ورغم مركزية هذا السؤال والاتفاق العام عليه، لا يبدو أن هناك اتفاق موازٍ حول المقصود بـ «الإصلاح الديني»، وهو ما كان مثار نزاع دائم بين تيارات مختلفة نسبت إليه معاني مختلفة ومتباينة بشدة، بحسب موقعهم الذي يتحدثون منه. فالإصلاح مرة كان عودةً إلى الدين وتحريره من جمود التقليد والمذهبية، ومرة أخرى كان دعوة إلى تفسير جديد ومختلف للدين بما يجعله متوافقاً مع القيم المعاصرة التي تشكل خلفية دعوة الإصلاح، وثالثة دعوة لقراءة تاريخية للنصوص المؤسسة.
مع هزيمة الربيع العربي، والدور الذي لعبته التيارات الإسلامية بكافة أشكالها في الوصول إلى هذه الهزيمة، عاد السؤال بإلحاح متزايد، خاصة أن النزاع مع الإسلاميين كان المدخل الذي استغلته الدولة العميقة والأنظمة العربية في تمزيق صفوف المنتفضين ودفعهم لمواجهة بعضهم البعض. فالسؤال حول موقع الإسلام ودوره في المجال العام والدولة في إطار النظام الجديد المأمول بعد الثورة كان حاسماً في بلورة منازعة أكثر مركزية من المنازعة مع النظام العربي، ما ساعد على شق صفوف المنتفضين (مثلما حدث في مصر) أو أقصى عنهم -منذ البداية- فئات واسعة من مجتمعاتهم التي وقفت في مواجهتهم مباشرة أو اكتفت بالحياد السلبي المستند إلى ريبة وتوجس من «إسلامية» المنتفضين (مثلما حدث في سوريا). مع عودة سؤال الدين والإصلاح الديني مجدداً إلى الواجهة، عادت المؤتمرات والندوات والنقاشات حول الإسلام والإصلاح والقراءات الجديدة، ما ترافق خصوصاً مع السعي لتقديم قراءة مقاصدية، هذه المرة، باعتبارها حلاً ممكناً للمعضلة الإسلامية.
ليس الهدف الذي تسعى إليه هذه الورقة الانخراط في نقاش الإصلاح، بقدر ما تهدف إلى إثارة التساؤل حول سؤال الإصلاح الديني نفسه، حول المنطق المضمر في السؤال ومدى رجاحته، خاصة أن السؤال صار بحاجة للتفحص بعد تعثر محاولات الإجابة عنه لما يزيد عن القرن. بالطبع، الإصلاح ليس مجرد سؤال مطروح على المستوى النظري، فالعديد من المحاولات الفكرية العظيمة والمهمة لتقديم قراءات جديدة وفتح آفاق جديدة لفهم الدين لم يكتب لها النجاح بالتحول إلى مشروعات نهضة متجاوزةً حدود الكتب أو قاعات المحاضرات. سؤال الإصلاح الديني سؤال عملي، أو بدقة أكبر سؤال يشتبك فيه العملي والنظري، سؤال غايته تقديم أيديولوجيا تتحول إلى قوة مادية يؤمن بها الملايين ويستلهمونها في تنظيم مُعاشهم. وبهذا فإن سؤال الإصلاح يتحول إلى سؤال عن الحامل الاجتماعي لهذا الإصلاح الذي يقع عليه عبء تحويله إلى واقع وممارسة. هذا جانب من المعضلة، لكن هناك جانب آخر يعنينا أكثر، وهو فحص الفرضيات الضمنية التي تعتمدها محاججة الإصلاح بما يسهم بشكل أفضل في فهم التعثر الذي لازم مشروعات الإصلاح وحال دون تحولها إلى أفكار مهيمنة وقادرة على فتح آفاق جديدة للممارسة الاجتماعية.
يمكن تقديم المحاكمة الضمنية التي تعتمدها دعوى الإصلاح على الشكل التالي:
1- أوضاعنا، سواء نظرنا إلى أنفسنا كأفراد أو جماعات، في أسوأ حال أياً كان المعيار الذي نعتمده، الهزيمة أو التخلف أو التأخر الاقتصادي أو المهانة والأوضاع المزرية للأفراد أو الاستبداد أو التوحش وهلم.
2- بالتالي فإن هناك شيء خاطئ في الطريقة التي نمارس بها حياتنا، بما يفسر تخلفنا وتدهور أحوالنا.
3- طريقة حياتنا محكومة بنظام معين من الاعتقادات، يشرح (بسببه) تدهور أحوالنا.
4- الدين هو الجزء المركزي من نظام الاعتقاد لدينا، بما يجعل أي حديث عن الاعتقادات يحيل بالضرورة إلى الاعتقاد الديني (هنا، فيما يخص الإصلاح، يكون الموضوع هو فهمنا للدين).
5- بالتالي، إذا أردنا الإصلاح والنهضة، فإن علينا إصلاح اعتقادنا الديني.
إن القضايا 2 و3 و4 تُشكّل لب هذه المحاكمة المؤيدة للحاجة الضرورية للإصلاح الديني، فيما يستند رفض سؤال الإصلاح الديني والحاجة إليه إلى رفض واحدة من هذه القضايا. يمكن تقديم استراتيجيتين رائجتين تعتمدان على رفض واحدة من هذه القضايا الثلاث. الاستراتيجية الأولى ترفض (2)، فسوء الأحوال ليس لأسباب تخصنا إنما لأسباب تخص آخرين، ولائحة هؤلاء الآخرين عادة ما يتقدمها الاستعمار والتغريب وغيرها. واليوم يوجد ما يشبه التحالف على رفض (2) بين تيار ما-بعد كولونيالي انتعش في الجامعات الغربية وتيارات أصولية. عموماً، لا أعتقد أن هذه المقاربة تستحق الوقوف عندها، ليس فقط لأنها تقوم على إعفاء النفس من المسؤولية، إنما لأنها لا تقول أي شيء مفيد حقاً لتغيير الحال. تحظى الاستراتيجية الثانية بنسختين: صلبة تنقض القضية (3) رافضةً إعطاء دوراً مركزياً للاعتقاد في تحديد طريقة حياتنا (ربما تكون الماركسية بنسخها الاقتصادية أكثر التيارات تعبيراً عن هذه الاستراتيجية)؛ ونسخة معتدلة تكتفي برفض (4)، أي كون الدين الجزء المركزي في موضوع الاعتقاد، ما يجعل الإصلاح الديني مسألة أقل أهمية فيما يتعلق بحياتنا. عموماً، معضلة هذا التناول هو أنه لا يستطيع تفسير حجم الدور الذي يلعبه الدين، لذا تصبح المسألة الإسلامية مسألة مستعصية مع محاولة ردها إلى بعد اجتماعي أو ثوري أو أي شيء آخر.
بعيداً عن هذه الاستراتيجيات، ثمة مشكلة مبدئية حيال هذه المحاكمة تتمثل في ابتدائها من حال الدنيا للنظر، انطلاقاً من هذا الحال، في صواب الدين والحكم عليه. فالغاية من الإصلاح الديني تحسين الحياة الدنيا، والسبب الداعي للإصلاح الديني ينتمي بدوره إلى الحياة الدنيا، تخلّفنا وسوء أحوالنا ومهانتنا. تجعل هذه المحاكمة من الدنيا حكماً على صلاح الاعتقاد بالآخرة، بالماورائيات.
يفترض هذا التصور أن الوضع الجيد، والتقدم والازدهار، علامة على صحة وسلامة نظام الاعتقاد الديني تحديداً. الحياة يجب أن تكون سعيدة و جميلة وهانئة، وإن حصل ما يعكر عليها هذا، فإن هناك أمراً خاطئاً فيما يخص اعتقاداتنا يجب إصلاحه. وهذا الشكل من التسويغ هو ما يجب التفكير فيه بطريقة أكثر تمحيصاً. هل حقاً الحياة الهانئة دليل على أننا نقوم بالأمور بشكل صحي، والحياة البائسة دليل على وجود خطأ ما في نظام الاعتقاد؟ أعتقد أن الجواب هو لا، أو بدقة أكبر، إن إجابة الإبراهيميين ستكون لا.
عودة إلى أيوب
تقدم العودة إلى أيوب فائدة عظيمة لتوضيح إشكال المحاكمة القائمة على الربط الشرطي بين حال الحياة الدنيا واعتقاداتنا الدينية: ازدهار نتيجة لصحة الاعتقاد. فالطريقة التي ينظر الإبراهيميون بها إلى علاقتهم بالله تجعل محاججة الإصلاح الديني نافلة تماماً، فالإصلاح –وللغرابة- يجعل من الدنيوي حكماً على الماورائي. الدنيا وحالها تحكم على العلاقة التي تجمعنا بالله، ومعها تصبح السعادة (التقدم والازدهار والرخاء وغيرها) هي مؤشرات نحكم بواسطتها على صحة علاقتنا مع الله. إن المحاكمة التي ينطلق منها الإصلاح الديني تضع الأمور على رأسها.
لا يكمن الرد الوحيد على المحاكمة الضمنية المعتمدة من طرف دعاة الإصلاح الديني في التنصل من المسؤولية وتحميلها لاستعمار ما، أو التهوين من دور الديني لصالح قراءة مادية أو أسبقية الإصلاح السياسي وهلم. الرد يكون بالتذكير بأننا أيوبيون، علاقتنا بالله لا تقوم على السعادة والمكافأة، إنما على الابتلاء والتجربة. يشير الشيخ أبو محمد العدناني في إحدى خطبه إلى مسألة مشابهة تماماً، حين يؤكد على الحاجة إلى الجهاد والقيام به حتى لو كانت الهزيمة ماثلة أمامنا. فالنصر وعد من الله ينفذه حينما يشاء، وواجبنا كمؤمنين القيام بواجب الجهاد بمعزل عما ينتظرنا. هذه العدمية تجد معناها في هذا اليقين المطلق الذي ينتظر اختباره.
يجعل الإصلاح الديني من الحياة الدنيا منطلقاً للابتداء، نحن بحاجة لإصلاح لأننا نحيا بطريقة مثيرة للشفقة. مثل هذه المحاكمة تبدو منفرة لأي إبراهيمي، وحتى خاسرة، كوننا نجعل من الحياة الدنيا حكماً على الحياة الآخرة. ليس علينا أن نسألهم عن مدى صلابة إيمانهم وهم يقدمون لنا هذه المحاكمة وحسب، إنما أن نشير لهم أيضاً إلى هذه المقايضة الخاسرة التي يقدمونها.
خاتمة
يسمح الانطلاق من تجربة أيوب بفهم أفضل للعلاقة بين الإنسان والله في الإطار الإبراهيمي. كذلك، فإن هذه التجربة تفسر بشكل ما فشل دعوات الإصلاح. فتجارب الإصلاح الديني هدفت إلى إنتاج اعتقاد ديني يتسق مع نظام ما من القيم (سواء تماثلت هذه القيم مع الحداثة كليةً أو حاولت المواءمة بين إرث التقاليد الدينية وتلك الحديثة)، غير أن معضلة هذه القيم كانت في اعتمادها الانطلاق من خبرة التجربة الدنيوية، مهملةً أولوية ومركزية التجربة الدينية في تجربة الإيمان الابراهيمي، والتي تجعل من الحياة الدنيا نفسها مكان للاختبار وحسب. لكن المحاكمة الضمنية لدعوات الإصلاح الديني –على تنوعها- تجعل من الحياة الدنيا مكاناً للحكم على صلاحية نظام الاعتقاد الديني وقيمه العامة، وهو ما يقلب نظام الاعتقاد الابراهيمي رأساً على عقب، وهذا ما يظهره اختبار أيوب بشكل جلي.
لن تجد الحاجة للإصلاح الديني انطلاقاً من شظف الحياة ومعاناتنا فيها، إنما تظهر الحاجة للإصلاح عندما يتلوث إيماننا ويبهت، عندما تشوبه البدع والانحرافات. عندها يصبح الإصلاح الديني أمراً ملحاً لاستعادة نقاء الإيمان وصفائه وقوته. بهذا، فإن الإصلاح الديني سؤال يمليه الإيمان ومن داخل منطقه، فهو شأن داخلي للمؤمنين.
غير أن نقل الإصلاح الديني من كونه سؤال الإيمان إلى كونه سؤال الدنيا يضعنا أمام المفارقة التي نواجهها عموماً في السجالات والنقاشات العربية، حيث يصبح الإصلاح الديني دعوةً يحمل لواءها الجميع، حتى الذين هم خارج جماعة المؤمنين المعنية أو المخاطبة بالإصلاح، فالإصلاح الديني يتحول إلى شأن عام ليدلي كل مرء فيه برأيه، حتى لو كان هذا الشخص ملحداً أو معتنقاً لدين آخر.
يحيلنا إدراك الإطار الذي يجب أن يُطرح سؤال الإصلاح من خلاله، وبالتالي حدود ما يمكن للإصلاح الديني أن يقوم به -وذلك بالإحالة دوماً إلى تجربة أيوب- أو يطرحه على نفسه، إلى نقطة أشد جذرية من دعوة الإصلاح الديني، وهي الحاجة إلى نقد الدين. يسعى الإصلاح الديني إلى إصلاح الإيمان من داخل منطقه نفسه (المنطق العميق لنظام الأشياء: الله والإنسان والطبيعة)، معيداً ترتيب الأولويات وتنقيته من الشوائب. في المقابل فإن نقد الدين يسائل هذا النظام نفسه، مساءلة من الخارج، سواء كانت مساءلة جذرية أو معتدلة مكتفية بالتشكيك في شكل معين ومحدد لترتيب الأشياء وحدودها (مثلاً النظر إلى الديني باعتباره شأناً خاصاً)، ولكنها على أية حال مساءلة خارجية. فنقد الدين يطلب من الديني، أياً يكن فهمنا لهذا الديني، تسويغه من الخارج، من وجهة نظر عمومية ومحايدة ومفتوحة للجميع. وهذا بدوره يفتح الباب لاستقلالية العالم الدنيوي كتجربة معاشة أمام الديني. تظهر تجربة أيوب مدى قدرة نظام الإيمان على إخضاع التجربة المُعاشة للعالم الدنيوي لشروط الإيمان، حتى لو لم يسندها أي تسويغ من داخل العالم الدنيوي نفسه، الذي هو مكان ابتلاء واختبار وليس مصدراً للمعقولية أو الحقيقة، وفي حالة أيوب الأكثر جذرية يصير العالم الدنيوي محض مكان ابتلاء لا يمكن تعقله، حيث المطلوب هو أقصى الإيمان. بالمقابل، تطلب المساءلة الخارجية التسويغ والمعقولية العمومية، وهذه لا يمكن تبريرها بالإيمان (الملزم فقط لأهله)، فنصير أمام إمكانيتين، جذرية تقوم على قلب المعادلة وجعل التجربة المعاشة للعالم الدنيوي مصدراً للحقيقة وشروطها وبالتالي نفي المفارق وشطبه، غير أن هذه الإجابة بدورها تحتاج شيئاً من الإيمان (هل يمكن للعالم الدنيوي أن يجيب فعلا عن كل أسئلتنا؟)؛ وأخرى معتدلة، تسأل عن التسويغ لما يمكن تسويغه، وتترك ما لا يمكن تسويغه للاختبار الشخصي. غير أن هذا الاختبار الشخصي (للإيمان مثلاً) لا يمكن له أن يكون مصدراً للإلزام العام. خصخصة الإيمان تعني بدورها وضع حدٍّ بين الخاص والعام، أو حتى تأسيسهما عبر رسم هذا الفاصل، وضمان استقلالية متطلبات الحقيقة والتسويغ في المجال العام عن تلك المتطلبات المؤسَسة على الإيمان الشخصي، وبشكل مقابل حماية الحقيقة المؤسَسة على الإيمان الشخصي من تدخلات المجال العام وإلزاماته.
لا يمكن لنا أن نطالب أيوب بأن يخضع لمتطلبات الإصلاح الديني وما يحمله هذا المطلب من مفارقة، لكن يمكن لنا إما رفض أيوب كلياً، أو أن نطالبه بأن يصير أيوب-الفرد. وهذه الإمكانية الثاوية يمنحنا إياها أيوب، في الحقيقة، منذ البداية، فلا يمكن لأيوب أن يعايش الابتلاء إلا بوصفه فرداً، وحتى عندما حضر الآخرون بقربه لم يكونوا إلا «معزون متعبون كلكم» (أيوب 2:16).
إن نقد الدين بداية ضرورية لكل نقد لاحق، لأنه يقدم هذا الخارج (خارج نظام الإيمان) كإمكانية عمومية ومفتوحة لكل شخص ليختار ويحكم بنفسه على الأشياء.