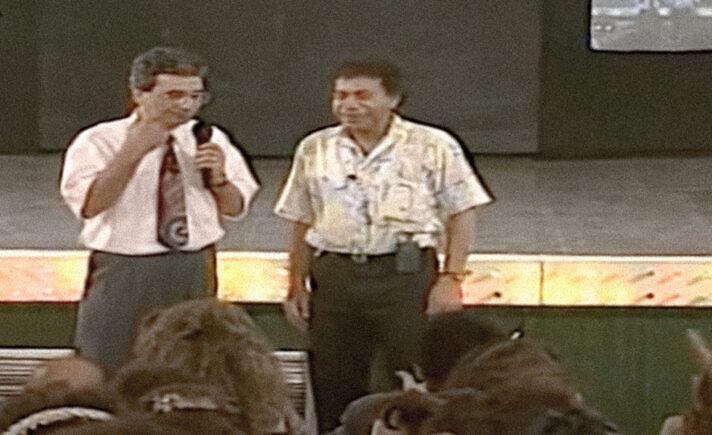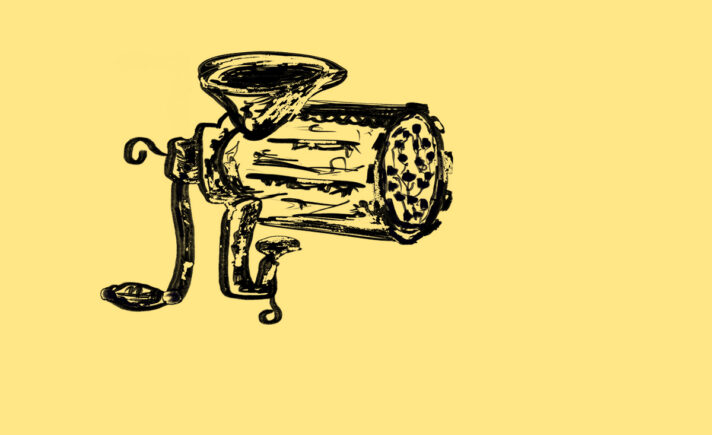عام 2008 كان للأنشطة الثقافية في دمشق طعم مختلف نسبياً عمّا هو معتاد، وكان المهتمون بعروض المسرح والموسيقى أمام فرصة صعبة التكرار في ظل حياة ثقافية محكومةٍ بوزارة لا تختلف عن غيرها من القطاعات الرسمية السورية. كانت دمشق حينها عاصمةً للثقافة العربية، وأوكلت مهمّة إدارة النشاطات الثقافية حينها للأمانة العامة لدمشق عاصمة الثقافة العربية التي لم تَنجُ بالتأكيد من سلطة الدولة عليها، إلا أنها حظيت بميزانية خارجية ضخمة، أتاحت مساحةً من المرونة لإعداد برامج أنشطة ذات جودة عالية وفرصةً لاستضافة عروض استثنائية في المدينة.
أتاحت الاحتفالية للصحفيين العاملين في الشأن الثقافي في سورية، ولجمهور الثقافة والفن أن يكونوا على تماس مع شخصيات وفرق وعروض عالميّة، واحدٌ من تلك العروض كان المفتش الكبير للمسرحي العالمي الذي غادر الحياة مؤخراً، الإنكليزي بيتر بروك، الاسم الذي ترك بصمته الواضحة على المسرح الحديث أوروبياً وعالمياً في القرن العشرين، وما بعده.
انتقاء القائمين على عرض بروك صالة الاستخدامات المتعددة في أوبرا دمشق، «دار الأسد للثقافة والفنون»، لتقديم العرض، كان مفاجئاً وربما مثيراً للاستياء من قبل البعض لأنها القاعة الأصغر، وهو ما يعني جمهوراً أقل وبالتالي بطاقات حضور أقل، وفرصة حضور قد لا تكون مُتاحة لكل من يرغب. لكن هذا الانتقاء سيلقى ترحيباً من آخرين وجدوا أن هذه الصالة الصغيرة هي الخيار الأمثل، بما تحمله من فرادة عن بقية مسارح العاصمة. واختصارها المسافة بين الجمهور والعرض حدَّ الاندماج – تلك نظرية شكسبير في المسرح أصلاً – واختلافها عن الصالتين الأخريين في الدار واللتين تأخذان شكلاً رسمياً أوبرالياً، مما سيجعلهما احتمالات بعيدة عمّا يقدمه مسرح بروك، بالإضافة إلى مشكلات الصوت التي لم تَنجُ منها الصالتان في غالبية العروض التي استضافتاها، بل وحفلات الموسيقى أحياناً.
مع الدخول إلى القاعة ستكون المفاجأة الثانية، بفقر الخشبة للديكور، واقتصاره على كرسي، ولكن المطّلعين على منتج بروك وأسلوبه يعلمون بأن هذا بند من بنود بيانه المسرحي يدعو فيه إلى قدرة اختصار المسرح على الممثل والموسيقى، واعتبار الديكور مكملاً يحبَّذ اختصاره قدر الإمكان، وخشبةً فقرُها سيعني فيما يعنيه مسرحاً أنضج.
في النص المقتبس من رواية الأخوة كارامازوف للروسي فيودور دوستويفسكى، يحاكم المفتش سجينه المسيح، الذي عاد للحياة حاملاً المهمة ذاتها التي حملها في قدومه الأول، ينشد فيما ينشده خلاصاً للإنسانية، وعدلاً وإحقاقاً للحق. إلا أنه لا يقع خارج مفهوم الديانة التلقينية وفرض التعاليم وقواعد الحياة. سَيَعِدُ المفتشُ سجينَه المسيح بالحرق، وسيظهر قاضياً في محكمة تفتيش تنتمي للعصور الوسطى، لا رحمة لديه تجاه من يحاول نقل رسائل الآلهة إلى البشر، يحرق أصحاب مختلف الدعاوى، ويحرق المتهمين بالسحر. سيكون المسيح واحداً منهم بالنسبة للمفتش الذي لعب دوره حينها الإنكليزي بروس مايرز، أحد أهم أبطال خشبة بروك، والعضو السابق في الفرقة الملكية الشكسبيرية.
زيارة واحدة بممثل واحد، فرضت عرضاً لا ينتمي قطعاً إلى العروض التي كان من المحلل عرضها على مسارح سوريا في ذلك الوقت. ليس القصد هنا الانتقاص ممّا قدمه مسرحيون سوريون وعرب على الخشبات السوريّة، إلا أن بروك قدّمَ عرضاً حوكم فيه نبي أمام الجمهور، وكان هذا العرض برمزيّاته واختلافه عن السائد، مثالاً فاقعاً على قدرة المسرح المحترف على الاختراق. هذا الاستثناء الذي صنعه بيتر بروك دون أن يحضر شخصيّاً حينها، كان صادماً لجمهور يدرك تماماً أن ما حدث هو استثناء.

عندما تعرّفَ الجمهور السوري على مسرح بيتر بروك، كان المخرج الكبير بعمر ثلاثة وثمانين عاماً، يخوض آخر تجاربه المسرحيّة، ويختصر في كل منها تجربة بدأها عام 1942 عندما كان بعمر سبعة عشر عاماً، تجربة لم تلتزم بلغة أو وطن، تنقّلَ فيها بين الخشبات والنصوص. وصلت إلينا متأخرةً بعد سنوات من تكريسه كأهم مخرج مسرحي على قيد الحياة، بعد عشرات العروض، وبعد تأسيسه للمركز العالمي للأبحاث المسرحية، وإدارته لمسرح ليه بوف دو نور الفرنسي الشهير.
ذروة التجريب الذي مارسه بروك في المسرح تمثَّلَ في اقتباسه من المرويّات التاريخية، واللعب بها حدّ تغييرها أو تحطيمها، أو على الأقل إعادة قراءتها على المسرح، وهو ما جعله في حالة تصادم دائم مع التيارات المحافظة عقائدياً. وهنا ليس القصد اصطدامه مع المسيحية فقط، إنما جرأته على قص الأساطير وإعادة تدويرها بشكل معاصر. تلك الذروة كانت، وفق إجماع نقدي عالمي، في تحفته الخالدة المهابهاراتا التي قدمها للمرة الأولى عام 1985. والتي خلقت ضده حالة عداء واسعة في الهند، وكانت بالنسبة للتيارات المحافظة في الهند أكبر إساءة للثقافة الهندية تاريخياً. التجريب الذي قدّمه بروك في العرض الذي امتد على مدى تسع ساعات، عبّر عن مختلف أقانيم رؤيته المسرحيّة، من إعادة تركيب الموروث، وربط الأخلاقي بالجمالي، إلى تحويل المسرح إلى جزء من حياة الجمهور، فتجربةُ الساعات التسع ستحتاج معايشة مع المسرح تمتد لأيام بعد تجزئة العمل.
لم يغلق بروك باب المسرح على ممثليه وجمهوره، كان مدركاً ضيق الخشبة أمام اتساع المدن والثقافات التي كان مهووساً بالتعرّف عليها وزيارتها وتقديم العروض بلغاتها. لجأ إلى السينما مكتسباً منها ميزة سهولة الانتشار مقارنةً بالمسرح، وإمكانية أرشفة الصورة، وهو ما أتاح لجمهور واسع لم يتح له حضور عروضه المسرحية مشاهدة نسخة سينمائية من المهابهاراتا سنة 1989، وقبلها لورد أوف ذي فلايز 1963، إضافة إلى مارات 1967، وتيل مي لايز 1968. والتي كانت أفلاماً سينمائية متكاملة أبرزت جانباً إبداعياً آخر لدى مخرجها، وهي مرونته في استخدام أدوات عادة ما لا يفضّل المسرحيّون استخدامَها، وفي مقدّمتها الكاميرا.
في كل بلد زاره مسرح بيتر بروك، كانت عروضه تظهر فيه بإضافاتٍ مختلفة، فتبدو وكأنّها نسخ مختلفة بحسب البلد الذي تُعرَض فيه، لاعتماده في كثير من الأحيان على ممثلين من البلد المضيف. عرض كونفرانس أوف ذا بيرد على سبيل المثال شهد تبديل طاقم الممثلين سبع مرات على سبيل المثال. أثار بروك من خلال ذلك جدليتين، إحداهما عمليّةٌ تجوب في فلك التنوّع، وإتاحة الخشبة لأبناء البلاد القريبين من جمهورها، والأخرى أكاديمية نظرية حول قضية القدرة الأساسية للممثل على تغيير مفهوم العرض وشكله. وهو ما ينتمي إلى جذرية أثر الممثل في صناعة المسرح وفق رؤية بروك.
اعتبر بيتر بروك السلطات التقليدية، ثقافية وسياسيةً ودينية، أسوارَ حصار تحيط بالمسرح، فكانت بموجب ذلك كل دعواته ثورية واعية ضد الأشكال التقليدية، بدءاً من الخشبة التي دعا إلى فتحها أمام الجمهور أينما كان، ففي الشارع والحديقة يمكن أن يولد العرض. مروراً بالمكونات التي ليس لها حدود في المسرح، وهي دعوة عرفت باسم المسرح الشامل الذي يمكن أن يتضمن كل شيء، من شعر إلى رقص وغناء وأزياء وسواها. ثورة على الديكور، فثورة على قيود الحركة للمثل، وأخرى على الزمن. كانت كلها أجزاءً متناثرةً من الثورة الراديكالية على المؤسستين الدينية والسياسية، اللتين لم يَدعُ لإلغائهما من الوجود، إنما دعا للجدل الدائم معهما، واختراق أصولهما وأدبياتهما ما شاءت النصوص.بالعودة إلى دمشق، لم تكن مسرحية المفتش الكبير الموعد الوحيد لمسرح بروك مع العاصمة الثقافية، بل عاد مسرحه بعد ثلاثة أشهر ليقدّم على خشبة مسرح فواز الساجر في المعهد العالي للفنون المسرحية عرضه فاروم فاروم، المستلهم من عدة عروض مسرحية عالمية، دمجها بروك في عرض واحد. كان العرض درساً بالغ الأثر لطلاب المعهد الذي يُعرَف عنه بأنه يُخرِّجُ نجوماً في التلفزيون أضعاف ما يخرَّج ممثلي مسرح، على الرغم من الاحتفاء الظاهري للبعثيّة بالمسرح. عند قدوم مسرح بروك لم تكن المؤسسة الأكاديمية التمثيلية الوحيدة في سورية معتادة على أن تستضيف عروض منظّرين في الثقافة والمسرح بحجم بروك، لكنّ يبدو أنه هو الذي أراد هذا اللقاء، من محض ذهنيّة مفكر مسرحي لا يرمي سيفه جانباً يوماً في مواجه سلطة المؤسسة، حتى في أعتى مواقع تجلياتها الديكتاتورية التقليدية.