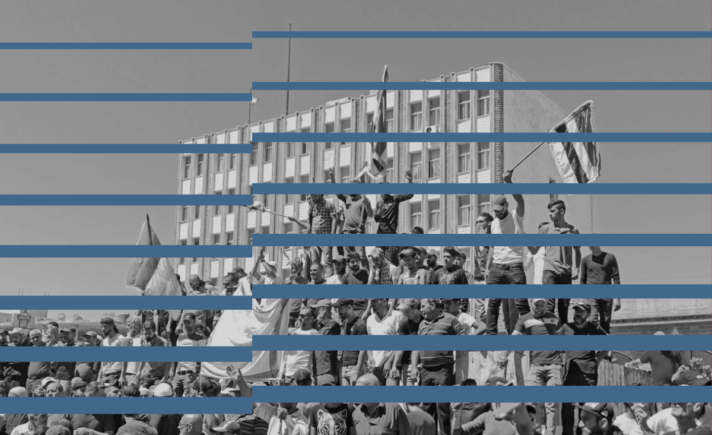يُعَدُّ «الجهل»، أو «عدم المعرفة»، واحداً من أكثر الذرائع استخداماً في التاريخ لتبرير إبادةٍ جماعية، أو مجازرَ وقعت بحق شعبٍ أو قوميةٍ أو أقليةٍ دينية. حتى الآن، ثمة شعوب تحاول إثبات جرائم إبادة وقعت بحقها، ذلك أنّ عدم توافر المعلومات الكافية حول مجزرةٍ ما يصبح مبرراً لغضّ الطرف عن ارتكابها، أو عدم الاعتراف بها.
في كتاب حيونة الإنسان، يوردُ الكاتب الراحل ممدوح عدوان وصفاً لتجربة عالم النفس الاجتماعي الأميركي والمحاضر في جامعة ييل الأميركية ستانلي مِلغرام، التي خلصَ فيها إلى طريقة النظام الدكتاتوري في التهيئةِ لارتكاب مجزرة. ويوضح مِلغرام أن توزيع المهام لعناصر مختلفة أثناء ارتكاب المجزرة يُخفّف العبء الناتج عن مسؤوليات القتل الجماعي، وهكذا فإن تهيئة الأرضية لارتكاب مجزرةٍ ما يتضمن نقص المعلومات أو «الجهل» حتى بالنسبة لمرتكبي المجزرة أنفسهم، بحجة أنهم لم يعرفوا السياق الكامل والأسباب التي هيأت الأرضية لمهامهم.
لكن التطور التكنولوجي، والقدرة الفائقة على التوثيق عبر التصوير بكاميرات الموبايل والكاميرات الرخيصة، أتاحَ لنا معلومات غاية في الدقة عن فظائع حدثت منذ اندلاع الثورة السورية. ما يضعنا أمام «علانية المجزرة»، بحيث يمكننا القول إن هذا العصر، كما هو عصر التكنولوجيا، فهو أيضاً عصر «كونية المجزرة»، بل ويمكننا إضافة دراميتها، أي الدراما الناتجة عن المجزرة بوصفها نوعاً من قتلٍ مُعلَن، يُقدَّم «كمادةٍ ترفيهية» على الشاشات بشكل لم يسبق له مثيل.
كيف شكَّلَت المجزرة وعينا في سوريا
شكَّلَت قصص وصور الإبادة والطرد الجماعي في دير ياسين وكفر قاسم وغيرهما في فلسطين ذاكرة مبكرة عن معنى كلمة «مجزرة» في بلادنا، ولم يَخلُ كتابٌ لمادة التربية القومية في المناهج الدراسية السورية من ذكرٍ لهما. وقد هيأت تلك المجازر نوعاً من الأرضية الفكرية والنفسية حول قدرة العدو أو «الآخر»، على ارتكاب عمليات قتلٍ وإبادةٍ جماعية. كانت صور تكسير العظام التي اتّبعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واحدة من المشاهد المفزعة العالقة في ذاكرتي، وفي وقت لاحق، استطعتُ كما كثيرين من أبناء جيلي التعرَّفَ على تفاصيل مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان. كانت وقائع القتل في المخيمات الفلسطينية أشبه بكابوسٍ مرعبٍ سيلازمني شهوراً طويلة، وكنتُ أتساءل في تلك السنوات حول قدرة إنسانٍ ما أو نظامٍ ما على قتل االناس بدمٍ بارد. ثم بدأت أسمعُ همسات حول مجزرة حماة في منزلنا، وكان مُربِكاً رسمُ صورةٍ واضحة عن وقائع القتل الرهيب التي حدثت في المدينة المنكوبة.
مع مرور الوقت، أدركتُ وبشكل غائمٍ أننا نعيش وسط قتلة محتملين، سيتّخذ شكلهم ملامحَ عناصر الجيش والأفرع الأمنية لاحقاً.
أساليب وأنماط مجازر النظام
تصف معاجم اللغة كلمة «مجزرة» بأنها مكان ذَبح وسلخ البهائم. تحمل الكلمة في شحنتها العاطفية توصيفاً دقيقاً لحالة القتل الرهيب التي تقومُ بها فئةُ ضد فئةٍ أُخرى، حيث يقوم مرتكبو المجازر بتجريد الضحايا من الصفات الإنسانية. ومنذ اندلاع الثورة السورية، كانت المجزرة سمةً أساسيةً فيها.
في يوم الثلاثاء، الثالث والعشرين من شهر آذار (مارس) 2011، قامت وحدات من جيش النظام وقوى الأمن بمحاصرة درعا البلد، مُمهدةً لفض اعتصام الجامع العمري. اقتحمت مجموعات من فرع المخابرات الجوية الجامع ونفّذت إعدامات ميدانية بحق المعتصمين، وفي صباح اليوم التالي خرجَ آلافٌ من أبناء القرى الشرقية لمحافظة درعا في «فزعة» استنكاراً لاقتحام الجامع، وبالتزامن مع ذلك تمركز قناصة بثياب سوداء في محيط نادي الضباط ومبنى الأمن السياسي في درعا، وقامت وحدات من الجيش والأفرع الأمنية بإغلاق جميع مداخل المدينة، تاركةً مدخلاً وحيداً من جهة البانوراما.
عند وصول مئات من الشبان إلى ساحة 16 تشرين في المدينة، فتحت قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين العزّل، وقام القناصة بالتفنّن في القتل والتهديف نحو الأعين بشكل مباشر.
أُغرِقَ الشارعُ وسط المدينة بدماء 38 متظاهراً، لم يكن في أيديهم سوى أغصان زيتون وبعض الهتافات والأغاني التراثية.
سيستمر هذا الأسلوب في مختلف المدن والبلدات التي تصاعدَ فيها خروج المظاهرات، ومع بداية عام 2012 وتوسُّعِ بقعة المناطق الثائرة، اتخذت المجازر منحاً مختلفاً ذا أبعادٍ متعددة، مما غير شكل المواجهة وشكل تحولاً جوهرياً في مسار الثورة. فقد دفع النظام من خلال المجزرة نحو تغير مسارها من السلمية إلى السلاح لتتحول إلى حرب أهلية، ومن ثم دفعها من خلال المجزرة أيضاً ليحولها إلى حرب أهلية طائفية، حيث بدأت وحدات من الجيش والأفرع الأمنية، والقوات الرديفة التي عُرفت بالشبيحة، بارتكاب مجازر ذات شكلٍ طائفيّ. نقول «شكلاً طائفياً» لأن النظام عمد إلى «إخراج» المجازر تبعاً للمنطقة أو المدينة أو الفترة الزمنية من عمر الثورة، فشكلُ المجازر المرتكب في درعا كان يختلف عن شكل المجازر المرتكب في بعض المناطق والمدن الحسّاسة طائفياً. وما يجب تمييزه هو أن الأفرع الأمنية ووحدات الجيش تعمل وفق تنسيق وخطط منظمة وممنهجة، عمدَ النظام من خلالها إلى تكريس البعد «العنفي» أي استخدام السلاح والبعد الطائفي، مستهدفاً إحداث شرخٍ في البنية الاجتماعية السورية. شَكَّلت المجازر ذات الشكل الطائفي دافعاً لصعود أصوات الخطابات الطائفية التي كانت خافتة جداً في بدايتهاـ فقد حرصت المظاهرات على هتافات ذات صبغة وطنية سواء تجاه الجيش أو «الفئات الاجتماعية المختلفة».
لقد تعمَّدَ النظام أن تكون المجازر ذات «الشكل الطائفي» علنيةً، وفي مناطق ومدن وبلدات حساسة. كان النظام يهدف دائماً لأن يترك بصمته الخاصة، التي تشير بإصبع الاتهام إليه وإلى بيئات أهلية بحد ذاتها.
في منطقة الحولة، قامت ثكنات عسكرية يوم الخامس والعشرين من شهر أيار (مايو) 2012 بتمهيد ناري على مجموعة من الأحياء السكنية، ثم دخلت مجموعات من الأمن والشبيحة إلى تلك الأحياء وقامت بذبح أطفال ونساء وتهشيم أجسادهم وحزّ أعناقهم. تزامنَ حدوث المجزرة مع تواجد لجنة تابعة للأمم المتحدة قامت بتوثيق المجزرة. وقد جاءت صور الأطفال التي عُرِضَت عقبَ المجزرة صدمة للسوريين، وتناقلت العديد من الصحف والمحطات العالمية تفاصيل المجزرة، إذ تحدثت جريدة التايمز البريطانية مثلاً عن تفاصيلها المروعة.
تتالت المجازر في سوريا وتعددت مستوياتها، ويمكننا رصد مجموعة من الأشكال التي اتخذتها مجازر النظام:
1- عمليات القتل الجماعي المُنظَّم أثناء الاقتحامات، مثل مجزرتي صيدا ومجزرة الأربعاء الدامي في درعا، ومجزرة اقتحام حماة لإنهاء مظاهرات ساحة العاصي.
2- عمليات القتل ذات الشكل الطائفي التي كانت تحدث لأسباب محددة ترسمها الأفرع الأمنية مثل التجييش الطائفي، ومنها مجزرة الحولة في ريف حمص ومجزرة جديدة عرطوز في ريف دمشق، ومجزرتي البيضة ورأس النبع بانياس.
3- عمليات الإبادة والقتل الجماعي بالأسلحة الثقيلة التي تستهدف مدناً وأحياء بكاملها، حيث استُخدمت على نطاق واسع في مختلف أحياء وبلدات سوريا، ووصلت ذروتها في استخدام صواريخ بالستية في حلب ومدينة الرقة ومن ثم استخدام الكيماوي في ريف الغوطة الشرقية، واستخدام البراميل في مختلف مناطق والمدن الخارجة عن سيطرة النظام.
4- عمليات القتل والإبادة في المعتقلات.
يميز عالم النفس والفيلسوف الألماني إريك فروم في كتابه تحليل التدميرية البشرية بين نوعين من العدوان: «العدوان غير الخبيث» الذي يندرج ضمنه على سبيل المثال عدوان الدفاع عن النفس، و«العدوان الخبيث» وهو خاص بالإنسان وغير مُستمَدّ من الغريزة الحيوانية. يشرح فروم أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يمكن أن يكون قاتل نوعه ومدمره دون أي مغنم معقول، سواء أكان بيولوجياً أم اقتصادياً. ويضيف أن ما هو فريدٌ في الإنسان أيضاً أنه الكائن الوحيد الذي يمكن أن يرتكب أعمال قتلٍ وتعذيب ويشعر بالشهوة لدى فعله ذلك.
إن العدوان الخبيث أشدُّ أنواع العدوان تطرفاً، ذلك أنه لا يهدف فقط إلى إخضاع الآخر، وإنما يهدف إلى قتل الآخر وإبادته. وقد اتخذ العدوان الذي قام به النظام ضد الثورة طابع العدوان الخبيث، وكانت الأفرع الأمنية هي الأداة والفاعل الرئيسي الذي سخَّرَ كل إمكاناته للتخطيط لتلك الإبادة وتنفيذها.
منذ انضمام الأفراد للأفرع الأمنية، يتم تدريبهم تدريجياً ليتحولوا إلى قتلة عبر سلسلة طويلة من التهيئة النفسية والجسدية. ولعلّ أهم عامل في تكوين عناصر الأفرع الأمنية، وبعض وحدات الجيش، هو امتلاك القوة المطلقة مع غياب أي نوع من أنواع المحاسبة. وهذا ما تم ذكره كثيراً في روايات المعتقلين، وما عايشتُهُ أثناء اعتقالي في مطار المزة العسكري، إذ إن كثيراً من عناصر الفرع كانوا يقولون لنا «أنا ربك» أو «أنا بعيشك وبموتك».
كما أن الأفرع الأمنية تُخرِّج قتلة محترفين قادرين على القيام بالقتل بدم بارد، وهو ما يحتاج إلى إعداد نفسي وجسدي. ولعلّ واقعة حدثت معي توضح التدرُّجُ النفسي الذي يمر به عناصر الأفرع الأمنية، إذ أن هؤلاء لا يولدون قتلة حتى ولو ساهم الظرف الاقتصادي والاجتماعي والبعد الطائفي أو الديني في تكوينهم وفي تكوين استعدادهم لارتكاب الجرائم. في مطار المزة العسكري استُدعيتُ إلى جلسة تحقيق، وكانت الجلسات تحدث في فسحة التنفّس القديمة للمعتقلين قبل 2011، حيث كان يتم التحقيق بشكل جماعي، أي عدة محققين مع عدة متهمين. كان هناك على ما يبدو عنصرٌ متطوعٌ حديثاً، لم يستطع المشاركة في عمليات التعذيب الرهيبة التي كانت تحدث أمامه، وقد استفرغَ من هول ما شاهده. كنتُ أسمعُ تشجيع المحققين له، وتلقينه أسلوب الضرب والتعذيب.
إن عمليات القتل والابادة الجماعية في سوريا هي عمليات منظمة بالكامل، يتاح فيها للعناصر والأفراد والمجموعات بعض الارتجال في تنفيذ سيناريو الإبادة، غير أنه لا تتم مجزرة في سوريا دون التخطيط لها على كافة المستويات الأمنية. ويبدو هذا واضحاً لأن وحدات من الجيش تبدأ بمحاصرة أو تأمين المكان في كل مجزرة، ثم تنصب مجموعة من الحواجز ويبدأ تنفيذُ اعتقالات عشوائية أو فتحُ النار بطريقة كثيفة أو قصفُ أحياء معينة، ومن ثم يتسلل عناصر من الأمن والجيش والشبيحة ويرتكبون المجزرة.
لقد نَفَّذَ وخطَّط ضباط وعناصر الأفرع الأمنية جزءاً كبيراً من المجازر المرتكبة في سوريا، ويمكننا القول إن الأفرع الأمنية كانت العقل والمنفذ لعمليات القتل والإبادة الجماعية، سواء خارج الأفرع الأمنية أو في المعتقلات. وقد كان ذلك واضحاً بالنسبة لي في شخصية عناصر الفرع من سجانين ومحققين، ففي مطار المزة العسكري، ميزتُ بين نوعين من التعذيب. الأول هو التعذيب المُنظَّم أثناء التحقيق، هدفه الحصول على اعتراف، وهو أقسى أنوع التعذيب لأنه يستهدف الوصول بالألم إلى أقصى درجاته مع الحفاظ على حياة المعتقل. والنوع الثاني هو الذي يقوم به عناصر من الفرع في أماكن مجهولة لنا كمعتقلين وغير خاضعة لرقابة المحققين أو ضباط الفرع، وهذا النوع من التعذيب كان يؤدّي في كثير من الأحيان إلى القتل، لأن أسلوب الضرب عشوائيٌ وبمختلف الأدوات والوسائل المتاحة.
كان فرع التحقيق في مطار المزة العسكري ينقسم إلى 12 زنزانة انفرادية و4 زنازين جماعية. ومهام العناصر موزعة بالتناوب بين إدخال الطعام والإشراف على خروج المعتقلين إلى الحمامات (هذه الإجراءات كانت تُستخدم للتعذيب أيضاً)، وبين نوبة التحقيق حين يتولى العناصر التعذيب خلال استجواب المحققين لنا. وقد لاحظتُ، كما كثيرين من المعتقلين، أن ثمة عناصر لا يقومون بتعذيبنا أثناء نوبة الحراسة، أي أنهم لا يقوم بضربنا عند الخروج إلى الحمام أو عند إدخال الطعام. كان بعضهم يلقون التحية علينا أحياناً، أو يُحضِرون لنا وجبة طعام بشكل استثنائي، أو يُخرِجون واحداً مِنّا إلى الحمام خارج نوبات الخروج. مع الوقت، استطعنا أن نميز أن هؤلاء هم أكثر عناصر الفرع وحشية أثناء التعذيب المرافق للتحقيق، أي أنهم كانوا يمارسون وظيفتهم بمنتهى الحرفية دون خلط مشاعرهم مع وظيفتهم. فالأساس إذاً في بنية عناصر الفرع وضباطه هو الانضباط بكل معنى الكلمة، وهنالك قوانين تحكم آلية عمل الأفرع وينصاع لها جميع العاملين فيها.
تُمثِّلُ عقلية العناصر والأفراد في الأفرع الأمنية مزيجاً من العدوان المُمتَثِل والعدوان الساديّ. والأول هو الذي يصفه فروم بأنه «العدوان الذي يتم القيام به لا لأن المعتدي تسوقه رغبة في التدمير، بل لأنه قيلَ له ذلك، ويعد من واجبه طاعة الأوامر. ولعل الطاعة في المجتمعات المبنية تراتبياً هي أعمق خصال الطاعة رسوخاً، فالطاعة مساوية للفضيلة، والعصيان مساوٍ للخطيئة. والتمرّد هو الجريمة الكبرى التي تنبع منها كل الجرائم الأخرى». لذلك، كان من المذهل بالنسبة لعناصر الافرع الأمنية خروجنا عن الطاعة في بداية المظاهرات، ولم يكن بمقدورهم استيعاب التمرّد على النظام. فقد بدا لهم في مرحلة مبكرة من الثورة أن عصيان النظام هو نوع من العصيان للأوامر الإلهية، الذي يوجب أكبر أنواع العقاب، على اعتبار أن الثورة والتمرد نقيضان لجوهر ما يقومون به، أي الامتثال. أمّا العدوان السادي، فهو الذي يهدف إلى الاستمتاع بالإبادة والتدمير، ولا يرتكبه العناصر بوصفهم فقط مُمتثلين أو منفذي أوامر، بل أيضاً بوصفهم فاعلين في عملية الإبادة.
أظهرَ عناصر الأفرع الأمنية خلال عشر سنوات وحشية غير مسبوقة في طرق القتل، ولا يمكننا أن نعزو الأمر إلى قلّة معلومات أو جهل، وذلك خلافاً للحالة السابق ذكرها في تحليل ستانلي مِلغرام. وكما حاول الشاعر الإيطالي دانتي وصف الجحيم بدوائر متعددة، يمكننا وصف سوريا بجحيم متعدد الطبقات، تمثّل الأفرع الأمنية الطبقة الأولى فيه، حيث يقوم النظام بإيقاظ جميع منابع الشر في أفراد عناصره بكل الوسائل المتاحة.
وإذا كانت الافرع الأمنية هي الدائرة الأولى من دوائر الجحيم، فإنها تتصل بحالة «الفرجة» العالمية على المجزرة، إذ إن القتلة ومرتكبي المجاز على دراية بأنه لن تتم محاسبتهم في الوقت الراهن من حياتهم. ومع استمرار ردة الفعل العالمية الباردة تجاه المجازر المروعة في سوريا، يبدو الأمر كما لو أنه إطلاقٌ ليد القتلة وإيذانٌ بإطلاق الشرّ في دواخلهم دون أي رادع.
معنى المجزرة الكوني
قد يكون ما قاله عالم النفس الألماني إريك فروم، في الكتاب نفسه، حول «دراما التدمير» مفيداً أثناء محاولة فهم التراجيديا التي نعيشها، اذ يقول إن الانسان ينشد ما يحرك النفس ويثيرها، وعندما لا يستطيع الحصول على الإشباع من خلال الدراما السامية كالفن والأدب والموسيقى، يُبدِعُ لنفسه مسرحية الدمار، إذ يبدو أن هنالك صلة غير مباشرة بين «دراما الدمار» التي نعيشها وحالة المُشاهَدة أو الفُرجة التي يمارسها العالم.
لقد قام مرتكبو المجازر في سوريا بنوع من الاستعراض أثناء تنفيذ تلك المجازر، وكأنهم يعون أن ثمة جمهوراً مُنتظَراً سوف «يتفرّج» على تلك الدراما. ويبدو في هذه العلاقة طرفان:
الطرف الأول هو الذي يقوم بالمجزرة، ويضيف الاستعراضُ في التصفية والانتقام جرعةً زائدة من الوحشية له تشبه حالة الممثلين عندما ينفعلون في أداء أدوارهم، وهذا ما كان يفعله القتلة المتسلسلون الذين كانوا يوغلون في الوحشية والتفنّن في أسلوب الجريمة، لعلمهم أنه ثمة محققين ومتابعين لتلك الجرائم.
الطرف الثاني هو الشاهد والمتفرج، وهو مجموعة كبيرة من مراكز الأبحاث والدراسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وأجهزة الاستخبارات الدولية والحكومات التي وصلها عددٌ هائلٌ من المعلومات عن الضحايا وطرق قتلهم. ويفتح هذا طبعاً سؤالاً حول الطريقة الأخلاقية التي تتعامل بها هذه الجهات مع مواد من هذا النوع، وحول طريقة إخفائها أحياناً أو استخدامها أحياناً دون ضوابط معينة أخلاقية ومهنية.
إذا كان العدوان التدميري ممارسة تهدف إلى المتعة واللذة، فيبدو أيضاً أن مُشاهدة العدوان التدميري تحمل في طياتها نوعاً من المتعة واللذة، ففي مسلسل الخيال العلمي الأميركي الشهير (Westworld)، المأخوذ عن كتاب يحمل العنوان ذاته، تتطور البشرية إلى درجة من التكنولوجيا بحيث تخلق مكاناً يحاكي العالم الحقيقي، يستطيع فيه الناس ممارسة جميع أشكال العنف والقتل والاغتصاب وحتى ارتكاب المجازر بحق روبوتات تمتلك من الذكاء الصناعي ما يتيح لها أن تتصرف مثل البشر، لكن دون أن تمتلك حرية الإرادة في التمرد على العنف غير المُبرَّر عليها، والذي يُمارَس فقط من أجل إشباع لذة التدمير. في ذلك العالم الافتراضي، ثمة مجموعة من العلماء والتقنيين والكتاب والسياسين يدرسون تلك السلوكيات من أجل سلطة أكبر وتَحكُّم أكبر، وفي اللحظة التي يتطور فيها إدراك الروبوتات، فإنها لا تستطيع فهم السبب الكامن وراء كل ذلك العنف المُمارَس بحقها.ليس بعيداً عن مسلسل (Westworld)، تبدو سوريا شبيهة بذلك المكان المُتخيَّل، حيث تُطلَق يد القتلة فيها كنوع من دراما تدميرية تتم فيها مراقبة سلوكيات الضحايا وأفعالهم وتطورات قصصهم الدرامية. يُطلَق العنف بكل أشكاله على أناس يحاولون التمرّد والتحرّر من سياق الاستعباد الممتد إلى عقود طوال، وفي كل مرة يطالبون فيها بالحرية مجدداً، يزداد العنف بحقهم حَدَّ المجزرة.