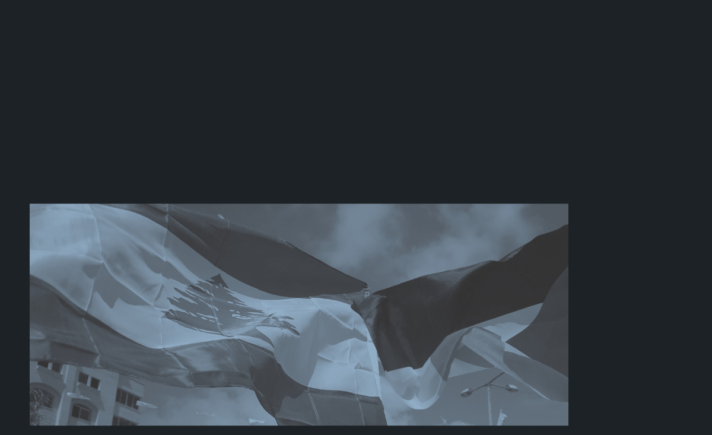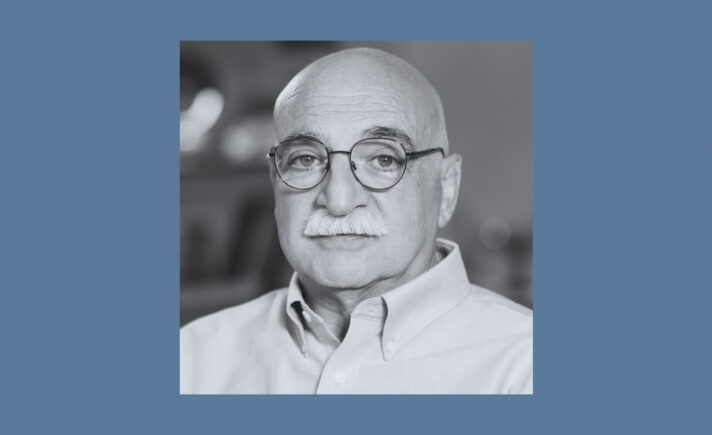آذار 2022
الرابعة والنصف فجراً. أوضب أغراضي وأترك مكتبي وأنزل الطوابق الثلاثة للفيلا البيضاء في شارع WallotstraBe بغرونيفالد. أفتح الباب وكالعادة أتوقف قليلاً أمام الأرجوحة الخشبية المنتصبة في قلب الحديقة المحيطة بالفيلا البيضاء. ورغم يقيني أن لا أحد سيلحظني الآن إلا أنني أبقى متردداً في الجلوس عليها. «يجب أن تجرب الجلوس عليها ولو لمرة واحدة فقط». أخطو باتجاهها قبل أن أسمع صوت بوم يأتي من جهة بحيرة هالينسي القريبة. أترك الأرجوحة وأسرع الخطى باتجاه الصوت لربما ألمح البوم الذي فشلتُ مراراً في رصده هنا في تجوالي الليلي. يتلاشى الصوت وأنا أقترب من البحيرة. ثم يقطع الطريق أمامي ثعلب. يتوقف على مقربةٍ مني وينظر إلي بثبات. أتسمر مكاني لكي لا أخيفه، نحدق ببعض. ألحظ حجمه الكبير وصحته الجيدة وأنا أتذكر الثعلب الأعرج النحيل الذي أصدفه عادةً قرب بيتي في نويكولن. ابتسم وأنا أفكر بأنه من المنطقي أن تكون صحة الثعالب في غرونيفالد أفضل من أشقائهم في نويكولن. ينصرف الثعلب ضجِراً مني، فأتبعه دون أن أنجح في اقتفاء أثره. ثم أقرر أن أجلس على مقعد خشبي يشرف على البحيرة الصغيرة. برودة الطقس مقبولة، لا بأس إذاً من الجلوس لخمس دقائق قبل أن أكمل المشي باتجاه محطة هالينسي لأستقل من هناك القطار المعروف باسم «الرينغ»، والذي يدور حول وسط برلين بالكامل ويأخذني في رحلتي المتكررة من مشارف غرونيفالد في جنوب غرب برلين إلى محطة هيرمانشتراسه في جنوبها الشرقي. يأتي صوت البوم قريباً جداً مني هذه المرة. فأقرر أن أغير سياستي بتعقب الصوت بأن أبقى صامتاً مُلازماً مكاني، لربما يمنح هذا البوم بعض الطمأنينة ويقترب مني أكثر. أغمض عيني وأتنفس ببطء شديد، فيتسرب الخدر إلى جسمي واستسلم لنومٍ خفيف تتخلله صور متقطعة وأصوات غريبة، ثم يوقظني صوت المنبه فأفتح عيني فزِعاً مستلقٍ على سريرٍ ضيق، أحدق في السقف العالي. الساعة الرابعة والنصف صباح التاسع عشر من آذار، لقد غفوت لنصف ساعة فقط. السائق سيأتي بعد قليل ليقلني إلى مطار بيروت. يتسلل ضوء القمر المُكتمل عبر نافذة البيت الملاصق للمنارة القديمة في منطقة رأس بيروت. أنهض وأذهب إلى الشرفة. ضوء القمر يطفو على سطح البحر ويغمر المكان بضوءٍ فضي شاحب. ياله من وداع إذاً يا بيروت! الآن فقط أشعر بالحسرة للمغادرة، فيما كنت للأمس فقط تواقاً للعودة إلى برلين. أحد عشر يوماً في بيروت الغارقة في بؤسها تركوني نهباً للكآبة، والآن في لحظة واحدة فقط أشعر بأنني للتو وصلت وأنني لا أريد المغادرة. يأتي السائق قبل موعده بخمس دقائق. أطلبُ منه بأن يسلك الطريق البحري المؤدي إلى المطار. ثم بأن يتوقف عند التلة المشرفة على شاطئ الرملة البيضا. أترجل من السيارة لأراقب القمر ينشر نوره على مدينة غارقة في عتمة مديدة. بعد دقائق لم أحتسبها يأتيني صوت السائق مازحاً: «بدها فنجان قهوة». أجيبه وأنا أعود إلى السيارة بإني لا أشربها، وفي محاولاته الحثيثة لقطع صمت الطريق نحو المطار يسألني «لوين مسافر؟»، وبعد ترددٍ قصير أٌجيبه «راجع على نويكولن». «وين هي؟»، يسألني بفضول. «ألمانيا» أجيب دون أن تتبدد حيرته. «شو إلك هونيك؟» يسأل مجدداً. «بيت».. أجيبهُ.
نويكولن
شتاء 2016
أريدُ أن أخلق حكاية لي..أن أتعلم كيف أتحمل منظراً قاسياً.. صرخةً عنيفة.. رائحةً واخزة.
السماء فوق برلين، فيم فيندرز
وصلتُ إلى برلين مُنهكاً مشوش الذهن ومُستسلماً تماماً لأقدار لم أتدخل إلا قليلاً في صنعها. عنوان المنزل كان مكتوباً على ورقة مطوية بعناية في جيبي، Weichselstraße 38. تلقفتني صديقة على بوابة مطار تيغل. كنتُ ممتناً لقدومها، فقررتُ أنه يجب علي على الأقل أن أجبر نفسي على الابتسام. وطوال الطريق من المطار إلى المنزل الواقع شمال حي نويكولن، بذلت صديقتي جهداً كبيراً كي لا تكرر السؤال الذي لم أملك حقاً الإجابة عليه، «لماذا طردوك من بيروت؟». عندما وصلنا إلى عنوان المنزل الذي سيصبح بيتي للعامين التاليين، ألحت الصديقة بسؤالها لي إن كنت أرغب في أي مساعدة قبل أن تنصرف. شكرتُها وقلت لها إني منهك وأود فقط النوم. لكني سرعان ما غادرت المنزل بعد أن انصرفَتْ بدقائق. مدفوعاً برغبة باكتشاف الحي مشيتُ بلا وجهة محددة لاكتشف قربي من شارع زوننأليه المكتظ بمحلات طعام ومتاجر عربية، وعبرته لأجد نفسي في شارع كارل ماركس الصاخب. بمسحٍ بصري سريع، أطمأنيتُ أني لن أفتقد للطعام السوري أو اللبناني أو التركي هنا. قفلتُ عائداً إلى المنزل، لكني تخطيته قليلاً لينتهي بي المطاف على جسر صغير يدعى Lohmühlenbrücke يشكل نقطةً فاصلة بين ثلاثة أحياء، نويكولن وكرويزبرغ وتريبتو، تخترقه قناة مائية يتسع مجراها باتجاه الشمال. كان الظلام على وشك أن يخيم. مجموعة من البجع الأبيض تجمعت بشكلٍ بديع على المياه قرب أسفل الجسر. اقتربتُ لأراقبها، فيما توزع بعض الصبايا والشباب على أطراف الجسر يتحدثون ويدخنون ويشربون. وفيما أراقب المياه من على الطرف الغربي للجسر، غمرني شعورٌ غريب بالألفة للمكان وكأنني كنتُ هنا من قبل في هذه النقطة بالذات أحدق في المياه! لكن ثمة شيء مفقود. نظرتُ جهة الشمال، كان يجب أن يكون هناك جدار يقطع هذا المكان! ثم تأتيني الصورة كاملة وواضحة من فيلم السماء فوق برلين لفيم فيندرز، الذي كنت قد شاهدته للمرة العاشرة ربما منذ أيام قليلة فقط وأنا أُحضّر نفسي لمنفاي البرليني. الملاكان داميل (برونو غانز) وكاسيل (أوتو ساندر)، يقفان هنا بالضبط، تماماً حيث أقف. في المشهد يسأل كاسيل صديقه إن كان مازال مصمماً على التحول من ملاكٍ إلى بشري، ليجيبه داميل: «نعم.أريد أن أخلق حكاية لي، أن أتعلم كيف أتحمل منظراً قاسياً..صرخةً عنيفة..رائحةً واخزة»، ثم يخترق الملاكان الجدار الذي كان يقسم المدينة إلى شطرين ويتلاشيان وراءه. لا جدار قائم اليوم، لكن كلمات برونو غانز تتردد في رأسي. أفكر بأني لا أعرف أي حكاية أريد أن أخلق لنفسي هنا، لكني أعرف أني، في هذه البقعة حيث تحول الملاك إلى بشر في الفيلم، تحولتُ لاجئاً ومنفياً وغريباً. خيم الظلام ومازلت واقفاً أحدق في مياه القناة، ثم قررت أن أمشي بلا هدى في الحي الجديد في ليلتي الأولى في المدينة. ومنذ تلك الليلة وعبر السنوات الست التي تلت ستصبح شوارع نويكولن وحدائقها ومقابرها خطوط تجوالي الليلي المتكررة. سأحفظ تفاصيلها، وأتعرف على سُكاراها ومشرديها ومدمنيها، ووببطء ولكن بثبات سيتحول الحي إلى بيت اخترعته طواعيةً بعد أن نفيتُ إليه عُنوة.
غرونيفالد
أيلول 2021
في سبتمبر الماضي، كانت بداية منحتي في معهد Wissenschaftskolleg zu Berlin في حي غرونيفالد البرليني الغني غرب المدينة. في هذه المؤسسة العريقة سألتقي بزملاء من كل أنحاء العالم، أكاديميين ومؤرخين وبيولوجيين وعلماء أوبئة وفلاسفة وسوسيولوجيين وفنانين بصريين وموسيقيين. سأتعلم منهم وعن حقولهم المعرفية في كل لقاء يجمعنا، في المحاضرات وعلى طاولة الطعام وفي سهراتنا الخاصة. وكجزء من المنحة أيضاً سأشغلُ مكتباً صغيراً في الطابق الأخير من الفيلا البيضاء، التي تقع قبالة المبنى الأساسي للمعهد. على عكس بقية الزملاء، لن أسكن في غرونيفالد، فقط سأتردد إلى مكتبي وغالباً في الليل، دون أن يراني أحد قادماً أو مغادراً. دون نيةٍ أو قرار، تشكلت علاقتي بغرونيفالد وبشكلٍ عفوي كزائرٍ متخفٍ يُخشى أن يُرى هناك. أحب المكان فعلاً، لكني أخشى البقاء فيه طويلاً. ربما أخشى الاعتياد على كل هذا الرفاه والهدوء! منذ وصولي إلى برلين في العام 2016، تنقلتُ بين ثلاثة منازل، حرصت أن تكون جميعاً في حي نويكولن، لا بل إني وفي بحثي عن المنزل الأخير كنت أرغب في تجنب المناطق المُحدثة من الحي حيث تنتشر مقاهي الهيبسترز ومتاجر الـ «بيو» واستديوهات المًصممين. كنتُ محظوظاً بأني وجدت بيتي الحالي في نهاية شارع هيرمانشتراسه على حدود منطقة بريتز، وعلى مسافة متساوية تقريباً من محطة نويكولن شرقاً وأطراف مطار تيمبلهوف القديم غرباً في منطقة يتعايش فيها سكان الطبقة الوسطى الدُنيا والفقيرة من الألمان مع وافدين آخرين من أصول مهاجرة، وخاصة تركية أو لبنانية أو فلسطينية. يُعرف عن المنطقة علاوة بأنها فقيرة، بأنها أيضاً مكان تنشط فيه عصابات مرتبطة بعشائر تحتكر عالم الجريمة المُنظمة. على أن هذا أمر غير مرئي بشكل ظاهرٍ في الحي. ما هو ظاهر هي مظاهر الفقر النسبية مقارنة بمناطق أخرى من برلين وكثرة عدد المشردين والكحوليين ومدمني الهيرويين ومروجيه، يتعايش هؤلاء مع رواد البارات والمطاعم التي تبقى مفتوحة لأوقات متأخرة من الليل حتى في قلب الأسبوع. صخبٌ وقذارة، يقابلهما هدوءٌ تام ونظافة مبهرة في غرونيفالد. يسألني بعض الأصدقاء: لكن لماذا الإصرار على العيش هنا؟ بالنسبة لي الأمر بسيط، أريد العيش في مكان يذكرني على الدوام بفظاظة الحياة وجمالها في آن، بهشاشة ناسها وبؤسهم وطيبتهم في آن، مكانٌ يذكر باختلال العدالة بل ربما استحالتها. تبقيني نويكولن، ولو بشكل مُتخيل، على صلةٍ مع عالم تركته خلفي مُجبراً، عالمٌ يسحقُ فيه الحرمان الناس في مُدنٍ تذوي باضطراد. ليست نويكولن بالطبع ضاحية في دمشق أو في أي مدينة سورية أخرى. الفرق شاسع، هناك مستويات الفقر والعوز والبطالة رهيبة ومجبولة بالقهر والخوف والقمع. على أن تجوالي الليلي في نويكولن ولقاءاتي بمشردي الحي ومدمنيه يبقيني متوازناً بعض الشيء، ويعيدني نحو تأمل وحشة عالم ما زال رغم ذلك يخبيء مساحات جمال متناثرة هنا وهناك. أما تجوالي الليلي في غرونيفالد، حيث الشوارع الهادئة التي تتوزع على أطرافها قصور وفيلات فاخرة وحدائق منسقة بإتقان، فإنه يثير لدي شجناً من نوع آخر. الصمت المطبق، وخلو الشوارع من الناس ومراقبتي للأضواء الخافتة القادمة من نوافذ البيوت المسوّرة يثير فيني حزناً لا أعرف تلمس مصدره ، لكنه يدفعني إلى شعورٍ متزايدٍ بالوحدة، شعورٌ يبقيني متأرجحاً بين الخوف والاستمتاع. مرتبكاً من هذا التناقض في كل مرة أعود أدراجي إلى نويكولن، هناك وعلى أبواب محطتها أو محطة هيرمانشتراسه قلما نجحت في أن أمضي وحيداً دون أن أصادف أحد مشردي الحي الذين باتت بيننا ألفة واتفاق واضح أيضاً. «لن أعطيكم نقود لأني أعرف أنكم ستشترون بها إما مزيداً من الكحول أو مزيداً من الهيروين. إن كنتم تريدون طعاماً أو كأس شاي فأنا جاهز». من بين هؤلاء أُحب على الأخص رؤية عباس. وعباس هو شاب من جنوب لبنان، لا أعرف بالضبط تشخيص حالته الصحية، لكني أعرف أنه يسمع أصواتاً كل الوقت ويتكلم مع نفسه بصوتٍ عال. في كل مرة يراني يقبلُ علي مبتسماً حتى إن لم يكن يريد أي طعام، وفي كل مرة يروي لي قصته وكأنها المرة الأولى التي نلتقي بها. ينسى عباس أنه قد روى لي الحكاية من قبل. شغفهُ المتجدد هذا يجعلني أصغي إليه كل مرة وكأنها المرة الأولى التي يروي لي قصته. أراقب قسمات وجهه الجميل وهو يروي لي التفاصيل التي بت أحفظها عن ظهر قلب دون أن أقاطعه، أنتظر حتى ينتهي، ثم أنصرف عنه. عباس هو صورتي اليوم عن حكاية السوريين عن بلدهم. ظنوا أنهم لو تكلموا فسيكترث أحد بهم. أعادوا الكلام مراراً وتكراراً، وفي كل مرة كانوا مدفوعين بالحماس أو بالشغف أو الحاجة يعيدون الحكاية، ينقلون ما يحدث ويحذّرون مما سيجري، لكن لم يصغ أحد إليهم. وعلى عكس حماس عباس المُتجدد لروي قصته، فإن كلامي عن سوريا يقل ويتباعد في السنوات الأخيرة. الكتابة عنها، لا بل الكتابة عموماً باتت فعلاً متعذراً بعد أن كنتُ شغوفاً بالكتابة والتدوين والروي. في السنوات الأخيرة ألجأ أكثر فأكثر للصمت في كل مرة أفكر فيها بالحديث عن سوريا. كلما حاولت الكلام عنها، أجدني مسترسلاً في الصمت. عباس ينتبه لصمتي الطويل وأنا أقف بجانبه في بعض الأحيان، فيتأكد أني مازلت أُصغي إليه. أكثر مقاطع حكايته شغفاً هي عندما يحدثني عن أيامه الأخيرة في بيروت، عن عودته من الموت هناك حينما كان يسبح في إحدى المرات فقفز وارتطم رأسه بصخرة وغاب عن الوعي وهو يغرق. «كنت عم روح على مهل، بطل في مي حوالي، كان في بس ضو قوي وشوي شوي كنت عم أغرق فيه، كنت مبسوط وما بدي أرجع……يا ريتهم ما طلعوني، يا ريتيني متت ببيروت».
بيروت
آذار 2022
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إن اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
سورة آل عمران
أنظر إلى جدار الغرفة الرطبة، فيما أم أحمد تضع أطباق الفاكهة بجانب أطباق الحلو، وزوجها أبو أحمد يغلظ الأيمان علي كي آكل أكثر، ويقول بأنه لن يقبل زيارتي المرة المقبلة وقد تعشيت سلفاً. أهز رأسي بالإيجاب فيما أراقب الأطباق المصفوفة بترتيب على طاولة بلاستيكية. عائلة أبو أحمد هي عائلة سورية اضطرت النزوح من أطراف مدينة حلب. تعرفتُ عليهم قبل مغادرتي بيروت أثناء مشروع كنت أعمل عليه في مخيم شاتيلا في بيروت. توافد الجيران أيضاً للانضمام إلى مجلسنا الذي لم يكن ينيره سوى بعض الشموع، فيما كان المطر يهطل مدراراً في الخارج. تنهدت أم أحمد وهي تقول «والله ما حدا يحس فيهم متلنا»، كانت تقصد اللاجئين الأوكرانيين الذين يهربون من بلادهم جراء الغزو الروسي. الحرب في أوكرانيا كانت حاضرةً معنا في تلك الغرفة الضيقة في مخيم شاتيلا في ليلة أخرى بلا كهرباء وسط عاصفة تضرب بيروت. وافق جميع الحضور على كلام أم أحمد، وهم ينظرون إلي منتظرين كلاماً أكثر عن الحرب هناك في أوروبا، حيث أعيش. لكن شعوراً متزايد بضيقٍ في صدري جعل أجوبتي مقتضبة قبل أن أتعلل بموعدٍ آخر علي اللحاق به لأنصرف مُطارداً بمطالبات أبو أحمد وأم أحمد لي بوعدٍ قاطع بأن أعود لرؤيتهم قبل أن أغادر بيروت. لجأتُ إلى كلمة «انشالله» السحرية وأنا أشق طريقي إلى الزقاق الذي تفيض فيه مياه المطر. لا شيء تغير في المخيم منذ غادرت بيروت منذ أكثر من ست سنوات. لا يتوقف الزمن هنا، بل يعود إلى الوراء، ويسحق بفعله هذا ناس المخيم ويرميهم في هوة سحيقة من العوز والنسيان. أضع المخيم خلفي وأتوجه نحو حي طريق الجديدة حيث سكنت لفترة إبان وصولي إلي بيروت قادماً من دمشق. تقودني أقدامي في دروب سلكتها مراراً، لكنها أصبحت متهالكة الآن. العتمة تبتلع المدينة، الكهرباء تأتي ساعة أو ساعتين في اليوم فقط. والباقي عليك تأمينه عبر استجرار الكهرباء من مولداتٍ خاصة. إن كنت فقيراً فهذا يعني أنك قد لا تستطيع تأمين الكهرباء لأكثر من بضع ساعات في اليوم. تجوالي الليلي في بيروت في هذه الزيارة القصيرة يتطلب مني أن أنظر إلى الأرض باستمرار كي أتجنب الوقوع في الحفر التي تنتشر في كل مكان. أحد عشر يوماً هي المدة التي أملكها لأرى أمي وأخي بعد انقطاعٍ طويل. اجتماع عائلي ناقص لم يستطع خلاله بقية أفراد العائلة القدوم. أحد عشر يوماً هي المدة المتاحة لأفهم ماذا حل ببيروت في السنوات الأخيرة؟ مررتُ على كل البيوت التي سكنتها في المدينة، في شوارع هجرها الكثير من أهلها وأُغلِقت فيها أبواب متاجرٍ ومطاعمٍ وبارات ظننتُ أني سأعود إليها يوماً لاستكمال أحاديث انقطعت وأخرى كانت تنتظر أن تبدأ. قبل بيروت، لم أختبر معنى أن تتحلل المدن ببطء. غادرتُ دمشق قبل أن تغير الحرب وجهها، وكل ما أعرفه عنها من ذاك الحين هو ما أراه من صور وفيديوهات وما يخبرني به أهلي الذين بقوا هناك. في بيروت تلمستُ معنى أن تنضب الحياة في مدينة، أن يجف الأمل في عيون ناسها. من طريق الجديدة وبعد أن توقف المطر، أكملتُ طريقي مشياً لأقطع جسر الكولا، ثم حي الجناح وصولاً إلى الرملة البيضا، قبل أن أصل لرأس بيروت من الطريق البحري. طرقات باتت موحشة وخالية من المارة في هذا الليل الطويل. وفي رأس بيروت أطلتُ التوقف عند البيت الذي عشت فيه لأطول مدة في بيروت. شقة في الطابق التاسع والأخير في بناء قديم، تطل شرفتها الشرقية على نهاية شارع الحمرا، ومن شرفتها الغربية ومن زاوية ضيقة تستطيع رؤية البحر. أقف بجانب شجرة زنزلخت قديمة، وأنظر إلى الضوء المتسرب من الشرفة الشرقية للشقة وأفكر بأن أدق الجرس وبأن أعرف عن نفسي ببساطة «كنتُ أسكن هنا منذ أكثر من ست سنوات، هل أستطيع رؤية المنزل؟». أعدل عن الفكرة، وأعاود التحديق في الضوء القادم من النافذة، وأتخيل حياة لي لم تكتمل هناك. ماذا لو بقيت في بيروت؟ في هذا البيت؟ صور وحكايا تزدحم في رأسي عن حياة لم تكن، وعن حب انقطع وصداقات تبعثرت. تبدو حياتي الأُخرى في برلين، الموزعة بين نويكولن وغرونيفالد، وكأنها حياة موازية لشخص آخر بالكاد أعرفه. غرقتُ في خيالاتي قبل أن تصلني رسالة نصية قصيرة من أخي «طولت وينك؟» لتنتزعني من أفكاري المبعثرة فأمضي نحو الفندق.
في الليلة قبل الأخيرة في زيارتي القصيرة لبيروت، أطلنا السهر في غرفة الفندق أمي وأخي وأنا. في الأيام القليلة التي أتيح لنا اللقاء فيها وبلعبة متقنة، لم نتفق عليها، تجنبنا جميعاً إظهار الكثير من المشاعر. كنا بارعين في تجنب أحاديث من شأنها أن تجر معها ذكريات لا طاقة لنا على مغالبة ثقلها. قضينا ساعات طويلة في غرفة الفندق نتابع أهوال الغزو الروسي لأوكرانيا. ثلاثة سوريين فرقتهم حرب طاحنة في بلادهم، يعيشون الآن «ديجافو». ولمغالبة القلق من لحظات الوداع في اليوم التالي، هربنا مجدداً نحو التلفزيون ونشرات الأخبار عن أوكرانيا. وقبل بزوغ الفجر بقليل، كان أخي وأمي نياماً وهم جالسين. أنظر إلى أمي تغفو على أريكتها، أراقب خصل شعرها الأبيض التي ازدادت والتعب الذي نال من وجهها في السنوات الأخيرة حين كنت بعيداً عنها. وكوخزة سكين في خاصرة يباغتني السؤال: «كيف مضت السنوات العشر الأخيرة؟ من سرقها منا؟» اقترب أكثر من أمي النائمة، ألمس رأسها بلطف، أحاول أن أعدل وضيعة نومها كي لا تؤلمها رقبتها. أهم بالهمس في أذنها أن أياماً قادمة ستكون أفضل ولقاءات كثيرة ستتلو، وبأننا ربما سنكون أقرب. لكني أتوقف وأراقب أنفاسها المنتظمة قبل أن ابتعد عنها وأفتح الباب بخفة شديدة وأمضي كي تبتلعني عتمة أزقة بيروت.
أرق
نيسان 2022
لن تجد بلاداً جديدة
سينتهي بك المطاف دوماً في هذا المدينة
لا تأمل في بقاعٍ آُخرى
ما من سفينة من أجلك وما من سبيل
ما دمت قد أضعت حياتك هُنا، في هذا الركن الصغير
فهي خرابٌ أينما حللت.
المدينة، قسطنطين كفافيس
منذ عودتي من بيروت أشعر بخفة غريبة. خفة تساعدني على التحايل على مشاعر الغضب والإحباط المتراكمة من مشاهد دمار المدن الأوكرانية وصور اللاجئين القادمين منها. علائم الربيع الأولى في برلين تساعدني في ذلك أيضاً، كذلك الأزهار المتفتحة التي تحيط بالأرجوحة الخشبية في الحديقة أمام الفيلا البيضاء. أشعر بالسكينة الآن حين أكون بغرونيفالد وتغمرني سحابة من اللطف حين أكون محاطاً بزملائي في المكتب حيث أمضي الأسابيع الأخيرة من منحتي هناك، كما أحاول اكتشاف دروب جديدة للمشي في الغابة القريبة. لكن هذا كله لا يفيد في التغلب على موجات أرق تشتد. يزورني الأرق بانتظام منذ قدومي إلى برلين، وكلما اعتقدتُ أنه نسيني يعاود تذكيري بلؤم بأنه يلازمني. مع الوقت اعتدتُ على صحبته عندما يأتي، وتعلمتُ أن مقاومته ستزيد فقط من عناده. ولأننا أصبحنا ندماء، أفضل صحبته في نويكولن، هناك حيث اختبرنا مراراً ليالٍ طويلة. أغادر مكتبي في غرونيفالد قبل ساعة من توقف حركة المواصلات العامة في برلين. يمنحني هذا بعض الوقت لأمشي قليلاً في الشوارع الهادئة هنا وصولاً إلى محطة هالينسي حيث سأركب القطار إلى نويكولن. المسافة بين غرونيفالد ونويكولن 15 كلم تقريباً. بين غرونيفالد ودمشق 3266 كلم، وبين غرونيفالد وبيروت 3266 كلم. يحلو لي دوماً تخيل القطار الليلي يتخطى نويكولن ويكمل طريقه جنوباً غير مكترثٍ بأي حدود هكذا إلى دمشق ومن ثم بيروت، ربما ألملم كُتبي المبعثرة والموزعة هنا وهناك وبعض الصور وقصاصات الأوراق. أتفرج على الأحياء التي سكنتها والوجوه التي عرفتها من وراء نافذة القطار. أحياء معتمة، أحياء مهجورة، أحياء عامرة بالحياة. وجوه ميتة، وجوه شاحبة، وجوه مبتسمة. يلوحون بعتب أو بغبطة فيما وجهي ملتصقٌ بنافذة القطار أغرف كل هذا بعيون مفتوحةٍ باتساع.
لكني ما زلت واقفاً على رصيف محطة هالينسي. أراقب وصول القطار الأخير، قبل أن استقله. وكالعادة في هذا الوقت المتأخر، تكون عربات القطار فارغة تقريباً. أستمتع بمراقبة وجوه رواد القطار الأخير وأنسج العديد من الحكايات عنهم في رأسي. صبايا وشباب عائدون من سهرة، عمال منهكون بعد يوم طويل، سُكارى ومشردين. أغلب رواد القطار الأخير يسافرون فرادى وصامتين. أفكر أحياناً أن أقف في منتصف المقطورة لأُعلن بصوتٍ عالٍ أنني أدعو الجميع إلى كأس، أو عشاء في بيتي الصغير كي نتعارف ونضحك، إذ لا يصح أن يذهبوا إلى النوم واجمين أو مثقلين بالهموم. طبعاً لم أفعل ذلك ولا مرة. عندما يقترب القطار من محطة تمبلهوف أشعر أنني على مشارف البيت. بعد هذه المحطة يقطع القطار مسافة طويلة نسبياً في عتمة تامة تشكل مساحة مطار تمبلهوف القديم الذي تحول إلى مساحة خضراء شاسعة مفتوحة اليوم. هذه هي دقائقي المفضلة في رحلة القطار. من النافذة أتأمل الحقل الشاسع في الظلام قبل أن تلوح أنوار محطة هيرمانشتراسة، وهي المحطة التي سأترك فيها القطار. أترجل من القطار باحثاً عن وجوهٍ مألوفة. في هذا الوقت يُجبر نزلاء المحطة المشردين على مغادرتها قبل أن يغلقوا الأبواب. أرى عباس من بعيد، أناديه فيهرول نحوي. أسأله إن كان يريد تناول الطعام معي فيوافق. نخرج من المدخل الشمالي للمحطة قاصدين مخبزاً يفتح طوال الليل. أشيرُ لعباس أن يطلب ما يشتهي، مع كأس شاي بالطبع. يحب عباس أن يضيف الحليب للشاي، أراقبة وهو يضع ست أو سبع قطع من السكر، ثم أوقفه لأن الكأس الكرتوني سيفيض لو وضع مزيداً من قطع السكر. يحرك الشاي بغبطة قبل أن نغادر المخبز. أخبره بأننا سنأكل في مكان قريب من هنا فسيتذمر لأنه أراد أن يجلس فوراً، لكنه يتبعني. نتوجه شمالاً نحو محطة لاينهشتراسة ومن هناك ندخل حديقة معتمة تفصل شارع هيرمانشتراسه عن مطار تيمبلهوف القديم. في هذه الحديقة التي تجاور مقبرة صغيرة أصدف البوم دوماً حين أكون محظوظاً. أسمع صوتهم ونحن نمشي، فأطلب من عباس التوقف عن الكلام والإصغاء. أنجح في ثنيه عن الكلام لثوانٍ فقط وعندما أفقد الأمل نتابع مسيرنا حتى نصل إلى نهاية الحديقة المفتوحة على مدخل فرعي لحقل تمبلهوف الذي تُغلق أسواره في الليل. نجلس على مقعد على زاوية مرتفعة بعض الشيء تشرف على الحقل الشاسع، حيث يمكنك رؤية بعض الأضواء في نهايته. في كل مرة أجلس هنا أتخيل أني أجلس ليلاً على شاطيء البحر وأرى أضواء شاطئ مجاور أو جزيرة تلوح من بعيد. أقول لعباس: «ألا يشبه بحر بيروت؟»، فيضحك عباس وهو يقول «مجنون إنت». أسأله «احكيلي ليش إجيت لهون عباس؟»، ودون حاجة لتكرار السؤال، ينطلق عباس في سرد حكايته التي أعرفها عن ظهر قلب. الطقس باردٌ قليلاً، لكن البخار مازال يتصاعد من كوب الشاي في يدي، يخيل لي أني أسمع صوت عندليب من بعيد. لعلّي أتخيل؟ فقد اقترب موعد وصولهم إلى برلين. بضع سحابات كثيفة تزين السماء وتتناوب على حجب القمر الهلال، دون أن تخفي نجوماً ساطعة. أراقب الأضواء البعيدة في نهاية الحقل، فيما ينساب صوت عباس بلا توقف يحدثني عن لحظاتٍ قليلة فصلته عن موتٍ مُشتهى في جوف بحرٍ دافيء، وعن بلادٍ قاسية وبعيدة لفظته رغم أنه أحبها، وعن بلادٍ جديدة لن تصبح أبداً بلاده.