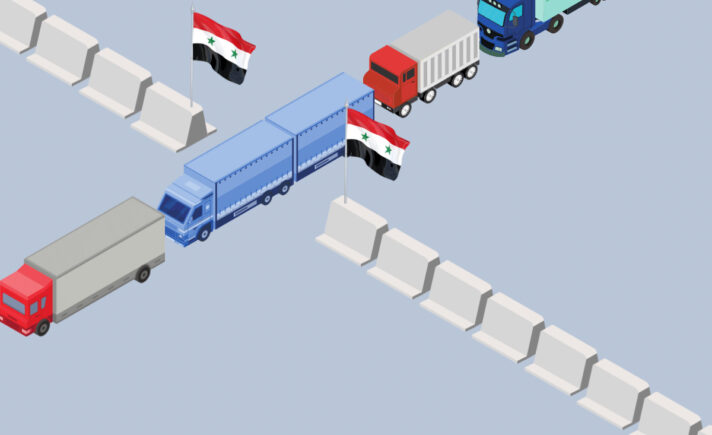شهد حيّ التضامن في الجنوب الدمشقي كثيراً من الفظائع. لم تكن المجزرة التي كشف عنها التحقيق الذي نُشر مؤخراً وحيدةً، لكنّ فظاعة التسجيل، الذي يوثق اللحظة الأخيرة من حياة سوريين وفلسطينيين، كانت قادرة على استعادة ذاكرة ما حدث وظل يحدث لسنوات في البلاد.
كانت منطقة التضامن ومحيطها في جنوب دمشق تنبض بالحياة قبل أن يتم تحويلها إلى ميدان للموت: الناس يذهبون صباحاً إلى الفرن، والموظفون المتعبون يتعلقون ببعضهم بعضاً وبالسرافيس للذهاب إلى العمل، وباعة متجولون ومحلات ألبسة أرخص أسعاراً في مخيم اليرموك القريب. ارتكب القتلة جرائمهم في تلك المنطقة طوال أشهر وسنوات، تم قتل واعتقال وإخفاء الآلاف، ومنهم واحدٌ وأربعون ضحية كشفَ تحقيق قرابين التضامن عن أسماء قتلتهم، دون أن يتم الكشف عن أسماء أغلبهم حتى الآن. قصة هؤلاء الضحايا جزء من وقائع القتل والاعتقال والتغييب في جنوب دمشق، وهذا النص جزءٌ من حكاية الضحايا وحكاية المكان.
حيّ على أنقاض هزيمة 67
استقبل حي التضامن منذ إنشائه، أواخر ستينات القرن الماضي، موجات النازحين من المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد هزيمة حزيران 1967، ليسكنوا إلى جانب أولئك الذين استقبلهم مخيم اليرموك الأقدم (تم إنشاؤه بداية الخمسينات) من فلسطينيين تم تهجيرهم من مدنهم وقراهم ولجأوا إلى سوريا في نكبة العام 1948. سكن المهجّرون الجدد، من أبناء الجولان السوري وبينهم فلسطينيون تم تهجيرهم عام 67 أيضاً، في محيط مخيم اليرموك، وكثيرون منهم سكنوا إلى الشرق والشمال الشرقي من شارع فلسطين، الذي يفصل بين حي التضامن ومخيم اليرموك.
لم يبقَ حي التضامن على حاله بالطبع، ونتيجة انخفاض تكاليف السكن فيه، فإنه كان يستقبل موجات عديدة من السكّان القادمين للعمل والعيش في العاصمة من مختلف المحافظات السورية، من درعا جنوباً إلى إدلب شمال غرب البلاد. وقد قام التوسع العشوائي للحي بدور أساسي في عملية دمج السكّان المتنوعين بشدة، غير أن عدداً من الحارات الأقدم نمت على أساس مناطقي ارتبط أيضاً بالانتماء الطائفي في حالات نادرة، أبرزها شارع نسرين، الذي سُمّي على اسم صيدلية مشهورة فيه، وكان يضم أبناء الجولان النازحين من قرية عين فيت المحتلة، وأبناؤها وبناتها ينحدرون من الطائفة العلوية.
كان التضامن عموماً منطقة أقل تكلفة للعيش من أحياء المدينة الأغنى، والتي ضاقت بسكّانها أصلاً، وذلك من دون تفاوتات طبقية كبيرة بين سكّانه حتى تسعينات القرن الماضي. إلا أنّ الأمر بدأ بالتغير منذ ذلك الوقت، إذ توسَّعَ ليضم حارات خارج المخطط التنظيمي للحي الذي يسمح ببناء الوحدات السكنية، ما ترك فوارق كبيرة أحياناً في أسعار العقارات. بدأت تلك الفوارق تترجم نفسها طبقياً منذ ذلك الحين ببطء، ومع ضمّه موجات من السكّان الآتين من أحياء أخرى من العاصمة دمشق نتيجة التوسع السكّاني، أخذَ الحي نفسه بالتغير، ليصبح أكثر تنوعاً على الصعيد الطبقي والمناطقي.
يمتد حي التضامن اليوم بين شارع فلسطين غرباً وبلدتي يلدا وببيلا جنوباً وشرقاً. وشارع فلسطين وهو شارعٌ قريبٌ من شارع مخيم اليرموك الرئيسي، يتفرع مثله عن ساحة تعرف بين السكّان بساحة البطيخة (الساحة تضم تمثالاً للكرة الأرضية). أما يلدا وببيلا فتُعدّان أولى البلدات أو الاحياء التابعة لمحافظة ريف دمشق من هذه الجهة. إلى شمال حي التضامن، يقع حي الزاهرة الدمشقي. ويتصل بالتضامن أيضاً حي السليخة من الشرق، وهو تابع بمعظمه لمحافظة ريف دمشق. يمتدّ التضامن فعلاً على أراضٍ تتبع إدارياً لمحافظتين؛ دمشق وريف دمشق.
كان سوق مخيم اليرموك، والأسواق في شارع فلسطين والشوارع المتفرعة منه باتجاه اليرموك، هي المركز الأساسي للحياة الاقتصادية بالنسبة لأحياء التضامن والحجر الأسود وبلدات جنوب دمشق، بالإضافة إلى مخيم اليرموك نفسه. كانت تلك الأحياء والمناطق أقرب إلى بعضها بعضاً من أحياء العاصمة الأخرى، وساهمت الفروق الطبقية بينها وبين أحياء العاصمة الأغنى القريبة أو الأبعد في وحدة الحال تلك. بين دمشق وفلسطين، كانت المنطقة أقرب إلى فلسطين.
لم يحظَ حيّ التضامن بأي رعاية حكومية، بل عاش إهمالاً مماثلاً لما عاشته معظم المناطق الأفقر. كان أحسنَ للعيش من بعض الأحياء العشوائية الأخرى مثل عش الورور ومزة 86، لكنّ مستوى الحياة فيه ظلّ أقلّ بكثير بالمقارنة مع أحياء دمشق الأغنى. كان غالبية سكانه من طبقة وسطى منهكة تقترب من الفقر، كانوا فقراء قليلاً أو كثيراً، لكن تلك الفوارق كانت تُمحى عند تمشيهم في كورنيش الميدان أو في حي المزرعة، وهي أحياء أصبحت مع الوقت حكراً على العائلات الأغنى في دمشق، الأغنى إلى مستوى يجعل سكّان التضامن كلّهم من الفقراء.
من الشبيحة إلى الدفاع الوطني
مع بداية الثورة السورية ربيع العام 2011، كان الضغط الأمني شديداً وسط العاصمة، في الأحياء المركزية والساحات العامة الرئيسية، حتى أنه وصل إلى حد استخدام سلاح متوسط ضد متظاهرين حاولوا الوصول إلى تلك الساحات. وقد أدّى ذلك إلى تركز المظاهرات والحراك المدني في الأحياء الطرفية للعاصمة دمشق، وما جاورها من بلدات ريف دمشق. تحولت أحياء مثل برزة إلى مركز للتظاهرات، بالمثل كانت أحياء التضامن وشارع فلسطين والحجر الأسود وبلدات يلدا وببيلا مركزاً للحراك السلمي والمظاهرات، الأمر الذي دفع النظام إلى البدء بالاعتماد على سكّان من تلك الأحياء كقوة بشرية مساندة لعناصر الأمن، الذين باتوا ينتشرون على مدار الساعة بلباس مدني في كل شوارع العاصمة لقمع التظاهرات. بدأ السكّان والمتظاهرون بإطلاق اسم الشبيحة على تلك المجموعات، وهو اسم مستمدّ من عناصر عصابات مرتبطة بأفراد من عائلة الأسد في اللاذقية، نشطوا في التهريب والسرقة والتعدي على السكّان خلال الثمانينات وبداية التسعينات (أرجحُ التفسيرات لتسمية شبيّحة هو أنها من شَبَح، وهو اسم محلي لسيارة مرسيدس S600 التي عرف بها المسؤولون، خاصةً المسؤولون الأمنيون في سوريا).
عبد الله الحريري ناشط وطبيب من المنطقة، عاش سنوات حصار مخيم اليرموك ولاحقاً بلدات جنوب دمشق. يقول للجمهورية: «عمل النظام على تطويق حي التضامن من خلال مجموعات الشبيحة، من شماله كانت المجموعات المرتبطة بشارع نسرين، فيما كانت هناك مجموعات تعمل مع الجبهة الشعبية-القيادة العامة من جهة شارع فلسطين بقيادة شخص اسمه سعيد محاد، وأخرى مرتبطة بفرع فلسطين (التابع للمخابرات العسكرية) يتزعمها شخص اسمه أبو محمد سريّة من جهة الجنوب. استقبل القسم الجنوبي من حي التضامن، إضافةً للتظاهرات والنشاط السلمي، أعداداً كبيرة من النازحين خاصةً من مدينة حمص. وقد عملنا هناك على تأسيس عيادات سرّية لمعالجة المصابين خلال المظاهرات، أو نتيجة استهدافات القناصين الذين نشرتهم مجموعات الشبيحة، وذلك في ورش كانت تعمل نهاراً في الخياطة، ونُجري فيها ليلاً عمليات الإسعاف وعمليات جراحية صغرى».
بدأت الأفرع الأمنية المسؤولة عن المنطقة تنظم تلك المجموعات ضمن ما يسمى باللجان الشعبية، وتسلّحها بأسلحة خفيفة بعد أن كانت تستخدم الأسلحة البيضاء والهراوات في قمع المتظاهرين، وبدأت أسماء عناصر من تلك الميليشيات أو من متعاملين مع فروع أمنية بالبروز نتيجة الانتهاكات التي قاموا بها.
كان عادل قطف يستخدم اسماً مستعاراً هو حاتم الدمشقي خلال عمله في المجلس المحلي لحي التضامن، وخلال نشاطه الإعلامي في الفترات التي سيطر فيها الجيش الحر على أجزاء واسعة من الحي. يقول قطف خلال حديثه للجمهورية: «استطعتُ خلال فترة وجودي في الحي، وأنا أحد ساكنيه، توثيق عدة مجازر قام بها النظام. كانت الميليشيات بقيادة فادي صقر، التي تحولت إلى مسمّى الدفاع الوطني أواخر 2012، ترتكب انتهاكات وجرائم بمساعدة دوريات تابعة لأفرع المخابرات العسكرية. كان هؤلاء الذين ظهروا في فيديو مجزرة التضامن، بمن فيهم أمجد يوسف، معروفين لدينا في الحي من خلال ارتكابهم المتكرر للانتهاكات وعمليات الاعتقال والتصفيات بحق ناشطين سلميين، وقيامهم بهدم أبنية في منطقة السليخة شرق التضامن. لقد وثقتُ خلال عملي الصحفي أسماء وقصص ضحايا أكثر من سبعة مجازر تم ارتكابها من قبلهم».
كان العامل الطائفي يلعب دوراً في تشكيل تلك المجموعات، لكنّه حسب الناشطين الذين عايشوا تلك الفترة لم يكن وحيداً. عبد الله الحريري يشرح خلال حديثه مع الجمهورية هذا التفصيل: «قد يكون العامل الطائفي أساسياً في تشكيل تلك المجموعات في البداية، لكنّها لم تكن بذلك المعنى صافية طائفياً. تعود أصول عائلة أحد الشباب الذين نعرفهم في المنطقة إلى عائلة سنيّة، وكان بحكم الجوار والصداقات مرتبطاً قبل الثورة بأحد قادة الشبيحة في المنطقة لاحقاً. بحكم تلك العلاقات، استطاعوا اجتذابه لمجموعات الشبيحة تلك في بداية الثورة. لاحقاً، ترك ذلك الشاب، الذي لا أريد ذكر اسمه خوفاً على أهله، مجموعاتِ الشبيحة بعد أن شاهدهم يطلقون النار مباشرة على المتظاهرين الذين يخرجون من أحد الجوامع. في حديث بيننا بعد سنوات، ذكرني هو بأنه كان مع أحد المجموعات التي قامت بضربي خلال مظاهرة قمنا بها».
يتابع عبد الله الحريري حديثه للجمهورية عن تلك المجموعات: «في المرحلة اللاحقة التي بدأ فيها تنظيم عمل الشبيحة، لا يمكننا فصل ما كان يجري في حي التضامن عن عموم منطقة جنوب دمشق، وذلك بسبب التزامن والتنسيق في تشكيل اللجان والمجموعات في حي التضامن ومخيم اليرموك، وحتى في منطقة السيدة زينب إلى الجنوب».
يقول الحريري: «لاحقاً عندما تم تنظيم مجموعات الشبيحة في لجان، وأنشأوا الحاجز الأول لهم في شارع نسرين عند مطعم البركة عام 2012، كان دور هذا الحاجز تحديد الحركة ومراقبة داخل حي التضامن لمنع الحراك ضمنه. وهو ما فعلته باقي المجموعات في الأحياء المجاورة، كما في حالة مجموعات القيادة العامة (الجبهة الشعبية – القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل) في مخيم اليرموك».
مختفون في غياب مظلم
حصلت مجموعات الشبيحة تلك على سلطات واسعة في المنطقة، نافست من خلالها نفوذ ضباط من رتب عالية في الجيش وحتى بعض أجهزة الأمن، ما انعكس على شكل زيادة في الاعتماد عليها في عمليات القمع وفي حماية حدود سيطرة النظام في المنطقة، بعد أن كانت مجرد رافد للقوى الأمنية خلال قمع الاحتجاجات والمظاهرات في عموم البلاد.
حازم يونس ناشط فلسطيني من مخيم اليرموك، كان يعمل في سفارة فلسطين (سفارة السلطة الفلسطينية في سوريا، وأصبحت تعرف باسم سفارة فلسطين بعد اعتراف سوريا بالسلطة كدولة مستقلة)، شاركَ في اجتماعٍ باسم السفارة كان يحضره ضباط رفيعو المستوى من جيش النظام أحدهم برتبة لواء، كما حضره فادي صقر متزعم مجموعات الشبيحة والدفاع الوطني لاحقاً. يقول حازم: «كان فادي صقر يوجه الإهانات للّواء دون أن يرد عليه الأخير. كانت سلطة صقر واضحة للعيان، كما كانت مجموعاته فوق أي محاسبة من قبل النظام».
بدأ الناس في تلك الفترة بالاختفاء على حواجز اللجان الشعبية حتى قبل تسميتها باسم الدفاع الوطني، وهو الاسم الرسمي اللاحق الذي عرفت به تلك المجموعات منذ أواخر عام 2012، بعد أن حظيت بدعم إيراني كبير. وبدأت قصص الناجين من الفظائع المرتكبة بالظهور. يحكي عبد الله الحريري قصة سمعها من طفل مصاب، جاء به أهله إلى المشفى الميداني حيث كان يعمل في مخيم فلسطين منتصف العام 2013: «قبل تطبيق الحصار الكامل على مخيم اليرموك، جاء إلينا في النقطة الطبية هناك طفل عمره لا يتجاوز 15 عاماً، كان قد استطاع الهرب من لجان الدفاع الوطني في شارع نسرين، بعد أن اعتقلوه عند حاجز الفرن الآلي وأدخلوه إلى محل قديم كانوا قد حولوه إلى سجن للاعتقال. استطاع الطفل الذي كان صغير الحجم الهروب من شباك صغير في الدكان (شباك المنور) والرجوع إلى المخيم، وقد روى لنا بأنّه شاهد جثامين ثلاثة أشخاص قتلوا ذبحاً في الدكّان، فيما كان الدمُ يغطي كل جدران المكان. كان الطفل قد تعرَّضَ لتعذيب بانت آثاره على جسمه، مثل مناطق مزرقة على الظهر وكدمات على الوجه».
يتذكر حازم يونس أيضاً قصص من قُتلوا أو اعتقلوا في المنطقة على يد تلك الحواجز والشبيحة: «أبو علاء جودة قتل برصاص قناص حاجز الريجة. أبو إبراهيم الخطيب خرج للحصول على طحين فاعتقلوه من على حاجز نسرين. أما المجرم أمجد يوسف فقد قام بقتل مدنيين على حاجز شارع نسرين عندما قتل أخوه في إحدى المعارك. أيضاً، روى لي صديقٌ في السويد هنا قصة عن عائلة خالته التي تعيش في مجموعة من أربع أبنية يقطنها فلسطينيون في حي التضامن، يقول إن الشبيحة اعتقلوا في اليوم نفسه كلّاً من مولود الخالد العبد الله، ديب الأحمد، إلهام العبد الله، إنعام العبد الله، ياسمين العبد الله وابنها الطفل عبادة العبد الله، الذين اختفوا جميعاً دون أي أثر بعد ذلك».
كانت الإهانات والمضايقات والابتزاز المالي أساس عمل الحواجز التي انتشرت في مداخل حي التضامن ومخيم اليرموك، كما كان العناصر يختطفون المدنيين دون أي رادع. يروي حازم يونس قصة فتاة اعتُقلت مع خطيبها على حاجز مدخل المخيم، فقط لأنّ خطيبها ردّ على إهانة أحد العناصر لخطيبته: «عند رد خطيب الفتاة على عناصر الحاجز، قاموا فوراً باعتقالهما وإخفائهما، وعلى الرغم من أنّ قريب الفتاة كان في منصب رفيع ضمن حركة فتح، وعلى الرغم من مطالبات السلطة الفلسطينية العديدة بالإفراج عن المعتقلين، لم يصل أي خبر منهم ويبقى أهلهم إلى اليوم من دون أي معلومات. لقد كانوا يريدون دخول مخيم اليرموك للاطمئنان على عائلاتهم التي أصيب بعض أفرادها نتيجة قصف طائرة ميغ للمخيم، وذلك في أولى حوادث قصف الطيران للأحياء المدينة في سوريا آن ذاك، لكن الأمر انتهى بهم مُغيَّبين حتى اليوم».
خلال تلك الفترة، لعب شبيحة شارع نسرين دوراً أساسياً، فكلّ المعتقلين على الحواجز في المنطقة كان يتم أخذهم إلى حاجز الفرن الآلي في الشارع أو الحاجز الآخر الذي أُنشئ في منتصفه، وهو ما كان يدل على السلطة التي امتلكها الشبيحة أو عناصر الدفاع الوطني لاحقاً.
وثَّق عادل قطف وزملاؤه، خلال عملهم الإعلامي في التضامن، العديد من الاعتقالات التي جرت قُبيلَ المجزرة التي كشف عنها تحقيق قرابين التضامن: «قبل أيام من حدوث تلك المجزرة، اعتقلت دوريات من المخابرات العسكرية ومجموعات تابعة للشبيحة ثلاث عائلات تسكن خلف جامع عثمان بالقرب من مكان حدوث المجزرة. كان هناك زوجان حديثا الزواج، وعائلة لديها طفل واحد وعائلة مع طفلين. اختفوا جميعاً منذ ذلك الوقت بعد أن اقتحم الشبيحة منازلهم وأخذوهم. كان صديقي من بينهم، كان يحاول تأمين منزل خارج التضامن قبل أيام، لكنّ تلك المداهمة أنهت بحثه ذاك، ليبدأ بحثنا نحن عن مصيره ومصير العائلات التي لا نعرف عنها شيئاً حتى اليوم».
بعض العائلات بدأت بالتعرف على أبنائها من خلال فيديو المجزرة الذي تم تسريبه. كشفت المشاهد الصادمة والفظيعة عن مصير عدد من ضحايا المجزرة، أحدهم كان وسيم صيام ابن مخيم اليرموك. يتذكر عمر صيام اللحظات التي سبقت اختفاء ابنه وسيم: «كان وسيم ذاهباً لجلب الخبز من الفرن الآلي في حي التضامن ليعود قبل إغلاق حاجز المخيم في الساعة الواحدة ظهراً، إذ كان المخيم حين ذاك محاصراً بشكل جزئي، وتُفتَح الحواجز لمرور المدنيين لساعات معينة من كل يوم. في الرابع عشر من شهر نيسان عام 2013، في الساعة الواحدة إلا ثلث، اتصلت بوسيم من أجل حثّه على العودة بسرعة إلى المخيم قبل إغلاق الحاجز. ردّ عليَّ بشكل غريب لم أكن معتاداً عليه منه، قال لي: ماشي ماشي، وأغلق الهاتف. بعد ساعات بدأنا بالسؤال عن وسيم، كان هاتفه قد أُغلق ولم نعلم عنه شيئاً منذ ذلك الوقت إلى أن شاهدناه في فيديو المجزرة. كنّا قبل فترة قد استخرجنا قيداً عائلياً بعد أن قام أفراد من أقاربنا بالمثل وحصلوا على شهادات وفاة لأبنائهم المعتقلين. كان وسيم حيّاً في السجلات». «تأملنا كثيراً»؛ تقول والدة وسيم التي شاركت والدهُ الحديث معي.
لم يتم التعرف على أغلب ضحايا مجزرة التضامن، التي تم الكشف عن مرتكبيها وعن تفاصيل منها في التحقيق الذي عملت عليه أنصار شحود وأور أونغور، وهي واحدة فقط من سلسلة مجازر، بعضها مصوّرٌ في فيديوهات أخرى ولم تُعرَف حتى اليوم أسماء مرتكبيها، كما لم تُعرف أسماء ضحاياها بعد. ضحايا سوريون وفلسطينيون، من كل سوريا وكل فلسطين، قتلوا وحرقت جثامينهم بوحشية لا يمكن تخيلها، فيما يبقى ضحايا الاختفاء القسري في جنوب دمشق وكل سوريا في الغياب، وأهاليهم لا يملكون القدرة على الوصول إلى أي معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة . وقد كشفَ الإفراج عن أعداد قليلة من المعتقلين لدى النظام، قبل أسابيع قليلة، عن أشخاص ظلّوا لسنوات مغيبين في سجون مثل صيدنايا. لا نعلم العدد الحقيقي للمختفين قسراً في سوريا. تشير بعض الأرقام إلى أكثر من مئة ألف، لكنّ الجهات الحقوقية نفسها تقول أيضاً إنّها لم تستطع توثيق كل الحالات التي قد يفوق عددها ذلك التقدير بكثير. وربما لا نملك الكثير لنفعله من أجل كشف مصيرهم وإطلاق الأحياء منهم، لكن رواية حكاية ضحايا التغييب هي نضالٌ ضد المُغيِّب، الذي يريد لرجال ونساء وأطفال من ضحاياه أن يختفوا في النسيان.