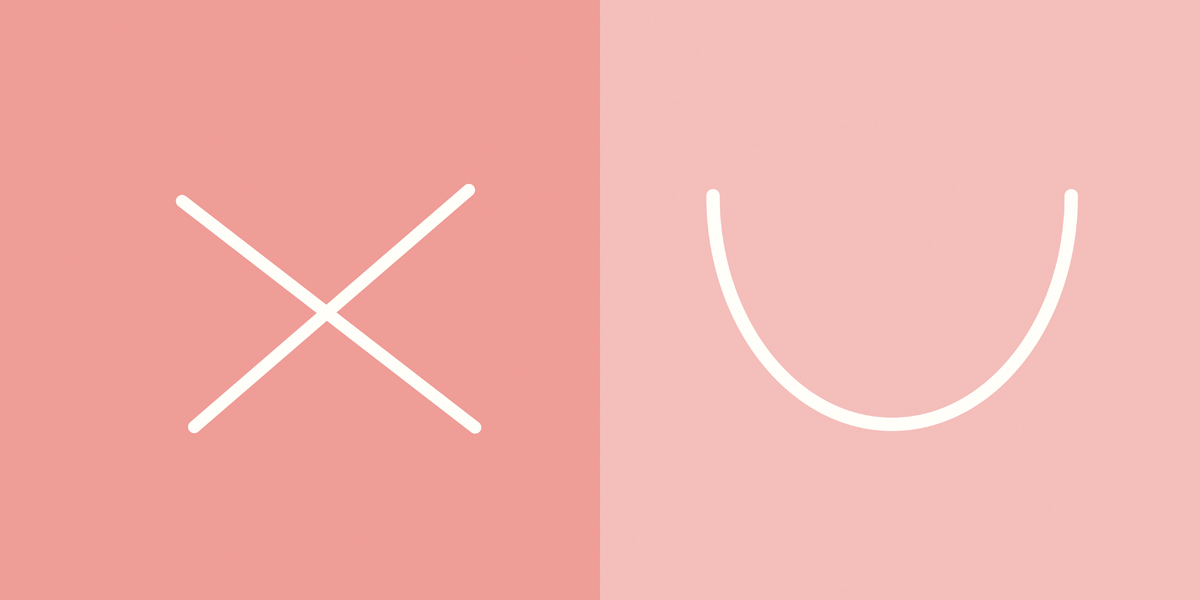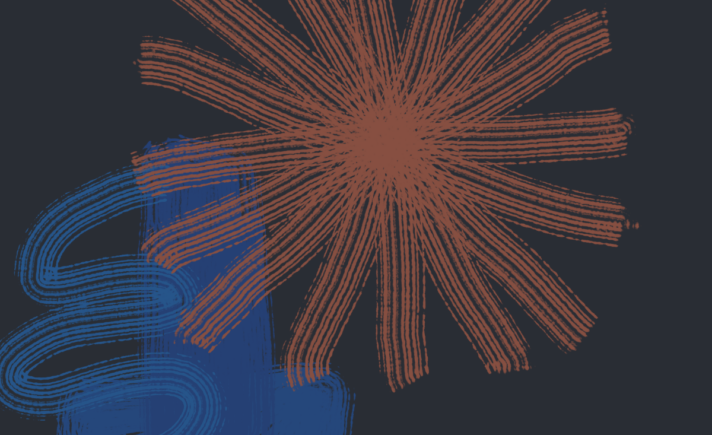أرضعت سحر ابنها عامين كاملين. «متولّعاً» بالثدي الأيسر كان يعضّ على الحلمة باستمرار، فترك لها ندبةً تشبه قطبتين صغيرتين. ستمرّ خمسة أعوام قبل أن يستأصل الأطباء ذاكرة أسنان ابنها بالكامل. تبدو سحر أكثر رقةً ونحولاً وهي تبوح لي بلهجةٍ جزراوية دافئة: «لمّا سمعت الخبر ما عدت جمّع بالفرنسي، حتى بالعربي ما كنت رح جمّع».
سحر لاجئةٌ سورية تقيم في باريس مع طفليها اللَذين انتظرت قدومهما طويلاً. كانت معلمةً في سوريا، ووصلت إلى فرنسا امرأةً غريبةً وممتلئةً بالهموم كما تصف نفسها. عملاً بنصيحة إحدى الصديقات، خضعت لفحصٍ روتيني لسرطان الثدي. الخبر السيء كان «غزو» الكتل الكلسية لثدي سحر، حسب تعبيرها، وتأكيد إصابتها بالسرطان. الخبر الجيد أنها لن تحتاج علاجاً كيماوياً أو إشعاعياً: ينصّ البروتوكول على استئصال الثدي كاملاً، فقط!
رغم تطور النظام الصحي نسبياً في فرنسا، تعاني الكثيرات من مريضات السرطان من صعوباتٍ للحصول على دعمٍ نفسي. إلا إن اللاجئات، وبشكلٍ خاص الواصلات حديثاً منهنّ، يعانين صعوباتٍ خاصة متصلة بسياق اللجوء. وعلى عكس بروتوكول العلاج الفيزيولوجي المُحدّد، ليس هناك بروتوكول دعم نفسي واضح ومُقدَّم بصورة ممنهجة مع العلاج من السرطان في فرنسا، مما يضاعف الحاجة لفهم المجتمع والجمعيات والخيارات المتوفرة، بالإضافة لشبكة علاقات اجتماعية وأسرية، للتمكن من تجاوز التجربة.
تظهر دراسةُ استطلعت آراء 287 امرأة مصابة أو سبق وأصيبت بالسرطان، أنه بعد تشخيص الإصابة بسرطان الثدي، فإن 44 بالمئة من النساء لم يتلقين أي دعمٍ نفسي، ولا يتم تضمين النفس في معادلة علاج المرض ما يقرب من نصف الوقت. في البروتوكولات الحالية، يبدو أن الأدوية والجراحة و/أو العلاج الكيماوي والإشعاعي وحدها المهمة في عملية الشفاء. 79 بالمئة من النساء اللواتي تمّ سؤالهنّ يعتبرنَ أن العامل النفسي يلعب دوراً أساسياً في الشفاء، و87 بالمئة من النساء يعتقدن أن المرافقة النفسية ضرورية أو مفيدة.
في المستشفيات والعيادات، يوجد طبيب/ة نفسي/ة من حيث المبدأ. أحيانًا يكون غائباً/ة ولا يتم استبداله/ا في حالة الإجازة أو المغادرة، وغالبًا ما يكون منشغلاً/ة بسبب العدد الكبير من المرضى والمريضات. من بين 287 امرأة في الدراسة، 45 بالمئة منهن لم يسبق لهن أن التقين به/ا و6 بالمئة لم يكنّ حتى على علمٍ بوجوده/ا.
الديمقراطية الصحية وموقع اللاجئات في النظام الصحي
«طلعت من عند الدكتور. شعلت سيجارة. يجي الباص أطلع، أنتبه إنه مو هاذ الباص، أنزل، أفوت عالمترو، لا ما بدي المترو، أرجع أنزل آخذ الباص، لا الباص ما يودّيني، طب أنا وين بدي أروح؟ أروح عالبيت؟ ما بدي البيت، أحكي مع رفيقتي؟ ما بدي أحكي مع رفيقتي، أختي ما بدي وأنا منهارة، رحت على دكتور سوري، دخلت وصرت أبكي». بهذا التيه تلخّص سحر يوماً لا يشبه غيره في حياة اللاجئة، اليوم الذي تصبح فيه -رسمياً- مريضة سرطان.
انسكب على سحر خبر إصابتها بالسرطان كدلو ماءٍ باردٍ في تشرين، وتلاه خبر تشخيصها بأم دم في الدماغ (تمدد الأوعية الدموية الدماغية Mycotic Aneurysm). تخبرني أنها حظيت في البداية بطبيبةٍ لطيفة جداً، حاولت قدر استطاعتها تخفيف وقع التجربة عليها. كانت قويةً ومدفوعةً برغبتها بالاستمرار لأجل أولادها، إلا إن الطريق بقي حافلاً بالمطبات.
تنقّلت سحر بين العيادات والمشافي وغرف التصوير دون أدنى فكرة عما ينتظرها خلف الأبواب المغلقة. مستوى اللغة الذي يكفيها في حياتها اليومية والاجتماعية لا يعينها على تفكيك شِفرات المصطلحات الطبية: إيريم، سكانر، بيوبسي، وكاتيتيغ، والوصفات والتعليمات السابقة واللاحقة للإجراءات التي تخضع لها. رغم محاولات التفسير، تجد نفسها مرةً مصلوبةً ومقيّدةً على سريرٍ مرتفع في غرفة باردة، وأخرى تتوقع ألماً عظيماً من سحب الخزعة لتكتشف أنه دغدغةٌ لا أكثر. وحين تحصل على شرح، يكون أحياناً بـ«قعدت الدكتورة الجراحة قدامي بجدية كتير. حطتلي ورقتين، ورقة مرسوم عليها امرأة عارية، والتانية مرسوم عليها امرأة مع X كبيرة على الصدر، وقالت أنتِ هيك، ورح يصير هيك». كل هذا الألم النفسي جاء مصحوباً بآلامٍ جسدية وأعباءٍ تنظيمية متعلقة برعاية الأطفال وإدارة حياتهم اليومية.
رغم كل هذا، على الأقل لم يكن لديها أي مخاوف مالية، فالنظام الصحي يتكفّل بكل تكاليف علاجها كلاجئة، ويوفّر لها دعماً لوجِستياً. عليها فقط أن تفكر بالتفتيش عنه. هذه إحدى مزايا الديمقراطية الصحية الفرنسية.
تحتفل الديموقراطية الصحية الفرنسية بعيدها العشرين هذا العام، والفاعل الأساسي فيها وكالات الصحة الإقليمية. تُعرّف هذه الديموقراطية بأنها «نهجٌ يهدف إلى إشراك جميع فاعلي النظام الصحي في تطوير وتنفيذ السياسة الصحية، بروحٍ من الحوار والتشاور». عندما نتحدث عن فاعلي النظام الصحي فإننا نشمل بالضرورة مؤسسات المجتمع المدني، والمستفيدين/ات، والمرضى وأسرهم/ن.
تنعكس هذه الديموقراطية بهيئة تفاوت في نوعية وأولويات الخدمات الصحية من منطقة لأخرى، وعلى عكس العلاج الكيماوي أو التدخل الجراحي، فإنّ بروتوكول الدعم النفسي لا يُعرض على جميع المريضات بصورةٍ ممنهجة.
تقول ميكاييلا روسناك، الأمينة العامة ومستشارة الصحة والاجتماع في المفوضية بين الوزارية لاستقبال واندماج اللاجئين، إنه «لا يوجد سياسة صحية خاصة باللاجئات، وهذه السياسة ليست حيوية. المطلوب هو تعزيز وصول اللاجئات للخدمات الصحية وتساويهنّ مع بقية النساء، لكن التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية غير كافٍ». لا تتقاطع اختصاصات الوزارتين هنا بالصورة الكافية، وتختصّ وزارة الداخلية بكل ما هو إداري وأمني. كما لا تبدو تحديات اللاجئات في الوصول للرعاية الصحية كأولوية لوزارة الصحة، سواءً على صعيد توفير حلول للترجمة أو التوعية للعاملين/ات في القطاع الصحي بخصوصية سياق المهاجرات واللاجئات.
تشرح روسناك أن الوزارة تطرح ثيمةً عامةً سنوية، وتموّل المشاريع التي تُقدّم في إطارها: «المفتاح هو وكالات الصحة الإقليمية. تطرح الجمعيات والأفراد المواضيع، ثم تُصاغ الاستراتيجيات والمشاريع لتمويلها. هناك مشاريع للفئات الضعيفة، ولكن ليس للاجئات. لسن مرئياتٍ بما يكفي ليُطرحن كثيمةٍ منفصلة».
في حالة مريضات سرطان الثدي من اللاجئات نواجه المشكلة التي تواجه أية ديموقراطية، وهي سؤال تمثيل أقلية غير مرئية بما يكفي لإطلاق إنذارات في إحصائيات الصحة العامة، وسؤالاً أقل بداهة يتعلق بمقدرة المريضات والمتعافيات على فهم هذه الديناميكية والتحوّل لعناصر فاعلة ضمنها، سواء أثناء مرحلة العلاج الشاقة، أو في رحلة التعافي التي قد تكون أكثر مشقةً أحياناً.
مع تكاثف الإحباطات الناجمة عن تعسّر التواصل، وما ينتج عن ذلك من أعباء طبية واجتماعية، تبرز الحاجة لتفعيل دور دوائر الدعم القريبة والبعيدة، افتراضياً وواقعياً.
دوائر دعم/ضغط
مرّ سرطان الثدي في المجتمع الفرنسي بمراحل عديدة وصولاً لتطبيعه ونزع هالة الرهبة عنه. ما زال يُرى كمرضٍ صعب، لكنّه لم يعد تابوهاً كما هو في مجتمعاتنا. ينعكس هذا التطبيع على ردود أفعال القطاع الطبي والمجتمع. قد يخفف هذا التعاطي من حدة التجربة على النساء اللاتي تُشِرن أو يشار لمرضهن بـ«هداك المرض»، وقد يُفسَّر كحالة لا مبالاة أو استخفاف بما هو ليس مؤلماً فحسب، بل مروّعاً للّاجئة السورية أيضاً.
بحسب المعهد الوطني للسرطان، يتوزع دور الأهل والأقارب والمعارف على محاور التعافي، والتواصل، وملاحظة أعراض جديدة، والدعم النفسي، والدعم اللوجستي والإداري، وإيصال المعلومات، والانتباه للعلاج، وملاحظة الألم والتعامل معه، والتعامل مع عودة المرض، ومراحل الحياة الأخيرة، والحصول على المساعدة الذاتية أيضاً.
هذه المهام لا يتقنها الأفراد فطرياً، وبالتأكيد تصبح أكثر تعقيداً حين تكون الدائرة القريبة مغمورةً بأعباء اللجوء والحروب، وتنتصب بينها وبين الوصول للمعلومة جدرانٌ لغوية وثقافية. لا أذكر في أي أكتوبرٍ ورديٍّ مرّ عليّ في سوريا أو فرنسا حملةَ توعيةٍ للمُقرّبات. لم يعلّمنا أحد أن «نترك مريضة السرطان بحالها، المريضة عايفة حالها»، «وطّوا صوتكن بس»، «بدي أحسّ في آدمي ماسك إيدي»، «يتحمل الطوابير والممرضات»، «أنا تعبانة، بديهي كون تعبانة»، وغيرها مما أخبرتني به الناجيات والشهادات التي قرأتها.
مازلنا في المجتمعات العربية، في الداخل والمهجر، نتعامل مع المرض بحذرٍ مبالغٍ فيه، يقود إلى تحويل دوائر الأهل والأصدقاء، في كثيرٍ من الأحيان، إلى جزءٍ كبيرٍ من المشكلة، وعبءٍ على المريضات بدل أن يتفعّل دورنا كشبكة دعمٍ متينةٍ وحيوية.
الطريق إلى جحيم جديد لسحر وابنها كان معبّداً بالنوايا الحسنة للجارات. لم تكن قد أخبرت أولادها بمرضها بعد: «كنت أحكي بعفوية للجارات. جاية من المشفى، جاية من الخزعة». تصادفَ يوم نتيجة الخزعة مع وقفة العيد. «قلتلن ادعولي، معي سرطان ادعولي، يمكن بين ليلة وضحاها ما أحتاج لاستئصال». تُشعل سيجارةً جديدةً وتتابع حكايتها: «وتعالي شوفي. صرت أوقف مع حدا، أول ما تضرب عينه على صدري». تصف الحالة الدرامية التي دخلن فيها بذريعة الاطمئنان عليها، والمبالغات والتهويل وصولاً للبكاء. «هادا القهر النفسي يمكن هو يلي سرّع استئصال الثدي عندي. عشت قهر شديد، ناهيك عن كم رسائل الواتس ‘يا شحاري عالأولاد’، ‘انحرق قلبنا عليكي’، وأنا حتى ما أعرفهن».
هذا الضغط قاد سحر للومِ نفسها على إخبارهنّ، تحديداً عندما بدأ الأطفال في صف ابنها بترديد عبارات من نوع: «أمك بدها تموت، أمك معاها سرطان»، «يا حرام أمه بدها تموت». ولم يكن وقع الحالة سهلاً على طفلٍ في السابعة والنصف من عمره، لكن لحسن الحظ تمّ تحويله إلى مختصة نفسية تابعته حتى تجاوز الأزمة.
عاشت سحر هذه الرحلة وحدها. «يوم سحب الخزعة قلت للممرضة عطيني إيدك، أحس في آدمي ماسك إيدي». لم تكن ترغب بوجود طليقها، زوجها آنذاك، لأنه يتأرجح بين اللامبالاة الكاملة والنزق وتهويل الأمور بسبب انتظار عدة دقائق في طابور أو برود إحدى الممرضات. يوتّرُها، وطاقته سلبية، كما تصفه سحر. لم تُرد أن تُثقل على صديقاتها بما يتعدى رعاية الأطفال عدة ساعات أثناء مواعيدها الطبية. أما أختها في سوريا فكانت تقويها وتدعمها عن بُعد.
تختلف تجربة مريضة السرطان التي تمرّ بعلاج كيماوي وإشعاعي. تحتاج المريضة أثناء فترة العلاج لخدماتٍ لوجستية يومية، ولدعمٍ نفسي وتشجيع على تحمّل الألم والأعراض الجانبية التي تمسّ جنسانية المرأة وصورتها في عين نفسها. هذا الدعم المتواصل يكلّف المحيط وقتاً وجهداً. وإنْ تكفّل النظام الصحي والاجتماعي بكثيرٍ من التكاليف، كإجازات مرافقة المريضة على سبيل المثال، يبقى مجتمع اللجوء أبعد عن الوصول للمعلومة والاستفادة منها. هذا ما اختبرته لينا (اسم مستعار). مرت لينا بعلاج كيماوي وإشعاعي طويل، تزامن مع وصولها وأعاق تعلّمها اللغة الفرنسية.
وصلت لينا إلى فرنسا منذ ما يقارب الأربعة أعوام والنصف، في الثلاثينات من عمرها، مصحوبةً بكتلةٍ خبيثةٍ لم تكن تعرف بوجودها بعد. استقرت في الجنوب الفرنسي بعد تنقّلها بين عدة منازل لعائلات فرنسية. كانت لينا واعيةً لأهمية الفحص الدوري لسرطان الثدي، حتى إنها عملت سابقاً في التوعية، لكنها أهملته تماماً بسبب الاكتئاب الحاد. رد فعلها الأول على تشخيصها كان الضحك: «الكانسر كان حالة خلاص».
مرض لينا كان يُعلن عن نفسه. لم تتعود طلب المساعدة أو التعبير عن ألمها، لكنّ إخبار المحيط لم يعد خيارها بعد أن فقدت شعرها: «عمبحكي مع ماما فيديو وأنا حاطة طاقية، عمحك راسي علقت الطاقية بظفري وطارت. كبيت الموبايل، حطيتا ورجعت، بس ماما لونها تغير». تشارك سحر أيضاً ندمها على المشاركة، وتقول إن والدَيها في سوريا حمّلاها مسؤولية عدم إخبارهما، وباتت مضطرةً لاصطناع دور المرأة القوية التي تعيش حياةً طبيعية، وللرد على الاتصالات فوراً لتجنيبهم حالة هلع، وهذه المهمة صعبةٌ جداً.
انتقلت لينا من الجنوب إلى باريس بناءً على «قرار» أختيها وشريكها، ليستطيعوا البقاء بجانبها، وهو ما ندمت عليه كذلك، لتلقيها رعايةً صحية أفضل في الجنوب، وارتياحها بالتعامل مع طبيبتها هناك أكثر من «الجزارين» غير القادرين على الإحساس بألمها كامرأة كما تشعر.
«ما كان لازم كون لحالي. اليوم بعرف إني ما لازم كون لحالي، بس ما كنت قادرة اطلب من حدا يكون معي». تضيف لينا بعد صمتٍ قصير: «حتى لو قلتي للشخص ما تجي، من جواتك بيكون بدك ياه يجي. عملياً أنا بحاجة لحدا، خصوصاً إنه ما بحكي لغة. مريض الكانسر لازم حدا يرافقه بكل تفاصيله».
أثّرت تجربة السرطان على علاقة لينا بشريكها. عدم قدرة لينا على طلب المساعدة بصورة صريحة، وارتباك مشاعرها وغيابها أحياناً «ما كان عندي مشاعر تجاه حدا، ولا مشاعر تجاه حالي حتى»، وردود أفعال شريكها غير المتناسبة دائماً مع المواقف التي تتعرض لها، وغيابه في مواقف احتاجته فيها، شكّلت ضغطاً على العلاقة. تذكر في إحدى المرات القليلة التي رافقها فيها شريكها إلى المشفى أنّ ممرضةً متدربةً كانت تحاول تركيب إبرة وريدية وتفشل في عدة محاولاتٍ مؤلمة. يضحك شريكها، فتنفجر بالبكاء لشعورها أن ألمها غير مرئي حتى لأقرب الأشخاص منها. العبارة التي كسرت العلاقة كانت: «إذا حاسة حالك متضايقة هون ارجعي للجنوب». إحساس الخذلان تصدّر الأسباب التي جعلتها تنهي العلاقة.
مع عودة لينا التدريجية إلى عجلة الحياة السريعة في فرنسا، أصبحت تتفهّم أكثر موقف وسلوك عائلتها والمقربين/ات منها: «ما بلومن، أنا كمان ما بطلب، ما فيني حملن المسؤولية».
هذه التعقيدات تجعل دور المرافقة من قبل جهات لديها الخبرة والموارد مهماً في تخفيف وقع التجربة على النساء.
دوائر دعم المجتمع المدني
منذ وصولها إلى فرنسا، تواصلت لينا مع جمعياتٍ ومنظماتٍ ساعدتها في النواحي الإدارية والمادية واللوجستية، لكنها لم تكن دائماً مساعدةً مختصة، وافتقرت في كثيرٍ من الأحيان لفهم سياق اللجوء والسياق السوري، بالذات في الجنوب الفرنسي في مدينةٍ يمينيةٍ إلى حدٍّ ما. «كنت فأرة تجارب للجمعية»، «حبابين بس ما بيعرفوا يشتغلوا» تقول لينا. تبتسم مع تذكّر «الست المغربية» التي سترافقها تطوعياً وبتفانٍ غير محدود إلى مواعيدها الطبية وجلسات الكيماوي اليومية الطويلة، وستستفيد من خبرتها كمساعدة اجتماعية سابقة.
لم تنجح لينا في الحصول على مرافقة شبيهة في باريس. من جهة لأنها لم تسعَ جدياً لذلك، لشعورها أنها قادرةٌ على تدبّر أمورها بالحد الأدنى، ومن جهة لأن الوصول لمعلومات حول ما يوجد ليس سهلاً حين لا تتحدث لغة البلد المضيف. شاركت لينا بالفعل في جلسة تعريفية بجمعية مرافقة لمريضات السرطان ومستوى اللغة لم يسعفها بفهم العرض، وسرعان ما توقفت عن زيارة الممرضة النفسية نظراً لصعوبة التواصل وتحوّل الزيارات إلى دروس لغة.
الشعور بالضياع هو المشكلة الأكبر التي واجهت لينا مع انقطاع المرافقة المفاجئ، والصدمة بأنها لا تعرف شيئاً عن حالتها الصحية فعلياً. وجود الوسيط ألغى الحاجة للشرح المفصل لها كصاحبة العلاقة. ورغم وجود المرافقة تعرضتْ لمواقف مؤذية نتيجة خللٍ في التواصل: «يوم تركيب المنفذ الوريدي دخلت عالغرفة لقيت مشارط وجهاز تنفس، ما كنت فهمانة شو رح يصير، فكرت لزقة أو سيروم. بلشوا يشتغلوا وأنا حاسة بكل مشرط وما قادرة احكي، صرت اسعل من الربو والألم الشديد، كنت حاسة بكل شي. طلعتْ وجهي أصفر، لو كنت عارفة في جراحة كنت خبرتن إني عندي مشاكل بالتخدير»، ولا تعرف لينا أين سقطت المعلومة في طريقها إليها.
في ظل حالة النقص في الدعم الذي تحظى به مريضات سرطان الثدي من اللاجئات، تلعب الكنيسة دوراً هاماً في بعض الحالات. خبرة الكنيسة تأتي من تاريخها في العمل مع المهاجرات والمهاجرين، وتحديداً توفير الرعاية في سياق المرض. تختلف هذه التجربة بالضرورة عن تجربة جمعيات ناشئة بدأت مؤخراً بالاهتمام بسؤال اللجوء والاطلاع على سياقاته وتحدياته، والجمعيات المتوجهة لمرافقة مريضات السرطان الفرنسيات أو الناطقات بالفرنسية.
كان هذا الدور أساسياً بالنسبة لرولا، وهي ناجية سوريّة من سرطان الثدي ولاجئة في فرنسا. تدرس رولا الترجمة الآن، وتركّز على دور المُترجمة في حياة مريضة السرطان، ودور المُترجم كمعالج أيضاً، وعلى توظيف الفن في كل مجالات الحياة والمرافقة الطبية. تؤمن بأهمية الفن كأداة معالجة ونمط حياة، وتداوم على التعبير عن نفسها في الكورال أسبوعياً. وتحدّثنا عن رحلتها مع العلاج.
الحدس دفع رولا لإجراء الفحص الطبي، صوتٌ داخليٌّ أدى لكشفٍ مبكرٍ عن سرطانٍ في الثدي، تبعه الاستئصال وترميمه بزرعٍ من الظهر تركها مع حقيقة ألمٍ ثابتٍ في الظهر، يخفّ لكنه لن يزول. وصلت رولا إلى فرنسا عام 2014، محمّلةً بذنب ترك والديها في سوريا للنجاة بابنتها الوحيدة التي لم تكمل عامها السابع عشر، وعازمةً على إعادة بناء حياتها بدءاً من تعلم اللغة الفرنسية. إقامة بضيافة سيدة فرنسية، ودروس لغة، ثمّ مهام تطوعية عديدة ساعدتها على التقدّم والحصول على عمل والالتحاق أخيراً بالجامعة من جديد.
رحلة السرطان لأمٍّ عازبة في المنفى لم تكن نزهةً خفيفة. لحسن الحظ، كانت والدتها في زيارةٍ قصيرةٍ لها عند معرفتها بإصابتها بالسرطان، ولسوء الحظ، تلقّت مرافقةً نفسيةً سيئة. تابعت رولا في البداية طبيبةٌ فرنسية «قح»، بحسب تعبيرها، متعصبة ضد اللاجئين، وبعيدة عن المهنية لحد الاستهزاء بلغة وإيماءات رولا أثناء الجلسات: “تكسّر بمقاديفي بالعامي»، ولهذا طلبتْ تغييرها.
المحطة التالية طالبة طب نفسي لطيفة، ولكن التواصل وتشكيل علاقة طبيبة/مريضة بقي محدوداً بحاجز السن ونقص الخبرة، وصولاً للمحطة الأخيرة مع طبيبٍ نفسي ساعدها على التعايش وقبول التجربة واستخدام قنوات تواصل بديلة عن الكلمة المنطوقة، قبل أن تتوقف هذه الخدمة مع إعادة ترتيب الأولويات بوصول مدير جديد وبالتزامن مع أزمة الكوفيد. هذا الواقع هو من تجليات الديموقراطية الصحية، وانعكاسات تهميش الصحة النفسية في معرض علاج السرطان. لا يمكن مثلاً تخفيض النفقات بالاستغناء عن العلاج الكيماوي، أما العلاج النفسي فمن الممكن حذفه دون توجيه المريضات لبدائل.
المحيط القريب الذي كوّنته رولا لنفسها عوّضها عن انقطاع المرافقة النفسية، وساهم في تخفيف وطء التجربة منذ بدايتها. صلابة ابنتها و«مفاجآتها الدائمة» عبر الفن بخيالٍ خصبٍ جداً حسب توصيات الطبيب، رغم عدم اقتناعها بالضرورة، بدا أساسياً أيضاً. وقوة والدتها التي مرت بتجربة السرطان سابقاً مدّتها بالقوة.
لعبت رعيةُ الكنيسة دوراً مركزياً في حياة رولا في فرنسا، وأحاطتها بالاهتمام والرعاية الدائمين. اللافت في هذا الدعم هو مدى تنظيمه ووعيه باحتياجاتها وحالتها النفسية في ظل المرض. داوم القس على زيارتها كصديق ورجل دين في المستشفى، وشكّلوا مجموعاتٍ صغيرة تتناوب على زيارتها في المنزل زياراتٍ قصيرة، ولو لعشر دقائق، لتلبية احتياجاتها ومساعدتها: صلاة مسبحة، الغناء، دعوتها لرحلات أو فعاليات، أو مجرد تقديم بعض الزهور. وتثمّن غالياً دعمهم الكبير عندما فقدت والدتها ولم تستطع الذهاب إلى سوريا لحضور القداس، وعدم تركهم لها إطلاقاً في تلك الفترة الصعبة. «كانوا يخبروني بكل الطرق إنه نحنا موجودين»، تختم رولا.