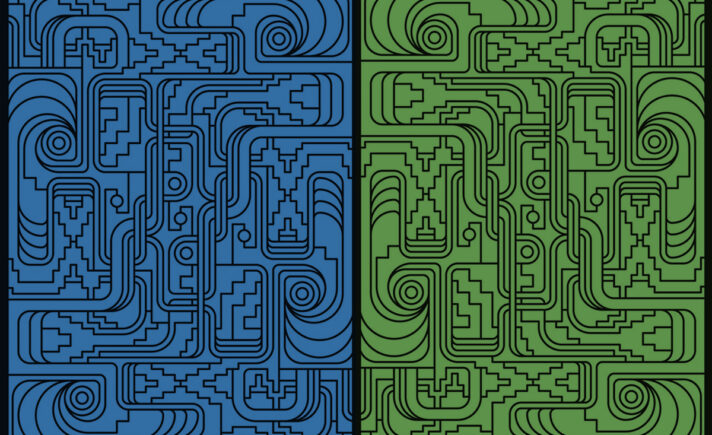«الفنّانون هم الوحيدون الذين لا يزالون يؤمنون بالعالم، إذ تعكس استمرارية العمل الفنّي طابع استمرارية العالم. وهم لا يستطيعون أن يسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا غرباء عن العالم».
حنّة آرنتHannah Arendt, Qu’est-ce que la politique?.
بطرحي الكلمات الثلاث الكبيرة التي تشكّل العنوان الفرعي لهذا المقال، أرغب في طرح مسألة العالم بوصفه إيماناً، لكنّني سأبدأ بالمقلوب، فأتحدّث عن العدمية والإنكار. وسوف أشرح قصدي حول «السذاجة» وحول سؤال عنواني الرئيسي: «ما فائدة استمرار وجود العالم؟».
كان بمقدوري البدء باقتباسٍ آخر: «لا تضيعوا دم الشهداء». سمعتُ هذه الجملة لأوّل مرّةٍ في سنة 2014، في فيلم العودة إلى حمص لطلال ديركي، وهي جملةٌ تلفّظَ بها عبد الباسط ساروت، وهو لاعب كرة قدمٍ شابٌّ أصبح ناشطاً، ثمّ مقاتلاً في مدينة حمص المقصوفة: كرّرَ هذه الجملة من بين الأنقاض وهو جريحٌ على نقّالة، وقد تمزّقت قدمه. كان ذلك في ربيع 2012. في تلك اللحظة، بكى الشابّ الذي كان يُنشِد بأعلى صوته أغاني الحرّية وإلى جانبه فدوى سليمان.فدوى سليمان ممثّلة وشاعرة ولدت في حلب سنة 1970، شاركت بنشاطٍ في المظاهرات منذ بدايات الثورة في حمص. بعد لجوئها إلى فرنسا، توفّيت في باريس بسبب إصابتها بالسرطان بتاريخ 17 آب (أغسطس) 2017.
الكتابة في الغيتو
سؤال العنوان «ما فائدة استمرار وجود العالم؟» هو جملةٌ قرأتها منذ بضع سنواتٍ في مذكّراتٍ سرّيةٍ كتبها يهوديٌّ نمساويٌّ نُقل إلى غيتو في بولونيا، اسمه أوسكار روزنفلد. وقد كتب هذه الجملة، «?Wozu noch Welt» ـ ما فائدة استمرار وجود العالَم؟ أو ما فائدة استمرار وجود عالَم؟ -،أصبح هذا السؤال عنوان مذكّرات أوسكار روزنفلد عندما نُشرت في ألمانيا، Wozu noch Welt ? Aufzeichnungen aus dem Getto Lods، تحرير هانّو لويفي Hanno Loewy، فرانكفوت، Verlag Neue Kritik، 1994. ذكرتُ هذه المذكّرات وهذا السؤال المتعلّق بـ«العالَم» بصدد الغيتوات البولونية في: (Wozu noch Welt ?’ / ‘Ce n’était pas un monde. Le ghetto comme monde et fin du monde)، الذي وردَ في كتاب (Judith Lindenberg éd., Premiers savoirs de la Shoah)، منشورات المركز الوطني للأبحاث العلمية، 2017، ص 37-76. وأعيدَ وضعُ هذه الحوليات والـ«Hurbnliteratur» في مدوّنةٍ أوسع هي مدوّنة آداب الكارثة النازية في: (La Littérature en suspens. Ecritures de la Shoah. Le témoignage et les œuvres, L’Arachnéen, 2015) ص 97-140. ذات يومٍ من تشرين الأوّل (أكتوبر) 1942، بُعيدَ ترحيل الغالبية العظمى من الأطفال والشيوخ من الغيتو، غيتو لودز، إلى معسكرات الإبادة. سبقت هذه الحملةُ كافّةَ الحملات الأخرى المتوالية، حتّى تصفية الغيتو، وهي تصفيةٌ أتت متأخّرةً جدّاً في لودز. في هذه المذكّرات، دوّنَ ذلك الرجل كلّ ما رآه حوله: التفكُّكُ المتسارعُ لمجتمعٍ بفعل الرعب، وكذلك كلّ ما كان يحاول مقاومة ذلك التفكّك، كلّ ما رآه يُقال ويُفعل مجدّداً، ممّا يستثير الاضطراب، وكان أحياناً مبتكَراً، والأشكال المبتَكرة للحياة أيضاً. كان ينوي أن يكتب «تاريخاً ثقافياً للغيتو»، على أن يكون هذا التاريخ تاريخاً لأشكال مقاومة إفناء شعب. في هذه الملاحظات التي حاول فيها منح «وجهٍ» إنسانيٍّ للبقاء على قيد الحياة، تَعودُ باستمرارٍ سلوكياتُ الأطفال وكلماتُهم.
في سنة 1942، كان «العالم» في وضعٍ بالغ السوء، إذ استشرت النازية في أوروبا كلّها وجرّت الديمقراطيات إلى حربٍ عالمية. في ذلك العالم، لم يعد لدى اليهود أيّ أمل، إذ علموا أنّ تلك الحرب لن تُبقي عليهم. لكنّ بعض الناس، مثل أوسكار روزنفلد، نظروا إلى الغيتو بوصفه هو أيضاً عالماً، جديداً وحتّى «فريداً»، يجب سرد حكايته. كانوا آنذاك لا يزالون يؤمنون بفكرة العالم، وبأنّ عيش الناس كبشرٍ لا يزال ممكناً. كثرٌ منهم، في لودز والغيتوات البولونية الأخرى، كتبوا بِسرّيةٍ ووثّقوا وأرشفوا ما يجري كلّ يومٍ في ذلك العالم، وحاول بعضهم الكتابة بلغة الشعر. ذلك التاريخ، تاريخ حربٍ أخلاقيةٍ داخل الحرب، سَرَده في غيتو وارسو مؤرّخٌ أميركيّ الأصل اسمه صموئيل كاسو في كتابٍ كبيرٍ نُشر منذ خمسة عشر عاماً، عنوانه: من سيكتب تاريخنا؟ الأرشيف السرّي لغيتو وارسوSamuel Kassow, Who Will Write Our History? Rediscovering a Hidden Archive From the Warsaw Ghetto, London, Penguin, 2009..
لئن كنتُ أتحدّثُ هنا عن هذا الكتاب، فلأنّني قرأته في 2016، وهي سنةٌ كنت أطّلع فيها يومياً على ما يحدث في سوريا، ليس عبر وسائل الإعلام فحسب، بل كذلك عبر الشبكات الاجتماعية: رأيتُ أشخاصاً من حلب يوجّهون إلى «العالم» رسائلهم عبر الفيسبوك أثناء سقوط حلب الشرقية؛ ورأيت ذات يومٍ صورة المكتبة الموجودة تحت الأرض والتي حوّلها مدنيّون شبابٌ في داريّا إلى جامعةٍ سرّية، إلى «كسرٍ للقواعد بالتعلّم» كما تقول دلفين مينوي في كتابها مهرّبو الكتب في داريّا.Delphine Minoui, Les Passeurs de livres de Daraya. Une bibliothèque secrète en Syrie, Paris, Seuil, 2017, P 82. استولت عليّ بدايةً هذه الصورة اللاواقعية، ثمّ ذلك السرد لإعادة انفتاح العالم في خضمّ السحق عبر اكتشاف الكتب وتَشَارُكها. تتمايز المقاومة الثقافية عن المقاومة السياسية، لكنّها تُرافِقها دائماً. أثناء لقاءٍ حول موضوعة «أيّ سوريا لأيّ عالم؟» انعقدَ في كانون الأوّل (ديسمبر) 2017، قال أسامة محمّد إنّ الثورة السورية هي «ثورةٌ ثقافية».أيّ سوريا لأيّ عالم؟، مركز بومبيدو، 9 كانون الأوّل/ ديسمبر 2017، مناقشةٌ في بداية حلقةٍ بحثيةٍ بعنوان: «سوريا: في البحث عن عالم»، مع جان بيير فيليو ومظفّر سلمان وناتالي بونتان وأسامة محمّد. وفي هذا الصدد، تحدّثَ ياسين الحاج صالح عن «تجربةٍ وجودية»، تجربةٍ تشبه في بعض أوجهها «تجربة الانعتاق» التي عاشها في سنوات سجنه الست عشرة في عهد حافظ الأسد، على الرغم من أنّها أزاحتها في الماضي. ومثلما دعا بوصفه شاهداً المجتمعَ المدنيَ إلى «إخراج الذاكرة من السجون»، فسُرعان ما دعا كلَّ شخصٍ للتفكير في تجربة الثورة وتوابعها في كتابةٍ «مسكونة».ياسين الحاج صالح، بالخلاص يا شباب، ترجمة ماريان بابو وناتالي بونتان بعنوان: Récits d’une Syrie oubliée. Sortir la mémoire des prisons، دار Les Prairies oubliées، 2015؛ حول بعض خصائص الكتابة السورية الجديدة، موقع الجمهورية، وقد ترجمت إليزابيت لونغنس نسخةً موجزةً لهذا المقال بعنوان: «L’écriture habitée. A propos de quelques caractéristiques de la nouvelle écriture syrienne»، ونُشرت الترجمة في العدد 99 من مجلّة: Confluences Méditerranée. Syrie : entre fragmentation et résilience، 2016-2017؛ أعيد نشرها في كتابٍ من تحرير فرانك ميرمييه Franck Mermier بعنوان: Ecrits libres de Syrie. De la révolution à la guerre، باريس Classiques Garnier، 2018، ص 13-28.
ينبغي أن يُكتَب ذات يومٍ تاريخُ مختلفِ أشكالِ المقاومة التي انتهجها المجتمع المدني، وتاريخ المجالس المحلّية في المناطق المتمرّدة، وكذلك تاريخ لجان تنسيق الثورة،انظر: ليلى الشامي وروبين ياسين قصّاب، Burning country. Syrians in Revolution and War،Plutopress ، 2016؛ (ملاحظة من المحرّر: Burning country, Au cœur de la révolution syrienne، ترجمة جماعية عن الإنكليزية، دار L’Echappée، 2019). بالعناية وجهد الفهم العميق عينهما اللذين بذلهما صموئيل كاسو وهو يكتب عن غيتو وارسو. ومثلما عرضَ كاسو بالتفصيل المعنى السياسيّ الذي منحه اليهود، من اليسار واليسار المتطرّف، المجتمعون حول إيمانويل رنغلبلوم (Emanuel Ringelblum) لجهودهم في الأرشفة في غيتو وارسو، وصولاً إلى التمرّد المسلّح، سوف يكون هذا التاريخ السوري تاريخ أملٍ وليس تاريخ انسحاقٍ فحسب. وسيُكتَب هذا التاريخ انطلاقاً من شهاداتٍ سورية، شهادات السجون وكذلك شهادات الثورة والقمع، وهي سيرٌ مسكونةٌ بفكرة «العالَم». لكنّ هذا التاريخ سيُكتَب بالطبع بطريقةٍ مغايرةٍ تماماً: ليس انطلاقاً من أرشيفٍ محفوظٍ في علبٍ دُفنت ثمّ نُبشت، بل انطلاقاً من ذاكرةٍ رقميةٍ استثنائيةٍ في وفرتها بالمواد الأوّلية والأرشيف، وهي بصريّةٌ أكثر ممّا هي مكتوبة. هذه الوفرة مُتعِبة، بل ومُرهِقة، لأنّها تُظهِر أنّ جريمةً ضدّ الإنسانية يمكن أن تُرتكَب جهاراً نهاراً، وأن تُعلَن ألف مرّةٍ ويُشار إليها وتوثّق عبر العالَم، من دون أن تستثير قرار تدخّلٍ من الأقوياء. وهذا خبرٌ سيّئ، ليس لشعبٍ فحسب، بل كذلك لهذا العالم، لنا جميعاً.
ما فائدة استمرار وجود العالم؟ / جسد الأطفال
لقد افترضت جهود التوثيق والكتابة التي بذلها اليهود البولونيون في 1942، وكذلك جهود السوريّين المقصوفين والمحاصَرين بدءاً من 2012، أنّه على الرغم من فقدان الأمل بالأمم، يستمرّ منظور وجود عالَم، كما يتواصل بقاءُ أفقٍ من المعنى. والحال أنّ من أكّدَ وهو يوثّق الحياة في الغيتو وجودَ هذا الأفق، أُصيبَ فجأةً بالعدمية عندما قال «ما فائدة استمرار وجود العالم؟»: فجأةً، لا يعود الشاهد يؤمن بشيء، ولا حتّى بالعالم. وهذا المساس الفظّ بالإيمان بالعالم يرتبط ارتباطاً مباشراً باختفاء الأطفال من الغيتو، بالحرمان الفظّ من وجودهم جميعاً، بأن يحرَم على هذا النحو من الطفولة نفسها، كما لو أنّ الطفولة ضمانٌ للعالم. غير أنّ أوسكار روزنفلد تمالكَ نفسه واستأنفَ عمله، فتابع الملاحظة والتدوين حتّى النهاية: يبدو أنّ إيمانه بالعالم نجا. لكنّ ما جرى بدا وكأنّه يخرج من الزمن التاريخي. ففي مذكّراته، يعود مرّاتٍ عدّةً إلى هذا الحدث كما يعود المرء إلى نكبةٍ كونية، ويذكره كلّ مرّةٍ كما لو أنّه حدث توّاً، كما لو أنّه يبدأ مُجدَّداً باستمرار. واقع الأمر أنّ الشهادة على تدمير الأطفال تُغرِق المرء في حاضرٍ لا يمكن أن يتحوّل إلى ماضٍ. أمّا شهادة الأطفال أنفسهم، فتبدو وكأنّها تُكتَب بصيغة الحاضر أو كأنّها تأتي من المستقبل. «نحن نأتي من المستقبل»، هذا ما يقوله فيلم تحريكٍ أخرجه جلال الماغوط وعُرض منذ يومين هنا.جلال الماغوط، «نحن نأتي من المستقبل»، 2014. «نحن نأتي من المستقبل، أفلام تحريك سورية»، عروض ـ لقاءٌ من تنظيم القسم الثقافي في جامعة باريس ـ ديدرو مع كاترين كوكيو وهالة عبد الله، 12 كانون الأوّل (ديسمبر) 2017، بحضور المخرجين جلال الماغوط وسامر عجوري وعامر البرزاوي ومحمد حجازي. تقديم هالة عبد الله.
لستُ بصدد مقارنة ما يجري في سوريا منذ 2011 بما جرى في بولونيا في 1942. فمن وجهة نظر الوقائع والتجارب معاً، تتباين الحكايتان تبايناً عميقاً. لكن هنا وهناك، يُطرح سؤال اختفاء العالم، أو خسوفه، بالصلة مع نمطٍ من التدميرية السياسية التي تجعل الطفل والطفولة هدفاً حاسماً. في الحرب على المدنيين التي يشنّها النظام السوري تحت ستار «حربٍ أهلية»، تحتلّ الضراوة ضدّ الأطفال والجسد الأنثوي والصلات العائلية مكانةً فريدة، تُقارِبُ بين عنف النظام والعنف الإبادي، أو بالأحرى النزوع إلى التدمير الإباديّ، لأنّ الإبادة لا تعود داخل نطاق العنف. إنّها في المقابل تدخل دائماً في نطاق الانتهاك والجريمة ضدّ الحميمية: يظهِر تنفيذ المجازر بالغة القسوة، المتوالية منذ سنواتٍ في سوريا، الهدفَ المحدّد لانتهاكٍ مُبرمَج، اغتصاب جسدي ونفسي على نطاقٍ واسع، منهجية إساءةٍ حميميةٍ ترتقي لتكون منظومةً وتضيفَ إلى تدمير الأجساد تخريبَ النفوس، أو ما يعنيه في النفس الأملُ في المستقبل والرغبة في الحرّية. ثمة مثالٌ يشير إلى ذلك، هو تمديدُ المتظاهرين على بطونهم والدوس على ظهورهم والصراخ: «تريدون الحرّية؟»، وهو تَصرّفٌ أصبح منهجياً بعد بدئه في نيسان (أبريل) 2011 في قرية البيضاء. إنّ إصابة الطفولة والأطفال تعني وأدَ هذه الرغبة في الحرّية والمستقبل في مهدها. والمصير الذي يتعرّضُ له الأطفال هو الصورة الأكثر فجاجةً لمقدار عنف هذا النظام: عنفٌ خارج القانون، يمارَس لذاته، لا دافع له، نزوعٌ إلى التدمير في الحالة الخام، يَترافَق بفظائع لا متناهية. أُفكّرُ في حمزة وتامر، وهما صبيّان شاركا في احتجاجات درعا، تعرّضا للتعذيب وسُلّمت جثّتاهما مشوهّتين إلى الأهل في أيّار (مايو) 2011.في أيّار (مايو) 2011، عُذّب حمزة علي الخطيب وتامر الشرعي وقُتلا ثمّ سُلّما إلى أهلهما بعد تعذيبهما. وأطلقت على يوم الجمعة 3 حزيران (يونيو) 2011 تسمية جمعة «أطفال الحرّية». وأفكّر بالبنات اللواتي اغتُصبنَ وعُذّبنَ في أقبية أجهزة الأمن، وتتحدّث عنهنّ النساء اللواتي يقدّمن شهاداتهنّ في الفيلم الوثائقي الذي صنعته أنيك غروجان (Annick Grojean) ومانون لوازو (Manon Loizeau) وسعاد وحيدي بعنوان: سوريا، الصرخة المكتومة (2017).
كذلك، تشهد سرديّاتٌ عديدةٌ على مفاعيل هذا العنف المُمَارس على الأطفال لدى الأهالي والبالغين، مثل سرديّات جمانة المعروف وسمر يزبك ومجد الديك. لن أذكر هنا إلّا بضع مقاطع من كتاب مجد الديك الذي يشهد على ما حدث في الغوطة الشرقية وصدر بعنوان: شرق دمشق، على حافّة العالم. شهادة ثائر سوري.Majd al Dik avec Nathalie Bontemps, A l’est de Damas, au bout du monde. Témoignage d’un révolutionnaire syrien, 2016. (ذكرتُ هذا الكتاب، وكذلك كتاب الثورة المستحيلة لياسين الحاج صالح وكتاب (De l’ardeur) لجوستين أوجييه المكرّس للمحامية رزان زيتونة، في نشرة: La Syrie existe.) في البداية يقول بخصوص إحدى المجازر: «عندما رأيت العائلات تتلقّى أطفالها وقد غطى أجسادهم الدم وآثار البساطير، فكّرت في أنّ الأموات وحدهم ينجون من مجزرة» (ص. 70). ولاحقاً، بصدد الهجوم الكيميائي في آب (أغسطس) 2013: «اقتربتُ من أجساد الأطفال. طلبتُ منهم أن يسامحونا لأنّنا لم نمت ولأنّنا نصوّرهم وهم في هذه الحالة. سالت دموعي الأولى عندما رأيت رجلاً يتعرّف على ابنته. صوّرته وهو يحملها بين ذراعيه. ولُمتُ نفسي على ذلك. تمنّيتُ الموت» (ص. 132). النجاة من مثل هذه الجريمة والاضطرار لتقديم شهادةٍ عنها موتٌ بطريقةٍ مختلفة، أو تَمَنٍّ للموت، لأنّ «الأموات وحدهم ينجون من مجزرة».
ما يُستهدف ويصاب هو أمرٌ آخر غير الجسد. فبإطلاق الرغبة في الموت، يُصيب قتلُ الأطفال قدرةَ البالغين على الأمل. تماماً مثلما أنّ الاغتصاب، وهو يلطّخ أجساد النساء ويعذّبها، يبتغي أيضاً تحطيم الرجال: لا يتعلّق الأمر فحسب بالحُكم عبر الترويع، بل يتعلّق أيضاً بتمزيق عائلاتٍ بأكملها ومنع أيّ تطلّعٍ للمستقبل. عبر إفساد الروابط المقدّسة، يصبح التألّم مادّةً أوّليةً وأداةً تفيد في الاجتثاث. تظهر «العدمية السياسية» لدى النظام بأوضح أشكالها في هذه الإرادة غير المحدودة في ممارسة القسوة والنزوع إلى التدمير، وفي عدم المحدودية المجنونة هذه.عُبّر عن هذه العدمية في عهد حافظ الأسد. ففي الرواية ـ الشهادة التي كتبها مصطفى خليفة بعنوان القوقعة، وأثناء وجود المعتقل في أحد أجنحة سجن تدمر، يستيقظ في غابةٍ من الأقدام والسيقان، يرفع رأسه فيرى طفلين ينامان على مواسير عريضة فوق كومةٍ من الأجساد المتكدّسة. يقول أحدهما: «لم أنم يوماً بهذا العمق» (وهي صيغةٌ تذكّر بالأغنية الفرنسية المرعبة للقدّيس نيكولا: «اعتقدتُ أنّني في الجنّة»). لا يتحدّث الراوي ـ الشاهد في القوقعة بعد ذلك أبداً عن الأطفال: أين ذهبوا؟ هذه العدمية هي التوقيع على الحرب التعصّبية التي يشنّها هذا النظام، جهاده الخاصّ، عدميةٌ صارمةٌ وغير تبشيريةٍ مثل عدمية تنظيم داعش ـ وهذا لم يمنع هذا وذاك من أن يكونا حليفين موضوعيين، ومن أن يختطفا الشعب السوري رهينةً لديهما، وهو شعبٌ أصبح أسير عدميّة كلٍّ منهما التي تعكس عدميّة الطرف الآخر، مثلما أظهر ذلك ياسين الحاج صالح في كتابه: الثورة المستحيلة.تُرجم إلى الفرنسية بعنوان: La Question syrienne، مجموعة نصوصٍ ترجمتها ناديا ليلى عيساوي وزياد ماجد وفاروق مردم بك، منشورات آكت سود، 2016. (The Impossible Revolution: Making Sense of the Syrian Tragedy، تقديم روبين ياسين قصّاب، 2018). وقد حوّل هذا الالتقاء سوريا إلى فخٍّ لشعبٍ بأكمله، فحوّل هذا البلد إلى مكانٍ للارتياع.
العدمية و«نبع الحياة»
لئن كان مجد الديك يُكثِر من ذكر الأطفال، فلأنّه تولّد لديه ـ ولا يزال ـ اهتمامٌ خاصٌّ بهم وبالهشاشة التي تُميّزهم. أسّس في الغوطة جمعيةً لدعم الأطفال نفسياً اسمها «نبع الحياة»، وفي الوقت عينه ساعد المحامية الناشطة رزان زيتونة في عملها في توثيق الجرائم، واستقى من هذا النشاط الصور التي يوردها هنا. هذا الموقف في منتصف الطريق بين الالتزام الإنساني والتربوي والالتزام السياسي يمنح أهميةً لهذا الكتاب اللاذع، وهو كتابٌ ثمينٌ بأكثر من وجه. فهو يجعلنا نلتقط الجانب الحاسم في رغبة الانعتاق الشخصي في حركة آذار (مارس) 2011، فيذكر النشوة التي تستثيرها أولى الشعارات التي نسمع الهتاف بها؛ ثمّ يظهِر كيف تغطّي ضرورة البقاء البيولوجي بسرعةٍ كبيرةٍ على الهدف الأوّلي بسبب القمع، حيث يتواجه المَثَل الأعلى الثوري والتربوي في آنٍ معاً كمشروع حياةٍ مع انفلاتٍ مميت، يرغم الناشطين على أن يصبحوا مسجِّلين للجريمة وعلى أن يستخلصوا الأدلّة على تدميرٍ يجب عليهم الهرب منه والبقاء على قيد الحياة، في حين أنّ الهدف كان الحياة بطريقةٍ مختلفة.
يعيش الشابّ هذا التطوّر كمُفاجأةٍ مستمرّة. يكتب عندما يطلق الجيش النار على الجماهير لأوّل مرّة: «لم نكن نريد تصديق أنّ الجيش يقتلنا» (ص. 77)، ثمّ يثير كلّ سلاحٍ جديدٍ يستخدمه النظام بلبلةً تزعزع القدرة على الصمود التي سادت حتّى ذلك الحين: في نهاية الفصل المخصّص للهجوم بالأسلحة الكيميائية، يخبره صديقٌ عضوٌ في تنسيقية زملكا بأنّ أصدقاءهما في المكتب الإعلامي قد ماتوا جميعاً باستثنائه.
«كان مصدوماً، ولم أكن أستطيع أن أجد أيّ تفسيرٍ لهذه الجبال من الجثث، لجريمةٍ كهذه. (…) لم يستطع أحدٌ النوم. أمضينا الليلة في تجميع الصور وإرسالها إلى وكالات الإعلام. اضطررتُ لمشاهدة مقاطع الفيديو التي صوّرتُها ولإعادة كتابة محتواها على الحواسيب. أخذَت مشاهد ذلك اليوم تتكرّر بلا نهاية. لم أكن أرى إلّا الجثث ولا أسمع إلّا صرخات المحتضرين في المستوصف. (…) وجب عليّ أن أعمل وأدفن قلبي. لم يكن لدينا الوقت للبكاء ولا إمكانية الهرب من مقاطع الفيديو والصور، إذ لابدّ من عدّها وتسجيلها. (…) بعد عدّة ليالٍ خلت من النوم، باتت الكوابيس تأتيني وأنا مستيقظٌ تماماً». (ص. 236).
يقابل الجنونَ التدميري الذي ينساق إليه النظام أرقُ الشاهد: نضال الناجي ضدّ جنونه الخاصّ، فهو مُرغَمٌ على حمل شحنة واقعٍ أصبح هلوسةً. يذكر مجد الديك مشروع «تقرير طبّي عن المنطقة»، فيكتب بصدد الأطباء الذين واجههم آنذاك متوسّطٌ قدره 250 جريحاً في اليوم:
«كانوا الأشخاصَ المعرّضين لأسوأ الشروط النفسية. ومثلما أَسرّوا لي في المقابلات، لم يعودوا قادرين على العيش بين البشر. إذ كانوا يعيشون في الدم ويرون الأجساد من الداخل والأحشاء التي تخرج من البطون والأدمغة التي تنبثق من الجماجم. انتهت حياتهم الزوجية. خسروا المشاعر التي تنتاب الآخرين، واحتاروا في ما إذا كانوا يحبّون أشباههم أم يكرهونهم». (ص. 260).
«لم أكن أستطيع أن أجد أيّ تفسيرٍ لجريمةٍ كهذه». الجريمة التي لا تفسير لها هي جريمةٌ لا سبب لها: لها منطق، لكن ليس لها أيّ معنى.حول مفهوم الجريمة التي لا سبب لها، أحيلُ إلى فيليب بوشرو Philippe Bouchereau في كتابه: La Grande Coupure. Essai de philosophie testimoniale، باريس، دار غارنييه للنشر، مجموعة «أدبيات التاريخ السياسي»، 2017، وهو أحد أهمّ الكتب اليوم في مجال التفكير في جريمة الإبادة ومظاهر إضفاء صفة الغريب التي يستثيرها إلغاء الانتماء في الوقائع وفي الكلام الذي يريد توصيفها. وهي لا تنتمي إلى العالم البشري. لا يعود المجرم يهاجم حاملي قضيّة، بل هو يتكلّم لغة الفظاظة المحضة ليقول أمراً واحداً: لن أتنازل أبداً ولن أقاسم أحداً السلطة، حتّى لو أدّى ذلك إلى حرق البلد وإبادة جميع أولئك المصمّمين على أن يريدوا عكس ذلك. وواقع أنّ بشّار لا يستطيع عقلانياً أن يريد تدمير السكّان السنّة لأنّهم يمثّلون 70 بالمئة من السكّانفي 2012، كانت النسبة 72.8 بالمئة. ليس حجّةً تناقض فكرة وجود سياسة إبادة، لأنّ كلّ عقلانيةٍ سياسيةٍ تراجعت منذ وقتٍ طويلٍ أمام الهدف الحصري، هدف الحفاظ على السلطة، وهو هدفٌ غير قابلٍ لأيّ تفاوض. في الحقيقة، لم توجد مثل هذه العقلانية أبداً. يتردّد اليوم صدىً مؤلمٌ لما كتبه ميشيل سورا بصدد حافظ الأسد: «أمّا حافظ الأسد، فهو لا يهتمّ على الإطلاق بتأسيس نظام (وهذا هو السبب في صعوبة اجتثاثه على يد معارضيه)».ميشيل سورا، (Syrie. L’Etat de barbarie)، باريس، المنشورات الجامعية الفرنسية، 2012، تقديم جيل كيبيل Gilles Kepel، ص 18.
ما العمل أمام مثل هذا العنف السياسي، أمام لاعقلانيةٍ تتكشّف أيضاً عن كونها تُدمِّر نفسها بنفسها؟ فقد خرّب النظام قواعده عندما أرسل العلويّين بأعدادٍ كبيرةٍ ليحاربوا وأخضعهم للابتزاز، وهو شكلٌ منحرفٌ للاضطهاد، في حين أنّ هروبه إلى الأمام جعله تابعاً للقوى الحليفة وللميليشيات الأجنبية. مثل هذا المنطق المجنون غير قابلٍ للنقاش السياسي، وبشّار معروفٌ بأنّه لا يقوم أبداً بأيّ تفاوضٍ دبلوماسيٍّ حقيقي. وحدها القوّة العسكرية يمكن أن توقف عنفاً بهذه الطبيعة، شرط أن تضمن هذه القوّة انتصارها. والحال أنّ القوّة التي تضمن انتصارها لا يمكن أن تكون إلّا دولية.
كثيراً ما أسمع أنّ عسكرة التمرّد كانت خطأً، لأنّه لم يكن بوسع النظام سوى الردّ بأسوأ ضروب العنف من دون أيّ شعورٍ بالذنب ـ ويكون الردّ دائماً بأنّ التسلّح كان مسألة بقاءٍ على قيد الحياة، مسألة دفاعٍ مشروعٍ عن النفس. كما أسمع أنّ الثورة السورية نفسها كانت «ساذجة»، لا بل غير مسؤولة. أطرح على نفسي أسئلةً كثيرةً حول ما يعنيه أولئك الذين يتحدّثون عن هذه السذاجة. ما الذي تقوله هذه الكلمة وهذا الادّعاء عن إيماننا المَرَضي بالعالم؟ أليس وصف هذه الثورة بالسذاجة إظهاراً لعدميّتنا نحن؟ لكن من «نحن»؟ نعلم أنّه من الناحية الجُرمية، تمّ تجاوز كافّة «الخطوط الحمر» بوضوحٍ وتواترٍ بلغ منهما أنّ فكرة الخطّ هذه أصبحت تعادل نكتةً عالمية، كما لو أنّ المجتمع الدولي، بموافقته هذه على القتل، قد رفع بدوره راية العدمية. فلا الأطفال الذين تعرّضوا للتعذيب منذ 2011 ولا الهجمات الكيميائية المتكرّرة ولا قصف المستشفيات ودور التوليد ولا حالات الاغتصاب والاختفاء بالجملة كانت كافيةً كي يتمكّن هذا «المجتمع الدولي»، أو يريد، إعلان الحرب على هذا النظام ـ وهي إحدى تلك الحروب العسكرية التي تستطيع وحدها منع جرائم القتل الجماعية التي تحدث، مثلما يعلم بذلك الأوروبيون من مصادر موثوقة، ومثلما رأينا في سريبرنيتسا وكيغالي وغروزني.
في غياب التدخّل الدولي، تحوّل الزخم الثوري إلى تطرّفٍ حربي، ردّ عليه النظام بحربٍ شعواء شاملة. ما يفاجئ في هذه الثورة هو استمراريتها غير المسبوقة على الرغم من القمع غير المسبوق. يكتب مجد الديك بصدد دوما في 2011، غداة حدوث مجزرة: «فهمتُ أنّ المدينة لن تتراجع». وكلّ قصةٍ تحكي عن هذا التراجع المستحيل.
ثمة ما يؤلم ويبعث على الاضطراب في هذه الطريقة في الذهاب إلى الموت لإبراز قيم حياةٍ جماعيةٍ مهما كلّفَ الأمر. وتجعلنا هذه الشجاعة منقطعة النظير ندرك ما عاشه الناس حتّى ذلك الحين؛ لكنّ الزخم الثوري اتّخذ بذلك مظهر تضحيةٍ دلالتُها الأخلاقية بالغة القوّة، لكنّ قيمتها السياسية معدومة. إذ على الرغم من أنّ كلمة «شهيد» للإشارة إلى المقاتل المقتول، وهي كلمةٌ يستخدمها الجهاديون والثوريّون في آنٍ معاً، تشير إلى استمراريةٍ بين الديني والسياسي، فمعناها متباينٌ بين الطرفين. من أين يأتي هذا التباين؟ من أجل ماذا يموت أولئك الذين يعودون للتظاهر؟ يقول مجد الديك: «كنّا نذهب لنُقتَل. نصل الخميس ونتظاهر الجمعة، ويوم السبت ندفن الشهداء. تحوّلَ الأمر إلى روتينٍ حقيقي. اعتادت المدينة على الموت بهذا الإيقاع. في كلّ يوم جمعة، ينتشر القنّاصة على الأبنية المرتفعة ويحاصر الجيش المدينة». (ص. 83).
إنسان كفرنبل المُستباح
تحوّلت هذه الآلية الرهيبة إلى تمرينٍ كوميديٍّ في فيلمٍ قصيرٍ أنتجه مركز الإعلام في مدينة كفرنبل المتمرّدة بعنوان: الثورة السورية في ثلاث دقائق،The Syrian revolution in 3 minutes، المركز الإعلامي في كفرنبل، 2014. حيث ينتفض رجالٌ من حقبة ما قبل التاريخ ويتكرّر موتهم على يد رجالٍ آخرين، ثمّ ينهضون مجدّداً من دون توقّف، ثمّ يُقتَلون من دون توقّف. هذه الفكاهة هي الأكثر فظاعةً. كما لو أنّ «الإنسان المُستباح/ homo sacer»، الإنسان القابل للقتل وغير القابل لتقديمه أضحيةً في الاحتفالات الدينية، والذي تحدّث عنه جيورجيو آغامبن، يجعل من نفسه مادّةً فكاهيةً ـ وهو أمرٌ غير مبرمجٍ في برنامج الأركيولوجيا السياسية؛ كما لو أنّ «حياتُه العارية» قد أصبحت هي نفسها لغةً سياسية، كما لو أنّ قبوله بالتضحية سلوكٌ يعلن عن كونه لا يزال سياسياً، أو السلوك الوحيد اللائق ردّاً على العنف المطلق الذي يمارسه النظام، بحيث تتحوّل المقاومة إلى تراجيديا مطلقة هي أيضاً.
أرى الثورة السورية بوصفها نوعاً من التكرار الجماعي للبادرة التي يحكي عنها مصطفى خليفة في القوقعة، عندما يقرّر البطل، الذي تحيط به كراهية الموقوفين الإسلاميين في سجن تدمر ويهدّده بالموت أكثرُهم تطرّفاً، أن ينهي صمته أخيراً ويضطلع بإلحاده: «تريد أن تقتلني؟ تفضّل هذا أنا، عارياً أمامك. (…) أنت لست ربّي لأقدّم لك كشف حساب».مصطفى خليفة، القوقعة (الترجمة إلى الفرنسية: La Coquille. Prisonnier politique en Syrie، ترجمة ستيفاني دوجول Stéphanie Dujols)، بابل، 2007. وعندما يصيح عبد الباسط، مقاتل حمص، باكياً: «لا تضيعوا دم الشهداء»، فيمكن أن يعتقد المرء أنّ بكاءه ناجمٌ عن معرفته بأنّه يخون المطلق، بسبب إنهاكه.
تفضّل هذا أنا، عارياً أمامك. هذا الكلام البطولي ليس عدمياً، بل هو مفعمٌ بالمعنى، وهو بهذا يتوجّه أيضاً إلى العالم. في نهاية فيلم المركز الإعلامي في كفرنبل المشار إليه أعلاه، نقرأ الرسالة التالية:
Death is death. Regardless of the way it was done, Assad killed 150.000. Stop him
لكن إلى أيّ جمهورٍ يتوجّه أولئك الناشطون ـ الفنّانون من كفرنبل؟ ما هو العالم المقصود؟ وهل نستطيع التحدّث إلى عالمٍ لا يقدّم إجابات؟ يحكي مجد الديك عن المؤتمر الصحفي الذي عقده ناجو اللجنة المحلّية في زملكا، وهم أنفسهم أصيبوا، في بثٍّ مباشرٍ مع وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك بفضل اتّصال إنترنت أمّنته لجان التنسيق: «لقد واصل الجميع العمل، ليس لأنّهم كانوا لا يزالون يتمتّعون بالطاقة اللازمة، بل لأنّ التوقّف يعني الانهيار وانتظار الموت. وهذا كلّه في خضمّ التخوّف من هجومٍ كيميائيٍ ثانٍ، نظراً لأنّ الهجمة الأولى لم تستثر أيّ ردّ فعلٍ دولي» (ص. 240). وبخصوص ردّ الفعل الدولي هذا، يستخلص الاستنتاج الذي فرض نفسه على الجميع ولا يزال يفرض نفسه: «أثناء الهجوم الكيميائي في 21 آب (أغسطس) 2013، قدّمت القوى العظمى للنظام رخصةً بالقتل». (ص. 295).
في تشرين الأوّل (أكتوبر) 2016، ولدى استماعي للخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية الوطنية بريتا حاجي حسن، رئيس مجلس مدينة حلب الشرقية أو «رئيس بلدية مدينة حلب الشرقية»، وإلى كلماته في باريس وفي الراديو، تساءلت عمّن يمكن ألّا يشعر بالاضطراب أمام نداءٍ كهذا، أيّ شخصٍ، وكذلك أيّ فرنسي.في هذا الرابط نص مداخلة السيد بريتا حاجي حسن وزملاؤه، وفي هذا الرابط تسجيل صوتي لها. لا أزال أشعر بالعار عندما أتذكّر كلماتٍ معيّنةً قالها ـ ليس عن عدد الأطباء الذي بلغ 21 طبيباً مقابل 300 ألف نسمة، ولا عن استهلاك 90 بالمئة من المخزونات، بل عندما استدعى ذاكرة الثورة الفرنسية. وسألتُ نفسي عن العالم الذي سيستطيع الردّ عليه، لأنّ التعاطف ليس ردّاً، والتضامن نفسه أظهر عجزه سياسياً. في شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) عينه، نشر تجمّع أبو نضّارة مقالةً بعنوان «من المُستحَبّ التعاطف مع السوريين».تجمّع أبو نضّارة للسينمائيين السوريّين: (Syrie. L’honnête homme et les communautés fratricides», Libération، 4) تشرين الأول (أكتوبر) 2016. سأقول إنّه من المستحبّ أيضاً عدم التعاطف مطلقاً. لكنّ صيغة «مُستحَبّ» تقول الحقيقة. إذ لا يضمن التعاطف أيّ فعلٍ سياسي، مثلما عرضت ذلك حنّة آرنت في نصّها: بشرٌ في أزمنةٍ حالكة، حيث تقول أيضاً إنّ التضامن بين المقموعين لا يبقى عموماً بعد التحرير، وليست له بالتالي أيّ «راهنيةٍ سياسية».Hannah Arendt, De l’humanité dans de sombres temps. Réflexions sur Lessing
ما العمل إذاً؟ توثيق الجرائم بهدف كتابة قصّتها، وكذلك لإتاحة الحكم عليها. لن أدخل هنا في النقاش الدائر حول توصيف الجريمة.الجلسة الثالثة من ندوة «سوريا: في البحث عن عالم»، 14/12/2017: «التدمير والمحو والنفي»، حيث تحدّث كلٌّ من ياسين الحاج صالح وجان إيف بوتيل Jean-Yves Potel وجويل هوبريشت Joël Hubrecht وفيرونيك ناحوم غراب Véronique Nahoum-Grappe وفريديريك دوتو Frédéric Detue. ترأّس الجلسة ريشار ريشتمان Richard Rechtman. فهو يطرح مشكلاتٍ دقيقة، يجب معالجتها بموجب العقلانية التي أملت اتفاقية 1948 حول منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي عقلانيةٌ قضائيةٌ سياسية وليست تأريخيةً أو فلسفية. فالحرب الشاملة التي يشنّها بشّار وحلفاؤه على من يعدّهم معارضته، والتي تجعله يستهدف كلّ ما يسعى إلى حماية الحياة العارية، تخضع لمنطق الإفناء، وتطلَق على هذا المنطق تسمية «التطهير»، مع استهدافٍ مناطقي وسوسيولوجيٍّ لعمليات القصف والتجويع واستخدام الغازات السامّة. عندما ستُحاكَم هذه الجرائم، لا شكّ في أنّه سيكون صعباً إثبات طابعها الإبادي قانونياً. فهنا نجد انتماءاتٍ عشائريةً ومناطقيةً وثقافيةً لا تغطّي المعايير الأربعة التي تحكم الإبادة الجماعية، أي الأمّة والعرق والإثنية والدين. لكن على الرغم من ذلك، فإنّ استبعاد مسألة الإبادة الجماعية على نحوٍ مسبقٍ يعادل الانسياق لشكلٍ من أشكال النفي المبدئي، وهو نفيٌ لا يمكن تأويله إلّا بوصفه نفياً للإنسانية. لا ينبع نفي الجريمة ونفي الإنسانية من المصادر عينها، لكنّ هذه المصادر تتلاقى وتؤدّي إلى الإفلات من المحاسبة، وبالتالي إلى استمرارية الجريمة وإلى شعورٍ هائلٍ بالظلم الذي تُعرِّض له الضحايا.
يحمل نفي حدوث الجريمة في داخله إنكارها، ويصبح الإنكار في الأوساط السياسية المتورّطة نزعةً إنكاريّة، وهي عقيدةٌ هذيانيةٌ يتناسب عنفها مع ضخامة الجرائم. بكلّ عقلانية، ليس هنالك مجالٌ لأن يفاجأ المرء بانطلاق الآليّة الإنكارية فور طرح جرائم الأسد، ولا باختلاط خطاباتٍ من اليمين واليسار، من اليسار المتطرّف واليمين المتطرّف في هذه الآليّة: فلنتذكّر بول راسينييه (Paul Rassinier) وبيير غييوم (Pierre Guillaume) اللذين تلاقيا مع مماحكات روبير فوريسون (Robert Faurisson) بصدد غرف الغاز.حول هذه الأسماء والظواهر، أحيل القارئ إلى أعمال نادين فريسكو Nadine Fresco وفلوران برايار Florent Brayard وفاليري إيغونيه Valérie Igounet. تستدعي التركيبة الحالية البرنامجَ القديم المناهض للإمبريالية بطريقةٍ تخالف التوقّع، ويزداد تأثيرها مع القوّة الضاربة التي تتمتّع بها البروباغندا الروسية، كما تقسم اليسار واليسار المتطرّف الفرنسي بطريقةٍ سبق تفكيكها مرّاتٍ عدّة.Julien Salingue, Sarah Kilani, Antoine Hasday. لكنّ تفكيك الخطاب الإنكاريّ لا يُدمّره، لأنّ قوّته تنبع من منطقٍ آخر غير المنطق الذي يستخدمه. كما أنّ التحليل لا يُقلِّلُ من العنف الذي يحمله الإنكار، فالإنكار هو دائماً سعيٌ لدفع الآخر إلى الجنون: يُشرَح للناجي أنّه لم تحدث أيّ جريمة، أنّ عائلته لم تُبَد، أو أنّها أُبيدت، لكنّ هذه الجريمة التي لم يرتكبها مجرم ليست من اختصاص أيّ عدالة.
لم يكن هذا الخطاب حول الجريمة التي لم يرتكبها مجرمٌ خطابَ بوتين وحده، بل كذلك خطاب الأمم المتّحدة. فقد أصبح برنامجاً شاملاً بعد أن عيّنت الأمم المتّحدة كوفي عنان في شباط (فبراير) 2012 موفَداً رسمياً لها المتحدة ولجامعة الدول العربية إلى سوريا. يكتب جان بيير فيليو: «كان بإمكاننا أن نأمل من الأمين العام السابق للمنظّمة والحائز على جائزة نوبل للسلام في 2001 أن يتمتّع بقدرٍ من المخيّلة، في حال افتقر إلى الشجاعة».Jean-Pierre Filiu, Le Miroir de Damas, P 256. لكن لماذا يجب علينا توقّع أمورٍ كهذه ممّن كان نائب الأمين العام في عهد بطرس بطرس غالي عندما حدثت الإبادة الجماعية في رواندا؟أفضل ما فعله عنان هو الاستقالة بعد بضعة أشهر، بعد أن هزئ به الأسد عبر «الاتفاق على نهج» إيقاف أعمال العنف. الحقيقة التعيسة للمجلس الذي أرى أنّ تسميته بالغة السوء، وأقصد مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، تلك المؤسسة التي صدرت عنها اتّفاقية 1948 حول الإبادة الجماعية، أفاد بها بانكي مون أثناء تحدّثه في جلسة افتتاح المجلس في أيلول (سبتمبر) 2016 عن «مأساةٍ تُكلّلنا بالعار، فشلٍ جماعيٍّ يجب أن يجعل جميع أعضاء المجلس مسكونين بها».أورده جان بيير فيليو، مصدر سبق ذكره، ص 262. لكنّ العار ليس أكثر فعاليةً من التعاطف. فالمأساة تسكننا والجريمة تتواصل.
النزعة الإنكارية والاستشراق
في مجال الإنكار، يجب توقّع المتواليات الأزلية عينها: خفض عدد الموتى التقديري وحرب الإحصائيات؛ المماحكات حول الكلمات والفصل بين الوقائع ومعانيها؛ تضخيم تناقضات الشهادات، المرفوضة كأدلّة؛ إنكار و/أو تبرير المجازر بذريعة الحرب أو الدفاع المشروع عن النفس الذي تمارسه دولةٌ مُهدَّدة؛ جعل الوقائع نسبيةً، لا بل قلبُ الجريمة؛ الاعتراف بالمجازر وإنكار تَقصُّد الإبادة؛ طلب الأدلّة والوثائق، وفي الوقت عينه إخفاؤها أو استبعادها؛ رفض تصديق الطرح الذي يقدّمه الضحايا ووصفه بأنّه كاذب، ووصف الضحايا بأنّهم يؤيّدون مصالح عليا أو قوى خارجية بعينها؛ وبالتالي تجريم الضحيّة وشيطنتها.أُحيلُ إلى ما كتبتُه في مقالة: (A propos d’un nihilisme contemporain : déni, négation, témoignage) التي وردت في كتابٍ من تحريري بعنوان: (L’Histoire trouée. Négation et témoignage)، دار L’Atalante، ص 22-98.
أمّا نفي السمة الإنسانية، وهو نفيٌّ يحيل بعض الحيوات إلى انعدام القيمة أو الغياب، فهو يقول هنا إنّ السوريين لا ينتمون في نهاية المطاف إلى العالم، أو أنّ العالم يستطيع الاستغناء عنهم. وهذا يعني تكرار ما يقوله النظام. إنّ عدم الانتماء إلى العالم والذي أصبح اليوم لا كونياً، إذا ما أردنا استخدام عبارات آرنت، ناجمٌ عن عقودٍ من سياسةٍ انغلاقيةٍ وهذيانية وعن «الجدار» الذي شيّدته سياسة آل الأسد حول السوريين، فأرغمهم على الانزواء داخل «قوقعتهم»، في استعارةٍ لصورة مصطفى خليفة. لكن من المحتمل أن يخصّ نفي السمة الإنسانية بصورةٍ أعمّ العربَ أو المسلمين، أو لنقُل بالأحرى شعوب الشرق الأوسط، أولئك الذين يعيشون في زاويةٍ ميّتةٍ من الوعي الغربي، مثلما يظهِر ذلك أيضاً غيابُهم في «إعمال الذاكرة» على الطريقة الغربية. يمسّ عدم انتماء السوريين إلى العالم العلاقة بين الغرب و«شرقه الأوسط القريب جدّاً» (ج. ب. فيليو)، وهي علاقةٌ تدوم فيها بعض أشكال الاستشراق.
نتذكّر أنّ إدوار سعيد رأى في الاستشراق «سلوكاً مناقضاً بعمقٍ للتجريبية»،إدوارد سعيد، L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident، باريس، دار Seuil، ص 87. «شكلاً من الهذيان»، يؤدّي إلى «معرفةٍ لا تنتمي إلى طبيعة المعرفة التاريخية الاعتيادية»(ص. 90): «تصبح الحقيقة تابعةً لحكم العالِم، وليس للمادّة الأوّلية نفسها التي تبدو مع الزمن وكأنّها تدين بوجودها نفسه للمستشرق» (ص. 84). وكتب في الفصل عن «المرحلة الحديثة» من الاستشراق أنّ فشله هو في الآن عينه ثقافيٌّ وإنساني. فهو يتمثّل في أنّه لم يعرف كيف يتعرّف في هذا «الآخر» على «تجربةٍ إنسانيةٍ» بوصفها كذلك (ص. 353).
لقد ميّز سعيد بين «استشراقيةٍ ظاهرة»، كثيراً ما تغيّر محتواها، و«استشراقيةٍ كامنة»، تُديم ثوابت و«محتوىً أساسياً» (ص. 236). ومثلما أشمّ رائحة العدمية عندما أسمع حديثاً عن «السذاجة» بصدد الثورة السورية، وكذلك عندما نسمع الحديث عن «الفوضى السورية»، يجب أن نضع أنفسنا في وضع الاستماع المتبدّل وأن نسمعه بوصفه من بقايا الخطاب الاستشراقي، حتّى إذا تعلّقَ الأمر خاصّةً بأن نسرع، فنُظهِرَ بذلك ابتعادنا أو جهلنا. والابتعاد والجهل متلازمان. كذلك توجد صلةٌ بين واقع أنّ تأريخيّات الشرق الأوسط محصورةٌ بالمتخصّصين في العلوم السياسية وبين الجهل بها، وهو جهلٌ يشيع بين الجمهور إلى حدٍّ كبير.وأنا جزءٌ من هذا الجهل بطبيعة الحال. فما الذي كنت أعرفه عن «الفيدرالية السورية» التي اخترعتها فرنسا في 1922 لترسيخ سلطتها، وعن فكرتها عن «دولةٍ علوية» إلى جانب «دولةٍ سورية»، تجمع دمشق وحلب؟ ما الذي كنت أعرفه عن دمشق التي قصفها في 1925 الجنرال الفرنسي موريس ساراي، وعن جوزيف كيسيل Joseph Kessel الذي صوّر البيوت السوريّة الصغيرة، وعن الرماة السنغاليين الذين أتوا للمساندة من أجل جعل السوريين يؤدّون التحيّة للعلم الفرنسي في 29 أيار (مايو) 1945؟ لم أكن أعرف شيئاً تقريباً، وقد عرفته ككثيرين غيري وأنا أقرأ كتاب جان بيير فيليو، Le Miroir de Damas (ص 209-211 و228)، وغيره من الكتب.
سأضيف كملحقٍ لرأي إدوار سعيد ما قاله جلال توفيق في كتابه تراجع التقاليد في مواجهة الكارثة غير المتناسبة: لا يكفي استنكار ضروب التنميط الاستشراقية، وحتّى هذا الاستنكار يسهم في استمراريتها، لأنّ اللاوعي يتجاهل الإنكار.جلال توفيق، Le Retrait de la tradition face au désastre démesuré، ترجمة عمر برادة Omar Berrada ونينون فنسونو Ninon Vinsonneau، دار Les Prairies ordinaires، 2011.
للأسباب عينها، بجب الكفّ عن استخدام مصطلح «المستبِدّ» في الحديث عن بشّار، لأنّ هذه الكلمة التي يفوح منها هي أيضاً استشراق المصطلح ـ مثلها إلى حدٍّ ما مثلُ مصطلح «القسوة الآسيوية» ـ تبدو لي مُخفَّفة، وحتّى غير سليمة. يجب تناول مفهوم الشمولي للحديث عن نظام بشّار الأسد، وكذلك عن نظام حافظ. لقد كان ميشيل سورا نفسه يتأرجح وهو يتحدّث عن «دولة البربرية»: العناصر «البدائية» التي تُطبِّع مع العنف (روح الجسد، القبيلة، المذهب) هي التي تسحب النظام في رأيه نحو الاستبداد. فإشارة حافظ للاشتراكية وتحالفه مع الاتحاد السوفياتي كانا بالنسبة إليه مسألة أسلوب، كما أنّه ذكر حنّة آرنت وكلود لوفور (Claude Lefort) بصدد التمييز بين السلطة الاستبدادية والهيمنة الشمولية. والحال أنّه يبدو لي أنّ نظام حافظ اندرجَ تماماً بدءاً من أواخر1979 ومطلع 1980 ـ المؤتمر القطري السابع لحزب البعث ـ في أنظمة السيطرة الشمولية. فقد أُضيفت إلى الانقلاب الذي سمح له بالاستيلاء على السلطة والمؤسسات في 1970 سيطرةٌ كاملةٌ على الأهالي: تطويقٌ للرأي العامّ وبروباغندا محمومة، مراقبةٌ معمّمة، وضع العوائق أمام المجتمع المدني بأكمله، التحكّم بالهيئات والنقابات، تنظيم الوشاية، إعادة هيكلة التعليم، تطهير الجيش وتكريسه، بناء دولةٍ بوليسيةٍ شبه مستترة، ميليشيا عشائرية توكَل إليها مهامّ الأعمال القذرة ومحصّنةٌ من العقاب، منظومةٌ أمنيةٌ حاضرةٌ في كلّ مكان. فلنتذكّر أنّ هذه المنظومة استوحيت من جانبٍ من التجربة السوفييتية، ومن جانبٍ آخر من النازي السابق ألويس برونر الذي أصبح مستشار حافظ منذ 1966 بعد أن كان مساعداً لأدولف أيخمان.
لقد غرقت هذه المنظومة في ثقافةٍ سياسيةٍ فريدةٍ من نوعها، تتضافر فيها روح الفريق والتعدّدية المذهبية والنزعة القبَلية، وهي أصلاً «إنكارٌ للدولة»، في حين اختُزلت الدولة بوظيفتها في السيطرة والتدمير.المصدر السابق، ص 19. أن تستنزف فئةٌ مغلقةٌ أو عشيرةٌ المجتمعَ بأكمله لا ينقِص شيئاً من السيطرة الكاملة. إذ تصبح السياسة الشمولية سياسة العشيرة أو الفئة المغلقة، وهي سياسة الانقسام المذهبي والاحتكار الطائفي، لكنّها ترث أيضاً الحداثة العلمانية الزائفة والاشتراكية من حزب البعث، المرتبط بـ«العروبة الصرف»: هذا الخليط من العناصر دفع ياسين الحاج صالح للحديث عن «الفاشية» وعن «الدولة السلطانية المحدثة». ففي كتابه الثورة المستحيلة، يقدّم تحليلاته عن «الأسباب الثقافية والسياسية للفاشية» في سوريا، وأكثر من ذلك، تحليلاته عن «العدمية السياسية» لدى النظام، وهي عدميةٌ تدفع لصعود «العدمية القتالية» بوصفهما بنيتين قاتلتين متناظرتين.ياسين الحاج صالح، الثورة المستحيلة، مصدر سبق ذكره. لا ينفي مزج العناصر البدائية (أو المغرقة في القِدم؟) بالحداثة السياسيةِ الطابعَ الشموليَ للنظام الأسدي، حتّى قبل أن يمضي بشار الأسد في حربه القائمة على الإفناء. وواقعُ أنّ الرعب المعمّم يمرّ أيضاً باستعراض الوحشية وصراع الجلّادين مع ضحاياهم، بإخفائهم ومحوهم وحبسهم الانفرادي، لا يناقض المنطق الشمولي للقبض الكامل على الحيوات والأرواح، كما لا يناقض دينامية الإبادة المقروءة في العمليات بوصفها شعارات.
سبق أن كان منطق كلّ شيء أو لا شيء هذا فعّالاً عندما قدّر رفعت الأسد، قائد سرايا الدفاع في عهد حافظ، أنّه يمكن «القضاء» على قسمٍ من السكّان من أجل «إنقاذ الثورة»، وحبّذ ذلك. ظهر هذا الكلام في صحيفة تشرين اليومية بتاريخ الأوّل من تموز (يوليو) 1980، بُعيد مجزرة تدمر وقبل سنتين من تعريض مدينة حماه للقصف العنيف وسفك الدماء. كانت فلسفة رفعت الأسد واضحة: «القائد يحدّد والحزب يؤيّد والشعب يصفّق. هكذا تعمل الاشتراكية في الاتّحاد السوفييتي. من لا يصفّق يذهب إلى سيبيريا».سورا، مصدر سبق ذكره، ص 59. كان رفعت الأسد يحبّ ذكر ستالين، لكنّ كلامه هنا يذكّر بالخمير الحمر، أولئك الخمير الحمر الذين دخلوا بنوم بنه بعد خمس سنواتٍ من انقلاب حافظ. قبل بضعة أسابيع من مجزرة تدمر، أوردت صحيفة تشرين عينها: «190 مليون عامل يقفون مع سوريا في معركتها» (13 أيّار/ مايو 1980)، وهي معركةٌ تستخدم «الاشتراكية الواقعية» من أجل قمعٍ أفضل للحركة الشعبية المتزايدة القوّة آنذاك.
هذا هو العالم مثلما افتُرِضَ أنّه موجودٌ بالنسبة إلى السوريين في 1979-1980 والسنوات التالية: هذا هو العالم الذي نراه ينغلق على الناس ـ الأطفال والمراهقين بصورةٍ خاصّة ـ في فيلم خطوة خطوة لأسامة محمّد. كان هذا العالم وهماً سياسياً، مثلما كانت الاشتراكية الواقعية حيثما اعتقدت أنّها تستطيع أن تملي على «العمّال» معركتهم. وتبع هذا الوهمَ وهمُ بشّار، المستوحى من نظرية المؤامرة، وهمُ بلدٍ يحاصره الإرهاب.
هذا هو العالم الذي «فتحته» ثورة 2011، وعلى هذه الثورة تنكبّ قوى النفي الأشرس. فإمّا أن توصف بأنّها ساذجة، أو بأنّها عديمة القيمة، أو ينكَر حدوثها أصلاً. يبدو لي أنّ موضوع «اللاجئين» الضخم مُكرَّسٌ هو أيضاً لنفي وقوع الحدث، الثورة وقمعها، ولمحو الأطراف الفاعلة في حكايةٍ سوريّةٍ تخصّ العالم، وشهودَها السياسيين. ثمة صلةٌ عميقةٌ بين نفي حدوث الجرائم وبين نفي حدوث الثورة. كما أنّ نزعة الإنكار عدميةٌ أيضاً، فهي تنفي إمكانية وقوع حدثٍ يقيم قطيعةً: قطيعةً ثوريةً وقطيعةً نجمت عن جريمةٍ لا تسقط بالتقادم. هذه النزعة رفضٌ لرؤية العالم ينفتح مع الثورة، رفضٌ لرؤية العالم يتحطّم بفعل جريمةٍ لا سبب لها، وبالتالي رفضٌ للتفكير في إنصاف المظلوم. في كلٍّ من هذه الحالات، هي رفضٌ للواقعي يتظاهر بأنّه نزعةٌ واقعية. كان جاك رانسيير مُحقّاً عندما وضع هذه «الواقعية السياسية» المزعومة ضمن «خطابات النهاية واللاشيء»، وأدرج فيها أيضاً النزعة الإنكارية.Jacques Rancière, Les énoncés de la fin et du rien, in G. Leyenberger et J.J. Forté éd., Traversées du nihilisme, منشورات Osiris, 1994.
*****
في أحد أوائل نصوص أوكتاف مانوني (Octave Mannoni) المكرّسة للمنطق الإنكاري، كتبه منذ 1962 وهو بعنوان الحاجة إلى التأويل، حلّلَ ممارسات روبير فوريسون الفيلولوجية، وأظهر أنّ مراجعاته الهوسية لقصائد رامبو ولوتريامون بهدف «نزع أسطرتها» تُظهِر رفضاً أو استحالةً لتصوّر حدوث ثورةٍ شعرية، وعلى نحوٍ أوسع، أيّ حدثٍ شعري الطابع.Octave Mannoni, Le besoin d’interpréter, Les Temps modernes, 1962. والحال أنّ الثورة السورية كانت بكلّ تأكيد، من بين غيرها وربّما لأقصى حدٍّ ممكن، حدثاً من هذا المستوى. فقد كانت بدايةً حدثاً سياسياً رئيسياً، له مدىً أخلاقيٌ هائلٌ حتّى في مآله المأساوي، ويجب أن نستخلص منه تجارب سياسية، وليس فحسب وعياً تاريخياً مفعماً بالمرارة والكرب. كما أنّها كانت أيضاً بالفعل ثورةً ثقافيةً وحدثاً شعريَ الطابع. وهي موجودةٌ بقوّةٍ في الشعر والفنّ، وهذا ليس سوى بداية وجودها. هذا الوجود ملهِم، وهو يعيد تماماً موضَعَة هذا الحدث في العالم. إحدى المهامّ التي تُعرَض علينا جميعاً هي من دون شكٍّ العثور على درب الواقعيّ، إن لم يكن العمل على ربط ميادين الفنّ والتفكير السياسي، ومقاربة واقعيةٍ أخرى، تجريبيةٍ غير وضعية، تأخذ بالحسبان وبالكامل التجارب الماضية والحالية، التجارب التي عاشها كلٌّ منّا، وتترك للممكن كلّ فُرَصِه: لإسقاطات الفكر، واللغة، والشكل الفنّي.
أفكّر هنا بالصفحات الأخيرة من كتاب ياسين الحاج صالح بالخلاص يا شباب، وكذلك بكلّ الصفحات الأولى في كتابه الثورة المستحيلة. فهو فيها ينسب لنفسه «السذاجة» بإلغاء هيغليته القديمة، حيث وعي الحاضر هو وعيٌ ساذجٌ يجب أن يترك مكانه للمعرفة المطلقة.(Impossible revolution) هو العنوان بالإنكليزية لكتاب (La Question syrienne)، لكنّ هذا النصّ المقتبس من المقدّمة الإنكليزية غير موجود في النسخة الفرنسية. يقول إنّ الثورة هي التي حرّرته من تلك الهيغلية، مثلما أعتقه السجن من أنواع الإيديولوجيا كلّها، حتّى لو ارتبطت بالسجن. لقد جعلت الثورة السذاجة ممكنةً، وهي سذاجةٌ تتيح لكلّ شخصٍ أن يفكّر الآن انطلاقاً ممّا عاشه. تقديم شهادةٍ عمّا حدث يعني تقديم شهادةٍ عن المستحيل الذي أصبحَ ممكناً، عمّا انبثق في الواقع، لكنّه دُمِّر. وفهم هذا التدمير يفترض أيضاً فهم هذا الانبثاق الممكن، والذي تحوّل إلى مستحيلٍ بسبب قوىً عدميةٍ تفعل فعلها في عالمنا.يستند مثل هذا التصوّر التطهيري للفكر والكلام إلى إيمانٍ بالعالم. وهذا الإيمان يبشّر به ياسين الحاج صالح في نصوصه كافّةً. فهو يدفعه إلى أن يكتب بأسلوبه الجذري الراهن تماماً أنّ سوريا اليوم هي العالم، وأنّ العالم هو سوريّ. لكنّ هذا الإيمان بالعالَم يعبّر عن نفسه في كافّة الأعمال التي يقدّمها لنا السوريون اليوم. الإيمان بالعالم غيرُ الأمل بعالمٍ آخر. كتب جيل دولوز في كتابه الصورة ـ الزمن أنّ هذا الإيمان هو «صلتنا الوحيدة»، وأوضحَ أنّه يجب إجراء «تحوّلٍ في الإيمان» كي نستطيع حقّاً أن نفهمه ونفعل فيه.جيل دولوز، (Image-temps)، باريس، منشورات مينوي، 1985، ص. 223-224: «وحده الإيمان بالعالم يستطيع ربط الإنسان بما يراه ويسمعه. يجب على السينما أن تصوّر، ليس العالمَ، بل الإيمان بهذا العالم، صلتنا الوحيدة. (…) سواءٌ أكنّا مسيحيّين أم ملحدين، في فصامنا العمومي، نحتاج إلى أسبابٍ للإيمان بهذا العالم. إنّه تحوّلٌ كاملٌ للإيمان». ربّما كان ما يدعونا السوريون إليه هو هذا التحوّل في الإيمان تحديداً.