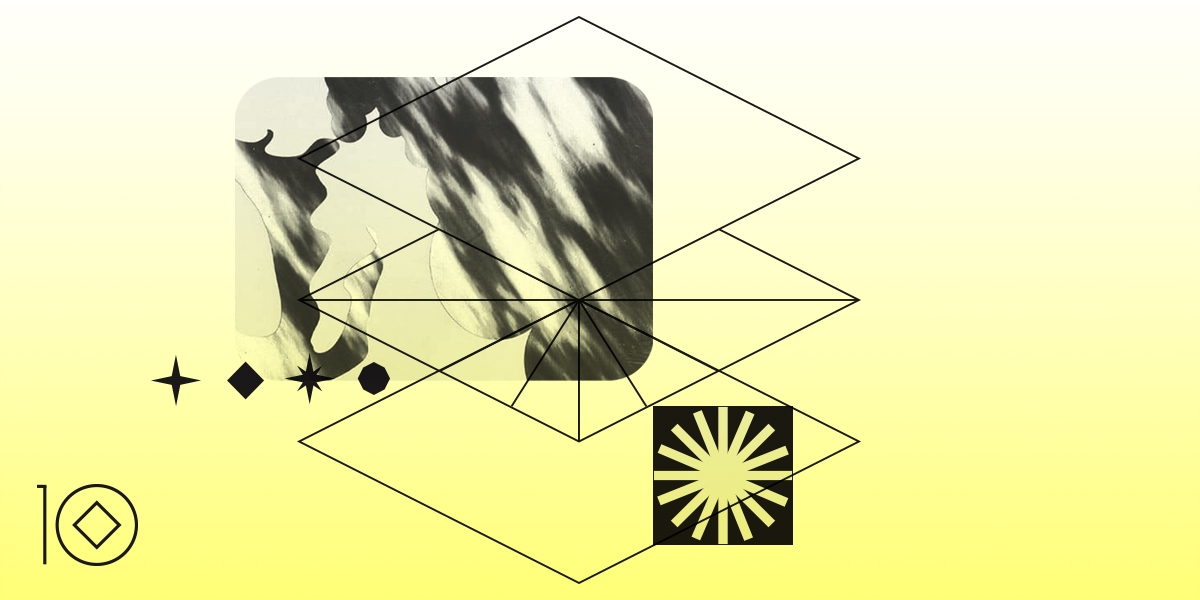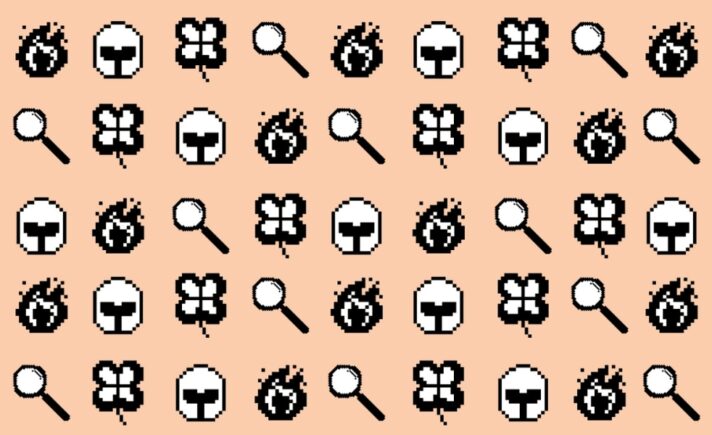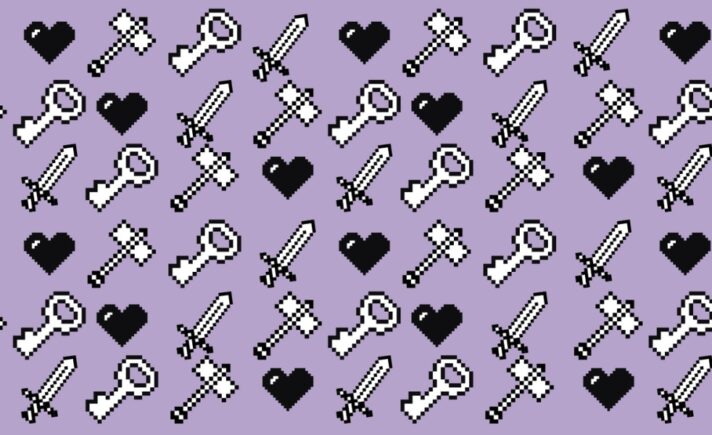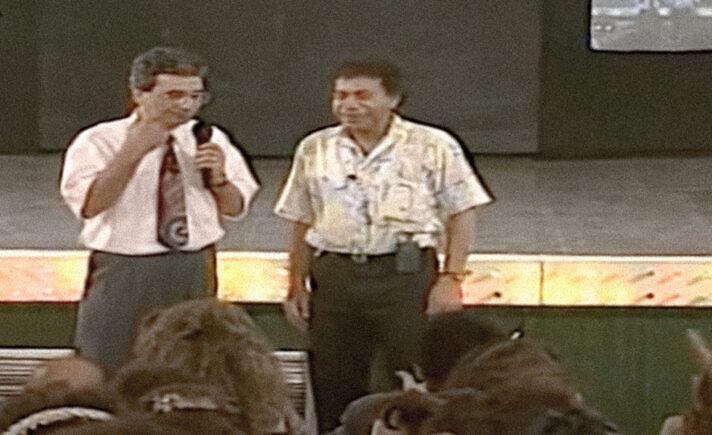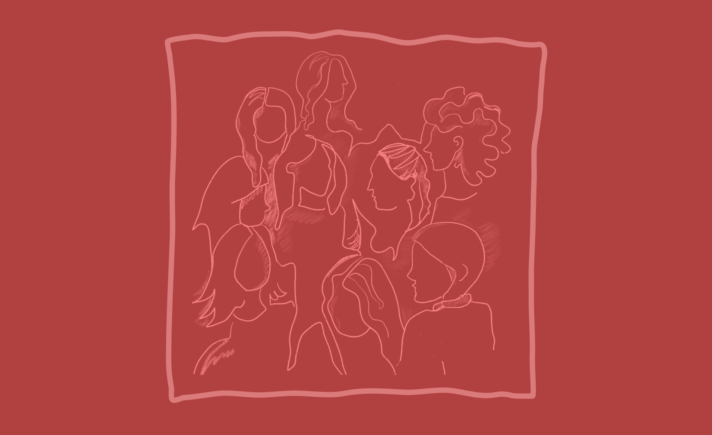الجواب البديهي الأول هو أننا نعمل هنا في موقع الجمهورية، نحرر نصوصاً ونكتب مقالات ونبني شبكات وندير عملنا ونتواصل مع بعضنا بعضاً ومع آخرين كثيرين قريبين وبعيدين. لكن ليس هذا فقط، بل نعتقد أننا نفعل أشياء أخرى، وأن لوجودنا معاً معانٍ تتجاوز عملنا اليومي الذي نحبه أحياناً ونضيق به أحياناً أخرى.
هذه محاولات للتفكير في تلك المعاني، وللإجابة على ذاك السؤال:
خمس ضربات فرشاة (ياسين السويحة)
سأصبح أباً خلال الأيام التي تحتفل فيها الجمهورية بعيد ميلادها العاشر. ربما يومها، الثلاثين من آذار، أو قبله بيوم أو يومين، أو بعده بأيام قليلة. ليس معروفاً بعدُ حين كُتبت هذه السطور. ومنذ معرفتنا بموعد الولادة المرتقب، بات متعذراً عليّ التفكير في أيّ من الميلادين بمعزل عن الآخر. من جهة، أُخبر نفسي بسخرية أن عليَّ المساهمة في «تأسيسٍ» مهمٍ ما نهاية آذار من كل عشر سنوات؛ ومن جهة أخرى، أكثر جدّية، بات من الصعب التفكير حول مرور سنوات عشر على تأسيس الجمهورية دون ربطه بفكرة، مبكرة للغاية قدر كونها لحوحة في بالي، أن عليّ الشروعَ في تحضير نوع من -أستعير هنا من رشا عباس عنوان مجموعتها القصصية- «ملخّص ما جرى».
وفي حين ما زال من المبكر للغاية التفكير في الأحداث والصراعات التي ينبغي أن تكون جزءاً من أي تلخيص ممكن «لما جرى»، إذ تستحيل معرفة أيّ منها سيبقى مفهوماً أو ذا معنى حين تحين فرصة تقديم «الملخّص» بعد سنوات، ثمة.. ثمة.. ماذا أسميها؟ أفكار؟ ربما ليست تماماً أفكار. حساسيات؟ هي أكثر من حساسيات، أعتقد. طيب، مع ذلك فلنقل: ثمّة حساسيات تحضر في ذهني حالما يحضر التفكير في «ملخّص ما جرى»، وتحضر معها أيضاً ضربات فرشاة، مواد في الجمهورية وضعت هذه الـ… هذه الحساسيات. ما زلت غير مقتنع أنها حساسيات.. ما علينا. مواد في الجمهورية وضعت هذه الحساسيات في كلام. أسترجعُ أدناه خمساً من ضربات الفرشاة هذه:
أولها، أن القول إنَّ سوريا الأسد لم تكن يوماً مئة بالمئة «سوريا الأسد» هو إحدى هذه الحساسيات. حسناً، هذه فكرة أكثر من كونها حساسية. عنونها صادق عبد الرحمن حينها بـ«دفاعاً عن سوريا التي لنا». رغم كلّ شيء، وعلى مرّ كل عصور الهيمنة الأسدية، لم تغب أنواع كثيرة من النضال للحفاظ على مساحات ما، من الثقافة، من الاجتماع، من التفكير، من الكلام ولو همساً. ليس هذا تخفيفاً للفداحة الأسدية المديدة بالطبع، بل صوناً لذاكرة من قاوموا، من مسيّسين ومناضلين دفعوا أعواماً طويلة من حيواتهم في السجون والمنافي، ومن بشر «غير مسيّسين» سعوا فقط لأن يحفظوا كرامة أنفسهم وأولادهم، وأن يعيشوا في عوالم محمية قدر الإمكان من الحمض الأسديّ المُخرِّش.
ثانيها، نجدها في برنامج تشفير لمنى رافع. لا أعرف حقاً كيف أشرح هذه «الحساسية» (وهنا فعلاً هي، حرفياً، حساسية). حين تقرأ هذا النص إما أن تشعر برعشة كهربائية تجتاز جلدك أو لا تشعر، وطوبى لمن لا يشعر. أعتقد حقاً أن هذه الرعشة هي تجلٍّ من تجليات «سوريا الأسد» على فيزيولوجيا أجسادنا.
ثالثها، عام كل شيء، 2011. شكّلنا قبل سنوات تنسيقية لتستعيد هذا العام بشكل غير نوستالجي، ولا أعرف إن كنا قد أفلحنا في ذلك تماماً. كيف تكون وفياً لعامٍ مرّ قبل أحد عشر عاماً دون أن تَعلَقَ فيه؟ كيف تتجاوزه دون أن تخونه؟ كيف تصون ذكراه دون أن تُصنِّمَه؟ وكيف تكون حنوناً معه دون أن تكذب عليه؟ عام كلّ شيء هو حساسية وفكرة. وهوية؟ لا لا. دعونا لا نتحدث عن الهوية.
الرابعة، وهنا نبقى في التنسيقية المذكورة أعلاه، الدفاع عن التفاجؤ. كُتب على جيلي آباءٌ أحببناهم «رغم كل شيء»، وأبوات هم «رغم كل شيء» فحسب، تميّزوا بشكل أساسي برهابهم للتفاجؤ، وقد ظلّوا رافضين للتفاجؤ بأي شيء إلى أن انكسروا، وبعضهم بقي غير متفاجئ حتى بعد أن صار ركاماً. ثمة بُعد نضالي حقيقي للدفاع عن الحق في التفاجؤ، وثمة فائدة نفسية ومعنوية هائلة في أن يتأكد المرء بين الحين والآخر أنه ما زال قادراً على التفاجؤ، وعلى التأثُّر أيضاً.
خامساً، لحظات التفكير التي لا بد أن يحتاجها المرء بعد قراءة «أنا، الشاذ». في لحظات كهذه، تخطر لي استحالة عدم استعارة «ابتذال الشر» من حنة آرنت -مع الكثير من التصرّف- للتفكير في «مؤسسة أخلاق» المُحافَظة المجتمعية. كيف يمكن لأناس ليسوا «أشراراً» كجوهر أن يقترفوا، دون أدنى وعي بالأذى في كثير من الأحيان، مروحةً متنوعةَ الفداحة ومن العنف ضد نساء وأفراد من مجتمع الميم، من خلال دورهم كبيروقراطيين في مؤسسة أخلاق المجتمع برتبة ذكوريين.
*****
بعد استعارة «ابتذال الشر» بتصرّف، أستعير بتصرفٍ مشابه «ابتذال الخير» من سانتياغو آلبا. يشرح في نصّه، أن نكون لطفاء، أن «الخير المبتذل»، وهنا يصفُ اللطف، هو ذلك الشيء الذي لا يؤلم اختفاؤه بشكل فوري، لكنه على المدى البعيد خيرٌ قد خُسِر، مع كل ما يعني ذلك. تساعدني هذه الفكرة على كتابة بعض الأسطر عن الجمهورية في عيدها العاشر، وقد خطرت لي خلال محاولة الإجابة على سؤال «ماذا يحصل لو اختفت الجمهورية»:
أحب أن أعتقد أن الجمهورية «خير مبتذل» بهذا المعنى. هي جزء جوهري في حياة عدد قليل جداً من الناس، فريقِ عملها، وهي مصدر رزقهم؛ ولها قيمة معنوية ومادية عند دائرة أكبر هم كاتباتها وكتّابها، قد يشمل المؤسسة ككل وقد يشمل موادهنّ وموادهم فحسب؛ وتعني زيارة يومية أو أسبوعية أو شهرية لعدد كبير من الأشخاص، لكنها زيارة كثيراً ما تكون بقرار من فيسبوك أو تويتر أو غيرهما من خلال رابط يظهر على «فيد» المستخدم. اختفاءُ الجمهورية لا شك سيكون له أثر مؤلم على فريقها، وسيكون سبب تأسّف لكاتباتها وكتّابها، ولدائرة مُواظِبة من قارئات وقرّاء الموقع. دائرة أكبر قد لا تنتبه للاختفاء إلا بعد مرور أسابيع أو أشهر، أو قد لا تنتبه أبداً لأن «فيد» فيسبوك وتويتر مبرمج لكي يكون أقوى من استشعار الغياب. لكن شيئاً ما سينقص. نصوص وأسماء وأفكار، و«حساسيات» كالمذكورة أعلاه لن تحضر، على الأقل لن تحضر كما تحضر الآن في الجمهورية.
أحب أن أعتقد أن الجمهورية «خير مبتذل» بهذا المعنى. نحن وما نفعل خاسرون حتميون في أي إطار مقارنة أو نقاش فيه «أولويات»، وفي سياقٍ قياميٍ كالسوري تحضر مقارناتُ ونقاشاتُ الأولويات أكثر بكثير، وبالتالي نخسر ويخسر عملنا سباقات أولويات بشكل يومي. أعترف أن الوعي بهذا الأمر ليس سهلاً، وفي الظروف الأصعب والأقسى والأكثر دموية قد يعيش المرء فصولاً حقيقة من التنافر المعرفي. لسنا أولوية. حسناً، ولكن من قال إن واجبنا أن نكون كذلك؟ الخير المبتذل الذي أؤمن أننا نعمل على تقديمه، لقارئاتنا وقرّاءنا، ولكن أيضاً لكاتباتنا وكتّابنا، الأصغر عمراً وتجربة بالذات، ضروري بالذات في السياقات التي تحضر فيها تراتبية الأولويات بقوّة، وهو ضروري فيها، للمفارقة، تحديداً لأنه يخسر سباقات الأولويات بالتعريف.
أحب أن أعتقد أن الجمهورية «خير مبتذل» بهذا المعنى. أن أفكر أننا نقدم شكلاً من أشكال اللمسة المُحِبّة على كتف كثيرات وكُثُر. ليسوا قلّة من لا يُحبّون هذا النوع من التعبير المُحِب، وقد يستفزهم ويغضبهم بشدة. لكن حتى هؤلاء، أعتقد، لن يطيقوا العيش في عالمٍ دون لمسات محبة، وبعض الابتسامات بين الحين والآخر.
نحن نحب أن نلمس بمحبة، وأن نُلمَس، ولذلك نحن هنا.
جمهورية خارج التراب (نائلة منصور)
هناك شعور عنيد ومُضنٍ تَلبَّسني لحظة خروجي من البلد، هو شعور أني لست في مكاني، شعور «المسرحة» في كل مكان، تماسفٌ أنظر فيه لنفسي وأنا ألعب لعبة «بيت وبيت»، في العمل، في الشارع، في النقاشات مع الأصدقاء والزملاء، في المناسبات الاجتماعية، في التجمعات، حتى التجمعات السورية منها. مضنٍ شعور عدم الشرعية، مثل «ابن حرام» يُكلّله العار في كل لحظة لأن أباه لم يعترف به. الأصدقاء المُستعجِلون الذين لا وقت لديهم إلا للإحساس بأنفسهم وما يجرحهم، يؤوّلون ذلك بأنه عقدة الذنب وعقدة الناجي. في الحقيقة، العار ليس إلا عارَ أننا لم نكن مواطنين في بلدنا، البلد أبٌ لم يحبنا بما يكفي.
في خضمّ كل هذا، كانت الجمهورية بالنسبة لي شرعيةً ومواطَنة، ورداءً يُلبَس على المقاس دون الشعور بأننا لسنا في مكاننا، لأنها تعطي الكلام لكل السوريين، أكيد، ولكن لأنها مثّلت من الداخل قيّماً كنا نصبو إليها في كل مكان آخر؛ إنجاح العمل الجماعي لنا نحن الذين وُصِمنا بالفشلة في أي عمل جماعي، ليس دونما قسر في أحيان كثيرة، بل قسرٌ وجبرٌ على اللطف، بوصف اللطف قيمة سياسية في تيسير أمور العادي اليومي. نجحنا في أحيان كثيرة في أن نعيد إحياء روح رسائل روزا لوكسمبورغ، التي كانت تطلب من داخل سجنها أن يُنسّق فلانٌ مع محاميها وأن يطبخ لها فلان، وأن يضع فلان الرسالة في البريد وأن يزورها فلان بانتظام. نحن كذلك حاولنا أن نعاكس القيم الضارية لبلدنا، حيث الضعيف يسقط سهواً ولا يلتفت إليه أحد. مرّ كثيرون منّا بظروف صعبة، وحاول الجميع المساندة بما يستطيع.
الجمهورية اعترفت بنا كما يليق بجمهورية أن تعترف بأولادها، لهذا ربما ما زلنا متمسكين بالاسم. جمهوريةٌ خارج التراب، ليس بالضرورة بانتظار الرجوع إلى التراب، ولكنها فكرة نحرص أن تبقى قابلة للعيش في سوريتها وكونيتها وعربيتها.
والجمهورية عنت بين ما عنت عروبة جديدة، تَعرَّفنا فيها على مواقع وصحفيين ومهتمين بالشأن العام من العالم الناطق بالعربية، لهم الحساسيات نفسها والتطلعات التحررية نفسها. كان كنز اللغة المشتركة هدية متبادلة لنُعبّر أننا لسنا وحدنا.
ولكن المِنّة الأكبر التي فاجأتنا بها الجمهورية هي أنها جسرٌ غير واهٍ بيننا وبين الشباب في داخل سوريا، استطعنا عبر الزمالة وعبر الأكاديمية البديلة أن نعزز فكرة أن الجمهورية بلدٌ بديل، أحسسنا بحرارة أجسادهم عبر الكاميرات رغم البرد وانقطاع الكهرباء واستطعنا أن نفهم من خلالهم أننا وهُم لسنا «برا» و«جوا». هناك شيءٌ ما «سوري»، هو ذلك البحث المشترك عن «السوري»، ذلك العنصر الشبحي المفقود الجامع للسوريين، الذي يتجاوز اللهجات المناطقية والحساسيات الدينية والطائفية والاصطفافات والنوستالجيا السياسية التاريخية والصور والإشارات والطقوس التمايزية، ذلك «الإيتوس» الغائب الذي نعرف أنه في مكانٍ ما.
أن نحاول إنتاج المعنى (صادق عبد الرحمن)
يُخيفني التحديق في خساراتنا السورية الرهيبة. وما زلتُ أحياناً أفكّر في أن كلّ هذا لم يحدث، في أنه كابوسٌ لعين سأصحو منه ذات يوم. هي آلامٌ لا تحتمل، وفوق هذا فهي لم تَعُد مفتوحة على نهاية معلومة، ولا على حصاد مأمول. هل يُعقل أن كل هذه الآلام من أجل لا شيء؟ هل يعقل أنها بلا معنى؟
لعلّ فضل الجمهورية الأساسي في حياتي أنها خفّفت عني وطأة هذه الأحاسيس الخانقة، أنها ساعدتني على إدراك معنىً لكل خساراتنا الرهيبة، وآملُ أن لها أثراً مشابهاً على القرّاء والقارئات، أو على بعضهم على الأقل. في مواجهة ضحكات بشار الأسد البلهاء التي تقطر دماً، وفي مواجهة مزيج الرثاثة والإجرام الذي أظهرته تشكيلات وجِهات أخرى من بينها جهات مناهضة للنظام، لا أرى شيئاً أكثر أهمية من طلب العدالة بإصرار، والدفاع عن الإنصاف والكرامة الإنسانية من حيث المبدأ، والتأكيد على أن فداحة المأساة لا ينبغي أن تعني التراجع عن طلب الحرية والعدل، بل ينبغي أن تعني جذرية أكبر في طلبهما لنا ولغيرنا.
ولقد حاولنا أن نتمثّلَ ذلك عبر ما كتبناه ونشرناه في الجمهورية، وذلك بالشراكة مع عشرات الكتّاب والكاتبات، الذين كان الشباب والشابات منهم بالذات دليلاً ساطعاً على أن هذه الخسارات لم تكن بلا معنى: أولئك الذين فتحوا عيونهم على عالم يتداعى ويُسحَق فيه العدل وطُلّابه بلا رحمة، فكان ردّ فعلهم أن أصرّوا على مزيد من طلب العدل، ومزيد من الرغبة في إنتاج المعنى ورواية الحكاية وبناء المعارف.
لا شيء في هذا العالم يمكن أن يعوّض الدماء العزيزة والأحزان العظيمة، لكن منحَ المعنى لهذه الخسارات هو ما يمكن أن يقدّم لنا وعداً بحياة ممكنة أقلّ ألماً وبأزمنة قادمة أقل قسوة. ولا شيء يمكن أن يمنح المعنى للمذابح الكبرى سوى أن نستخلص منها ما قد يساعد في عدم تكرارها، أو في بناء حياة أفضل للناجين منها ولأجيال أخرى قادمة.
يخوض عددٌ لا يحصى من السوريين والسوريات غمار محاولات إنتاج المعنى، ومعاركَ الدفاع المستميت عن الحق في طلب العدل. ويحاول موقع الجمهورية وشركاؤه والمساهمون فيه القيام بسهمٍ في هذه المحاولات والمعارك، على وعد أن الأيام والسنوات القادمة ستحمل لنا بعضاً من العزاء والسلام والآفاق المفتوحة.
استراحة على الطريق (عروة خليفة)
الكتابة في الجمهورية عنت لكثيرين -أنا منهم- امتلاكَ ذكرياتهم وعالمهم من جديد، عالم ضاع بين أنقاض مدن وبيوت، ضاع على أطراف حواجز لا نستطيع العبور منها دون أن نموت؛ أن نمتلك مجدداً شوارعنا وقصصنا ومظاهراتنا وعالمنا، الذي بدا أنه ضاع حال عبورنا خطّ الحدود. البعض لم يعبروا ذاك الخط، لكنّهم خسروا مساحات هائلة من عالمهم الذي دُمّر جلّه الآن.
البحث عن السياسي في تجاربنا، امتلاك القدرة على الكلام عنّا، عن سوريا وتاريخها واجتماعها. لم يكن الأمر سهلاً أبداً، خاصةً عندما تكون محاطاً بكثير من الخبراء الذين يمتهنون الحديث عن بلادك، ستكون دخيلاً على عالمهم، مُقصِّراً عن حق في أحيان، ومنفياً بقصد في أحيان أخرى. في الجمهورية، وجدتُ البلاد مجدداً دون رتوش. مشيتُ من حرستا إلى المخيم ومن دمشق إلى حلب ودرعا إلى السويداء. عاينا جميعاً الحال، لكن قبل كل شي تعرفنا على بعضنا. قد لا تكون تلك الصفحات التى كتبناها سويةً هي التي ضمّت وحدها مسيرةً طويلة بين طرق وحارات سوريا، لكنّها كانت الأقرب إلى قلبي. في الجمهورية، ليس هناك ممنوعون من الكلام سوى القتلة. نستطيع دائماً أن نعبّر عن أفكارنا حول بلادنا وعنها، كلامٌ وأفكار ذات معنى، حيوات تجتمع معاً بلا رقيب؛ هذا ليس قليلاً.
عشر سنوات مرت على بدء الجمهورية، كبرنا خلالها عشرات السنين، ضاع من أعمارنا أكثر من ذلك، لكننا نجونا وجمهوريتنا. نجونا بما في ذلك من شعورٍ بالذنب، والغبطة، والغضب، والحيرة. لا بأس ببعض الغضب، لكننا اليوم ننظر إلى عشر سنوات من عمر جمهوريتنا ونشعر بالغبطة. قد نقف محتارين في كثير من المواقف، لكنّنا لم نعد محتارين حول ما تعنيه تلك السنوات لنا.
اليوم نأخذ استراحةً، نجلس إلى جانب الطريق، ننظر، نتعلم بالطبع. لم تكن عشر سنوات بلا معنى بالنسبة لنا، الجمهورية في وسط المعنى الذي نخلقه لنعيش.
يجمعنا الحب أيضاً! (قاسم البصري)
نحن فريق من جيلين أو ثلاثة، تتقاطع اهتماماتنا وتفترق. أزعم أن أكثر ما يجمعنا، من بين مشتركاتٍ كثيرة، هو التطلع الصادق إلى العدالة وكرامة الإنسان؛ كل عدالة واجبة وضرورية، وكل كرامة كذلك. يلتقي هذا مع تطلعات الثورة السورية التي نؤمن بها، بدءاً من كونها ثورة كرامة كما يحب تسميتها سوريون وسوريات كثر، ووصولاً إلى محاولة سحقنا الفظيعة التي جعلت منا أكثر حساسيةً للعدالة كحق لا يمكن التراجع عنه.
نحن موجودون: نكتب، ونناقش، ونحرر، ونتبادل الأدوار والمهارات، لأننا قاومنا محاولات السحق ونزع الفاعلية، ولأننا ما نزال مصرين على حقنا المشروع وغير المشروط بالكرامة، ولأن لدينا ما نقوله عن بلدنا سوريا، وعن العالم. ما يزال بوسعنا الكلام لأننا جديرون به، وما نزال مصرين على حقنا فيه، مثل إصرارنا على حق جميع السوريات والسوريين فيه.
نحن فريق قليل العدد، ويجبرنا ذلك على أن نتعلم أشياء كثيرة من حقول عديدة حتى نمتلك العدة الثقافية والمعرفية لمواصلة عملنا كما يليق بتطلعاتنا. هذا ظرف عمل ضاغط بلا شك، ولكننا مدينون له لأنه مُثقِّف ومُعلِّم. يجمع هذا الفريقَ الصغيرَ ظرفُهُ الشتاتي أيضاً، وتوزّعُ أفراده بين دول وقارات. هذا اليوم شرطٌ سوريٌّ بامتياز، لم نختره بأنفسنا، ونتشاركه مع ملايين غيرنا، لكننا نحاول أن نكون في سوريا، قريبين منها ومن أهلنا وأحبتنا هناك، نقاوم كل أشكال الاقتلاع التي مورست علينا، ونحرص على أحقيتنا الدائمة بامتلاك مكاننا في بلادنا. كما نحاول أن نكون جزءاً من العالم، وحيثما نعيش ونتفاعل ونتعلم ونبني الصداقات.
نحن سوريون من أماكن وخلفيات متنوعة، أغلبنا لم نكن نعرف بعضنا البعض قبل 2011، ولكننا نشعر اليوم أننا متشابهون في القيم التي نحمل، لا سيما التي اكتسبناها من خلال عملنا المشترك ونقاشاتنا الطويلة على مر السنين. نستطيع الضحك سوياً، وقضاء أوقات لطيفة داخل وخارج أوقات العمل، نطل من خلال أحاديثنا على سوريا لم نكن نعرف بوجودها، ونكتشفها في كل يوم.
نحن مدينون بالكثير للكاتبات والكتاب الذين عملوا معنا، الذين تحمّلونا وتحمّلناهم، فقد تعلمنا منهم الكثير، وصاروا أصدقاء وصديقات لنا، ونأمل في أننا قدمنا لهم شيئاً ما يستذكرونه. ندين كذلك للقرّاء، وما منحوه لنا من طاقة على مواصلة العمل. لا شيء أكثر جمالاً من الكلام اللطيف والمشاعر الدافئة التي نتلقاها من أناسٍ لم نحظَ بفرصة اللقاء بهم يوماً، ولكننا نُقدّرُ أنهم موجودون خلف الشاشات الصغيرة.
يجمع هذا الفريق الحب، وهو قيمة إنسانية عظيمة. ما كان بوسع الجمهورية أن تستمر لعشر سنين لولا هذه القيمة. سنتقوّت بالحب في السنين الطويلة
| مجموعة الجمهورية |
القادمة من عمر الجمهورية.