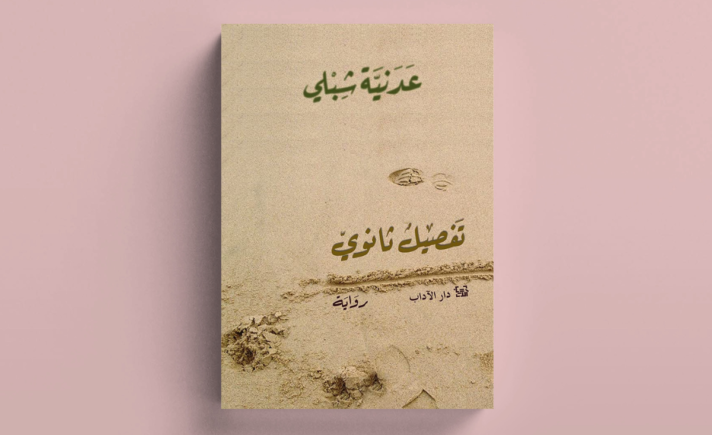سيجد أي مخرج سينمائي عربي نفسه اليوم في حيرة أمام سؤال أساسي، يطرح نفسه عليه قبل أن تدور كاميرته لتصوير فيلمه الجديد: هل أقوم بتصوير المشاهد الجريئة أم لا؟ ليس القصد هنا فقط مخاوفه من تحدّي مؤسسات الرقابة بأشكالها المختلفة، أو «الذائقة العامة» إن صحَّ أنها رافضة بأغلبيتها لمشاهد العري والجنس، إنما خلق نقطة مركزيّة سيُنظَر إلى الفيلم من خلالها مقابل تهميش بقية أجزاء الفيلم، وحصول الفيلم على الشهرة وتصدّره التريند بما يحتويه من مشاهد جريئة، بل وإغفال مكامن ضعفه وقوّته خلف جدليّة حق السينما في كشف الجسد، واستخدامه كلغة مجرّدة من القيود. من هنا سنجد أن أفلاماً كثيرة، تجاوزت ضعفها البنيوي، وباتت حديث الأوساط الفنية والثقافية، بمشهد واحد، حصدت منه شهرتها، ونالت نصيباً كبيراً من الدفاع عنها، والهجوم عليها، بناءاً على هذه الجزئية، وفيلم المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد الجديد صالون هدى هو النموذج الأوضح والأحدث عن ذلك.
منذ تَسرُّب الفيلم إلى فضاء الإنترنت العربي، وبداية انتشاره، ندرَ وجود مادة نقدية أو موقف من الفيلم غير متأتٍّ من المشهد الأول فيه، وهو مشهد قيام صاحبة الصالون النسائي هدى بتعرية زبونتها من ملابسها بعد تخديرها، وتصويرها مع شاب متواطئ صوراً فاضحة، لإجبارها على العمل مع المخابرات الإسرائيلية. هذا المشهد، كما هو متوقّع بلا شك، سيكون هو الفيلم، ستصنع منه الرقابات بتعدد أشكالها وأنواعها فيلماً قائماً بذاته، ولعلّ جريمة الفيلم هنا جريمتان، أولهما جريمة «أخلاقية عامة»، وثانيهما «نضالية فلسطينية» قد تتفوق على الأولى بفداحتها، فقد لعبت بما هو مقدّس وغير قابل للرؤية بغير المنظور التقليدي.
لنفترض أن الفيلم كنّى عن مشهد العري بإحدى الترميزات، وهو ليس بالأمر الصعب، فيمكن إيصال الفكرة ببساطة بالاستغناء عن المشهد الواضح. وهنا بالتأكيد ليس القصد أن المشهد كان غير مهم، أو أن استخدام الجسد العاري في السينما بحاجة إلى مُبرِّرِ عدم إمكانية تقديم الفكرة بدونه، لكن الفرضية تهدف إلى رؤية الفيلم بشكل أوضح: كيف سيكون الفيلم دون المشهد؟ لعلَّه في هذا الموقع سيظهر فيلماً مجرَّداً عادياً قابلاً للنقد الهادئ الحقيقي، ستظهر تلك الحوارات المفككّة والضعيفة، وستظهر القصة المباشرة الفجّة التي لا تختلف في مواقع كثيرة عن أفلام ناديا الجندي في التخابر والجاسوسية، ستظهر صورة المناضل التقليدية وجُمَلهُ التي تتردد في كتب القوميّة المدرسية ذاتها، وكذا مبررات الخيانة ستظهر دراميّةً لا أبعاد عميقة لها في الشخصية، ولا في الواقع الاجتماعي والسياسي، كما كان من المفترض أن تكون أمام كاميرا سينمائي محترف. سيظهر الفيلم هشّاً في موقع القوة الأساسية التي يُفترض أنه يستند عليها.
يمتد حوارٌ يجمع المناضل المقاوم حسن (يلعب دوره علي سليمان) مع أسيرته العميلة هدى (تلعب دورها منال عوض) على طاولة في قبو معتم، ولمدّة طويلة تمت تجزئتها على عدة مشاهد تتخلل دراما الفيلم المتمثّلة في محاولة الضحية ريم (تلعب دورها ميساء عبد الهادي)، التي تم تصويرها في الصالون، الخلاص من مصيرٍ تراه محتوماً. المُفترَض أن هذا الحوار الطويل حاملٌ لجدليّتين أساسيّتين، هما جدليّتا المقاومة والعمالة. لماذا هناك من يقاوم، وهناك من يرضى أن يكون عميلاً؟ تلك الصفات لم تُخلَق في الشخصية منذ ولادتها، إنما هي أفعال صنعتها التجارب. لكن ما تفضي إليه المكاشفة بين الشخصيتين هو أنّ كلاً منهما تبنى فعل المقاومة أو الخيانة لتغطية عطب ما أصيبت به الشخصية، مقاوم حمل السلاح بعد أن تسبب في طفولته بمقتل صديقه البريء برصاص الاحتلال، خشية أن يموت هو بهذا الرصاص، وسيدة تصبح عميلة خشية فضيحة الخيانة الزوجية وتبعاتها. نظرياً يبدو هذا الحوار، الذي يقود إلى تقديم الشخصيتين كضحايا للظروف، شيّقاً قادراً على تقديم خلاصة إنسانية جريئة في تقييم سلوكين متناقضين تماماً في ظل قضية واحدة، إلا أن ما يفتقده الحوار ككل هو السينما لا غير، حيث كان باهتاً غير شيّق، مرصّعاً بالكلام المنمّق وكأن كلا الشخصيتين حفظتا عن ظهر قلب مبرر ما أوصلهما إلى هنا بطريقة طبيب نفسي ماهر قادر على نبش جذور السلوك الإنساني. كان هذا المشهد المديد جزءاً أساسياً من الفيلم، وكان بلا شك جزءاً أساسياً من مكونات مكامن الضعف فيه. هذه اللغة الصلبة ضربت الأداء في مقتل، حيث من المحبط أن ترى ممثلاً بكفاءة علي سليمان في مستوى أداء مرتبك كالذي قدمه في صالون هدى.
تنجو المشاهد العائلية من صلابة وجذرية الحوار، وتبدو سينمائيةً طبيعية وجميلة حين تجتمع أسرة الزوج على طاولة غداء أعدّته الزوجة الضحية لأخوات زوجها وأمه. الزوجة القاسية الحاسمة في انتقاد زوجها الشَكَوك الضعيف، والهشّة في البحث عن حل لمعضلتها الكبرى، تفشل في الانتحار حين تفرغ أسطوانة الغاز أثناء محاولتها الانتحار، وترتبك في استخدام الهاتف للتفاوض على خلاصها. تنعكس طبيعية الحوار والسلوك هنا على أداء ميساء عبد الهادي التي كانت الاستثناء الوحيد على صعيد التمثيل، وهي التي سبق وأعلنت مدى ارتباكها حين عرض فيلمها الأول بحضور والدها، كونه سيرى ابنته الممثلة الشابة وهي تدخّن السجائر في الفيلم. هي اليوم في هذا الفيلم ستكون عاريةً أمامه، فكم من الجرأة تطلّبَ منها أداء هذا الدور أمام والدها، وأمام المجتمع والمؤسسات الفلسطينية الجاهزة للوصاية على جسدها.
مقابل مُسلّمة الخوف من الاحتلال، وقدرته على تصفية من شاء، هناك خوف يشير إليه الفيلم بوضوح، وهو الخوف من المقاومة، التي لن تعدم السبل لتصفية النساء الضحايا اللائي تم ابتزازهن بالصور العارية لأجل ممارسة العمالة. المفارقة هنا ستنعكس بشكل أو بآخر خارج إطار الدراما، لنجدها واقعيّةً فيما بعد مرحلة عرض الفيلم للجمهور، فمن يحمل الباسبور الإسرائيلي من أفراد طاقم الفيلم لن يرضخ للدعاوى المرفوعة ضده من قبل أطراف فلسطينية عدّة، ومحامين وجدوا في الفيلم إساءة لقضية الشعب الفلسطيني، بينما سيكون الممثلون الذين لا يحملون هذا الباسبور عرضة للمساءلة حسب ما يظهر، حيث أشارت وسائل إعلام عربية إلى أنه من المُتوقَّع استدعاء الفنانة منال عوض كونها الوحيدة التي تحمل الجنسية الفلسطينية بين أفراد طاقم الفيلم.
منذ فيلمه الجنة الآن المنتَج سنة 2005 والذي رُشِّحَ لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، اتجهت أفلام هاني أبو أسعد نحو موضوعات متشابهة مرتبطة بشكل أساسي بالمقاومة والعمالة، لكن لغتها السينمائية انحدرت مروراً بفيلم عمر 2013 وصولاً إلى صالون هدى. وبعيداً عن مفاهيم النقد وتحديد مستويات القوة والضعف في الأفلام، فإن مبادرته فيما يتعلّق بحذف مشهد التعرّي من فيلمه الجديد في النسخة التي سيتم عرضها للجمهور العربي، مقابل الحفاظ عليه في نسخته الأصلية للجمهور الآخر، مبادرة غير موفّقة، لا تخلو من تنميط للجمهور، وتحديد مستوياته الفكرية والجمالية، من بوابة تفهّم الاختلاف وتقبّل محدودية الرؤية والتفكير عند الجمهور العربي. أمّا تلميحات وزارة الثقافة الفلسطينية إلى أن «الإساءات» الواردة في الفيلم، ستلعب دوراً في قرارها لترشيح فيلم فلسطيني لجوائز الأوسكار، فتبدو محدودة، وتحمل دلالة على مدى سلطة مؤسسة غير مهنيّة في التعاطي مع السينما، تقيّم الفيلم بناء على مشهد أو مشاهد «مخلّة بالأخلاق». وبعيداً عن هذا التقييم، فإن الفيلم يحمل في طياته أسباباً كثيرة لعدم أهليته للترشح إلى الأوسكار، ليس منها بالتأكيد مشهده الأول والأَشهَر.