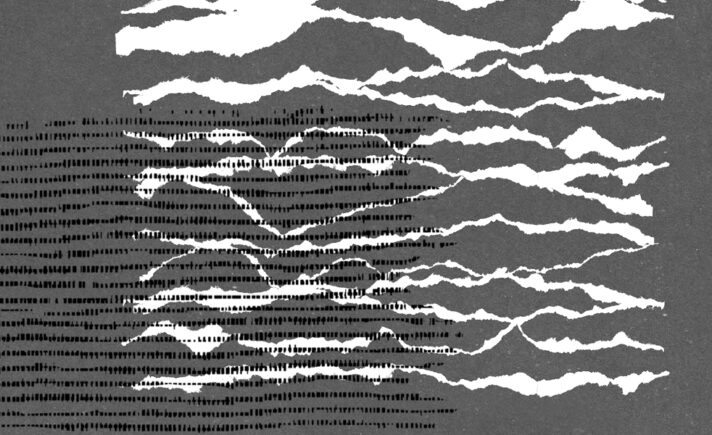«أوعى تفتكر إن في سلطة كاملة، السلطة المطلقة هي المثل الأعلى اللي عمرو ما حيتحقق، السلطة دايماً ناقصة، وهي المشكلة اللي محدش قادر يحلّها» تمر هذه الجملة في حوار بين ضابط المباحث و«المواطن»، في فيلم مواطن ومخبر وحرامي (2001) للمخرج المصري داوود عبد السيد، جملة مباشرة واضحة الدلالات، وغير مستهجنة المرور في السينما المصرية عموماً، وقد عجت عشرات الأفلام بمثيلاتها، لكن مرورها في هذا الفيلم له وقع مختلف، إذ أدارها ووظّفها مخرجٌ يحترف اللعب في المساحة الفاصلة بين النخبوية و«الشعبوية» أو ما يطلق عليه جزافاً التجارية، نَشَد خلال مسيرة طويلة في السينما شكلاً قادراً على البيع في شباك التذاكر لتكون السينما صناعة مربحة له، تجنّبه ظرفاً يعجز فيه عن الاستمرار بالإنتاج، وفي الوقت ذاته كان هذا الشكل نخبوياً بطريقة خاصة، إذ وعلى عكس نموذج السينما النخبوية التقليدي عربياً، لا ينتظر هذا الشكل التمويل من جهات حكومية أو غير حكومية، عادة ما تكون هي من يدفع أجر إنتاج هذا النوع الذي لم يستطع بناء علاقة طيبة مع شبابيك التذاكر إلا في تجارب نادرة. منها بلا شك تجربة عبد السيد الذي أعلن اعتزاله مؤخراً، موجهاً القرار للجمهور ومحمّلا إياه مسؤولية هذا الاعتزال، غير آبه بحجم المواجهة مع النقاد ومع الجمهور ذاته.
منظور عبد السيد للجمهور واختلاف الاهتمامات والهموم والذائقة، بين ما قبل الألفية الجديدة وما بعدها، هو منظور سينمائي بحت، لم يرضَ يوماً أن يفصل فيه بين شخوص أفلامه الروائية، وبين جمهور مشاهدي السينما، فذاك الجمهور المحتشد على شباك قطع التذاكر هو ابن الطبقات المتفاعلة ضمن بنية المجتمع المصري، وضمن بنية أفلامه التي كانت موضوعاتها منذ أول فيلم كتبه وأخرجه الصعاليك (1985)، وحتى آخرها قدرات غير عادية (2015) هي الطبقات الاجتماعية، وبنى العلاقات بينها، والتي كان فيلم مواطن ومخبر وحرامي أكثرها وضوحاً ومباشرةً في هذا السياق، فالمواطن ابن الطبقة الوسطى، التي تفقد تدريجياً قيمتها و«مشروعها» للاستمرار في حفظ ثقافة وبنية المجتمع أخلاقياً، باتَ رهينة الدولة المتمثلة بشخصية المخبر الذي يحكم شكل علاقات الطبقات ببعضها، من شخصيات قاعٍ منحلة إلى نخبويي المال والسلطة، شرّح حينها الفيلم بعفوية وطريقة مبتكرة لا تخلو من الكوميديا السوداء طريقة انسياق الطبقة الوسطى وفق رغبات الطبقات الأخرى، وفقدانها مشروعها المتأتي من إرادة ذاتية ووعي، لصالح الآخر التخريبي، ليتدرّج هذا السقوط وتتالى انهيارات هذه الطبقة فيلماً فآخر، وصولاً إلى عدم إيمان المخرج أصلاً بوجود طبقة قادرة على مشاهدة أفلامه، ودفع ثمن التذاكر التي تضمن له استمرار مشروعه السينمائي، ليس من باب القدرة الشرائية حسب تصريحه في اللقاء الذي أعلن فيه اعتزاله، إنما من باب اختلاف الاهتمامات، فما يهم الجمهور اليوم لا يهم عبد السيد.

يمكن القول وبشفافية أن مخرجاً من رواد الواقعية المصرية الجديدة، وأحد أهم الأسماء في سينما المؤلف العربية، وقف خلف الكاميرا ليرصد انهيار الطبقة الوسطى، فأصبح ضحية لهذا الانهيار، ولتكون الشخصيات التي لامس بها الواقع بحساسية شديدة في أفلامه، متمثلة أمام عينيه في الواقع، لدرجة تحميلها ذاتها مسؤولية اعتزاله الحديث عنها. لم تعد هذه الطبقة موجودة؛ إذاً عمّن سيتحدث داوود عبد السيد؟ ولئن قدر على الحديث من سيهتم ويقبل دفع ثمن تذكرة سماع القصة؟
تسعة أفلام طويلة أخرجها داوود عبد السيد خلال مسيرته في السينما الروائية الممتدة عبر 30 عاماً، كان قد بدأ قبلها كمخرج للأفلام الوثائقية التي لا تنفصل بموضوعاتها عن همّه العام في السينما، إلا أن اسمه شعبياً ارتبط بفيلم واحد هو الكيت كات (1991)، الذي تحوّل بشكل من الأشكال إلى معيار قيميّ ثابت، قورن ما جاء قبله وما جاء بعد به، فأصبح صاحب هذا الفيلم مقصّراً بكل ما أخرجه بعده، وهي خمسة أفلام، كانت على مستويات متفاوتة في القيمة والجماهيرية، لكنّها ظلت خارج المقارنة مع الكيت كات. لعل ذلك يبدو منطقياً، ولعلها أيضاً واحدة من مشكلات سينما المؤلف المنتمي للواقعية، المتمثّلة في قلّة عدد الأفلام التي يقدّمها السينمائي الواحد، ووجود فيلم واحد يحتلّ مرتبة القمّة، ويغشي الرؤية نسبياً عن باقي الأعمال.
من مستويات عدة يستحق الكيت كات أن يرتقي قمّة أعمال مخرجه، فهو ابن رواية مالك الحزين للروائي المصري الراحل إبراهيم أصلان، الرواية التي ستتطلب جرأة من مؤلف سينمائي اعتاد إخراج نصوصٍ يكتبها بقلمه، ليقرأها بمرونة، ويغيّر بنى العلاقات فيها، ويختصر شخوصها، ويغيّر سياقاتها الزمنية، ليتمكن من ضبط إيقاعها أمام الكاميرا، بمشاركة أبطالٍ سينمائيين ليس من المبالغة القول أن تجربتهم في الفيلم، هي أفضل أدوارهم السينمائية، من محمود عبد العزيز بدور الشيخ حسني، إلى شريف منير بدوريوسف، وعايدة رياض بدور فاطمة، ونجاح الموجي بدور الهرم. كل شخصيات الفيلم وما تحمله من أسرار تخفيها عن سكّان الحي الصغير، ستكون عارية أمام عيني شيخ ضرير، إعاقته هي الأكثر وضوحاً لأولئك الذين لا يخلو أحدهم من إعاقة مخفيّة، وهو ما يؤكده المخرج ذاته كنقطة محورية في الفيلم.

وضوح كل شيء أمام عيني البطل المطفأتين، دفعه للظن والإصرار أنه مبصر في الواقع، لدرجة أنه قادر على المغامرة بقيادة الدراجة النارية في الحي أكثر من مرة، وقادر على مكاشفة الجميع بمكشلاتهم في خلوات تدخين الحشيش في الدكان القديم مع الصهبجية، أولئك الذين يقضون النهار بمهنهم البسيطة، ثم يجتمعون ليلاً ليغنّوا، ويتركوا للشيخ حسني أن يقدّم أجمل نسخة من الأغنية التي كتبها صلاح جاهين ولحنها سيد مكاوي، فكان لها الطعم المختلف كلياً في غرزة الحشيش، على لسان من سيفضح أسرار الحي على الملأ، حين نسي أحدهم إغلاق الميكروفون في مجلس عزاء، هنا فقط يدرك الجميع أن شيخاً ضريراً، مدمناً على الحشيشة، يرى بوضوح ما لا يرونه هم أنفسهم في دواخلهم.
تحسست كاميرا داوود عبد السيد المكان، الذي تطوّر مدى حضوره في أفلامه واحداً فآخر، حيث زادت اللقطات الصامتة كلما تعمّقت تجربة المخرج أكثر، وتفعّلت أهمية حركة الكاميرا، وقلّت أهمية الحوارات، لتبلغ بطولة المكان ذروتها مع فيلم رسائل البحر (2010)، والذي فاق فيه الترميز تلك الحدود التي كان يضعها المخرج لسابق أفلامه، لدرجة أنه كان من أكثر الأفلام الجدلّية في تاريخه، فانقسم مشاهدوه بين من اعتبر الفيلم تحفة فنية نادرة المثيل في السينما المصرية، ومن رآه تهويمات غاص فيها عبد السيد في طريقة شرح انحلال الطبقة الوسطى، حتى تسرّبت الحكاية من بين أصابعه. في هذا الفيلم الذي انبرت أقلام نقديّة كثيراً تعيب عليه المضامين الجنسية التي حملها، كانت الصورة سيدة الموقف، وكانت دلالات ما هو رمزي فيه بالغة الوضوح، والمعاني ليست بحاجة إلى جهد كبير للقراءة والاستنباط، كان دور الطبيب المتلعثم يحيى الذي لعبه آسر ياسين، أفضل الأدوار تمثيلاً للعلاقات الطبقية في تاريخ سينما عبد السيد، كان يحيى طبيباً يقرر العودة إلى منزل أهله القديم في الإسكندرية ليعمل صياداً، فيجد نفسه محاصراً بسلطة أصحاب النفوذ والمال الذين سيأتون على كل التفاصيل الجميلة في حياة أولئك الهاربين من سطوة المجتمع القاسي، الذي لا يحترم الخصوصيات الفردية. سيسلبون الذاكرة مكوناتها الجميلة، بقدرتهم على شراء الأبنية والشوارع، وسيسلبون البحر أسماكه التي ستُضلُّ طريقها عن صنارات الصيادين، حين يخطفها الديناميت، وسيجعلون الجمال رهينة رغباتهم، فيصبح الاغتصاب شرعياً طالما أنه جنس مقونن، ويصبح الحب وصمة عار طالما أنه جنس خارج عن إطار المشروعية الاجتماعية والإدارية. وسيستمر الوحش القادم بالتهام كل الضعفاء، على الرغم من أن قابيل – الذي لعب دوره محمد لطفي – قد تاب عن القتل كلياً بعد جريمة ما زال نادماً عليها حتى الآن.
في 2015 قدّم داوود عبد السيد آخر أعماله، ليأتي اعتزاله اليوم كتحصيل حاصل، كما قال هو نفسه حين أعلن الاعتزال، ويكون بذلك بين أواخر الخارجين من تلك المدرسة الحداثية في السينما المصرية، والتي أطلق عليها الناقد الراحل سمير فريد اسم الواقعية الجديدة ليميّزها عن كلاسيكيات صلاح أبو سيف وجزء من سينما يوسف شاهين وغيرهما، لكن روّاد تلك الواقعية الجديدة بمعظمهم قد غيّبهم الموت، من محمد خان إلى عاطف الطيب ورضوان الكاشف ورأفت الميهي، أما الباقون منهم، فبينهم من يكافح اليوم لإنتاج فيلم سينمائي بمقاييسه الخاصة التي لم تعد تحظى بالمقبولية ذاتها في سوق الإنتاج المصري كما في السابق، ومنهم من قرر ترك الساحة، رافضاً أن يكون للسينما مصدر تمويل آخر سوى شباك التذاكر.