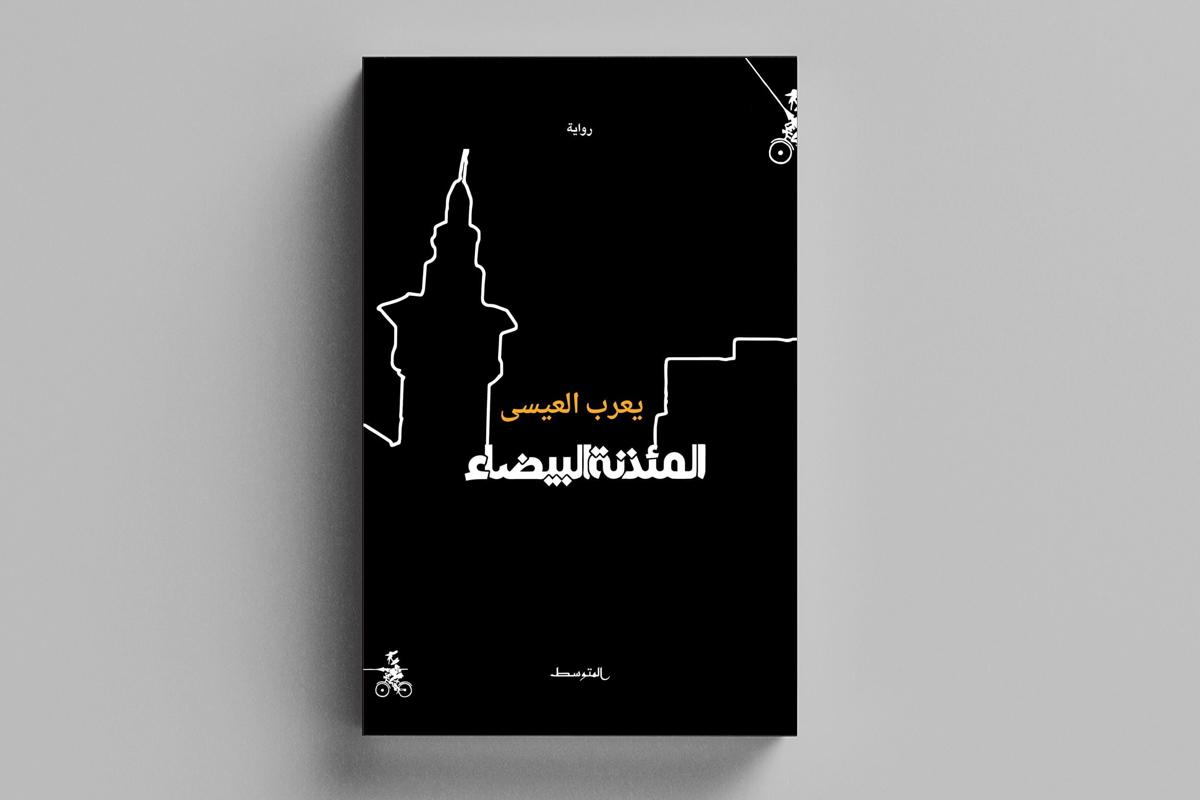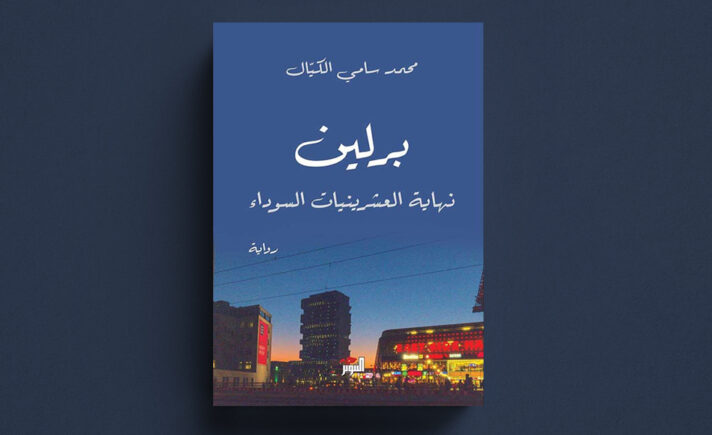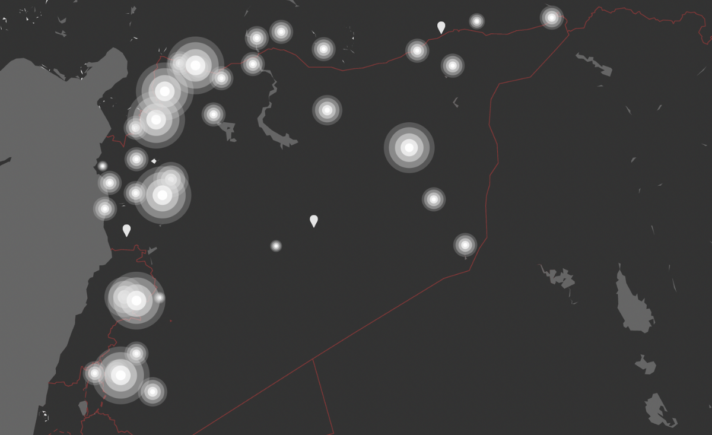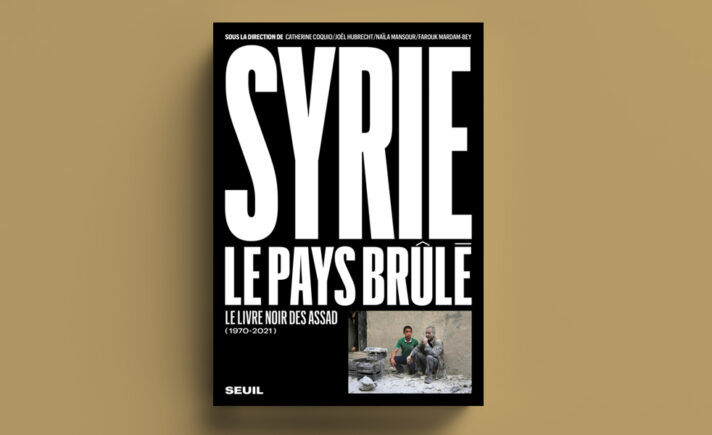صدرت رواية المئذنة البيضاء – دار المتوسط- و التقفها القرّاء وكأنها حدث لم يسبق له مثيل، إذ تناولها الأصدقاء و«الأعداء» بالمديح والتنكيل، وبتلميحاتٍ طائفية أحياناً. لاختصار الجدل، نحن أمام عمل متخيّل، رواية وإن ضمت صوراً فوتوغرافيّة لجرائم بعينيها، فهي «رواية»، تحكي عن الرحلة شبه الفاوستوسيّة التي يتحول فيها غريب الحصو إلى مايك الشرقي، الذي أسرت حكايته الراوي كما جاء في المقدمة فانطلق باحثاً عن وجهه الذي لمحه أو لمح صورته.
غريب، الشاب شبه المتسول الذي تتملكه مئذنة باب شرقي في دمشق تنتهي سيرته وهو واحد من أغنياء العالم إثر صفقة كان قد عقدها مع الشيطان، الذي باعه غريب روحه، لعله يشتريها منه مرة لاحقاً. هذه الأسطر قد تصلح كتلخيص عجول للرواية، التي تتحرك أحداثها بين عامي 1984 و2020، بين دمشق وبيروت وقبرص وأوروبا والصين.
نذكر المعلومات الصحفية السابقة لأنه من غير المجدي كتابة عدة أسطر، مهما طالت، لاختزال 424 صفحة، وما يتخللها من أحداث وحقائق وأكاذيب وصفقات وأنواع صحفيّة، وحقائق تاريخيّة وتلفيق لحقائق تاريخيّة، كما أن التحولات التي يمر بها مايك الشرقي وسعيه لتأسيس دين جديد أو تجسيد مسيحٍ دجال مترابطة ومتعددة، تبدأ من أشد التصرفات لا إنسانيّةً ودناءةً، انتهاءاً بالدعوة إلى المحبة و الله وغيرها من حذلقات الشيوخ والدراويش.
أسطورة الرجل الواحد
أبرز ما نتلمسه في الرواية هو أزمة الرجل الواحد، ولا نقصد هنا القراءة الجندريّة، بل التحول المستحيل لمايك الشرقي، الذي لا يمكن إلا أن يكون متخيلاً، بسبب خصائص «العالم» الذي يعيش ضمنه، القسوة والفساد والعنف والجنس وكل ما ينتمي إلى «نظام أعمال الخفاء»، ثم التحول إلى «نظام الأعمال الشرعي»، وهو ما يثير الرعب فيما نقرأ، لا حكاية مايك نفسها وآراءه ومعتقداته.
يبيح العالم الذي يتحرك ضمنه الشرقي لشخص واحد فقط، أي شخص، أن يحقق ما حققه مايك من جاه ومال ورغبة بالتحول إلى أسطورة. كل التواريخ والحذلقات واللعب السردي لا تنفي أن مايك في عالم يشبه عالمنا، لكنه لا يمتلك ذات شروطه، وهنا نطلق أحكاماً أخلاقية، هل مايك شرير؟ أم عصامي يريد النجاة؟ أم مؤمن من نوع ما؟ كل هذا لا يهم لأننا في عالم بلا شروط أو حدود، سلطة الحلم والإرادة الشخصيّة والعنف الشديد هي القوى التي تهيمن وتذلل العقبات، وهذا يكشف عن المفارقة العميقة في الرواية، هل فعلاً الصفقة مع الشيطان هي ما سهّل طريق مايك وتحوله؟ أم أن «العالم» ذاته يبيح لمايك أو أي أحد أن يصبح مسيحاً دجالاً يريد إحياء الأساطير القديمة؟
خرائط من يمشي حافياً
نتعرف في الرواية على جغرافية لدمشق يألفها من لا منزل له، إذ تتكشف أمامنا المدينة بصدقها و«كذب» الراوي من وجهة نظر من يمشي فيها متشرداً، لا مُستقر له، فكل الشوارع مساحة صالحة للنوم أمام «غريب» قبل تحوله لمايك. ولاحقاً، حين عاد إليها للاستقرار، كان يفضل السير على الأقدام، والتنزه في شوارع وأزقة المدينة القديمة، وكأنه ينتمي دوماً إلى «الخارج»، الذي يبلغ أوجه في الحلم التي يتبناه ويسعى إليها، وهو إعادة تشكيل المدينة و«خارجها» ليكون إما مسيحها المخلص أو دجالها الذي يدفعها للنهاية. والملفت أيضاً أن الراوي نفسه يعيد ترتيب عناصر المدينة ومكوناتها، من قبور المتصوفة حتى المئذنة وتوزيع الشوارع، وكأن كل ما في المدينة خارج مكانه، وما يضبط الحركة ضمنها هو الحذاء ومدى اهتراءه، والطاقة التي يختزنها طعام الشوارع. أما البصر، فيقيّده الإسمنت والأكاذيب. أما الكلام فيهذبه الأمن والوشاة والسفلة. أما الحلم، فهو مساحة مايك، لا رقيب عليه.
دليل استخدام المال والسيمياء
تتحول الرواية في فصولها الأخيرة إلى ما يشبه الدليل البراغماتي لتحقيق النبوءات الدينية، الذي تصبح الدولة بعمقها وظاهرها ضمنه أشبه بأداة لتحويل الحكاية إلى حقيقة، وذلك بالتوازي مع جهود مايك لتحقيق حلمه بصورة أشبه بدرس في السيمياء التاريخيّة وأسلوب تمكينها بشكل مادي، فهناك الأبحاث حول الرموز، وتداخل القطاعات المعرفية المختلفة، وحكايات السكارى والشيوخ، ثم المال لتحويل الحلم إلى واقع وخلق علاقات رمزية جديدة بين الأفراد تمهيداً للنبوءة.

هذه القراءة لوظيفة الدولة مثيرة لاهتمام، وكأننا أمام سيادة تعتمد أساطير كل من يمتلك السلطة والمال لتحريك التراب والناس، الشأن الذي تنكشف خطورته حين يقود الدولة أو المتخيل الجديد عن الدولة، رجل واحد فقط. وهنا تظهر المفارقة الثانيّة، «سوريا» المفترضة والعالم حولها الذي تدور فيه الأحداث يمكن لشخص واحد أن يحقق فيه ما يريد، وتتعمق المفارقة حين ننظر لسوريا «الرسميّة»، فهي أيضاً حلم رجل واحد، خالد، تمكن ومن حوله من تحويل نفسه إلى حكاية، وامتلاك من يعبدونه حقاً.
وُصفت الرواية في العديد من النصوص بأنها تتبنى النفس الاستقصائي، أي تكشف ما خفي وراء ما نعرفه من معلومات وحقائق عن سوريا، ثم تقديم بديل لها، متخيل كان أم حقيقية، وكأن الراوي ينزع عما نعرفه «حقيقته» ويزيحه إلى وهم آخر، فهناك حكاية سابقة على ما نعرفه، حكاية أعيد ترتيب تفاصيلها و«رموزها» وبعثرتها. وهنا يطرح سؤال: ما الذي تستقصيه الرواية؟ ما الذي يبحث عنه الراوي ويحاول نفض الغبار عنه؟ والأهم، أي «حقيقة» نأخذ بها؟، ما نعرفه عن قبر محي الدين ابن عربي؟ أو ما نقرأه في الرواية عن مكانه الأصلي على سفح جبل قاسيون ؟
لا إجابات عن التساؤلات السابقة، فتاريخ سوريا وسياسات ما بعد الحقيقة والقمع وغياب الأرشيف يتركنا أمام «تواريخ» و«حقائق» متعددة، ويمكن لكل واحد أن يختار الرواية التي تناسبه، والاختلاف «بيننا» وبين مايك الشرقي هو أنه قرر تقديم نسخة جديدة أو محدثة من الحكاية التي نتداولها، وترسيخها على الأرض عمراناً وإيماناً، وهنا نعود إلى إشكالية تلخيص الرواية التي تفاديناها بدايةً، تحت أي نوع فرعي من الرواية نضع المئذنة البيضاء؟ المغامرات؟ رواية الطريق؟ الرواية الوثائقية؟ الرواية التشرديّة؟ يمكن التقاط ملامح كل هذه الأنواع ضمن الصفحات الأربعمئة من الرواية، لكن لا أحكام ومحاولات تصنيف حالياً، إذ نقرأ على الغلاف الخلفي للكتاب نهاية التعريف عن يعرب العيسى بأن «المئذنة البيضاء هي روايته الأولى».