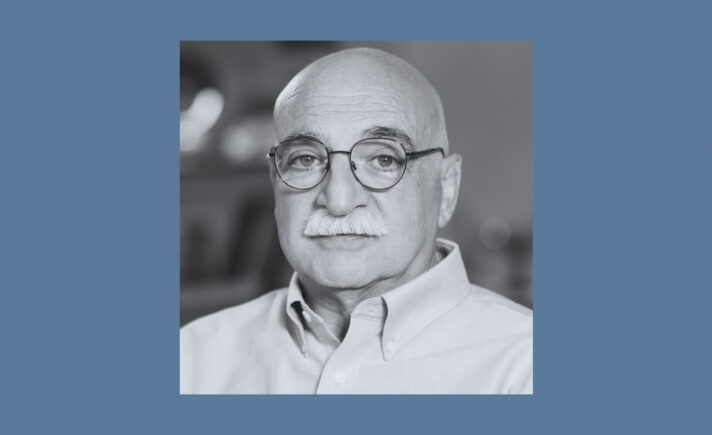ترددتُ دوماً بالكتابة عن سميرة الخليل أو إليها. يثيرُ الأمر شجناً شخصياً علاوةً على كونه بالأساس جرحاً مفتوحاً يُمثل قضيةً عامة ورمزاً لثورة السوريين المسحوقة. ينبع الحزن الشخصي بالأساس من تذكر لقاءات متقطعة بسميرة عبر ما يقارب عقداً ونصف العقد، تزامنت مع محطات مفصلية في تشكل وعيي وفي تحديد الدروب التي سلكتها أو تلك التي فُرضَت علي. سأختار هنا ثلاثة لقاءات متباعدة حدثت في ظروف مختلفة لأوجز الحكاية.
نبتة صغيرة
في مطلع الألفينات كنتُ مدفوعاً بحماسٍ يساري لتلمّس معنى قضايا الحرية والعدالة الاجتماعية في سوريا. شكلت فسحة الأمل التي أسميناها «ربيع دمشق» رافداً مهماً لهذا الحماس، قبل أن يقوم نظام الأسد الابن بإجهاض هذا الربيع سريعاً. على أن اندفاعي هذا كان مُتحرراً من أعباء حمولات إيديولوجية حزبية صادفتها في جلسات زينتها وجوهٌ لرجالٍ متجهمين، جعلتني أنفر من الانضواء في أي من التنظيمات الحزبية آنذاك. كانت القراءة هي وسيلتي الأنجع في توسيع رقعة معارفي في الشأن السوري المُعارض، وهي التي قادتني لمقالات موقعة باسم ياسين الحاج صالح. لكن مَن هذا الياسين الذي يكتب بكل هذا الوضوح، وبكل هذه الجرأة من قلب سوريا؟ مفتوناً بهذه الشجاعة سعيتُ إلى التعرف إليه. أخبرني أصدقاء مشتركون سيرة ياسين وشريكته سميرة. الزوجان المتحابان كانا معتقلين سياسيين. أمضت سميرة 4 أعوام في السجن، فيما كان نصيب ياسين 16 عاماً كاملة، كلاهما بتهمة الانتماء لتنظيمات يسارية. وبفضل الأصدقاء أيضاً، تم الاتفاق على أن أزور ياسين وسميرة في بيتهما في ضاحية قدسيا، كان هذا في ربيع العام 2003. متهيباً ذلك اليوم من ذلك اللقاء التعارفي، قررتُ أني لن أذهب فارغ اليدين، فكان أن اشتريتُ نبتة «مونستيرا» في أصيص صغير. كان هذا غريباً ومُرتجلاً بحق نظراً لجهلي المطبق بالنباتات ورعونتي في التعامل معها. ورغم أني أمضيتُ اليوم الذي سبق اللقاء أذكر نفسي بضرورة الامتناع عن توجيه أي سؤالٍ عن السجن لكليهما، إلا أني فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً. لا أعزو فشلي لخرقي وحماسي آنذاك فقط، وإنما لكل ذلك الدفء الذي أحاطني به ياسين وسميرة اللذان أشعراني، أنا الفتى، بأني صديقٌ قديم يتجدد اللقاء به بعد انقطاع. كرم ضيافة سميرة لا يماثله سوى دماثتها المترافقة بابتسامة لا تخلو من خجل لكنها تغمرك كسحابة من الطيبة. انصرفت من ذلك المنزل الصغير يومها بأفكارٍ كبيرة. فيما بعد سأعرفُ من ياسين كم تركت هذه النبتة الصغيرة من أثرٍ طيبٍ لدى سميرة في حينه، وكيف ارتبط ذكري فيما بعد بها. يغمرني سرورٌ يصعب وصفه كلما تذكرتُ هذا.
كملاكٍ حارس
في 13 حزيران 2011 قرب جامع الحسن في حي الميدان بدمشق، فض الأمن بالعنف ما عرف يومها بمظاهرة المثقفين، وهو اسم لم أستسغه يوماً. تشتّت شملُنا في الشوارع الفرعية للحي. مستجمعاً أنفاسي محاولاً أن أعرف من تم اعتقاله من الأصدقاء ومن نجى، تظهر لي سميرة رفقة اثنين من الأصدقاء مبتسمةً وهادئة كملاكٍ حارس. أعرفُ حينها أنها أيضاً كانت في المظاهرة، وهي الآن تحاول الاطمئنان على الجميع. غادرتني بعد حديثٍ مقتضب وبعد أن تأكدت أني سأبتعدُ مسرعاً عن الحي. كان هذا لقائي الأخير بسميرة.
تهويدة
منتصف آب 2013 مساءً في بيت أهل ياسين في الرقة حيث كان مُتخفياً. كنتُ أتردد عليه هناك بعد أن أنهي ساعات ورشة عمل التدريب المسرحي التي كنت أقوم بها في الرقة مع مجموعة صبايا وشباب سيقتل بعضهم بقصفٍ لقوات النظام لاحقاً، فيما سيخطف الدواعش بعضهم الآخر فلا نعرف عنهم شيئاً حتى اليوم، فيما توزع من نجى منهم في الشتات. جلستُ في عمق غرفة الصالون التي كانت تنقسم إلى غرفتين مفتوحتين على بعض. في الطرف الآخر كان ياسين ينهي مكالمةً عبر السكايب مع سميرة. كنتُ منهكاً ذلك المساء بعد يومٍ حار جداً، وما زاد الطين بلة أني التهمت وجبة كبيرة من الكباب الديري بعد انتهاء ورشة العمل. وأنا أرتشف الشاي بانتظار ياسين، أغمضتُ عيوني وأنا أسمع ياسين و«سمور» كما يحلو له أن يناديها، يتوادعان وهي تضحك. كم وددتُ لو تطول تلك المكالمة حينها. كانت مغالبة النعاس شاقة على تلك الأريكة المريحة وصوت ياسين وضحكات سمور ينسابان كالتهويدة من بعيد. كانت تلك آخر مرة أسمع فيها صوت سميرة. غادرتُ الرقة بعدها بيومين دون أن أعلم حينها أنها ستكون المرة الأخيرة التي ستطأ فيها قدمي سوريا. في قلبي حنينٌ شجي لتلك الأمسية ولتلك التهويدة.
سميرة
حكاية سميرة، قبل الثورة وخلالها وبعدها، تكثيفٌ لحكاية بلدٍ اسمه سوريا. فصّل شريكها ياسين ذلك في عديد المرات التي كتب فيها عنها وإليها، ومنها مقاله «سميرة وسوريا»، وهو فصلٌ في كتاب «سميرة الخليل يوميات الحصار في دوما 2013». ولأننا محرومون اليوم من معرفة مصير سميرة ورفاقها المختطفين، ومحرومون أيضاً من إحقاق العدالة في أي بقعة من سوريا، تجتاحنا موجاتٌ من اليأس والشك بكل شيء؛ تهددنا المرارة بأن تتحول لقوتنا اليومي. لكننا نتذكر حكاية سميرة ورفاقها، ونتذكر حكايات أخرى لسوريين مُغيّبين وآخرين قضوا في السجون أو تحت القصف. نتذكر كل هذا الكرم والشجاعة والنبل في هذه الحكايات، ونعلم أن الهزيمة الماحقة تكون فقط إنْ تحولنا لضحايا مريرين. ما زلنا قادرين على التذكر والروي، وما زلنا قادرين على التفكير، وعلى اللجوء حتى إلى الخيال لتصور أوضاع تصون كرامتنا وكرامة المغيبين والراحلين منا. هذا ما فعلته سميرة على الدوام. تكتب سميرة مثلاً في أحد تدويناتها من قلب دوما المحاصرة: «عم فكر لو علّت الطيارة وكان بالغيمة مغناطيس يبلعها قبل ما تبلع حياة من في الأرض». رغم إصرارها على توثيق أهوال الحصار والمجازر في الغوطة، رفضت سميرة في تدويناتها الاستسلام للغةٍ مريرة وساخطة، بل مزجت هذا بإصرار على التفاؤل، وطعّمته بالتهكم وخفة الدم أيضاً، وبإطلاق العنان للفكر والمُخيلة القادرين على اختراق أعتى حصار.
منذ حوالي السنتين بدأتُ، وعلى غير العادة، باقتناء نباتاتٍ منزلية والاهتمام بها بحرصٍ شديد. لم أستطع تفسير هذا التحول الغريب الذي طرأ علي! قالت لي صديقةُ عزيزة ممازحةً بأن هذه علائم بلوغ رجل أعزب سن الأربعين. ربما هي محقة! لكن ما لم أخبرها به، بأنني أطلقُ اسماً على كل نبتة بعد شهورٍ من العِشْرة، وبأنني أتكلم معهم أحياناً عندما أسقيهم، وذلك بناءً على وصيةٍ قرأتها في أحد المواقع المُتخصصة. ومع قدوم فصل الشتاء الطويل والقاتم في برلين، أدخلُ في قلقٍ مديد على صحة النباتات وحياتها. إحدى هذه النبتات شبيهة بنبتة المونستيرا التي أهديتها لسميرة وياسين منذ قرابة العشرين عاماً. من بين شقيقاتها، يبدو لي أن هذه النبتة ذات روح مقاتلة ولن تستسلم لظلام الشتاء الطويل. لم يكن من باب المصادفة أني أناديها سميرة.