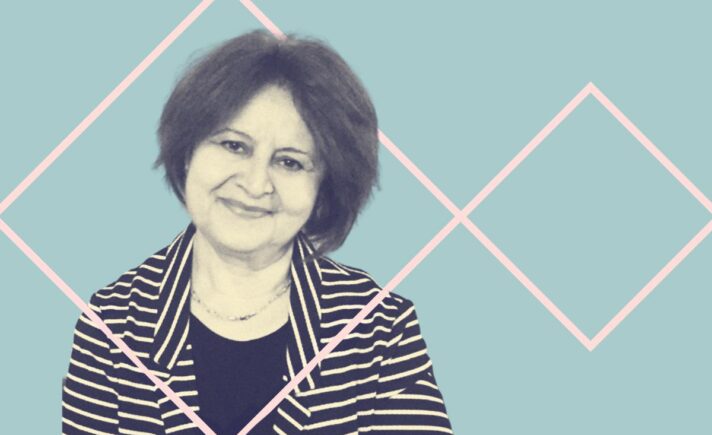أين كنت في آذار 2011 يا علياء، وأين أودت بك دروب الثورة والحرب؟
كنت حينها أعمل مرشدةً في مدارس وكالة الغوث (الأونروا) في مخيمات دمشق وريفها، بعد أن عايشت قبلها المخيمات الفلسطينية في حمص واللاذقية وحلب. وكنت بدأت للتو تدريباً إقليمياً مع معهد جنيف لحقوق الإنسان حول آليات تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. اهتممت مبكراً بالقراءات السياسية، لكني ومع تقديري للتجارب السياسية الشجاعة لكثير من الصديقات والأصدقاء، اتخذت قراراً بعدم الانضمام لأي تنظيم سياسي، لقناعتي بأن الانتماءات السياسية لا بدّ أن تقيّد أصحابها وتأسرهم في إيديولوجياتها. هكذا لم أنتمِ لأي حزب، عدا التنظيم الإجباري في حزب البعث، كغالبية طلاب المدارس الإعدادية والثانوية المُنَسّبين إليه بصورة آلية هزلية. وحين أردت الدراسة في المعهد العالي للعلوم السياسية، علمتُ أني فُصلت منه لعدم حضور الاجتماعات أو دفع الاشتراكات، وكان لزاماً علي إحضار وثيقة تثبت انتمائي للحزب، إذ لم يكن يُسمَح لغير أعضائه بالدراسة في المعهد، وهو ما دفعني غير آسفة للتخلي عن تلك الدراسة.
عشيّة الثورة، وُلد طفلي الأول، وبدأ يكبر على أصوات الصديقات والأصدقاء الذين كانوا يقصدون بيتنا بعد المظاهرات مفعمين بالأمل والحياة. لم أستطع المشاركة بالمظاهرات، لظروف الولادة أولاً، ثم بسبب العنف الوحشي الذي انتشر لاحقاً وقتل آمالنا جميعاً، وقُتل بعضاً من خيرة الأصدقاء، كما اعتُقل آخرون وأخريات أو أُخفيوا قسرياً. الثورة بحد ذاتها أُخفيت قسرياً، لتحلّ الحرب محلّها مدمرةً كل الآمال والأحلام، ومودية بالبلد وناسها نحو الكارثة.
كيف صرتِ نسوية؟ هل كان ذلك تمرداً باكراً على ظروف شخصية عانيت منها كأنثى، أم وعياً عميقاً نشأ تدريجياً مع سنوات الدراسة والاكتشاف، ووجد فرصته مع رياح التغيير التي هبّت مع الثورة؟
أعتقد أنني من النساء اللواتي أسمّيهن نسويات بالفطرة، فأنا أؤمن أن هناك استعداداً فطرياً لدى الإنسان للسير في طريق يتوافق مع شخصيته. في مرحلة الطفولة يطرح الأطفال عادة أسئلة وجودية وفلسفية كبرى، على بساطتها، وبالنسبة لي كانت أسئلتي الطفولية ذات طابع نسوي فطري، فهي حساسة تجاه وعيي بذاتي كأنثى، وتجاه التمييز ضدّي وضدّ بنات جنسي في المجتمع الذي أعيش فيه. لم تقنعني الأجوبة التي برّرتْ تفضيل الرجل على المرأة، أو التي تحاول تجميل الأقفاص والأقفال التي تحبس النساء داخلها. قرأت كثيراً، وما زلت أقرأ، شاهدت الكثير من الأفلام، عشت كثيراً من التجارب، رافقت نساءً كثيرات وتوغّلت معهن في تجاربهن. كل هذا ساهم في بلورة رؤيتي النسوية الثورية الخاصة، وكان ذلك قبل الثورة. أما بعدها، وعلى ضوء التجارب التي خضتها وخاضتها النساء من حولي، أصبحتُ أميل نحو مواقف ذات طابع تحليلي ونقدي، وازداد يقيني بأن الثورة النسوية ينبغي ألا تكون مجرد انفعال عابر، أو شعارات رنّانة وجمل جاهزة مكرّرة، بل يجب أن تكون معرفية بالدرجة الأولى، ونقدية طبعاً، كي تستمر وتطوّر نفسها، وتبلغ أهدافها أيضاً، وهو ما يتطلّب السير بخطوات منهجية ومنظّمة، وتشبيك جهود المهتمات والمهتمين بالقضية النسوية، بغض النظر عن النوع الاجتماعي.
في كتابكِ واقع المرأة السورية في الأزمة الراهنة (2014) حاولت الإجابة على سؤال ما إذا كان انخراط المرأة السورية في الأزمة، موالاة أو معارضة، يشكل معبراً إلى إنجاز حقوقها أم أنه يزيد من معاناتها؟ إلى ماذا توصلت في بحثك؟ وهل لاحظت فرقاً في وضع المرأة الموالية والمعارضة؟ وكيف تقيّمين استنتاجاتك حالياً على ضوء الامتداد الزمني الطويل للأزمة والهزائم التي تكبدتها جميع الأطراف؟
ميّزت في بحثي بين نوعين أساسيين من مشاركة النساء في الثورة والحراك الحاصل: مشاركة باردة اقتصرت على اتخاذ مواقف شخصية بعيدة عن السلوك الفعلي الملموس في الفضاء العام، حيث وقفت سوريات كثيرات مع الحراك أو ضده من منطلقات مختلفة، وقوفاً مع الثورة وتمرداً على السلطة الأبوية المتحكمة بهن، أو ضدّها في تماهٍ مع السلطة ورضوخ لها والخوف من قدوم سلطات أكثر تسلطاً وذكورية تسحب منهن مكتسباتهن على ضآلتها. والنوع الثاني تمثّل في مشاركة إيجابية فعّالة وجريئة، عُبّر عنهما أيضاً عند كلا الطرفين، المؤيدات والمعارضات، فنهجت نساء كثيرات أساليب مختلفة للتعبير عن انتماءاتهن السياسية. ورغم المخاطر الكثيرة، شاركت النساء المعارضات في المظاهرات المندّدة بالنظام، وتحمّلن نتائج هذه المشاركة على صعوبتها. وتحدّت كثيرات القيمَ الذكورية للمجتمع، وثُرن عليها بشجاعة كبيرة. وبالرغم من تحول الثورة إلى الأسلمة والعسكرة، والأثر السلبي لهذا التحول على مشاركة النساء، والحد من إمكانية تواجدهن في فضاءات كثيرة، إلا أن ذلك لم يمنعهن من إبداع أشكال مشاركة أخرى لاعنفية يعبرن فيها عن آرائهن.
أرى أن النساء، على الجانبين، عانينَ من هيمنة العقلية الذكورية التي اختلفت وطأتها شدّة أو ضعفاً تبعاً لعوامل متعددة. بعض النساء تماهين مع هذه العقلية وتصالحن معها بل وكرّسنها في خطاباتهن سواء كنّ مؤيدات أو معارضات، وبعضهن الآخر، وهنا أقصد الثائرات غالباً، وقفن في وجه العقليات الذكورية أينما كانت، وحاربن ومازلن يحاربن من أجل حقوقهن وحقوق النساء عموماً.
توصّل البحث إلى أن نماذج مشاركة النساء على اختلافها، غيرت في المشهد العام وتحولت من مشاركة صورية معتادة قبل الثورة، إلى مشاركة عملية جسورة متعدّدة الأوجه بعدها. بل إن هذه المشاركة غدت بالفعل نقطة تحول ينبغي التمسك بها والانطلاق منها لتحظى المرأة بحقوقها وحريتها واستقلالها.
بالتالي، رغم تطاول المدّة، ورغم الهزائم التي تكبدتها جميع الأطراف، وفي ظل ركود العملية السياسية وغياب الإرادة الدولية لإيجاد حل سياسي حقيقي يضمن عدالة انتقالية، إلا أن الوقائع أكّدت جانباً من استناجات البحث بشأن خلخلة المعايير، وتمكّن النساء من التقدّم وإثبات أنفسهنّ وقدرتهنّ على الفعل السياسي والمجتمعي، ومن ثمّ ضرورة وجودهنّ في مواقع القرار، وإثبات هذا الوجود والدفاع عنه والإصرار عليه من موقع نسوي، ليشكل نقطة ارتكاز في الدفاع عن مكتسبات النساء ما قبل الحراك، والنضال من أجل الحفاظ عليها واستكمال بقية الحقوق غير المنجزة، وإن بدا الأمل ضعيفاً في ظل الظروف الدولية الراهنة.
تعملين مدرِّبةً حول الاتفاقيات والعهود العالمية التي تتناول حقوق المرأة. ولكن هناك جدل حول اتفاقيات حقوق الإنسان بالعموم، وبخاصة تلك التي تتناول حقوق المرأة، حيث أن البعض يرى أنها لا تتناسب مع خصوصيتنا الثقافية الإسلامية. ماذا يعني ذلك؟ وهل ترين أن تلك الاتفاقيات تتعارض في بعض وجوهها مع تاريخنا وثقافتنا وطموحنا؟ وإذا كان جوابك سلباً، فمن أين جاء ذلك اللغط إذن؟ وما هي الطريقة المجدية بالتعامل معه؟
لا أجد أن مصطلح «الخصوصية الثقافية الإسلامية» دقيق، وإن دُرج على تداوله حجةً هزيلةً لرفض أي طروحات تناهض الهيمنة والممارسات الذكورية، فما يمكن اعتباره خصوصية ثقافية، يمتد ليشمل جوانب لا تعد ولا تحصى ولا يمكن حصرها بالدين فقط. على سبيل المثال «الخصوصية الثقافية الإسلامية» في إندونيسيا لا تتشابه مع المسمى نفسه في المغرب العربي، وهذه لا تشبه «الخصوصية الثقافية الإسلامية» في بلاد الشام، وحتى في البلد الواحد تختلف هذه الثقافة (والخصوصية) من منطقة إلى أخرى.
والتعاليم الدينية الإسلامية يتم تفسيرها وممارستها وفقاً لمذاهب متعددة، تختلف اختلافات جوهرية في نقاط كثيرة تؤدي إلى وجود خصوصيات ثقافية متعددة جميعها تحمل صفة «الإسلامية». غير أن الأمر المشترك بين كل هذه الاختلافات هو الاتفاق على تقييد حرية النساء، وتبعيتهن للرجل. التحرر من الهيمنة الذكورية عبر تفعيل الاتفاقيات الدولية خصوصاً المتعلّقة بالنساء، هو ما يحاربه سدنة الأديان (الإسلام وغيره) بذريعة ما يُسمّى «الخصوصية الثقافية» .
هذه الاتفاقيات تناهض صراحةً ودون مواربة العنف الموروث تاريخياً، والذي تحميه وتكرسه «الثقافات» في المجتمعات، ومن هنا جاء رفضها. ورغم أن كثيرين من مناهضي هذه الاتفاقيات لم يكلّفوا أنفسهم عناء قراءتها، إلا أنه يكفي أن يهاجم أحد رجال الدين أو السلطة اتفاقية ما، لتنحو الجموع نحوه، فترفض وتُدين الاتفاقية وتحاربها، بل تحمّلها ما لا تحتمله، وآخر الأمثلة قرار السلطات التركية بالانسحاب من «اتفاقية اسطنبول» المتعلّقة بحماية النساء من العنف والعنف الأسري، بزعم أنها «تدمّر الأسرة وتشجّع على المثلية» ، ولا نعلم كيف توصّل حكّام تركيا إلى هذا الاستنتاج العجيب!
هناك من يريدون استمرار وبقاء التمييز ضد النساء وقوننة العنف ضدهن لحماية مكتسباتهم التمييزية، والاحتفاظ بالسلطات الممنوحة لهم لمجرد أنهم ذكور في مجتمع يعطيهم درجة أعلى من الإناث، بحجج مستمدة من التراث والتاريخ، أو مستندة إلى الدين والثقافة. التعامل مع هذا الوضع هو مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، عبر سلطتها التشريعية والسياسية. فالدولة القائمة على المواطنة المتساوية والقوانين العادلة تحد من التراتبية الهرمية التي تكرسها بقية السلطات الرمزية في المجتمع، وتجعل من تنشئة جيل يؤمن بالمساواة والمواطَنة ويتمثّلهما في وعيه وسلوكه أمراً ممكناً، وستغدو الاتفاقيات الدولية وتطويرها هدفاً وطموحاً للمجتمع والدولة لضمان حقوق مواطناتها ومواطنيها أينما كانوا.
اشتغلت النسويات في سوريا والمنطقة العربية على إلغاء التحفظات على اتفاقية سيداو في زمن ما قبل الثورات، ولكنهن لم يفلحن بسبب الديكتاتورية التي لا تكترث بشرعة حقوق الإنسان رغم ادعاءاتها بالعلمانية. وما زلنا حتى الآن نسمع أصداء النسويات اللواتي يَدرسنَ ويُدرِّسن تلك الاتفاقيات والعهود. إلى أي مدى ترين أن الشغل على تلك الأدوات القانونية مجدٍ في ظل ضعف الدولة والديمقراطية بالعموم؟ وكيف ينبغي أن يكون الشغل برأيك؟
مع التقدير لجهود النسويات السوريات اللواتي اشتغلن طويلاً، سواء على رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، أو المطالبة بسن قوانين منصفة أو تعديل قوانين جائرة وتمييزية، إلا أن الجهود كانت ضئيلة ومبعثرة، فهي إما فردية أو مقتصرة على مجموعات صغيرة لم تستطع حتى الوصول إلى النساء كفئة مستهدفة، لأسباب عدة أبرزها الأنظمة الدكتاتورية التي طالما عرقلت العمل الحقوقي والإنساني. ولفترة قريبة نسبياً لم يكن هناك وجود على أرض الواقع لحركة نسوية فاعلة في أغلب الدول العربية، وفي سوريا خصوصاً، لذلك لم يكن العمل على تلك الأدوات القانونية ممكناً كما يجب.
أما الآن، ومع التغييرات العميقة التي حصلت بعد الثورة، فالعمل على هذه الأدوات وبطريقة منهجية أصبح ضرورة ملحّة، وإن لم يتغير وضع الديكتاتوريات واستمر منع الحريات، إلا أن الإمكانيات صارت متاحة أكثر للتعريف بالمفاهيم الحقوقية ونشر الوعي وثقافة الحقوق والاتفاقيات وتوضيحها، ورفع اللبس الحاصل بشأنها كخطوة أساسية ومهمة، فضلاً عن كسب الرأي العام وكسب مزيد من المواطنات والمواطنين المؤمنات والمؤمنين بالعدالة والمساواة، لتشكيل قاعدة قوية من الداعمين والمناصرين لقضية المرأة، والتوجه إليهم سواء عن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والوصول إلى شرائح أكبر وأوسع، عدا عن توسيع الإطار البحثي والمعرفي والدراسات الميدانية التي تلعب دوراً في تحديد المشكلات بعمق، وتحليلها بشكل يساهم في المستقبل على حلها. كل هذا جزء من عملية كبيرة متفاعلة لإحداث تغييرات تدريجية مهمة على صعيد الحقوق التي تنادي بها الاتفاقيات.
ما زالت كثير من النظريات والمصطلحات التي اشتغلت عليها النسويات العالميات غير معروفة لدينا. على سبيل المثال، هناك كثير من المتعلمين والمتعلمات ممن لم يسمعوا بالنسوية التقاطعية قبلاً، مما يجعلهم يترددون حول مدى صلاحيتها لمجتمعاتنا. ما هي النسوية التقاطعية؟ وهل هي صالحة للتطبيق ضمن السياق السوري؟ ولماذا برأيك؟
حتى لا نظلم المتعلمات والمتعلمين في مجتمعاتنا، للأمانة يتوجب القول إن كثيراً من المتعلمين في البلاد الأوروبية أيضاً لم يسمعوا بهذه المصطلحات الجديدة أو التخصصية. هذا ما خبرته بنفسي خلال سنوات من الإقامة والعمل في بلد أوروبي متقدّم مثل ألمانيا. أعتقد أن السبب وراء قلة هذه المعرفة هو أن العلم النسوي علم سياسي بالضرورة، والناس في العالم أجمع في صراع يومي من أجل البقاء والخبز اليومي، أو التعامل مع ضغوط يومية من نوع آخر في البلدان المتقدّمة التي تجاوزت شعوبها أزمة التفكير في كيفية تأمين الحاجات الأساسية. كما أن هناك حالة عامة من اللامبالاة أو عدم الاهتمام بما هو خارج حدود وإطار المصالح الشخصية، فضلاً عن الخوف من كل جديد وعدم الرغبة بالتعلم واكتشاف طرق حياة مختلفة، وهذا ما يدفع كثيرين لرفض أي شيء جديد سواء النسوية التقاطعية أو غيرها.
يُنسَب مصطلح التقاطعية للمحامية الأميركية من أصول أفريقية كرمبلي كرينشو في مقالتها «التقاطع بين التمييزين العرقي والجنسي: قراءة نقدية لعقيدة مناهضة التمييز والنظرية النسوية وسياسات مناهضة التمييز على أساس العرق من وجهة نظر النسويات السود» المنشورة عام 1989. حيث حاولت الكاتبة، في سياق الدفاع عن النساء السوداوات في وجه التمييز القائم على العرق والجندر ضدّهن، أن توضح أن تقاطعات التمييز والعنف التي يتعرضن لها في آن واحد تولد عنفاً وتمييزاً جديداً لا يعالج بشكل صحيح، مما يجعل قضايا النساء السود مغفلة في قائمة المطالب الحقوقية للحركات التي تدّعي الدفاع عنهن. فعند المطالبة بحقوق النساء، تكون قضايا النساء البيض هي المعيار، وعند الوقوف على قضايا العنصرية، تكون قضايا الرجال السود هي المعيار، الأمر الذي جعل من مشكلات النساء السود وقضاياهن مهمشة وغير مرئية.
هذا ما نظّرت له كرينشو في مقالها وعملت على شرحه مستكملة التاريخ الأساسي لظهور المصطلح، والذي نشأ بسبب النزاعٍ القائم بين الحركات النسوية التي انقسمت إلى تيارين أساسيين بشكل واضح: الأول يمثل ما اصطُلح على تسميته «النسوية البيضاء» التي تهدف للحصول على مزيد من القوة والسلطة للنساء الحاصلات أساساً على مكتسبات محددة، لكنهن يسعين لزيادتها، ويُطلق عليهن اسم «نساء النخبة»؛ والتيار الآخر جمع التيارات النسوية المناهضة للمنظومة البطريركية الأبوية والعلاقات التراتبية الهرمية الناتجة عنها، مثل النسوية المناهضة للاستعمار، والنسوية السوداء، والنسوية البيئية.. إلخ، والتي ترزح مناضلاتها عموماً تحت ضغوط أكبر وأشد من نظيراتهن في الجهة المقابلة. وتطور هذا النزاع ليصبح انشقاقاً في الحركة النسوية، فمطالب نساء النخبة وآليات نضالهن لم تنسجم مع احتياجات النساء الأقل حظاً، واللواتي تجاهلتهن الحركة النسوية التي هيمنت عليها نساء النخبة آنذاك. هكذا جاء المنهج التقاطعي ليسلّط الضوء على الأهمية التحليلية للعلائقية، وكيف أن المواقف الاجتماعية المختلفة التي يشغلها الفاعلون والأنظمة والترتيبات الهيكلية السياسية والاقتصادية، تكتسب المعنى والقوة (أو لا تكتسبهما) من علاقتها المتداخلة مع المواقف الاجتماعية الأخرى. وتفترض كرينشو أن الجهود الحقيقية لتحرير السود من قيود وظروف التبعية العرقية لا بد أن تشمل تحليلاً للعنصرية الجنسية والأبوية، وتطالب بأن تشمل النسوية تحليلاً للعرق إن أرادت التعبير عن مطالب النساء غير البيضاوات. وإن ممارسة كلا الحركتين يجب أن تتركز على الفرص والظروف المعيشية للناس المهمشين الذين يجب تسليط الضوء على قضاياهم.
هذا ما يقدمه المنهج التقاطعي بوصفه منهجاً نقدياً وتحليلياً لا يقتصر على الأوضاع التي انطلقت منها كرينشو، وإنما يتيح التعمق في كافة المجالات التي ينشأ عنها التمييز المركب والمتقاطع، وبالتالي يركّز على التجارب الإنسانية المختلفة، خاصة للفئات المهمشة والأكثر تعرضاً للتمييز. ومن هذا المنطلق أجده قابلاً للتطبيق في السياق السوري، الذي يحمل في طياته تنوعاً هوياتياً كبيراً، كان له تأثير عميق في ظهور أشكال مركّبة ومتقاطعة من التمييز والعنف. بالتالي، فإن تحليل هذه الهويات وعلاقاتها المتبادلة وعلاقاتها بمراكز القوة، بالاستناد إلى الموشور التقاطعي، يساعد على فهم أدق وأعمق لأوضاع النساء داخل هذه الهويات وتأثرهن بالصراعات الحالية في سوريا، ويساهم في رسم السياسات المستقبلية على نحو أكثر عدالة ومساواة. على سبيل المثال، يساهم المنهج التقاطعي في تحليل أعمق لحالة النساء السوريات اللاجئات، اللواتي يتعرضن لأشكال متقاطعة من التمييز والعنف وفقاً لتموضعهن في مواقع تهميش أو امتياز، حسب انتماءاتهن المختلفة (العرق، والطبقة الاجتماعية، والدين، والأصل القومي، والإعاقة، والمستوى التعليمي، والتوجه الجنسي) التي تجتمع لتشكّل تجربة اضطهاد فريدة لكل امرأة.
ودراسة أوضاع النساء اللاجئات من منظور تقاطعي، يساعد في تحليل البنى البطريركية التي يعانين من اضطهادها، الأمر الذي يساهم في تفكيكها، ويساهم في تحديد الاحتياجات بشكل أكثر دقّة وملائمة لاحتياجاتهنّ الفعلية، ويساعد أيضاً على انتماء النساء للحركة النسوية عن طريق تمثّل مطالبهن الخاصة، وطموحاتهن بدون التعالي عليهن ووضعهن ضمن قوالب نمطية مسبقة. وقد أجريتُ مؤخراً بحثاً حول النسوية التقاطعية في السياق السوري ضمن ملف النسوية في مجلة قلمون، آملة أن يشكل نواة أو مدخلاً للدراسات النسوية التقاطعية في السياق السوري.
ها نحن – أنا وأنتِ – منشغلتان بالتنظير بطريقة ما، ولكن سوف يأتي دائماً من يقول إن كل هذا مجرد حبر على ورق أمام الوضع المأساوي الذي يعيشه السوريين والسوريات. برأيك، هل تصمد النظرية النسوية أمام الجوع والبرد والدمار؟
شخصياً لا أكتفي بالتنظير، فإلى جانب الكتابة والبحث، أتواصل بشكل دائم مع النساء، ساعيةً قدر الإمكان إلى ربط الأفكار النظرية بالواقع العملي واختبارها في ضوء معطياته. بحكم اهتمامي البحثي شخصياً وطبيعة عملي في منظمة الداميغرا، ومن خلال قنوات أخرى سورية وغيرها، أعمل على تحليل أوضاع النساء، وقياس احتياجاتهن وبناء البرامج والأنشطة التي تلبيها بالشكل الأفضل قدر الإمكان، وقياس مدى التغيرات الطارئة عليهن في السياقات التي نعمل عليها، مع التأكيد على ضرورة مشاركة النساء أنفسهن في هذه الخطوات.
ومن خلال تجربتي العملية ومعايشتي اليومية لقضايا النساء السوريات المهاجرات واللاجئات، يمكنني القول إن هناك تقدماً بطيئاً يحرز في مجال الوعي بحقوق المرأة وانعكاس هذا الوعي على طرائق حياة السوريين والسوريات وخياراتهمن، لكن هذا لحد الآن يحدث فقط في ألمانيا وأوروبا، وفي ظروف لا تقارن بما يحدث في سوريا، هناك حيث لن تصمد أي نظرية سياسية أو فلسفية أو اجتماعية أمام الجوع والبرد والدمار والدكتاتورية والقمع أيضاً، فما بالك بالنظرية النسوية التي ما يزال الاختلاف عليها قائماً بحدة. لكن الفرصة لتغيير هذه الظروف تظل قائمة في حال تغير هذا الواقع بتغير الظروف السياسية بالدرجة الأولى، عندها يمكن أن نفكر في مستقبل النظريات على الأراضي السورية التي تزداد حالياً بؤساً ومأساة للأسف.
تعملين مع اللاجئات السوريات في منظمة داميغرا الألمانية. كيف هو وضع اللاجئة السورية في ألمانيا بالعموم؟ وكيف هو تجاوبها مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على حياتها؟ وهل بدأت تسترد توازنها وتقدر على مواجهة متطلبات الحياة الجديدة؟ وما هي أكبر التحديات التي تواجهها برأيك؟
لاشك أن اختلاف الظروف القانونية، والمناخ الأكثر حرية – نسبياً – في البلد المضيف انعكس إيجاباً ولو بشكل طفيف على النساء السوريات. لكن لا يمكن الجزم أن التغيرات كانت إيجابية على الجميع بالمستوى نفسه، فالنظر إلى اللاجئات وكأنهن كتلة واحدة متجانسة ومتشابهة أمر لا يبخسهن حقهن وحسب، بل يكرّس ما تروج له النظرة الاستشراقية المتجددة بطرق مختلفة، التي تتجاهل أن لكل امرأة ظروفها المختلفة، وليس كما تصوّره الصور النمطية في الإعلام أو في البرامج المخصصة لدعم اللاجئات، وهو ما تسعى منظمة داميغرا إلى مواجهته، فتعمل وفق مقاربات مختلفة للقضايا من خلال تبنّيها المنهج التقاطعي.
هناك نساء استطعن شق طريق جديد لحياتهن على جميع الصعد، وحققن إنجازات كبيرة في فترة قياسية، فاستعدن ذواتهن، وطورنها، واتخذن قرارات شجاعة في حياتهن. إلا أن كثيرات من هذه الفئة، واجهن مشكلة التنميط ومحاولات الأَسْر ضمن نطاق النظرة المسبقة والسلبية الرائجة عن اللاجئات، وهذا ما يسبب لهن تحديات جديدة مختلفة لا يمكن تمييزها بسهولة أو حتى تسميتها وتفسيرها. وفي المقابل ازدادت الصعوبات والتحديات في وجه نساء أخريات، نتيجة التغيرات الجديدة، فمنهنّ من عاشت تجارب عنصرية قاسية، ومنهن من واجهت تمييزاً هيكلياً وقانونياً. فألمانيا بلد يعترف فيه المسؤولون أنفسهم بمشكلة العنصرية ورفض الأجانب، وتتعرض اللاجئات السوريات بلونهن المختلف وثقافتهن الغريبة عن هذا المجتمع لأنواع مختلفة من التمييز، إلى جانب كونهن أسيرات الثقافة المجتمعية الذكورية التي هاجرت معهن من سوريا. ذلك أن العقليات الذكورية ما زالت مهيمنة على المشهد العام في مجتمعات اللجوء، والوصمات نفسها تلاحق النساء في خياراتهن.
على سبيل المثال، يشاع كثيراً حول ازدياد نسبة النساء السوريات اللواتي طالبن بالطلاق في أوروبا، رغم أنه لا وجود لإحصائيات رسمية تثبت هذه الفرضية، بل إن العاملات والعاملين بشكل مباشر مع اللاجئات، يعرفون أن كثيرات يخشين ويرفضن طلب الطلاق رغم تعرضهن لجميع أشكال العنف المنزلي، خوفاً من الوصمة والتبعات الاجتماعية، فيتحملن مزيداً من العنف بصمت وسط دهشة المراقبين والمختصين الاجتماعين الذين يتابعون مثل هذه القضايا بشكل قانوني. أعتقد أن التحديات ما تزال كبيرة جداً قبل أن تستطيع اللاجئات فعلاً الخروج من الصدمات المتلاحقة التي عشنها ويعشنها يومياً في المجتمع الجديد.
هناك من يؤمن أن سوريا المستقبل سوف تبنى على جهود النساء اللواتي سوف يكن قادرات على إخراج البلاد من مستنقع العنف والحرب والاقتتال مع الوقت، ويكن المبادرات في تعبيد الطريق نحو إعادة إعمار تبدأ من الشارع واحتياجات الإنسان. هل أنت متفائلة بهذا الخصوص؟ وماذا ينبغي علينا، كنساء ونسويات، فعله أو تركه من أجل أن تتحقق تلك النبوءة؟
ردّدتُ طويلاً أن النساء الشجاعات يصنعن المستقبل، ولكن الآن وفي ظل الوضع المأساوي على الصعيد السوري، وعلى صعيد السياسات العالمية المتواطئة مع الإجرام ضمنياً أو على المكشوف، أعتقد أن هذه المقولة تحمّل النساء فوق طاقاتهن التي يستمر تقييدها أصلاً وإعاقتها بكافة الأشكال وعلى جميع الصعد. إخراج البلاد من مستنقع مخيف كهذا مسؤولية الجميع على الإطلاق، وليست مسؤولية منوطة بالنساء وحدهن، على أهمّية وأولوية دورهن. في الوقت الحالي لست متفائلة أبداً، فلا وجود لإرادة سياسية دولية تدعم إيقاف العنف، بل إننا نشهد عكس ذلك، كالتطبيع مع النظام الذي ارتكب انتهاكات موثقة وجرائم ضد الإنسانية، وتعويمه في أروقة المحافل الدولية.
مع هذا، لا أجد بداً من ضرورة المقاومة بالمعرفة والفكر والثقافة الحقوقية، لأن للوعي دوراً حاسماً على المدى المستقبلي، ويتوجب على جميع المؤمنات والمؤمنين بحقوق الإنسان، حقيقةً وليس ادّعاءً واسترزاقاً، أن يحرصوا على تنظيم أنفسهم والتضامن معاً في مواجهة كلّ هذا الخراب، بطرق سلمية ومن منظور مختلف، بعيداً عن منطق الغلبة والقوة الذكوري، إلى آفاق إنسانية أرحب وأكثر تنوّعاً، يشكّل الفكر النسوي أحد مداخلها الممكنة.