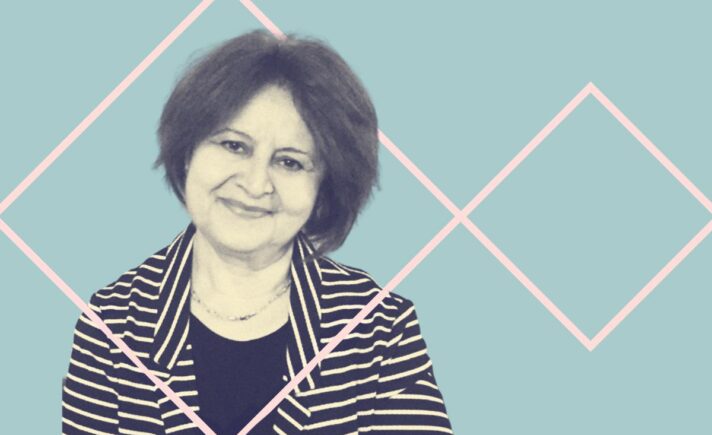أين كنتِ في 2011 يا بيان، وماذا كنتِ تعملين؟
كنت طالبة جغرافيا سنة ثالثة، ولا أحب فرعي التخصصي إلى درجة امتنعتُ معها عن الذهاب إلى الامتحانات. كنت أفكر جدياً بترك الفرع. إلى جانب دراستي الجامعية، كنت أعمل في الثانوية الشرعية في دوما كمدرّسة في مادتَي التاريخ والجغرافيا. كانت هذه أول مرة أكسب فيها مالاً بنفسي، مما منحني إحساساً رائعاً. وقد كنت في الوقت ذاته ملتزمة مع القبيسيات، اللواتي قضيت معهن أغلب أوقات حياتي ونشاطاتي. كما تطوعت بالجمعية الخيرية في دوما ضمن مشروع أسستُه مع آنستي القبيسية ورفيقتين أُخريَين، وهو مركز التعلم المجتمعي الذي كان يدرّس أطفال مدينة دوما الفقراء. كانت حياتي في تلك الفترة مكرسة ما بين المدرسة والجامعة والتحصيل العلمي الديني خلال أيام الأسبوع، وفي المركز التطوعي والعائلة الكبيرة أيام العطل، فأنا اجتماعية جداً وأحب اللقاءات العائلية ومع الأصدقاء.
في تلك الفترة بدأ انتشار النت، فترددت على المركز الثقافي وصرت أشتري بطاقات، وأدخل على المنتديات وأقرأ آخر الأخبار. ومع بداية الربيع العربي، انتشر برنامج ويندوز لايف مسنجر، وبدأت أتكلم مع صديقة المدرسة نور، التي سوف ترافقني في جميع مراحل الثورة وتشاركني حبي الشديد للتغيير وكرهي للواقع. كنت أنتظر اللحظة التي سوف نبدأ فيها في سوريا. كنت متحمسة جداً، ولكن والدي كان متشائماً من واقعنا، وأمي هي صاحبة الأثر الأكبر بحياتي. كانت أمي لا تكفّ عن الدفاع عني أمام المجتمع، وتدعمني في كل قراراتي، وتزرع في داخلي حب الخير للناس، وتحثني كي أرفع صوتي ضد الظلم.
انتسبتِ في سن صغيرة إلى تنظيم القبيسيات، حتى أنك كنتِ من بين المتميزات ووصلتِ إلى مراتب عالية معهن. هل كانت القبيسيات يجتهدن في صياغة تشريعات أكثر عدلاً للنساء، أم كنّ يستهلكن الدين كما ورد عن الذكور في حلقات نسائية تكرّس نفسها لخدمته؟ وهل تؤمن القبيسيات بدور المرأة في الاجتهاد؟
القبيسيات ينقسمن إلى أفرع. الحاجّة الكبيرة هي منيرة القبيسي، وتحتها مجموعة من الآنسات. وكل آنسة تتميز عن الأخرى بخطها التي تتبعه مع طالباتها. أذكر أنه كانت هناك خلافات كبيرة بيننا وبين طالبات آنسة ثانية. لدينا مثلاً آنسات تخصَّصنَ بالسيرة النبوية، وألمعُهنّ هي المرحومة الدكتورة سميرة الزايد، التي أعادت كتابة السيرة النبوية من جديد، ويُعتبر كتابها من أفضل ما قُدِّم عن السيرة النبوية. وهناك آنسات انتهجنَ القراءات العشر للقرآن، وأخريات تخصصن بالحديث. أنا من اللواتي ركّزن على التاريخ الإسلامي. كل هذه الدراسات لم يكن هدفها الاجتهاد في التشريعات. فمثلاً الحاجّة درية العيطة ركزت على الفقه الإسلامي، لكن مواضيعها لم تتجاوز أحكام الصلاة والصيام والطهارة والحج. ولم تُتناوَل أحكام فقهية جوهرية تخص وضع المرأة، بل اعتُمِد الفقه الذكوري. هناك فقهاء رجال، والقبيسيات تبنَّينَ آرائهم. طبعاً يحصل أحياناً أن نحاول مناقشة تلك الأحكام، وقد نحتجّ على عدم المرونة. بعض الآنسات يتقبلن النقاش، ولكن كان ذلك على الأغلب مرفوضاً. أنا مثلاً كنت أفضل البحث في المذاهب الأخرى، وليس فقط في المذهب الشافعي الذي اعتمدته القبيسيات، لأن ذلك يمنحنا بعض المرونة ويمنع التعصب لرأي إمام واحد. وقد كان لدينا مادة اسمها «الفقه المقارن»، والتي تسمح لطالب العلم التنقل بين المذاهب الأربعة. بالعموم، لم تقم القبيسيات بالاجتهاد، بل كن ينسقنَ مع العلماء الرجال، ولم نكن نناقش الفتاوى بشكل فعلي. لم تكن القبيسيات حركة تدعو إلى العدالة للنساء. كانت لدينا أحكام فقهية وكنا نناقشها دون معارضة.
هل كنتِ تشعرين كامرأة أن الأحكام الدينية لم تنصفكِ بطريقة ما؟
بصراحة لا، والسبب هو أني كنت أحصل على حقي ضمن عائلتي، ولذلك لم أكن أشعر بذلك. ولكن بعدما كبرت وبدأت أخرج عن نطاق عائلتي، صرت أرى الظلم الواقع على النساء في مجتمعاتنا. وهنا بدأ تفكيري يتغير. أنا واثقة أن الله سبحانه وتعالى ليس ظالماً، ولن يرسل شريعة ظالمة لأحد. تكمن المشكلة في تفسير كلام الله من قِبَل من لم يفهم حكمته.
هل كانت القبيسيات يتوخَّينَ فعلاً إعداد نساء قويات يقدمن شيئاً جديداً للمجتمع السوري؟ وما هو ذلك الشيء؟
لعل القبيسيات من أوائل من تبنى فكرة برنامج إعداد القادة والبرمجة اللغوية العصبية في الوطن العربي. كانت القبيسيات يطمحن إلى تغيير المجتمع عبر تغيير النساء وبناء تحالف قوي فيما بينهن. إذا صنفناهنّ كتيار سياسي، يمكننا القول إنهنّ نجحن في فترة من الفترات في بناء قاعدة شعبية كبيرة وكسبنَ ثقة الناس. كما انتشرن في دول الجوار، وحتى في دول أوروبية وأميركا.
ما هو هدفهنّ؟ تديّن المجتمع فقط؟
التدين هو مرحلة. حين تتغير المرأة، سوف تغير أولادها وزوجها وعائلتها، إلى أن نصل في آخر المطاف إلى إعادة بناء دولة إسلامية. حتى ولو كانت القبيسيات لا يصرحن أبداً أن لهنّ علاقة بالسياسة، ويرفضن التدخل فيها، ولكن ليس هدفهن فقط إدخال الناس الجنة. طبعاً سيحتجن إلى عقود من الزمن حتى يحققن أهدافهن، ولكن حين يسيطرن على الأعداد الكبيرة التي انضمت إليهن، سيصبحن قادرات على التغيير. ومن عاش فترة التسعينات والألفينات في دمشق وريف دمشق وحمص وحماة، لا بد أنه لاحظ مدى انتشارهن واتساع نفوذهن وتأثيرهن على النساء.
كانت القبيسيات من أنشط الحركات. يخترن دائماً صاحبة الشخصية القيادية، ويعزّزن تلك الصفات فيها، ويسلّمنها مهام قيادية ضمن الجماعة، ويقوّين شخصيتها. يحصل أحياناً تغيير كامل في شخصية المنتسبات. أَدينُ بشخصيتي القيادية للتربية القبيسية التي تلقيتُها. لا بد أني أتمتع بصفات معينة اشتغلتُ عليها، ولكن تلك التربية منحتني توازناً عاطفياً ونفسياً كبيراً. كما أني أطلقت جميع الخبرات التي تعلمتُها عند آنساتي القبيسيات في خدمة الثورة السورية.
من الأدوات التي استخدمتها القبيسيات لتمكين أنفسهن العزوف عن الزواج. والفكرة هي أن الزوج والأطفال والبيت سيصادرون جلّ وقت المرأة وجهدها، ولن تتمكن بعد ذلك من تكريس نفسها لدينها. قامت القبيسيات بحل معضلة استعباد المرأة في المنزل عن طريق إلغاء الأسرة وقتل الشهوة. لا أدري لماذا أرى شبهاً بين هذا الحل وما تتوصل إليه بعض النسويات بعد تجربة، وهي المقايضة بين العلاقة الحميمة والإبداع؟ ألا ينطوي ذلك الحل – العملي ظاهرياً – على يأس كبير من إمكانية التعاون مع الرجل؟ وهل فعلاً لا توجد حلول وسط؟
هذا التطرف النسائي واضح، سواء لدى القبيسيات أو حتى بعض النسويات. نجد عزوفاً عن الزواج، وعن العلاقة مع الرجل، واعتباره نداً وليس شريكاً. خلال الفترة الأولى من التِزامي مع القبيسيات، لم أكن أعلم أن لدينا آنسات متزوجات. وكنّ دائماً يقلن لي إني طالبة متميزة، وعلي ألا أتزوج، بل أبقى للدعوة. ولكنهن لا يمانعن زواج الفتيات الأقل تميزاً. الموضوع انتقائي إلى حد ما.
بالنسبة لي، لم أكن أتخيل يوماً أني سوف أقضي عمري من دون زواج وشريك. لا يمكنني أن أعيش دون أن تكون روحي كاملة، لأن الصديق أو الشريك جزء أساسي في كياني كامرأة. لدي حب، وأحتاج أن أمنحه لهذا الرجل. هذه فكرتي منذ كنتُ قبيسية. وحتى الآن كنسوية أرفض ثنائية تجريم المرأة أو تجريم الرجل. ينحو الموضوع أحياناً إلى البدائية في الطرح. حين كنتُ قبيسية، لم تكن الحرب معلنة بشكل صريح، ولا يوجد صوت عالٍ حيال ظلم الرجل. بل على العكس، غالباً تقف القبيسيات مع الرجل ضد المرأة في المشاكل الزوجية.
الزواج لا يمنع الإبداع برأيي. ولكن وقت المرأة المتزوجة لا يكون ملكها مقارنةً مع غير المتزوجة. حين يكون عندك شريك أو أطفال، سيتطلب ذلك منكِ جهداً كبيراً. وحين تكونين حرة، يكون إنجازك أعلى، إلا في حال توفرت لك بيئة تشجع على الإنجاز، كأن يساعد الرجل في أمور البيت مثلاً. هذا ليس متوفراً لجميع النساء. ولذلك كان الضغط على القبيسيات غير المتزوجات كبيراً كي يحرقنَ المراحل وينجزنَ أكبر قدر ممكن، لأنهن لن يتمكّنَّ من ذلك بعد الزواج.
بعد أن عشتِ جواً نسائياً حصرياً مع القبيسيات، اقتحمتِ عالم الرجال بين ليلة وضحاها من خلال اشتراككِ في أول مظاهرة في الثالث من نيسان 2011. وواصلتِ التظاهر رغم توقف النساء بشكل عام، حتى صرتِ واحدة من بين أربع سيدات فقط ممن شاركنَ في آخر مظاهرة عام 2016. كيف حصل هذا الانقلاب الفجائي لديك؟ وماذا تغير حتى تخليت عن تلك القيود؟ وما الذي دعاك إلى الانشقاق عن القبيسيات؟
ما دعاني إلى الانشقاق عن القبيسيات هو الموقف من الثورة السورية. الثورة هي الحد الفاصل في حياتي في كل شيء، ومن بينها علاقتي مع القبيسيات، وبخاصة أن إحداهن حاولت أن تجعلني أتراجع عن انطلاقتي في الثورة، ولكني كنت حادة في جوابي، فسارعت لطعني عند بقية القبيسيات، وسببت لي مشكلة كبيرة أدت إلى اجتماع مع آنساتي. وكان قراري أن يكون ذلك اليوم آخر يوم لي مع القبيسيات.
أنا نفسي لا أدري كيف تمكّنت من الانقلاب. أتكلم الآن بعد مضي عشر سنوات. فعلاً مع أول مظاهرة خرجتُ فيها، انكسر عندي كل شيء. أنا نفسي لا أستوعب من أين جاء الانفجار! ولكن هناك شيء مهم: حين شاركتُ بالثورة، لم تكن ثورتي فقط على الاستبداد السياسي، بل لعل أكثر ما كان يؤلمني هو الفساد والاستبداد الاجتماعي الذي كنا نعيشه. وقد كان هذا محركاً أساسياً للثورة. حين جاءت الثورة، شعرتُ أني تحرّرتُ بالكامل، لم يعد ثمة رادع خوف. كان عمري وقتها حوالي أربعة وعشرين عاماً، وكنت أعاني من ضغط اجتماعي هائل لأني لم أرغب بالزواج قبل إنهاء دراستي. كما عانيتُ من «خَطّابات الصالونات»، أي حين تأتي امرأة وتقول لك إنك طويلة أو قصيرة أو بيضاء أو سمراء. كان هذا يُشعرني بالظلم. مَن هؤلاء اللواتي يقيِّمْنَني؟ ولماذا يفعلن ذلك؟
أتذكر أني كنت في الصف الثامن حين ناقشتُ آنساتي وذكرت أني لن أتزوج شخصاً لا أحبه. كان بإمكان تلك الكلمة في تلك الفترة أن تسبب لي جريمة شرف في محيطي ومجتمعي، ولكن عائلتي كانت أوعى من ذلك. كنتُ منذ صغري واضحة بالأمور التي أريدها. قبل الثورة، لم يكن لدي أي علاقات مع شباب، ولا أتكلم معهم، وكنت مدرّسة في ثانوية شرعية لمدة سبع سنوات. حين انطلقَتِ الثورة، كنتُ أضع حدوداً للتعامل مع الشباب، وخاصة أن الناس «طق مخها» ولا أعرف ما الذي أصابها. كان الشاب يأتي ليتكلم معي، فأقول له لماذا تتكلم معي، أو مَن أنت حتى تتكلم معي؟ أنا قادرة أن أنظم نفسي بنفسي، وقادرة أن أعمل مظاهرة بنفسي. أذكر أن الشباب خرجوا في ثاني مظاهرة ليحموا مظاهرة النساء، فكنتُ أقول لرفيقتي: لماذا جاء الرجال ليحمونا؟ نحن مثلنا مثلهم! هم يتعرضون للموت، ونحن أيضاً نريد أن نموت. ما دخلهم بنا؟!
بعد ذلك كنتُ في تنسيقية دوما في «المراسلون»، وبدأتُ أتعرف على الشباب بشكل أفضل، وقد أعطتني صفتي كمعلمة في الثانوية الشرعية رمزية معينة في المدينة. الشيخ والآنسة لهما مكانة في المجتمع، وأنا كانت لدي مكانة بينهم وكانوا يحترمونني. أذكر أن أخي – الله يفك أسره – كان يقول لي مازحاً: أستغرب كيف الناس يرددون وراءك في المظاهرة، لو كنتُ مكانهم لما مشيتُ معك! ما أريد قوله أن عدد النساء الظاهرات كان محدوداً في تنسيقية دوما، مما جعلني أتعرف على الشباب بشكل أسرع، وأعرفهم جميعهم. ومع الوقت بدأوا يثقون بي، ويعطونني شغلاً لكوني أسرع بالحركة كفتاة. بعد أربعة أشهر من انطلاقة الثورة، كنتُ قد كسرت جميع الحواجز. تصاعُدُ الثورة هو الذي جعلنا نزيد نشاطنا. لو انتهت الثورة في السنة الأولى، لما كنتُ كما ترينني الآن. ولكن الوتيرة التي اشتغل فيها النظام جعلت الموضوع عبارة عن فعل وردة فعل. نحن دائماً الأسرع في التطور. في البداية كنا نخرج في مظاهرات ويكون الرجال والنساء منفصلين عن بعضهم بعضاً، وبعدها صرنا نخرج سوية، وبعدها نخرج أيام الجمعة، وبعدها نخرج مع الإسعاف، وبعدها صرنا نخرج في الليل. حين تعيشين الثورة على أرض الواقع، سوف تلاحظين أن التغيير لا يدوم، بل هو آني، وسوف تنشغلين بمواكبة الحدث. هذا جعلني أسرع بالحركة، فضلاً عن صِدقِيَّتي على أرض الواقع التي ساعدتني على كسب ثقة الشباب.
النقطة المحورية كانت اعتقالي، فقد خرجتُ من المعتقل بيان أخرى تماماً. لم أعد أخاف من أي شيء، لأن أسوأ شيء يمكن أن يحصل حصل، وها أنا ذا خرجت والحمد لله على قيد الحياة. الكابوس الأكبر عشته إذن، وكل ما سيأتي لاحقاً عادي. كما انكسر عندي الخوف من أي منصب أو سلطة. هذا الموضوع التغى تماماً، مما انعكس بوضوح على مساري. سواءً كان الشخص الذي أتعامل معه هو قائد جيش الإسلام، أو رئيس عملي، أو رئيس المنظمة التي أشتغل فيها. لا أخاف من أحد أكبر مني، ولا أحد يمكن أن يُمسكني من يدي التي توجعني. بعض الناس يخافون أن ينقطع رزقهم، أنا أقول: فلينقطع رزقي، الله معه! هذا حصل بعد الاعتقال. طبعاً تجربة الاعتقال تختلف من شخص لآخر، وأنا أتكلم عن تجربتي.
أسستِ في نهاية 2012 مركزاً تعليمياً للأطفال في دوما بالتعاون مع مجموعة من الشباب والشابات. كان ذلك خلال فترة سيطرة عدة فصائل إسلامية على دوما. ماذا تتذكرين عن تلك المرحلة؟ وكيف كانت الأجواء تحت سيطرة جيش الإسلام؟ وما الذي جعلك تقولين «الضغط على وجودي كامرأة كان أصعب من القصف بالنسبة لي»؟ وكيف تمكنتِ من مواصلة العمل كامرأة في ظل تلك الظروف الذكورية المتعصبة؟
في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 خرجتُ من الاعتقال مع صديقتي نور، وتوجَّهنا إلى دوما. في ذلك اليوم ارتكب النظام مجزرة كانت السبب بتحرير الغوطة الشرقية، حيث استنفرت الناس للقتلى. حين عدت إلى دوما كانت نسبة كبيرة من الناس قد نزحتْ عنها، ولكني رفضتُ الخروج من المدينة. توجهت مع صديقتي إلى الإسعاف في مشفى ميداني. كنا نشتغل نهاراً كمُسعفات ومساءً في الإعلام. وبعد أسبوعين ارتكب النظام مجزرة في الشفونية، وسيق الجرحى إلينا. كانت من بينهم فتاة راحت تناديني: آنسة بيان، آنسة بيان! لم أتعرف عليها مباشرة بسبب الإصابة، ولكني تذكرتُها بعد ذلك: كانت إحدى طالباتي. طلبتْ مني أن أبقى إلى جانبها لأنها كانت خائفة، وظلت طوال فترة علاجها متمسكة بي. رغم فقدانها لعشرة أفراد من عائلتها، احتفظتْ تلك الطالبة بثقتها بي، وهذا ما جعلني أفكر بالعودة إلى التعليم. صديقتي وأصدقائي الشباب شجعوني على هذه الخطوة.
قررنا فتح المدرسة، واخترنا صالة أفراح لأنها كانت قبواً وآمنة من القصف. دُرنا على العائلات الموجودة لندلّهم على مدرستنا، وأحضرنا المقاعد من المدارس المقصوفة. وبدأتُ البحث عن المدرِّسات، دققتُ أبوابهن باباً باباً. وقد كانت الجهود التي بذلناها جميعاً صادقة وجبارة ودون أي دعم أو مقابل مادي، حتى أنه لم يكن لدينا كهرباء. في 1 كانون الأول (ديسمبر) 2012 تم افتتاح المدرسة. بدأنا بحوالي خمسين أو ستين طالباً، وأنهينا الأسبوع الأول بثلاثمئة طالب. كانت فرحة الأهالي كبيرة جداً بهذا المشروع. كنت أنا المديرة، وحتى الشباب تقبلوا فكرة أن أكون مديرتهم. وبعد شهر من عملنا، بدأنا نجذب انتباه الناس، وأذكر أن رزان زيتونة زارتني لتهنئني بالخروج من المعتقل وافتتاح المدرسة.
كذلك زارني زهران علوش، الذي كان قائد «لواء الإسلام» في حينها. عبّر علوش عن إعجابه بعملنا وعرض مساعدته. قال إنه سيوفر لنا مولّداً كهربائياً يشتغل ساعتين أثناء النهار ويساعد على شفط الهواء في الأقبية. كذلك عرض أن يشغّل باصاً ليجلب الأطفال إلى المدرسة ويدفع أجرة السائق. قبلتُ المساعدة على أن تكون غير مشروطة، وعلى ألا يحق له طلب أي شيء مقابل مساعدته. وفي تلك الأثناء، بدأت الناس ترجع إلى الغوطة الشرقية، فاحتجنا لفتح مركز ثانٍ وثالث ورابع. وبلغ عدد الطلاب ثمانمئة طالب على الأقل.
جاء علوش مرة ثانية ليعرض علينا رواتب. وبما أننا لم نتلقَّ دعماً من أي جهة أخرى، ولم يكن دعمه مشروطاً – أي أنه لم ينتزع مني أي تنازل – قبلت بعرضه، لأنه لا يمكنني أن أطلب من الناس التطوع بلا نهاية، وخاصة أنهم لا يملكون مصدر رزق آخر. كانت الرواتب المقدَّمة تتراوح بين 3,000 و6,000 ليرة. لم يكن قرار القبول قراري وحدي، بل اتخذته بعد التشاور مع زميلاتي المؤسِّسات.
لكن في نهاية 2012، ذهب علوش إلى إدلب وظهر في مقابلة تلفزيونية على قناة الجزيرة. تفاجأت من قوله أن لواء الإسلام سيتحول إلى جيش الإسلام، وأن لديه خطة للمستقبل ومن بينها مشاريع مدنية كـ«مدرسة اقرأ التعليمية». كانت هذه الشعرة التي قسمت ظهر البعير، لتنطلق حروب طاحنة بيني وبينه. كيف تتبنى عملنا يا زهران وتنسبه لجهة عسكرية؟ أنت أحرقتَ جهودنا، وكذبت على التاريخ! كنت تساعدنا، ولكنك لم تشترِنا! ثم بدأ جيش الإسلام بالضغط علي. كنت المديرة التنفيذية، ولكن سرعان ما قيل لي أن هناك مكتباً إدارياً آخر لمدارس اقرأ، وأنني ممنوعة من أن أكون المديرة التنفيذية مع السماح لي بأن أكون في مجلس الإدارة. رفضتُ ذلك، لا دفاعاً عن حقي فقط، وإنما عن حق زميلاتي المؤسِّسات كذلك. وهنا بدأ زملائي يضغطون، لأن المدارس صارت كبيرة ونحن غير قادرين على الاستمرار، خاصة أنه لا توجد جهة أخرى تدعمنا. قبلتُ على مضض أن أكون في مجلس الإدارة نيابةً عن المؤسِّسات، غير أن الأمور أخذت منحىً آخر، وتم تشكيل المكتب التعليمي الذي كان زهران علوش عضواً فيه. وبعدها تم تأسيس مديرية التربية والتعليم في الغوطة بعد إقصائنا نهائياً، مع أننا كنا أول مؤسسة مدنية في الغوطة الشرقية.
وطبعاً كل ذلك حصل بينما كان القصف مستمراً، والمجازر على الأرض، وأخي في المعتقل، وأنا أشتغل دواماً كاملاً في المدرسة. وفي الوقت نفسه ينبغي عليّ أن أحارب كي أثبت نفسي كامرأة في وجه تلك الضغوطات. المصيبة أن عدد الصبايا الناشطات إعلامياً كان محدوداً. قسم كبير من النساء لم يرغبن بالصراع، وقسم آخر خِفن على أنفسهن، وخاصة أني تعرضتُ لتشويه سمعة. أحد قادة جيش الإسلام شرع يشوّه سمعتي (وقد انشق لاحقاً حين صار في تركيا ليدّعي أنه ناشط مدني). كما أُهدِر دمي في لقاء خاص مع أبو أنس دلوان، وهُدِّدتُ بعِرضي من قبل شخص يدعى أبو زياد. في الحقيقة، هذا هو السبب المباشر الذي جعلني أفرمل وأقبل بمشاركتهم في الإدارة، لأني خفت أن يضيع المركز التعليمي مني.
باختصار، انكفأت النساء عن الظهور، وفرغت الساحة للرجال. والأدهى أن تنسيقية دوما صارت ذكورية بالكامل، وبدأت تأخذ نَفَس جيش الإسلام. إخوتنا في العمل الثوري صاروا يتكلمون معي على الخاص، ويتجنّبونني على العام لأني امرأة غريبة. صرتُ أحس بنوع من الانفصام، وصارت التناقضات رهيبة على الأرض حين فازت القوة العسكرية. كما بدأتُ أتضايق من كون الجميع يرمي الحِمل علي. فقدت ثلاثين كيلوغرام، وكان وضعي المادي تحت الصفر، وصحتي سيئة، ومع ذلك بقي صوتي عالياً ومشاكلي تملأ الدنيا.
لكن الفرق بين مشاكلي مع زهران علوش والمشاكل التي واجهتها لاحقاً في تركيا مع منظمات المجتمع المدني، هو أن الأولى كانت متوقّعة بحكم تعارض وجهات نظرنا، فقد كنا لا نخفي اختلافاتنا على أرض الواقع. أما في تركيا فمكن الممكن جداً أن يعمل رجال إقصائيون وعدائيون واستغلاليون، ولكنهم يتشدقون في الوقت نفسه بمناصرة النساء ودعمهنّ من أجل مصالح العمل. أفكر أحياناً أنه لو كان لديهم سلاح لما فرقوا عن السلطة العسكرية في شيء.

عملتِ اعتباراً من 2014 كموظفة في مكتب العلاقات العامة والإعلام التابع للمجلس المحلي في دوما، وفي 2015 أسَّستِ مكتب المرأة، وترشَّحتِ في 2017 لانتخابات الهيئة العامة للمجلس المحلي للدورة الخامسة عن مقعد التعليم. ما الذي دعاكِ إلى خوض تلك التجربة الفريدة بالنسبة للنساء السوريات؟
ثورتنا لم تكن فقط من أجل تغيير الوضع السياسي، بل كانت لها علاقة أيضاً بتغيير الوضع الاجتماعي. قسم كبير من الاضطهادات يقع على عاتق النساء السوريات، مثلهن في ذلك مثل معظم النساء في بلدان العالم الثالث. عشتُ في بيئة جعلتْني أشهد على ظلم النساء بجميع أشكاله. لم أتعرض للظلم بنفسي، ولكني كنت أرى ذلك في محيطي. كان دافعي الدفاع عن المظلومين، وبخاصة النساء والأطفال. هذا مبدئي في الحياة، وحين تضيع مني البوصلة، أعود إلى ذلك المبدأ الأساسي، أي مبدأ العدالة الاجتماعية لجميع طبقات المجتمع. نحن كنساء نعاني من ظلم بين رجل وامرأة، وظلم العائلة، وظلم الطبقة الاجتماعية والحالة المادية، وفوق ذلك التخلف والاستبداد الاجتماعي. برأيي، يأتي التغيير عن طريق سَنّ قوانين ناظمة وعِقد اجتماعي، ولا يمكننا التركيز على الأفراد طيلة الوقت. هذا ما دفعني لدخول تجربة المجلس المحلي.
وكيف تمكنتِ من فرض نفسكِ كسياسيّة قيادية على زملائكِ ومحيطكِ وناخبيكِ؟
فرضتُ نفسي بالعمل المضاعف. كنتُ أشتغل مرة لأني موظفة تريد أن تثبت جدارتها، ومرة لأني امرأة. أحياناً أقوم بأعمال ليست من مهامي، ولكني أفعل ذلك من أجل تغيير النظرة حول النساء الموظفات اللواتي يقال إنهنّ يقضين دوامهنّ بشرب القهوة وفصفصة البازلاء وفرْم الجزر. هذا هو مفهوم المرأة العاملة في مجتمعنا. وللأسف كانت هذه النماذج موجودة فعلاً في دوائر الدولة.
العمل المضاعف أثّر على صحتي وعافيتي وسبب لي أمراضاً مزمنة. مرت أيام داومتُ فيها 24 ساعة في المجلس المحلي. في البداية لم يشجعني أحد على عملي، والسبب أن المكان كان حكراً على الرجال. أذكر أن دعوة الترشيح جاءت من أكرم طعمة، رئيس المجلس المحلي، كما أن أهلي ساندوني في قراري ذاك. لم يكن لدي يوم عطلة، ولا حياة شخصية، وراتبي لم يكن يكفي لشراء كيلو سكر واحد، ومع ذلك كنت أقدّس عملي. كان وزني ينزل أمام العالم، وكانت أعمالي تدلّ علي: لم يدق بابي أحد ورددْتُه خائباً؛ حتى حين أكون عاجزة عن المساعدة كنت أستمع وأواسي. حاولت أن أقارب بين جميع الشرائح المجتمعية، وبقيت على تواصل مع الجميع.
ما أهم التحديات التي واجهتكِ وزملاءك في تلك الفترة؟
تحديات كثيرة تخص أمني الشخصي!
ولكن دعينا لا نتكلم عن الرجال فقط، لأني عانيت كذلك من بعض الصبايا، حيث بدأ عامل الغيرة يشتغل، فبدأن باتهامي أني أحب الظهور الإعلامي، بينما كنت أعتقد أني أغطي الأحداث في الغوطة الشرقية وأُوْصِل صوت النساء. حرقتُ كل أوراقي عند النظام، فصارت تظهر مشاكل موجعة من نوع آخر. أقول «موجعة» لأنها صدرت عن بنات جنسي. اتهمّنني بحب الظهور، علماً أننا كنا نترجّاهنّ كي يشاركن في التغطية الإعلامية دون جدوى. كانت بعضهن يفكّرن على الأغلب في خط الرجعة مع النظام.
ومن التحديات التي واجهتُها أني خسرتُ حياتي الاجتماعية، حياتي الخاصة. كنتُ في فترة من الفترات المرأة الوحيدة التي ترفع صوتها عبر الإعلام. خسرتُ حياتي الاجتماعية بالكامل. كانت هذه من التضحيات التي قدمتُها.
لماذا خسرتِ حياتكِ الاجتماعية؟
لأن الرجل في مجتمعنا يحترمكِ ويقدّركِ ويعترف أنكِ رائعة وذكية، ولكن ليس لديه الجرأة للارتباط بكِ. من هو الرجل المستعد للارتباط بامرأة بارزة اجتماعياً وإعلامياً في تلك الفترة وتلك المنطقة؟ كان هذا مؤلماً جداً، لأنكِ تشتغلين من أجل البلد ونهضته وتغيير المجتمع، ولكن المجتمع الذي تشتغلين من أجله ينتهككِ ويأكل من روحكِ. أذكر أني خرجت بأكثر من تصريح إعلامي أقول فيه إن أول من ظلم الناشطة السورية هو الناشط السوري. لدينا كثير من الناشطين الذين يرتبطون في نهاية المطاف بفتيات صغيرات وليست لديهنّ أدنى علاقة بالمجال العام، ومع ذلك يزاودون علينا بانفتاحهم وإيمانهم بدور المرأة.
وكيف انتهت تجربة العضوية في المجلس المحلي في دوما؟
في عيد ميلادي الثالث والثلاثين، أي في 1 نيسان 2018، هُجِّرتُ قسرياً في أول قافلة، بل في أول باص أخضر إلى إدلب. خرجتُ بعد أن أحرقتُ مكتبي ومستنداتي ومشاريعي وجميع السجلات والأوراق. لولا التهجير ما كنتُ خرجتُ من البلد أبداً.
منذ شهرين، أرسلتْ لي إحدى نساء الغوطة رسالة تقول فيها: «يا حْوينة [حسرة على] هذه البلد بدون بيان!». هذه الكلمة كانت كافية بالنسبة لي، أحسستُ أني أخذت حقي. كذلك حين قدمتُ على الانتخابات ونجحت، أحسستُ أني أخذت حقي. بعد كل هذا الشغل، انتخبني أهل مدينتي بشكل ديمقراطي. لم أكن أريد الخروج من الغوطة. كان لدي أمل أن أستشهد وأُدفَن فيها. لم أكن أريد عيش مرحلة ما بعد الغوطة.
ضمّت سمر يزبك في كتابها تسع عشرة امرأة: سوريات يروين قصة فاتن التي هي أنتِ. تحدثتِ عن الأهوال التي عشتِها في المعتقل، وفي ظل الجوع والقصف والمجازر والاستبداد الإسلامي المحلي. ولكنكِ في يوم ما من عام 2018 اضطررتِ إلى الخروج من دوما المدمَّرة وترك كل شيء وراءك. والآن أنتِ لاجئة في ألمانيا، تحاولين أن تبدأي مجدداً من الصفر. ماذا يعني أن تكوني ناجية؟ وماذا تفعلين كي تستردين توازنكِ النفسي؟
لا أعتبر نفسي ناجية أبداً. لا زلت أعيش كل التفاصيل ولم تخفّ مشاعري. أي شارع أمشيه في ألمانيا قد يذكرني بشيء في الغوطة. أساساً، أنا دائماً أبحث هنا عن الأشياء التي تذكرني بها. لذلك لا أشعر أني ناجية أبداً. أحاول أن أتأقلم وأستردّ عافيتي وأُقلع من جديد. لذلك باشرتُ بدورات اللغة الألمانية. هذه هي أول خطوة أقوم بها بعد عشر سنوات انقطاع عن الدراسة الرسمية والجامعة. أحاول أن أعود إلى الحياة العادية، وأتذكر كيف كنت أعيش قبل 2011.
حين كنت في تركيا، قمت بعدة جلسات لدى مستشارة اجتماعية. كنت حين أخرج من عندها، أشعر أني سبّبت لها كارثة. أعرف تماماً أني إذا أردت أن أتكلم عن حالة الجوع التي مررنا بها، سيظن الناس أني أكذب. حين أقول أن وزني نزل 40 كيلو أثناء الحصار، بينما أزن الآن 40 كيلو فوق المعدل الوسطي، سيظنون أني أكذب. هذا هو تصوري. طريقة كلامي تدعو إلى الاستغراب. أتكلم وأنا أبتسم. أحكي عن المجازر بينما أتذكر تفاصيل طريفة جداً حصلت أثناءها. من يستمعون إلي سيُحبَطون جراء الكوميديا السوداء التي أرويها، أو سيعتقدون أني كاذبة أو أبالغ. لذلك قررت أن أحتفظ بهذه المآسي لنفسي. وهناك سبب آخر جعلني لا أتكلم عن الوجع، وهو تجنّب الدخول في مزاودات مع السوريين الذين سبقوني إلى الخارج.
كيف تتعاملين مع ما تحتفظين به لنفسكِ؟
لا أتعامل معه. لو كنت أعرف كيف أتعامل معه، لتجاوزت أموراً كثيرة في الغربة. هذا ما يزيد ألمي. حين كنت في الداخل، كنتُ أحسب أن ثمة من يسمعوننا في الخارج، وأن الهولوكوست الذي نمر به ليس خاصاً بنا، والعالم بأسره يعلم به. ولكن عندما تخرجين من البلد، تكتشفين أن الجميع يمشي وأنت الوحيدة الواقفة لمدة عشر سنوات.
أعتقد أني أفتقد مبدأ الصداقة الشفافة التي كنت أعيشها في الغوطة. أحتاج إلى صديق أزوره في هذه الغربة وأشرب معه فنجان قهوة. كل الذين كانوا يتابعوننا أثناء الحصار يعرفون قدسية التزام القهوة بالنسبة لي. هذا هو الطقس الوحيد الذي يُرجعني إلى الحياة نوعاً ما في أوروبا. صحيح أن لدي زوجي وأختي، ولكني بحاجة إلى صديق أفضفض له ويحكي لي وأستمع إليه من غير مزاودة بالوجع. بصراحة أنا لا أحب كلمة ناجية، بودي أن أسألك من أين جئنا بتلك الكلمة؟!
أعتقد أننا ترجمناها عن الإنكليزية أو لغة أوروبية أخرى، لأن المعنى العربي الجديد لكلمة ناجي-ة يشبه إلى حد كبير التعبير الذي أطلقه الأوروبيون على ضحايا الحرب العالمية الثانية ممن بقوا على قيد الحياة رغم المآسي التي مروا فيها. ولكن أخبريني لماذا لا تحبين كلمة ناجية؟
باعتقادي لا يوجد شخص يعيش مجزرة أو حرب ويتمكن بعدها أن ينجو منها. على سبيل المثال، حصلت مجزرة الكيماوي في عام 2013، ولكني ما زلتُ حتى الآن أشمّ رائحة الكلور وأرى جثث الشهداء أمامي حين يأتي أحد على ذكرها. أتذكر أدق التفاصيل. كنت أتوقع أني أعاني من أزمة نفسية لوحدي، ولكني تعرفتُ في تركيا على آخرين ممن عاشوا مجازر، ووجدت أن لديهم الذاكرة المتعبة ذاتها. حتى الآن ما زال شباب الغوطة الشرقية يسترجعون في بداية شباط كيف كانوا يكتبون على فيسبوك في تلك الفترة، ويسترجعون بدايات التصعيد واستخدام مصطلح «شباط الأسود» لأول مرة، مع أن معظمهم يعيش الآن في الشمال السوري أو تركيا أو أوروبا.
لذلك حين حضرتُ في تركيا عدة دورات مع مجموعات ما يسمى بالناجيات، استغربتُ ذلك الضخ الحاصل حول المصطلح خارج سوريا. أحسستُ أنه أقرب إلى ذر الرماد في العيون. مَن بمقدوره نسيان مجزرة عاشها؟ مَن بمقدوره نسيان عذاب نفسي أو اعتقال أو احتجاز؟ أنا مثلاً ما زلت غير قادرة على التخلص من ملابسي القديمة أو الأدوات البلاستيكية التي لا أحتاجها أو حتى الطعام التالف، لأن تلك الأشياء كانت ثروة أثناء الحصار. أنا لست ناجية، أنا فقط أتعايش مع الوجع.
أرى أن المعركة تحولت من إمكانية أخذ حقي كضحية إلى شيء آخر. بدلاً من أن تتوجه جهود التعافي نحو الأخذ بحقي أو تحقيق جزء من العدالة، أرى أن الجهود مصبوبة تجاه الضحية مرة أخرى. مضى قرابة تسع سنوات على مجزرة الكيماوي في دوما، وثلاث سنوات على مجزرة الكيماوي في خان شيخون، وحتى الآن ما زالت ثمة أصوات تتهم المعارضة أنها ضربت نفسها بالكيماوي. كيف سأتعايش مع الوجع إذا كنتُ غير قادرة أن أثبت دولياً أننا تعرضنا لمجزرة كيماوية قام بها الأسد؟ كيف سأقول الآن أنني ناجية من التجربة؟ لا، أنا لست ناجية طالما ما زلتُ أشم رائحة الكلور وأعاني من أمراض جسدية بسبب الحصار الذي عشتُه. كلمة ناجية لا تليق بالوجع الذي نعيشه.
عشتِ فترة طويلة في دوما، وبعدها في إدلب، وبعدها في تركيا، والآن في ألمانيا. هذا يعني أنكِ عاينت الوضع على الأرض إلى درجة معقولة، وأنك قادرة على قول شيء مفيد بخصوص الحراك النسوي. هل برأيك ثمة حراك نسوي سوري ملموس على الأرض؟ هل لدينا قاعدة؟ لا أقصد الأرض السورية فقط، ولكن أرض الواقع أينما كانت السوريات؟ أم ترين أن النسوية متواجدة افتراضياً بالدرجة الأولى؟ وإذا كان الحراك على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس الواقع، فهل لديك فكرة كيف يمكننا العمل على ردم تلك الفجوة ضمن الأوضاع العملية المتردية؟
في سوريا قبل الثورة، كان هناك عدد من النسويات، ولكن تأثيرهنّ كان محدوداً بفعل الاستبداد السياسي الذي منع جميع أشكال الحراك الذي لا يصبّ في مصلحته. تغير الأمر حينما اندلعت الثورة، والتي ضمت أناساً من جميع التوجهات والأفكار والعقائد. ومن العوامل المساعدة على تأجيج الحراك امتدادها الزمني، فقد نشأت منظمات المجتمع المدني، وطُرِحت مواضيع جديدة، وتعرفنا على تجارب نسائية من بيئات مختلفة، وبدأ الكلام حول المفاهيم الجندرية والعنف المجتمعي. وهنا انبثقت حركة ناشطات سوريات لا يسمين أنفسهن نسويات بعد. نشأت ثقافة جديدة لم يكن جيلنا يعرفها من قبل.
وينبغي هنا التمييز بين قسمين من الناشطات. الأول يشتغل من داخل سوريا، والقسم الآخر صار خارج سوريا مع بدايات الثورة، سواء في تركيا أو من وصلن إلى أوروبا. كان اندماج الأخيرات ضمن الحراك النسوي أسرع، حيث تمكّنّ من حضور دورات مباشرة. أما سوريات الداخل فكن مرهقات بشكل أكبر وعالقات في حرب طاحنة مع النظام، ومع ذلك انتشرت بينهن شيئاً فشيئاً ورشات الحراك النسوي، وإن اختلفت أوضاعهن قليلاً عن أوضاع الناشطات خارج سوريا. نسويات الداخل مثلاً مضطرات للتعامل مع سلطات الأمر الواقع، فأنت ستعرضين حياتكِ للخطر في حال تكلمتِ عن العنف القائم على الجندر في منطقة يسيطر عليها فصيل عسكري لا تقبل سياساته ذلك المصطلح. في الخارج، يمكنك مناقشة المصطلحات كما هي، أما في الداخل فعليك تغييرها قبل استخدامها لتتناسب مع واقعكِ وكي تتجنّبي الاصطدام. فضلاً عن أن أوجاع نساء الداخل ومتطلباتهنّ تختلف عن متطلبات نساء الخارج، واللواتي حققن نوعاً من الأمان والاكتفاء الغذائي وحتى درجة من التحصيل العلمي. هذا يعني أن لدينا شرخاً كبيراً بين ناشطات الداخل وناشطات الخارج. هناك اختلاف بالرؤية والتطلعات والمطالب.
ولكني أخشى أحياناً من التقليل من أهمية عمل سوريات الخارج. لا أعتقد أن ثمة كثيرات تمكّنّ من نيل حريتهنّ المنشودة، وما زالت كل امرأة تشتغل على حريتها من منطلق واقعها الاجتماعي المتغيّر. الاختلاف بين أوضاع السوريات لا يقلل من أهمية الصراعات التي يعشنها جميعاً، فلكل امرأة دربُها نحو الحرية الذي يختلف عن الأخرى، ما رأيكِ؟
لا أنكر ذلك أبداً. أنا أشير فقط إلى الاختلاف بين الداخل والخارج. حين تكونين في الخارج، أنتِ تشتغلين على نفسكِ وأفكاركِ. ولكن لا يمكن لسوريات الداخل أن يكتفين بتغيير أنفسهنّ، بل يحتجن أن يشتغلن على تغيير الشريحة التي تحيط بهن والمجتمع بشكل عام. وهذا أصعب بكثير. حين أكون في الخارج وأطرح فكرة جديدة حول المساواة في الميراث مثلاً، وأتمسك بفكرتي، فأنا أعرف أنه لن يرسل أحد دورية لتأخذني.
ولكن حين تتكلم النساء اللواتي يتمتّعن بقدر من الأمان، ألا يصبّ ذلك في مصلحة جميع النساء، حتى اللواتي في الداخل؟ أليس التواصل بين السوريات والتأثر فيما بينهن أكبر مما تطرحين؟
طبعاً لا أريد أن أعمِّم. هناك ناشطات في الخارج على تماسّ ومعرفة كبيرة بواقع نساء الداخل ولديهنّ القدرة على تغيير لغتهنّ حين يعملن معهنّ. سوف أضرب لك مثالاً: كنا نعلن عن افتتاح معاهد للتمكين المهني (خياطة وحياكة وحلاقة)، ولكننا كنا نعقد كذلك ورشات سياسية وتمكين نسائي وتوعية حول العنف القائم على الجندر والانتخابات والحوكمة الرشيدة.
هل ما زال لديكِ تواصل مع نساء الداخل؟
أجل. أنا أقضي جزءاً كبيراً من وقتي في التواصل مع نساء الداخل، وبعضهنّ متواجدات في مناطق النظام. يحصل أن أحضّر بعض المواد التدريبية لهنّ. شاركتُ بعد خروجي من سوريا في ورشات مباشرة، وصرتُ آخُذ المواد وأُعيد صياغتها، بحيث تتناسب مع ظروف الداخل. أعطيهنّ المادة وبعض التوجيهات دون الحاجة لذكر اسمي عليها.
هناك جدل حول النسوية الإسلامية. بعض النسويات يرين الكلمتين متنافرتين من حيث المبدأ ولا يمكن التوفيق بينهما، فالإسلام برأيهنّ لا يعترف بالتساوي بين الجنسَين، مما يجعل ممارسة النسوية ضمن إطار ديني غير ممكنة. كذلك لاحظت رفضاً من قبل (بعض) الإسلاميات للمصطلح، كما لو أن الإسلام قادر أن يجدد نفسه دون النسوية «الدخيلة». ومع أن المصطلح متداول عالمياً، إلا أنه ما زال يسبب لغطاً بيننا نحن السوريات. هل لدينا نسوية إسلامية سورية برأيك؟ وإذا كان الجواب بالنفي، ألا تعتقدين أن ذلك مشكلة كبيرة؟ وهل تؤمنين بإمكانية ازدهار النسوية الإسلامية السورية على المدى القريب؟ وماذا يمكن أن تقدم لنا ونقدم لها؟
يحصل أن تطغى في مجتمعاتنا حرب مصطلحات على حرب المضمون. كثيراً ما حوربتُ أثناء مسيرتي وعملي في سوريا بالمصطلحات. البعض يسمّينني قبيسية، والبعض الآخر يتهمني بالعلمانية، وآخرون يقولون إني كافرة. وطبعاً تجد بعض النسويات أني إسلامية، لا بل إسلامية متطرفة. كم يُضحكني ذلك! جميعنا نُنسَب الآخر إلى جماعات وأحزاب دون أن نسأله: ماذا أنت؟
حضرتُ فعلاً صراعاً بين نِسويات غير متدينات ومتأكّدات أنه لا توجد نسوية إسلامية. كنّ يقاتلن من أجل إثبات ذلك. كما حضرتُ صراعاً نشب بين سوريات مسلمات متدينات ومتأكدات أن النسوية هي العدوة القادمة من الغرب وأنها ستخرّب بلدنا. أنا كنتُ جالسة في كلتا الحالتين على الحياد. رأيتُ المعركة، وتأكدتُ أنه لو استمرت الأمور على هذا المنوال، فلن نصل إلى حراك يلامس واقع المرأة السورية أبداً أبداً أبداً.
اسمحي لي أن أعلق على من يعتقدن أنه لا توجد نسوية إسلامية، لأن الإسلام دين تمييزي وذكوري وسلطوي. أنا كامرأة متدينة أرى أن الإسلام يدعو إلى العدالة الاجتماعية. أحياناً لا حاجة لأن يكون حقي متساوياً مع الرجل، بل أحتاج أن يكون حقي أكثر منه. نحتاج إلى العدالة وليس المساواة. لا يمكنني أن أحاسب أصحاب الاحتياجات الخاصة بالطريقة نفسها التي أحاسب فيها الآخرين مثلاً.
ولكن هل هذه العدالة الاجتماعية موجودة فعلاً في الأوساط الإسلامية؟
لا، غير موجودة. أنا أتكلم عن الإسلام كدين، وليس عن الإسلاميين. المفارقة نفسها موجودة في النسوية، فهي تدعو إلى العدالة الاجتماعية وتدافع عن حقوق الفئات الضعيفة، ومع ذلك تجدين نِسويات – أعتبرهنّ متطرفات – ينفين وجود نسوية إسلامية، لا بل يذهبن أبعد من ذلك، ويرفضنَ أن تكون امرأة محجبة ونِسوية في آن. وبالمقابل، لدينا النساء غير المطّلعات نهائياً على النسوية ولا على تاريخها في المجتمعات، ولكنهنّ متأكدات أن النسويات خرّابات بيوت. برأيي تكمن المشكلة في جهل كل طرف بالآخر. الطرفان لا يعرفان حقيقة الأمور التي يتكلم عنها الآخر. هذا هو واقعنا للأسف: نحن لا نصغي إلى بعضنا، نحن نهاجم بعضنا فقط. والحرب تكون أحياناً على لا شيء.
من المهم أن ندرك أنه، مثلما تعرّضت السوريات غير المحجّبات لتنمُّر وإقصاء ورفض من المجتمع، كذلك المتدينات يتعرّضن للإقصاء. كثيراً ما رُفض طلبي للعمل من قبل منظمات المجتمع المدني في اسطنبول بسبب حجابي، مع أني أستوفي شروط الشاغر الوظيفي! كما أذكر أن رئيسة إحدى المنظمات قالت لي مرة إنني سأكون أجمل لو كنتُ غير محجبة. فقلت لها: عفواً؟! أولاً أنتِ تتنمّرين عليّ لأنني محجبة، وثانياً أنتِ اختزلتِني في حجابي، وثالثاً أنتِ تنادين بمفهوم تمييزي، أي الجمال، ويُفترَض أنكِ كنسوية خارج هذا التمييز، أليس كذلك؟
أعيش الآن في أوروبا، وكمحجّبة أُعتبر من الفئات المستضعفة. ومع ذلك أعاني أحياناً من السوريين والسوريات أكثر من معاناتي مع المجتمع الألماني. أصدقائي الألمان يحترمون ثقافتي واختياري في الحياة وطريقة تعبيري عن نفسي. بيننا حوارات مفتوحة وتقارب في وجهات النظر، وأجد نفسي أحياناً متقاربة معهم بأفكاري أكثر من تقاربي مع امرأة محجبة أو امرأة نسوية. لدي أصدقاء وصديقات من كافة الأيديولوجيات، وجميعنا وصلنا إلى نقطة من احترام الحوار. المهم هو أن تدعو مبادئنا للتعايش والتغيير نحو الأفضل وليس الأسوأ.
عودةً إلى سؤالنا، هل لدينا نسوية إسلامية سورية أو هل تتوقعين ازدهارها على المدى القريب؟
سوف تزدهر النسوية الإسلامية السورية بكل تأكيد. التجربة التي عاشتها السوريات فريدة في العالم. كان هناك اختصار للزمن. قد تحصل عندنا أمور احتاجت إلى مئة سنة في المجتمعات الأخرى. أدت الثورة وتسارع الأحداث والاصطدامات إلى اختصار خطوات كبيرة في العمل. صارت لدينا رؤية، وتجارب في مجتمعات جديدة، ونسويات يملكْن خبرات ومعرفة ممتازة تؤهلهنّ أن يكنّ مؤثرات.
برأيي لن يبقى الإسلام على ما هو عليه الآن في حال كان لدينا خمسمئة مجتهدة إسلامية عالمية تحاول تجديد الدين من داخل منظومته. لا يمكننا ترك هذه المهمة الجبارة للرجال فقط كي يواصلوا مراكمة التشريعات الذكورية التي تحفظ لهم امتيازاتهم، ولا تضعهم موضع المساءلة. وبما أنك تلقيتِ تعليماً دينياً لفترة طويلة، وقلبك ينبض في الوقت نفسه للحرية والعدل، أتساءل فيما إذا كان لديك مشروع في ذلك الاتجاه؟ وإذا كان جوابك إيجاباً، ما هي المواضيع التي تجدين الشغل عليها ضرورياً؟ وكيف تهيئين نفسك منذ الآن؟
سوف أستعير مقولة للشيخ سلمان العودة: «الدين ثابت لا يتغير، ولكن الآراء البشرية هي التي تتغير، لذلك على الفقهاء أن يمتلكوا الشجاعة ليفتحوا الأبواب القابلة للفتح قبل أن يكسرها الآخرون». بناءً على كلامه، أقول إنه لو عندنا فقيهات مسلمات (خمسمئة كما قلت) لاستطعن أن يخلقن توازناً مع الآراء الفقهية المتداولة حالياً. المشكلة أن أغلب الفقهاء رجال، وكثير من الأحكام الشرعية والآيات تُفسَّر بما يتوافق معهم. لدينا دائماً وجهة نظر أحادية، وليس لدينا فقيهات يضعن آراءهنّ مقابل آراء الفقهاء كي تتّحد وجهتا النظر وتشكلا رؤية كاملة. ما أتمناه أن تكون لدينا فقيهات لا يتخصصن فقط بأحكام الصلاة والصوم والطهارة والحج، بل كذلك بالأمور الجوهرية، وقتها يمكن أن نحقق نقلة نوعية وتغيير مباشر في المجتمع.
كامرأة تلقت العلم الديني، أعرف الكثير من التفاصيل المجتمعية التي تُنسَب إلى الدين، غير أنها لا تمت للدين بصلة. نحتاج إلى نساء يُعِدن النظر في تلك الأمور وغيرها، ويطرحن رؤية جديدة في حوارات مفتوحة واجتماعات بعيدة عن السلطة السياسية التي تؤثر سلباً على الدين غالباً. هكذا يمكننا أن نصل إلى التغيير الذي نطمح إليه.
وكيف تنظرين إلى دوركِ الشخصي؟
تلقيتُ العلم الديني على مدار سبعة عشر عاماً. وفيما بعد تعرفتُ على النسوية من خلال الثورة، ولكني طبقتُها قبل ذلك على أرض الواقع كامرأة مناصرة لحقوق النساء. أول مرة سمعتُ بالسيداو كانت في 2016. لستُ صاحبة خبرة كبيرة، وما زلتُ في مرحلة تعلم عن النِسوية، واكتساب المهارات والخبرات النِسوية، والاطلاع على تجارب نساء عالميات ساعدن مجتمعاتهنّ على التغيير.
أتوقع أن يكون لدي مع الوقت إنتاج فكري خاص بي وبالتشاور مع السيدات المنتميات إلى مختلف التيارات. يهمني أن أعطي صديقاتي المعرفة التي وصلت إليها بحكم موقعي الجغرافي البعيد عن سوريا أو واقعي الوظيفي. كذلك بودي أن أستفيد من تجارب الأخريات، وأن يكون لدينا تعليم ذاتي وسريع، ونقدر على تغيير مجتمعاتنا على جميع المستويات والأصعدة. لستُ مشروع فقيهة، ولكن قد أكون باحثة بعد خمس سنوات. ما زلتُ أجد تلك الأمور كبيرة علي. قد أشتغل على كتاب أو مقالات تتناول النِسوية الإسلامية من وجهة نظر السوريات، مثلما فعلت المغربيات والمصريات على سبيل المثال.
كيف تنظرين إلى مستقبل سوريا؟
يعيش الناس حالياً في صراع مناطقي وطبقي وعرقي وديني. تحتاج سوريا إلى فترة طويلة كي تتعافى. التجاذبات والمصالح السياسية هي التي سوف تحدد المستقبل على المدى القريب. في بداية الثورة، كان لدي قناعة كاملة أن أبناء وبنات سوريا سيحددون مستقبلها، وأننا نحن الذين سنبني سوريا. ولكني أرى الآن أن المصالح السياسية هي التي ستحدد المستقبل، لأننا كسوريين لم نتجاوز المشاكل فيما بيننا كي نبني سوريا.
كيف ستحاول بيان أن تتجاوز تلك المشاكل كي تبني سوريا؟
بتقديم مصلحة سوريا على مصلحتي الشخصية. هذا ما كنت أفعله منذ البداية حين كنتُ على أرض الواقع. سؤالكِ يحرق قلبي، لأني اشتغلتُ وكنت سعيدة بشغلي، ولكنّ قوةً سحبتني وشدتني إلى الخارج. الأمر موجع أكثر مما تتصورين!