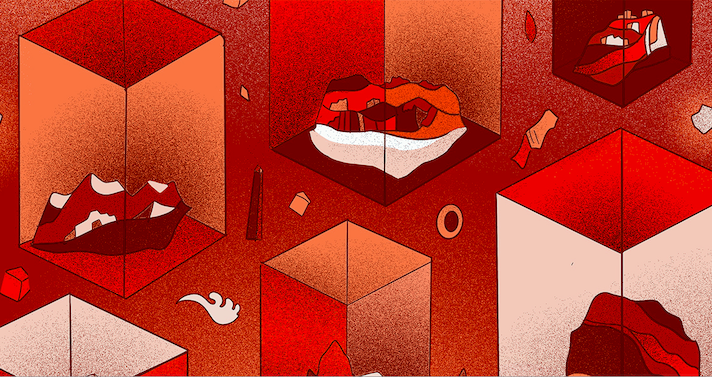مرت الآن عشر سنين ويزداد النظر للخلف ثِقَلاً. من بين كل الصور التي ظهرت في السنوات العشر الماضية، ظلت صورة الجسد السوري الميت حاضرة بكل ثقلها؛ صور الدماء والأجساد والأشلاء، صور الأجساد المعذبة والأهل والأصدقاء المنكوبون. تخرج للعلن دوماً صور جديدة للحظات قديمة تعيد فتح نقاشات سابقة، فتبدو العودة للصور ومحاولة التعمق فيها رغم كل قسوتها هي واحدة من آليات التعامل مع هول ما حدث.
نعي طبعاً أن هنالك زوايا مختلفة ومتعددة للحديث عن صورة الجسد السوري، ونختار في هذه المقالة أن نتطرق إلى نظرية التلقي، وعبر هذا الخط نبحث عن قدرة الصورة في التأثير وفاعليتها في إحداث تغيير، وربما يمكننا الإضاءة هنا على حدث وثيق الصلة بموضوعنا وهو مجموعة صور قيصر، فقد استطاعت هذه الصور انتزاع اعتراف رسمي عالمي بمدى قسوة ومباشرة حضور الجسد السوري كضحية للنظام، بالتالي لم يكن من الممكن غض النظر عنها، ربما بسبب روتينيتها وترتيبها الوحشيين، واللذين ربما ذكّرا أو أعادا للذهن صور الهولوكوست وضحايا الإبادة النازية مع إدراك الاختلاف الكبير بين السياقين بالطبع. أما بعيداً عن صور قيصر، فسنجد أن من الإشكالي الحديث عن أثر الصورة القادمة من سوريا، لأسباب متشابكة نحاول هنا تَلَمُّسها أو الإحاطة بها.
تاريخ التصوير كمرافق أساسي للحروب
خلّف انتشار صور الأشلاء والموت بمختلف أشكاله حالة من الإشباع لدى من رأوها. تعود بعض أسباب هذا الإشباع إلى الإغراق البصري الهائل الذي نعيشه اليوم، فقد أصبح للموت بسبب العنف المسلح والحرب صورة واضحة في مخيلتنا. كل شيء مباح، وبضع ضغطات فقط هي ما يبعدنا عن رؤية أبشع ما يمكن للبشر فعله.
تاريخياً، تعود أولى صور الحرب إلى عام 1847، عندما التقط مصور أمريكي غير معروف سلسلة من الصور التي تصور مشاهد من الحرب المكسيكية الأمريكية في سالتيلو المكسيك. سرعان ما تغيرت الأمور من تلك اللحظة، مع إدراك أهمية وقع الصورة وإمكانات استخدامها في الصحافة والسياسة. وهكذا بدأت تنشأ مجموعة من الأخلاقيات والقواعد والأعراف التي تحاول تنظيم عملية تصوير الحرب وشناعتها، وبرز حينها السؤال الدائم: ما الذي يجوز تصويره، ومن ثم عرضه، وما الذي لا يجوز؟
وعليه، حاربت الصورة الصحفية التي تصور أهوال الحرب مطولاً لتخرج للعلن. كان هنالك تخوف دائم من نشر صور واضحة وحقيقية عن بشاعة الحروب. في عام 1924، نشر الناشط الألماني المناهض للحرب إرنست فريدريش كتاباً صادماً حينها بعنوان الحرب ضد الحرب. عرض هذا الكتاب مجموعة كبيرة من الصور التي تُظهر واقع الحرب العالمية الأولى، أشهرها كانت مجموعة صور تعرض حالات تَشَوُّه الوجه التي عاناها الجنود الباقون على قيد الحياة بعد الحرب.
مع الإيمان بضرورة عرض شناعة الحرب كواجب أخلاقي للحّد من الحرب أو إيقافها، أو كضرورة لمصداقية العمل الصحفي، كافح الكثيرون لعرض تلك الصور عبر الصحف والمجلات، ولاحقاً عبر التلفاز، وأشهر هذه الصور التي خرجت عن المألوف أو العرف في تقديم صور الحرب واستطاعت تحريك مشاعر الناس المختلفة كانت صور الجسد البشري في الحرب. تقول هذه الفكرة الكثير حول التماهي مع الضحية الذي قدّمته تلك الصور، حين نقلت الصور مركز الثقل من شعارات لا يمكن تصويرها حول الواجب والوطن وغيرها من مبررات الحروب منذ الأزل، إلى الجسد الحي في خضم هذه الحروب.
صورة الجسد الميت في الحرب كأداة
تِباعاً، تضخمت قيمة الصورة، وأصبح فريق التصوير ملازماً لطاقم الحرب في القرن العشرين، وربما أغلبنا ما زال يذكر أثر صور غزو العراق في التسعينات والإغراق الذي بذله الإعلام ليواكب الحرب بأكثر الطرق دعائيةً، وكيف تحولت الصورة إلى قوة قادرة على تكذيب خطاب أي مؤسسة عسكرية مهما كان ثقلها، وكيف وجهت أنظار المؤسسات والدول إلى أن احتكار الصورة هو نصر جزئي في حرب،
وربما أهم ما يدعم حديثنا حدثان: الأول منع كل التغطية الإعلامية البريطانية لحرب الفوكلاند عام 1982 بين بريطانيا والأرجنتين، واقتصارها على صحفيَّين فقط، وبالطبع كل الصور التي خرجت من هذه الحرب كانت تخضع لموافقة المؤسسة العسكرية البريطانية؛ والحدث الثاني هو منع الرئيس الأميركي جورج بوش الأب نشر أي صور حول أكفان الجنود الأمريكين العائدين من حرب الخليج الثانية 1991، وذلك لمنع حضور كلفة الحرب البشرية على ساحة النقاش، واقتصار التغطية الصحفية على صور موافق عليها من المؤسسة العسكرية رغم التغطية الهائلة التي حصلت عليها هذه الحرب.
هذا النوع من التغطية الصحفية، الذي صار يعرف بالتغطية الصحفية المُضَمَنة (embedded journalism)، حيث يرافق الفريق الصحفي القوات العسكرية ويحصل على الحماية بشرط الحصول على الموافقة قبل نشر أي صور وفيديوهات، هذا النوع من التغطية أصبح هو المعتاد، وما يخالفه أصبح هو القليل.
صار الحديث متشعباً عن أخلاقيات حضور الجسد-الضحية في الصورة، وما هو الوازع الأخلاقي للمصور، وكيف تُنقل الحرب خاصة إذا كانت في مكان بعيد عن المتلقين. بالتالي، خلقت كل تلك النقاشات ساحة للتفكير في المعنى خلف الصورة، خاصة إذا كان المصور أجنبياً ويوثّق ما هو بعيد عنه تماماً، وقد لخصت سارة سنتيليس في مقالة لها فكرة أن «تصوير تذكارات الحرب – ممارسة التقاط صور للعدو الميت وإحضار تلك الصور إلى المنزل مثل الهدايا التذكارية – يجعل كل الصور التي تم التقاطها في الصراع العسكري موضع شك».
هنالك الكثير مما يُقال ويُبحَث في سؤال أخلاقيات الصورة القادمة من الحرب، وهو نقاش متعدد الجوانب، ففي لحظة، يبدو أن الأسئلة التي تخوض في أخلاقيات التصوير الصحفي في الحرب تنقسم لعدة محاور: من الفاعل، أي من يصوِّر؟ ومن المفعول به، أي من يُصوَّر؟ وأين هي الصورة؟ وكيف تظهر؟ وكيف يتلقى المتلقي هذه الصور؟ وما هي الحساسيات التي تُعنى بها هذه الصور؟
ما يهمنا نحن من كل هذا النقاش هو التباين في الشروط التي تُعرض فيها صور الأجساد الميتة القادمة من الشرق الأوسط، أو أفريقيا أو أفغانستان أو غيرها من دول المستعمرات السابقة، مقارنة مع تلك التي تُصوِّر ضحايا الإرهاب أو العنف المسلح ضمن أوروبا أو أميركا مثلاً. وهذا التباين يودي إلى تباين في تلقي الصور وتأثيرها وفاعليتها. هذا ما ناقشته الكاتبة والفيلسوفة سوزان سونتاج في كتابها بخصوص ألم الآخرين فقد اعتبرت أنه كلما كان المكان أبعد، وكلما كان إكزوتيكياً أكثر، أصبح عرض الصور القادمة منه بشكل مباح كلياً أسهل، يستطيع معها المشاهد الغربي مشاهدة كل تفاصيل الموت والأشلاء والدماء، لتكون هذه الصور تابعة لنفس آليات الآخَريّة (أو صنع الآخر) والعنصرية وعلاقات القوة المختلفة التي تزيد التعقيد الأخلاقي المرتبط فيها.
الثورة السورية والإنترنت والمواطن الصحفي
تزامن الربيع العربي مع لحظات تقنية فارقة، منها الانفجار العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي، وازدياد انتشار الأجهزة المحمولة القادرة على التصوير والوصول للإنترنت، مما ساعد على التوثيق والتصوير، وقدّم بدائل لكل الوسائل الإعلامية التقليدية، وخلق إمكانية حضور «المواطن الصحفي» بكل ثقلها، خاصة في بلاد محكومة بنظام قمعي مُسيطِر على كل مرافق الحياة مثل سوريا.
في تلك اللحظة، ومع دخول المواطن الصحفي – الذي جمع بين الفاعل والمفعول به – الساحة الإعلامية، نشأت طبقة جديدة من المعنى للصورة الملتقطة، حيث تركب سؤال من يُصوِّر مع سؤال من يُصوَّر، وتشابه السؤالان، وبذلك دخل مستوى جديد لتعقيدات الأخلاقيات المتعلقة بها. استطاع ذلك بالطبع تقديم مواكبة مباشرة للثورة عبر مئات آلاف الصور والفيديوهات والبث المباشر، وبات واضحاً لنا أن صور السوريين تخترق الفضاء الافتراضي؛ صور تُجَسِّد رحلة شعب من لحظة المظاهرات الأولى والأغاني والهتافات، والقدرة غير المسبوقة على التجمع السياسي، إلى القصف والقتل والدمار، إلى التهجير والنزوح.
أثناء البحث المرافق لكتابة هذه المقالة، ومن بين الكتابات والأصوات المختلفة لمفكرين ومصورين عن أخلاقيات وأسئلة التصوير الصحفي في مناطق النزاع المسلَّح والحرب، يستوقفنا تصريح الصحفي بول ماسون في صحيفة الغارديان البريطانية عام 2014، الذي عبّر عن عدم موافقته أخلاقياً على تصوير آثار الحرب الأكثر بشاعة، فهو لا يرى أن تصوير الحرب يوقف الحرب.
ربما لم تَقدِر كل الصور والتوثيقات لما حدث ويحدث في سوريا على منع استمرار عنف النظام، ولاحقاً عنف الميليشيات والفصائل المسلحة الإسلامية. لكنْ هناك اختلاف أساسي يجب عدم نسيانه، وهو أن أغلب من كتب عن رسالة الصورة الصحفية في الحرب وأثرها كنّ أشخاصاً بعيدين عن الحدث نفسه، أو تواجدن كزوار يرحلن مع انتهاء عملهن. ورغم أهمية دورهن إلا أن تلك الحالة تفترض وجود امتياز القدرة على المغادرة والنجاة والنظر من مسافة بعيدة لكل ما حصل ويحصل؛ امتياز هو القدرة على النظر للصورة كمُشاهِدة خارجية ممتلكة لكل الخيار بأن تكون أو لا تكون معنية.
الصورة في حالة الثورة السورية وما تلاها كانت في كثير من الأحوال أداة وحيدة للمقاومة والبحث عن العدالة، قبل أن تكون «وثيقة»، وضمن رغبة الصحفيين.ات كانت تسعى بشكل أساسي للتحكم بالسردية وحمايتها من ماكينة النظام وحلفائه على الصعيدَين العسكري والإعلامي. ورغم الرغبة الكبيرة بأن تصل الصورة للكثيرين، وأن تحقق أثراً ما، كانت الصورة لأصحابها فعل مقاومة بحد ذاتها؛ فعل بقاء واضح، بينما المتلقي والتأثير عليه نتيجة جانبية لا الهدف الأساسي بالضرورة.
هل تُوْقف صور الضحايا الحرب؟
دائماً ومع مثل هذه الأسئلة عن القيمة الأخلاقية للصور القادمة من مناطق الحرب، تظهر لنا صورة إعدام في سايغون على أنها مثال الصورة التي شاركت في إنهاء الحرب في فيتنام؛ صورة كُرِّست لفترة طويلة على أنها صورة بشاعة الحرب، وربحت جائزة بولتزر سنة 1969. إلا أننا في لحظة زمنية بعيدة جداً عن ذلك الوقت كما يبدو، ولا بد من ربط السؤال من جديد بسياقنا، فهو سؤال مهم ومؤثر في متن الحديث عن الثورة السورية، وعن الصور التي ترافقت مع صيرورتها المستمرة.
الخوض في نقاش التلقي هنا لا يدّعي التأثير لدى المتلقي كمطلب يشابه الاعتراف الذي يحكمنا بعلاقتنا مع الغرب البعيد عن سياقاتنا، وإنما ينبع بشكل أساسي من فهمنا لمعايير القوى الدولية وأقطاب الثقل العالمي. بالتالي، فإن البحث عن أثر لهذه الصورة يصطدم كما تقول الفيلسوفة جوديث بتلر بقدرة الناظر على سحب الإنسانية من «الآخر» المعروض الصورة، بالتالي التعاطف أو التواصل معها. بينما تشرح الفيلسوفة سوزان سونتاج لماذا يحدث ذلك، حيث تقول إن محاصرتنا بالكم الهائل من الصور العنيفة يحملنا على التذبذب في الأحكام الأخلاقية الواضحة للصورة، بل تجعل هذه الصور في حكم الكليشيه والمكرر.
سونتاج ترى أن هذه الصور للغرب تحمل رسالة مزدوجة: من جهة تُظهر معاناة شائنة وظالمة ويجب إصلاحها، ومن جهة أخرى تُظهر أن مثل هذا العنف أو هذه الحروب لا تحدث إلا في البلاد الفقيرة المتخلفة، وليس لدينا نحن في البلاد المتحضرة. ويمكننا فهم ذلك كله من تقاطع عدة عوامل على الصورة، عن لون بشرة الضحايا، جنسهن، عرقهن، والفاعل الذي أدى إلى هذا العنف.
كل هذه العوامل تزيد سحب الإنسانية من الأشخاص الذين تعرضهن الصور، وتقلل قدرة المشاهدين في الغرب على التواصل معها، حيث تُقدِّم صورة تُوافق توقعاتهم عن تلك الأماكن وما يحدث فيها، مما يجعلها معتادة ولا تستحق الاهتمام. في ذات الوقت، ومن تلك التقاطعات كلها ربما، يمكننا فهم انتشار وتأثير العديد من الصور التي أصدرتها داعش. ففي أغلب تلك الصور التي انتشرت بشكل كبير وحققت رواجاً عالمياً، كانت الضحية بيضاء غربية؛ الضحية الممتلكة لكل عناصر الإنسانية والمستغرب وجودها ضمن هكذا سياق، أما الفاعل في تلك الصورة فيماثل كلياً النمطية العنصرية المفترضة حول المتدينين الإسلاميين وهمجيتهم.
ربما لا تستطيع صور الضحايا اليوم الوصول بشكل سهل في عالم مُشبَع بصرياً ومن ثم تحقيق أثر ما، لكن هذا الأمر مرتبط بشكل كبير بالضحية التي تعرضها الصورة. فبالتأكيد، ليست كل ضحايا العنف المسلح سواسية، رغم التبجُّح الدائم بهذا ضمن كل اجتماع دولي. نحن نعيش ضمن منظومة معقدة لعلاقات القوة، لها تاريخها الطويل الذي ما زال يلعب دوراً كبيراً في تحديد قيمة ذلك «الآخر» بالنسبة للمنظومة. الأكثر أسفاً في واقع الحال هذا أن الصور التي قاوم بها الشعب السوري الظلم الذي طاله، هي نفسها التي تُستعمَل لتؤكد آخريّة الجسد/الفرد السوري؛ الآخر البعيد، الأقل إنسانيةً بالنسبة للمتلقين الغربيين، بدل أن تساعد تلك الصور في تحرُّره أو إضفاء المزيد من الإنسانية عليه.
الصور تحمل الكثير من المعاني المكنونة فيها، بالإضافة لتلك التي نُحملّها نحن إياها. ليس بالضرورة أن يرى كل شخصين نفس الشيء في ذات الصورة. لعل خصوصيتها تتمثل في أن ما تبقى لدينا اليوم من كثير من أحبائنا هو صورهم فقط، وذكريات بعيدة أصبحت بشكل أو آخر غريبة عنا رغم أُلفتها، بل حتى تكاد تكون من حياة أخرى. النظر إلى الخلف أمر صعب؛ نحن نحمل مخزون صور هائلاً عن الفرح والحزن والهموم والانكسارات والهزائم، ونحاول دوماً أن نتعامل معه. إلا أنه لا بد أن ندافع عن هذه الصورة؛ أن نجعلها حاضرة؛ أن تكون هي الصورة البديلة لكل دعايات النظام؛ أن تصبح قادرة على التمايز، وأن تُرى كما هي، على حقيقتها الموجعة، وبما تخفيه من آلام شعب كامل. علينا النظر وعدم إغلاق أعيُننا، وعلينا جعل الجميع ينظر بحق أيضاً.