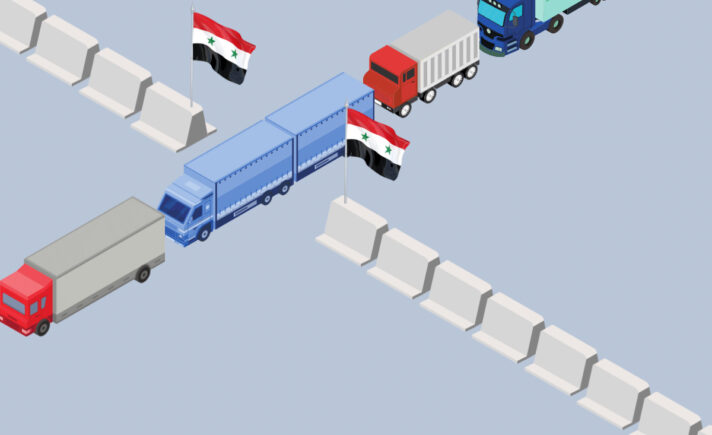بعد الوقفة السنوية في عامودا لإحياء ذكرى ضحايا مجزرة حلبجة الرهيبة، التي استخدم فيها نظام صدام حسين السلاح الكيميائي ضد المدنيين الكُرد، وتحديداً بعد انتهاء دقائق الصمت حداداً على أرواح ضحايا المجزرة، وقف من عرفتُ أنّه صديقي بهزاد حمو يهتف بصوته الجهوري «بالروح بالدم نفديكي يا دمشق». كان ذلك في السادس عشر من آذار (مارس) 2011، بعد يوم واحد فقط من أولى المظاهرات التي خرجت في العاصمة. لم تتحول تلك الواقعة، التي رواها لي إسماعيل شريف، إلى مظاهرة علنية ضد النظام، لكن الهتاف كان تحية واضحة لمظاهرة الخامس عشر من آذار في دمشق. بعدها بأسابيع قليلة، سيخرج الآلاف في عامودا بريف الحسكة مطالبين بإسقاط نظام الأسد.
يحكي هذا التقرير قصة هي خلاصة حوارات مع صبايا وشباب من كرد سوريا، كانوا حرفياً في الصفوف الأولى للثورة عام 2011، وانتهى بهم الأمر يشاهدون عربات تركية مدرعة عام 2018 تدخل مدينة عفرين برفقة فصائل كانت تسمى جيشاً حراً ذات يوم. تقول بيريفان أحمد: «نهاية العام 2011، لففتُ علم الثورة على خصري تحت ملابسي وعبرتُ به الحواجز. كان يمكن أن أُقتلَ إذا اعتُقلتُ وهو بحوزتي. عَبرتُ به حواجز أمنية في مدينة دمشق من أجل المشاركة في مظاهرة. العلم ذاتُه رأيته مرفوعاً على مدرعات وعربات تحتل ّعفرين بعد أعوام».
بيريفان أحمد، غيفارا نمر، بيروز بريك، إسماعيل شريف، بشير أمين: صبايا وشباب كُرد، شاركوا في حراك الثورة السورية منذ آذار ونيسان 2011، يتحدثون اليوم عن تلك اللحظة بعد كلّ ما حدث، ليس في عفرين فقط، لكن بعد كل شيء منذ اقتحام فصائل مُعارِضة للنظام، كانت تضم ’غرباء الشام‘ وفصائل إسلامية منها ’جبهة النصرة‘، لمدينة رأس العين في صيف 2012.
* * * * *
كانت بيريفان أحمد تعيش في المدينة الجامعية، وتكمل سنتها الدراسية الرابعة في جامعة دمشق: «من بداية 2011 كان المجتمع عم يغلي، ونحنا عم نغلي. بالنسبة للكردي أو الكردية السورية، كان الشعور بالقمع والظلم مضاعفاً. كنا ننتظر تلك اللحظة التي ستبدأ الانتفاضة فيها».
واجهت بيريفان في البداية صعوبة في التنسيق من أجل المشاركة في المظاهرات، لكن لم يكن شي ليمنعها: «كان أصدقائي المقربون الذين شاركوا في المظاهرات يرفضون مساعدتي على معرفة مواعيدها ومكان انطلاقها خوفاً عليّ، خاصةً وأنّني كنتُ أعيش في المدينة الجامعية حيث الرقابة أكثر تشديداً بكثير. أذكر بوضوح المرة الأولى التي شاركتُ فيها في مظاهرة في جديدة عرطوز قرب دمشق، ذهبت إلى المنطقة وأنا مصمِّمة تماماً على الانخراط في الحراك. لم يكن هناك مجال لنقاشي أبداً، لا من أصدقائي ولا عائلتي التي كانت قلقة للغاية. كان الحلم يتحقق، فلماذا الانتظار الآن؟ في تلك اللحظة، وأنا في طريقي إلى المظاهرة، عرفتُ أنني لا أريد التخرج. كان التخرج يعني أن أترك دمشق التي أحسستُ للمرة الأولى بالانتماء إليها. حتى هذه اللحظة، عندما أتذكر تلك اللحظات التي توالت علينا ونحن نتظاهر خلال السنة الأولى من الثورة، أتذكر كم كان مدهشاً لنا أن نهتف للحرية وضد النظام في مدينة دمشق».
وُلِدَتْ غيفارا نمر في مدينة دمشق، وعاشت فيها معظم سنين حياتها. كانت المشاركة في الحراك أمراً غير قابل للمجادلة بالنسبة لها: «عندما سُئِلتُ قبل فترة قريبة: لماذا شاركتِ بالثورة السورية؟ فوجئتُ من السؤال. الأمر كان بالنسبة لي منطقياً للغاية، ولا يحتاج للنقاش والتبرير طوال تلك الفترة. لماذا شاركتُ بالثورة؟ لأنّ هناك ثورة انطلقت وعلى الجميع المشاركة بها. بهذه البساطة كان جوابي».
انتقلت غيفارا فوراً للمشاركة في تنظيم نشاطات ضمن الاحتجاجات في دمشق: «كنتُ مع مجموعة اسمها أيام الحرية، كنا ننظم نشاطات حراك سلمي بدمشق، مثل المظاهرات الطيارة، أو تلوين نوافير في ساحات رئيسية في العاصمة باللون الأحمر. شاركتُ في تنظيم عدد من المظاهرات في دمشق، ولاحقاً قمتُ بالتركيز على التصوير خلال عام 2012. بالعودة الآن إلى ذكريات عام 2011، أظن أنه من الجيد تَذكُّرُ من نظموا المظاهرات أيضاً، الذين ربما لم يستطع بعضٌ منهم المشاركة فيها، فيما البعض الآخر شارك في المظاهرات من دون القدرة على المساهمة في تنظيمها. ربما من الجيد تذكر الأمرين اليوم؛ المنظمون والمشاركون في تلك المظاهرات».
في الشهر السابع من العام 2011 اعتُقِلت غيفارا خلال مشاركتها في مظاهرة في حي الميدان: «كانت عائلتي في تلك الأيام تنتظر دورها للحصول على الهوية السورية لأول مرة. تأجَّلَ ذلك الموعد لأشهر بسبب اعتقالي. كنتُ أحس أنّني لم أُعتقَل لأيام قليلة في فرع الأمن الجنائي فحسب، بل سأخسر ربما فرصتي الأخيرة بالحصول على هوية. أحسستُ بذنب فظيع لأنني قد أكون قد تسببتُ في خسارة أفراد عائلتي لهذه الفرصة أيضاً. في فرع الأمن الجنائي بعد ساعات من اعتقالي، عاد المحقق المسؤول عنّا، فتح باب الزنزانة ووجه الكلام لي: غيفارا نمر، أجانب حسكة وعم تتظاهري! أخرجني من الزنزانة وأعاد التحقيق على مدى ساعات، موجِّهاً طوال ذلك إهانات لأنني كردية لست حاصلة على الجنسية السورية».
أما إسماعيل شريف فكانت المشاركة في الحراك بالنسبة له أمراً شديد الأهمية، ما دفعه إلى تغيير مسار دراسته: «في بداية الثورة كنتُ أدرس في معهد إعداد المعلمين في مدينة اللاذقية. عندما عدتُ من إجازتي التي أخذتها في عيد النوروز، والتي قضيتُها في مدينتي عامودا، عرفتُ بالمظاهرات التي خرجت في اللاذقية في حي الشيخ ضاهر. كان أمراً غَيَّرَ حياتنا. لم أُرِد البقاء طويلاً بعيداً عن عامودا التي بدأت فيها بعض التحركات، لذلك عدتُ في بداية شهر نيسان. المظاهرة التي حدثت في 8 نيسان 2011 كانت أولى المظاهرات التي أشارك فيها، واستمر هذا الحال من مشاركاتي في التظاهر خلال إجازاتي من المعهد، ومشاركتي مع تنسيقية عامودا التي بدأنا بتنظيم العمل ضمنها من أجل المظاهرات والحراك السلمي في المدينة، إلى أن نَقلتُ دراستي في العام التالي إلى مدينة الحسكة كي أبقى بالقرب من الحراك في مدينتي. استمرَّ الحراك في المدينة حتى صيف 2013، عندما حدثت مجزرة عامودا. عندها اضطُررتُ للهرب من المدينة بعد اعتقال عدد من أصدقائي في التنسيقية، لم يعد البقاء ممكناً بعدها».
في آذار 2011 كان بشير أمين يدرس للشهادة الثانوية في مدينة عامودا: «عند انطلاق الثورة لم أكن مسيَّساً بالمعنى الفعلي، ولم أكن أتابع الشأن السياسي بشكل دائم. لكنّ ما حدث في آذار 2011 صنع فارقاً كبيراً بالنسبة لي. لقد أخرجَ ما كان واضحاً إلى العلن. هذا النظام شديد السوء والطغيان، والثورة أعطتنا فرصة لمقاومته. شاركتُ في العديد من المظاهرات في مدينتي عامودا. بعدها بدأت المجموعات الأكبر التي شاركتْ في تلك المظاهرات بالانقسام سريعاً، اتخذ المقربون من ’حزب الاتحاد الديموقراطي‘ موقفاً خاصاً، بينما نظمت الأحزاب التي تجمعت في ’المجلس الوطني الكردي‘ لاحقاً تنسيقيات خاصة بها، وظلّ الشباب المستقلون الذين كانت تمثلهم تنسيقية عامودا بشكل أساسي عصبَ الحراك في المدينة. استمرَّ الحراك حتى صيف 2013، عندما حدثت مجزرة عامودا والحصار الأمني الذي قامت به وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، التي اعتقلت وقتلت شبّاناً من الأحزاب الكردية الأخرى ومن المستقلين. خرجتُ من المدينة في تلك الفترة التي تمّ منع الحراك تماماً فيها».
بيروز بريك من جهته كان قد قرّر الالتحاق بالمظاهرات التي دعت إليها صفحات على فيسبوك ربيع 2011: «قرّرتُ أنني سأتوجه للجامع الأموي يوم الجمعة 18 آذار بناءً على تلك الدعوات. عندما انتهت صلاة الجمعة، وقفَ شاب ووجه حديثه لخطيب الجمعة وقت ذلك، الشيخ البوطي. كان هناك ضجة كبيرة ولم يكن الصوت واضحاً، لكنني عرفتُ أنّ الاحتجاج سيبدأ داخل الجامع من نبرة الشاب في الحديث. وعندما بدأت الهتافات توجَّه أشخاص نحو البوطي، لم أكن متأكداً من أنهم كانوا يريدون ضربه أو الاعتداء عليه كما أُشيعَ وقتها، ربما كانوا يحتجوّن على مضامين حديثه المؤيدة للنظام. عندما خرجت المظاهرة إلى صحن الجامع الخارجي، بدأ هجوم الشبيحة علينا. ركضتُ باتجاه باب صلاح الدين واستطعتُ الهرب من ضرباتهم. قبل ذلك، كان هناك شيخ كبير في العمر، حاول تخليص أحد المتظاهرين من أيديهم، لكنّهم بدأوا بضربه بدلاً من الشاب. كان منظراً فظيعاً. عرفتُ وقتها مع مَن نتعامل».
يذكر بيروز ارتباطاً عاطفياً بينه وبين دمشق: «قضيتُ فيها 13 عاماً خلال دراستي وخدمتي العسكرية الإلزامية، وقد واصلتُ المشاركة في المظاهرات في مدينة دمشق لأشهر طويلة بعدها. كنتُ أسميها ’ثورة‘، وأنظر إلى ما يجمعنا كطيف مدني ديموقراطي، وهو الرغبة بالعدالة والديمقراطية في هذا البلد. اليوم أميلُ إلى تسمية ’الانتفاضة‘ بدلاً من ’الثورة‘. هناك خيبة أمل كبيرة حصلت بعد كل تلك السنوات».
* * * * *
كان من المفترض أن يكون سؤالنا المحوري في هذا التقرير متعلقاً بالمشاعر والتناقضات التي يُحسّ بها شباب وصبايا كُرد شاركوا في حراك الثورة السورية منذ 2011، بعد الذي حصل في عفرين عام 2018. لكن في الحقيقة، لم يكن ذلك الحدث نقطة التحول الوحيدة ولا الصدمة الأولى، بل كانت هناك لحظات وصدمات أخرى، سابقة ولاحقة، دفعتهم إلى الفصل بين تلك اللحظات الثورية في 2011 وكلّ ما جرى بعدها
تقول غيفارا: «أرى أن الأمر قد بدأ قبل عفرين. ما حدث هناك كان في رأيي مجرد نتيجة. الصدمات توالت منذ اقتحام فصائل مسلّحة معارِضة لرأس العين في صيف عام 2012. كانت تلك الصدمات بالنسبة لي مشابهة لوجود تنظيمات مثل ’جيش الإسلام‘ في صفوف الثورة. هؤلاء شركاؤنا في الوطن (للسخرية). بعد كل تلك الصدمات التي عشناها، أواجه اليوم موقفاً شديد التعقيد. ارتباطي بالثورة بالنسبة لجزء من الناشطين الكرد أصبح تهمة، فقد تخليتُ في نظرهم عن هويتي الكردية. في الطرف الآخر، اكتشفَ البعض فجأة أنني كردية، وأصبحتُ مضطرة في نظرهم لتبرير انتهاكات قسد و’حزب الاتحاد الديمقراطي‘. اليوم، أرى أن الذي قتل مشعل تمو كان يعرف إلى أين سيقودنا كل ذلك، ويبدو أنّه نجح في مساعيه. ها نحن قد وصلنا إلى أسوأ مكان، حيث الكثيرون أصبحوا مضطرين للعودة والاحتماء بهوياتهم المختلفة. ليس لأنّ مشعل بطل خارق كان سيوقف حركة التاريخ لوحده، لكنّ وجود مشعل وما يُمثّله كان بالتأكيد سيسمح لأصوات مغايرة بالظهور وسط هذا التوتر. كان وجوده سيدعم مبادرات تساهم في المطالبة بحق تقرير المصير إلى جانب الديمقراطية. بالنسبة لي، هذان مطلبان غير منفصلَين. قضيتي اليوم هي حماية حقوق الإنسان في هذه البقعة الجغرافية التي ننتمي إليها بهوياتنا المتنوعة، وإذا لم يكن هذا جوهر اتفاقنا كسوريين فإن ما يجري سيستمر من دون أن نعرف نهاية له».
كذلك بيريفان سبق شعورها بالخذلان أيضاً ما حصل في عفرين. هي كانت قد انتقلت إلى مخيم اليرموك قبيل نهاية العام 2012، لتشارك في المنطقة المحاصرة آنذاك في العمل الإنساني كمُسعفة ضمن النقطة الطبيّة، وضمن تنظيم النشاطات الحراك المدني في اليرموك: «لم يكن أمام الحراك إلّا الانتقال إلى المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام. كان الوصول إلى الغوطة الشرقية صعباً للغاية بالنسبة لي، بينما كان لدي إمكانية للانتقال إلى مخيم اليرموك. كان المخيم امتداداً للعاصمة، التي كنتُ أرى أنّ الحراك فيها أساسي من أجل إسقاط النظام. قضيتُ عاماً وأربعة أشهر في المخيم، كانت فيها أقسى اللحظات التي عشتها، لكنني لستُ نادمة، وإذا عاد الزمن لن أغيّر في قرارتي. ربما ستكون أكثر تعقُّلاً، لكنني لست نادمة على أي لحظة. رغم تمسُّكنا بسلمية الحراك ورفضي الشخصي للسلاح، كان السلاح قد أصبح أمراً واقعاً. كانت نظرتي العاطفية، أو لنقل موقفي في ذلك الوقت، أننا رغم موقفنا ضد التسلّح، إلّا أنّ دورنا الآن هو أن نُمنطق وجود السلاح. كان هذا أحد أسباب دخولي إلى اليرموك أيضاً. لكن التجربة اليوم أثبتت لي أن المنطق والسلاح لن يجتمعا أبداً. بعد سبعة أشهر قضيتها في مخيم اليرموك، قضيتُ معظمها في العمل ضمن نقطة طبية لإسعاف الجرحى نتيجة القصف والمعارك، اختطفتْني مجموعة إسلامية بذريعة اتهامات لي بالعلاقة مع أحزاب كردية. كنتُ موجودة في نقطة قريبة جداً من خط الجبهة، لذلك ظننتُ أنّ النظام اعتقلني في اللحظات الأولى. لم أعرف تماماً أين أنا لأن عيوني كانت مغطاة طوال الوقت، لكن عندما بدأوا التحقيق معي وهم يصوّبون المسدس إلى رأسي عرفتُهم. لقد عرفتُ الأصوات، فقد أسعفتُ عدداً منهم خلال تلك الأشهر، وقد قلتُ لهم ذلك. كان الإحساس بالخذلان طاغياً عليَّ في تلك اللحظات. قررتُ وقتها أنّني أريد الخروج من المخيم. بعد ذلك بأشهر غير قصيرة خرجتُ بصعوبة شديدة من الحصار إلى مدينة دمشق. لم أكن أعرف ما الذي أريد فعله، حاولتُ الدخول إلى الغوطة الشرقية، لكن لم أُفلِح. انتهى بي الأمر خارجة من سوريا في 2014».
يقول بيروز أنّ آمالاً كبيرة تبخرت بعد كل ذلك: «بعد انتشار السلاح بيد الإسلاميين وتحكم العصابات بالناس، تبخرت آمالنا. كنتُ أشعر، ككردي، أن الانتكاسات أكبر بالنسبة لي، وحتى قبل احتلال عفرين، فقد كان الهجوم على مدينة رأس العين في 2012 مؤشراً واضحاً على تبدل وجه الثورة وأولوياتها لدى من حملوا السلاح. كانوا يحملون علم الثورة واقتحموا المدينة. كنتُ فيها وقتها لأن بيتي هناك، وبقيتُ إلى اليوم الثالث من سيطرتهم على المدينة. رأيتُ كيف تعاملوا مع الناس، وكيف قتلوا عناصر أمن وشرطة وجيش لم يشاركوا في أي انتهاكات أو يقمعوا المظاهرات التي كانت تخرج فيها سابقاً. منذ ذلك الوقت رأينا أحداثاً كثيرة، دفعتنا… لن أقول إلى الندم، لكن إلى مراجعة الحسابات. صرنا ننظر إلى الثورة بمنظور آخر، بمنظورنا الخاص، فبالتأكيد لم يكن هناك أي رابط بيننا وبين الذين دافعوا عن تلك الانتهاكات والتصرفات. لكن اليوم، وبعد كل ما حدث، عندما أستعيدُ تلك الحالة الأولى خاصة في الشهور الستة الأولى، لو عاد بي الزمن، فإنني سأعود للمشاركة فيها. تلك البداية التي أحسسْنا فيها بأنّ سقوط النظام والتحول إلى نظام ديمقراطي سيقود تلقائياً إلى حل القضية الكردية. اليوم، أصبح هذا المطلب أبعد، وما زال الحضور السياسي الكردي في سوريا مهدَّداً. لم تكن تركيا بحاجة لحجّة قسد أو ’حزب الاتحاد الديمقراطي‘ لاحتلال عفرين أو سري كانييه، برأيي أنّ الهدف هو الوجود الكردي والتنوع الإثني والثقافي في هذه المنطقة. هذه التوجهات تشكّل اليوم خطراً على وجود الكرد أنفسهم، وليس على مشاركتهم السياسية فقط».
أما بشير فيظن أنّ استعادة لحظات 2011 أصبحت أكثر صعوبة بعد كل ما حدث: «لم أعد أستطيع الحديث عن تلك الفترة أمام أقاربي ومحيطي الكردي بالطريقة نفسها. أشعر بالانزعاج الشديد الآن لأني أقول ذلك، لكن للأسف لم أعد أستطيع، ومع ذلك لا زلتُ أحاول. هذه الثورة، بغض النظر عمّا جرى لاحقاً، غيَّرتْ فيَّ الكثير. كنتُ سأكون شخصاً آخر بالتأكيد لولا الثورة، لكنّ هذا الخطاب لم يعد ينفع في الوسط الكردي. أمام الضحايا والتطرف الذي يستهدف الوجود الكردي، لم يعد هذا الخطاب يحقق أي شيء. الكرد يُحسون اليوم بأنهم يحاربون من أجل وجودهم وليس من أجل مشروع سياسي. الأمر صار أن تكون أو لا تكون».
إسماعيل يقول إنّه بالتأكيد لن يشعر بالندم، لكن ما حدث غير الكثير: «بالنسبة لنا لم يكن احتلال عفرين الحدث الأول، كنا قد شاهدنا ما حدث في رأس العين صيف 2012، لكن عفرين كان نقطة مفصلية بالنسبة لي، فقد شاهدتُ كتائب تقول إنها تمثل الثورة، وتحمل علم الثورة، تقتحم مدينة عفرين وتقوم بانتهاكات بحق الأهالي. المدنيون في عفرين ليسوا من البي كي كي، وليسوا من أحزاب المجلس الوطني. الانتهاكات ارتُكِبت وتُرتكبُ بحق الجميع، بحق شعب كامل. منذ اليوم الأول الذي دخلوا فيه إلى عفرين، كانت الصورة التي خرجت من المدينة مخزية».
يقول إسماعيل إن أخته تسكن في مدينة رأس العين، عادت مع عائلتها إليها بعد نزوح لسنوات بسبب معارك 2012: «أعادوا بناء منزلهم هناك، لكنهم لم يقضوا فيه عامين حتى بدأت العمليات العسكرية مجدداً في المدينة، عندما اقتحمت القوات التركية وفصائل سورية تابعة لها المنطقة أواخر العام 2019. أرسلت أختي لي صورة للبيت، حتى الشبابيك والأبواب تمّت سرقتها. قبل ذلك، بعد وفاة الساروت شاركتُ فيديو له من مظاهرات حمص، فاتصلت أختي بي لتُعاتبني: هل ما زلت معهم؟ هل ما زلت تحترم هذا العلم؟ للأسف لُطِّخَ هذا العلم بالدماء. كان كلامها من أصعب المواقف التي واجهتها في حياتي. لا أشعر بالخجل أو الندم على تلك السنوات، ولا بالصور التي لديّ من مشاركاتي والتي تضمّ علم الثورة. كنتُ أشارك فيها مقتنعاً بأنها الطريق الوحيد لنا، لكنني لن أحمل علم الثورة اليوم، ولستُ نادماً في الوقت ذاته على رفعه سابقاً. كانت لحظات غيّرتْنا جميعاً».
* * * * *
يوم أمس كان عيد النوروز، هذا العيد الذي مُنِعَ الاحتفال به في عفرين خلال الأعوام القليلة الماضية، ثم خرج الائتلاف هذه السنة بقرارات تُعلنه عطلةً رسمية؛ الائتلاف نفسه الذي يمثّل سياسياً فصائل سورية مدعومة من تركيا، تقتل وتعتقل وتقمع كرداً من أبناء المنطقة وبناتها، وتُهجِّر كثيرين وكثيرات لن يستطيعوا الاحتفال بهذا العيد في بيوتهم، لكنّ عيونهم ترقب بالتأكيد.
,