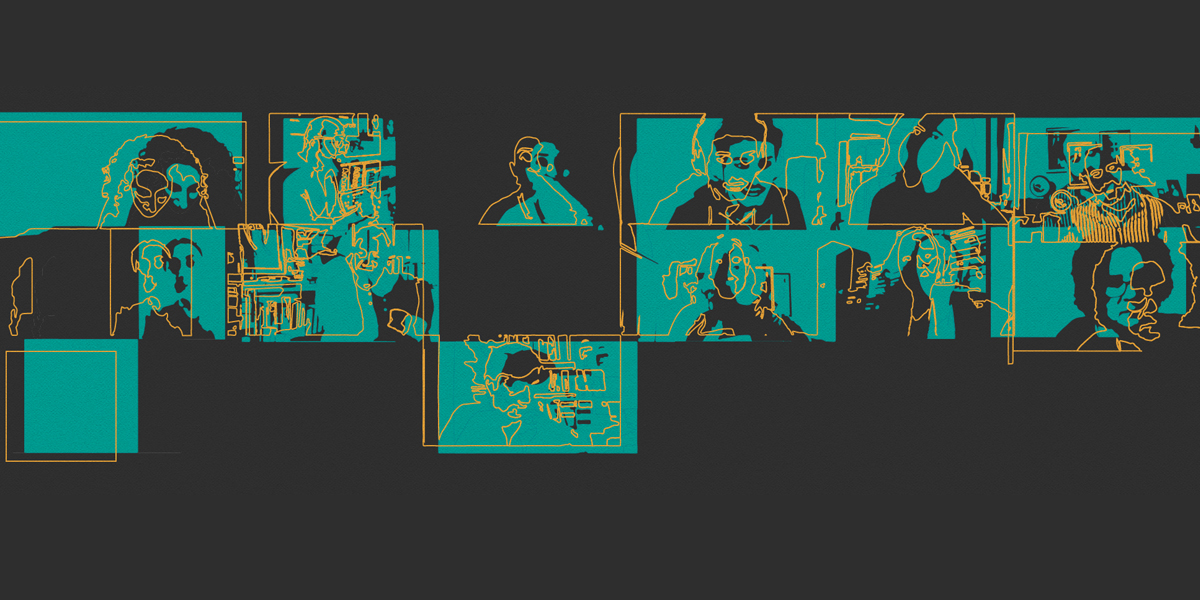في تجربة التبعثر والشتات السورية، وقبلها في تجربة الثورة نفسها ذات الطابع الترابي المتغير من منطقة لأخرى في سوريا، أتيح لنا مفارقة وفرصة نادرة، وهي أن الجماعات السورية أصبحت في كبسولات متمايزة زمنيًا وجغرافيًا، ولكنها تلتقي بشكل متزامن على شبكات التواصل الاجتماعي بواسطة نسغ جامع، هو هذا «اللوغوس» أي اللغة-العقل. والاصطدام عبر اللغة بين واقعين بعيدين ومتنافرين أخذ يظهر بالنسبة لسوريين ما زالوا تحت هيمنة الاستبداد الأسدي، وفي وضع حياتي يومي يزداد تردّيًا فيما تزداد «غرابة» الكلام عن الثورة -الثورة كلحظة ما زالت ساخنة في أذهان من انحازوا وانخرطوا عام 2011 في الثورة السورية، ولكنهم غادروا البلد. انطباع الغرابة هذا متبادَل حين يكتشف الطرفان كيف يتطور ويتبدل (أو لا يتبدل) واقع الطرف الآخر.
هناك تعابير وعبارات تكتسب غرابة الزمن حين تُستعاد. ما يُتيح عملية الاستعادة هذه هو النسغ الحي، أي اللغة المُتاحة -كتابةً وتسجيلًا- بشكل كثيف وغير مسبوق. ماذا لو استعدنا هذا السجل في السياق السوري عبر تقليب وقراءة اللغة التي أُنتجت عام 2011 وخلال السنوات القليلة التي تلتها؟ وماذا لو فعلنا ذلك بدءًا من الآنية الزمنية، وانطلاقًا من سؤال محوري: ما هو الضروري للحياة الآن في بلداننا؟
يتيح لنا سؤال كهذا أن نرتاح من الذكرى كألم وانتحاب، لنبدأ التذكر كفعل تفكر واستمرار في التغيير، كما يتيح لنا الحق في النسيان الذي هو بأهمية فعل التذكر ويرتبط به بشكل عضوي؛ النسيان بمعنى التخفُّف مما لم يعد سديدًا لحاضرنا، وليس بمعنى محو الواقعة التاريخية.
في عملية التذكر الديناميكي، نتأمل في غرابة المسافة، فنتمكن من التأريخ لتطور الأفكار والتعابير والكلمات التي تداولناها، لنتخفَّف من بعضها عبر قراءتها بمفعول رجعي، ونصقل مفاهيم أنطولوجية أساسية ما زلنا بحاجة إليها الآن من أجل الحياة، فنُعيد تعريفها وفق تجربتنا وآنيتنا. في هذا إذاً دعوة لتثبيت تعريفات معيارية، كأن نقول إن الكرامة والعدالة والحريات المغتصبة من نظام مسلخي لا يفهم من السياسة إلا هتك الأجساد، ما زالت مفاهيم ضرورية وآنية جدًا ولم تتغير عبر الزمن. أما الكلمات ففي استعادتها فرصة لتذكر الفاعلين أصحاب الخطاب ومتلقيه، وانطباعاتهم وتحولاتهم، وفرصة لفهم العلاقات الاجتماعية؛ مَن المسيطر والتابع فيها، وفهم العواطف والمشاعر التي ارتبطت بالحدث-الكلمة، وفهم الطفرات المدلولية المرتبطة بتبدل الواقع سريعًا. بذلك تكون الكلمات تواريخ صغرى لا يُمحى فيها الفرد لصالح جموع.
هذا التمرين التأريخي المبني على استعادة لحظة 2011، بمشاعرها المحمولة في اللغة ولكن بدءًا من مشاعر الآن، هو تأريخ يتخفَّف من صنمية اللحظة الثورية، ومن جعلها «تراثًا» أو فولكلورًا هوياتيًا جامدًا غير متفاعل مع الحاضر، كما يتخفف من جعل التاريخ ثقيلًا، أو ما أسماه أحد الفلاسفة: «حمى التاريخ». في إعادة تفحص تاريخ الأفكار، نتخفف من إعادة وتكرار «الذكرى» كعَرَض لذاكرة مرضوضة تستغرق في استعادة الألم والرضّ؛ ذاكرة هي متحف للموتى. التذكر الديناميكي كمضاد للذكرى السكونية يستبطن الحق بالنسيان والإقدام عليه ونزع التعلم، ولكنه لا يعني على الإطلاق الإنكارية أو المراجعة للحدث/ الحقيقة/ الواقعة التاريخية. النسيان لا يعني أن نقول إن هناك «حقائق» بدلًا من «الحقيقة».
قرأت مرة هذه الصورة البلاغية التي تحاول تفسير تصور فالتر بنيامين للتاريخ: أن التاريخ يتلمس حائط المقبرة بخفّة، ويتقدم والذكرى موجودة في قلب المقبرة تنتحب بذاكرة حارّة مؤلمة. ربما اللغة هي التذكر الذي يسمح بسحب الذاكرة المُنتحِبة نحو التقدم. إن أكثر ممكن ثوري هو موجود الآن، وهو قراءة الآن. عندها ينبغي على كل قراءة لأي نصوص وخطابات ووثائق أن تكون مرتبطة بالممكن الآن، وبالسديد الآن. وكذلك فإن تحديد سياقات استخدام لغة ما؛ السياقات التاريخية والظرفية، مفيد لنفهم أنها لم تعد سديدة، أو أنها فارغة باستعادة رجعية.