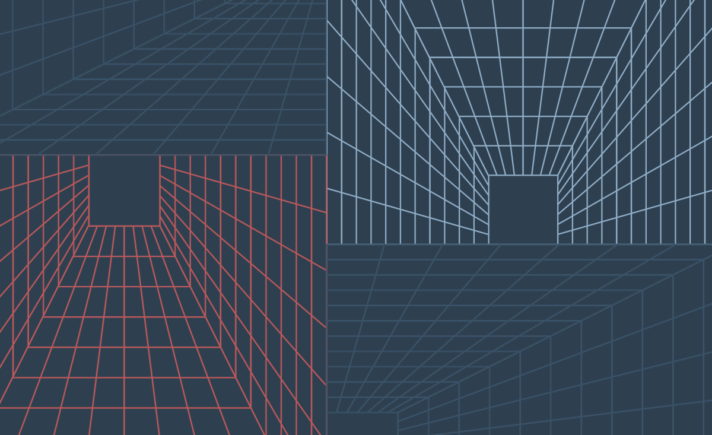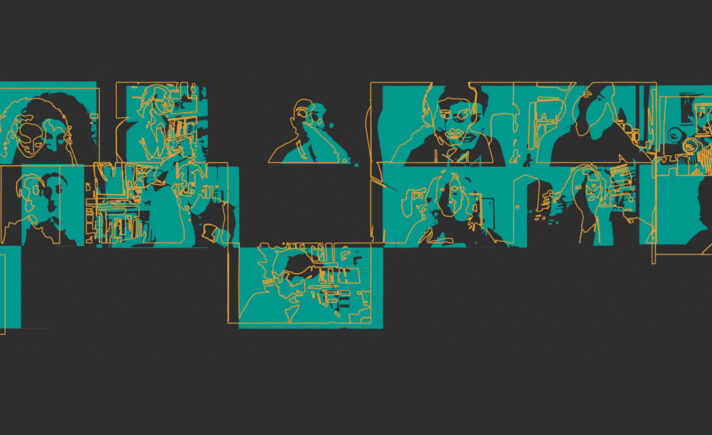إن كان هناك ما ميّز العام الماضي هو «الشذرات»، والشَذَرة هي القطعة والفقرة. والفعل منها شَذَّرَ أي فَصل وقطّع. وهكذا كان عامنا: عيش مستأنف بين إغلاقَين، صمت ودّي للعقل بين فكرتين مضطربتين، تناقض حميمي لإفادة من ذات النسق. ويرافق كل هذا، كوصيّ بالغ أحياناً وسلطوي جبان في أحيان أخرى، انعدام تام للرؤيا: انكفأ المستقبل على الآن واكتفى بحدوده ورغباته. وجد البعض عزاءهم في التواء الزمن على نفسه، فرأوا ازرقاقا غامقاً بين شذرة وشذرة، غصوا وهم يلهثون طوال الوقت هاربين منه. آخرون لم يسبروا غور هذه العتمة، فابتلعوا «بهجة يائسة» كي لا يغصّوا بأي من مركباتها على حدة.
وعلى هذا النسق المتشذّر لعام من الصعب ألا يُفلت من أصابعنا، لصلاة انقطعت عدة مرات بسبب الحاجات المادية والوعي الزائف، نُنهي العام بشذرات أيضاً، ونستذكر أن للفعل شَذَّرَ معانٍ أخرى: أن تُصرِّح بعيوب، وأن تزيِّن، وأن تتأهّب لقتال وشرّ، وأن تختلف مذاهبنا، وكلها تصلح لأوقاتنا غير المتماسكة…
(1) الصوت
لقد مرّت عشرة أعوام على الثورات العربية. وما هي الثورة إن لم تكن ضجيجاً؟ الكثير منه أيضاً. ضجيج على خلفيّة اختناق، خنق متعمّد للقدرة على الكلام، للرغبة به، كائن متحدث وموضوع كلام ينصهران تماماً ويصبحان واحداً. الثورة كصوت هي أن يصبّ بنا الكلام في مكان جديد فيفاجئنا، أو مكان نألفه ولكنه لنا. كلام غير مكرر، وكأنه يصدر منا الآن ولا يعرف كثيراً عنا وعنهم، وكقوة تضرب الآن جذوراً في الأرض، لا تنظر إلى الوراء، تفكك مفاهيم لغوية وتُحيلها إما بلا معنى أو فاعلة أولى وأخيرة.
وفي الضجيج الكثير من اللغط أيضاً، ففي استعادة القدرة على الكلام الكثير من التلعثم وعدم المعرفة والتيه.
كنا نعرف الشعارات الكبيرة، ولكننا لم نكن نعرف أنفسنا ولا قدرتنا على الكلام. ليس بحميمية الصراخ الجماعي. كان متنفّساً جديداً لم يكن متاحاً. تمرّناً أيضاً على الاستماع حيناً، والإخراس أحياناً. نفعل الآن على الملأ ما كان عصياً على الصدع حتى في أوهامنا: نُصدر أصواتاً.
على هامش الصوت، تفجّرت ثورات جانبية، كبيرة وصغيرة، محلية وعالمية، شخصية، جماعية وهوياتية. غبنٌ هناك كان كبير، وهنا لا معنى له، وما اعتقدناه التأم، وما كان منه إلا أن تحوّل إلى غبن أكثر ذكاء وأقل ضلالاً. لا يريد انتقاماً، ولكنه يبغي عدلاً بجلالة الكلمة وضحالة تجليها.
الصوت فعل بناء.
(2) الصمت
ليس صدفة أن الكثير من النساء وجدن أصواتهن خلال العشر سنوات الأخيرة، في العديد من الأماكن وعلى العديد من المستويات، وإحدى هذه كانت صاخبة: شهادات التحرّش قالت ما كنا نعرفه وخنقناه، وعلى خلفيّة الاختناق، واستعادة الصوت والقدرة على الحديث أيضاً، لم يُسعفْنا التلعثم، لأن الاتهامات كانت جاهزة (ضد النسوية، ضد فعل التصريح العلني، ضد الشهادة)، فصاحبَ ذلك فقدان للسذاجة؛ للوقت اللازم لترتيب الفروق الدقيقة ولمواجهة قوة فعل البوح.
كنا بحاجة لبعض الوقت لإعادة ترتيب علاقتنا مع ما قيل إننا شيّدناه في ليلة وضحاها: «محاكم ميدانية». أيُمكن أن تحكم خارج قاعات العدل؟ أيمكن أن تعترف خارج أريكة المعالج النفسي؟ أهناك حقائق مرتجِفة، أم كلها دامغة؟ لماذا قيل محكمة ميدانية ولم يُقل «شهادة علنية»؟ أتحمل كل شهادة حكمَها كطيف ملاصق، أم أن بإمكانها أن تصطاده أو تتجنبه بحسب الضرورة؟
يذكّرنا جاك رانسيير أن ما يجعل المصطلح مصطلحاً سياسياً هو الصراع على معناه، وهذا الصراع السياسي هو على الكلمات.
وهكذا قد يساعدنا أن نفهم قوة الشهادة العلنية كفعل غير معياري إن بحثْنا عن معانٍ أخرى للحقيقة. مثلاً، يقترح هايدغر (بناء على الأصل اليوناني لكلمة حقيقة: أليثيا ἀλήθεια) أن نفهمها كانعدام للتخفي، بهذا المعنى فهي لا تمت بصلة لبنية الوقائع الفعلية والإثبات أو الإقرار. الحقيقة ككشف عن المخفي، عن المنسي، عن المشوّه؛ وليس كصوابية. وتُسعفنا هنا اللغة العربية – لأن الحق والحقيقة وإن كانتا ترجمة جيدة لـtruth إلا أن الأولى هي في ما وُضع من القول للأمر الحسن والمستحب، والثانية ما وضع من القول حسناً كان أم قبيحاً. وإن حررنا الخيال، بإمكاننا أن نرى الصوت كفعل خفّة: أن تتخفف من ذاتك فتكشفها.
(3) الصمت والصوت معاً
جدلية الصوت والصمت هي إشكالية الاعتراف الأبدية: أيُّ الكلام هو أكثر مما يجب، وأيُّه لا يكفي؟ هذا السؤال في جوهره أيضاً سؤال جندري.
ومن ثم: أين يذهب كل هذا الكلام بعد أن يُصيب أو يَخيب؟ حتى ونحن نقول، بكل ثقة؛ ما هو «حقيقة»، أن بإمكاننا أن نأسر الخيال أو أن نحرّره، تبقى الفائدة والمعنى تنافسان الحقائق على كثافتها، وتسأل دائماً عمّا يمكن أن يُصرَّف إنسانياً؟ أيُّ عتمة بإمكاننا أن نتشاركها إنسانياً، وأيُّ عتمة بإمكاننا أن نتيه فيها عن وجودنا المشترك؟
«الاعتراف فعل كلامي، من خلاله يؤكد المتحدث على من هو، يربط نفسه بهذه الحقيقة، يضع نفسه في علاقة تبعية مع الآخر، ويغيّر في الوقت نفسه علاقته مع ذاته»، يقول فوكو. الاعتراف إذن لا يقول الحقيقة فقط، وإنما يصنعها، يتخيّلها، ويؤدّيها أيضاً. هكذا مثلاً نفهم أن الشهادات العلنية تصنع ذواتٍ حتى وإن أجّلت سؤال العدل.

هذا ليس تمريناً في الحق عن التعبير عن الذات، ولا هي قضية حريات عامة وخاصة. هذه حقيقة لها ثمن، ولهذا بإمكاننا أن نسميها حقيقة سياسية. ولكن كي تبقى كذلك قد تكون هناك حاجة لنتخيّل الشهادة بشكل مختلف بنيوياً وجوهرياً عن الاعتراف الذي يأتي على ذكره فوكو. قد يكون عليها أن ترفض إغراء البوح والاستفاضة. لربما ستتلعثم، ولربما يأسرها خيالها، فنصدّق بخيالنا نحن – المستمعين إليها – ما ترويه هي. وقد يكون من الضروري أيضاً على الشهادة، كي تكون حقيقة سياسية، أن تتم خارج أروقة أريكة العلاج والمحاكم، لأنها تواجه قوة فعليّة ولا تتخلص فقط من ترسّبات ماضيها. بهذا تختلف الشهادة بنيوياً عن الاعتراف بكونها أداة عملية، لديها أهداف. وقد يكون هذا دور المستمع أكثر من المتحدث. علينا نحن، المستمعات والمستمعين، المتضامنات والمتضامنين، أن نسأل ما الذي سنفعله كي يحلّق خيالنا ويقدر على جذب الممكن والمُعلَن. وأن أَسَرَ الكلام الخيال، هل باستطاعة الصمت أن يحرّره؟ ما دورنا في صناعة المساحة التي ستُترك لنا بعد أن يجترحنا كل هذا الكلام، فنؤكد على حاجتنا بأن يكون هناك معنى لكل هذا الدمار؟ معنى لا يشبه الوجهة التي قصدناه منها. فأيُّنا لا تُفتتَن بالخروج منتصرةً من معركة ملحمية هي أداتُها. غايتنا ألا نخرج بأكتاف محنيّة أكثر، وبألم فائض لا حاجة به. ليس مهماً من أي ضفة سنسبح في هذا الألم، أو هل سنقفز من ضفة البرّ أم من ضفة الإثم. سننتهي كلنا هناك – غرقى أو ناجين. نريد وبحق أن نخرج وقد تعلّمنا شيئاً ما.
لنُعِد إذن للأسئلة مكانتها، دون أن ننسى بعض الأمور الجوهرية أو نسهو عمّا تعلمناه بجدّ وتعب: إن الشكّ هو مبحث المسؤولية، وإن اليقين هو مبحث الحبّ، وإننا نتمسّك بالاثنين ولا نفاضل. نخطأ ونندم ونُعيد الاعتبارات، ولكن لا نريد أن نمشي بجنازات وهميّة. وإذا كان لا بد من موت، فليكن ذاك الذي نتعلّم من بعده شيئاً عن الحياة، وليس عن إفسادها.
الخلق الحقيقي هو الخلق المحرَّر من الماضي.
(4) الحقيقة
الصمت وهو يؤجل البناء، يبني. في علاقات غير متكافئة، رفض الانكشاف هو ربما خوف من الحقيقة، ولكنه أيضاً فعل مقاوم: أن تخلد كلماتك للنوم بجانبك. وهي تشبهك. لأن حقيقتنا أحياناً هي الفعل وليس القول. فقد يخدع القول في كل مرة يعتقد أنه يؤثث المكان ويجمّله لما هو جديد، وهو لا يفعل إلا أنه يكرر ذاته. في التكرار تأزيم للحقيقة، والحقيقة لا تحتاج إلى تثبيت.
وفي الاعتراف أيضاً قولٌ أكثر مما نعرف، لأنه يفترض البوح وليس الكلام، أي التطهّر (كتقنية دينية). فتصير وأنت تقول تصنع، وتصنع ما تصيره. من هنا قول جاك لاكان عن «ولادة الحقيقة بالكلام»، ولهذا أيضاً ادعى أنه لا يمكن أن تقول إلا أنصاف الحقائق.
تحرّرنا الأفكار العائمة من التمترس بهوية وحقيقتها، فلا تولد حقيقة ولا تموت أخرى، بل تستأنف الروايات كلها وهي تراها تطفو على أطراف الحديث، المحكي منه والصامت، ولا تأسر خيالنا. هذا لا يعني أن علاقتنا مع الواقع تصبح غثة أو هزيلة؛ على العكس، نحرّر خيالنا كي يعود الواقع إلى جذوره الممكنة الوحيدة: بناء جسور «الثقة» حيث يغيب اليقين – هذا الشيء البشري الوحيد المتاح لنا، والذي بإمكاننا أن نفتخر به كإضافة حيوية وإنسانية على جوهر الطبيعة المتقلب، فيصير مردود الخيال ودياً وساحراً أكثر.