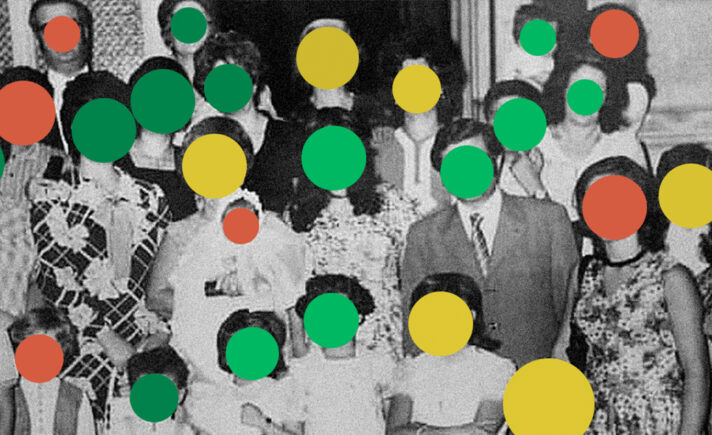لمرضى الأورام علاقة خاصة مع مشافيهم. تتهادى هذه العلاقة ما بين العشق المطلق لها في تجلٍّ لمتلازمة ستوكهولم تبحث عن خلاصٍ من المرض فيها ومنها، وبين الكره الأبدي لها كردّ فعل على الخوف والألم وروائح الموت المعقمة. وهي علاقة تشبه علاقة المؤمن/ة ببيت الإله الذي يعبده/ا، هو جانب قيمة الحياة واستمراريتها. وتختلف إلى حدّ ما عنها، وتحديداً لجهة معنى هذه الحياة وجدواها. وكأي «مريض» (Patient، «صبور» بالإنكليزية) تراني أذهب إلى مشفى الأورام خاصتي وأعود منه بشكل دوري، على اختلاف المدن التي تطأها قدماي. من حلب إلى بيروت واليوم ميلانو، سبع سنوات وأنا في ذهابٍ وعودةٍ مستمرين لمشافي الأورام، تتعدد أسبابهما. فآخذ مواعيد لإجراء فحوص وصور مقطعية، وأخضع لعملياتٍ جراحيةٍ على تنوّعها، وأتلقى العلاجات الإشعاعية والكيماوية.. وجميع هذه الأسباب هدفها واحد: انتشال السرطان أينما حلّ، الفتك به وإيقاف تمدده.
شاءت الأقدار أو شاء جسدي أن يعود السرطان مرةً أخرى، لا يهم أين أو كيف، لكن ما يهم وكما نعلم جميعاً (أكثر من اللازم، ربما) أن وباء الكوفيد حاضرٌ بيننا اليوم، يوحّد جهود البشرية تارةً ويقتلها تارةً أخرى. ولحظي الخلّاب، أقطن في منتصف مدينة ميلانو، عاصمة إقليم لومبارديا، التي تُعدّ بؤرة انطلاق الوباء إلى جميع زواريب إيطاليا وأغلب حارات القارة العجوز على الأرجح.
ماذا يعني أن تكون مصاباً بالسرطان، أو أي مرضٍ آخر في بلدٍ ليس بلدك، لا تتكلم لغته، وشكلك يُنَقّط شرق أوسطيةٍ في فترة صعود يمينه، وفي حضرة وباءٍ عالميٍّ يثير الهلع والفوضى في كل مكان؟
تزداد غربتك غربةً، ويتضاعف خوفك من إهمالٍ ممكن، وإلى حدٍّ ما مفهوم بسبب حالة الشك، الفوضى، ورهاب تفضيل ابن البلد «المريض». تراقب الكوادر الطبية والمشافي تعمل بطاقتها القصوى في مختلف الاختصاصات، ما يؤدي إلى شلّ قدرتها وتعب كوادرها بعد فترةٍ وجيزة. وتتباطأ الإجراءات الطبية، وتطبّق سياسة الأولوية في العلاج بشكلٍ أكثر صرامة.. تحوّلٌ رأيته يحصل إلى حدٍّ ما أمامي، في مشفى الأورام خاصتي.
لكن، وعلى عكس ما توقّعه لي رهاب «تفضيل ابن البلد» عليّ، أنا السوري الذي كنت سأُحسب في عداد الموتى لو بقيت في وطني، إن بسبب الحرب الطاحنة أو بسبب نوعية علاج السرطان، تم وضعي كأولويةٍ للعلاج، وقيل لي إن القرار اتّخذ نظراً لعمري الصغير وندرة السرطان خاصة جسدي وشراسته. لم يفضّلوا البدء بإنقاذ حياة ابن البلد الإيطالي قبل حياتي، أو، بلغةٍ أكثر رأسمالية، لم يتم حصر موارد وطاقات مشفى الأورام بأبناء البلد فقط، لا بل اتسعت لتشملني أنا، «الغريب» السوري، في أكثر الأزمنة صعوبةً على إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية. يحلو لي أن أتذكّر الآن أصوات أصوليّي منطقتنا وهم يسخرون من «أخلاق دول الغرب» و«ادّعاء حقوق الإنسان».
بعد حوالي أسبوعين من اكتشاف عقدةٍ لمفية قد تكون مصابةً في آخر العنق تحت عظم الترقوة، حان موعدي مع مبضع الجرّاح في المشفى. تزامن موعدي هذا مع بدء إجراءات حظر التجوال بسبب انتشار الوباء، وكان الإجراء الجراحي المقترح يومها عملية استئصالٍ يشارك فيها جرّاحو عظم لنشر عظم الترقوة، وجرّاحو سرطان لاستئصال العقدة المشكوك فيها تحت العظم السالف ذكره. انطلقت إلى المشفى واضعاً كمامتي على فمي، لابساً الكفوف المطاطية في يديّ، وملقياً حقيبة التخييم في المشفى على ظهري. فأنا سأمكث هناك لحوالي أسبوع، بعد تقطيع الأطباء جسدي وانتشال الورم.
الشوارع فارغةٌ تماماً من ناسها. إنها الثامنة صباحاً في منتصف الأسبوع. عادةً، في مثل هذا الوقت، تكون وسائل النقل كعُلب الكونسروة، ممتلئةً بالبشر بدلاً عن المخلل. لكنّ الوضع اختلف في ظلّ الوباء، وأصبح المترو علبة خوفٍ من الآخر. كنا أنا وخمسة أشخاص في المترو كله، «نزاور» بعضنا البعض لوجودنا هنا وحسب، حاملين بأيدينا ورقة التصريح التي تفيد بسبب مغادرتنا المنزل، لنظهرها للشرطة في حال توقيفنا.
تذكّرني هذه الورقة بـ«دفتر العسكرية» في سوريا للشباب: إن خرجتَ من المنزل من دونه، يكون مصيرك بين يدي الأمن العسكري إذا ارتفعت حظوظك، أو على الجبهة في الخطوط الأمامية للاشتباك عند انخفاضها. كذلك هي الحال مع التصريح الخطي في إيطاليا: إن أوقفتك الشرطة الإيطالية وأنت لا تملكه، تدفع غرامةً كبيرةً تتراوح ما بين 400 و3000 يورو، ويتم وضع إشارةٍ بالمخالفة على سجلك المدني.
خرجت من المترو بعد رهاب مسك أيّ عمودٍ فيه كي لا أصاب بالفيروس اللعين، وبدأتُ السير باتجاه المشفى. في طريقي هذا، أمرّ بجامعة الهندسة الأهم في ميلانو، الـ«بوليتيكنيكو»، التي يجتمع أمامها وفيها عادةً جحافلٌ من الطلاب والطالبات فأحسدهم على طبيعية حياتهم وأنا أحثّ الخطى إلى مشفى الأورام. اليوم، لم أجد أحداً هناك، لا طلاب ولا عِلم ولا حسد. أحجار مبنى الجامعة العتيق تقف وحدها في هذا الصمت، تنتظر عيناً تراها وتشفق عليها. وها هي عيني التي تراها تشفق عليها، بينما تستمتع بجمال هذا البناء التاريخي للمرة الأولى بعد ثلاثة أعوامٍ من المرور به ذهاباً وإياباً بلا أدنى انتباهٍ لتفاصيله. يبدو أني كنت أنشغل عنه بالطلاب الذين أحسدهم عليه. ما علينا.. أتابع الخطى وأقطع حديقةً صغيرةً خاليةً هي الأخرى إلا من رجلٍ سكّير، يشرب البيرة كحليب الصباح، خارج الزمن وأوبئته، بينما يجرّ كلبين صاحبُهما ليخرج بهما من المنزل. لولاهما لبقي الرجل حبيس منزله بالقانون، والقانون اليوم يتيح حرية الكلاب وتنزّهها، لا البشر وأوبئتهم.

دخلت الباب الرئيسي للمشفى، وإذا بفريقٍ طبيّ متكامل يقف عند الباب: ثلاث شابات إلى اليمين وثلاثة شبّان إلى اليسار، يلبسون السترات الواقية الطويلة، ويضعون أقنعةً من البلاستيك على وجوههم؛ يعقّمون أيدي المرضى، يبدّلون كماماتهم بكماماتٍ جديدة، ويفحصون حرارتهم قبل الدخول إلى أقسام المشفى ومتاهاته.
أتممت الإجراءات واحدةً تلو الأخرى بسؤدد؛ شجاعة واعتزاز، وانطلقت إلى جناح تصوير الصدر ليؤكّد خلوّ الجسد من الكوفيد قبل تجهيزه للعملية الجراحية. كنا أنا وخمسة أشخاص في غرفة الانتظار، بيننا امرأةٌ مصريةٌ ورجلٌ ألمانيٌّ متقدّمٌ بالسن. أعتقد أنه ودَّ قضاء فترة تقاعده في إيطاليا، فخانته إحدى خلاياه.
حان دوري. استلقيت كالحورية على جهاز التصوير الذي يشبه آلة الزمن، وبدأت الألوان تتغير في سقفه بينما أنا ممدّدٌ داخله. أشعر بخوف الأطباء المستجد من الأجساد، يسيل من عيونهم خوفُهم من أجسادنا نحن مشتبَهي الإصابة بالكوفيد، يختبئون منه خلف المعقمات وألبسة روّاد الفضاء، كي لا ننقله إلى معدّاتهم وآلاتهم وأجسادهم. في السابق، كان الخطر بالنسبة إلى الأطباء يكمن داخل أجسادنا، نحن مرضى السرطان؛ خطرٌ يفتك بنا نحن قليلي الحظ. أما الآن فقد أصبحنا متعددي الأخطار، قنابل موقوتة بزمنين: زمنٌ بطيء يوقّت التهام السرطان لصاحبه، زمنٌ شخصانيّ وذاتيّ؛ وزمنٌ سريعٌ هو حمل الكوفيد ونقله بأبسط الطرق، ذاتيٌّ أيضاً لكنه يسعى إلى الآخر، يشاركه الفيروس من دون قصد. كأنّ خطر السرطان قد تراجع قليلاً وتواضَع أمام الكوفيد الذي يقف بيننا هنا في غرفة التصوير في ميلانو بهياً مسيطراً.
أتممتُ الفحص ومنعني الأطباء فجأةً، بحزمٍ وبصوتٍ عالٍ نسبياً من أن ألمس شيئاً. صورة الرئة المقطعية أشارت إلى إمكانيةٍ عاليةٍ في أن أكون قد التقطته! يا للسخرية، هل يُعقل أن أحمل الكوفيد أيضاً، وأن أبدأ نوعاً جديداً من الآلام لا علمَ لي به ولا إرادة، وأن توافيني المنية بسببه؟ ألا يكفيني السرطان وعلاجاته، أيتها الحياة؟ هكذا تمتمت في قلبي بينما هم يمنعونني من أن ألمس شيئاً.
توجّهتُ إلى غرفة المحجورين على شاكلتي. وجدتُ فيها فتاتين من سنّي تقريباً؛ لم يتجاوز أيٌّ منا ثلاثة عقودٍ من العمر. لا شعر لديهما بسبب كيماويٍّ طائشٍ سرى في أوردتهن. مثلي، تجلسان مدهوشتين من سبب وجودنا في هذه الغرفة. أخذوا مسحاتٍ من فتحات أنوفنا الستّ ومن حلوقنا الثلاثة، وذهبوا بها إلى المختبر لتجزم حول إذا ما كنّا مصابين بالفيروس أم لا. ألقى أطباء السرطان محاضرةً علينا فحواها أنّه يجب علينا حجر أنفسنا والالتزام بوضع الكمامات والابتعاد قدر الإمكان عن البشر ريثما يخبروننا بالنتائج. تأجّلت الجراحة إذاً، فعدتُ إلى المنزل لأحجر نفسي من جديد، متناسياً السرطان الذي يقطن صدري.
في اليوم التالي، أتت نتيجة مسحة الكوفيد سلبية، فعاد الهمّ ليتموضع في إمكانية وجود سرطانٍ جديدٍ في صدري. تأجّل موعد العملية بانتظار إجراء صورةٍ جديدةٍ يمكن أن تنفي ما شهدوه في الصورة السابقة من ارتشاحاتٍ على الرئة. فقد تكون هذه الارتشاحات التي أظهرتها الصورة ناتجةً عن إصابتي بالكوفيد فعلاً، قبل التصوير بحوالي الأسبوعين، لكنّ المسحة ظهرت سلبيةً يومها لأن زمناً طويلاً قد مرّ على حملي للفيروس، فلم تستطيع مسحة الكوفيد كشفه، ما يعني عدم دقة المسحة المأخوذة يومها.
بطبيعة الحال وبكل الأحوال، بقيت في المنزل محجوراً، أقتل الوقت بمحاولات قراءةٍ فاشلة وبمسلسلات نتفلكس فاشلة هي الأخرى.. أطلُّ من شبّاك غرفتي الجامعية على الشارع، لا طير يطير ولا جحش يسير.
لا أعلم إلى أين ستأخذني هذه الرحلة، رحلة علاج السرطان هذه، ربما لشفاءٍ ما أو لفناءٍ ما. ولا أعلم إلى أين سيأخذنا هذا الوباء، لعالمٍ أكثر عزلةً أم لعالمٍ أكثر تعاوناً وانفتاحاً على الآخر. لا أعلم كيف سأُخرِج أصوات سيارات الإسعاف من رأسي، هنا الآن في ميلانو، وهي تركض لتنتشل من يختنقون في بيوتهم. كيف أقطع تقاطعها في رأسي مع سيارات إسعاف مدينتي حلب منذ 4 أعوام، التي كانت تولول هي الأخرى لانتشال من أصبح تحت الأنقاض، أو من بُترت قدمه أو يده. تحاصرني ضغوط الوباء على المستوى المحلي، فأرقام المصابين والموتى بازديادٍ هنا. وتحاصرني بدورها ضغوط التنبؤات المستقبلية حول ماذا سيحصل لو ضرب الوباء بلدي سوريا، فلا أستطيع تصور أو استيعاب مدى المأساة التي ستقع. لا داعٍ للإشارة إلى أن النظام سيكون ممتناً كلما نقص عدد الشعب بأوفر الطرق..
وما بين هذا وذاك من دوامات الأفكار، أتمالك نفسي وأقول لها: ما رأيك ببيتزا ساخنة يجلبها لنا شابّ التوصيل، قدّس الله سره؟