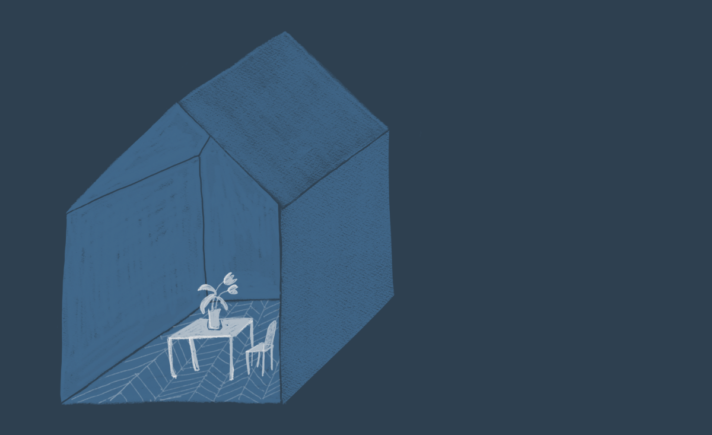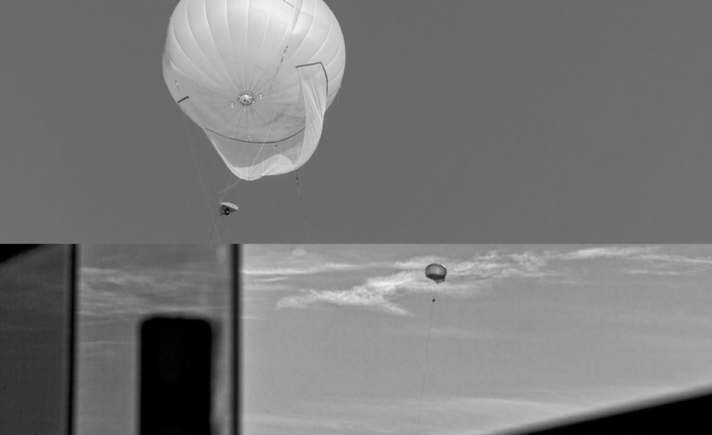عملت الحركات النِسوية على جبهاتٍ عديدة؛ بدءاً من السياسية الاجتماعية التي عملت على تحرير المرأة من السلطة الأبوية في بنية اجتماعية طويلة الأمد، ووصولاً إلى مَنْ ناضلَ لإدخال المرأة إلى الحقل السياسي، ولدعم صوت النساء ضد خطابٍ ونظامٍ مؤسساتيّ ممنهج. بطبيعة الحال، كانت الكثير من الحركات تعمل أيضاً على تحرير النساء من الحال العبودي ومن العنف الشديد الذي نشهده حتى اليوم في أحداثٍ عديدة وأماكن مختلفة. كما كان لبعض النسويات عيونهنّ النقدية التي ساقتهن إلى نقد وتفنيد المفاهيم الفلسفية التي تشكّلت، تاريخياً، من منظور ذكوري، والمتحيزة للرجل علانيةً، أو تحت أغطيةٍ من التبريرات العقلانية و«الموضوعية».
في الجمهورية التي نَظّر لها أفلاطون، اقترح وجود المرأة في أعلى منازل المجتمع، ووضع قدرتها على الحماية والدفاع عن الجمهورية في فئة الحرّاس الجمهوريّة، ولكنه شكَّ بوجود اختلافٍ بالقوة لصالح الرجل. وكان لأرسطو أن اتفق مع أفلاطون حول العدو والنفس والأطفال، لكنّه اختلف معه في ما يخصّ النساء، فيقول أرسطو: «إن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة الدونيّ مع الرجل المتفوق، ويجب أن ننظر إلى شخصية المرأة على أنها نوعٌ من عطبٍ في الطبيعة». تطوّر هذا «العطب» في خطاباتٍ أكثر تعقلناً، تسعى إلى تأسيس جذورها للفهم الاجتماعي والسياسي لقرون مديدة، ومحتفيةً بالذَّكَر كفاعلٍ سياسيّ اجتماعي، وكوكيلٍ اقتصادي مُنتِج ومُحتكِر؛ ترسيخاً لبنيةٍ أبستمولوجية تُشرّع الهيمنة الأبوية وسطوة الذَّكر الفرد.
عن فلسفة الحداثة ومصادرة العقل: بدايات نفي المرأة من النطاق العام
في وقتٍ لاحق، مع بداية الفلسفة الحديثة، انتقل الفلاسفة إلى مصادرة العقل كمصدر أخلاقٍ من المرأة لصالح الرجل، فكان لإيمانويل كانط أنْ جرّد المرأة من العقل بموجب المشاعر، معتقداً أن المرأة لا تستطيع أن تفعل الشر «لأنه ليس جميلاً»، حيث يكون الجمال مركز حكمها. وذكر في كتابه نقد العقل المحض أنّ فلسفة المرأة هي الإحساس وليس المنطق. أما توماس هوبز، الفيلسوف السياسي، فيعتبر انتقال العقل من حال الطبيعة والعنف الدائم إلى شرط النظام السياسي والقانوني، بمثابة خروجٍ من الصراع الوحشي الخاص بالذكورية الإكراهية. إذاً، الانتقال إلى حياة القانون كانت متحيّزةً للرجل المُشكِّل للجسم السياسي المُبتغى، بعد قدرته على عقلنة حال الطبيعة العنيف، وفهمه المنطقي لضرورة تأسيس عقدٍ اجتماعي ليعم السلام.
اجتمع الفلاسفة عبر التاريخ ليقولوا إنّ العقل والعقلنة هما الآلية والمصدر لتحقيق الأخلاق، وتكون الأخلاق هي المسؤولة عن اتّخاذ القرارات والأفعال بعد تداولٍ منطقيٍّ عقلي، فالعقل يسعى لعالمٍ أفضل؛ لمجتمعٍ قادرٍ على تحقيق أهداف العقد الاجتماعي، التي يتخطى فيها الإنسان «طبيعته الوحشية». لكن كان الرجل هو المعنيُّ دائماً بالنظرية الأخلاقية؛ لأنّ التطبيق يشترط العقلنة التي يتمتّع بها، بينما كان السائد أنّ المرأة هي كائنٌ عاطفيٌّ أكثر من كونها تستند إلى العقل، حيث يصير الرجل هو المعنيّ بالنظرية الأخلاقية نتيجة قدرته على العقلنة، بينما المرأة صاحبةُ مشاعر تُفضي إلى قراراتٍ بعيدةٍ عن الأخلاقي، وبذلك ترتبط الشروط العقلانية بالرجل، في المستويين العملي والرمزي.
حسب الفيلسوفة النسوية فيرجينيا هيلد، نرى في هذه الثنائية: المشاعر/العقل، تعزيزاً لمركز الرجل وسيادته، وخاصّية العقل هي أحد الأسباب المزعومة التي دفعت بالرجل ليكون في مراكز الحكومة والدولة وصناعة القرارات. كان ذلك يعني أنّ المرأة، في هذه الصورة منقوصة الخصائص الإنسانية، تعود إلى كونها أقرب للطبيعة؛ متطابقةً مع صورة الطبيعة الأم والأمومة؛ فالأم تقوم بتربية أطفالها وإدارة منزلها، لكن ليس كواجبٍ أخلاقيٍّ يساهم في بناء المجتمع، بل كوظيفةٍ غرائزيةٍ طبيعية لا تحتمل المحاكمة العقلية. لذا كانت المرأة منفيةً من الحكم الأخلاقي، ولا يُنتظر فعلٌ أخلاقيٌّ نابعٌ عن عقلنتها. وبعض فلاسفة التنوير، مثل روسو، أقرّ بأنها تحتاج إلى أن تُدرَّب منذ الطفولة على أن تخضع لإرادة الرجل العقلانية.

هذا ما أفضى إلى ثنائيةٍ أخرى، وهي الفضاء العام/الخاص. يُعرَّف الفضاء العام بكونه المساحة التي يجب في نطاقها تخطي الطبيعة الوحشية للإنسان إلى الطبيعة الاجتماعية. بينما يكون النطاق الخاص، المنزل، مكان الطبيعة الذي يحتوي الكائن الطبيعي، وهو المرأة ككائن مُنجب ومُربّي بشكلٍ متكرّرٍ ودائم. كانت المرأة تُعرّف قبل الثورة الصناعية على أنها كائن الإنجاب والتكاثر؛ على أنها أمٌّ فقط، لا وظيفة لها سوى هذه الوظيفة البيولوجية والتربوية كغريزة طبيعية، شبيهة بأنثى الحيوانات. فكانت النظرية الأخلاقية لا تُطبّق في البيت، فهو فضاءٌ لا يحتمل التداول والأعراف الأخلاقية، بل هو فضاء الطبيعة، أو نطاق الأنثى التي عُرِّفت كمخلوقٍ عاطفيّ يعمل بطبيعته من أجل الإنجاب والتربية والرعاية، وهي أبعد من أن تُحاكَم أو تُحَاكِم أخلاقياً. وفي نفيها من الفضاء العام فهي منفية من كونها كائناً سياسياً؛ إذاً هي غير قادرة على أن تكون في أجهزة الحكومة وصناعة القرار، ولا في العمل والتجارة والتعليم، ولا هي قادرة على التواصل خارج كونها أم.
الماركسية كأبوية والنقد الماركسي النسوي: عن النظام الأبوي كـ«عدو أساسي»
أسّست الرأسمالية لانتقال المرأة إلى النطاق العام بغية تجنيدها في عمالة المصانع، وذلك بالتزامن مع تحوّلٍ لافت نحو انتشار الماركسية في الغرب كفكر تحرّري مادّي. كانت المرأة محصورةً مع الرجل في الإنتاج المنزلي في العصر الإقطاعي، حيث كان المنزل متماهياً مع الأرض؛ الأول امتداد للثاني، يُنتِج الرجل والمرأة من الأرض والزراعة والماشية، وهذا النِّتاج، بدوره، يذهب إلى السوق ليعود على العائلة بربح. ومع الدخول في طور العالم الصناعي، اتجه المجتمع نحو تقسيمٍ جديدٍ في سوق العمل، قائم على علاقة وسائل الإنتاج والجندر. ذلك التقسيم وضع الرجل خلف الآلة وخطوط الإنتاج، هناك حيث يكون مساهماً في السوق والناتج القومي الإجمالي للدولة؛ وكيلاً حصرياً للدخل الشهري. في المقابل، بقيت المرأة غالباً حبيسة المنزل. كرّستْ النظرية الماركسية كلّ جهودها لتحرير العمال، أما عن تحرير النّساء فأُحيلت أسباب معاناتهن إلى سطوة الرأسمالية، فما أن نتخلّص من النظام الرأسمالي حتى تتحرّر المرأة. لكنّ هذا تحررٌ معنيٌّ بالمرأة العاملة، في المصانع على وجه الخصوص.
جادلت النِسوية الماركسية كرستن دلفي Delphy, Christine and Diana Leonard. 1984. Close to Home: A Materialist Analysis of Women’s Oppression. Amherst: University of Massachusetts Press في هذا الصدد، منطلقةً نحو تحليلٍ ماديّ للمنزل بكونه نمط إنتاج استغلالي لا يعود بفائدةٍ على المرأة بوصفها عاملاً منتجاً يضعُ طاقته وجهوده في عملٍ يوميٍّ غير مأجور. العمل المنزلي على غرار العمل والجهد البدني للعمال في شرط المجتمع الرأسمالي، فالعمال، حسب ماركس، يضعون كلّ طاقاتهم في سلعٍ ليست لهم؛ يؤدّون عملاً لا يعود عليهم بأيّ تطوّرٍ ذاتي، بل إنه مأجورٌ بأدنى مدخول يمكن أن يتقاضاه العامل. تُلغي دلفي التصور عن علاقة الرأسمالية باستغلال المرأة كما أراد الماركسيون التقليديون القول، لتفصل العلاقة بين النمط الاستغلالي للإنتاج الرأسمالي واستغلال المرأة داخل المنزل بوصفه نمط استغلال أبوي للإنتاج. يتضمّن فعل الإنتاج هنا جميع المهمّات التي تقوم بها المرأة في نطاق العائلة، من تربية إلى طبخ وتنظيف؛ أي أنّ المرأة تُنتج للرجل في المنزل ما يُنتج العامل لصاحب العمل من قيمة فائضة. هي علاقة إنتاج مستبعدة من قيمة السوق، قائمة على افتراض أن قيمة إنتاج المنزل قيمة استخدامية لكونها تنتهي باستهلاك ذاتي، منتجةً الافتراض الثاني لدى الماركسيين بأنّ القيمة الاستخدامية لعمل المنزل غير معرّضةٍ للاستغلال؛ لكونها لا تحمل قيمة السوق، وأن عمل المرأة غير مأجور لأنّه لا يفضي إلى قيمة فائضة لبرجوازيّي المجتمع.
وعن المجتمع الأكثر تعقيداً اليوم، تبقى المرأة العاملة خارج المنزل معرَّضةً لضغوط المنزل الاقتصادية. حيث، ومن كونها امراةً عاملة، تقوم بتعويض غيابها عن العمل المنزلي بإنفاق أجرها على احتياجات البيت الإدارية؛ كأجر لعمال التنظيف ورعاية الأطفال من قبل مختصين. في هذا الامتداد للسطوة الأبوية على المنزل وعلاقات الإنتاج فيه، نرى الرأسمالية كامتداد للأبويّة، حاملةً لعناصرها الاستغلالية والاضطهاديّة ومشكّلةً لسلطةٍ اقتصادية أكثر تعقيداً. لتثبت لنا دلفي نظريتها بأن معاناة النساء لا تنتهي بتجاوز النمط الرأسمالي كعدو أساسي، كما يحلو للماركسيين التفكير؛ بل بتجاوز علاقات الإنتاج المنزلية وتحميلها قيمة السوق لتعود على المرأة بأجر. أو، كما اقترحت بعض النسويات، بتقسيم مهام المنزل بين الرجل والمرأة بشكلٍ عادل، ومنح إعانة للأمومة من الدولة.
ليس علاقات الإنتاج، بل علاقات الجنسانية: أبوية مُنتِجة لتمثّلات الحقيقة
تفتح النسوية والحقوقية كاثرين ماكينن في بحثها: النسوية، الماركسية، المنهج، والدولة: أجندة للنظرية Feminisim, Marxsim, Method, and the State: an Agency for Theory, Catharine A. MacKinnon; Signs Vol. 7 Number 3; 1982. النقاش نحو فهمٍ أكثر تعقيداً لاضطهاد المرأة، القائم في جوهره على العلاقات الجنسية في المجتمع الأبوي المُغاير جنسياً، على عكس الماركسية النِسوية السائدة بتحليلها المادي لعلاقات الإنتاج. تقدم ماكينن مقارنةً بين المنهج الماركسي والنِسوي باعتقادها أنّ ماهيّة الجنسانية بالنسبة للنِسوية مساويةٌ لماهيّة العمل عند الماركسيين، هو «أغلى ما يمتلكه المرء، ومع ذلك يُصادر معظمه». تحاول في تحليلها محاذاة الماركسين، ولكن دون التورط في أدوات التحليل المادي. وتعتقد أنّ الجنس مثل العمل؛ أي أنّ التقسيم الجنساني وتقسيم العمل كلاهما وسائل تحكّم وعلاقات سلطة، فما أن يعمل العامل من أجل مصالح الآخرين؛ أصحاب رأس المال، فهو يحقّق شكل الطبقة، وما أن يجري تشييء المرأة ككائن جنسي، فذلك يقيّدها ويضبطها، وهو ما يفضي إلى تحقيق تقسيم قائم على الجنسانية في العلاقات الاجتماعية. وترى ماكينن أنّ بنية هذا التشييء تعتمد بشكل رئيسي على بنية المجتمع المغاير جنسياً وما تتضمنه من عناصر الجندر والعائلة والتكاثر.
تشترك ماكينن بذات الموقف مع دلفي بنقدها للماركسية التقليدية؛ إذ ترى أن تقسيم المجتمع إلى طبقات كصراع رئيسي، العدو الأساسي فيه هو الرأسمالي، ضربٌ من العمى في إدراك هيمنة الرجل في المجتمع. فالرجل مهيمنٌ على المجاز الرمزي للمرأة: تمثيلاتها الجسدية، ومقومات الاجتماع ومعاييره، وإدارة الحياة الجنسية ضمن الصائب والجائز والخاطئ والمُحرّم. الرجل هو مصنع إنتاجٍ للأنوثة، بكونها هوية مفروضة على المرأة وموضوع الرغبة عند الرجل في آنٍ معاً؛ أي أنها ذاتٌ مجهزةٌ للخضوع والإدارة حسب الرغبة الأبوية.
إنّ اقحام المرأة ومعاناتها ضمن الصراع الطبقي وضرورياته التاريخية في التصور الماركسي، كان بمثابة امتدادٍ لحجج الأبوية التي تُصرّ على إدارة المجتمع تحت ذريعة تطويره وحمايته. تذكر ماكينن في المقال ذاته ماصرحت به الماركسية روزا لكسمبورغ بإدانة النِسوية غير الخاضعة للحتمية التاريخية للصراع الطبقي، واصفةً تلك النساء بـ«متطفلات الطفيليات»، ومصنّفةً ومُدينةً لأيّ تحركٍ نسائيٍّ خارجَ الصراع الطبقي، بوصفه خاضعاً للأيديولوجيا البرجوازية ويخدمها. مشيرةً لتلك النساء على أنهنّ مُنتَج الرجل البرجوازي. بينما ترى ماكينن أنّ هذا الاستنتاج، المُنطلِق من أدوات التحليل المادية، يُقحم النساء في تصنيفٍ أشبه بكونهنّ مجموعةً ثقافيّةً أقليّة، مشكّلةً علاقة خصام خالية من الديالكتيك في خضمّ الصراع ضد الرأسمالية، إلا إذا كنّ نساءً عاملات. في الخلاصة، فإن مسألة النساء عندما دخلت في حيز النقاش الفلسفي كانت دائماً تختزل نحو مسألة ثانية تخصّ صراع الرجال في عالمهم الذين يسيطرون عليه.
قضية النساء، حسب ماكينن، قضية أساسية غير قابلة للتجزئة أو الاختزال، تحاول ماكينن تحليل عالم أكثر تعقيداً من علاقات الإنتاج. نقرأ أثر سيمون دي بوفوار في فهم ماكينن للعالم كتركيبة من التمثيلات الذكورية التي تنتج «الحقيقة»، وتساهم في التباسات مُحددة لديناميكيات النفوذ وتنظيم الهيمنة الذكورية. هذه التمثيلات تؤدي، حسب ماكينن، إلى تسليع المرأة؛ أي رسم بنيةٍ مُشيّئةٍ لها عبر جنسانيتها، لتظهر المرأة كما لو أنّها حاملةٌ لقيمة الشيء في طبيعتها، وأن التركيبة الاجتماعية بريئة من عملية التّشييء هذه.
عطفاً على ما ذُكر آنفاً عن علاقة فلسفة الأخلاق والعقل، والماركسية التقليدية المُختزلة لمعاناة النساء وعدوهم، فإن للفلسفة جذورها الأبوية، المتعمّدة لاستبعاد النساء من كونهنّ صوتاً متفرّداً؛ كما في الماركسية، أو حتى فاعلاً اجتماعياً سياسياً كما في الأمثلة السابقة عند الإغريق أو في الفلسفة الحديثة. هنا، نحن بصدد خياراتٍ معرفيّة واعية تسعى لهيمنةٍ أبوية، سعت هذه الخيارات إلى إنتاج أساس النظام التمثيلي للمرأة على مرّ العصور في أكثر الحقول ترشيداً للواقع وعلاقات التفاعل الاجتماعية فيه؛ إذ أنها عملية إعادة تشكيل «الحقيقة» ضمن مفاهيم عقلانية متمسّكة بذات الأُطر الجنسانية وقصور خصائصها «الطبيعيّة».
ينتج ذلك أبويةً ذات دلالة نفوذ ذاتية غير مُكترِثة بتفعيل وتشريع نفسها؛ بسبب تلقائية منزلة المرأة «الدونية» في تمثيلات الواقع منذ ولادتها؛ حيث الهدف أن تكون ذاتاً مدرّبةً على الخضوع. تجدر الإشارة هنا إلى الكاتبة كيت مانيManne, Kate. Down Girl: The Logic of Misogyny; 2017. في تحليلها المعني بمنطق «كراهية النساء»، فهي لا تكتفي بتفكيك واقِعَيْ النساء وتاريخ الأبوية، بل عطفتْ هذه الهيمنة الذكورية على عصب كراهية النساء، كعنصرية جنسية ذات بنية تاريخية متينة. هذه الكراهية تعيد إنتاج نفسها عند إخفاق عقلنة الفوقية الأبوية ضمن ذريعة الطبيعة الجنسية. تعمل هذه العنصرية (misogyny) لتنظّم وتفرض سيطرة الاعترافات الأبوية بـ«حقيقة» العالم.