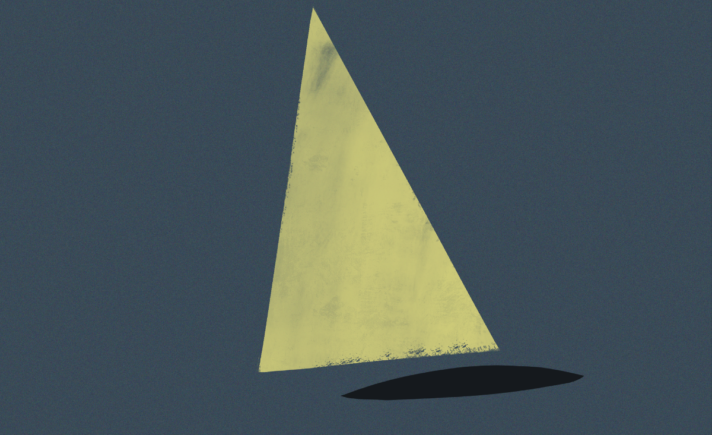يحكم الخوف والريبة زيارات العيد للسوريين، والتي يُسمح من خلالها للاجئين بقضاء إجازتي العيدين (الفطر والأضحى) داخل الأراضي السورية، ومن ثمّ العودة إلى تركيا وفق توقيتٍ محدّدٍ عبر رابط إلكتروني تطلقه الحكومة التركية في المعابر التابعة لها، منذ العام 2016. وقد مرت هذه الأذونات بمراحل مختلفة وقرارات ولوائح متعددة في كل سنة، لتتوقف هذا العام بُعيد أيامٍ من إقرارها بسبب جائحة كورونا. وكان من المقرر في العام الحالي أن تمتدّ «الإجازات» على معظم أشهر السنة، بدءاً من بداية شهر آذار(مارس) وحتى نهاية كانون الأول(ديسمبر). وترافق ذلك مع قراراتٍ تقضي بمنح إجازاتٍ أخرى من معبر قرقميش (جرابلس)، كان قد أقرّها والي عنتاب، وتقضي بالسماح للأشخاص بزيارة سوريا خارج فترة العيد، وذلك بعد الحصول على الموافقة.
الخوف والريبة
يقول بعض من تحدّثنا معهم، ومنهم غياث الحايك (يعيش في ولاية كلّس) وسعيد الياسين (يعيش في عنتاب)، وهما ممّن اعتادوا الذهاب في زيارة العيد، إنّ الخوف يبدأ منذ إقرار الزيارة، مع الشائعات التي تبدأ بالانتشار عن استحالة العودة مرةً أخرى إلى تركيا، والإجراءات الجديدة المُتّبعة للدخول والخروج. بعضها الآخر يتحدث عن رموز وأرقام توضع على ورقة الدخول، والخوف من ضياعها الذي سيؤدي حتماً إلى تحويلهم لعالقين. وينتهي هذا الشعور بالخوف ما إن تطأ قدمك سوريا، كما يخبرنا من تحدثنا معهم، لتبدأ الريبة قبيل أيامٍ من موعد العودة.
نفرح إن وصلنا ونفرح بالعودة، وينقسم شعورنا كما تقسّمت أوطاننا، بتنا نشعر أننا ننتمي للمكانين في آن معاً، وبنفس الدرجة، فحظّ اللاجئ دوماً أن يحمل قلقه، لا لشيءٍ سوى عدم قدرته على المطالبة بما ليس له؛ ما الذي يمنع الحكومة التركية من استصدار قرارٍ بمنعنا من العودة، أو إغلاق المعابر حتى إشعار آخر؟ السؤالان اللذان يرافقاننا دائماً دون أن نجد إجابة، سوى منهج الاعتياد، وأن ذلك لم يحصل في السنوات السابقة، ثم ما الذي يدفعنا إلى المغامرة؟ للسؤال هذا إجابةٌ واضحةٌ وإن تعددت الأسباب، إلا أن جميعها يصب في مكان واحد، بلادنا.
وسيرافقنا الشعور بالخوف طيلة مراحل هذا التقرير الذي نتحدّث فيه عن «إجازة العيد» في العام الحالي، وعن آثارها على الحياة العامة والسكان، إضافةً لأثرها الاقتصادي.
لماذا يواظب السوريون في تركيا على زيارة العيد؟
في عينةٍ عشوائيةٍ تحدّثنا معها، تضمّ نحو عشرين سورياً يعيشون في ولايات تركية مختلفة، كان الحنين هو الدافع الأول الذي يحكمهم لتكبّد مشاق وأكلاف السفر، وحدهم أو رفقة عائلاتهم. وكان الرجال أكثر رغبة من النساء بهذه الزيارة، كذلك الأعمار الكبيرة (ما يزيد عن 40 عاماً) من الفئة الشابة.
يُجمع من تحدثنا معهم، ومنهم أبو ناصر من جبل الزاوية ويعيش في الريحانية، أنّ للعيد في سوريا نكهة مختلفة، لما يعنيه من ارتباط اجتماعي بالعائلة وزيارة أقاربه، وحتى قبور أحبّائه؛ تلك الزيارة فرصةٌ لاستعادة الذاكرة والاطمئنان على من يعنينا أمرهم، وهي أيضاً مساحة للابتعاد عن أجواء العمل القاسي في تركيا، حيث يعمل أبو ناصر كبائع خضار بشكلٍ يوميٍّ دون إجازة منذ قدومه إلى تركيا في العام 2014، وللترويح عن النفس واستنشاق هواء القرية التي ولد فيها.
ويقول أحمد العلي، وهو مدرّسٌ من ريف حلب الغربي: «لم أتخلّف زيارةً واحدة. كنت أريد لوالدتي أن ترى أطفالي ليس على شاشة الهاتف، كنت أريدهم أن يتعرفوا على المكان الذي أتوا منه، وفي الوقت ذاته كنت أريد أن أبرّر لهم سبب رحيلي عن البلاد. مشاهد القصف والدمار والمقابر التي امتلأت، كل ذلك كان محوراً في زيارتي وتنقلاتي رفقة أطفالي. أردت لأطفالي أيضاً أن يتعرّفوا على أقربائهم». ويتابع العلي قائلاً: «غالباً ما كان القصف والطيران يعاود في كل زيارة عيد. عشنا بعضاً من هذه الأحداث، أحياناً كنت أندم وأتعهّد بعد رجوعي إلى تركيا بأن لا أعود مجدداً إلى سوريا، وعندما يحين الوقت لا أعرف كيف تقودني قدماي من جديد إلى هناك».
الحياة هنا مؤقتة ولا تصلح لسكنٍ دائم، يقول غياث الحايك. ويتابع حديثه: «كثرٌ من السوريين يعيشون حالة انعدام الاستقرار، يتحيّنون فرصةً للعودة والهرب من قلة فرص العمل والنظرات القاسية التي تطالهم كلاجئين، ربما الهرب من السمة ذاتها. في سوريا وخلال الساعات الأولى نعامل كضيوف، ثم ما نلبث أن نصبح أهل المكان. أما في تركيا فنفتقر للحالتين معاً، نحن لسنا ضيوفاً ولا سكاناً، بين هذين الوصفين نمضي أيامنا».
ويحكي لنا الحايك أيضاً عن الشعور بالحنين لكل شيء؛ «لصوت الباعة، لطعم لبن الغنم، للخبز الكبير الخارج من الفرن، لكعك العيد ورائحته، للفاكهة الموسمية، للسلام عليكم التي تُبادلها للجميع، للشوارع التي مررت بها ومشيت فيها. أحياناً للبندقية على كتف أحدهم، لليرة السورية، كل التفاصيل الصغيرة، والأهم من ذلك للأشخاص، هو حنين من يغبطك وتغبطه في آن معاً، ولكل منا أسبابه».
هناك دوافع أخرى، تتشعب عن الحنين وتفضي في جزءٍ منها إليه، ومنها الزواج، يقول فايز الخطيب، وهو شاب يسكن وحيداً في مدينة بورصة التركية بينما يعيش أهله في ريف حلب الشرقي، إنّه ومنذ ثلاث سنوات دخل تركيا للبحث عن عمل، ويخبرنا أنه الآن في سن الزواج، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتزوج بعيداً عن أهله، إذ تبحث له والدته عن عروس من قريته، شأنه شأن كثير من السوريين، خاصة وأن الزواج، حتى من فتاة سورية، في تركيا أمرٌ بالغ الصعوبة دون الأهل، فضلاً عن التكاليف العالية. يخبرنا أيضاً أنّه طلب إلى والدته فعل ذلك، وإنها في كل زيارة عيد تخبره بأسماء الفتيات اللواتي تعرفهن لخطبتهن. هذا العيد كان موعد خطبته إلا أن كورونا وإغلاق المعبر حالا دون ذلك.

مع إغلاق المعابر زادت العودة الطوعية إلى سوريا، وهو ما يعني تخلي العائدين عن حقهم بالحماية التركية لخمس سنواتٍ لا يُسمح لهم فيها بدخول الأراضي التركية من جديد، يضاف لذلك أسباب كثيرة كغلاء المعيشة في تركيا وندرة فرص العمل.
وفي كل عام كان عددٌ من الداخلين لزيارة العيد يجدون أنفسهم أمام قرار البقاء، ساهم في ذلك، خاصةً في ريفي حلب الشمالي والشرقي، الاستقرار وشبه الأمان الذي يسود المنطقة هناك. يقول أحمد السعد إنه قرر البقاء في سوريا في العام الماضي، دون عودة، وهو ليس نادماً، فقد «طقّت روحه في تركيا» كما يخبرنا، وهو في تركيا يعمل في مجالٍ غير مجال عمله، إذ اضطرته الظروف للعمل كـ«عتّال» في إسطنبول من أجل الحصول على لقمة عيشه، بينما يمارس عمله اليوم في أرضه التي يملكها بعد أن قرّر البقاء.
يلجأ كثيرٌ من السوريين الراغبين بالعودة إلى زيارات العيد كاختبارٍ للوضع وقدرتهم على البقاء، يقول السعد إنه فعل ذلك لسنتين قبل قرار البقاء، كان يدرس فيهما قدرته على الحياة والأمان المرتبط بحالة الاستقرار والتغيرات التي طرأت على الحياة في سوريا منذ خروجه منها.
ويخبرنا من تحدثنا معهم أنّ قرار التخلي عن الحماية المؤقتة كان دوماً يقابل بالنصيحة التالية: «روح عالعيد وشوف إذا الوضع مناسب»، كيلا يفقد حقه بالعودة. ومع المدة الطويلة التي منحتها الحكومة التركية للراغبين بالإجازة، والتي وصلت في السنتين الأخيرتين لعدة أشهر، بات الأمر أكثر يسراً، إذ يقضي قسمٌ من العائدين نصف سنة أو أكثر في سوريا، ليعودون عودةً مؤقتةً إلى تركيا ريثما يتم السماح بزيارة جديدة، بعضهم قرر البقاء بشكل دائم أيضاً بعد تكرار التجربة.
كذلك، كان الاطمئنان على ما يملكه الأشخاص من عقارات وأراضي ومتابعة أمورها واحداً من الأسباب التي تُوجبُ زيارة العيد، فضلاً عن الحصول على بعض الأوراق الرسمية أو الرواتب التقاعدية بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين يستطيعون الوصول إلى مناطق النظام.
بقرار إغلاق المعابر لهذا العام، فقد السوريون صلتهم بوطنهم الأم، وهو ما جعل قسماً منهم يعيش حالة اضطرابٍ وترقّبٍ في انتظار أيّ قرارٍ يسمح لهم بالدخول، بينما ينتظر السكان في الداخل وصولهم ككل عام.
انتعاش اقتصادي مفقود
يدخل في إجازات العيد السنوية ما يزيد على مئة ألف شخص سنوياً، بعضهم يبقون لأيام وآخرون لأشهر، وهو ما كان يساهم في زيادة انتعاش الاقتصاد المحلي. يقول محمد زيدان، وهو تاجر جملة بريف إدلب الشمالي، إنّ الأيام الأولى لوصول الزائرين كانوا يبدون فيها كـ«سائحين». ويضيف أنّ معظمهم كان يحاول التيسير على عائلاتهم وأقاربهم، سواء من خلال شراء الاحتياجات اللازمة أو الهدايا، وكانت مبالغ كبيرة تُضخّ في مثل هذا الوقت، مما يؤدي إلى «دورة حياة كاملة»، بحسب وصفه.
الاقتصادي أحمد عبد الكريم المُقيم في مدينة اعزاز، قال إن معظم المحلات، خاصة الألبسة والأغذية، كانت تتجهّز قبل وصول الوافدين إلى المنطقة لزيارة العيد، الذين بدورهم كانوا يصرفون مبالغ كبيرة، وبحسْبةٍ بسيطة يخبرنا أن أكثر من خمسة ملايين دولار شهرياً على الأقل كانت تضخ في السوق، بافتراض أن يصرف كل قادم نحو ألف ليرة تركية على أقل تقدير.
كذلك، ينتعش سوقا الصرافة والنقل في الوقت ذاته وترتفع الأسعار. يقول مصطفى الحافظ الذي يعمل كسائق حافلة إن «حركةً كبيرة تشهدها وسائط النقل العامة، وذلك لإيصال القادمين إلى قراهم أو إلى أصدقائهم، وبسبب فارق العملة، كانت الأجور أفضل حالاً من سابقتها. أما منير أبو علي، وهو صاحب محل ألبسة، فقال: «كثيرون من بين القادمين يسعون لشراء الألبسة من سوريا، سواء لأقاربهم أو لعائلاتهم، نظراً لكون أسعارها في سوريا أقل بكثير مما هي عليه في تركيا، كما أنها تناسب الذوق الذي اعتادوا على ارتدائه، خاصةً الملابس النسائية وملابس الأطفال».
ويخبرنا الصائغ علي الخطيب أنّ سوق الذهب أيضاً كان يشهد إقبالاً جيداً، إذ يمثل الذهب أحد أهم المدخرات للسوريين، وغالباً ما يقوم الوافدون بشرائه من سوريا، وذلك لاعتيادهم على الذهب السوري عيار 21 قيراط، بينما يسيطر العيار 22 قيراط على السوق التركية، بالإضافة إلى فارق السعر بين سوريا وتركيا وتعدد الخيارات المناسبة.
ويقول مصطفى طبشو أبو رسلان، وهو صاحب محل ألبسة في اعزاز، إنّه ومع توقف إجازات العيد، وارتفاع أسعار الدولار ثم تأرجحه، تشهد المنطقة حالة من الشلل الاقتصادي، مؤكداً أنّ الأعوام السابقة كنت تشهد إقبالاً جيداً على جميع البضائع والمحلات. ويؤكد أبو رسلان أن التحضيرات للأعياد لم تكن كسابق عهدها، خوفاً من الكساد، وهو ما كان في العيد الماضي، الذي لم يشهد ربع الإقبال مقارنةً بالأعياد السابقة.
ويوضح أبو رسلان الأثر الذي تركه توقف الإجازات بأمرين؛ الأول هو المقارنة السعرية التي كان يجريها القادمون مع نفس البضائع في تركيا وتفاوت السعر، ما يجعلهم يقبلون على شرائها، وكذلك المبالغ التي تضخ في السوق من مساعدات يقدمونها لذويهم، والتي تساعدهم على شراء ما يلزمهم.
ورغم وجود التحويلات المالية المتاحة بين تركيا وسوريا إلا أنّ أبو رسلان يقول إن للحضور والمشاهدة بـ«العين» أثرٌ مختلف، ولا يمكن لأحدٍ الوقوف على أحوال ذويه من بعيد. المشاهدة تفرض حالةً من التعاطف والمساعدة، خاصةً إذا أخذنا بالاعتبار عدم قدرة الأهالي على الشكوى لأبنائهم في «الغربة»، وللحساسية الدينية أيضاً باعتماد ألفاظ من التعفف والحمد دائماً. يرافق ذلك الهوة التي أوجدها البعد بين العائلات، إذ «يُصرّف السوريون في أذهانهم معظم المبالغ بالليرة السورية ويقارنوها بالأسعار زمن وجودهم فيها، وليس بعد تضاعفها لأضعاف كثيرة».
ويروي أبو رسلان عن ذلك قصصاً ومواقف طريفة، عن تأفف كثير من الزائرين لمحله قادمين من تركيا، حين يعلمون بسعر بنطال مثلاً بقيمة عشرة آلاف ليرة، وهو سعر متوسط حالياً، قبل أن يمضوا أياماً قليلة ليتأقلمو مع حالة الغلاء، فيبدؤون بشراء هذه الملابس لأنفسهم أيضاً عند مقارنتها بالليرة التركية. يقول أبو رسلان: «إنّ زيارات العيد تعيد للسوري ذاكرته، وتعطيه تصوراً واضحاً عن صعوبات الحياة التي يعانيها ذووه، وهو ما سيؤثر أيضاً على الحوالات المالية التي سيرسلها بعد عودته، إن توفرت».
ويضيف أبو رسلان لبنةً جديدة لأسباب هذه الزيارات، إذ يخبرنا أن مشاريع تُبنى لبعض أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في سوريا من جديد، كسوق العقارات السكنية وبعض المحلات، وشراء الأراضي الزراعية، وبناء شراكات بين تركيا والداخل السوري على صعيد التجارة.
بدي شوف ولادهم
تشتّتْ العائلات السورية في مختلف بلدان العالم، ويبقى اللاجئون في تركيا الأوفر حظاً باحتمال التئامها وإن في مناسباتٍ معينةٍ وأشهرٍ أو أيامٍ قليلة. تقول أم محمد، وهي أمٌّ لثلاثة شبان يعيشون في تركيا، إنّ زيارة العيد كانت تمثل لها كل حياتها، بالاطمئنان على أولادها وأحفادها ولمسهم بيديها. تخبرنا أنها لا تستطيع العيش في تركيا، خاصةً مع عدم قدرة باقي أبنائها وزوجها على الدخول عن طربق التهريب، ولكونها لا تستطيع ترك منزلها وقريتها حيث عاشت طيلة حياتها. وتقول أيضاً: «صدري يضيق في كل مرةٍ أتذكّر فيها أنني لن أرى أحداً منهم في هذا العيد، وهو ما دفعني للامتناع عن تحضير أي مظهرٍ من مظاهره، فلا عيد بدونهم». هكذا «أتت الأوامر»، تقول ابنتها مريم، وهي تخبرنا أنّ والدتها لم تصنع كعكاً وفرضت عليهم الامتناع عن لبس ثيابٍ جديدة، كذلك أمضت عيد الفطر الماضي بالبكاء واكتفت بالصلاة والدعاء.
أم محمد مثلها مثل غيرها من الأمهات السوريات اللواتي فقدن عيدهن، بعد أن بات التعلّق بمعبرٍ مغلقٍ كلّ أحلامهن، يدعون الله بالفرج، ويلعنّ كورونا الذي حرمهنّ من لحظةٍ يشعرن فيها بالفرح. يقلن إن إغلاق المعابر في العيد الماضي كان مفهوماً، أما في العيد الحالي فلم يعد كذلك، إذ فتحت الدنيا حدودها رغم المرض. وكذلك، كل يومٍ يدخل عبر المعابر الأربعة مئات الأشخاص من حملة التصريحات دون ممارسة حجرٍ أو تحليل، كل ما في الأمر أن يرتدوا الكمامة ويقيسوا الحرارة، إلا أنهنّ سرعان ما يتراجعن عن ذلك بالقول: «المهم يكونوا بخير».
شكلت زيارات العيد خلال السنوات السابقة شريان حياةٍ لمناطق المعارضة السورية، اقتصادياً واجتماعياً، وكانت خطوةً أولى لمعرفة الواقع الحياتي لذويهم والمنطقة، معرفة أسهمت في عودة أشخاص كثُر للاستقرار داخل سوريا من جديد. كذلك، أسهمت في تنشيط عجلة الحياة الاقتصادية، وحققت توازناً نفسياً وعاطفياً بعد أن باتت متنفساً للسوريين للعودة إلى ذاكرتهم وحياتهم الاجتماعية وتقاليدهم التي ألفوها، وأراحتهم من صفة «اللاجئ»، هناك، حيث البيت بيتهم وسكانه هم أهلهم وذووهم.