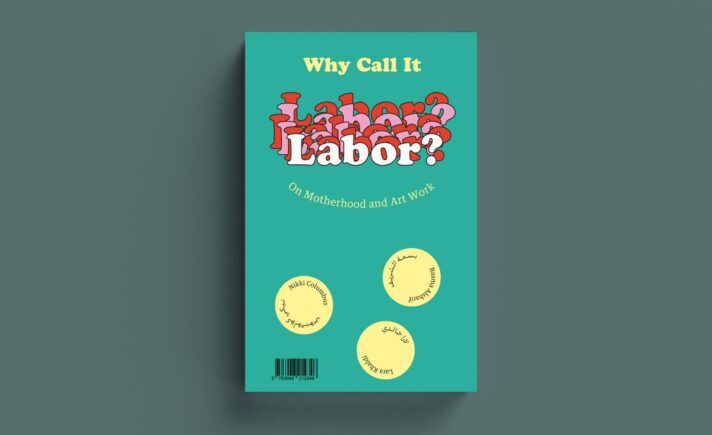أثناء بحثي السري عن السعادة في الأوقات التي يتسلل فيها الحزن والكآبة إلى داخلي، لجأتُ إلى غوغل بحثاً عن تلك السعادة المنشودة، ووجدتُ كماً هائلاً من المؤلفات والفيديوهات التي تُعلّمنا كيف تكون السعادة، وما هي العقبات التي تقف في طريقنا إليها. أخجل، كما يخجل غيري من الأصدقاء والزملاء، من الاعتراف بأني لجأتُ في بحثي البائس إلى قراءة مؤلفات التنمية الذاتية، وتتبُّع بعض من الوسائل الفاشلة التي ينصح بها خبراء «العقل الباطن» من أجل مستويات أعلى من الرضى الذاتي والامتنان وحب الذات، وغيره من الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر ولا ينتج إلّا هوساً عصابياً بالوصول إلى لحظة منتظرة، يكون المرء فيها سعيداً. هذا الهوس ذاته هو مصدر الربح الأساسي الذي يعتمد عليه العاملون في مجال صناعة السعادة.
للأسف، لم ترشدني خوارزمية غوغل، عند بحثي هذا عن السعادة، إلى كتاب وعد السعادة لسارة أحمد. وهذا مفهوم، لأن هذا الكتاب لا يعلمنا التقبل والتكيف والامتنان والتسليم بالوضع الراهن، ما يعني أنه لا ينتمي إلى سوق «صناعة السعادة» الرائج. على العكس تماماً، يعلّمنا هذا الكتاب اكتشاف أسباب انعدام الإحساس بالسعادة الذي يسكننا طوال الوقت، بحيث تبدو لنا السعادة وكأنها لحظة مفقودة، وكأن هناك احتمالاً كبيراً بأننا فقدناها في الماضي، فلا يبقى لنا إلا مشاعر نوستالجية؛ أو أن هذا السعادة قد تأتي في وقت ما في المستقبل، فلا يمكننا في هذه الحالة إلّا انتظارها والعمل من أجل الوصول إليها. وصلتُ إلى كتاب وعد السعادة، الذي صدر عام 2010، من طريق مغايرة تماماً، وذلك بعد قراءة مقال عن النسوية والاكتئاب النسوي لإسراء صالح ، ذكرت كاتبة المقال فيه عنوان الكتاب واسم الكاتبة. ولأني أبحث عن السعادة لجأتُ فوراً إلى قراءته، وفُتحت أعيني على عوالم أخرى لم أستطع وحدي تسميتها أو تشخيصها.
سارة أحمد (1969) كاتبة بريطانية أسترالية من أب باكستاني وأم إنجليزية، وهي باحثة في مجال الدراسات الثقافية والنِسوية بشكل خاص. إلّا أن سارة أحمد تستند في أبحاثها ومؤلفاتها على ما هو أوسع من النظرية النسوية، أي التقاطعية التي تجمع بين قضايا أخرى بمحاذاة القضايا النسوية ولا تنفصل عنها، مثل القضايا الكويرية ومناهضة العنصرية. هذه التقاطعية ليست نظرية بحثية بالنسبة لسارة أحمد، بل تشكل جزءاً أساسياً من هويتها الخاصة بما أنها كاتبة وباحثة نسوية، مثلية الجنس، ومن أصحاب البشرة الملونة، وابنة من الجيل الثاني لعائلة مهاجرة. عُرِفَت سارة أحمد على نطاق واسع من خلال مدونتها نسويات قاتلات للبهجة، التي نشرت فيها مانفيستو أول عن النسويات قاتلات البهجة في آب (أغسطس) عام 2013، بالإضافة إلى مجموعة من المؤلفات الأخرى، منها كتاب السياسات الثقافية للشعور The Cultural Politics of Emotion, 2004.(2004) وكتاب فينومينولوجيا الكوير Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others,2007. (2006) وأحدثها كتاب أن تحيا حياةً نسوية Living a Feminist Life,2017. (2017).
لا يمكننا أن نتوقع إيجاد السعادة المنشودة في هذا الكتاب، لكن ما يمكنه أن يُهدّئ بحثنا المحموم عن السعادة هو اكتشاف الطرق والديناميكيات التي جعلت من السعادة شيئاً مفقوداً، لا يمكن الوصول إليه إلّا إذا اقترن بمجموعة من الصفات والسِمات وطرق الحياة، ما يجعل شعورنا بالسعادة صعب المنال، مثل ارتباط السعادة بالفضيلة والعمل الشاق والرخاء وفعل الخير من أجل الآخرين. كما أنه من الضروري الاعتراف بأن هذه الدعوات من أجل التفكير بإيجابية، والبقاء إيجابيين حيال ما يحدث لنا، ليست إّلا غطاء سياسياً واجتماعياً فُرض علينا، يخفي تحته مشاعرَ ضاغطة ومختلفة من الحزن والاكتئاب والغضب.
فالسعادة التي من المفترض أن تتحقق بالزواج والإنجاب والرخاء المادي ليست ما نبحث عنه، بل هي المحددات التي يجب تحقيقها والعيش وفقها من أجل أن نصبح سعداءَ يوماً ما. محددات السعادة تلك هي بمثابة عقد اجتماعي، ووسيلة للحفاظ على وضع قائم يخفي تحته ظلماً واضطهاداً وممارسات عنصرية تحرّم السعادة على فئات معينة من المجتمع وتشرّعها بالنسبة لآخرين. أما طريق السعادة، بحسب ما تشرح سارة أحمد في الفصل الأول من الكتاب، فهو ينطوي بالضرورة على «تشجيع العودة إلى المُثل الاجتماعية العليا التي تضمن سعادة المجتمع، في حين أن الفشل في الوصول إلى السعادة ليس سببه المثل الاجتماعية القائمة بل الفشل في تتبّع هذه المثل».
ليس من السهل الإفصاح عن مشاعر الغضب والبؤس لأن السعادة، بحسب ما يُروَّج، هي التزام ومسؤولية تجاه الإحساس الجمعي بالرضى، ولذلك فإن أي تعبير عن عدم الإحساس بالسعادة هو مسؤولية فردية يتحملها الأفراد، أو الفئات، الذين فشلوا في الوصول إلى السعادة.
تُركّز سارة أحمد في بحثها حول تأثير سياسات السعادة وديناميكيتها على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات؛ النساء والمثليون/ات جنسياً والمهاجرون/ات في المجتمعات متعددة الثقافات. تبدو العودة إلى هذا الكتاب، والتفكير بالنسوية والكويرية والعنصرية من منظور السعادة، وغيرها من الأفكار التي طرحتها سارة أحمد في الكتاب منذ عام 2010، راهنةً جداً في ظل الحديث المستمر عن حقوق النساء والمثليين والعابرين جنسياً، وحقوق اللاجئين وسياسات الاندماج المتبعة، والاضطهاد المتكرر والمستمر لهذه الفئات، على شكل جرائم شرف واغتصاب بحق النساء، وانتحار، وتجريم للمثلية الجنسية، وقتل وترحيل اللاجئين والمهاجرين أصحاب البشرة السمراء.
لماذا تشعر النسويات بعدم السعادة؟
يعرف كل واحد أو واحدة منّا عدداً لا بأس به من الصديقات والزميلات اللواتي أصبحن ربّات البيوت، لديهنّ زوج وأطفال وبيت واسع ونظيف ويتمتعن بظروف معيشية جيدة، لكن كم واحدة منهنّ يمكن وصفها بأنها ربة بيت سعيدة؟ كم واحدة منهنّ تشعر بالرضى حيال أداء الواجبات المنزلية والزوجية وواجبات الأمومة؟
تمتلك ربات المنزل أسباب السعادة المتفق عليها اجتماعياً وجندرياً، ولذلك فمن المتوقع منهنّ أن يشعرنَ بالسعادة طالما أن مصادرها متوفرة، أي البيت والأطفال والرجل الذي يتكفل بتكاليف الحياة وتأمينها. لكن الحقيقة التي يتم تجاهلها هي أن ابتسامة ربة المنزل أمام المجتمع تُخفي ورائها علامات التعب والاضطهاد والعزلة والتحييد عن ميدان الحياة العامة.
وعند الحديث عن ربات المنزل البائسات، تُوجَّهُ التهمة تلقائياً إلى النساء اللواتي لا يُدركن النعيم الموفَّرَ لهنّ، بدلاً من الاعتراف بأسباب شعورهنّ بعدم السعادة التي انتظرتها النساء منذ الطفولة، نتيجة توجيههنّ بشكل أساسي نحو حلم الزواج والارتباط والإنجاب. لا سيما وأن اكتشاف الشعور الحقيقي وراء دور ربة البيت السعيدة الذي يروّج له، ما هو إلّا وظيفة اجتماعية في البيت والعائلة. بكلمات أخرى، يجب على ربات البيوت أن يَكُنّ سعيدات، لأن دورهن في البيوت هو تأمين الشعور بالسعادة والراحة للرجل والأولاد والأب والعائلة ككل.
كما أن سعادة النساء لا تعني شعورهنّ الخاص، بحدّ ذاتهنّ، بالسعادة، بل هي أيضاً «سعادة مشروطة» كما تسميها سارة أحمد، لأنها لا تتحقق إلا بموافقة الجماعة على أن مصدر السعادة، أو الغرض الذي يحقق السعادة، يتناسب مع مصادر السعادة للأب والأم والزوج وكامل العائلة. بمعنى آخر، «إذا شعرت إحداهن بالسعادة بسبب X، يجب أن يحقق X السعادة لكامل العائلة حتى تكون هذه السعادة مشروعة». يمكننا، وبسهولة، البحث عن هذه العلاقة المتعدية بين النساء والآخرين فيما يخص الشعور بالسعادة في تاريخنا الخاص، إذ ما علينا إلّا أن نفكر في عدد المرات التي حُرِّمَت علينا فيها صداقات وعلاقات حب أو مهنة ما لأنها لا تُحقق السعادة للعائلة والمجتمع من حولنا.
وماهو أسوأ من ذلك، أن شعور النساء بعدم السعادة، أو مجرد تعبيرهنّ عن ذلك، هو أيضاً إفساد لبهجة الآخرين أو تعبير عن عدم الاتفاق مع الخطوط المتفق عليها. لذلك ارتبطت النسوية بالشعور بعدم السعادة، ولذلك استحقت النسويات لقب «قاتلات البهجة» عن جدارة. من جهة أخرى، يجدر التنويه إلى أن النسويات لم يصبحن نسويات بسبب فشلهنّ في تحقيق السعادة، بل إن النسويات لا يشعرن بالسعادة بسبب سياسات وممارسات مسؤولة عن بؤسهنّ وغضبهنّ. كما أن النساء غير السعيدات لم يصبحن نسويات بسبب إحساسهنّ بالغيرة والحسد من اللواتي وصلنَ إلى السعادة، بل إن السبب المباشر هو ولادة الوعي النسوي الذي تكتسبه النساء، ويفتح أعينهنّ على حقيقة أن سعادة ربات البيوت ليس شعوراً خاصاً بهنّ، بل واجب لا يتجزأ عن واجبات الدور الاجتماعي، والتبسم حتى عند عدم الشعور بالراحة أو الانزعاج هو مسؤولية اجتماعية ضاغطة لعدم إفساد بهجة الآخرين المجتمعين على مائدة، أو عند تبادل النكات المهينة للنساء.
تشرح الكاتبة في الفصل الثاني من الكتاب كيف يتحول وعي النساء وإدراكهن بعدم سعادتهنّ إلى سبب أساسي في غربتهنّ الداخلية، في البيت وضمن المجموعة: «أن تدرك النساء كونهنّ “لا” أو “غير” سعيدات، هو بمثابة إدراكهنّ لحقيقة أنهنّ يفتقرنَ لمؤهلاتِ أو مستلزماتِ السعادة. أن تكوني غير سعيدة هو أن توجَّه عيون الآخرين إليكِ، في العالم الأبيض، المتشكّل حول الأجساد البيضاء. الوعي “أنكِ لستِ” ينطوي على إحساس بغربة داخلية؛ تدركين نفسك كشخص غريب».

أعاد هذا النقاش إلى ذهني مشهداً من فيلم The Assistant للمخرجة كيتي غرين المُنتج عام 2019، عندما تقرر الشابة التي تعمل كمساعدة في مكتب المدير أن تبلّغ عن ممارسات مديرها في العمل تجاه النساء الشابات اللواتي يُحضرهنّ إلى المكتب ليلاً، ويُرافقهن إلى الفندق، ويستغل موافقتهن وحاجتهن من أجل ممارسة الجنس معهن. تتوجه المساعدة الشابة إلى أحد الموظفين المسؤولين للتبليغ عن المدير، إلا أنها لا تسمع منه أي رد سوى أن كل ما عليها فعله هو التأقلم مع حقيقة أن النساء الأخريات اللواتي يتحرش بهنّ المدير هنّ أكثر جاذبية منها، وألا تدع إحساسها بالغيرة والحسد يفسد عليها عملها ويفسد «بهجة» المدير.
تفتح سارة أحمد الفصل الثالث من الكتاب، عن الكوير غير السعيد، بقصة عن كتاب حريق الربيع Spring Fire، الصادر عام 1952، والذي اضطرت فيه الكاتبة فين باكر (Vin Packer) إلى جعل نهاية الرواية غير سعيدة من أجل إرضاء ذوق الرقابة آنذاك، إذ لم يكن من الممكن أن تُنشر رواية عن المثلية الجنسية وأن ينتهي أبطالها إلى مصير سعيد، لأن ذلك سيحمل معنى تشجيعياً على المثلية الجنسية لا يتوافق مع أخلاق المجتمع السائدة التي تقدس العائلة التقليدية (التي يُتوقّع أن تتناسب سعادتها طرداً مع التزامها بالتقاليد). فوفق هذه الأخلاق، لا يمكن النظر إلى المثلية الجنسية إلا بوصفها انحرافاً عن السيناريوهات المحددة مسبقاً، والتي تؤدي إلى السعادة.
لم يُنظر إلى المثليين والمثليات جنسياً على أنهم أفراد غير سعيدين فحسب، بل أيضاً على أنهم أسباب للتعاسة أو الاحساس بعدم السعادة حيثما وُجدوا، حتى في العائلات التي ينتمون إليها، ما يجعل الآخرين يخشون الاختلاط بهم أو الإفصاح عن علاقة تجمعهم بأفراد مثليين جنسياً، خشية أن تجلب لهم هذه العلاقة بؤساً اجتماعياً، أو عدوى بالبؤس وعدم السعادة بسبب الانحراف عن خطوط السعادة الموجودة مسبقاً.
حتى الجمل المعتادة التي يرددها الأب أو الأم المتفهمان عند مصارحة الطفل الكوير بمثليته الجنسية؛ «افعل ما تشاء طالما أن ذلك يجعلك سعيداً. أريدك فقط أن تكون سعيداً. وأنا سعيد طالما أنك أن سعيد»، فهي تحيلنا، مجدداً، إلى السعادة المشروطة. تحاول أن توضح الكاتبة أثر جملة كهذه والرسائل الضمنية المقصودة منها، فهذه الجملة كما تقول أحمد تدلّ على القبول والتسامح مع فشل الطفل الكوير بأن يرث قواعد السعادة في العالم الذي جاء إليه، لكنها بالمقابل تذكرنا بالأشياء التي يجب أن نفعلها حتى نكون سعداء ونحقق السعادة للآخرين من حولنا. تشير هذه الجملة أيضاً إلى جزء محدد من الحرية المتاحة، لكنها في الوقت ذاته تحاول إعادة توجيه الأفراد نحو خيارات ومسارات جاهزة من أجل تحقيق السعادة. وتصبح جملة «افعل ما تشاء طالما أن ذلك يجعلك سعيداً» وكأنها حكمٌ مسبقٌ على الكوير بحياة غير سعيدة. والحكم بغير السعادة يولد الشعور بعدم السعادة فعلاً.
فشلت المجتمعات في تحقيق الاعتراف العادل بالحب الكويري لأن هذه العلاقات لا تثمر، وليس لها جدوى اجتماعية متمثلة بالإنجاب. وإذا كان الغرض من علاقات الحب بين الرجل والمرأة هو تحقيق السعادة، فإن شعور الحب في حد ذاته هو مطرح للتساؤل والشك في علاقات الحب الكويرية. قَسّمَ هذا الاعتراف الرسمي بعلاقات الحب المغايرة جنسياً علاقات الحب إلى علاقات «سوية» بين المغايرين جنسياً تحقق سعادة تشاركية؛ أما علاقات الحب الكويرية، غير السعيدة، فتتم إزاحتها إلى الهوامش، حيث يختبئ الأفراد التعساء بما فيهم المثليون جنسياً.
أشد لحظات التي يتكثف فيها حزن الكوير وبؤسه بسبب عدم اعتراف المجتمع بالحب الكويري، هي لحظة موت الشريك. في هذه اللحظة، حتى الحزن وإعلان الحداد على فقدان الحبيب أو الحبيبة يجب أن يُخبّأ تحت عنوان «الصداقة المقربة»، ويتم تجاهله من قبل العائلة أو من قبل أقارب، لأنه ليساً حباً مشروعاً أو معترفاً به، ولا يمتلك أحد صفة تؤهل الكوير أن ينتحب على موت الحبيب كما بالنسبة لأفراد العائلة أو الزوج والزوجة. الاعتراف والقبول بالحب الكويري قد يكون وعداً بالسعادة، لكن لا ننسى أن الحصول على القبول سيحدث في مجتمعات قد قررت وكرّست مسبقاً ما هو المقبول.
يعيش المثليون والمثليات جنسياً حياة بائسة فعلاً، ليس لأنهم لا يجدون السعادة في علاقات الحب، بل لأن نضالهم لا يمكن أن يظل معاناة من غير أمل أو طموح بحياة أفضل وأكثر عدلاً.
هذا الأمل والتطلع نحو حياة يمكن احتمالها هو حاجة ملّحة، تُعبّر عنها أحمد من خلال العودة إلى الجذور اللاتينية لكلمة aspiration، التي تعني بالانجليزية الطموح أو التطلع نحو تحقيق أمل ما، أما الجذور اللاتينية للكلمة ذاتها فهي تعني أن تتنفس. إذاً، يجب أن يُمنح الكويرون مجالاً ومساحة أكبر لأن يتنفسوا بحرية أكبر.
المهاجر الميلانكولي
المجتمعات متعددة الثقافات هي المجتمعات المرشحة أكثر من غيرها لأن تكون مجتمعات غير سعيدة، وذلك لأن وصول المهاجرين إليها يُخرج السكان المحليين من دائرة الراحة والأمان. ومن أجل أن تكون المجتمعات متعددةُ الثقافات سعيدة مجدداً، يجب أن يتم التركيز على تحقيق مستوى من الانسجام والاندماج بين المهاجرين والسكان المحليين، المبني على التشارك في قيم وولاءات محددة تُمكّن المجتمعات متعددة الثقافات من استعادة السعادة بوصفها مادة لاصقة اجتماعية تجمع أفراد المجتمع سوية، وبهذا يصبح الاندماج بحسب تعبير الكاتبة «أكثر من مجرد طموح، بل وسيلة للحفاظ على البقاء».
توجه سارة أحمد انتقاداً لسياسات الاندماج السائدة، وذلك من خلال استعادة التاريخ الاستعماري للامبراطورية البريطانية في الهند، والمحاججات التي استند عليها مفكرو المذهب النفعي من أجل تبرير الأهداف الاستعمارية للامبراطورية التي كانت تسعى لتعظيم عدد الأفراد السعداء في امبراطوريتها. هذا الهدف، في واقع الأمر، يدل على رغبة الامبراطورية البريطانية بضم عدد أكبر من الأفراد تحت قيم وأخلاقيات إنكليزية، لا يمكن تحقيق السعادة إلا بتتبعها والانصياع لها. تم التنظير للسعادة في الفترة التاريخية الاستعمارية البريطانية في الهند، بكونها مقياساً للحضارة، ولم تكتفِ الكولونيالية البريطانية بتبرير أهدافها بنشر السعادة انطلاقاً من التضحية ومحبة الخير، ولم يكن هدفها زيادة نسبة الشعور بالسعادة عند الأفراد، بل أيضاً تعليمهم كيف يمكنهم أن يكونوا سعداء ومتحضرين من خلال اكتساب عادات جديدة.
مفهوم السعادة المشروطة الذي أسست له أحمد في الفصول السابقة من الكتاب يتخذ أبعاداً مختلفة في سياق الحديث عن الكولونيالية الإنجليزية. من جهة الكولونيالية، ينص مبدأ السعادة المشروطة على أن سعادة الهنود واجب من أجل تحقيق سعادة المستعمر الإنكليزي، الذي أخذ على عاتقه مسؤولية نشر السعادة في المستعمرات. لكن تطبيق مبدأ السعادة المشروطة ليس معكوساً في حالة المهاجر القادم من الهند مثلاً إلى إنكلترا، أي أن سعادة المهاجر ليست أولوية في هذه الحالة بل هي سعادة المواطن الأبيض «الواصل أولاً» بحسب تعبير الكاتبة. وذلك معناه أنَّ مصدر سعادة المهاجرين يجب أن يتناسب مع سعادة السكان المحليين بحسب الخطوط والمعايير المتفق عليها من أجل تحقيق السعادة. أما وعد السعادة بالنسبة للمهاجرين، فهو يكمن في أن يصبحوا يوماً مواطنين في الدول التي وصلوا إليها.
وقبل الخوض في أسباب ميلانكوليا المهاجرين، علينا أن نوضح معنى وسبب استخدام كلمة ميلانكوليا بالتحديد. عادةً تُستخدم الميلانكوليا أو الميلانخوليا في اللغة العربية لوصف حالة الحزن أو الاكتئاب، لكن في كتابها تفسر لنا سارة أحمد السبب الذي دفعها لاستخدامها هذه المفردة تحديداً لوصف شعور بعض المهاجرين بعد خوض رحلة الهجرة، وذلك استناداً على الفرق الذي نَظَّرَ له فرويد بين الحزن الشديد على موت أحد الأحبّة (Mourning) وبين الميلانكوليا.
بحسب فرويد، الحزن الشديد والتفجع عند موت أحد الأحبة هو حالة صحية تساعد الشخص على إدراك ما الذي خسره، وأن هذا الحبيب المتوفى لم يعد موجوداً في هذا العالم، وذلك ما يساعد الشخص الحزين على الإقرار بخسارته والتسليم بها «to let go». أما الميلانكوليا، التي تُصنَّفُ كواحدة من الأمراض النفسية، فهي طريقة معاكسة للتفجع وقبول الخسارة؛ التمسك بهذه الخسارة وصعوبة الإقرار بها (To hold on).
تركز سارة أحمد اهتمامها على التفكير في هذا الشيء المفقود، أو الذي تمت خسارته. في حالة الموت، الأمر أشد وضوحاً ومن الأسهل تحديد الشيء المفقود، أما في حالة الميلانكوليا، يبدو من الصعب التعرّف على الشيء المفقود لأنه غالباً ما يكون مجرداً ولا يأخذ شكلاً محدداً، ومن الصعب أن يعرف الشخص الميلانكولي ما الذي خسره فعلاً، وما إذا كان الشيء الذي خسره قد فُقد فعلاً.
«متى يمكننا أن نحكم على شخص ما بأنه شخص ميلانكولي؟ وهل الميلانكوليا أصبحت حكماً ضد الأشخاص الذي يتكلمون عن خسائرهم؟ هل من الممكن أن نحكم على أشخاص مهاجرين بأنهم مصابون بالميلانكوليا بسبب خسائر غير محددة تماماً تم نعيها وتصنيفها على أنها ميتة من قبل آخرين وبالنيابة عنهم؟». تطرح أحمد هذه الأسئلة حول تشخيص الميلانكوليا عند المهاجرين في المجتمعات التي وصلوا إليها، وآلية التعامل معهم فيما يخص خسائرهم، التي يمكن أن تكون جملة من الأشياء الكثيرة التي يفقدها المهاجرون، مثل البيت، الأمان ، الوطن… «شيء ما مفقود».
يُفهم المهاجر الميلانكولي على أنه فرد فشل في إنهاء عملية التحول والاهتداء إلى طريق السعادة بحسب المحددات الجديدة، لأن ما يسعده يختلف عن ما يسعد الآخرين، لكن سعادة الآخرين أولوية، ومن واجب المهاجر أن يكون سعيداً بما يتلائم مع سعادة المجتمع الجديد، ولو أن ذلك يعني التخلي عن عالم ماضي وعن ذاكرة وعن قيم تنتمي للعالم القديم والاندماج مع المجتمع الجديد من أجل مجتمعات متعددة الثقافات منسجمة وسعيدة.
كتاب وعد السعادة لا يفتح أعيننا فقط على أسباب الكآبة والحزن اللذين يتسللان إلى داخلنا من وقت إلى آخر، بل أيضاً يشجعنا على رفض مطارتنا السعادة حسب المحددات القسرية المطلوبة والمفروضة على أجسادنا وأرواحنا، لأننا سندرك في لحظة متأخرة أننا في خضمّ مطاردتنا اللاهثة للسعادة، نطحن ذواتنا، ونعيد تصميم أجسادنا ورغباتنا وإعادة توجيه تطلعاتنا نحو وجهات لا نرغب أبداً بالوصول إليها.
وعندما تلاحقنا الأسئلة الضاغطة من كل صوب، مثل متى ستنجبين طفلاً ؟ متى ستتزوج؟ هل فكرت يوماً بالبحث عن الحب في علاقة سوية؟ إنك تعيش في أوروبا، وماذا تريد أكثر من ذلك؟ لماذا لا تعبر عن امتنانك لهذا أو ذاك؟ وغيرها من الأسئلة التي تجبرنا على تحقيق توقعات الآخرين منّا، فإنه يمكننا أن نتجرأ وأن نرفض الخوض في حرب السعادة غير العادلة، التي لا تكترث لحاجاتنا النفسية والجسدية، ولا لرغباتنا التي نسعى إليها، والتي ليست بالضرورة تُبهج الآخرين، خاصةً؛ يمكننا ذلك عندما ندرك أن قناع السعادة يُفرَض علينا لأغراض سلطوية وذكورية وعنصرية في أحيان كثيرة.