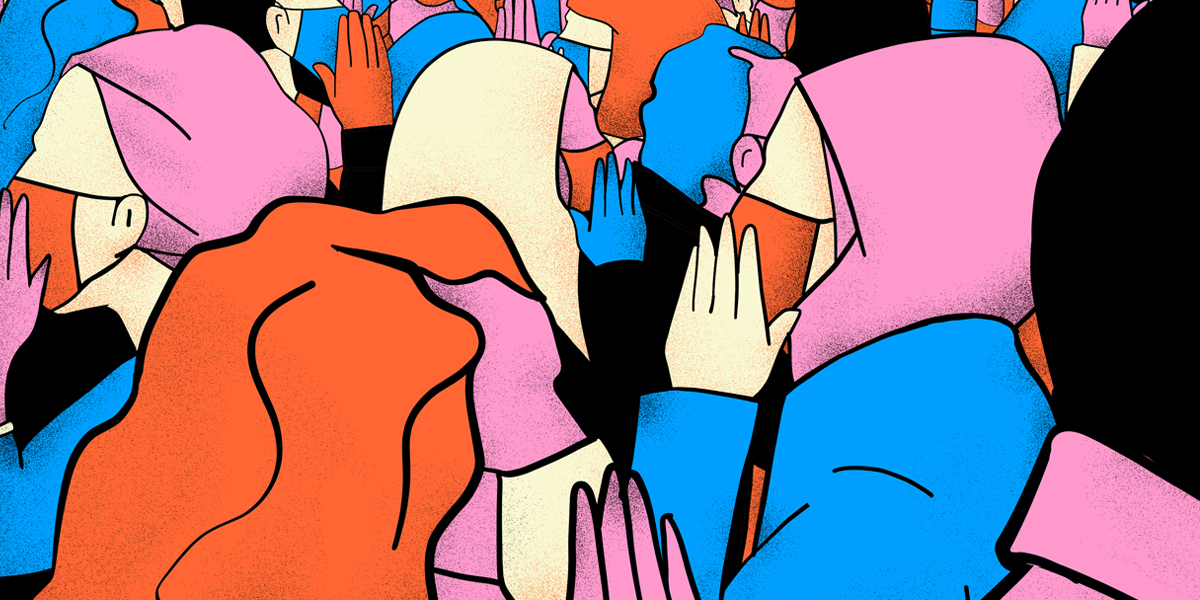إنها العاشرة ليلاً، أكتبُ هذا النص والظلام يلفّني بعد سقوط الشمعة الأخيرة صريعةَ وحش الظلام منذ نصف ساعة. انقطاع التيار الكهربائي هنا يعني انقطاع الانترنت؛ شريان المعرفة الذي يصلني بالعالم الخارجي الافتراضي. كذلك أنا منقطع عن محيطي الواقعي؛ ممنوع من الخروج من المنزل بفعل حظر التجول المفروض يومياً بعد الساعة السادسة مساء، الحظر الذي جاء بعد نفي حكومي لوجود أي إصابة في بداية الأسبوع الثاني من آذار الماضي. بعد ذلك بثلاثة أيام، أصدرت وزارتا التربية والأوقاف قراراً بتعليق الدوام في جميع المدارس، وإغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة، مع استمرار النفي الرسمي لوجود أي إصابة بالمرض.
استمرّت الحكومة في النفي أياماً بعدها، وكذلك في إصدار قرارات لتعطيل الحياة العامة مُحاوِلةً منع التجمعات، حيث قررت إغلاق جميع المطاعم والمقاهي في العاصمة، وإيقاف العديد من المؤسسات الحكومية عن العمل. وقد عطّلت هذه الإجراءات شريان الحياة في دمشق، التي لم أرها في يوم من الأيام إلى مدينة مصنوعة من ضجة وازدحام، مقارنة بالأرياف التي تحيط بها. بدأت هذه القرارات تُبطئ عمل قلب المدينة، ليأتي بعد ذلك قرارٌ بإعلان حظر التجول الليلي وإيقاف جميع جوانب الحياة باستثناء ما يخص الطعام والشراب، وتغرق العاصمة في صمت وحذر لم أشهد مثيلاً له من قبل.
الصمت الآن هو المتجول الوحيد في أحيائها، لا يكسره سوى أصوات الجنود المدججين بالسلاح لمواجهة كورونا! منذ بضعة أيام فُرِضَ حظر التجول؛ وبدأت تُسيّر دوريات من الشرطة معززة بعناصر من ميليشيات «الدفاع الوطني» لمطاردة أي شخص يعصي القرار، وبتنا لا نسمع إلا أحاديث الجند وعواء بعض الكلاب الشاردة التي أصبحت أكثر حرية من البشر في شوارع المدينة.
مقترحات الترفيه التي يعرضها رواد فيسبوك للقضاء على الملل، مثل تنزيل الألعاب الافتراضية أو مشاهدة قوائم الأفلام والمسلسلات عن طريق الإنترنت، لا يمكن أن أرى فيها الآن سوى محض ترف؛ زيارة الكهرباء يجب استغلالها بأشياء أكثر واقعية، مثل الاطلاع على آخر القرارات الرسمية التي تنظم حركتنا في البيت وخارجه على حد سواء. تصيح أختي من الغرفة المجاورة: «ابتداء من يوم الأحد سيُمنع مجيء القاطنين في الأرياف إلى المدن»، وهذا يعني أن معظم سكان العشوائيات، ومثلهم سكان غوطتَي دمشق المرتبطتين بها عضوياً، لن يستطيعوا الدخول إليها حتى إشعار آخر. ورغم تبرير هذا القرار بضرورة منع الاختلاط، إلا إنه يعيد إلى رأسي فكرة ثنائية الريف والمدينة، وكثيراً من قصص الازدراء الذي يتعرض له أهالي الأرياف عند قدومهم إلى المدن.
عند زيارة الكهرباء لمنزلنا القابع في أحد أحياء العشوائيات المحيطة بدمشق، يهرع أفراد العائلة إلى المحيط الأزرق، فيسبوك، لمعرفة آخر الأخبار، ونبدأ القراءة: سقط اليوم 1000 ضحية بوباء كورونا في إيطاليا، فتُعلِّقُ أمي بإيمانٍ فاتحةً ذراعيها للسماء بكثير من الرجاء: «يا رب… إذا بأوروبا المتطورة تموت هذه الأعداد، عندما يصلنا كم روحاً سيحصد في هذه البلاد؟ يا رب». أمي تتعامل مع الفيروس كأنه عاصفة أو إعصار جوي، ولا تجد إلا الخوف والدعاء للتصدي له.
خلال نحو تسع سنوات من المقتلة السورية، لم نكن نهتم بأعداد الضحايا خارج الجغرافيا السورية، كان حضور الموت السوري هو الذي يثير اهتمامنا وقلقنا، ويلهينا عن الأحداث والضحايا في مناطق العالم الأخرى. الآن أصبحنا أكثر اتصالاً؛ لقد وَحَّدَ كورونا الضحايا في مختلف بقاع العالم، فأعداد الوفيات في كل من إيطاليا والصين، وسرعة تفشيه في أوروبا، أمورٌ تزيد القلق من تفشيه أكثر فأكثر في بلادنا. أصبحنا نهتم بأعداد المصابين في كافة بقاع العالم، ونشعر بهم ونخاف عليهم كضحايا مفترضين للمرض رغم انفصالنا الجغرافي عنهم. أصبحنا نستقبل أخبار انتشار مرض كورونا في أي مدينة في العالم بالطريقة نفسها التي كنا نتلقى بها الأنباء عن دخول الشبيحة إلى البلدات السورية، بانتظار معرفة أعداد الضحايا. اختلفَ مكان الضحايا، وتحوَّلَ الشبّيح إلى فيروس يفتك بكافة سكان الكرة الأرضية، وأصبحنا نعيش في حالة من الشك والخوف. نتساءل؛ هل استطاعت جحافله التسرب إلى بلادنا.
*****
قرار منع الخروج من المنازل أشعر شريحة المطلوبين للخدمة الإلزامية في الجيش، ومثلهم المطلوبين لدواع سياسية، بالعدالة نوعاً ما. الآن هناك الملايين الذين يشاركونهم الحجر نفسه، الذي فرضوه على أنفسهم من قبل خوفاً من الاعتقال.
أحد الأشخاص كان مطلوباً لفرع الأمن العسكري، وكان لا يزال متخفياً خوفاً من الاعتقال، قال لي إنه يشعر بالعدالة عندما يرى جميع الناس محجورين في بيوتهم، مضيفاً أنه كان قد تمرّس بشعور الملل المستجد الذي يشعر به الناس الآن هو فيه من قبل. ومع حديثه عن الخوف من الاعتقال، راحت صور المعتقلين تدور في رأسي؛ ماذا لو دخل كورونا إلى مهاجعهم؟ ماذا لو تفشّت العدوى بينهم؟
وقد دفع الخوف من تفشي الأوبئة بشار الأسد إلى إصدار قانون عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 22 من شهر آذار الماضي، لكن هذا العفو لم يشمل المعتقلين السياسيين داخل الأفرع الأمنية، الذين لا يعترف بهم النظام أصلاً. تلاه بعد ذلك مرسوم بتسريح دفعات من الضباط وصف ضباط ممن تم الاحتفاظ بهم بعد إنهاء سنوات خدمتهم إلزامية، وهو الأمر الذي طالبوا به كثيراً في السابق دون الاستجابة لمطالبهم. زادت كلّ هذه الإجراءات من حالة القلق والتساؤلات عن مدى انتشار المرض، أو الخوف من انتشاره.
*****
السلطات الرسمية تخفي الأمر، دائرة القلق والشكوك تحيط بنا كهالة حول رؤوسنا فيما نسمع أخباراً متضاربة؛ تم اكتشاف ثلاث حالات في مستشفى المجتهد! يتناقل الناس تسجيلات على تطبيق واتساب لممرضات يُصرِّحنَ بعدد من الوفيات في مستشفى المواساة، ثم يخرج مصدر طبي لينفي هذه الأرقام وينسب الوفاة إلى التهابات في الرئة. الإجراءات الرسمية، وتضارب الأنباء، إضافة إلى انعدام الثقة بصدقية الأرقام الرسمية لدى معظم السوريين على اختلاف مشاربهم السياسية، كلّ ذلك يفاقم يومياً من حالة الخوف.

لم يلبث أن صدر تعميم طبي بعدم تداول أي معلومات طبية خارج المراكز الصحية، مرفقاً بمنع التصوير من خلال الهواتف المحمولة داخل المستشفيات، إضافة إلى منع اصطحاب المرافقين للمرضى، وذلك بحسب شهادات العديد من العاملين في المستشفيات. في حين تم إلزام طلاب الطب للسنة الخامسة والسادسة بالدوام، رغم انقطاع وسائل المواصلات العامة.
يخرج كثيرٌ من الطلاب باكراً لتقلّهم سيارات الخضار القادمة إلى دمشق، وهي السيارات الوحيدة المسموح لها بالدخول إلى العاصمة من أريافها، ومنهم من يستعملون درجات هوائية، وخاصّة القاطنين في ضواحي دمشق القريبة. سيارات الأجرة باتت تطلب أربعة أضعاف تسعيرتها، وهو ما لا قدرة لأبناء الطبقة الفقيرة على دفعه يومياً، في حين بقيت مراكز التجميل وإزالة الشعر مشرعة أبوابها، شرط أن تتحول إلى مراكز صحية تقدّم الخدمات الطبية، وهي الحالة التي تنطبق على عدد من المراكز داخل العاصمة فقط، في حين فَضَّلَت المراكز الموجودة خارج العاصمة إقفال أبوابها.
*****
الحظر الذي تفرضه علينا القرارات الرسمية، إضافة إلى زيادة التقنين في الكهرباء، أنتجَ مفهوماً آخر للوقت لدينا، فالموعد الرسمي لانتهاء اليوم هو الساعة السادسة مساء؛ ساعة بدء سريان حظر التجوال اليومي. وقد أدّى اختصار اليوم إلى اثنتي عشرة ساعة يمكن الخروج فيها من المنزل إلى تغيّر مفهومي عن الزمن؛ اثنتا عشرة ساعة مقسمة على أربعة مجموعات، ثلاث ساعات قطع، وثلاث ساعات إنارة… وهكذا. يخرج بعضنا من المنزل لتأمين احتياجاتنا، بينما لا بد أن يبقى البعض الآخر لاستغلال الكهرباء، لا سيما في ظل شحّ الوقود.
هكذا أصبح موعد يقظتنا أكثر فلاحيّة إذا صح القول؛ نستيقظ عند السادسة صباحاً، نُقسّم أوقات نومنا تزامناً مع انقطاع الكهرباء. أخرج من المنزل، أمشي وأنا أحترس من لمس الأسطح والجدران، جسدي أصبح أكثر مركزية بعد أن كنت أعتبره مساحة فالتة يمكنها أن تحتك بأي شيء دون أن أعي ذلك. ازداد وعيي بحدود جسدي، أُحاذِرُ أن ألمس أي شيء خارج حدوده. أكثر ما كان يخفيني عندما أخرج للشارع أن أمشي تحت بلكونات الأبنية المسقوفة خشية الدمار الذي قد تحدثه فيها قذيفة هاون، كنت أنظر إلى السيارات المركونة فتثير ريبتي، أخشى انفجارها في وجهي، كما أخشى دورية شرطة تتربص في هذا الحي أو ذاك. الآن، جميع مخاوفي تلك قد تلاشت، أو لنقل إنها أصبحت مخاوف قزمة أمام خوفي من كورونا.
*****
اختفى المشردون من شوارع العاصمة، المشردون الذين انتشروا بكثافة فيما سبق نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، وكنّا يفترشون الحدائق أو زوايا الأرصفة، ينامون تحت أغطية متسخة في أحسن الأحوال، وما أن أتى قرار حظر التجول حتى اختفوا، كأنهم تبخروا من شوارع العاصمة. بدأت حالة اختفاء معظم المشردين من العاصمة بعدما أجبرت محافظة دمشق القسم الأكبر منهم على الخروج منها إلى بلدات قريبة منها، فيما القسم الصغير الباقي تكفّلت به جمعيات خيرية عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
حالة الشلل التي تحاول فرضها السلطات هنا، بعد قرار إغلاق جميع المحلات في كافة المناطق التي يسيطر عليها النظام باستثناء محلات المأكولات والأغذية، أعادت تشكيل العديد من العلاقات الاقتصادية بين البائع والمشتري، فعند التجوّل في سوق البحصة للإلكترونيات أو في شارع رامي المختص ببيع المعدات الكهربائية، نجد جميع أبواب المحلات مغلقة؛ الهدوء والصمت يعم المكان، باستثناء بعض الشبان الذين ينظرون إليك نظرات معرفة مسبقة لكي تبدأ بالسؤال عمّا تحتاجه؛ يخفي هؤلاء هويتهم كأصحاب محلات أو على أقل تقدير عاملين فيها، حتى تبادر أنت بالسؤال: إلى متى سيبقى الإقفال؟ أو أين أستطيع الحصول على غرض كذا؟ فيكون الجواب دائماً: «موجود، خمس دقائق وسيكون ما تريد لديك»، لكن بسعر مضاعف بسبب الحظر.
تَحوَّلَت جميع عمليات البيع والشراء إلى ما يشبه السوق السوداء أو اقتصاد الظل، حيث يمكن شراء أي شيء بالطريقة نفسها التي تشتري فيها الحشيش أو المخدرات، أي بشكل سرّي. يتحكم البائع بالسعر ونوعية البضاعة، ولا يمكنك الاعتراض أو حتى المفاصلة، ولا الذهاب إلى أنواع أخرى أقلَّ سعراً بسبب محدودية العرض. هذا النوع من عمليات البيع والشراء يعكس حقيقة ما يجري في البلاد، حيث تبقى القوانين سارية ظاهرياً، إلا أن اقتصاد السوق السوداء هو المحرك الأساسي. الآن، أصبحت جميع عمليات البيع والشراء تحصل في السوق السوداء، دون رقيب أو حسيب.
استطاع حلّاق حارتنا، عبر حيلة يراها ذكية، أن ينجو من قرار الإغلاق، فهو يُنظّم مواعيده منذ الصباح الباكر، ويتقاطر الزبائن إلى منزله القديم، ويدخلون من باب المطبخ إلى محل الحلاقة المجاور من الباب الخلفي. تمرّ دوريات التموين والشرطة فترى المحل مغلقاً، لكن خلف الباب المغلق يجتمع الزبائن، يشربون المتة ويدخنون الأركيلة ويقصّون شعورهم، ويدفعون عن طيب الخاطر. تتكرّر طبعاً توصيات الحلّاق بعدم إفشاء السر خارج حدود الحارة.
أصحاب محلات تصليح السيارات أقفلوا محالهم، واستعاضوا عنها بحقيبة تشبه حقائب الأطباء الإسعافية، بهدف تصليح السيارات داخل الحارات والأزقة بعيداً عن عيون شرطة المحافظة. الحياة تمشي كما قبل كورونا، ولكن بعيداً عن أعين الشرطة وبتكاليف مالية أكبر بكثير، تصل أحياناً إلى ثلاث أضعاف.
*****
أَستقلُّ حافلة للعودة إلى بيتي الكائن في أحد ضواحي دمشق، نتدافع عند وصول إلى الحافلة، فلا مكان لكورونا بيننا عند حجز دور في الحافلة. الجميع يبتسم ابتسامة المنتصر بعد الظفر بكرسي للجلوس. نبدأ بجمع النقود على صوت الراديو، والحكومة تتوعد من يخرج منزله في أوقات الحظر. تُجري المذيعة حواراً مع القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي، الذي يقول فيه إن مخالفة تعليمات الحكومة هي مخالفة لشرع الله، إذ لا تجوز معصية أولي الأمر، فهذا ذنب شرعي. لم يتغير الخطاب الرسمي وشبه الرسمي منذ خمسين عاماً، دائماً يكون بلهجة وصائية استعلائية، حيث السلطة تعرف وحدها ما هو في مصلحتنا، نحن الشعب الذي لا يُقدِّرُ ولا يعرف مصلحته بسبب جهله.
يُخفِضُ السائق صوت الراديو قبيل وصول الحافلة إلى أحد الحواجز، يقف طابور من السيارات كسرب من النمل، وتتناسب سرعة عبور السيارات طرداً مع سرعة يد العنصر الذي يأمرها بالعبور، فيما تتباطئ يده عندما يشغله أي أمر ما، مثل مكالمة هاتفية أو إشعال سيجارة أو التدقيق في هويات ركّاب سيارة نمرتها إدلب أو دير الزور، أو عند استلطافه الثقيل لإحدى الراكبات في الحافلة. الجميع مرهون بحركة يد الجندي على الحاجز، هي كلمة السر التي تسمح لك بالتنقل بين مناطق دمشق.
منذ إعلان بدء الحملة ضد كورونا بحسب التوقيت المحلي، اختلف شكل الحاجز. ما يزال الجنود يرتدون بدلاتهم خاكية اللون وما تزال بنادقهم تتدلى من أعناقهم، لكنهم الآن يرتدون إضافة إلى قبعاتهم العسكرية كمّامات وكفوفاً، ويتعاملون مع لباسهم الطبي الجديد، بحسب تعبير أحد الجنود، على أنه جزء من اللباس الرسمي الذي يجب أن يراعى دون الاكتراث بالوظيفة المفترضة التي يقوم بها، مثل الوقاية والحد من الاحتكاك بالآخرين تجنباً لنقل العدوى. لا بأس لو كان العنصر لا يضع الكمامة فوق الأنف والفم كما يجب، بل ينزلها لتغطي الرقبة بما يجعل التنفس أسهل، لكنه لا يجرؤ على خلعها لأن هناك قراراً رسمياً بارتدائها.
يفتح الجندي باب الحافلة، يطلق سؤالاً مدوياً داخل الحافلة على شكل نكتة: «في حدا منكم حامل كورونا؟»، ترتسم على وجوه معظم ركاب الحافلة الابتسامة نفسها وبالقدر نفسه، استجابةً لِحس الدعابة الذي أطلقه العنصر. يذكرني هذا بالسؤال الذي كان يُطرح في بداية الثورة على الحواجز: «معك فيسبوك؟».
يبقى باب الحافلة مفتوحاً ريثما يخرج من جيبه علبة السجائر، إذ لا تساعده الكفوف التي ألزموه بلبسها في إخراج سيجارته بسرعة. يشعلها وينفث دخانها في وجوهنا، وينظر إلى سائق الحافلة قائلاً: «امشي»؛ كلمةٌ تعطينا كثيراً من الراحة إذ لا داع للتفييش وفحص الهويات، وتعطينا مزيداً من الزمن كي نستطيع العودة إلى بيوتنا قبل الساعة السادسة، توقيت بدء حظر التجوّل.
*****
يشيع على فيسبوك كلامٌ عن التسامح والوحدة العالمية، ومعه دعوات للجلوس مع الذات، وذلك الخلفية العزل الذي يفرضه كورونا. لكن هذا الكلام لا ينعكس عند السوريين في الداخل شعوراً بالراحة أو الطمأنينة التي تدفع إلى مراجعة الذات، ولا يزيدهم إلا لهاثاً وفزعاً، ليس من كورونا فقط، بل أيضاً من ازدياد صعوبة المعيشة وتحصيل قوت اليوم. ازداد لهاث السوريين على مدار اليوم، وحظر التجول أفرغ ما في جيوبهم من ليرات قليلة أصلاً، وتركهم وجهاً لوجه مع خطر الجوع في ظل تردي حالتهم الاقتصادية.
تتواصل التعليمات والفيديوهات وتصريحات المسؤولين والأطباء عن ضرورة التعقيم ومنع الاحتكاك والاختلاط، وتبقى كلّها سارية المفعول حتى الوصول إلى أبواب المؤسسة الاستهلاكية أو أحدى طاقات أفران الخبز؛ هناك تسقط كافة معايير الحجر، لا مجال للنصائح، حيث تُصَمُّ الآذان وتتكلم البطون الخاوية، التي تريد الحصول على قوت يومها قبل السادسة مساءً، موعد انتهاء اليوم. العديد من الأشخاص يقضون ساعات الصباح الأولى على أبواب المؤسسة الاستهلاكية للحصول على بعض المنتجات بأسعار مدعومة، كي لا يقعوا فريسة تسعيرات التجار. صحيحٌ أن نوعية المنتجات في المؤسسة الاستهلاكية تعتبر من الدرجة الثانية والثالثة، ولكن السؤال عن النوعية يعتبر ترفاً لأصحاب الجيوب الخاوية، لنجد أنفسنا أمام استعادة لحقبة الثمانينيات، عندما كان الحصول على الموز وعلب المحارم رفاهية.
*****
رغم الرعب العالمي الذي تسبب به المرض، إلا أن الناس هنا ما يزالون يعطون الأولوية للحصول على قوتهم اليومي. الخوف من العَوَز والجوع يرمي بثقله على الناس، إذ أن هناك قلقاً كبيراً من عدم قدرة النظام على القيام بكافة الإجراءات الاقتصادية اللازمة لتأمين مستلزمات المعيشة الأساسية للسكان، مع استمرار وتفاقم شح الوقود، وتدهور سعر صرف الليرة. عَوَز السوريين هذه المرة مختلفٌ عن أي عَوَز عانوه سابقاً، هناك قسمٌ كبيرٌ منهم يعتمدون على حوالات تأتيهم من أحد أفراد أسرتهم في الخارج، لكن الشلل الاقتصادي يضرب كافة القطاعات في العالم، إضافة إلى صعوبة في تحويل الأموال إلى سورية بسبب إغلاق عدد كبير من مكاتب التحويل لتجنّب المرض، مما حرم كثيراً من السوريين دفعات مالية كانت تسدّ رمقهم، يضاف إليها ضعف التجهيزات الطبية في المشافي العامة، وارتفاع تكلفة الاستطباب في المشافي الخاصة، بالترافق مع اكتظاظها الدائم ونقص الأدوية، ليكون القلق والصمت هو الفاعل الأكبر في العاصمة دمشق، التي يرتفع فوقها شبح الخوف من الموت جوعاً أو مرضاً.